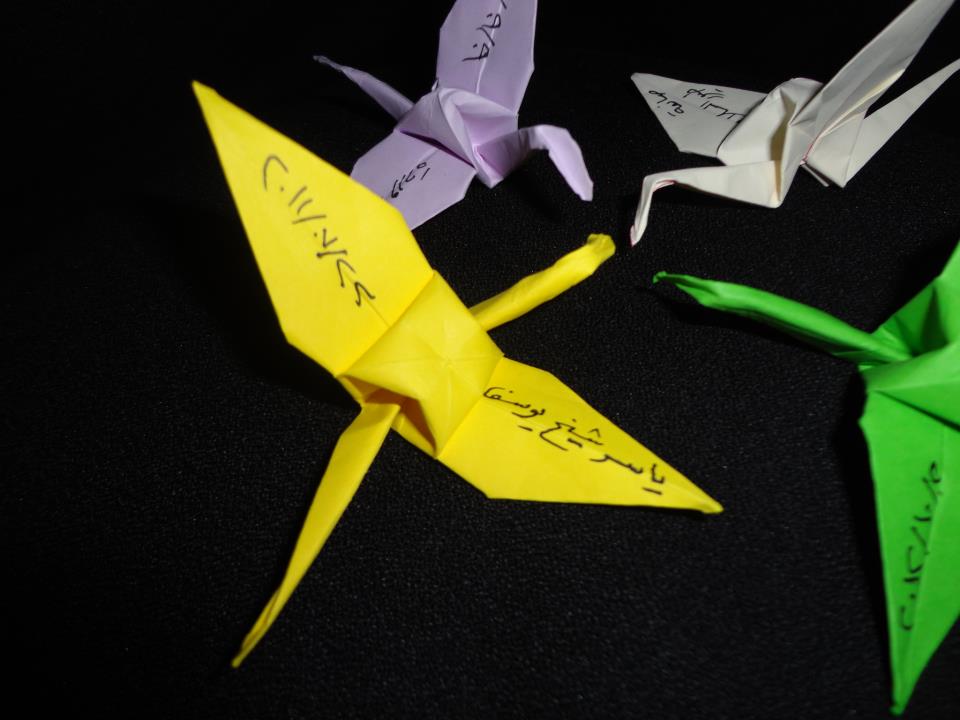أيّ داعش ـ غيت تشغل واشنطن وطهران هذه الأيام؟/ صبحي حديدي
نعمنا، خلال الأسبوع المنصرم، بسلسلة تصريحات إيرانية وأمريكية، تشير إلى طبيعة أخرى للعلاقات بين واشنطن وطهران، مخالفة لحقائق المستوى الباطن، لكي لا يقول المرء: منافية، لما يتبدى على السطوح الظاهرة. بعضها صدر عن مسؤولين على رأس عملهم (مثل حسين أمير عبد اللهيان، مساعد وزير الخارجية الإيرانية للشؤون العربية والأفريقية)؛ وبعضها الآخر عن رجال شغلوا مناصب حساسة في إدارات أمريكية سابقة، وصوتهم بالتالي ما يزال مسموعاً (مثل هنري كيسنجر وجيمس بيكر، وكلاهما تولى وزارة الخارجية).
قال عبد اللهيان (وأنكرت سوزان رايس، مستشارة البيت الأبيض للأمن القومي) إنّ إيران تتراسل مع الإدارة الأمريكية حول «داعش»، الأمر الذي يعني اشتراك طهران في التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن، رغم النفي. كما أضاف اللهيان، أو بالأحرى تقصد تسريب، تقدير إيراني تمّ إبلاغه إلى المحاوِر الأمريكي، حول الصلة بين إسقاط نظام بشار الأسد وأمن إسرائيل: «إذا أراد التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم الدولة تغيير النظام السوري، فإن أمن إسرائيل سينتهي»، حسب وكالة فارس الإيرانية؛ و: «إيران حذرت أمريكا وسائر الدول المتحالفة معها من أنّ السعي لإسقاط نظام بشار الأسد، خلال المواجهة القائمة مع داعش، سيعرض أمن إسرائيل للخطر»، حسب أسوشيتد برس.
بيكر، خلال حوار مع قناة NBC الأمريكية، قال إنّ السبب الوحيد الذي يحرج واشنطن في ضمّ طهران إلى التحالف الدولي، هو مخاطر ظهور أمريكا بمظهر حليفة الشيعة ضدّ السنّة، مفترضاً بالطبع أنّ «داعش» هي ممثلة السنّة وإيران زعيمة الشيعة. «لن أُفاجأ بأنّ إيران تساعدنا بهدوء»، قال بيكر، مشدداً من جديد على يقينه بأنّ التحالف الراهن ينبغي أن يكون أعرض بكثير مما هو عليه: «نحتاج إلى استجماع كل دول المنطقة. نحتاج إلى الاتحاد الأوروبي، وروسيا، والصين، وأنفسنا بالطبع، لإطلاق نقاش ومؤتمر ومفاوضات حول كيفية تمكين القوى المعتدلة في المنطقة، وكيف نحدّ من المتطرفين في المنطقة، وكيف نقوم بذلك كله دون إلهاب النزاع السنّي ـ الشيعي»!
في ذهن بيكر، بالطبع، وكما ذكّر محاوره ومشاهديه، ذلك «التحالف الرائع» الذي استجمعه رئيسه جورج بوش الأب، ضدّ نظام صدام حسين، قبل وخلال «عاصفة الصحراء»، 1991: 50 بلداً، أرسلوا 200 ألف جندي، بالإضافة إلى 550 ألف جندي أمريكي. ولكن… هل قتال «داعش»، وخفض قدراتها العسكرية تمهيداً للقضاء عليها كما أعلن الرئيس الأمريكي باراك أوباما، يحتاج إلى مقارنة كهذه، حقاً؟ وبأيّ عقل يستخفّ بيكر حين يشترط هذا النطاق الدبلوماسي والعسكري الكوني الأوسع، ضدّ تنظيم يعدّ بعشرات الآلاف فقط؟ ومَنْ، سوى يعض الجهلة من مشاهديه، يستغفل حين يعيد المسألة إلى محتوى تقليدي، خاطىء ومضلل، هو «النزاع السنّي ـ الشيعي»؟
المرء، في هذا السياق العريض، ولكن ضمن تداعياته العراقية خاصة، يتذكر «مجموعة دراسة العراق»، التي قادها بيكر مناصفة مع السناتور الديمقراطي لي هاملتون، سنة 2006، وهدفت إلى «إيجاد حلّ للمشكلة العراقية»؛ أو، على وجه أدقّ، مأزق أمريكا في العراق. ذلك لأنّ الحال، يومها، كما الآن إلى حدّ كبير، لم تكن «مشكلة» فقط، بل مسألة، وقضية، ومستنقع؛ ولهذا فإنّ الحلول التي اقتُرحت لم تخدم عراقاً ديمقراطياً، بل عراقاً منقسماً إلى طوائف وإثنيات؛ وخدمت مصالح أمريكا أولاً، ثمّ إيران وتركيا ثانياً، قبل خدمة طموحات العراقيين.
وحين يُسأل بيكر، اليوم، عن الفارق بين ضمّ نظام حافظ الأسد إلى تحالف «درع الصحراء» سنة 1990، والامتناع عن ضمّ نظام الاسد الابن، وكذلك إيران، إلى التحالف الراهن ضدّ «داعش»؛ يجيب: لهذا الغرض تحديداً: مخافة خلق الانطباع بأنّ الولايات المتحدة «تنخرط إلى جانب الصفّ الشيعي»، وهذا هو التفسير الضحل الذي لا ينمّ عن الجهالة وحدها، بل التجهيل أيضاً. فضيلة السؤال تقود بيكر، مع ذلك، إلى إقرار لعلّه الأوّل من طرازه، خاصة إذْ يصدر عن وزير خارجية أمريكا خلال الحقبة المعنية: اشتراك نظام الأسد في تحالف «عاصفة الصحراء»، بل مشاركة قوّاته الفعلية في بعض العمليات العسكرية كما يسجّل بيكر نفسه، كان ثمناً لإطلاق يد النظام السوري في لبنان على امتداد 15 سنة لاحقة.
في الحوار ذاته، مع NBC، ذكّرنا كيسنجر بما لا نجهل: أنّ «إيران الدولة حليف طبيعي للولايات المتحدة»، ولا يقوم العداء بين البلدين إلا على مستويات دينية وإيديولوجية؛ وبالتالي، ليس عجيباً، ولا طارئاً، أن تتعاون طهران مع التحالف الدولي، سواء ضُمّت إليه علانية، أم انخرطت فيه سرّاً. ولن يكون هذا التصريح عجيباً، ولا طارئاً، إذا استعاد المرء حقيقة كبرى في تاريخ العلاقات الأمريكية ـ الإيرانية: في عام 1975 وقّع وزير الخارجية آنذاك، كيسنجر نفسه، ما يُعرف باسم «مذكرة القرار الأمني 292»، التي أرست دعائم التعاون النووي الأمريكي ـ الإيراني، بقيمة استثمارية صافية تبلغ ستة مليارات. وبعد سنة فقط، وقّع الرئيس الأمريكي جيرالد فورد أمراً إدارياً بتمكين إيران من شراء وتشغيل منشأة تتيح فصل البلوتونيوم، أي المرحلة الأعلى في تصنيع القنبلة النووية!.
كذلك فإنّ البرنامج النووي الإيراني لم ينطلق في عهد الثورة الإسلامية الإيرانية (1979)، بل قبل اندلاعها بما يقارب ربع قرن، في أيام الشاه رضا بهلوي؛ وكان البرنامج جزءاً من ألعاب الشدّ والجذب بين واشنطن وموسكو، خلال عقود الحرب الباردة؛ ولهذا فإنّ الولايات المتحدة الأمريكية هي الجهة التي رعت وأشرفت على تنفيذ البرنامج. كذلك كانت واشنطن هي التي زوّدت طهران بمفاعل نووي طاقته 5 ميغاواط، وأمّدت المفاعل بالوقود اللازم، أي اليورانيوم المخصّب (نعم: اليورانيوم المخصّب ذاته الذي يقيم الدنيا ولا يقعدها اليوم!)، كما قبلت إقامة منشآت لتخصيب اليورانيوم في إيران.
صحيح أنّ إيران الشاهنشاهية ليست إيران الخمينية أو الخامنئية، ولكن على مستوى مقتضيات الدولة، تماماً كما يشير كيسنجر وتبرهن تصريحات عبد اللهيان، هل تغيّرت شبكات المصالح كثيراً، حقاً؟ وهل وقعت فضيحة «إيران ـ غيت» أيام الشاه، أم في حياة آية الله الخميني ورونالد ريغان، بمباركة إسرائيل؟ كلا، بالطبع، ولحمقى «الممانعة» أن يعمهوا في الحمق، الغريزي أو المصطنع، حين تواصل حشودهم هتاف «الموت لأمريكا»؛ وفي الآن ذاته تواصل طهران، راعية «الممانعين»، خدمة أمريكا وإسرائيل، في العراق وسوريا ولبنان واليمن…
وتبقى استعادة أخيرة، في مناسبة حديث كيسنجر اليوم عن الخلافات الإيديولوجية والدينية باعتبارها أدنى قيمة في علاقات الدول، من المصالح. ففي سنة 2006، كتب كيسنجر ما يلي عن العراق: «من المؤكد أنّ التاريخ لا يكرّر نفسه بدقّة. فييتنام كانت معركة تخصّ الحرب الباردة؛ وأمّا العراق فهو أحدوثة في الصراع ضدّ الإسلام الجذري. لقد فُهم أنّ تحدّي الحرب الباردة هو البقاء السياسي للأمم ـ الدول المستقلة المتحالفة مع الولايات المتحدة والمحيطة بالاتحاد السوفييتي. لكنّ الحرب في العراق لا تدور حول الشأن الجيو ـ سياسي بقدر ما تدور حول صدام الإيديولوجيات والثقافات والعقائد الدينية. ولأنّ التحدّي الإسلامي بعيد النطاق، فإنّ الحصيلة في العراق سيكون لها من المغزى العميق أكثر ممّا كان لفييتنام».
أين ذهب ذلك المغزى، اليوم؟ أهو في باطن كيسنجر، أم في ظاهر «الخليفة» البغدادي؟ و
٭ كاتب وباحث سوري يقيم في باريس
البغدادي إلى بغداد/ بشير البكر
كل المعطيات تشير إلى أن “داعش” وضع بغداد هدفاً رئيسياً، وهو يحشد، منذ أن اجتاح الموصل في العاشر من يونيو/ حزيران الماضي، للوصول إليها. ويبدو أن زعيم التنظيم، أبو بكر البغدادي، لم يختر الاسم من فراغ، وهو الذي ينحدر من مدينة سامراء، كان في وسعه أن ينسب نفسه إلى مسقط رأسه، لكنه اختار بغداد عاصمة الخلافة الإسلامية.
وبعيداً عن رمزية بغداد التاريخية والراهنة، هناك أمر يلفت الانتباه، هو أن البغدادي لم يهاجم سامراء مدينته الأم، حتى الآن. ولذا، بقيت تحت سيطرة المليشيات التي تحرس أضرحة الإمامين العسكريين، وكأنه يريد أن يقول إن حساباته مختلفة، وهدفه بغداد.
معركة بغداد وشيكة، هذا ما تؤكده معلومات متقاطعة من أطراف أميركية وعراقية رسمية، وتبرهن عليه حركة “داعش”، وطرق تقدمه، عبر الأنبار التي تساقطت فيها القوات العراقية، في الأيام الأخيرة، بطريقة لا تثير الاستغراب فحسب، بل على نحو يوحي بأن قوة “داعش” عصية على المقاومة حتى الآن.
ومن يراقب الاستعدادات المرئية من الجانب الآخر لا يستطيع أن يعلق آمالاً كبيرة على هزيمة ماحقة لـ”داعش” على أبواب بغداد. هناك بقايا جيش عراقي منهزم من كل المواجهات مع “داعش”، ومليشيات رصيدها يكمن في حروب داخلية، بالإضافة إلى إسناد أميركي بالخبرة وبعض طائرات الأباتشي. والورقة التي لا تزال مخفية هي الورقة الإيرانية. وهنا، يكمن السؤال الجوهري، كيف سيتصرف الإيرانيون، وما الذي سيكون عليه موقف الأميركيين، في حال أرادت إيران أن تدافع عن بغداد، وتمنع سقوطها؟
بغداد هي المعركة الرئيسية في هذه المواجهة المفتوحة، ومنها تتحدد المسارات اللاحقة، فإما أن ينكسر “داعش” على أبواب عاصمة الرشيد، ويصبح متاحاً تشتيت صفوفه والقضاء عليه، أو أنه سينقل المواجهة إلى مستوى مختلف كلياً، وهو مستوى المواجهة القائمة على حرب استنزاف طويلة الأمد، حرب عصابات مفتوحة على رقعة جغرافية واسعة، تمتد من ريف حلب حتى بغداد.
صحيح أن “داعش” امتلك سلاحاً ثقيلاً غنمه من الجيشين، العراقي والسوري، وهو يخوض، الآن، مواجهات تمزج بين استراتيجيات الجيوش وحروب العصابات، لكنه، في نهاية الأمر، كناية عن عصابات تقاتل بطرق مختلفة كلياً عن الجيوش الرسمية، وهذا ما يعقّد مسألة التصدي له وهزيمته.
وكلما يمر الوقت، تتأكد حقيقتان. الأولى أن عامل الزمن يلعب لصالح “داعش”. والثانية أن المواجهة الناجعة معه لا يمكن أن تكون غير برية. وغير ذلك هو نوع من الدوران في حلقة مفرغة، وهذا ما تأكد بعد حوالي أكثر من شهر من الغارات الجوية التي تجاوزت الألفين، ولم تحدث فرقاً ملحوظاً على الأرض، بل على العكس، لا يزال التنظيم يتقدم بقوة في العراق وسورية، ومثال ذلك الانتصارات التي حققها في الأنبار وعين العرب.
يؤكد العارفون بجغرافية المنطقة ومشكلاتها أن “داعش” ينهزم بطريقة واحدة فقط، وهي إذا وجدت العشائر السنية بين حلب وبغداد مصلحة لها في التصدي له، وهذا أمر قاله الأميركيون، منذ اليوم الأول لتشكيل التحالف الدولي، لكنهم يقولون شيئاً، ويتصرفون بطريقة مختلفة. وبدلاً من أن يشرعوا في العمل على ترتيب الوضعين، العراقي والسوري، على هذا الأساس، فإنهم يضيعون الوقت في الهامش. مرة يراهنون على إيران، وأخرى على تركيا، وثالثة يحفظون دوراً غير منظور لبشار الأسد.
طريق البغدادي إلى بغداد سالكة حتى الآن، وهو يستعد لاقتحامها في وقت قريب، بينما تعمل الاستراتيجية المقابلة على خطة عملٍ، بعيدة المدى على أعوام، لا يأمل منها أحد حتى حماية البصرة.
العربي الجديد
مبايعات «داعش»: فقه التلفيق والتكتيك/ صبحي حديدي
لم يكن شهيد الله شاهد، الناطق باسم حركة طالبان باكستان، يخادع ممثلي وسائل الإعلام العالمية حين جمعهم لإعلان مبايعة «داعش»، حتى إذا كانت آلاف الكيلومترات تفصل بين سنجار والموصل في العراق، أو الرقة وكوباني في سوريا؛ وبين المناطق الجبلية الوعرة، والقبائلية البشتونية غالباً، على خطوط الحدود مع أفغانستان. «كلّ المسلمين في العالم يعلقون عليكم آمالا كبيرة. نحن معكم، وسنزودكم بالمجاهدين وبكل دعم ممكن»، قال شاهد، بعد ساعات على إعلان «داعش» ذبح مواطن غربي إضافي.
بمعزل عن انتفاء المخادعة، إذْ يجوز الافتراض بأنّ هذا الجهادي العصابي تحديداً يتلهف حقاً لمساندة «داعش»، ثمة ذلك الإشكال الأكبر المزدوج الذي يكبّل هذا الطراز من المبايعات، خاصة إذْ تصدر عن تنظيمات جهادية في شرق آسيا وآقاصي العالم المسلم: 1) أنّ «كلّ المسلمين» ليسوا، البتة، من معلّقي الآمال على «الجهاد» عموماً، وعلى هذه التنظيمات الإرهابية المتطرفة خصوصاً، بل العكس هو الصحيح، فلا تناصرهم إلا قلّة قليلة، أقرب إلى الندرة عملياً؛ و2) أنّ «فقه الجهاد» ذاته، إذا جازت تسميته هكذا، لا يبيح تلك المبايعات على النحو الاستسهالي الذي تتخذه، كما في مثال طالبان باكستان مثلاً، إذا لم يطعن في سلامتها الشرعية أحياناً.
الدليل على هذا أن شاهد نفسه اضطر، بعد يومين فقط، إلى إصدار بيان لاحق يوضح أنّ تأييد «داعش» لا يعني الإقرار للبغدادي بموقع خليفة المسلمين (الأمر الذي سوف يعني نزع الصفة عن الملا عمر، رغم أنّ الناطق باسم طالبان باكستان تفادى الخوض في هذا التفصيل)؛ ولا يعني، أيضاً، ذوبان الجهاد الباكستاني في الجهادَين السوري والعراقي. لكنه يعني، في المقابل ـ وهذا تطوّر أخطر ربما، وأبعد أثراً، لم يتطرق شاهد إليه ـ أنّ الحركات الجهادية في شرق آسيا يمكن ان تقتفي الدروب التي سارت عليها «داعش»، فتقتبس مسارات تطورها، من حيث طرائق التمويل والتسلّح والتجنيد والتمدد، وتعيد إنتاج تكتيكاتها القتالية على الأرض، وربما خياراتها العنفية القصوى في معاملة الرهائن الغربيين.
وفي تشريح أهواء القلة القليلة من المسلمين المناصرين لـ»داعش»، ثمة، بادىء ذي بدء، ذلك الإغواء الطاغي الذي تمثّله فكرة الخلافة الإسلامية، وما يقترن بها من إحياء أمجاد الإسلام الغابرة، وردّ الكرامة إلى المسلمين في أربع رياح الأرض. وهو إغواء لا يتحوّل إلى جاذبية، فقناعة، فالتزام بـ»الفكر»، فالتحاق بصفوف الجهاد… إلا إذا اقترن بخيبة أمل، ومرارة، من بعض فئات القيادات الجهادية ذاتها: إمّا لأنها تراخت، أو قصّرت، أو انكمشت، أو انحسر نفوذها العالمي (كما في مثال «القاعدة» تحت قيادة أيمن الظواهري الحالية)؛ أو لأنها تخلت عن قضية الجهاد، وربما «خانت»، فانخرطت في حوار مع «أعداء الله» (كما في مثال حوار طالبان أفغانستان مع أمريكا(.
في الجانب الآخر من المبايعات، هنالك مواقف التأييد التي أخذت تنهال على «داعش» من بعض القبائل والعشائر والأفخاذ، في العراق وسوريا على حدّ سواء؛ بعد انّ كان العكس هو سيّد المعادلة، كما حين انتفض الشعيطات ضدّ «داعش» في ريف دير الزور، شرقي سوريا، قبل أسابيع فقط. دافع العشائر المؤيدة تكتيكي محض، في المقام الأوّل، وهو أقرب إلى التحالف العابر، المؤطر في الزمان والمكان، الذي يسعى إلى مكاسب محلية مؤقتة؛ منه إلى أيّ تعاطف ديني إسلامي، أو عقائدي جهادي. ولهذا فإنه قابل للتبدّل، وفقاً لما تأتي به الرياح، في شروط نقيضة.
هي، إذاً، خلاصات تمزج بين تلفيق الآمال واستثمار الخيبة وانتهاج التكتيك، إلى حين فقط؛ قد يقصر، أغلب الظنّ، أكثر مما يطول: زمناً وجغرافية، معاً.
أميركا.. بين القدرة والإرادة في سوريا/ سلامة كيلة
أصبح التدخل الأميركي في سوريا أمرا واقعا بعد الغارات التي طالت تنظيم الدولة الإسلامية “داعش” في الأراضي السورية كما يصرح المسؤولون الأميركيون. ولكن هل يتعلق الأمر بـ”داعش” فقط؟
معلوم أن الإدارة الأميركية تستفيد من التدخل في العراق لتغيير موازين القوى في “العملية السياسية”، بحيث تضعف التأثير الإيراني الذي هيمن بشكل كامل في سنوات حكم نوري المالكي، وهي بذلك “تحاصر” إيران في مرحلة التفاوض حول برنامجها النووي، وربما دورها الإقليمي، بحيث تستطيع عبر ذلك الوصول إلى تفاهم تسعى الولايات المتحدة إليه في ظل رؤيتها لوضع الخليج في المرحلة القادمة، ولموقع إيران في هذه الرؤية، وبالتالي حدود التوافق الممكن لدورها هناك.
وقد كان واضحا أن تدخلها لم يكن بهدف “تدمير داعش” بالضبط، ولا حماية الأكراد بعدما زحفت داعش للسيطرة على أربيل، فهذه كلها تكتيكات مفهومة لكي تتدخل.
وإذا كان الأمر واضحا في العراق، فما المغزى من التدخل في سوريا، وماذا تريد أميركا بالضبط، خصوصا بعد أن أهملت الملف السوري طيلة السنوات التالية لاندلاع الثورة؟
كانت الإدارة الأميركية تعالج الوضع في تونس ومصر، وتدفع دول الخليج لمعالجة وضع اليمن والبحرين، وفرنسا لتولي ملف ليبيا، حين اندلعت الثورة في سوريا، وقد عمدت إلى الدفع لتحقيق تغيير سريع في تونس ومصر قبل أن تتجذر الثورة ولا يعود بالإمكان ضبطها والالتفاف عليها، وبدا لها أنها نجحت. لكن انفلات وضع الثورات بالشكل الذي ظهرت فيه في الأشهر الأولى، والذي أذهل العالم، جعلها تبدو “غير معنية” بما يجري في سوريا.
ورغم أن تصريحات أوباما حول الوضع السوري لم تشر في المراحل الأولى من الثورة إلى ضرورة رحيل بشار الأسد كما فعل في تونس ومصر، وأن دور الأميركي حينها بدا وكأنه يتمثل في لجم اندفاع فرنسا وتركيا إلى “فعل شيء”، وكان يعني ذلك التدخل العسكري. ورغم كل الكلام عن “المؤامرة الأميركية” كان الموقف الأميركي يبدو غير مبال على الإطلاق، فأميركا لن تتدخل عسكريا، ولن تدعم أيا من الأطراف، وهي تقدم كلاما عاما في تصريحاتها.
حينها كانت أميركا منخرطة في إعادة بناء رؤيتها بعد أن توصلت بعد سنتين من الأزمة المالية التي وقعت في سبتمبر/أيلول 2008، إلى أنه لا أمل في تجاوز الأزمة، ومن ثم يجب التكيف معها، والعمل على “إدارتها”.
وقد توصلت إلى إستراتيجية أعلنها باراك أوباما في 6 يناير/كانون الثاني سنة 2012، تنطلق من نقل الأولوية إلى منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وبالتالي تقليص القدرات العسكرية وضبط إمكانيات التدخل، اعتمادا فقط على الطيران في منطقة “الشرق الأوسط”، وارتأت أيضا أن عليها إعادة موضعة تحالفاتها وتقليص مطامحها.
هذا المخاض الذي عاشته أميركا طيلة سنة 2011 جعلها تبدو غير مبالية بالوضع السوري، وحتى لمسارات التحول في تونس ومصر بعد أن ركنت لإستراتيجية وضعتها تهدف إلى إشراك الإسلاميين في السلطة، وتركت أمور اليمن وليبيا لـ”حلفائها”.
بداية سنة 2012 أعلن باراك أوباما أن على روسيا أن ترعى مرحلة انتقالية في سوريا كما حدث في اليمن، وبعد الارتباك الروسي في التعامل مع الوضع السوري، توصل الطرفان ضمن مجموعة العمل الخاصة بسوريا إلى مبادئ جنيف1 في 30 يونيو/حزيران 2012.
ومع ذلك ظل الدور الأميركي “باردا” متكئا على الفيتو الروسي الصيني، في ظل الحديث حول خلاف في تفسير مبادئ جنيف فيما يتعلق بوضع بشار الأسد الذي بدا أنه حُسم في أبريل/نيسان 2013 لمصلحة أن تكون الهيئة الانتقالية التي يجب تشكيلها كاملة الصلاحية بما في ذلك صلاحيات الرئيس، وهذا ما حرك الدور الأميركي المباشر، حيث عملت أميركا على ترتيب وضع المعارضة بما يجعلها تقبل بمبادئ جنيف1 وبالرعاية الروسية، وكذلك الأمر بالنسبة للدول الإقليمية التي كانت لديها مطامح في سوريا.
هدد باراك أوباما بتوجيه ضربة عسكرية بعد استخدام السلطة لأسلحة كيميائية في 21 أغسطس/آب 2013 (رغم أنها لم تكن المرة الأولى). حُل الأمر بموافقة السلطة على تسليم أسلحتها الكيميائية، وبتضمين بيان مجلس الأمن الدعوة لعقد جنيف2 الذي عُقد في يناير/كانون الثاني 2014، دون أن يتوصل إلى نتائج، حيث ظهر واضحا أن السلطة لا توافق على مبادئ جنيف1 أصلا وأن روسيا لم ترتب وضع السلطة بما يجعلها قابلة بالحل المطروح، ومن ثم غرقت روسيا في أزمة أوكرانيا ولم تخرج منها بعد.
الآن -مستغلة وضع العراق- وجدنا أن أميركا تعود للتدخل في سوريا، ماذا تهدف من ذلك؟ هل يتعلق الأمر فعلا بداعش؟
أظن أن داعش هي “المشجب” كما في العراق، وأن الأمر يتعلق بوضع الدولة السورية، فبعد لا مبالاة طويلة بعد أن فشلت إدارة بوش في تغيير النظام بعد اغتيال رفيق الحريري، ومحاولة تطبيع بعد استلام أوباما الرئاسة، ثم دور “هامشي” كما أشرنا للتو، وتسليم بأحقية روسيا في سوريا، ها هي أميركا تستغل الفراغ الذي لم تستطع روسيا ملأه لكي تعمل على تغيير موازين القوى، ربما من خلال تحقيق التغيير في بنية السلطة (الأمر الذي فشل الروس في تحقيقه).
ربما تظن الإدارة الأميركية أنها من خلال الغارات الجوية على “داعش”، ومحاولة فرض سيطرة قطاعات من “الجيش الحر” على المناطق التي تحت سيطرة داعش، تستطيع أن تستميل طرفا في السلطة يقبل بـ “الحل السياسي” (ربما كذلك وفق مبادئ جنيف1). فالإدارة الأميركية لا تريد إنهاء الدولة، بل تعتقد بأنه يجب أن تبقى، لكن بدون بشار الأسد، ومن ثم يمكن أن يدمج “الجيش الحر” في بنيتها تحت عنوان “الحرب ضد داعش”.
بطبيعة الحال سيعتمد تحقق هذا الأمر على مدى تأثير الضربات الجوية على بنية السلطة، ما دامت هذه الضربات لن تطال “جيش السلطة”، ولا حتى مطاراته التي تنطلق منها الطائرات التي ترمي البراميل المتفجرة، أو مدى مقدرة الإدارة على إقناع طرف في السلطة بضرورة التخلص من بشار الأسد وتسهيل أمر تحقيق مرحلة انتقالية.
في هذه الحالة تكون أميركا قد كسبت سوريا بعد أن فقدت الأمل بذلك منذ فشل محاولة التغيير (2005/ 2006) وبعد أن باتت في طريقها إلى “مغادرة الحلبة الشرق أوسطية” على ضوء أزمتها وتموضعها العالمي الجديد. لكن ما أهمية ذلك وسوريا باتت مدمرة؟ وخصوصا أن القدرة على التأثير المستمر على الوضع لن يكون متاحا لها نتيجة تراجع تأثيرها بفعل التموضع المشار إليه من قبل؟
لا شك في أن تغيير وضع النظام في دمشق بتأثير أميركي يعني “قلب المعادلة” في لبنان، ومن ثم محاصرة حزب الله، خصوصا بعد أن أرهق بأعداد القتلى، وتصاعد التوترات ضده، لكنه يعني كذلك تقليص وجود إيران وحصرها ضمن حدودها بعد أن تمددت إلى البحر المتوسط، ويصب ذلك في سياق السياسة ذاتها التي اتبعتها الإدارة الأميركية في العراق، وربما أيضا ترتيب الوضع مع الدولة الصهيونية، التي تعيش إرباكات تقلبات الوضع في المنطقة وفي الاقتصاد العالمي. لكن السؤال الأساسي هنا يتعلق بقدرة أميركا على ذلك دون استخدام قواتها البرية؟ أو هل سيقود بالتالي تدخلها إلى إطالة أمد الصراع في سوريا؟
ربما يعتمد ذلك على إمكانية خروج فئة من داخل السلطة لكي تكسر البنية التي خاضت الحرب ضد الشعب “إلى النهاية” كما صرح رامي مخلوف منذ بدء الثورة، وتقبل “الحل السياسي”، حيث ليس من الممكن تغيير السلطة دون أن يأتي من داخلها ما دام الأمر يتعلق بضربات جوية.
نحن الآن في لحظة محاولة أميركا استعادة موقعها في المنطقة بعد أن ظهر أنه يضعف نتيجة تركيزها على منطقة آسيا والمحيط الهادئ، لكن في لحظة لا تمتلك فيها القدرة على التدخل الفعلي نتيجة حصر مجهودها في تلك المنطقة التي باتت تحظى بالأولوية كما أشرنا، الأمر الذي منعها من تحريك قوات برية ليس بالإمكان كسب الحرب دونها.
ويبدو أنها تراهن أولا على وهن وضع المنطقة ذاتها، خاصة في سوريا والعراق وحتى إيران وحزب الله، ومن ثم يكون هذا المستوى من التدخل قادرا على تحقيق هدف سياسي “كبير”، كما أشرنا إلى ذلك من قبل. وثانيا على فشل الروس في ترتيب الوضع وتبيان ضعف مقدرتهم، ومن ثم غرقهم في “المستنقع الأوكراني”، في وضع ربما بات يظهر أنه في حاجة إلى حل.
وتبقى الولايات المتحدة الأميركية في بحثها عن حل جديد تائهة بين القدرة والإرادة، بين الحلول السياسية والخيارات العسكرية. فهل تتمكن أخيرا من تحقيق “الحل السياسي” الذي ما زالت تؤكد أنه الخيار في سوريا؟
الجزيرة نت
درس من معركة عين العرب/ خورشيد دلي
ليست معركة عين العرب (كوباني) مجرد معركة بين المقاتلين الكرد وتنظيم داعش، للسيطرة على المدينة الصغيرة الواقعة على كتف الحدود السورية التركية، بقدر ما حملت معها دلالات إقليمية ودولية، في إطار صراع الأولويات ورسم المشاريع والخرائط المتدفقة من رحم الأزمة السورية. الأكراد الذين دافعوا عن مدينتهم ببسالة يحسون، في العمق، بخيبة أمل كبيرة من الجميع، فتركيا الدولة الجارة والقوية، والتي أوحت مرارا بأنها ستتدخل لمنع سقوط المدينة لم تتحرك، وظلت طائراتها ودباباتها تراقب بدقة كل خطوة وتفصيل وحركة، طوال الأسابيع الماضية. الولايات المتحدة التي تتزعم التحالف الدولي قالت، صراحة، إن كوباني ليست لها قيمة استراتيجية. النظام السوري الذي يقال إن حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي حليف له لم يتخذ أي إجراء عملي، لكي لا تسقط المدينة. الدول الأخرى ظلت تحذر من وقوع مجازر ضد أهل المدينة، على غرار ما ارتكبه التنظيم في سنجار في شمال العراق، من دون أن تتحرك عملياً. وعليه، واصل داعش زحفه إلى المدينة، غير مكترث بغارات التحالف المتقطعة، والتي بدت من دون فعالية، حتى أصبحت المدينة عملياً تحت سيطرة التنظيم.
ما حصل في كوباني عكس معادلات كثيرة قائمة في أجندة الدول وحروبها الناعمة وأولوياتها وحساباتها. بالنسبة للغرب، وتحديدا الولايات المتحدة، كان تكريسا لسياسة المصالح والازدواجية في النظر إلى الأكراد، وتتجلى الازدواجية الأميركية هذه في كيفية النظر إلى القضية الكردية، وهي تتراوح بين إظهار العطف الإنساني والمبادرة إلى تقديم المساعدة والدعم لأكراد العراق، كلما لاح خطر عليهم، أو أزمة إنسانية تهددهم في مقابل سياسة اللامبالاة تجاه أكراد سورية وإيران وتركيا، على شكل ترك هؤلاء لأقدارهم ومصائرهم، والتي، غالباً، ما تكون دموية. تركيا الدولة التي توجهت إليها الأنظار تعاملت، هي الأخرى، مع أزمة كوباني من زاوية مصالحها وأجندتها الخاصة، وهي تعاملت مع هذه الأزمة على ثلاثة مستويات.
استقبال آلاف النازحين من زاوية إنسانية. التأهب الأمني لحماية حدودها والتعامل مع أي طارئ يهددها. استثمار هذه الأزمة لإقناع واشنطن القبول بأجندتها التي تتراوح بين إسقاط النظام السوري ومنع تشكيل كيان كردي على حدودها السورية، وما الإصرار على إقامة منطقة عازلة إلا تعبير عن رؤية عملية، لتحقيق الأجندة المذكورة، في إطار رؤية شاملة للأزمة، خلافا للرؤية الأميركية التي تبدو مرتبكة، وغير واضحة.
وعليه، يمكن القول إن معركة كوباني، منذ البداية، لم تكن معركة على رقعة جغرافية محددة، بقدر ما كانت معركة إرادات ومشاريع. بالنسبة للكرد، كانت معركة وجود وتطلع إلى الحقوق المستقبلية، فيما بالنسبة لداعش كانت معركة توسيع حدود دولة الخلافة التي أعلنها. وعلى المستوى الدولي، لم تكن بالنسبة لأميركا سوى مواجهة هامشية، هدفها عدم السماح لداعش بامتلاك المزيد من عناصر القوة والمساحة الجغرافية والتوسع وجذب المقاتلين. وبالنسبة لتركيا، كانت معركة تأكيد دور الجغرافية والقدرة على رسم خرائط ومصائر، وإن لكل شيء ثمن في السياسة. وعليه، يمكن القول إن سيطرة داعش على كوباني ستكون لها تداعيات على الجميع، ولا سيما الأكراد الذين سيخسرون واحدةً من المقاطعات الثلاث التي أعلنوها، وستصبح مناطقهم مقطوعة الأوصال جغرافياً، فضلا عن خسارة معنوية كبيرة، نظرا لأن المدينة كانت لها مكانة رمزية كبيرة، إذ لجأ إليها الزعيم الكردي، عبدالله أوجلان، عندما هرب من تركيا عام 1979، فضلا عن أنها مسقط رأس زعيم حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي، صالح مسلم، وينتمي إليها قادة كرد عديدون.
بالنسبة لداعش، ستحقق السيطرة على كوباني ميزة جغرافية استراتيجية كبيرة، إذ، للمرة الأولى، سيسيطر التنظيم بالكامل على منطقة جغرافية، تمتد من الحدود السورية التركية شمالاً إلى مشارف بغداد جنوباً، وستصبح محافظة الحسكة السورية ذات الأغلبية الكردية محاصرة وربما هدفاً مباشراً للتنظيم في المرحلة المقبلة.
ولن تكون تركيا نفسها في منأى عن تداعيات سيطرة داعش على كوباني، إذ ستجد نفسها، للمرة الأولى، على تماس مباشر مع حدود دولة الخلافة التي لها طموحات لا تنتهي، ما يعني إمكانية أو احتمال انتقال المواجهة إلى الداخل التركي، خصوصاً في ظل تقارير عن إنشاء التنظيم خلايا نائمة داخل مدن تركية عدة، ووجود نحو خمسة آلاف تركي انضموا إلى التنظيم، ويقاتلون في صفوفه، كما أن عملية السلام الكردية – التركية قد تكون من أول ضحايا خسارة كوباني، في ظل موجة الغضب الكردي، احتجاجا على الموقف التركي، وتحول هذا الغضب إلى أعمال عنف، وسط تهديدات كردية وتركية بوضع نهاية للعملية السلمية.
في الواقع، يكشف ما حصل في كوباني عوامل الخلل في استراتيجية التحالف الدولي ضد داعش، فهناك حرب أولويات من الأطراف المشاركة في هذه الحرب، وهناك شكوك عميقة بين هذه الأطراف، وما اتهامات نائب الرئيس الأميركي، جو بايدن، للسعودية والإمارات وتركيا بدعم الجماعات المسلحة، على الرغم من اعتذاره، إلا تعبير عن عدم الثقة بين هذه الأطراف. ولكي لا تقع مدن أخرى عديدة، على غرار كوباني – عين العرب، ضحية لتضارب الأجندة الإقليمية والدولية، ينبغي على التحالف البحث في استراتيجية واضحة وشاملة، لمعالجة مجمل أزمة المنطقة، قبل أن يقع الجميع في مستنقعٍ، لا أحد يعرف كيفية الخروج منه.
العربي الجديد
عين العرب والاستثناء الكردي/ عبدالله أمين الحلاق()
لا يمكن بأي حال من الأحوال، ورغم ما يتنازع الأكراد والعرب في سوريا تجاه هذه المدينة، فصل مسار الأحداث في مدينة عين العرب «كوباني» عنه في معظم سوريا بعد ما يقارب 4 سنوات من عمر الثورة السورية. ومرد المقاربة تلك يكمن في أن مدينةً سوريةً مهددة اليوم من قبل قوة فاشية دينية سبقتها فاشية أسدية في تهديد مدن سورية أخرى وإسقاطها، وأخذها من يد من حررها من النظام في يوميات ثورة لم تكتمل.
وما فعله النظام السوري وحزب الله وحلفاؤهما في القصير ويبرود، يحاول تنظيم الدولة الإسلامية أن يكرّره في عين العرب، من محاولات اقتحام واحتلال لها تبدو حتى الآن صعبة المنال عليه، وسط مقاومة بطولية من أهلها ومن المسلحين المحليين فيها، وهو ما يؤخر وربما يمنع، كما نأمل، تكرار تجربة القصير ويبرود مرة ثالثة في أقصى شمال سوريا، على الحدود مع تركيا.
والحال، أن عين العرب تبدو محطة مهمة تثير وتطرح تساؤلات كبرى في الواقع السوري وما يحيط به من تحليلات وتنظيرات ورؤى مختلفة، خارج يوميات المعركة فيها وتفاصيلها على أهمية هذه التفاصيل، ذاك أن هذه المدينة أعادت إلى الواجهة ما كان قد غاب في الأشهر الاخيرة، بعد أن بدا تنازع النفوذ في سوريا محصوراً بين النظام السوري وتنظيم الدولة الإسلامية وجبهة النصرة وفصائل جهادية وإسلامية أخرى، وعلى حساب المكون المدني والعسكري داخل الثورة السورية، وهو المكوِّن الذي غاب صوته أو خفُت بفعل عوامل كثيرة لسنا في مجال سردها والحديث عنها في هذا المقال. ولعل أهم ما أعادته معركة» كوباني» إلى الواجهة هما إشكاليتا التسلح والدفاع عن النفس أولاً، ودور العامل الخارجي والقوى الدولية والإقليمية في النزاع الحاصل ثانياً، خصوصاً وأن صوت الرصاص من «كوباني» وعليها يترافق مع هدير طيران التحالف الدولي في «حربه على الإرهاب»، وهاتان مسألتان شكلتا إحدى أكثر الإشكاليات الثقافية والسياسية في حديث السوريين والمهتمين بالشأن السوري عموماً منذ انطلاق الثورة، ولا يمكن اعتبارهما تفصيلاً أو هامشاً حتى لو جاء الكلام عنهما في مدينة تختلف من حيث اليوميات فيها منذ آذار 2011 وحتى اليوم، عن مدن أخرى داخل العمق السوري وليس على الحدود.
إن الانتقائية في الموقف من الجلادين ومن الضحايا، والتي لازمت الثورة السورية منذ انطلاقها، وكاد مثقفون سوريون «معارضون» أن يرددوا معها مقولة مؤيدي النظام التي تقول بضحوية هذا النظام «المسكين» الذي اضطر «للدفاع» عن سوريا في وجه قبضات وحناجر أبنائها الهاتفين لحريتهم، ونظّروا طويلاً لحظر إمكانية المقاومة بكل أشكالها بما فيها المقاومة بالسلاح.. تحط اليوم رحالها في كوباني عين العرب، ليس بسبب التجريد اللفظي للأكراد من حق رفع السلاح في مواجهة الدولة الإسلامية هذه المرة، وإنما لأن هذا التجريد اللفظي السابق لكل من ليس كردياً، بدا جلياً أكثر مع حصر هذا الحق بيد الأكراد في كوباني اليوم. أصحاب هذا الاحتكار التمييزي هم غالباً سوريون «معارضون» أو مؤيدون، ولبنانيون يجنحون نحو خندق المقاومة والممانعة ورمزهما الأبدي – الأسدي.
لا تفترض السِّلمية في الثورة السورية تحديداً، وتبعاً لطبيعة العدو الذي تواجهه، استمرارية حتمية لتظاهرات الورود وأغصان الزيتون إلا في مناطق سورية كانت أقل عرضة لعنف النظام من غيرها، ولا تزال بعض تلك المناطق في منأى عن الخوض في غمار التسلح والتسليح تبعاً لخصوصيتها وتبعاً لمستوى ودرجة الهدوء النسبي الذي تشهده، مقارنة بمناطق مشتعلة لم تعرف حيزاً للتظاهر والعمل المدني والسلمي إلا لماماً. كما أنه من المستحيل، على ما نرى، أن يحوز الخيار العسكري في مواجهة النظام نظافةً مرجوّة تبدو السِّلمية هي الأقرب لها لو استمرت، ولم تستمر. العسكرة خيارٌ طالما وُضع سوريون دُفعوا إليه في موقع الإدانة والهجوم عليهم من قبل سلميين مفترضين لم يسجل لهم أي موقف قوي من النظام السوري لا في لحظات ازدهار الثورة السِّلمية في سوريا وصعودها، ولا في مراحل عسكرتها اللاحقة والكارثية. يبدو الأكراد اليوم محط التفاف حولهم وحول سلاحهم وبطولاتهم الحقيقية من قبل من كان يرى ربما أن المقاومة بالسلاح حق لشعب دون آخر، أو لعرق دون آخر، كما الحرية على ما يبدو، وهي حرية «يبدو شعبنا غير مهيأ لها» قياساً بشعوب أخرى غير سورية، تبعاً لأصوات استشراقية متماهية مع الغرب وتصدح صبح مساء من داخل سوريا، ليس الأكراد في معركتهم اليوم منها، ذاك أن هؤلاء الأكراد الذين يواجهون تنظيم الدولة الإسلامية الذي واجهه سوريون قبلهم ولا يزالون، إنما يؤكدون أن العدو واحد للعرب والأكراد في سوريا، ممثلاً بالدولة الإسلامية «داعش» وبالنظام السوري، لا ينتقص من ذلك وجود أشخاص مثل صالح مسلم وغيره في موقع معادٍ علناً لداعش وغير معادٍ علناً أو سراً للنظام، كما لا ينتقص منه دفاع بعض المثقفين السوريين «المعارضين» عن صالح مسلم وحزب الاتحاد الديموقراطي الكردي «PYD« وقوات وتنظيمات مسلحة كردية أخرى.
يجدر بالذكر أن الأكراد عموماً توحدوا في كوباني على أرضية الموقف من داعش وليس الموقف من النظام السوري، وهذا حصل أيضاً في مناطق سورية غير كردية يبقى ترف الاختيار فيها موجوداً، بغض النظر عن عدم فاعلية الكلام النظري في أوساط المثقفين السوريين والكتّاب والمراقبين والناشطين المدنيين، والذين يقعون خارج دائرة ونطاق العسكرة، وهي دائرة غير قابلة للترف والخيارات التي يتيحها الاسترخاء خارجها.
أما التدخل العسكري الدولي الذي يدغدغ أطراف داعش، بينما يقف داعش على بوابات «كوباني»، فمسألة اليوم يعاد طرحها بشكل انتقائي كما هو الموقف من السلاح، سوى أن التدخل العسكري الدولي وضربات قوات التحالف تبقى أقل من أن يبنى عليها خلاص ما من «داعش» في «عين العرب» وفي سائر سوريا، ولن يبنى عليها خلاص من الأسد على ما يبدو. مع ذلك ثمة من كان يحاجج ضد التدخل العسكري الخارجي وهو يهلل اليوم لضرب «داعش»، علماً أن الضربات العسكرية اليوم لا تبدو متمايزة عن تلك التي لم تحدث في العام الماضي بعد مجزرة الكيماوي في الغوطة، باستثناء تحليق وقذائف خجولة تحتاج سنوات طويلة لتنهي تنظيماً إرهابياً من نحو 30 ألف مقاتل. إلى ذلك، يبدو الحظر الجوي محل أخذ ورد بين الأتراك والامريكان في تصريحات متضاربة ومتناقضة يوماً بعد يوم، ومعه التدخل التركي البري.
وفي ظل التجاذبات التاريخية بين الكرد والعرب بشأن موقع الأكراد وموقفهم من الكيان السوري أو من فكرة الانفصال، وهي مسائل رحّلتها إلى الأفق اليوم تلك المعارك الضارية في «عين العرب» وما حولها في مواجهة «داعش»، فإن «عين العرب» اليوم تبقى علامة فارقة في مسيرة الأعوام الأربعة الأخيرة من عمر سوريا، ليس فقط بسبب الصمود البطولي لأهلها في مواجهة تنظيم انهارت أمامه مدن سورية بشكل درامي أكثر سرعة، وليس بسبب بروز عقدة قومية دفينة أتيح لها النمو وادعاء التفوق لدى بعض من الكرد، وإنما لأنها أعادت إلى الواجهة ذلك النقاش الذي غيبه صوت الرصاص والقذائف، ألا وهو السلاح والتدخل الخارجي ودوره في ساحة سورية ملتهبة، ليس أبناؤها هم من فتح الباب أولاً وثانياً وثالثاً للعسكرة والتدخل الخارجي بشكله الغربي أو الروسي أو الخميني، على أمل أن تحطم «كوباني» أيضاً أسطورة نجاح الدولة الإسلامية في السيطرة على كل بقعة سورية تستهدفها.
() كاتب سوري
المستقبل
انتصار «داعش» لا يناقض الفوز الأميركي/ لؤي حسين
لم تبدِ «داعش» أي رد فعل على الهجمات الجوية للتحالف الأميركي عليها. تعاملت مع الأمر بكل موضوعية، ونظرت إليه على أنه نشاط ما في الطبيعة، كالبرد والحر أو الموت. حاولت أن تتقيه من دون التفكير بإلغائه. وتابعت مسارها بخطى القادر الواثق، من دون تذمر أو شكوى.
واشنطن، في المقابل، لم تغيّر شيئاً في أدائها مع تمكّن داعش من توسيع مناطق سيطرتها، إن كان في العراق أم في سورية. تعاملت مع الأمر، أيضاً، بكل موضوعية، وكأنه نشاط عرَضي للطبيعة، كالإعصار مثلاً. فلم تحاول أن تلغيه أو توقفه، بل حاولت أن تتقي أخطاره لا أكثر. فلم تتجاهله: تدرسه جيداً، تضع استراتيجيات مفتوحة الزمن والاحتمالات للتعامل معه، والأهم: تحاول الاستفادة منه.
المراقبون والمحللون يتساءلون: كيف لـ «داعش» أن تستمر في انتصاراتها في توسيع مناطق سيطرتها مع استمرار الهجمات الجوية عليها. إذاً هجمات التحالف الأميركي لا تجدي نفعاً. فواشنطن لم تقل أو تدّع أن ضرباتها الجوية ستقضي على «داعش»، لا في العراق ولا في سورية. ولم تعد بأنها ستحقق انتصارات مهمة خلال أسابيع قليلة. ما قالته إنها ستحارب «داعش» في زمن مفتوح، حده الأدنى ثلاث سنوات. و «داعش»، في المقابل، لا تجد عقبات لانتصارها، بل لم تقل إنها في حاجة لشيء كي تنتصر، قالت: أنا منتصرة.
الأمر المهم ليس فقط انتصارات «داعش» العسكرية في العراق وسورية، بل ازدياد عدد مقاتليها على رغم ما تخسره في المعارك، ورسوخ حكمها وسيادتها في المدن والبلدات التي تسيطر عليها (مع استثناءات قليلة). هذا على رغم عدم وجود أي دولة تدعمها أو تؤيدها علناً. بل على رغم مواجهتها في سورية من قوى التحالف الأميركي والقوات الحكومية السورية المدعومة من روسيا وإيران، إضافة للمجموعات المسلحة الكردية وغير الكردية. واستناداً إلى هذا يمكننا القول إن كل ما تقوم به هذه الأطراف والقوى، الآن، في مواجهة «داعش»، غير كافٍ وغير مجدٍ للقضاء عليها، ولا على ردعها حتى. بل كل ذلك لا يؤثر في ازدياد جاذبيتها للمقاتلين المحليين، ولا على قبول سكان الكثير من المناطق العيش في ظل حكم «داعش» (مع قلة المعلومات عن ظروف هذا العيش). وهذا يعني بوضوح شديد أن لدى «داعش»، على رغم الهمجية التي تظهرها، قيادات تمتلك الكثير من الدراية والحنكة والمهارة في تحقيق أهدافها.
هذا غير غائب عن صنّاع القرار في الدول المعنية، الإقليمية منها أو البعيدة، ولكن مصالحها ومنافعها لا تتوافق بالضرورة مع مصالح شعوب منطقتنا ومنافعها، بل يمكنني الجزم بذلك. فغير خاف عن هؤلاء أن مواجهة «داعش» تحتاج الى برامج سياسية وثقافية واقتصادية واجتماعية جدية تحقق لأهالي منطقتنا العيش الحر الكريم، بل أن يشعر أبناء هذه الشعوب بهذا العيش الحر الكريم، ويرتضونه.
صحيح أن لدى «داعش» الكثير من مقومات القوة الحقيقية، لكن من غير الصحيح أن يكون في مقدورها الاستمرار في انتصاراتها لو كانت الدول والأطراف تعمل بصدق وجدية على القضاء عليها. لكن جميع الأطراف التي تعلن مواجهتها لـ «داعش» تعمل بالمطلق للاستفادة منها، أو من مواجهتها، لتحقيق فوز على الخصوم الآخرين. فصراعهم ليس مع «داعش» بل بين بعضهم البعض بالاستفادة منها بذريعة مواجهتها. فلو كان الأمر غير ذلك لواجهوها في مرحلة نشوئها الأول، وما كانوا سمحوا لها أن تنهض وتكبر. إذ لم يكن من الصعب رؤية نشوء ظواهر متطرفة ضمن معمعة المقتلة السورية بعد مضي حوالى السنة على انطلاق الانتفاضة السورية.
بالعموم ليس بين الأطراف من يستهدف «داعش» بحد ذاتها، أو يريد القضاء عليها، أقلّه في الوقت الراهن. وهذا ينطبق على «داعش» في سورية أكثر منها في العراق. فالنظام السوري، الذي بات معروفاً عدم قيامه سابقاً بأي عمل جدي في مواجهة «داعش»، عسكرياً أم سياسياً أو حتى أمنياً، يعتقد أن أي إضعاف جدي لها ستستفيد منه القوى المسلحة المناوئة له غير الموصوفة بالإرهابية دولياً، والتي تحظى بقدر ما من الدعم والاعتراف بها كمعارضة شرعية من قبل غالبية المجتمع الدولي. كذلك فهذه القوى تخشى أن يصبّ إضعاف داعش في مصلحة النظام، لعدم ثقتها أن لديها المقدرة على كسب ما تخسره «داعش»، ولتقديرها أن وجود «داعش» يساهم بشكل ما في إضعاف النظام.
روسيا، على رغم اضطراب موقفها الآن، لها نفس موقف النظام السوري، بل على الأرجح هي من يملي عليه مواقفه، وتجعله يصحح من هذه المواقف ما لا يرضيها أو يخدمها، كموقفه المؤيد لهجمات التحالف الأميركي في البداية. ولإيران، بقدر ما، نفس هذا الموقف. في المقابل، فإن واشنطن تجد في القضاء على داعش أو التضييق الجدي عليها في هذا الوقت تقليصاً لدورها الجديد الذي اكتسبته من قيادة التحالف، الذي مكّنها من التقدم خطوة مهمة في تقليص دور ونفوذ روسيا في المنطقة وتصغيرها دولياً. بقية دول التحالف تنقسم مصالحها في مواجهة «داعش» بين إضعاف الدور الروسي وإضعاف الإيراني والسير في ركب القائد الأميركي. وإلى أن يتم العمل الجاد على التوافق على سلطة وطنية يشعر جميع السوريين أنهم مشاركون فيها فعلياً، فيلتفون حولها دفاعاً عن وطنهم السوري، كخطوة أولى لتحقيق مواجهة دولية حقيقية وجدية لـ «داعش»، ستبقى «داعش» تتسع جغرافياً، وتتعمق أيديولوجياً، وتتكرس اجتماعياً في مجتمعاتنا المشرقية.
* رئيس تيار بناء الدولة السورية
الحياة
لماذا يركز التحالف الدولي على «داعش» ويتجاهل الآخرين؟/ غازي دحمان
يستنفر العالم اليوم، بقواه الإقليمية والدولية، لمحاربة تنظيم «داعش» ونظائره، وتأخذ الحرب طابعاً شمولياً لا يقف عند حد المواجهة العسكرية بل يتعداه إلى قلب المجال اللوجستي الذي يشكل شبكة التغذية الأساسية للجسد «الداعشي»، التجنيد والتمويل، وتفكيك ما يعتقد أنها حواضن «داعش»، واللافت أن هذا المجال الهجومي يجري تأطيره بجملة من قرارات مجلس الأمن، وكلها تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، التي تتطلب الالتزام بها من كافة الأطراف الدولية.
لا شك أن هذا الأمر يعكس قدراً من الجدية في الحرب التي يخوضها التحالف، كما أنه يثبّت قاعدة مهمة وهي أن العالم متى ما أراد فعل، لكن ذلك أيضاً يثير جملة من التساؤلات لدى قطاعات واسعة في المنطقة، ترفض الفكر والنهج «الداعشي»، لكنها في الوقت ذاته اكتوت من فكر مماثل ونهج متطابق، هو ممارسات التنظيمات الدينية القتالية الإيرانية، التي تساوي من حيث العدد أضعاف أولئك الذين ينضوون تحت لواء «داعش» و»النصرة» والكتائب السنّية المتشدّدة المتناثرة هنا وهناك، ويقدّرها البعض بأكثر من عشرين تنظيماً وحزباً، تتوزع بين أربعة بلدان عربية، العراق وسورية ولبنان واليمن، فضلاً عن التنظيمات النائمة في دول أخرى.
ليست تلك التنظيمات بطبيعة الحال مكوّنات مجتمع مدني ولا هيئات حزبية سياسية تعمل في أطر الثقافة والتنمية والخدمة الاجتماعية، بل هي تنظيمات مسلحة حتى أسنانها تتلقى تمويلاً ودعماً منتظمين، وقد جرى تأسيسها تحت شعارات مذهبية، إذ لا أهداف وطنية عامة لها، فهي ليست مخصصة لمقاومة الاحتلال الأميركي في العراق الذي انسحب ولم يحصل أن تصادمت معه يوماً، ولا هي مخصصة لمقاومة إسرائيل التي لم تعد موجودة في لبنان أصلاً، وكل تلك التنظيمات لا تخفي عداءها للمكوّن السني في المنطقة الممتدة من البصرة إلى صور في جنوب لبنان.
تسعى المنظومة التبريرية لوجود هذه التنظيمات إلى إدراجها ضمن نسق موجة «الأمن الذاتي» التي تحاول إبراز الطابع الأهلي على أصل تلك التنظيمات وطبيعة عملها، لكن هل هي مخصصة لحماية الأحياء والشوارع فقط؟ الواقع يقول أن مهمة هذه التنظيمات هجومية بالدرجة الأولى، وليس ذلك وحسب، بل وذات طبيعة عدوانية، والشواهد على ذلك أكثر من أن يجري إحصاؤها، ووفقاً لتقارير غربية فإن الشرطة المحلية في بغداد تعمل، كل يوم، على إخراج عشرات الجثث من نهر دجلة لشباب يجري ذبحهم ليلاً، يتم اصطياد بعضهم من العائدين من أعمالهم، وكذلك عبر مداهمات بيوت تقع في نطاق النشاط الأمني لتلك المنظمات، وينتمي كل المقتولين إلى مكوّن واحد (السني)، والقصد من وراء ذلك تحقيق عملية تطهير مذهبية!
في سورية أيضاً، يوجد العشرات من هذه التنظيمات، وقد جرى توثيق أعمالها التي يقع أغلبها على طيف من السلوكيات الجرمية التي تمتد من النهب (التعفيش) إلى الإخفاء والتمثيل بالجثث وارتكاب المجازر بحق قرى وأحياء ومناطق واسعة، في غالب الأنحاء السورية، وبكثافة في المنطقة التي تمتد من القلمون حتى ريف إدلب، وما بينهما حمص وحماة وريف اللاذقية، وامتاز إجرامها هنا بالمنهجية والتخطيط والتنظيم، بهدف إفراغ هذه المناطق من سكانها، وتشير الإحصاءات بهذا الخصوص إلى أن النسبة الأكبر من ضحايا الحرب على السوريين هم من أبناء هذه المناطق، ما يثبت تحقق أهداف تلك الميليشيات بدرجة كبيرة.
والمعلوم أن تلك التنظيمات ترتبط بطرف خارجي هو إيران، فهي التي أشرفت على هندستها من حيث الهيكلية والبنية وقامت بموضعتها في الجغرافيا المشرقية واخترعت لها مبررات وهمية، فيما هي تنخرط ضمن المشروع الإيراني بوصفها أدوات تنفيذية، وتستطيع إيران من خلالها ممارسة كل ما لا تستطيع دولة ممارسته، ووصل الأمر إلى حد أن إيران ما عادت تخفي ارتباطها بهذه المنظومة، حيث تتباهى بأنها صارت قابضة على زمام أربع عواصم عربية هي دمشق وبيروت وبغداد وصنعاء.
والغريب أن إيران تتشدد في الحرب على الإرهاب، فهي لا يعجبها أن يحارب التحالف الدولي «داعش» و»النصرة» وحسب، بل تطالب بشمول الحرب كل الثوار السوريين، ولا بأس من قتل بيئاتهم والتنكيل بها، ويذهب رئيس إيران حسن روحاني، ومن على منصة الأمم المتحدة، إلى حد مطالبة بعض الدول بالاعتذار من الأجيال القادمة، ربما لأنها ساعدت في إنقاذ الملايين من اللاجئين!
والسؤال الذي يطرح نفسه: لماذا يتجاهل التحالف الدولي هذه التنظيمات المرتبطة بإيران ويركز على «داعش»؟ لا تختلف تلك التنظيمات عن «داعش» سوى أنها تقتل ضحاياها من دون إعلام أو تصوير، فهل العالم يجامل على حساب الدم السوري؟ ألم يظهر «داعش» أصلاً كرد فعل همجية على الإجرام الذي مارسته تلك الجماعات التي جاءت تقاتل تحت رايات دينية وتطالب بالثأر لأحداث تاريخية غابرة؟
لن يهدأ المشرق ولن تتوقف السكين التي تغلّ في صدره طالما بقيت إيران تحرك أذرعها في قلبه، وبدل «داعش» سيظهر مئات الدواعش، لأن الشعوب ستجد نفسها دائماً أمام خطر وجودي، وعند تلك اللحظة لا يكون أمامها ترف التمييز بين السيء والحسن، بقدر ما سينصب همّها على حماية حقها في الحياة.
* كاتب سوري
الحياة
عن أردوغان و «داعش» والمعارضة السوريّة…/ هوشنك أوسي
نفي الحكومة التركيّة الاتهامات الموجّهة اليها بتقديم الدعم اللوجستي لتنظيم «داعش» الإرهابي، يطابق نفي نظام الأسد الأب تقديم الدعم لحزب العمال الكردستاني، وإيواء زعيمه عبدالله أوجلان في الثمانينات والتسعينات. ويطابق أيضاً نفي نظام الأسد الابن، تقديم الدعم والمساندة للتنظيمات التكفيريّة التي كانت تقاتل الأميركيين في العراق!. فحتى لو حاولت تركيا الاغتسال في بحر من ماء زمزم، فإنها لا تنجح في محو ضلوعها وتورّطها الفاقع الذي جعلها الحضن الدافئ والملاذ الآمن لكل التنظيمات التكفيريّة الإرهابيّة كـ «داعش» و «جبهة النصرة» و «حزب الله التركي»!. وهذا مردّه كثرة القرائن والأدلّة.
والحقّ أنه لا يمكن حصر فترة دعم تركيا التنظيمات التكفيريّة في حقبة حكم حزب العدالة والتنمية الإسلامي، بزعامة أردوغان – داوود أوغلو، بل يرقى ذلك إلى مطلع الثمانينات، حين احتضن نظام انقلاب 12 أيلول (سبتمبر) الفاشي – العسكري، بقيادة الجنرال كنعان إيفرين، جماعة الإسلاميين السوريّة، وقدّم لها الدعم العسكري واللوجستي ضد نظام حافظ الأسد، عملاً بمبدأ المعاملة بالمثل، إذ الأخير كان يدعم العمال الكردستاني، وكل فصائل اليسار التركي المتطرّفة. فضلاً عما سلف، رفضت حكومة أوغلو مناشدة المبعوث الأممي ستيفان دي مستورا، بخصوص فتح الحدود التركيّة أمام المتطوّعين الكرد والسلاح والمؤن للدخول إلى كوباني والقتال مع المقاتلين الكرد ضد داعش، ورفضت أنقرة الضغوط الأميركيّة للحؤول دون سقوط المدينة الكرديّة في يد «داعش»، على رغم إعلان أنقرة مشاركتها في التحالف الدولي ضد «داعش»، ومصادقة البرلمان التركي على تفويض يمنح الجيش حريّة القيام بعمليات خارج الحدود التركيّة لحماية أمن تركيا. أفلا يعني كل ذلك و «مطلقاً» أن تركيا ضالعة في دعم «داعش»!؟.
يجادل الإعلام الموالي للحكومة التركيّة، وبعض أبواقه في المعارضة السوريّة، وبعض الكتّاب والمثقفين العرب المقيمين في تركيا على نفقة الاستخبارات التركيّة، في اتجاه معاكس مفنّدين التهم الموجّهة الى تركيا بخصوص دعمها «داعش»، مضيفين حجّة سخيفة وركيكة أخرى مفادها: لو كانت الحكومة التركيّة تدعم «داعش» لما آوت مئات ألوف السوريين، وما يزيد عن مئتي ألف كردي سوري من كوباني!. وربما يتغافل هؤلاء عن أن ما تقوم به تركيا من فتح حدودها أمام اللاجئين السوريين، كرداً وعرباً، هو من صميم واجبها، وليس منّة، وذلك لأسباب عدّة:
1- التزاماً بالاتفاقيّات والمواثيق والعهود الدوليّة التي تجبرها على فتح الحدود لحماية المدنيين أثناء الحروب.
2- إذا أغلقت حدودها في وجه النازحين السوريين، الفارين من وحشيّة «داعش» أو الأسد، فهذا يعني أنها تشارك عمليّاً في حملة «الأنفال» والتطهير العرقي التي يمارسها «داعش» ضدّ السوريين عموماً، والكرد خصوصاً!.
3- تفريغ المناطق الكردية من سكّانها مصلحة تركيّة بامتياز. وفي حال رفض فتح حدودها أمام نازحي كوباني، سيعتبر ذلك فضيحة سياسيّة وأخلاقيّة، إذ تسمح للنازحين العرب السنّة بدخول أرضيها، وترفض دخول الكرد السوريين. وبالتالي يظهر وجهها الطائفي والقومي، ضدّاً على كل المساحيق والأقنعة.
4 – تركيا تزعم أنها مناصرة للثورة السوريّة، وتسعى إلى إسقاط نظام الأسد، وتقول إنها من مجموعة أصدقاء سورية، وبالتالي من واجبها الوفاء بكل هذه الاستحقاقات، فإن لم تفعل أصبح كلامها مجرد فقاقيع صابون ملوّنة!.
الغريب أن غالبية المعارضين السوريين، بخاصّة منهم «الأخونجيّة» والعلمانيون «المتأخونون»، صاروا يرددون الأسطوانة التركيّة حول إيواء اللاجئين السوريين، في شكل ممجوج ومقرف. بحيث أصبح حال هؤلاء أسوأ من حال نظام الأسد، حين كان «سمناً على عسل» مع نظام أردوغان، قبيل اندلاع الثورة، بحيث تنازل الأسد الإبن عن لواء إسكندرون للأتراك، وعن الكثير من السيادة الوطنيّة، إرضاء لأنقرة. وكان الأجدى بهؤلاء المعارضين رفض تمنين أنقرة المواطنين السوريين، ووضع قضيّتهم على بازار مكاسبها السياسيّة.
لقد سقط بعض المعارضين السوريين في درك «تمسيح الخوج الأردوغاني» لدرجة استرخاصهم الاهتمام الدولي بمدينة كوباني السوريّة، وتقليلهم من المقاومة التاريخيّة التي يبديها المقاتلون والمقاتلات الكرد في وجه الهجوم الداعشي البربري!. وكان عليهم الردّ على تصريح أردوغان الذي قال فيه «لقّنت «داعش» أكراد سورية درساً استحقوه»!. لكن يبدو أن المعارضة السوريّة أسيرة القبضة الأردوغانيّة. وحالة الارتهان والذلّ والتبعيّة المطلقة للنظام الأردوغاني هذه إنما تمنح تبريراً قويّاً لعدم فكّ حزب الاتحاد الديموقراطي ارتباطه بالنظام الأسدي، إذ المعارضة أسوأ حالاً وأكثر عنصريّةً من النظام؟.
وعليه، تسعى الحكومة التركيّة، سواء عبر ذراعها العسكرية الخفيّة «داعش»، أو ذراعها السياسية «الائتلاف الوطني لقوى المعارضة السوريّة»، إلى محاصرة الكرد السوريين. كما تسعى إلى نقل معركتها مع العمال الكردستاني من تركيا إلى داخل السوري، وممارسة نفس تقاليد نظام الأسد والنظام الإيراني في ما يخصّ تحريك التنظيمات الإرهابية كي تحارب بالوكالة عن تركيا، فضلاً عن فرض المنطقة العازلة في الشمال السوري، للسيطرة على نفط وغاز منطقة رميلان الكرديّة السوريّة. وبينما لا يخجل المسؤولون الأتراك من مطالبة حزب الاتحاد الديموقراطي بفكّ ارتباطه بالنظام السوري، فيما يعجز أردوغان وحزبه عن ردع حزب الشعب الجمهوري المعارض، وكل أحزاب اليسار المتطرّف التركي، وغالبية العلويين في تركيا، عن دعم ومساندة نظام الأسد. بل إن العشرات من المواطنين الأتراك، كجماعة معراج أورال، يقاتلون مع شبيّحة الأسد، كما أن مئات من المواطنين الأتراك السنّة يقاتلون مع «داعش». فكيف، والحال هذه، تطالب أنقرة الحزب الكردي السوري بذلك!. زد على هذا وصف أردوغان المشاركين في حركة الاحتجاجات التركيّة في حزيران (يونيو) 2013، وحزب الشعب الجمهوري وجماهيره الذين يزيدون عن 10 ملايين تركي، بأنهم خونة وإرهابيون ومشاغبون، وإطلاقه الوصف نفسه على أنصار حليفه السابق فتح الله غولن، وعلى عشرات الألوف من المواطنين الأكراد المحتجّين على دعم أنقرة «داعش». وهذا كله يُشير إلى أن نصف الشعب التركي في نظر أردوغان إرهابيون وخونة. وهكذا فإن احترام الرئيس التركي شعبه إنما يشابه احترام بشار الأسد شعبه، وهو الذي وصفهم باللصوص والجراثيم والإرهابيين والمندسّين في مطلع الثورة السوريّة.
* كاتب كردي
الحياة
صفحة جديدة في الشرق الأوسط/ عبدالناصر العايد
أخيراً، حدث التدخل الخارجي في سورية، وهو أمر كان محتوماً منذ نزول أول دبابة إلى الشارع في مواجهة المتظاهرين قبل أكثر من ثلاث سنوات، وتخندق إيران وروسيا مع النظام وراء خيار الحل العسكري. بوصف التدخل الآن هو للجيش الأميركي، أقوى آلة عسكرية عبر كل الأزمنة، فإن مصير النظام السوري المتآكل وتنظيم البغدادي المتعيّش على إجرام وجنون عائلة الأسد، سيكون في عهدة الولايات المتحدة، وهي ستدافع عن قراراتها وموقعها القائد في العالم، وسترد بعنف فيما لو لجأ كل من إيران و»حزب الله» وربما روسيا إلى أعمال استفزازية للتشويش على دورها ورؤيتها.
لقد أرّخ تحليق أول طائرة للتحالف فوق الأراضي السورية، لنهاية الطور الصاعد من حياة تنظيم «داعش»، الذي سيدخل منذ الآن في طور العمل السري، والحرب عليه ستستمر إلى مدى زمني طويل كما هو واضح من طبيعة وأهداف الهجمات التي يتم شنها عليه. وترتبط معاودة التنظيم للظهور في زمن مقبل، بالمعالجة الميدانية الناعمة للتنظيم على الأرض، على اعتبار أن القصف الجوي العنيف من الجو هو معالجة خشنة بالمقاييس العسكرية. والمعالجة الناعمة ذات شقين، عسكري تضطلع به قوات المشاة والمدرعات، وأمني تختص به أجهزة الاستخبارات والإعلام، وليس من المعروف بعد من سيتولى هذه المهمة، الجيش الحر أم قوات دولية متحالفة، أم كلاهما.
توضح خريطة الأهداف التي قُصفت أن هناك تركيزاً على قطع طريق التنظيم عبر الحدود السورية – العراقية، ما يشير إلى فصل سياسي في التعامل مع التنظيم على جانبي الحدود، وليس مجرد عملية تقطيع أوصال للجسد العسكري للتنظيم، بل عملية تحديد لحيّزين سياسيين متمايزين، عراقي وسوري، لكل منهما متطلباته وقوانينه. ويؤكد وجود الدول العربية ضمن التحالف، إلى طبيعة الحرب الحالية وأهدافها، فهي معركة العرب من أجل إبقاء سورية في الصف العربي وتخليصها من النفوذ الإيراني، ومن حيث الطبيعة حرب ضد التطرف السني، الذي لن ينجح في تخفيف حدته سوى تدخل أطراف سنيَّة، تمنح الدور الأبرز تكتيكاً، بعد الدولة العظمى التي ترتكز إليها الحرب استراتيجياً. وينبئ الانكفاء التركي إلى احتجاج وخسارة القضية سياسياً لمصلحة الطرف العربي، وما مطالبته بمنطقة حظر جوي على حدوده سوى مطالبة بتعويض، قد يمنح له في المرحلة الحالية جانب منه، وبما يمكنه من مواجهة تهديد المتطرفين الأكراد وحسب. على أن استرضاءه واجب، إذ إن الإعلان التركي عن إعادة ألف جهادي كانوا ينوون التوجه إلى سورية، تحذيري أكثر مما هو تطمينياً.
إيران بدورها ليست خارج اللعبة تماماً، لكن مجالها الحيوي هو العراق، وإن شاءت أن يكون لها دور في سورية، فثمنه التدخل ضد التنظيمات والمنظمات الشيعية المتطرفة في هذا البلد، وهو ما لا يظن أنها قادرة على تقديمه في الوقت الراهن.
إن شمول الضربات الجوية «جبهة النصرة» وجماعة «خراسان»، يعني قطع الطريق على أي اعتراض أو معارضة روسية وصينية، إذ ليس لـ «داعش» حتى اليوم نشاط دولي يمكن التذرع به لوضع الحرب الحالية في إطار التهديد العالمي، واستجلاب جماعة «خراسان» ومخططاتها الكونية في الأيام الأخيرة، ربما كانت في سياق رص وتنمية الحلف الدولي الذي تقوده أميركا والمؤلف من أربعين دولة، للوقوف في وجه تحالف مضاد روسي وصيني محتمل. وعلى اعتبار الحرب حرب عصابات، طويلة الأمد بطبيعتها، فإن ترسيم الشكل النهائي للصفحة التي فتحت في الشرق الأوسط اليوم، وإقرار معادلاتها، مازال مبكراً. وبالتالي ستحرص كل الأطراف ذات الصلة على التحلي بسياسة ضبط النفس، إزاء التدخل العسكري الأميركي، وقد كان النظام السوري أول المبادرين، حين رحب بالهجمات بعد أن هدّد بالتصدي لها في ما مضى.
لقد حدّد شكل التحالف والدول المنضوية فيه، ملامح الاتجاه السياسي للمرحلة المقبلة، ومن يقف في موقع الهجوم ومن في موقف الدفاع، وينتظر أن تحدّد اتجاه العمليات العسكرية ومكانها، ملامح أكثر دقة للتطورات السياسية المقبلة، وسيكون حاسماً فيما لو نتج من العمليات تسليم الأرض للجيش الحر بعد طرد «داعش» منها. فهو سيعين بدوره الموقفين الإيراني والروسي، ويضع العلميات في طور المرحلة النهائية، لكن ذلك سيستغرق بعض الوقت، فقد أعلن البيت الأبيض أنه في حاجة إلى أربعة أشهر لتأهيل قوى المعارضة المعتدلة، ونحو ثمانية لفرض وجودها على الأرض كبديل لنظام الأسد وتنظيم «داعش»، وقد ينشط في هذه الأثناء سوق المساومات والتسويات السياسية، ويغير مجرى العمليات العسكرية.
* كاتب سوري
الحياة
نار كوباني تحرق تركيا/ بكر صدقي
35قتيلاً ومئات الجرحى هي الحصيلة الأولية لقمع تظاهرات التضامن الكردية مع محنة كوباني في المدن التركية. هذه فاتورة عالية بالمعايير التركية، إذا أخذنا بعين الاعتبار أن الحرب المديدة بين حزب العمال الكردستاني والدولة التركية متوقفة منذ نحو سنتين، وخاصةً بعد إعلان عبد الله أوجالان «نهاية الكفاح المسلح» لحزبه في 21 آذار/مارس 2013، والبدء بسحب عناصره المسلحة من الأراضي التركية في إطار الحل السلمي بين «الكردستاني» والدولة التركية.
تشير المظاهرات العنيفة لكرد تركيا، احتجاجاً على موقف الحكومة السلبي من حصار كوباني، قبل كل شيء، إلى قوة العصبية القومية الكردية في تركيا التي لم تفقد من زخمها شيئاً على رغم مسار الحل السياسي المتعثر بين الحزب الكردستاني والدولة، ربما بسبب هذا التعثر، أي بسبب مماطلة الطرف التركي وتردده في الوفاء بالتزاماته. ويتحدث بعض المحللين الأتراك والكرد عن خروج هذه الاحتجاجات عن سيطرة الحركة السياسية الكردية في تركيا. لوحظ ارتباك رئيس «حزب الديمقراطية للشعوب» (HDP) صلاح الدين دمرتاش وهو يدعو إلى عدم استهداف العلم التركي وتماثيل مصطفى كمال أتاتورك. كما وجه عبد الله أوجالان نداءً إلى كرد تركيا بعدم الانسياق وراء العنف. بل إن ثلاثة من قادة الحركة السياسية الكردية أطلقوا نداءً مشتركاً لوقف التظاهرات وعدم الانجرار إلى التحريض والاستفزازات من قبل «حزب الله» التركي الذي واجه مظاهرات الكرد بالسواطير والأسلحة النارية.
من جهة أخرى، نجح الكرد في تحويل معركة كوباني إلى قضية الساعة على المستوى الدولي، فضلاً عن كسبهم لمعركة اسم البلدة (كوباني) على المستوى الرمزي. فقد أصبح اسم هذه البلدة الصغيرة المهملة على ألسنة كبار القادة في العالم، واستحق من الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون موجةً جديدة من قلقه الشهير. هذا ما دفع ببعض من الرأي العام السوري إلى نوع من الحسد: لماذا لا تثير مجازر النظام السوري بحق المدن والبلدات السورية، ولا جرائم داعش بحق المناطق الخاضعة لقواته الاهتمام السياسي والإعلامي نفسه الذي أثاره حصار كوباني؟
لكنه حسد متكرر، سبق وظهر إزاء الاهتمام العالمي بمحنة الفلسطينيين في قطاع غزة أثناء الحرب الإسرائيلية الأخيرة عليها، وإزاء محنة اليزيديين في جبل شنكال (سنجار) الذين تعرضوا لغزو قوات داعش. إذا كان التعاطف العالمي مع الفلسطينيين مفهوماً بالنظر إلى التسويق الجيد نسبياً للقضية الفلسطينية لدى الرأي العام العالمي طوال عقود، وبالنظر إلى الحروب المتكررة التي تشنها إسرائيل عليهم كل بضع سنوات، كما إلى الكراهية الغربية المكبوتة ضد اليهود ودولتهم العنصرية، فتحويل معركة كوباني إلى قضية تلقى التعاطف بالزخم الذي ظهر به، بحاجة إلى تفسير.
قبل كل شيء، لم يحظ كرد كوباني بالدعم الذي حظي به كرد إقليم كردستان في مواجهة تقدم قوات داعش باتجاه العاصمة أربيل. بالعكس، حوصرت كوباني من الجهات الأربع، وامتنعت تركيا عن فتح حدودها أمام المتطوعين الذين أرادوا الانضمام إلى القوات المدافعة عنها، ولا سمحت لأطراف ثالثة بإيصال أسلحة أو ذخائر إلى قوات المقاومة. وهذا ما دفع كرد تركيا إلى الشوارع ليهاجموا مقرات الحزب الحاكم أو بعض مؤسسات الدولة. كما لعبت الجاليات الكردية في أوروبا دوراً كبيراً في تسليط الضوء على محنة كوباني، وحشرت الحكومات الغربية في زاوية ضيقة من خلال التأثير على الرأي العام في البلدان الأوروبية.
كان واضحاً أن تركيا لن تساعد الفرع السوري لحزب العمال الكردستاني الذي أقام كيانه المسمى بالإدارة الذاتية لصق حدودها. بل إن المناخ السائد في الأوساط الحكومية وقسم من الرأي العام التركي (القومي المتشدد) هو الشماتة بضرب داعش لقوات حماية الشعب الدائرة في الفلك الأوجالاني، والرغبة في سقوط كوباني بوصفها المختبر الحي لفكرة أوجالان بصدد الإدارة الذاتية الكردية في تركيا. ولم يكن من الواقعية في شيء مطالبة أنقرة بتقديم أسلحة نوعية لمقاتلي كوباني أو السماح بتمريرها أو الزج بقوات برية تركية لمواجهة داعش في البلدة المحاصرة. فكل ذلك مما يتعارض مع هواجس الأمن القومي التركي. ولم تنفع زيارة صالح مسلم الخاطفة لاسطنبول في تذليل التناقضات بين الجانبين. فقد طالبه الجانب التركي بشروط تعتبر تعجيزية من وجهة نظر حزب الاتحاد الديموقراطي، أهمها تغيير تموضعه من حليف غير معلن لنظام الأسد إلى عدو صريح.
الواقع أن التيار الأوجالاني، في سوريا وتركيا معاً، حاول استثمار محنة كوباني إلى أقصى حد للضغط على حكومة أنقرة لتوريطها في تعقيدات الأزمة السورية، بصورة متسقة تماماً مع الحرب الأمريكية المعلنة على داعش. الحكومة التركية المنخرطة أصلاً في الصراع الداخلي السوري لمصلحة التيارات الإسلامية، وجدت نفسها فجأةً أمام تحديات غير مسبوقة تطالبها بتحويل الدفة ضد الإسلاميين، ولمصلحة أعدائها المعلنين: نظام الأسد الكيماوي والعمال الكردستاني. هذا ما رفضته أنقرة ووضعت شروطاً لمشاركتها في الحرب الأمريكية على داعش.
ومن زاوية نظر «الكردستاني»، شكلت معركة كوباني فرصة لتسويق نفسه، أمام المجتمع الدولي والولايات المتحدة بخاصة، كالطرف الوحيد المؤهل لمواجهة قوات داعش على الأرض. حتى قبل الحصار الأخير بدأت الأصوات الكردية في تركيا تعلو مطالبةً الحكومة التركية بتزويد مقاتلي الكردستاني في جبل قنديل بالسلاح لمواجهة تقدم داعش في شمال العراق، بالقول إن ذلك من شأنه دفع مسار الحل السلمي للقضية الكردية في تركيا إلى الأمام.
الحسابات الداخلية التركية، إذن، هي الغالبة في مواقف «الكردستاني»، في حين تسعى أنقرة إلى مواجهة الضغوط الأمريكية الهادفة إلى توريطها في حرب خاسرة في جميع الأحوال. فحتى لو حقق التحالف هدفه المعلن بالقضاء على داعش، كان نظام الأسد هو الرابح الأكبر، الأمر الذي يعني انهيار كامل للسياسة التركية في سوريا، وخدمة مجانية للعدو الأساسي في نظر حكومة أنقرة.
٭ كاتب سوري
القدس العربي
التدخل السوري المفقود/ نجاتي طيّارة
تقوم الدنيا ولا تقعد منذ أسابيع، بسبب أخبار كوباني، وهي التي ما زالت تشهد اجتياحاً متواصلاً من داعش، ترافق مع تهجيرٍ جديد، طاول عشرات آلاف السوريين، ذوي الأصول الكردية.
كوباني الكردية، أوعين العرب، أو عين الإسلام الداعشية، تثير سوقاً مفتوحة لكل أنواع التدخل. فالتحالف الدولي يتدخل حالياً من الجو، وتركيا مطالبة بالتدخل في البر، أما إيران، فأعلنت استعدادها للتدخل، لكن بشرط التنسيق مع نظام الأسد! وذلك كله، لأن كوباني تثير حساسية جيو سياسية وقومية عالية، كونها تضم أغلبية كردية ذات مشروع كياني، لا بد له أن ينعكس داخل حدود تركيا نفسها، بل صار يهددها باضطراباتٍ قومية متصاعدة.
من هنا، استعدت السلطات التركية للتدخل، وحصلت على موافقة برلمانها، وحشدت القوات على الحدود، لكنها أعلنت أنها لن تقدم عليه، إذا لم يكن ضمن استراتيجية تتضمن إقامة منطقة عازلة وحظر جوي لا يسمحان للأسد بالاستفادة من ضرب داعش، كما لا يسمحان بإقامة كانتون كردي على حدودها، بل يشكلان مناطق آمنة لمئات ألوف السوريين الهاربين من مذابح النظام.
هكذا، يبدو أن المسألة السورية الأصلية قد دخلت، بصورة أكثر وضوحاً، في سياق بالغ التوتر. ذلك أن كوباني، في الواقع، إذا كانت تكرر جوانب فاجعة في المأساة السورية التي يستمر فيها موت السوريين وتدمير بلدهم، منذ حوالى أربع سنوات، فإنها أصبحت نقطة تقاطع وتحول لمصالح القوى الإقليمية والدولية، كون تركيا الشديدة الاهتمام بضبط الطموحات الكردية لإنشاء كيانٍ سيهدد وحدتها الوطنية، تتقدم، أيضاً، بصفتها عضواً في الحلف الأطلسي، لحماية حدوده الشرقية من تهديد طموحات إيران، وأصدقائها الجدد في روسيا، وكان نصب شبكة صواريخ الباتريوت علامة على ذلك. ومن جهتها، تساوم إيران على جبهتها الأمامية السورية، في إطار مصاحب لمفاوضات الملف النووي، وهو ملف ما زالت أميركا راغبة في تسويته معها، واستكشاف إمكانات ضبط إيران، الدولة والمصالح، في إطاره، بينما ارتفعت درجة المساومة الإيرانية إلى درجة التصريح، على لسان معاون وزير خارجيتها، أن أمن إسرائيل سيتهدد في حال سقوط نظام حليفها الأسد.
وبانتظار تطور الأوضاع، واحتمال انفتاحها على متغيراتٍ، لا تستبعد إعادة رسم جديدة للخرائط السياسية والمجتمعية في شمالي سورية، يبدو أن السوريين، أنفسهم، صاروا أكثر، من أي وقت مضى، موضوعاً للعبة، ليس لهم دور فيها إلى هذا الحد أو ذاك، ومن ذلك استمرار المعارك والقصف والتدمير في كل مكان في أنحاء سورية اليوم، من الحارّة إلى جوبر والوعر وحلب. والموتى فيها سوريون في الأعم والأغلب، على الرغم من مشاركة أجانب من حزب الله وداعش. وهم، كما يعلم الجميع، لا يقاتلون من أجل حرية السوريين، بل من أجل استبدادٍ ليس فيه فرق بين ولي الفقيه أو الخليفة! ومن ذلك أيضاً، أن اجتماع الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية منشغل بالصراع حول تشكيل حكومة مؤقتة، لا تملك من أمور سيادتها شيئاً، بينما كان يجدر بالائتلاف الاهتمام بدوره السياسي، الذي يفترض فيه دفع الحرب الجارية ضد الإرهاب لما فيه مصلحة سورية والسوريين.
وهناك فشل، أو تعثر، مفاوضات التوصل إلى هدن مؤقتة في داريا ومساكن عدرا العمالية وغيرها، وخصوصاً في الوعر الذي يشهد حصاراً وقتلاً تدريجيا لحوالى مئتي ألف مدني، مع ملاحظة انسحاب الوسيط الإيراني وتركه للتدمير، بعكس ما حدث في مفاوضات فك الحصار عن حمص القديمة. وهي مفاوضات استثمرت العمل السياسي، إلى جانب العمل العسكري بين أوساط السوريين، وسبق لها اكتشاف توسطات بينهم ومحاولة إيجاد مناطق خضراء، وسط جبهات القتال الدامية، وذلك في جبهات استقر فيها شكل من التوازن بين جانبي الصراع، وأمكن استثمار تواصلات مختلفة، لما فيه فائدة حياة الناس والمجتمع المحلي المغلوب على أمره، مثل تبادل المعتقلين والمخطوفين، وفك الحصار وتمرير قوافل التموين والمواد الطبية إلخ، وكلها أمور عرفها تاريخ الحروب والصراعات البشرية، وأثبتت حيوية المجتمعات وقدرتها على التكيف، على الرغم من هول الحروب وآلامها، وعلى الرغم من مرارة التجربة السورية التي كشفت خروج النظام عن قيم كل تراث إنساني في هذا الشأن.
التدخل أو الدور السوري مفقود اليوم، واستعادته مسؤولية من بقي لديهم حرص على الوطنية السورية، أينما كانوا وفي أي موقع، وخصوصاً في جوانب الصراع. ومن المفهوم أن أحداً لن يعطيهم هذا الدور، ولن يتحقق إلا بمبادرتهم أنفسهم، وهو دور لا يعني، اليوم، إلا إنقاذ ما تبقى من معنى سورية وطناً لجميع أبنائه، وبغض النظر عن الأهداف البعيدة المدى لكل منهم، كما أنه يمكن أن يبدأ من تحت ومن الأطراف، ولا يحتاج دوماً إلى أن يبدأ من فوق ومن الرأس، فيفتح بذلك باباً لإقامة هدن ومصالحات ومناطق خضراء، في كل مكان متاح من سورية، بينما يكون على كل السوريين الانصراف لدحر وحش الإرهاب الذي يكاد أن يلتهمهم جميعاً.
العربي الجديد
الحرب بـ”داعش”/ سلامة كيلة
الغريب أن حجم داعش وقدرتها كبرتا بعد الحرب الأميركية عليها، حيث إنها، على الرغم من مئات، وربما آلاف الغارات التي شنتها قوات “التحالف”، لا زالت تتقدم وتتوسع. على الرغم من أن “منطقة الحرب” صحراوية مكشوفة، وليست جبلية، لكي تصعب على الطائرات الأكثر حداثة وتطوراً. تقدمت داعش نحو عين العرب التي كان في وسع القصف الجوي أن يقطع طرق الإمداد عنها، ودخلتها ليصبح القصف للمدينة. وهكذا في هيث والأنبار، وحيث تتقدم داعش نحو بغداد. آلاف الغارات لم تقتل سوى عشرات، وآلاف أطنان الأسلحة لم تؤثّر في مسار توسع السيطرة.
الأمر يطرح الأسئلة، حيث يظهر أن دور طيران “التحالف” هو حماية تقدم داعش، وليس مواجهتها، وتسهيل سيطرتها، وليس وقف توسعها.
كان تقدم داعش نحو أربيل المدخل للتدخل الأميركي الذي توسّع، لكي يشمل سورية بعد العراق. بالتالي، ما الهدف من دفع داعش، لكي تحتل عين العرب، وربما تتقدم نحو كل الشريط الحدودي مع تركيا؟ إحراج الحكومة التركية أم نقل الصراع إلى داخل تركيا؟ حيث إن عدم الدفاع عن عين العرب بات يؤجج المشكلة الكردية في تركيا، بعد أن ظهر أنها في سياق الحل. أميركا تريد إشراك تركيا في الحرب على داعش، والحكومة التركية تريد ربط الحرب عليها بالحرب ضد النظام السوري، بهدف التدخل من أجل إسقاطه، الأمر الذي لا ترغبه أميركا. وهذا لافت، ويطرح الأسئلة حول الهدف الأميركي من الحرب ضد داعش في سورية التي يبدو أنها خارج سياق الصراع الذي يجري في سورية، والذي يريد إسقاط النظام، وخارج حساب تركيا التي تريد الإفادة من الوضع القائم للتدخل البري وفرض “سلطتها”.
في العراق، بدا أن التدخل الأميركي قد فرض تغيير التوازنات في “العملية السياسية”، بعد أن سيطرت السلطة الإيرانية، تماماً، بعد الانسحاب الأميركي. لكن، ما معنى أن تحاصر داعش بغداد؟ من الواضح، في الأيام الأخيرة، أن إيران ما زالت لا تريد التنازل عن سيطرتها على الحكومة العراقية، ولهذا ما زالت “العملية السياسية” تتعثر، هل هدف “زحف” داعش على بغداد هو استمرار الضغط من أجل فرض معادلة جديدة في العراق؟
من هذا المنظور، يمكن تصوّر ما تريده أميركا، حيث يبدو أنها تريد تغيير معادلة التوازنات، وهي تسعى إلى التفاهم مع إيران. لهذا، تعمل من أجل أن يجري الضغط في سورية والعراق، من أجل تغيير “حصار” ها، وسحب الأوراق من يدها، لكي يكون ممكناً التفاوض من موقع مختلف عما تنطلق إيران منه الآن، أي من موقع أنها تسيطر، تماماً، على الوضعين السوري (واستتباعاً اللبناني) والعراقي. ذلك كله في إطار المفاوضات حول البرنامج النووي الإيراني. لهذا، يبدو أن هدف أميركا في العراق هو تغيير توازنات السلطة فيه، والضغط عبر التدخل في سورية، لترتيب التوافق على طبيعة السلطة فيها. فأميركا معنية، منذ مدة، بالتفاهم مع إيران، ومعنية بأن تعيد الربط معها، ضمن رؤيتها العالمية (حصار الصين، واستقرار الخليج)، ولكن، لا تريد أن توافق على المطامح الإيرانية التي كانت كبيرة، بحيث تصبح قوة ليس إقليمية فقط، بل قوة عالمية، ومن ثم تريد تقزيمها، بحيث تقبل بدور إقليمي متوافق عليه معها.
بهذا، الحرب ضد الإرهاب هي من أجل الضغط، وليس لإنهاء داعش. والموقف الأميركي واضح هنا، لقد كرروا: لا نريد إنهاء داعش، بل وقف تمددها. بالتالي، ليبدو أن الأمر هو ليس داعش، بل هو الوضع السياسي والتوازنات السياسية في المنطقة. لهذا، يمكن أن نقول: أن الحرب هي ليست ضد داعش، بل إن الحرب هي بـ داعش.
العربي الجديد
ليس دفاعاً عن تركيا/ علي العبدالله
أثار الموقف التركي من الاشتراك في عمليات التحالف الدولي ضد تنظيم «داعش» الإرهابي في سورية والعراق، والشروط التركية للمشاركة فيها أسئلة كثيرة، وقد زاد من حدة الأسئلة واستنكاريتها ما يحصل من قتل وتدمير وتهجير في مدينة عين العرب/ كوباني الكردية.
ماذا وراء التحفظ التركي؟
قالت تصريحات وتحليلات كثيرة، خصوصاً كردية، إن لموقف تركيا علاقة مباشرة بالملف الكردي، وإنها استثمرت في «داعش» لتحجيم النهوض الكردي وضرب تجربته «الديموقراطية» التي أطلقها بإنشاء كانتونات الحكم الذاتي في سورية، وها هو ذا النظام التركي يقف متفرجاً على المذبحة في كوباني للضغط على الكرد وقواهم السياسية للقبول بمطالبه مقابل التدخل عسكرياً لمنع سقوط المدينة بيد الإرهابيين.
مع التسليم بوجود العامل الكردي في خلفية الموقف التركي، فإن هذه القراءة غير كافية لتفسره بأبعاده المحلية والإقليمية والدولية. لذا، كي نحدد دوافعه لا بد من أخذ كل العوامل والنظر في خلفياتها وانعكاساتها عليه بدءاً من الوضع المتفجر في الإقليم وخلفيته المذهبية إلى التوجهات الدولية في شأنه، والتي تثير هواجس النظام التركي ومخاوفه، إن لجهة تعزيز مواقع أعدائه أو نقل التوتر والصراع إلى حديقته ووسط داره. فتنظيم «داعش» الإرهابي لم يأتِ من الفضاء الخارجي، بل نشأ ونما تحت أنظار القوى الإقليمية والدولية التي استثمرت في الظاهرة لاعتبارات آنية ومن دون التفات إلى المترتبات والنتائج المستقبلية الخطيرة التي ستنعكس سلباً على الأمن والاستقرار في الإقليم كله.
فالنظام السوري وحلفاؤه الروس والإيرانيون وجدوا في التنظيم الإرهابي حليفاً موضوعياً في ضوء استهدافه قوى المعارضة واستيلائه على المناطق المحررة من جهة، وإعطائه صورة سلبية عن الثوار السوريين كمجموعات تكفيرية إرهابية من جهة ثانية.
الولايات المتحدة وجدت في التنظيم فرصة لخلط الأوراق ومد عمر الصراع لحسابات إقليمية ودولية (المفاوضات النووية مع إيران والمواجهة مع روسيا في أوكرانيا). الدول العربية المعنية وتركيا فاجأها التنظيم الذي مر تحت نظرها ويديها.
غير أن الصدمة التي حدثت باستيلاء التنظيم على عدد من المدن العراقية أسقطت الرهانات السابقة وأجبرت الأطراف الإقليمية والدولية على إعادة حساباتها وترتيب أولوياتها، وهذا اضطر الإدارة الأميركية لتعديل موقفها والانخراط عسكرياً في الصراع، ومحاولة خلق توافقات وإجماع على محاربة التنظيم وضبط التوترات والانفجارات السياسية التي فجرتها السياسات الإقليمية المتعارضة (إيران وسعيها للسيطرة على الإقليم وتصعيدها التوتر الطائفي بين السّنة والشيعة، سياسة حكومة المالكي الطائفية والتمييزية، دول الخليج ومخاوفها من التمدد الإيراني وردها عبر الجماعات السّنية، تركيا ودعمها المعارضة السورية، بخاصة جماعة «الإخوان المسلمين»، لتعزيز دورها في سورية ومحاصرة الكرد).
وهذا ما استدعى تشكيل حلف الراغبين لتوفير غطاء سياسي ومالي للحرب وتمريرها من دون قرار أممي بالاستناد إلى دعوة الحكومة العراقية إلى المساعدة في محاربة التنظيم.
إلا أن تشكيل تحالف متماسك وناجح يحتاج إلى توافق على الأهداف والوسائل، وهذا ما أحجمت الإدارة الأميركية عن طرحه وسعت لفرض قرارها ومطالبها على الحلفاء. من هنا، ثارت الشكوك وتحركت الهواجس والمخاوف ونشأت تباينات بين دول التحالف، وتناقضات بين التحالف والدول المستبعدة (إيران، روسيا، الصين)، على الأهداف والوسائل والمصالح. تركيا من الدول التي تعاطت بفتور مع الدعوة الأميركية إلى تشكيل التحالف حيث رفضت التوقيع على بيان جدة ورفضت منح القوات الأميركية حق استخدام أراضيها في تنفيذ عملياتها ضد التنظيم، والتعديل الذي جرى على موقفها بعد لقاءات الرئيس التركي مع المسؤولين الأميركيين خلال دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك لم يكن محدداً وحاسماً، حيث طرح بصيغ ملتبسة ومجزأة وكأنه يقدم خطوة في انتظار خطوة من الطرف الآخر: الإدارة الأميركية.
وحتى مع الضغوط العالية والمتكررة، وإغرائها بتكليفها تدريبَ قوات المعارضة السورية المعتدلة، وتحريك العامل الأخلاقي بتوظيف مأساة المواطنين الكرد في كوباني، لم تنجح واشنطن في دفع تركيا خارج دائرة حذرها وحساباتها الخاصة.
في الحسابات التركية هواجس ومخاوف من توجهات الإدارة الأميركية وموقفها من النظام التركي في ضوء التأييد الأميركي لإسرائيل بعد حادثة أسطول الحرية لكسر الحصار عن غزة ومقتل المواطنين الأتراك على أيدي القوات الإسرائيلية وضغطها على تركيا لإعادة العلاقات والتخلي عن شروطها لتحقيق ذلك، وتصريحات السفير الأميركي في تركيا ضد سلوك النظام أثناء تظاهرات ساحة «تقسيم» ومواجهتها من جانب الشرطة باستخدام القوة المفرطة، إلى ما تقوله أنقرة عن تحريض أميركي لفتح الله غولن، والحملة الإعلامية الضارية ضدها تحت راية كشف الفساد والفاسدين، التي اعتبرتها ضغوطاً لإضعافها وضرب دورها الإقليمي والدولي.
وكان الموقف من النظام السوري النقطة الأبرز في الخلاف بينهما حيث تبنت كل منهما خياراً مختلفاً، فتركيا مع دعم المعارضة السورية كي تحقق هدفها في إسقاط النظام بينما الإدارة الأميركية مع استنزافه لإقناعه بالقبول بحل وسط، وقد تجسد ذلك في الضغط الأميركي لتحديد سقف الدعم المقدم للمعارضة السورية، كماً ونوعاً، والالتزام بالرؤية الأميركية للصراع، وتحرك واشنطن لصوغ المعارضة السورية بجناحيها السياسي والعسكري، بحيث لا تكون في السلة التركية عبر العمل على تحجيم دور حلفائها.
وهذا، إضافة إلى وقوف واشنطن إلى جانب الحكومة العراقية في مسألة تصدير نفط كردستان العراق وبيعه عبر تركيا ودخول واشنطن في مفاوضات سرية مع إيران من دون اطلاع تركيا أو أخذ مصالحها في الاعتبار، كرّس الخوف والقلق التركيين.
في اللقاءات والحوارات التي جرت من أجل تشكيل التحالف الدولي، تصرفت واشنطن كصاحب قرار ولم تضع الحلفاء المفترضين في صورة موقفها واستراتيجيتها، بل ركزت على دعوتهم إلى المشاركة ودعتهم إلى القيام بمهام محددة. لذا، لم تجد تركيا ما يحفزها للقيام بذلك في ضوء حساباتها ومصالحها الوطنية ومخاوفها من تداعيات الحرب على الإرهاب على ملفات ما زالت مفتوحة، من ملف المصالحة الوطنية مع الكرد إلى مستقبل الوضع في سورية والحالة الكردية فيه. وهذا دفعها إلى التمسك بتحفظها والإصرار على أخذ مخاوفها وهواجسها في الاعتبار والاتفاق على هدف الحرب، وعلى مستقبل الوضع في سورية، بحيث تحافظ على دورها ومصالحها في سورية الجديدة ولا تجد نفسها أمام كيان كردي جديد على حدودها الجنوبية، فوضعت تصورها القائم على منطقة آمنة وحظر طيران وإسقاط النظام السوري كأرضية لتدخلها.
* كاتب سوري
الحياة
النظام السوري وضرب “داعش”/ ميشيل كيلو
تدور في أوساط سورية معارضة متنوعة حوارات يومية عن الجهة التي ستفيد من ضرب “داعش”. هناك رأي يقول إن النظام وإيران ستفيدان وحدهما من ذلك، بينما يقول رأي آخر إن الضربة ستكون محكمة سياسيّاً وعسكريّاً، كي لا يفيد منها أحد غير المشاركين فيها كالتحالف الدولي، وفي الوقت الملائم: الجيش الحر.
إذا كان من الصعب تحديد الجهة التي ستفيد من ضرب “داعش” في سورية، فإن هناك جهات عراقية أفادت من الضربات التي أصابت التنظيم الإرهابي، وغطتها عراقيّاً المرجعية الشيعية وهيئة علماء المسلمين، وأيدها الكرد، ومعظم أحزاب البرلمان والجيش.
أما في سورية ، حيث المعركة ضد الإرهاب تالية في أهميتها للمعركة ضده في العراق، كما قال أوباما، فثمة غموض في خطط التحالف والأحداث الميدانية، وهناك بلبلة ترتبت على سياسات أميركية تنتقل من الركود والسلبية إلى وضعٍ، يختلف في طبيعته وأبعاده ومقاصده، من غير المعلوم بعد إلى أين سيصل، وخلال أي زمن، مع أن مجرد دخول أميركا النشط إلى الصراع السوري يغير أدوار المنخرطين فيه، فكيف إن كان يثير الانطباع بأن سياساتها ستتحول من قوة عطالة إلى قوة عصفٍ، يرجح أن تبدل، أيضاً، أدوار الفاعلين ورهاناتهم في الساحة السورية: شاركوا في الحرب ضد الإرهاب، أم لم يشاركوا فيها.
ثمّة ملاحظة عن هوية من سيفيد من ضربات التحالف، هي أن “داعش” حاضر بقوة في المناطق التي كان الجيش الحر قد حررها، وأخرجه من معظمها، وغير موجود أو ضعيف الوجود في مناطق النظام. والآن: هل يفيد ضرب “داعش” في مناطق قوته النظام، الذي أخرج منها، أم الجيش الحر الذي يقاتل “داعش”، ويفضي إضعافه إلى تقويته؟ وهل ضربه في مناطق النظام، حيث هو ضعيف، سيفيده مع أنه بالكاد موجود فيها! منطقيّاً: ستضعف ضربات التحالف “داعش”، وتقوي الجيش الحر، إذا عرفت قياداته وقواته كيف تبقى بعيدة عن صراعات الائتلاف والمعارضات السياسية، وبادرت إلى تنظم صفوفها وتعزيز أوضاعها، وعرفت كيف تفيد من الحرب ضد الإرهابيين، لكي تستعيد المناطق التي انتزعوها منه، وتسترد، أيضاً، من انضموا إليهم من عناصره. إذا ما حدث هذا، يرجح أن تتغير معادلات الصراع، وإن بصورة تدريجية، وأن يتراجع دور “داعش” بانحسار مساحات ومناطق سيطرته، وأن يبرز من جديد التناقض الذي كرسته الثورة بين البديل الديمقراطي والنظام، الذي تلاشى مع تراجع الجيش إلى 10% من مجمل الأرض السورية، يقع بين جيش النظام في الوسط والجنوب، و”داعش” في الشمال.
من المستبعد، في الوقت نفسه، ذهاب عائد الحرب ضد “داعش” إلى النظام الذي تحالف معه، واستخدمه في مناطق وقع طرده منها، فطرد الجيش الحر من معظمها، وفرض عليه قتالاً يوميّاً على جبهتين، أرهقه وأضعفه. ثم، كيف يمكن لنظامٍ رفض العالم مشاركته في الحرب ضد “داعش” الإفادة من ضربه، إذا كانت أنشطته وأهدافه تتكامل، اليوم، أيضاً مع أنشطته وأهدافه، وكان إضعافه يعد بالضرورة إضعافاً له؟ وفي النهاية، كيف يقوي ضرب “داعش” النظام، إذا كان سيسقط رهانه الاستراتيجي على الإرهاب، لتبييض صفحته الدولية، وجعله خياراً إجباريّاً بالنسبة إلى العالم؟
هناك، أخيراً، مشروع دولي لتسليح الجيش الحر وتدريبه، لن يتحقق في حالتين: إذا شارك النظام في الحرب ضد الإرهاب، أو أحبطت قيادات المعارضة المشروع الدولي، بنقل صراعاتها إلى صفوف الجيش الحر، وإبقائه أسير ضعفه وانقساماته، بدل توحيده وتقويته.
العربي الجديد
كوباني.. عين العرب والكرد وداعش/ علي العائد
من غير أن ينتهي الجدل بين السوريين حول الأصل في تسمية «عين العرب»، أم «كوباني»، دخل داعش على خط «النقاش» المتزامن مع تهجير أهالي المدينة، ودكها بالأسلحة الثقيلة، وقرر التنظيم تسميتها «عين الإسلام»!
عادة ما تسمي البلديات القرى والمدن الصغيرة والأحياء بما توافق عليه أهل البلدة، أو الحي، تاريخياً، فالحكومة طارئة في أغلب الأحوال، إلا في إنشاء مدينة لم تكن موجودة أصلاً. لكن لحزب البعث مآثر وسوابق في هذا المجال، بعدما قرر في منتصف ثمانينيات القرن الماضي تغيير أسماء مئات، وربما آلاف القرى في الجزيرة السورية. وعلى ما أعلم، فإن ذلك جرى في الحسكة والقامشلي بعد ترحيل مئات العائلات من منطقة الغمر، في «بحيرة الأسد» التي غمرت مئات القرى هناك إلى ريف القامشلي. وأعطاهم نظام حافظ الأسد أراضي قال إنها مملوكة للدولة السورية، بينما ينازع الكرد هذه الرواية بأن الدولة انتزعت ملكياتهم الزراعية ومنحتها لـ «المغمورين».
لم يجر ذلك في ريف الحسكة والقامشلي فقط. ففي ريف الرقة جرى تغيير أسماء مئات القرى. وفي منتصف ثمانينيات القرن الماضي، على سبيل المثال، جرى تغيير إسم قرية لاتزال تسمى «رْجيمان» (بتسكين الراء) إلى «الزنبقة». لكن شيئاً لم يغير الإسم على ألسنة سكان القرية وجوارها، ولم تشكل اللافتة التي تحمل الاسم الجديد جديداً بالنسبة لإسم قريتهم، رغم أنهم كانوا مجبرين على استخدام الإسم الجديد في الأوراق الرسمية لملكياتهم من الأراضي.
روايات عُرفية
نقلت شبكة الأخبار العربية عن وكالة أنباء الأناضول ثلاث روايات لأصل تسمية «كوباني». وقال أحمد جمو (كردي من محافظة حلب): لا معنى محدداً لإسم كوباني في اللغة الكردية، فالاسم يعود إلى أن الشركة الألمانية التي كانت تمد سكة الحديد الواصلة بين اسطنبول وبغداد عبر شمالي سوريا، مطلع القرن الماضي، افتتحت مكتباً لها في عين العرب، وسكان المناطق القريبة كانوا يسمعون من بعض الخبراء الأجانب اسم «كومباني» بالإنكليزية، ومع مرور الزمن تم تحويره ليصبح «كوباني».
المهم في هذه الرواية، على ضعفها، أن كردياً يرويها. وضعف الرواية يأتي من أن الكرد موجودين في المنطقة قبل مئات السنين من قدوم الشركة الألمانية، فما هو اسمها قبل قدوم الألمان؟ لا يذكر جمو شيئاً عن ذلك، وهذا يُحسب لأنصار تسمية «عين العرب».
يستدرك جمو أن هنالك رواية تاريخية أخرى تشير إلى أن أصل «كوباني» هو «كانيا عَرَبَان»، الذي يطلقه إلى الآن الكرد في المدينة على المنطقة الشمالية من المدينة، نسبة إلى عين مياه صغيرة كان يسقي الرعاة من العرب أغنامهم منها، وترجم الاسم للعربية لاحقاً إلى «عين العرب».
ويذكر باحث تاريخي كردي من حلب (طلب عدم ذكر اسمه)، لوكالة أنباء الأناضول، أن الكرد اجتمعوا للاتفاق على التصدي لعشائر عربية كانت تعتدي عليهم في المنطقة، وأطلقوا على اجتماعهم «كوم بانيا»، الذي يعني بالعربية: «الإجماع على موقف»، وتحوّر الاسم ليصبح «كوباني».
وأضاف الباحث نفسه رواية أخرى تقول إن عشيرة «مللان» في منطقة «رأس العين» (سري كانيه، بالكردية)، تحالفت مع عشيرة أخرى في منطقة «عين العرب» للتصدي لاعتداءات العشائر العربية عليهما معاً، واختارتا اسماً لتحالفهما «كوما باني»، وتعني كوما: الجماعة، وباني: العليا، وتقابل «كوما خوار»، التي تعني «الجماعة السفلى».
والمهم في الروايتين الأخيرتين هو حالة الصراع بين العرب والكرد. والصراع نفسه يثبت وجودهما معاً في المنطقة.
وعودة إلى دخول داعش بازار التسميات، فإن سوابقه تجعل تلك الإشاعة مرجحة، بعد أن أطلق على المحافظات والمدن والبلدات الكبرى التي سيطر عليها في كل من سوريا والعراق «ولايات»، حيث غيَّر اسم مدينة دير الزور إلى «ولاية الخير»، واسم مدينة الحسكة إلى «ولاية البركة».
أيا يكن الأصل، فلن يقتنع أحد الطرفين بوجهة نظر الآخر، وسيبقى جدل الإسم مستمراً، حتى تحت نار داعش.
كركوك سوريا
حتى الآن لم يخرج زعيم كردي ليقول ما قاله رئيس إقليم كردستان العراق، مسعود البرزاني، من أن ما قبل سيطرة البيشمركة على كركوك ليس كما قبلها، في إشارة منه إلى نجاح البيشمركة في صد هجوم داعش عليها بعد سيطرة الأخير على الموصل، في حزيران الماضي، واندحار الجيش العراقي أمام داعش في يوم وليلة.
لكن برزاني نسي كلامه، محبطاً، أو قام بتراجع سياسي تكتيكي موقت، حين اكتشف أن قوة داعش لا قبل للبيشمركة بها دون مساعدة إخوانه العرب في الجوار، ومساعدة الطيران الأميركي والغربي، بل ومساعدة إيرانية للدفاع عن المناطق الكردية في إقليم كردستان العراق.
مناطق كردية
استمر الجدل رغم خطر داعش، ولا يزال الناشطون العرب والكرد يذكرون الجدل القديم في نهاية السنة الأولى من الثورة السورية، حين ادعى الصحافي الكردي مسعود عكو أن من «حق» الكرد الدفاع عن مناطقهم في رأس العين، وسائر مناطق الحسكة وصولاً إلى الشرق في القامشلي، في إشارة إلى حرمان الجيش الحر من هذا «الحق». وقتها اشتبكت قوات الحماية الكردية مع الجيش الحر، وجرت هدنات وتهدئات ووساطات سياسية، لئلا تنحرف بوصلة الثوار عن عدوهم المشترك، فاستقر الوضع نسبياً لقوات الحماية الكردية.
ما يدعو إلى هذا الاستطراد اللوم الكردي للمقاتلين العرب بعدم دعم المقاتلين الكرد ومساندتهم في مواجهة داعش. وهنا يجب التذكير أن بين مقاتلي داعش كرد إسلاميون يقاتلون ضد أبناء «جلدتهم»، وبين الثائرين في درعا وريف دمشق كرد يحاربون النظام دون الاعتداد بأن هذه المناطق ذات أغلبية كردية، أو عربية، أو أي من الطيف السوري الطائفي المربك دائماً.
مشعل تمو
معظم هذه النقاشات تجري على فضاء الفايسبوك، بعيداً عن أرض الواقع. وهنالك من يلوم الناشطين العرب أنهم لم يغيروا صورة البروفايل دعماً لـ»كوباني». مع ذلك، هنالك من تعاطف، وكتب بغضب متأثراً بالمأساة التي وصلت كأسها إلى عين العرب كوباني، كلٌّ يرفع من شأن حصته من المدينة المنكوبة. صحيح أن جرح الكرد في مدينتهم أشد ألماً من جرحهم في الرقة، ودير الزور ومدنها الأخرى، لكن ذلك يعيدنا إلى بدايات الثورة السورية، وشعار «الشعب السوري واحد»، و»جمعة آزادي»، حين كانت سذاجتنا تؤكد أن الثورة مبرأة من المحاصصات المناطقية، وأطياف العنصرية المؤسسة على الاختلافات الطبيعية بين السوريين من باب الخصوصية. وقتها، لم تكن الرايات واللحى قد ظهرت، ولم نسمع صوتاً نشازاً يشوش على سذاجتنا.
جاء اغتيال مشعل تمو في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2011 ليضعنا أمام لغز من اغتاله. مشعل تمو الشهيد انضم إلى المجلس الوطني السوري، قبل أن تثور الشكوك حول عدم فاعلية المجلس وأعضائه، ورفض أن يكون للكرد وضعاً خاصاً في الثورة، في تلك الظروف على الأقل. اغتاله أربعة مجهولين في دقيقة واحدة، وأصابوا ابنه مارسيل، والناشطة زاهدة رشكيلو.
خرج ليلة الاغتيال عشرات الآلاف احتجاجاً على مقتل تمو، خصوصاً في القامشلي وعامودا، وحطموا تمثالاً لحافظ الأسد. وفي اليوم التالي، قُدِّر عدد مشيعي تمو بخمسين ألفاً في القامشلي وعامودا والدرباسية، وتحول التشييع إلى تظاهرات تطالب بإسقاط نظام بشار الأسد.
وشهدت منطقة القامشلي إضراباً عاماً ترافق مع تظاهرات، فأطلقت قوات الأمن النار وقتلت ستة متظاهرين. كما خرجت تظاهرات في عين العرب، وعفرين، واللاذقية.
مَنْ قتل مشعل تمو؟ ظل السؤال من دون جواب، بينما توجهت معظم الأصابع إلى النظام. كان ذلك وقت أن كانت الثورة طفلة، وكان الشعب السوري واحداً.
كوباني الآن
قد تكون كوباني سقطت في يد داعش، أو لا تكون، عند نشر هذه المقالة، لكن الجدل سيستمر، من دون أن يعني ذلك الأبطال المدافعين عنها «الآن». هم أصلاً في شغل عن كل هذا الهذر.
قد ينزح ما تبقى من أهل كوباني الذين لم ينزحوا بعد، وقد يقعون تحت حكم داعش، شأنها شأن مدن محافظة الرقة.
ما أثار انتباهي، في معرض الحديث عن تنازع الحق في اسم كوباني، أو عين العرب، عدم ذكر السكان العرب لكوباني، وهل من نزح هم الكرد فقط، دون سكانها العرب مهما كانت نسبتهم، وهل عدد اللاجئين إلى تركيا بعددهم الذي تجاوز 180 ألفاً كلهم كرد؟ إن كان ذلك صحيحاً فهي إذن كوباني، وتسمية عين العرب نظرية بعثية ستالينية حاول نظام الطاغية فرضها على الأكراد السوريين، وقد جاء الوقت لتصحيح هذا الخطأ التاريخي، وإن كان على يد داعش.
كاتب وصحافي سوري.