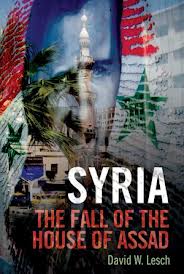نحن وغرامشي.. صعود التاتشريّة واليمين في بريطانيا وأزمة اليسار/ ستيورات هول

ترجمةكريم محمد
مقدمة المترجم
هذا النصّ نصٌ قديم؛ لكنّه جديدٌ في الوقت ذات. يرجع زمن كتابة هذه المادّة إلى عام 1987، وقد كتبها المنظّر الثقافيّ ذائع الصيت ستيورات هول، وأعاد نشرها مؤخراً موقع (Versobooks) في ذكرى غرامشي، ربّما أشهر منظّر ماركسيّ. فلهذه المادّة أهميّة مزدوجة، أو ثلاثيّة: أولاً لكاتبها، ثمّ لغرامشي، ثمّ لأهميتها في فهم السياق الإنجليزيّ وصعود مارجريت تاتشر واليمين في بريطانيا، وأفول الدّولة الكينزيّة ودولة الرّفاه هناك؛ فهي مادة تاريخيّة بالأحرى، وإنْ كانت هي بالأصل في الفلسفة السياسيّة.
كما أنّها تركّز على اليسار ودوره، والحاجة -حينذاك- لتجديد الاشتراكيّة. وقد كتب ستيورات هول كتاباً رائداً في ذلك الأمر سمّاه الطريق الشاقّ للتجديد: التاتشريّة وأزمة اليسار، وقد تكون هذه المادّة التي نُشرت لاحقاً في كتاب مجمّع بعنوان أنطونيو غرامشي: تطبيقات معاصرة، وعنوان المادّة بالأصل كما هو “نحن وغرامشي”.
نص المادة
ليس هذا بعرضٍ شاملٍ لأفكار أنطونيو غرامشي، ولا هو بتصوّر نَسقيّ للموقف السياسيّ في بريطانيا اليوم. إنّ هذه المقالة هي محاولة لـ “التفكير بصوتٍ عال” مع المعضلات المربكة التي تواجه اليسار، وذلك في ضوء أعمال غرامشي -ومن ومنظورها-، ولا أدّعي بحالٍ بأنّ غرامشي “يملك الأجوبة” أو “يحمل المفتاح” لمشاكلنا الراهنة. وأؤمن أنّنا علينا أن “نفكّر” في مشاكلنا بطريقةٍ غرامشيّة، وذلك أمرٌ مختلف؛ إذ لا يجب علينا أن نستخدم غرامشي -كما أسأنا ماركس لزمانٍ طويل- مثل نبيّ العهد القديم الذي سيوفّر لنا، في اللحظة الصحيحة، التثمين المناسب والمواسي. فليس بإمكاننا أن نقتلعَ هذا “الساردينيّ” -نسبةً إلى غرامشي المولود بجزيرة ساردينيا الإيطاليّة،مـ- من تشكله السياسيّ المميّز والذي لا نظير له، ونسقطه في نهاية القرن العشرين، ونطلب منه أن يحلّ مشاكلنا لنا: لا سيّما وأنّ مجمل تفكيره كان رافضاً لهذا النقل السهل للتعميمات من وضع أو شعب أو عهدٍ إلى آخر.
والحال أنّ هناك شيئاً حول غرامشي قد حوّل طريقة تفكيري في السياسية بالفعل، ألا وهو السؤال الذي ينشأ من دفاتر سجنه. فإذا نظرتم إلى النّصوص الكلاسيكيّة لماركس ولينين، فستُقادون إلى توقّع مفاده حدوث تطوّر تاريخيّ ثوريّ يبزغ من نهاية الحرب العالميّة الأولى فصاعداً. وبالفعل، قدّمت الأحداث دليلاً كبيراً على أنّ تطوّراً كهذا كان يحدث. ينتمي غرامشي إلى هذه “اللحظة البروليتاريّة”. فقد حدثت في مدينة تورينو في العشرينيّات، وفي أماكن أخرى؛ حيث إنّ أناساً مثل غرامشي، متمّاسّين مع طليعة الطبقة العاملة الصناعيّة -ثمّ في مقدّمة الإنتاج الحديث- ليعتقدون أنّه لو أنّ المدراء والسياسيين ابتعدوا عن الطريق، لربّما كان لهذه الطبقة من البروليتاريين أن يقودوا العالَم، وأن يستولوا على المصانع، وتغنم مكائن المجتمع برمّتها، وتحوّلها وتديرها ماديّاً واقتصاديّاً واجتماعيّاً وثقافيّاً وتقنيّاً.
والحقيقة بشأن العشرينيّات هي أنّ “اللحظة البروليتاريّة” قد انحلّت تقريباً؛ فقبل الحرب العالميّة الأولى وبعدها مباشرةً، كانت هذه اللحظة في وضع خطرٍ فيما يخصّ ما إذا كان العالم، تحت قيادة طبقةٍ كهذه، قد لا يكون تحوّلَ؛ كما كانت روسيا في 1917 بحلول الثورة السوفياتيّة. فقد كانت هذه لحظة المنظور البروليتاريّ حول التاريخ. وما سمّيتُه سؤال غرامشي في دفاتره إنّما ينشأ في أعقاب هذه اللحظة، مع الاعتراف بأنّ التاريخ لم يكن ينوي المضيّ بهذه الطريقة، لا سيّما في المجتمعات الرأسماليّة الصناعيّة المتقدّمة في أوروبّا الغربيّة. وكان على غرامشي أن يواجه نكوص هذه اللحظة، وفشلها: فالواقع أنّ لحظةً كهذه، وقد مرّت، لن تعود أبداً في زيّها القديم؛ وههنا، واجه غرامشي وجهاً لوجه الخصيصة الثوريّة للتاريخ بحدّ ذاته. فعندما يكشفُ وضعٌ ما عن نفسه، فليس ثمّة “عودةٌ”؛ إذ التاريخُ يحوّل التروس، والأرضُ تتغيّر؛ فأنتم في لحظةٍ جديدة؛ وعليكم الاعتناء، “بعنفٍ”، بـ “تشاؤم الفكر” في قيادتكم، لـ “انضباط الوضع”.
أضِف أنّ غرامشي كان عليه أن يواجه قدرة اليَمين -لا سيّما يَمين الفاشيّة الأوروبيّة- للهيمنة على هذه الهزيمة (وهذه إحدى العلل الأساسيّة التي تجعل فكر غرامشي وثيق الصّلة بنا اليوم). لذلك كان هناك انقلابٌ تاريخيّ للمشروع الثوريّ، ووضع تاريخيّ جديد، ولحظةٌ كان اليمينُ، لا اليسار، قادراً على السيطرة عليها. وهذا يشبه لحظة الأزمة الكليّة لليسار، عندما أُطلقت النيران على كلّ النقاط المرجعيّة، وعلى كلّ التكهّنات؛ فالكون السياسيّ، كما جئتَ لسكنه، ينهارُ.
إنّني لا أريدُ أن أقولَ إنّ اليسار في بريطانيا واقع في اللحظة ذاتها بالضبط؛ بيد أنّني آملُ أن تدركوا سماتٍ بعينها متشابهة بصورة لافتة للنّظر؛ لأنّ هذا التشابه بين هاتين الحالتين هو ما يجعلُ سؤال دفاتر السّجن مهمّاً جدّاً في مساعدتنا على فهم شرطنا وحالتنا اليوم. فغرامشي لا يقدّم لنا الأدوات التي نحلّ اللغزَ بها، وإنّما يقدّم لنا الوسائل التي نسأل بها الأسئلة الصحيحة حول سياسة الثمانينيّات والتسيعينيّات، وهو يفعلُ ذلك بتوجيه انتباهنا -بلا هوادةٍ- إلى ما هو محدّد ومختلف حول هذه اللحظة؛ إذ يصرّ غرامشي دائماً على هذا الانتباه للاختلاف والفرق، وهو درسٌ لم يتعلّمه اليسارُ في بريطانيا بعدُ؛ فإنّنا نميلُ إلى الاعتقاد بأنّ اليَمين ليس حاضراً معنا فقط؛ بل إنّه هو الشيء نفسه بالضبط دائماً: النّاس نفسهم، مع المصالح نفسها، والتفكير في الأفكار نفسها.
نحن نحيا عبر تحوّل المحافظيّة البريطانيّة، وتكيّفها الجزئيّ مع العالَم الحديث، بواسطة “الثورات” النيوليبراليّة والنّزعة النّقديّة (monetarist) (من النّقود، لا النَّقد -مـ)، فقد أعادت التاتشريّة (نسبةً إلى مارجريت تاتشر -مـ) هيكلة المحافظيّة والحزب المحافظ، والحال أنّ رجال الأعمال المنفعيين والبرجوازيين الصغار مسئولون الآن، وليس الطبقات المُطاردة والفريسة. ومع ذلك، رغم أنّ هذه التحوّلات تغيّر الأرضيّة السياسيّة للصراع أمام أُمّ أعيننا؛ فإنّنا نعتقدُ أنّ الاختلافات ليس لها أيّ تأثير حقيقيّ على أيّ شيء؛ فلا تزال تُشعر “اليساريّ” بصورة أكبر لأن يقول إنّ سياسة الطبقة الحاكمة القديمة تعمل بالطريقة القديمة ذاتِها.
من ناحيةٍ أخرى، عَلِمَ غرامشي هذا الاختلاف واهتمّ به بصورة خاصّة؛ لذا، بدلاً من التساؤل “ماذا يمكن لغرامشي أن يقول حول التاتشريّة؟”، علينا أن نعتني ببساطة بهذا الانتباه من غرامشي لفكرة الاختلاف، ولخصوصيّة الوضع التاريخيّ: كيف تتجمّع القوى المختلفة معاً، بالتحامٍ، لخلق الأرض الجديدة التي يجب على السياسة الجديدة أن تتأسّس عليها؛ هذا هو الحدس الذي يوفّره لنا غرامشي حول طبيعة الحياة السياسيّة، والذي يمكن أن نأخذ زمام المبادرة منه.
أودّ القول إنّني على ما أعتقد أنّ “دروس غرامشي” هي موجّهة، في المقام الأول، إلى التاتشريّة ومشروع اليمين الجديد، وثانياً، إلى أزمة اليسار. وإنّني ههنا أُقرّب الحَدّ الصارم لما أفهمه بالتاتشريّة، وأحاولُ أن أعالج فاتحة مشروعٍ سياسيّ جديد في اليَمين، منذ منتصف السبعينيّات فصاعداً. وبقولي مشروعاً؛ فإنّني لا أعني مؤامرة (كما حذّر غرامشي)، وإنّما أعني بنية أجندة جديدة في السياسة البريطانيّة.
لم تهدف تاتشر دائماً إلى انقلاب انتخابيّ قصير، وإنّما إلى تملّك تاريخيّ طويل للسّلطة. ولم يكن هذا التملّك للسّلطة مقتصراً على الإمساك بزمام أجهزة الدّولة. وبالفعل، نُظِّمَ المشروع، في المراحل المبّكرة، كمعارضة للدّولة، وهي الدّولة التي قد أفسدتها، من وجهة نظر تاتشر، دولةُ الرّفاه والكينزيّة وبالتالي ساعدت على “إفساد” الشعب البريطانيّ؛ فقد أتت التاتشريّة إلى حيّز الوجود في تعارض مع دولة الرّفاه الكينزيّة القديمة، ومع “الدولتيّة” الديمقراطيّة الاجتماعيّة التي، من منظور التاتشريّة، قد سيطرت على فترة الستينيّات. إنّ مشروع التاتشريّة كان رامياً إلى تحويل الدّولة من أجل إعادة هيكلة المجتمع؛ أي لفكفكة وإزاحة تشكّل ما بعد الحرب بأكلمه؛ وذلك لقلب الثقافة السياسيّة التي شكّلت أسس التسوية السياسيّة -أي المساومة التاريخيّة بين العمل ورأس المال- التي كانت قائمة منذ عام 1945 فصاعداً.
والحال أنّ عمق الانقلاب الذي تمّ استهدافه كان عميقاً؛ أي قْلب القواعد الأساسيّة لهذه التسوية، وللتحالف الاجتماعيّ الذي عزّزها وللقيم التي جعلتها شعبيّةً، ولا أقصد مواقف وقيم النّاس الذين يكتبون الكتبَ، وإنّما أعني أفكار الناس الذين يتوجّب عليهم ببساطة، في الحياة اليوميّة العادية، أن يحسبوا كيف يبقون أحياء، وكيف يعتنون بهؤلاء القريبين منهم.
هذا هو ما يُقصَد حينما يُقال إنّ التاتشريّة هدفت إلى إحداث انقلاب في الحسّ العامّ العادي. وقد بُنيَ “الحسّ العامّ” للشعب الإنجليزيّ حول الفكرة القائلة إنّ الحرب الأخيرة بنت حاجزاً بين الأيام الخوالي السيّئة في الثلاثينيّات وبين الآن: فدولة الرّفاه قد حان بقاؤها؛ ولن نعود إلى استخدام معيار السّوق كمقياسٍ لاحتياجات النّاس، واحتياجات المجتمع. ويتوجّب دائماً أن يكون هناك شيءٌ من القوّة الإضافيّة والتزايديّة والمؤسّساتيّة -الدّولة، وتمثيل المصلحة العامّة للمجتمع- من أجل مواجهة السّوق، وتعديله.
وإنّني على وعيٍ تماماً بأنّ الاشتراكيّة لم تُدشَّن في ١٩٤٥. فأنا أتحدث عن الأساس المُسلَّم به والشعبيّ لديمقراطيّة الرّفاه الاجتماعيّة التي شكّلت الأساس الفعليّ والملموس الذي يجب أن تُبنى عليه أيّ اشتراكيّة تستحق هذا الاسم. فقد كانت التاتشريّة مشروعاً رامياً للاشتباك مع هذا المشروع، ولمنازعه، ولتفكيكه أينما أمكنَ ذلك، ولإحلال شيءٍ ما جديدٍ محلّه، وأدخلت التاتشريّةُ الحقلَ السياسيّ في نزاعٍ تاريخيّ، ليس بالنسبة إلى السّلطة فحسب؛ وإنّما للسلطة الشعبيّة، وللهيمنة.
إنّه مشروعٌ رجعيّ وتقدميّ في آن واحد؛ وهذا أمرٌ يربك اليسار بلا منتهى. رجعيٌّ؛ لأنّه يأخذنا، في بعض النواحي الحاسمة، إلى الوراء، ولا يمكنك المضي إلى أيّ مكان آخر سوى الوراء لتعزّز أمام الشّعب البريطانيّ، في نهاية القرن العشرين، الفكرة القائلة إنّ أفضل مستقبلٍ بالنسبة إليهم هو أن يصبحوا، لمرّة ثانية، “فيكتوريين مرموقين” (Eminent Victorians) فهو مشروعٌ رجعيّ، وقديمٌ، ومائت.
لكن يجب أن لا يُساء فهمه، فهو أيضاً مشروع لـ”التحديث”. إنّه شكلٌ من أشكال التحديث الرّجعيّ؛ وذلك لأنّ التاتشريّة، في الوقت ذاته، كانت لها عينها الثاقبة المركزة على إحدى الحقائق التاريخيّة الأكثر عمقاً فيما يخصّ التشكّل الاجتماعيّ البريطانيّ؛ أي أنّه لم يدخل بتاتاً حقبة التحديث البرجوازيّ الحديث؛ فهو لم يحدث هذا التحوّل إلى التحديث، ولم يُمأسس، بمعنى سليم، التحضّر وبنى الرأسماليّة المتقدّمة؛ ما أسماها غرامشي بـ”الفورديّة”. ولم يحوّل هذا التشكّل بناه السياسيّة والصناعيّة القديمة، ولم يصبح أيضاً قوّة ثورة صناعيّة رأسماليّة ثانية، كما فعلت الولايات المتحدة، وألمانيا واليابان، فلم تقم بريطانيا بهذا التحول العميق الذي جدّد، في نهاية القرن التاسع عشر، الرأسماليّة والطبقات العاملة؛ وعليه، تعلم تاتشر بأنّه ليس هناك مشروعٌ سياسيّ جَدّيّ اليوم في بريطانيا والذي لا يتعلّق أيضاً بهيكلة السياسة وبصورة ما يمكن أن تكونه الحداثةُ بالنسبة إلى شعبنا، وإنّ التاتشريّة، مرتكزة إلى الماضي وناظرة إلى الوراء بدلاً من النّظر إلى الأمام نحو عهدٍ جديد، قد دشّنت مشروع الحداثة الرجعيّة.
في هذا الصّدد، ليس هناك ما هو أكثر حسماً من إدراك غرامشي بأنّ كلّ أزمة هي لحظةٌ لإعادة البناء والهيكلة؛ وبأنّه ليس هناك تدمير لا يعيدُ أيضاً البناء؛ وبأنّه ما من شيءٍ يُفكَّك، تاريخيّاً، دون محاولةٍ لإحلال شيءٍ جديد محلّه؛ وبأنّ كلّ شكلٍ من أشكال السّلطة لا يقصي فحسب؛ بل ينتجُ شيئاً ما. والحال أنّ هذا تصوّر جديدٌ تماماً للأزمة والسّلطة؛ إذ عندما يتحدّث اليسار عن الأزمة، فإنّ كلّ ما نراه هو الرأسماليّة مفككة ومفتتة، ونحن نمشي ونستولي عليها. إنّنا لا نفهم أنّ عرقلة العمل الطبيعيّ للنظام الثقافيّ والاجتماعيّ والاقتصاديّ القديم إنّما يتيح الفرصةَ لإعادة تنظيم هذا النظام بطرقٍ جديدة، لإعادة هيكلته وتشغيله، لإعادة تحديثه ولقلبه رأساً على عقب. وبالطبع، يحدث ذلك حتى ولو لزم الأمر على حساب السماح لعدد جَمّ من الناس -في الشمال الشرقيّ، في الشمال الغربيّ، في ويلز واسكتلندا، في جماعات التعدين وفي المدن الصناعيّة المدمّرة، في المدن الداخليّة وغيرها- بأن يتمّ إرسالهم إلى مزبلة التاريخ؛ فهذا هو “قانون” التحديث الرأسماليّ: التطوّر غير المتكافئ، واللاتنظيم المنظّم.
وجهًا لوجهٍ مع هذا التشكّل السياسيّ الجديد الخطير؛ فإنّ الإغراء ليتمثّل دائماً، أيديولوجيّاً، في تفكيكه وإجباره على الوقوف في مكانه، وطرح السؤال الماركسيّ الكلاسيكيّ عليه: مَن الذي يمثّله حقّاً؟ والآن، عادةً عندما يسألُ اليسار هذا السؤال الماركسيّ الكلاسيكيّ القديم بطريقةٍ قديمة، فإنّنا لا نسألُ سؤالا في واقع الأمر؛ وإنّما نلقي بياناً. فنحن نعرفُ الإجابة بالفعل. بالطبع، يمثّل اليمين عن طريق رأس المال إشغال الدّولة التي ليست سوى أداة له. والكتّاب البرجوازيّون ينتجون رواياتٍ برجوازيّة. والحزب المحافظ هو الطبقة الحاكمة، إلخ.. هذه هي الماركسيّة كنظريّة بلا مشاحة؛ فالسؤال لا يقدّم أيّة معرفة جديدة، ووحدها الإجابة نحن نعرفها أصلاً؛ إنّها ضربٌ من ضروب اللعب، والنظريّة السياسيّة كمطاردة مبتذلة. في الواقع، إنّ السبب الذي نحتاج أن نطرح هذا السؤال من أجله هو أنّنا في الحقيقة لا نعرفُ.
إنّه لمن المحيّر حقّاً القول، بأيّ معنى بسيط، مَن يمثّل التاتشريّة. فههنا ظاهرة محيّرة لأيديولوجيا برجوازيّة صغيرة “تمثّل” وتساعد على إعادة بناء كلّ من رأس المال المحلّيّ والعالميّ. ومع ذلك، فإنّها تفوز في سياق “تمثيل” رأسمال الشركات بموافقة قطاعات كبيرة جداً من الطبقات المُهيمَن عليها والخاضعة. فما هي طبيعة هذه الأيديولوجيا التي يمكنها إدراج مثل هذه المجموعة الواسعة من المواقف والمصالح بداخلها، والتي يبدو أنّها تمثّل جزءاً ضئيلاً من الجميع؛ بمن فيهم معظم قرّاء هذه المقالة!
وبصورة لا تخطئ؛ فإنّ لكلّ جزء صغير منّا جميعاً مكان داخل المشروع التاتشري، فنحن ملتزمون كلّنا مئة بالمئة بطبيعة الحال؛ لكن بين حينٍ وآخر -صباحات يوم السبت، أو قبل مظاهرة مباشرة- نذهب إلى سنسبري ونحن مجرّد جزء ضئيل من المواطنين التاتشريين. كيف لنا أن نفهم أيديولوجيا ليست متماسكة، أيديولوجيا تتحدث الآن في أذنٍ بصوت رجل السوق الحرّ والمنفعيّ، وفي الأذن الأخرى بصوت الرجل المحترم، والبرجوازيّ، والأبويّ؟ كيف تتألّف هاتان المجموعتان معاً؟
إنّ الطبيعة المتناقضة للتاتشريّة لتربكنا جميعاً. إنّنا نفكّر، بطريقتنا الفكريّة، بأنّ العالَم سينهار كنتيجة للتناقض المنطقيّ: وهذا هو وهم المثقف؛ أي إنّ الأيديولوجيا يجب أن تكون متماسكة، وكلّ جزء منها يتناسب مع بعضه بعضاً، كما لو أنّه تحقيق فلسفيّ. في الواقع، يكون الغرض بأكمله لما أسماه غرامشي بالأيدلوجيا العضويّة (أي، الفاعلة تاريخيّاً) عندما تتمفصل في ترتيب ذواتٍ مختلفة، وهويات مختلفة، ومشاريع مختلفة، وتطلعات مختلفة. إنّها أيديولوجيا لا تعكس، إنّما تبني “وحدةً” خارج الاختلاف.
لقد وقعنا في قبضة المشروع التاتشري، ليس منذ عام 1983 أو 1987 كما كان المذهب الرّسميّ للمشروع، وإنّما منذ 1975. إنّ عام 1975 هو الفترة الحرجة في السياسة البريطانيّة؛ إذ ارتفع النفطُ، أول شيء، وثانياً حلّت بداية الأزمة الرأسماليّة، وثالثاً، حصل تحوّل المحافظيّة الحديثة عن طريق تولي تاتشر القيادة. وهذه هي لحظة الانقلاب عندما تضافرت العوامل المحليّة والعالميّة معاً، كما حاججَ غرامشي، ولم تبدأ هذه اللحظة بالانتصار الانتخابيّ لتاتشر؛ لأنّ السياسة ليست مسألة انتخابات وحدها فحسب؛ حيث تقع هذه اللحظة في عام 1975، تماماً في منتصف الضفيرة الشمسيّة السياسيّة للسيّد كالاهان.
إنّها تقسم السيد كالاهان إلى اثنين -وهو أصلاً خيزرانة مكسورة-؛ نصفٌ لا يزال أبويّاً ومحافظاً اجتماعيّاً، والنصف الآخر يرقصُ على نغمةٍ جديدة، وأحد أصوات الإنذار، وحداء الأغنية الجديدة في أذنه، هو صهره، بيتر جاي، وهو أحد مؤسّسي المدرسة النقديّة، في دوره التبشيريّ كمحرّر اقتصاديّ في صحيفة التايمز. لقد رأى أول الأمر قوى السّوق الجديدة، والمستهلك السياديّ الجديد، آتينَ إلى تلّ مثل المارينز. والرّجل القديم، مستمعاً إلى إنذارات المستقبل هذه، يفتحُ فمَه: ماذا يقول؟ لا بدّ أن تتوقف القُبل، واللعبة انتهت، والديمقراطيّة الاجتماعيّة أفلت، ومضت دولة الرفاه إلى حيث ألقت رحلَها أمّ قشعمِ. لا يمكننا أن نتحمّل ذلك؛ لقد بِعنا أنفسنا أكثر مما ينبغي، معطين أنفسنا كثيراً من الوظائف الزائفة، ولدينا الكثير من الزمن المتأرجح.
يمكنك فقط أن ترى النّفس الإنجليزيّة وهي تنهار تحت وطأة الملذّات غير المشروعة التي كانت تتمتع بها؛ التساهل، الاستهلاك، الأشياء الجيّدة. كلّها زائفة، مبهرجة، وخادعة. لقد عصفَ العرب بها جميعها، وأصبح لدينا الآن تقدماً بطريقة مختلفة؛ حيث تتحدث السيدة تاتشر عن “مساقها الجديد”. وتتحدث عن شيءٍ ما آخر، عميق في النّفس الإنجليزيّة: مازوخيّته. إنّها العوز الذي يبدو معه على الإنجليزيّ أن يتمّ تمييزه من قبل المربيّة التي ترسله إلى السرير دونما حلوى، وإنّها الحساب الذي عن طريقه يتوجبّ على كلّ صيف جيد أن يُدفع لقاء عشرين شتاء سيّئا. تلك هي روح دونكريك؛ أي كلّما كنا أشدّ فقراً، كلّما تصرّفنا أفضل.
لم تعدنا تاتشر بمجتمع الحريّة. قالت إنّها أزمنة حديديّة؛ لنعد إلى الجدار؛ اخفوا مشاعركم؛ تحرّكوا؛ وامضوا إلى عملكم؛ ونقّبوا. التمسّك بالقديم، واختبار الحقائق، وحكمة بريطانيا القديمة. لقد حافظت الأسرة على تماسك المجتمع وعاشَ بها. إرجاع النساء إلى المنزل، وإرسال الرجال إلى الحدود الشماليّة الغربيّة، وفي وقت لاحق، تبعت تلك الأيام الصعبة عودة للأيام الخوالي الجيّدة. إنّها تطالبك بالمزيد من الحريّة، لا تطلب بنداً واحداً بل اثنين وثلاثة.
وتقول، في النهاية، سأكون قادرة على إعادة تعريف الأمّة بطريقة تكونون بها جميعاً، مرة أخرى، وللمرّة الأولى، منذ أن بدأت الإمبراطوريّة بالانحدار، مدركين لما يعنيه أن تكونوا جزءاً من بريطانيا العظمى اللامحدودة. سنكون قادرين، مرّة أخرى، على إرسال أبنائنا “إلى هناك”، ولرفع العلم، والترحيب بالأسطول، ستكون بريطانيا عظيمة مرة ثانية، وبرأيي، لا يصوّت الناس للتاتشريّة لأنّهم يعتقدون أن الصغير يطبع؛ فالنّاس في صحيح عقولهم لا يعتقدون بأنّ بريطانيا الآن ذات اقتصاد مزدهر وناجح؛ إلّا أنّ التاتشريّة كأيديولوجيا تتعامل مع مخاوف الناس وقلقهم وهوياتهم الضائعة؛ فهي تدعو الناس إلى التفكير بشأن السياسة في الصور. إنّها موجَّهة إلى استيهاماتنا الجماعيّة، وإلى بريطانيا باعتبارها جماعة متخيلة، وإلى المخيال الاجتماعيّ. والحال أنّ السيدة تاتشر هيمنت تماماً على هذه اللغة، بينما اليسارُ يسعى بشكلٍ يائس إلى جرّ النقاش حول “سياستنا”.
هذا هو المشروع التاريخيّ الخطير، والتحديث الرّجعيّ لبريطانيا، وقد كسب الناس العاديين لذلك، لا لأنهم سُذّج أو أغبياء، أو لأنّ الوعي الزائف أعماهم؛ ففي الواقع، بما أن الخصيصة السياسيّة لأفكارنا لا يمكن ضمانها من قبل موقفنا الطبقيّ أو من قبل “نمط الإنتاج”، فإنّه من الممكن لليمين أن يبني سياسة تتحدث عن تجربة الناس، وتدرج نفسها فيما أسماه غرامشي بالطبيعة المتناقضة المتشظية حتماً للحسّ المشترك، وتتقاطع مع بعض من تطلعات الناس العادية. ويمكن لهذه السياسة، في ظروف بعينها، أن تستعيدهم كذوات تابعة، في مشروع تاريخيّ يهيمن على ما اعتدنا -خطأً- أن نفكّر فيه باعتباره مصالحهم الطبقيّة اللازمة. إنّ غرامشي أحد الماركسيين المحدثين الأوائل الذين أدركوا أنّ المصالح ليست معطاة سلفاً؛ ولكن يجب أن تُبنى سياسيّاً وأيديولوجيّاً.
يحذرنا غرامشي في الدفاتر بأنّ الأزمة ليست حدثاً فورياً وإنما سيرورة: فيمكن لها أن تستمر لفترة طويلة من الزمن، ويمكن أن تُحلّ بأشكال مختلفة جداً: بالترميم، بإعادة البناء، بالتحول السلبيّ. وأحياناً تكون أكثر استقراراً، وأحياناً أكثر زعزعة؛ لكن المؤسسات البريطانيّة، بمعنى عميق، والاقتصاد البريطانيّ والمجتمع والثقافة البريطانيتين كانوا في أزمة اجتماعيّة عميقة لمعظم القرن العشرين.
وينبهنا غرامشي بأنّ الأزمات العضويّة لهذا النظام إنّما تندلعُ ليس في المجال السياسيّ أو النطاقات التقليديّة للحياة الصناعيّة والاقتصاديّة فحسب، وليس في الصراع الطبقيّ، بالمعنى القديم؛ بل في سلسلة عريضة من الجدالات والنقاشات حول الأسئلة الجنسيّة الأساسيّة والأخلاقيّة والفكريّة، وفي أزمة تتعلق بعلاقات التمثيل السياسيّ والأحزاب؛ بشأن مجموعة كاملة من الإشكالات التي لا تبدو مُمَفْصلَةً، بالضرورة، وفي المقام الأول، بالسياسة، بالمعنى الضيق، على الإطلاق، وهذا هو ما يسمّيه غرامشي بأزمة السّلطة، التي هي لا شيء سوى أزمة الهيمنة أو الأزمة العامّة للدولة.
ونحن بالضبط في هذه اللحظة، لقد شكلنا “أزمة السلطة” هذه في الحياة والثقافة الاجتماعيّة الإنجليزيّة منذ منتصف الستينيّات؛ ففي منتصف الستينيات، أشير إلى أزمة المجتمع الإنجليزيّ في عدد من النقاشات والصراعات الدائرة حول نقاط جديدة من العداء، والتي بدت أول الأمر أنها حذفَت من الساحة التقليديّة للسياسة البريطانيّة. وكثيراً ما انتظر اليسار بصبرٍ أن تُستعاد الإيقاعات القديمة للصراع الطبقيّ، في حين كان الأمر في الواقع أن شكل “الصراع الطبقيّ” نفسه يجري تحويله على أرض الواقع. نحن لا نفهم سوى هذا التنويع من الصراعات الاجتماعيّة في ضواء إصرار غرامشي على أنّ الهيمنة، في المجتمعات الحديثة، يجب أن تبنى وتُشيَّد، وأن ينازَع عليها وتُكسب على أصعدة مختلفة، بما أنّ بنى الدولة الحديثة والتعقد الاجتماعيّ ونقاط العداء الاجتماعيّ تتزايد وتتكاثر.
لذا، فإنّ أحد الأشياء الأكثر أهميّة التي قدمها غرامشي لنا هو أنّه يعطينا تصوراً موسعاً بعمق لما هي عليه السياسةُ نفسها، وبالتالي أيضاً لما هي عليه القوّة والسّلطة. ولا يمكننا، بعد غرامشي، أن نرجع إلى فكرة السياسة الانتخابيّة الخاطئة، أو السياسة الحزبيّة بالمعنى الضيّق، أو حتى حيازة سلطة الدولة، باعتبارها تشكّل أرضيّة الدولة الحديثة نفسها؛ حيث يفهم غرامشي أنّ السياسة هي حقل أكثر اتساعاً، وأنّ الأصعدة، لا سيّما في مجتمعات كمجتمعاتنا، التي تُؤسس السلطة عليها ستكون متنوّعة إلى حدّ كبير.
إنّنا نعيشُ من خلال تكاثر مواقع السلطة والعداء في المجتمع الحديث، والانتقال إلى هذه المرحلة الجديدة حاسمة بالنسبة إلى غرامشي؛ فهي تضع مباشرة على كاهل الأجندة السياسيّة أسئلة القيادة الأخلاقيّة والفكريّة، والدور التربويّ والتكوينيّ للدولة، و”خنادق وحصون” المجتمع المدنيّ، والإشكال الحاسم المتعلّق بقبول الجماهير وخلق نوع جديد أو مستوى من التحضر، وخلق ثقافة جديدة. إنّها لترسم الخط الفاصل بين صيغة “الثورة المستمرّة” وصيغة “الهيمنة المدنيّة” فهي الحافّة بين حرب الحركة وحرب الموقف: وهي النقطة التي يلتقي فيها عالم غرامشي بنا.
لا يعني هذا، كما يقرأ البعضُ غرامشي، أنّ الدّولة بالتالي ليست ذات أهميّة بما يكفي؛ فمن الواضح أنّ الدولة مركزيّة قطعاً في مفصلة نطاقات التنافس المختلفة، وفي نقاط العداء المختلفة، إلى نظام حكم؛ إذ إنّ اللحظة التي يمكنك فيها الحصول على قوّة كافية في الدّولة لتنظيم مشروعٍ سياسيّ مركزيّ لحظة حاسمة، لذلك يمكنك أن تستخدم الدولة للتخطيط والإثارة وللحث وللإغواء وللمعاقبة، للتكيّف مع مواقع السّلطة المختلفة والقبول بنظامٍ أحاديّ؛ وهذه هي لحظة “الشعبويّة السّلطويّة”؛ فالتاتشريّة “في الأعلى” (أي في الدّولة) و”في الأسفل” (مع الشّعب هناك) في آن واحد.
حتى ذاك، لم تخطئ السيّدة تاتشر التفكير بأنّ الدّولة الرأسماليّة لها خصيصة سياسيّة أحاديّة وموحدة؛ وهي على وعيٍ تماماً بأنّه على الرّغم من أن الدّولة الرأسماليّة تُمفصَل لتأمين الشروط طويلة الأمد والتاريخيّة للتراكم الرأسماليّ والرّبحيّة، ورغم أنّها حارسةٌ لضرب بعينه من ضروب التحضّر والثقافة البرجوازيّة والأبويّة؛ فإنّها ميدانٌ للتنافس، ولا تزال كذلك؛ فهل هذا يعني أنّ التاتشريّة، بعد كلّ شيء، هي مجرّد “تعبير” عن الطبقة الحاكمة؟ بالطّبع يعطينا غرامشي دائماً موقعاً مركزيّاً لأسئلة الطبقة، والتحالف الطبقيّ، والصّراع الطبقيّ؛ فحيثما يبرح غرامشي عن النّسخ التقليديّة من الماركسيّة فهو أنّه لا يفكّر بأنّ السياسة نطاقٌ يعكسُ ببساطةٍ الهويات السياسيّة الجماعيّة الموحّدة بالفعل، أو يعكس أشكال الصراع المؤسّسة أصلاً؛ فالسياسة، بالنسبة إلى غرامشي، ليست مجالاً مستقلاً.
إنّ السياسة تكون حيث يجب على القوى والعلاقات، في الاقتصاد والمجتمع، أن تعمل بفاعليّة على إنتاج أشكال محدّدة من القوّة، وأشكال من الهيمنة. ذلك هو إنتاج السياسة؛ أي السياسة بوصفها إنتاجاً. وهذا التصوّر للسياسة مشروطٌ بالأساس، ومُطلق من حيث الجوهر. ولا يوجد قانونٌ للتاريخ بإمكانه أن يتنبّأ بما يجب أن يكون حتماً نتيجة لصراع سياسيّ؛ إذ تقوم السياسة على علاقات القوى في أيّ لحظةٍ معيّنة، والتاريخ لا ينتظر في الأجنحة ليلاحقَ أخطاءَك في نجاحٍ آخر محتوم؛ فأنت تخسرُ لأنّك تخسرُ.
إنّ “الحِسّ السليم” للناس موجود؛ لكنّه مجرّد بداية السياسة، لا النهاية؛ فهو لا يضمن أيّ شيء. وبالفعل، قال غرامشي إنّ “التصوّرات الجديدة لها مكانةٌ متزعزة للغاية في أوساط الجماهير الشعبيّة”. وليس هناك موضوع وحدويّ للتاريخ؛ فالموضوع مقسّم بالضرورة، وطاقم: نصفٌ هو العصر الحجريّ، والآخر ينطوي على “مبادئ العلوم المتقدّمة، والتحيّزات من كلّ المراحل السابقة من التاريخ، ومؤسّسات لفلسفة المستقبل، وكلٌّ من هذين الشيئين يتصارعان داخل رؤوس الشعوب وقلوبها لإيجاد سبيلٍ لمفصلة أنفسهم سياسيّاً، ومن الممكن، بطبيعة الحال، أن يجنّدوا أنفسهم لمشاريع سياسيّة مختلفة للغاية”.
إنّنا نحيا، لا سيّما في يومنا هذا، في حقبةٍ تنهارُ فيها الهويّات السياسيّة، ولا يمكننا أن نتخيّل الاشتراكيّة طارئة بعد من خلال صورة هذه الذات الأحاديّة والفريدة التي اعتدنا أن نسميها بالإنسان الاشتراكيّ؛ فالإنسان الاشتراكي الذي لديه عقل واحد، ومجموعة واحدة من المصالح، قد مات؛ فهل مَن يحتاج”ه” الآن، باستثماره في حقبة تاريخيّة بعينها، وبحسّـ”ه” الخاص بالذكوريّة، إنما يعزز “هويّته” في مجموعة معينة من العلاقات الأسريّة، وفي نوع معين من الهويّة الجنسيّة؟ وهل مَن يحتاجه باعتباره الهويّة الأحاديّة التي من خلالها يجب على التنوع العظيم للنوع البشريّ وللثقافات الإثنيّة في عالمنا أن تدخل القرن الحادي والعشرين؟ إنّه ميت: ومضى بلا رجعة.
لقد نظر غرامشي إلى عالم كان معقداً أمام أمّ رأسه؛ فنظرَ غرامشي إلى تعدديّة الهويّات الثقافيّة الحديثة، الناشئة بين خطوط التطور التاريخيّ غير المتكافئ، وطرح هذا السؤال: ما هي الأشكال السياسيّة التي من خلالها يمكن أن يُبنى نظام ثقافيّ جديد، انطلاقاً من “تعدديّة الإرادات المتفرقة هذه، وهذه الأهداف والمرامي غير المتجانسة” ونظراً إلى أنّ هذا هو ما عليه الناس حقاً، وباعتبار أنّه ليس هناك قانون من شأنه أن يجعل الاشتراكيٌة أمراً واقعاً؛ فإننا نجد أشكالاً من التنظيم ومن الهويّة ومن التحالف ومن التصورات الاجتماعيّة التي يمكنها أن تتصل بالحياة الشعبيّة، و، في الآن نفسه، بتحويلها وتجديدها؟ فلن تصل الاشتراكيّة إلينا عبر باب التاريخ من قبل بعض الخارقين.
لقد أصر غرامشي دائماً على أنّ الهيمنة هي ظاهرة أيديولوجيّة، ولا يمكن أن تكون هناك هيمنة دون النواة الحاسمة لما هو اقتصاديّ، ومن ناحية أخرى، لا تسقط في فخ الاقتصادويّة الميكانيكيّة القديمة وتعتقد بأنّه إذا أمسكت بزمام الاقتصاد فإنّك يمكنك أن تنقل بقيّة العالم، فطبيعة السلطة في العالم الحديث هي أنّها تُبنى أيضاً فيما يتعلق بالمسائل السياسيّة والأخلاقيّة والفكريّة والثقافيّة والأيديولوجيّة والجنسيّة؛ إذ إنّ سؤال الهيمنة دائماً هو سؤال النظام الثقافيّ الجديد، والسؤال الذي واجه غرامشي فينا يتعلّق بإيطاليا ليواجهنا نحن اليوم فيما يخصّ بريطانيا: ما هي طبيعة هذا التحضر الجديد؟ ليست الهيمنة بحالة نعمة مثبتة إلى الأبد. وهي ليست تشكلاً يضمّ الجميع، وفكرة “الكتلة التاريخيّة” مختلفة بالأساس عن فكرة الطبقة الحاكمة المتجانسة والموحدة.
تنطوي الهيمنةُ على تصور مختلف تماماً لكيفيّة إمكان مفصلة القوى والحركات الاجتماعيّة، في تنوعها، في مجموعة من التحالفات الاستراتيجيّة؛ فأن تبني نظاماً ثقافيّاً جديداً يعني أنّك بحاجة ليس لانعكاس إرادة جماعيّة مشكلة من قبل أصلاً؛ بل لتدشين إرادة جديدة، ولافتتاح مشروع تاريخيّ جديد.
لقد تحدثتُ عن غرامشي في ضوء التاتشريّة، وفي أعقابها؛ حيث استخدمُ غرامشي لفهم طبيعة وعمق التحدّي الذي تمثّله التاتشريّة واليمينُ الجديد على اليسار في الحياة والسياسة الإنجليزيتيْن؛ لكنّني في اللحظة ذاتها تحدثتُ عن اليسار لا محالة، أو بالأحرى لم أكن أتحدّث عن اليسار؛ لأن اليسارَ في شكله المنظّم والعُمّاليّ، لا يبدو أنّه يمتلك أدنى تصوّر لما يجمع مستلزمات مشروع تاريخيّ جديد.
إنّه لا يفهم الطبيعة المتناقضة حتماً للذوات البشريّة، وللهويات الاجتماعيّة، كما أنّه لا يفهم السياسة باعتبارها إنتاجاً، ولا يرى أنّه من الممكن الالتحام مع المشاعر والتجارب العاديّة التي لدى الناس في حيواتهم اليوميّة، ولا يمفصلها تدريجيّاً إلى شكل أكثر تقدماً وحديثا من الوعي الاجتماعيّ. كما لا يبحث -عن- ولا يعمل على التعدديّة الهائلة للقوى الاجتماعيّة في مجتمعنا، ولا يرى أنّه من الممكن في طبيعة التحضّر الرأسماليّ الحديث بحدّ ذاته تكاثر مراكز القوّة، وبالتالي رسم نطاقات الحياة في العداء الاجتماعيّ أكثر فأكثر، ولا يدرك أنّ الهويات التي يحملها الناسُ في رؤوسهم -وذاتياتهم، وحياتهم الثقافيّة، وحياتهم الجنسيّة، وهوياتهم الجنسيّة، وصحّتهم- أصبحت مسيّسة على نطاق واسع.
إنّني لا أعتقد ببساطة، على سبيل المثال، بأنّ القيادة العمّاليّة الحالية تفهم أن مصيرها السياسيّ يتوقف على ما إذا كان بإمكانه أن يبني سياسة أم لا، في السنوات العشرين المقبلة، والتي تكون قادرة على معالجة نفسها، ليس وحدها، ولكن مع تعدّديّة نقاط العداء المختلفة في المجتمع؛ أي توحيدهم، باختلافاتهم، في مشروع مشترك. ولا أعتقد بأنّهم قد أدركوا أنّ قدرة العمّال على النموّ كقوة سياسيّة إنّما تعتمد تمام الاعتماد على قدرتهم على الاستفادة من القوى الشعبيّة للحركات المختلفة بحدّ ذاتها؛ أي الحركات خارج الحزب التي لا تعمل -ولا يمكنها ذلك-، والتي لا تستطيع إذن أن تدير وتحكم؛ فهي تحتفظُ بتصوّر بيروقراطيّ تماماً عن السياسة.
فإذا لم تخرج الكلمة من أفواه القيادة العمّاليّة، فيجب أن يكون هناك شيءٌ ما تدميريّ حيال ذلك. وإذا كانت السياسة تحفّز الناسَ على تطوير مطالب جديدة، فذلكم علامةٌ يقينيّة بأنّ أبناء البلد في قلق لا يهدؤون. يجب عليك أن تفصل عدداً قليلاً أو تعزلهم، وعليك العودة إلى الخيال، إلى “الناخب العمّاليّ التقليديّ؛ لهذه الفكرة المسالمة والمتأنّية للسياسة؛ حيث الجماهير تختطفُ الخبراء إلى السلطة، وبالتالي يقوم الخبراء بشيء ما للجماهير: لاحقاً… لاحقاً بكثير. إنّه التصوّر الهيدْرُولِيكِيّ للسياسة.
هذا التصوّر البيروقراطيّ للسياسة لا علاقة له بتعبئة مجموعة القوى الشعبيّة. وليس لديه أيّ تصوّر لكيف يصبح الناس مُمكّنين من خلال القيام بشيءٍ ما؛ أولاً وقبل كلّ شيء عن مشاكلهم العاجلة، ثمّ توسّع السلطة قدراتهم السياسيّة وطموحاتهم؛ كي يبدؤوا في التفكير مرة أخرى فيما قد يماثل ما يعنيه أن تحكم العالم.. فسياستهم كفّت عن أن تكون ذات صلةٍ بهذه الحلول الأكثر حداثةً؛ أي تعميق الحياة الديمقراطيّة.
والحال أنّه من غير تعميق المشاركة الشعبيّة في الحياة الوطنيّة-الثقافيّة، فلن يكون للناس العاديين أيّ خبرة في إدارة أيّ شيء فعليّاً. نحن بحاجة إلى إعادة اكتساب الفكرة القائلة إنّ السياسة تتعلق بتوسيع القدرات الشعبيّة، وقدرات الناس العاديين، ومن أجل فعل ذلك، فيجب على الاشتراكيّة نفسها أن تتحدث عن الناس الذين تريد هي تفويضهم، وذلك بكلماتٍ تنتمي إليهم باعتبارهم الأناس العاديين لأواخر القرن العشرين.
لقد لاحظتم جميعاً أنّني لا أتحدث عمّا إذا كان الحزب العمّاليّ قد اكتسب سياساته فيما يخصّ هذا الموضوع أو هذا الإشكال. إنّني أتحدثُ عن تصوّر بأكمله للسياسة: القدرة على إدراك الخيارات التاريخيّة الكبرى في مخيالنا السياسيّ أمام الشعب البريطانيّ، اليوم. وأتحدث عن تصورات جديدة للأمّة نفسها: ما إذا كنتم تعتقدون أنّ البريطانيين يمكن أن يقدّموا إلى القرن المقبل بتصوّر لما يعني أن تكون “إنجليزيّاً” الأمر الذي تمّ تشكيله تماماً انطلاقاً من المسيرة الإمبرياليّة الكارثيّة الطويلة لبريطانيا في كافّة أنحاء المعمورة. إذا كنتم تعتقدون ذلك، فلن تدركوا التحول الثقافيّ العميق اللازم لإعادة تشكيل الإنجليز، وهذا النوع من التحوّل الثقافيّ هو ما تدور حوله الاشتراكيّة في أيامنا هذه.
والآن، برأيي، إنّ لدى الحزب السياسيّ لليسار، مهما تمركز حول الحكومة، حول الفوز في الانتخابات، هذا النوع من القرارات المعروض عليه بالضبط، والسبب في أنّني متشائمٌ بشأن “الحزب الجماهيريّ للطبقة العاملة” الذي لا يفهم طبيعة الخيار التاريخيّ الذي يواجهه هو أنّني متشكّك في أنّ العمّال لا يزالون يعتقدون سرّاً بأنّ هناك عدد ضئيل جداً من اليسار في اللعبة القديمة والاقتصاديّة-الشركاتيّة والتزايديّة والكينزيّة؛ فالحزب يعتقد بأنّه قد يعود إلى جزء ضئيل من الكينزيّة ههنا وإلى جزء أكبر قليلاً من دولة الرّفاه هناك، وإلى جزء ضئيل من الجمعيّة الفابيّة القديمة.. وبالفعل، رغم أنّني ليست لديّ رؤية كارثيّة للمستقبل، فإنّني أعتقد بصدقٍ أنّ هذا الخير مسدود الآن. لقد استنفذ؛ ولا يعتقدُ أحدٌ به بعد الآن. فقد اختفت شروطه الماديّة، والشعب البريطانيّ العادي لن يصوّت له لأنّهم يعلمون في أذهانهم أنّ الحياة ليست هكذا. وما تطرحه التاتشريّة، بطريقتها الراديكاليّة، ليس ما يمكننا أن نعود إليه وإنّما ما الطريق الذي نمضي عليه قدماً؟ ليس أمامنا سوى الخيار التاريخيّ: الاستسلام للتاتشريّة، أو إيجاد سبيل آخر للتخيّل.
لا تقلقوا بشأن السيّدة تاتشر نفسها؛ فهي ستتراجع إلى مدينة دويتش؛ لكن هناك غيرها الكثير من التاتشريين من جيل ثالث ورابع وخامس، جافّين كما الغبار، يقرعون للإنسان، في انتظار أن يحلوا محله. فهم يعتقدون أننا ديناصورات، ويعتقدون أنّنا ننتمي إلى حقبةٍ أخرى. وبينما تنحدرُ الاشتراكيّة تدريجيّاً، يبدأ عصرٌ جديد وهذه الأنواع من الرجال التملّكيين سيكونون مسئولين عن هذا العصر. إنّهم يحلمون بسلطة ثقافيّة فعليّة، والعمّال، بهدوء، لا يهزّون القارب، آملين أن تفتح الانتخابات الطريق، أمامهم بالفعل هذا الخيار فقط بين أن يصبحوا غير ذي صلة تاريخيّاً أو أن يرسموا طريقاً جديداً تماماً من التحضّر.
إنني لا أقول الاشتراكيّة، خشية أن تكون الكلمة مألوفة لكم فتظنون أني أعني مجرّد وضع البرامج القديمة نفسها التي نعرفها جميعاً مرّة أخرى على القضبان. إنني أتحدث عن تجديد المشروع الاشتراكيّ برمته في سياق الحياة الاجتماعيّة والثقافيّة الحديثة، وأعني نقل علاقات القوى؛ لا لكي تحل اليوتوبيا بعد يوم واحد من الانتخابات؛ لكن لكي تبدأ النزعات بالعمل بطريقة أخرى.
مَن يحتاج إلى فردوس اشتراكيّ حيث يقبل الكلّ بالكلّ، وحيث الجميع هم الشيء نفسه بالضبط؟ معاذ الله! إنني أعني مكاناً نستطيع فيه أن نبدأ في الشجار التاريخيّ ما يجب أن يكون عليه نوع التحضّر الجديد. هل من الممكن أن تكون القدرات المادية الجديدة والثقافيّة والتكنولوجيّة الضخمة التي تفوق بكثير أحلام ماركس العاصفة، والتي هي الآن بالفعل في أيدينا، ماضية إلى أن يتمّ تجنيسها سياسيّاً للتحديث الرجعيّ للتاتشريّة؟ أو هل بمقدورنا أن نتمسّك بوسائل صناعة التاريخ تلك، ووسائل صناعة الذوات البشريّة الجديدة، وأن نسوقها في اتجاه ثقافة جديدة؟ هذا هو الخيارُ أمام اليسار.
أمّا بعد، فقد كتب غرامشي بأنّه “يجب على المرء أن يشدد على الأهميّة التي لدى الأحزاب السياسيّة، في العالم الحديث، في إعداد ونشر تصورات للعالم؛ لأنّ ما تقوم به أساساً هو إنجاز إيتيقا وسياسة مناظرة لتلك التصورات والعمل كما لو كانت هي “مختبرهم التاريخيّ”.
____________________________
المقال مترجم عن: الرابط التالي
http://www.versobooks.com/blogs/2448-stuart-hall-gramsci-and-us
ميدان