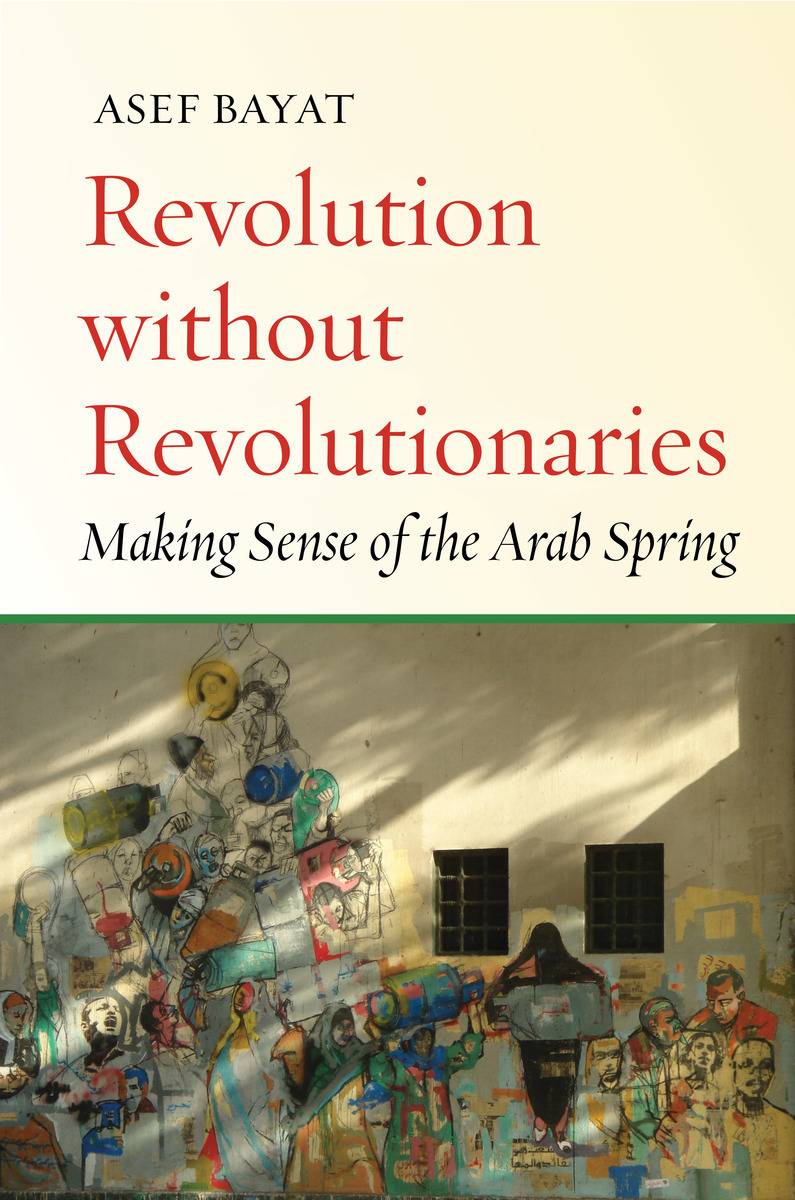هاني درويش في موجة الكتابة العارمة/ حسن داوود

فادي العبد الله، وهو واحد من ثلاثة أصدقاء قدّموا لكتاب هاني درويش، ووصف الأخير بكونه جبرتي القاهرة المعاصرة. كان هاني كذلك في ما خصّنا، نحن اللبنانيين. بل إنه سعى إلى أن أن يكتب، بعلمه ذاك، فصلاً عن بيروت، بادئاً بوصف طريق المطار، أي من المشاهدات الأولى لنزوله فيها. تلك الصورة للفتاة المستلقية بثياب البحر، مالئة إحدى اللوحات الإعلانية العريضة، أدخلها هاني إلى ذاكرتنا وثبّتها فيها، بتفاصيلها الصغيرة، على الرغم من أننا لا نذكر أننا شاهدنا تلك اللوحة فعلاً. ونحن، في السهرات هنا، كنا نقول له “إحكِ يا هاني، قل لنا أيضا كيف وجدت بيروت”. تلك الرؤية الثانية لمدينتنا، على طريقة ما يقول المريض أنه يحتاج إلى رأي ثان من طبيب آخر، كانت تطمئننا إلى أنّ هناك أشياء مفرحة ما زالت باقية فيها.
من المقالات التي كانت تنشر له، هنا في بيروت، كنا نتعرّف على النسخة الأخيرة من تحوّلات القاهرة، تلك المدينة التي نحتاج، على الدوام، إلى تجديد معرفتنا بها. ذاك أننا نميل، أو تميل هي، إلى إبقاء صورها القديمة راسخة في أذهاننا. ونحن في الثمانينات مثلاً كنا نظنّ أنها باقية كما كانت في الستينات، بترتيبها ذاته الذي نقلته لنا أفلامها بالأبيض والأسود. يسري نصر الله، الذي كان يعمل صحافيا في بيروت آنذاك، عاد لنا منها آنذاك بما يقلب تصوّرنا عنها رأسا على عقب.
وكذا فعل هاني في ما خصّ ما يحتمل أن نسمّيه وجه القاهرة الأخير. وقف الجبرتي عند المشاهد العريضة التي حدثت في زمانه، على غرار الشهود الؤرّخين آنذاك.أما هاني فوصف لنا بالتفاصيل كلّ ما جرى حوله في تلك المدينة، كارهاً له، أو مستبشراً به، أو ناقماً عليه، أو شاعراً بذنب تحوّله عنه كما في وصفه لذلك المصيف الذي أعدّ ليكون مراحا للأغنياء والسائحين.
كان دائماً هناك في المشهد، في تلك الفوضى الكاسرة مثلاً، الوسخة، التي أحاطت بأبيه الراقد في غرفة المستشفى تلك. لا يُنسى أبداً ذلك الوصف الذي منه مثلاً قعدة المرحاض الأجنبي التي جُعلت كرسياً للجلوس، واتساخ الوسادة، وخطّ البلغم الممتد بين سريري المريضين، والكرتونة الفارغة لشركة “هايدلينا” التي وضعت ليمسح المرضى عليها أقدامهم. ولم يكن ذلك لمحض الوصف، فتلك الغرفة هي المصل الفاسد الذي يُعطى للوالد المريض، وللمرضى الستة الآخرين في الغرفة. بذلك التفصيل المتدخّل أيضاً روى لنا تلك المواجهة مع مندوب الشرطة التي أوصلته إلى كشف المكاتب العليا لأولئك الذين يمنحون التسوية،أو العفو، مدوّنا على ورقة صغيرة، بمساحة ربع ورقة .A4 ولنضف إلى ذلك التغيّرات الأكثر تفصيلية للأمكنة وبشرها المتحوّلين في واحد من مطافاتهم الأخيرة إلى كراهية جيرانهم ونبذهم. وإلى ما يصنعونه أو يتلقّونه من خليط الأصوات التي تجعل فضاء الميكروباص مشحونا بتيارات صخب متلاطمة. ثمّ تلك المتابعة لثورة مصر والتي ذهب بها إلى ما لم نقرأه في مكان، راجعا من ميدان التحرير إلى منبت هؤلاء وتواريخهم وثقافاتهم…
في زيارة لي إلى القاهرة، ودائماً كنت هناك معه، روى لي عيانا تفاصيل منطقة الجمالية، بناءً بناءً، وإسماً إسماً، وتاريخاً تاريخاً. أحسست أني حاضر، جسمانياً هذه المرة، بالبيوت الثلاثة في ثلاثية نجيب محفوظ وفي الساحات المطلّة عليها نوافذها. لا أحد يعرف مدينته هكذا مثل هاني درويش. هناك يستطيع أن يدلّك على بيوت ممثلي السينما السابقين، بيتاً بيتاً، وهو بدا محتجاً غاضباً على ما حلّ ببيت أحمد مظهر مثلاً. تلك الرحلة معه، بدت لي، نبذة مختصرة عما كتبه عن بيوته القاهرية الثلاثة التي تنقّل بينها تباعاً منذ طفولته الأولى. لم يسبق لي أن قرأت في نصّ أدبي هذا القدر من الأسماء. لم يترك شيئاً، صغيراً أو كبيراً، من دون تسميته، لا أسماء الشوارع وأسماء التقاطعات والزواريب الصغيرة والبيوت بل أسماء بشرها وعائلاتها أمهات وآباء وأطفال، طفلاً طفلاً، حتى من أضيفت إلى أسمائهم ألقاب لم يغفل عن ذكرها. ولم يكن يقصد من ذلك التعدادَ وتمرين الذاكرة، بل لظنه، ولاعتقاده أيضا، أنّ الإسم يقرّب صاحبه ويستحضره ماثلا كما كان. وإن لم ينجح ذلك كثيرا مع من سيقرأ تلك السيرة المكانية، يبقى للكاتب حصّة استمتاعه بما يكتب.
تلك السيرة التي تقع في نحو أربعين صفحة من صفحات الكتاب، رواية داخلها ميل هاني العميق إلى وصل التفاصيل الخاصة بمآلاتها الإجتماعية. كلا الكتابتين حاضرتان بقوّة في هذا النصّ الذي ظللت أتساءل، فيما أنا أقرأه، إلى أيّ من إتجاهيه كان هاني يحبّ الذهاب، ذلك يعني أن يفكّر ماذا عليه أن يُبقي وماذا عليه أن يُهمل من مواهبه المتعدّدة الكثيرة.
“إني أتقادم- مسارات شخصية في أحراش القاهرة” كتاب لهاني درويش جُمعت فيه مقالات له، وهو كتاب أوّل ستعقبه كتب أخرى بحسب ما ورد في تقديم الكتاب الصادر عن “الكتب خان للنشر والتوزيع”، 2014.
هاني درويش في سيرته بين أطلال القاهرة العمرانية والبشرية/ محمد أبي سمرا
بعد رحيله، وقبل شهرين، صدر لدى دار “الكتب خان” في القاهرة كتاب هاني درويش “إني اتقادم – مسارات شخصية في أحراش القاهرة”. قام أصدقاء الراحل بجمع نصوص الكتاب وتنسيقها. وهو الأول في سلسلة يُنتظر صدورها تباعا، متناولة في ما يشبه بيوغرافيا تأملية في أحوال القاهرة المعاصرة التي كتب فادي العبدالله أن درويش جبرتيّها المعاصر، “الجالس ساخراً على قارعة المشهد، والمؤرخ لسير حيوات وموت أمكنة وأنماط عيش وأنواع موسيقى واعلانات”، إضافة الى حقب اجتماعية وسياسية. وهذا كله في جملة كتابية واحدة شديدة التوتر والصخب البصري، كالمشي في شوارع القاهرة.
ولد هاني درويش في العام 1974 في حوش للاقامة العائلية الموسعة في حي شعبي مكتظ بمهاجري الأرياف المصرية النازلين في حي الحطابة خلف قلعة محمد علي باشا، على طرف القاهرة. وفي العام 2014 توفي وحيداً في منزل مطل على سفح الهرم، في ما يعتبر بالمقاييس المصرية الراهنة حياً “بورجوازياً حديثاً”، يدعى حدائق الاهرام ويتبع محافظة الجيزة داخل القاهرة الكبرى. في السادسة والثلاثين من عمره قام، على مدار أسبوع، برحلة استعاد فيها، بالسرد الفوتوغرافي، سيرة إقامته في حي ولادته، وفي حي المطريّة الشعبي الذي سكنت فيه أسرته النواتية في ستينات القرن العشرين، ثم في حي عزبة النخل العشوائي، الذي طُردت اليه الأسرة في تسعينات القرن نفسه. هو يسمي سرديته هذه “الدراما الأسرية” و”ألاعيب الحظ العاثر”، مستعملاً الكاميرا لتنشيط ذاكرته بلقطات – صور تمكّنه من “تنسّم القليل من حقيقة ما حدث” وبعضاً من رائحة الأزمنة التي انطوت في تلك الأماكن.
فتاة الميني جوب الخائبة
في الحطّابة – الحي الذي يعود إنشاؤه، على ما تدل تسميته، الى أيام تشييد قلعة محمد علي، وإقامته الحطابين المشاركين في بنائها بيوتهم خلف سورها الجبار – نزل والده القادم من قرية كلبشو في السادسة عشرة من عمره عام 1961، ليعمل ملاحظ عمال في شركة مصر للاسمنت المسلح، “إبنة المجد الانشائي لثورة يوليو”/ تموز 1952 الناصرية. أقام الموظف البسيط، الفتى أو الشاب، في غرفة يشترك في سكنها عازبون مثله من قريته وأقاربه. كان البناؤون الأوائل للحي يجعلون جدار القلعة حائطاً داخلياً للبيوت المتلاصقة النازلة هبوطاً على التلة “في ما يشبه أسمال معمارية، حيث ولدتْ أمي – يكتب هاني درويش – وتربت”، طالبة فاشلة رسبت خمس مرات في الشهادة الابتدائية. هي سامية محمد الصادق التي تحصّلت في مراهقتها على “دبلوم” في الخياطة والأزياء في محترفات أجنبية في وسط القاهرة، وعملت في محل للملبوسات “الحريمي” في منطقة الحلمية، قبل أن تكلّل مهارتها بالعمل في محترف “رجاء الجداوي التي بدأت صلتها بالفن كمصممة ازياء شهيرة” لتنانير الميني جوب في الستينات.
في الحطّابة أحبّ الشاب العازب – بدر درويش الدسوقي، الموظف البسيط في شركة الإسمنت – سامية “المراهقة الشابة المستقلة الحرون، الكارهة للرجال”، مزهوة في تنانير الميني جوب التي ترتديها. بعدما أضناه الحب تقدم الهزب المتيّم لخطبتها، فـ”رفضت وحرنت”، استجابة لمخيلتها المسكونة بـ”أضواء وسط القاهرة الواعد بمجد غرامي”. لكن مهنة الخياطة التي كانت الألسن تلوك سمعة عاملاتها “انسجاماً مع الخيال الشعبي”، حملت والدها على إرغامها، في العام 1972، على الزواج من “ابن أصول ريفية مضمونة”، و”مضمون مستقبله الوظيفي” في حسابات أبناء المدينة. هكذا ظلت فتاة الميني جوب الخائبة بعد زواجها، تلعن والدها على مسامع أطفالها الذين أنجبتهم من “زوج فقري”، معلنة أن جدهم “استغل مهرها في تشييد الدور الثالث من المنزل، وجهّزها (كعروس) بأثاث مستعمل، وأكل ميراثها عن أمها”. أما ابنها – الذي انسحر في فتوته وشباه الأول، مثلها، بوسط القاهرة، لكن بمثالات أخرى في زمن آخر – فيكتب: “هل كانت الشابة غير الجميلة تستحق أكثر من الشاب ذي السوالف، الخجول، اللي ما بيرفعش عينه عن الارض؟، على ما كانت تردد جدتي؟”، أمها المتوفاة سنة 1980.
في العام 2000، ها هوذا هاني درويش حاملاً كاميرته، مطارداً الصور والروائح والذكريات في مسقطه، فيصعد درجات سلم خشبي، متجاوزاً ثلاث غرف جانبية على سفح الجبل الرملي الصحراوي، وصولا الى غرفة جدته “ماما كريمة”، منجبة خالاته الخمس من دون خال ذكر. تلوح منه التفاتة دائرية، فيبصر الحمام الحجر الضيق، غرفتين إحداهما لعمّه الأخرس عبد العزيز الذي تزوج من خرساء مثله، فانجبا أطفالا ينطقون. أما في “الغرفة الأخيرة، على سريرها النحاسي، تحت لمبة الكاز نمرة 2، فولدتُ لتتحسس قدمي الصخور الكبيرة في سور القلعة”، ثم تنقلت صور الطفولة: “زوج عمتي سيد الحصري” جالس في مقهاه المواجه لمبنى الدفترخانة في شارع باب الحديد، حيث يجلس لاعبو القمار ومدخنو الحشيش في إشراف زوج العمة رجاء المتوفاة قبل عام من الرحلة الاستعادية للسيرة المكانية هذه، من الحطّابة الذي تعود بدايات نشوئه الى زمن محمد علي، فالى حي المطرية، عنوان “حداثة تمدين ثورة يوليو (الناصرية)، ثم الى عشوائيات الرئيس مبارك في عزبة النخل، (وبعدها) الى أين المفر؟ من القلب الى الأطراف، الى أطراف الأطراف. واليوم يتم تخريم المدينة من خارج أطراف الأطراف بالطريق الدائري، لتخلق المدينة مراكزها الجديدة التي كانت أطرافاً، لتنتشي بالأمل في حياة أقرب الى موت” المدينة.
فنان السكة الحديد المثلي
في المطريّة، حي الطفولة والفتوة والصبا، صاحبَ الراوي – الكاتب في رحلة الاستعادية، طقسٌ مغبّر، فلم يتعرف اليه أحد. حتى حسن، ابن جارته “أم زيزي” التي كانت أماً ثانية له، لم يتعرف اليه، حين فتح باب الشقة، وأعلمه بأن أمه ماتت قبل سبع سنين. صوّر الزائر فرن الخبيز البلدي، محل حلاقة العم أحمد الشامي، محل الكوى ناصيف، المتوفي أيضا، والذي أصر حفيده “على ذكر اسمه الكامل، كي يؤكد أن جده الذي أسلم في لحظة ضعف، عاد مسيحياً قبل وفاته”، بعدما كان “فاجأ الجميع باشهار إسلامه وهجره زوجته، واستمراره سنين يوصي القادمين من الحجاز بتزويده بالمصاحف وسجاجيد الصلاة والمسابح”. هذا قبل بحث الزائر المتقصي عن مصطفى الناغي، المعروف في “دوائر المثقفين”، كروائي وفنان تشكيلي، وهو ابن أسرة عمالية يسارية شهيرة في شرق القاهرة. فـ”تعلم الكتابة على كَبَرٍ، وكتب روايته الأولى (دم فاسد) في بداية التسعينات، من دون أن يترك عمله في السكك الحديد، بالرغم من ما ترتب على روايته الهذيانية السوداوية البديعة من مشاكل”. إنه “حساس، مهذب، مثليٌ جنسياً”، وكتب رواية ثانية عنوانها “علبة الليل المعدنية”، فلم يتحمس ناشر “لهذيانه الإبداعي عن محطات السكك الحديد والعلاقات الجنسية بين النباتات والحيوانات في أحراس مهملة”. من مشاهد روايته هذه لقاء الراوي بروائية يسارية معروفة، زارها في منزلها عارضاً عليها مخطوطة روايته. حين علمت أنه عامل سكة حديد، طلبت منه تصليح “شطافة حمامها”، فدخل الى حمام “المثقفة الكبيرة، وبدأ في تأملاته عن علاقة غائطها المتجلط بالماء وأثره على الشطّافة”.
يستقبل مصطفى الناغي زائره، صاحب الرحلة الاستعادية، بعد انقطاعهما 4 سنوات، وانقطاع مصطفى تماماً عن التسكع اليومي في وسط القاهرة، وتلقية دورة تدريبية على ترميم اللوحات الفنية، وإحالته المبكرة على التقاعد من عمله، ودخوله في “كهف الرسم”، فعرض على زائره، صديقه القديم، رسومه لمحطات القطار كما رآها طفلاً، وعمل فيها شاباً. ثم روى له حكايات عن قدامى سكان المطرية: الأرمنية سميكة هانم، صاحبة القصر المطل على السكة الحديد، والتي تعوّد فتية الحي الشعبي القريب على الإغارة على ثمار أشجار الليمون في حديقته، فقام ابنها بقتل أحد السارقين، مما حملها الى تقديم الحديقة ديّة لأهل القتيل، قبل أن يُقتل الإبن في حرب 1948. ويروي الناغي أيضاً سير “فيلات الأجانب” من إيطاليين وأرمن ويهود، وسيرة “قصر البرنس يوسف كمال، الذي تحول معهداً لبحوث الصحراء، وفيه صُوّر فيلم “رد قلبي”. الفيلات هذه اختفت وحلت مكانها مدارس إسلامية خاصة، بعدما كانت فتيات مسدلات الشعر، تخرجن قبل 20 عاماً للتجول على دراجات هوائية في الأمسيات بين الفيلات.
عزبة النمل والنفايات والسلفية
في عزبة النخل، أو النمل، أو الصين الشعبية، يستعيد مقتفي آثار بعض من مشاهد سيرته الأسرية والشخصية المكانية أو السكنية، وقائع “الصراع الطائفي المكتوم”، لكن الشديد الوضوح. فالعزبة كانت ملجأ المسيحيين، بعد ترحيلهم إليها، تحت الضغط، من أحيائهم الأثيرة في شرق القاهرة: الزيتون، حدائق القبة، شبرا، ومن سواها في قرى الصعيد الملتهب ومدنه، كأسيوط معقل الجماعات الإسلامية في الثمانينات. تجمع السيحيون في أحياء العزبة التي تخدمها 3 كنائس، في إحداها ظهرت العذراء أثناء احتدام الحوادث الطائفية. وفي نهاية الثمانينات اختفى في العزبة القيادي الإسلامي الشهير الدكتور أيمن الظواهري، لأربع سنوات فاصلة بين عودته من أفغانستان وانطلاقه مجدداً منها مع بن لادن. وفي أثناء اختفائه افتتح عيادة طبية باسم مستعار وتزوج ومارس المهنة. وحين عبر في العزبة خط مترو الانفاق في العام 1988، ظهرت “عمارات قبيحة تجلّلها آيات القرآن والصلبان”، وارتفعت أكوام النفايات، حيث امتد عالم تدويرها وتكاثرت حضائر الخنازير الشهيرة. والى هذا كله، عشّش فيها أيضا الإسلام المتطرف وخرج منها، “فالتحى أخي – يكتب هاني درويش – وتحجبت أخواتي وعاد أبي الى الصلاة، وتخمّرت (وضعت الخمار) أمي التي لا تحفظ الفاتحة”. وتحت أكوام النفايات تهالكت مدرسة “الجيل الحر، ومدارس “براعم الإيمان الاسلامية، وانتشرت عربات “التوك توك” للنقل، ومحال أجهزة الهاتف الخليوي والملابس الصينية، لأبناء “مخصلين للزمن العشوائي”.
أما وقت وفاة والده، فكانت سنوات قد مضت على انقطاع الراوي – الكاتب عن عزبة النخل. وبعد ساعات من غسله غسلة الموت التي أشرف عليها “خمسة من أعضاء الجماعة السلفية، هواة حصد ثواب الموت”، فقد انحشر جثمان أبيه في الكفن على سلم المنزل الضيق، ثم شيّع الى مدافن العائلة في القرية التي خرج منها في الستينات من القرن العشرين. وبعد دفنه هناك، أيقن ابنه البكر، أي الراوي نفسه، أنه قد أتمّ فطامه.
في المشهد الأخير من الرحلة الاستعادية هذه، وقبل مغادرته عزبة النخل، جلس هاني درويش في مقهى من مئات المقاهي التي تعج “بالسلفيين المتعطلين، وداهني حتى الهواء” بشعاراتهم. جلس محدقاً في انفجار الشوارع بالفتيات المسيحيات الحاسرات، فيما تحملق بهن العيون الجاحظة لـ”داخلي الجنة بثواب أسلمة المسيحيين. على الجانب الآخر وجوه مجهدة محجبة، مستغفرة مكفهرة”. حتى “الهواء يكاد يشتعل”، جراء حرق النفايات على نواصي الشوارع، وارتفاع أصوات الترانيم الكنسية المتصاعدة في مواجهة تلاوات القرآن في متجرين متجاورين.
مصر المريضة
للراغب في المزيد من مشاهد قاهرة هاني درويش، من تدفق مشاهدها الحية مختلطة بلهاثه سائراً في أدغالها، مستعيداً صوراً وشخصيات من أفلامها السينمائية، إيقاعات وكلمات من أغاني مطربيها، ملامح من تغير أزياء بشرها المتدفقين في شوارعها وحواريها التي لا تنام… أن يقرأ كتابه “إني أتقام” الذي رتبه ووضبه جامعو نصوصه بعد موته المفاجئ. وهو كتاب “عن مصر المريضة” كما عنون رسالته الى ابنه آدم، راوياً له فيها لحظات من أيام الأخيرة “في الغرفة 604 بالدور السادس، درجة ثالثة” من “المسلخ البشري المسمى تجاوزاً مستشفى صيدناوي للتأمين الصحي”، حيث “الممرضون في الخارج منهمكين في اقتسام وجبات المرضى”، فيما “يدخل مراهق يحمل صينية عليها أكواب شاي، وهو يغني بصوته الأجش: حب إيه اللي انت جاي تقول عليه؟”.
النهار