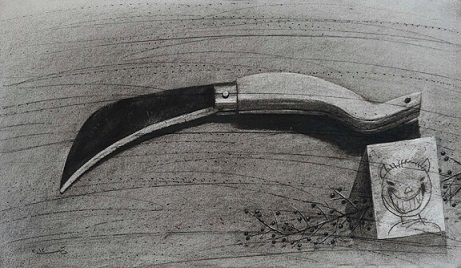هل بدأت أميركا بـ “تقويض نفوذ طهران في سورية” مقالات مختارة

المطرقة الأميركية والمسمار الإيراني في سوريا/ هوازن خداج
تبدّلات المشهد العام وتوالي القرارات للإدارة الأميركية الجديدة للحدّ من تنامي النفوذ الإيراني في المنطقة، يشيران إلى متغيرات حادة في السياسة الأميركية أهمها إسقاط مقولة أن الإرهاب السنّي هو الإرهاب الوحيد الذي يستهدف الغرب ويهدد أمنه ومصالحه، والتي وضعت إيران ضمن قائمة الإرهاب والسعي لتحجيم دورها العسكري في مناطق الصراع.
التصعيد في التوجّهات الأميركية الذي كان مستبعدا في السابق يشكّل خطورة فعلية على إيران، إلا أنها رغم هذه الخطورة مازالت تحرص على تأكيد دورها الرئيسي الداعم للنظام السوري في معاركه ضد المعارضة، والذي بدا واضحا في التغطية الإعلامية المكثفة سواء للزيارة التي قام بها قائد فيلق القدس قاسم سليماني إلى ريف حماة الشمالي في مارس الماضي، أو في صفقة “المدن الأربع” بين إيران وحزب الله وجيش الفتح، والتي تقضي بإخراج المدنيين والمسلحين من المناطق التي يتبادل الطرفان محاصرتها، والتي تعتبر نوعا من الرد على التصريحات الأميركية بتقويض الوجود العسكري الإيراني، وتظهر أن إيران غير مبالية بتصريحات واشنطن أو بما أقرّته من عقوبات.
ولكنها أقدمت على القيام بمتغيّرات “جزئية” في التوجهات الإيرانية لا تمتّ بصلة لخروجها من سوريا، وإنما تفاديا للأزمات الداخلية والخارجية وعلى رأسها قرار حزب الله الذي أعلن عنه في ذكرى تصفية القيادي مصطفى بدرالدين عن تفكيك وحداته العسكرية على الحدود السورية الشرقية، والتي فسّرها البعض -رغم وجود حزب الله في الداخل السوري- كخطوة استباقية للترتيبات التي ستشهدها المنطقة، والتي لن تسمح له بالاستمرار في سوريا في ظل التمسّك الأميركي بضرورة إنهاء الدور الإيراني في سوريا.
إلا أن هذه الخطوة “القاصرة” كانت مسبوقة بإعلان إيران في 30 مارس الماضي عن تشكيل ميليشيا جديدة شبيهة بالحشد الشعبي تحت مسمّى “فوج عشائر منبج/ رعد المهدي” بقيادة معمر الدندن الملقب أبوالفاتح، وبحسب بيان التشكيل فإن الميليشيا الجديدة تضم ما يقارب 37 ألف شاب سوري من حلب وريفها من كافة الطوائف من الذين تلقوا التدريب على أيدي “الضباط والحجاج والأصدقاء”، وأشارت إلى أن هدفها هو “الانتشار في كافة الأراضي السورية بما فيها لواء إسكندرون والجولان”.
وقد أعلنت القيادة العامة للجيش السوري عن تنظيم العناصر من العسكريين والمدنيين الذين يقاتلون مع الميليشيات الإيرانية ضمن “أفواج الدفاع المحلي”، لتكون تحت مظلة القيادة العامة للجيش السوري، وبالتالي تم تقديم الغطاء القانوني اللازم للميليشيات المقاتلة مع الجانب الإيراني.
الخطوات الأميركية تجاه إيران رفعت كثيرا من شأن التوقعات، فكثرت التحليلات التي تسعى لإعطاء الانطباع بأن إيران ربما تفكّر في الخروج من سوريا، منها ما هو مسنود بتصريحات واشنطن عن ضرورة خروج إيران، وتحميلها أكثر مما تحتمل، فهذه التصريحات لم تكن يوما ذات فعالية حقيقية على أرض الواقع، لكنها ضرورية للتذكير الدائم بسطوة المطرقة الأميركية وقدرتها على التدخل عند الحاجة.
ومنها ما هو مستند على أن مواصلة تورط إيران في المستنقع السـوري تهـدد مصالحها وتستنزف قدراتها المالية والبشرية، في الوقت الذي تعاني فيه من مشكلات اقتصادية كبيرة، لكن كل ذلك لا يشكل سببا كافيا لخروجها، فدولة الفقيه تعتبر المشاركة في الصراع السوري جزءا من حماية أمنها القومي، وخروجها منافيا لسياستها الأيديولوجية التي تقوم في الأساس على التمدد في مناطق بعيدة، وعدم السماح للخصوم بالاقتراب من حدود الدولة.
بالنتيجة إيران لم تدخل سوريا لتخرج وهذا ما تم تثبيته حتى الآن، فقد استطاعت تثبيت نفوذها الاقتصادي والاجتماعي الواضح، حيث سعت إيران خلال الفترة الماضية إلى شراء أراض وعقارات وشاركت في تطوير بعض منشآت البنية التحتية، خاصة في مجال الاتصالات وفي مناجم الفوسفات والتنقيب عن النفط، وتسعى للحصول على مرفأ على الساحل يكون إطلالتها على المتوسط، واستطاعت التمدد داخل المجتمع السوري ونشر التشيّع وتثبيت موقعها كمرجعية للمتشيّعين بشكل يزيد من الصعوبات التي يمكن أن تواجه أي جهود قد تبذل لإخراج المسمار الإيراني من سوريا، فقد يتم إخراج الميليشيات بقرار إيراني أو دولي، لكن هل ستخرج إيران حقا؟
كاتبة سورية
العرب
ترامب وتقطيع أذرع إيران/ مالك ونوس
بدا الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في خطابه في قمة الرياض الإسلامية الأميركية أخيرا، وقد اهتدى، فحصر الإرهاب بإيران، ودعا المجتمعين إلى “العمل معاً لعزلها، ومنْعِها من تمويل الإرهاب”، بعد أن كان هذا الإرهاب هيوليّاً وافتراضياً لا كيان له، صوَّره لنا الأميركيون، بعد اعتداءات 11 سبتمبر/ أيلول 2001، أنه عابرٌ للقارات، من الواجب عليهم محاربته في كل أصقاع الدنيا، معلنين أن من ليس معهم في تلك الحرب، فهو ضدهم. غير أن تعامل الأميركيين مع الملف النووي الإيراني، أكثر من عقدين، يدّل على أنهم لم يكونوا مرة جدّييّن في مواجهة إيران، بل إنهم أمَّنوا لها عوامل القوة، مدعَّمةً باتفاقٍ بينها وبين المجموعة الدولية، صَبَغَ برنامجها النووي بصِبغةٍ قانونيةٍ، أزاحت فكرة ضربه من التداول.
ولكن، لماذا يريد الرئيس الأميركي التحشيد من أجل مواجهة إيران؟ لا يضيف ترامب شيئاً حين يتكلم عن دور إيران المتعاظم، أو يردَّدَ ما يقوله مسؤولو إدارته عن ضرورة تقطيع أذرعها في المنطقة، كي يقنع مستمعيه، قادة الدول العربية والإسلامية، بضرورة التحضير لمواجهتها، وهم الذين لم يكن يسيطر عليهم، خلال فترة سير أعمال قمتهم، سوى الهاجس الإيراني. لا بد أن ترامب كان في حاجةٍ إلى تأكيد معرفته بهواجسهم حيال إيران، ولا بد أنه اطلعَ على ما بذلوه من جهودٍ لحثِّ الإدارة الأميركية السابقة على الامتناع عن عقد الاتفاق النووي مع إيران، لكنها لم تفعل، فزادت من مخاوفهم من قوة هذا الجار الذي لم يأمنوه، منذ إعلان قادته انتصار ثورتهم الإسلامية سنة 1979.
وإن كان القول إن إدارة الرئيس الأميركي السابق، باراك أوباما، كانت قاصرةً عن مواجهة
“لم يضع ترامب خطوطاً عريضةً للكيفية التي سوف يتبعها من أجل “عزل إيران” ا لأخطار التي تحدق بحلفاء واشنطن، وكانت سبباً في تراجع دور أميركا في المنطقة، وما قابله من تمدّد “داعش” وتعاظم دور إيران، هو قول مسلّم به، تبعاً لسياساتها المتبعة وسجلِّ ممارساتها، فإن هذا الرأي يعد سديداً من الناحية النظرية. لكن النظر إليه من باب التشكيك يمكن أن يفيدنا أن تلك الإدارة ربما كانت تراقب الوضع عن بعد، وتتعمد الابتعاد كي تأخذ الحوادث مجراها الذي أخدته، فأوصلت المنطقة إلى ما وصلت إليه، وأجبرت سكانها على إطلاق صرخة استغاثة، لبَّتها إدارة ترامب من فورها. وهو في مجمله لا يعدو أن يكون سوى سياسةً أميركيةً جديدةً، تفترق، من حيث ترتيب الأولويات والاستجابة إلى التهديدات، عن سياساتها السابقة التي اتبعتها طوال القرن الماضي، إذا أخذنا الثمار التي قطفها ترامب بعد زيارته الرياض، الأسبوع الفائت، بالاعتبار.
ومن هنا، لا يمكن التصديق أن الولايات المتحدة تسعى إلى خفض التوتر، أو حل النزاعات التي تشهدها منطقة ما، فما بالك بمنطقةٍ تُعْتَبَر النزاعات فيها استثماراً أميركياً تؤتى ثماره بأقل التكاليف والجهود. علاوة على أن النزاعات هي سبيل أميركا إلى تجميع الحلفاء حولها، وزيادة ولائهم لها. لذلك، لا بد أن الإدارة الأميركية وجدت أنه لا يكفي الاستثمار في خطر تنظيم داعش، لكي تُثبت الحاجة إليها، فعمد قادتها إلى تناول إيران ووضعها على الطاولة التي نزلت عنها بعد توقيع الاتفاق النووي، بينها وبين مجموعة الدول الست، في يوليو/ تموز 2015، والعمل على تعظيم خطرها الذي لم يكن خافياً، من أجل العودة إلى المنطقة بقوة، وبأعلى نسبة من الفوائد، من باب مواجهة الخطر الإيراني الذي، لو أنهم كانوا فعلاً جديين في مواجهته، لفعلوا حين تبدّى عبر التمدُّد في العراق وسورية واليمن ولبنان، إذ من المعروف أنَّ هذا التمدُّد يعد خطاً أحمرَ في عرف السياسة الأميركية، يُحظَّر على أي كان تجاوزه.
فمن تجربة الولايات المتحدة مع مواجهة الخطر الإيراني الذي يسوِّقونه هذه الأيام، نستطيع
“لا يمكن التصديق أن الولايات المتحدة تسعى إلى خفض التوتر، أو حل النزاعات التي تشهدها منطقة ما” تأكيد عدم جدية واشنطن في ما تدّعيه، فبالنسبة لخطر النووي الإيراني، دأبت وكالة المخابرات المركزية الأميركية، ومنذ سنة 1995، على التنبؤ بأن إيران على وشك امتلاك القدرة على تصنيع سلاح نووي، وردَّدت كثيراً أنه يجب منعها من ذلك بأي طريقة، غير أن الحصول على دليلٍ على هذه الفرضية كان متعذراً على الوكالة، ما جعل واشنطن، وعلى مدى سنوات عديدة، تعمد إلى تكرار التلويح بالعزم على توجيه ضربة عسكرية لبرنامجها في حال توفر الدليل، وتبادلت أدوار التهديد بتوجيه الضربة مع الكيان الإسرائيلي، مُغفلةً واقعة ضرب العراق واحتلاله، بناءً على شبهة امتلاكه برنامجاً كهذا، من دون أن يُطبِّق الأميركيون عليها مقولة وزير دفاعهم الأسبق، دونالد رامسفيلد، المأثورة، عندما تحدّث عن الدليل على حيازة العراق أسلحة نووية، وهي: “غياب الدليل ليس دليلاً على الغياب”.
لم يضع ترامب، في خطابه، خطوطاً عريضةً للكيفية التي سوف يتبعها، هو ومن دعاهم إلى العمل معه، من أجل “عزل إيران”، أو تقطيع أذرعها، لوقف إرهابها وتمويلها الإرهاب. لكنه بكلامه ذاك وضع أجندةً للخطوات التي ستتبعها بلاده للعودة إلى المنطقة بقوة، من أجل إطفاء الحرائق التي يتعذّر إطفاؤها بسهولة، بعد أن استعرت نارها ولم يسلم أحد من لهيبها، إن صدّقنا أن أميركا يمكن أن تعمل فعلاً على إطفاء أي حريق.
العربي الجديد
هل ترتدع إيران؟/ بكر صدقي
ما أضافته زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الرياض، والقمم، العربية – الأمريكية والإسلامية – الأمريكية، التي كانت العاصمة السعودية مسرحاً لها، واضح بلا أي تزويق: زيادة التسلح والاستقطاب الإقليمي الحاد. هذا ما يمكن استنتاجه بسهولة من كلمة ترامب وصفقة الأسلحة الضخمة التي أبرمتها الولايات المتحدة مع السعودية. غاب عن الزيارة وقممها أي توجهات متعلقة بالسلام الإقليمي أو التنمية أو الإصلاح السياسي أو الانفتاح الثقافي في دول المنطقة، لتحضر طبول الحرب وحدها: ضد الإرهاب السني والنزعة التوسعية الإيرانية. أو بكلمات أخرى: الإرهاب «الإسلامي» بجناحيه السني والشيعي.
هل هذا جيد؟
قد يبدو كذلك للدول المتضررة من النزعة التوسعية الإيرانية التي تهدد أمنها الوطني، بالنظر إلى المبلغ الضخم الذي تم تخصيصه لمواجهة عسكرية محتملة مع إيران أو امتداداتها داخل المجتمعات العربية. وهذا مما يتلاقى مع السياسة الإيرانية للولايات المتحدة في عهد ترامب. معنى ذلك أن الدول المعنية تستعد، بأموالها وامكاناتها البشرية، لخوض الحرب الأمريكية على إيران، فيما تخوض حربها الخاصة ضد مركز الشيعية العالمية، من دون أن يكلف ذلك الأمريكيين أي شيء، باستثناء تقديم الغطاء السياسي من الدولة العظمى الوحيدة. حرباً لا يمكن أن تكسبها لا إيران ولا خصومها، في حين يذهب الربح الصافي فيها إلى الطرف الأمريكي وحده.
بالمقابل يمكن خفض خسائر العرب والإيرانيين إلى حدودها الدنيا، وتحويلها إلى مكاسب لاحقة، إذا ارتدعت إيران من الموجة العاتية القادمة ضدها، فتخلت عن سياستها التدخلية التي مفادها تصدير الشيعية السياسية المسلحة تحت غلاف «تصدير الثورة» على ما زعمت «الجمهورية الإسلامية» منذ قيامها في أواخر السبعينات. وتشير نتائج الانتخابات الرئاسية التي جرت في إيران، يوم الجمعة الماضي، إلى توق المجتمع الإيراني بغالبيته إلى التغيير، سواء في الداخل أو في السياسة الخارجية. قد لا يكون لمنصب الرئاسة في النظام الإيراني أي أهمية في تحديد السياسات العامة أو اتخاذ القرارات الكبيرة، لكن هذا التصويت الكثيف وهذه النتيجة الكاسحة في فوز الرئيس روحاني المحسوب على التيار الإصلاحي، هما بمثابة استفتاء شعبي يعبران عن الرأي العام السائد لدى الإيرانيين. بمعنى أن قراراً من النظام بتغيير السياسة الخارجية نحو الانفتاح على العالم وإقامة علاقات تعاون مع الجيران، سيلاقي دعماً شعبياً مؤكداً، مقابل معارضة ضيقة متمثلة في أوساط الحرس الثوري وبيئته الاجتماعية.
أي أن تغييراً إيجابياً في السياسة الخارجية، لن يكون مجرد خضوع أمام تهديدات خارجية جديرة بإثارة الخوف، بقدر ما هو استجابة لتوق اجتماعي في الداخل الإيراني، فضلاً عن كونه متسقاً مع قيم العصر الإيجابية، وبداية الطريق في ترميم آثار العزلة الطويلة والعقوبات المؤلمة، للانتقال بعد ذلك إلى نهضة اجتماعية – اقتصادية تملك إيران كل مقوماتها، باستثناء… القرار السياسي الشجاع.
تبدو السطور السابقة ضرباً من الخيال الجميل، بالنظر إلى ردود الفعل المتشنجة من القيادة الإيرانية على زيارة ترامب إلى السعودية، وما يبدو أنها أسسته من تحالف معادٍ لها من دول إقليمية بدعم أمريكي كامل. بل إن إيران استبقت زيارة ترامب باستعراض قوة غير رمزي أبداً، وإن حمل رسالة إيرانية، حين أطلق المتمردون الحوثيون صاروخاً حربياً باتجاه الرياض، عشية الزيارة بالذات، تم تدميره في الجو من قبل الدفاعات السعودية. خيار التصعيد لدى إيران، في مواجهة الضغوط الأمريكية الكبيرة، ظهر قبل ذلك أيضاً، بعدما وجهت المقاتلات الأمريكية ضربة موجعة لقوات النظام الكيماوي والميليشيات الشيعية الحليفة قرب معبر التنف، عند تقاطع الحدود السورية – العراقية – الأردنية، الممسوك من قبل قوات معارضة مدعومة من واشنطن. فبدلاً من أن ترتدع طهران من تلك الضربة الموجعة التي كلفتها عدداً غير معروف من القتلى، أعلنت عن توجيه حملة جديدة من قوات حزب الله إلى الهدف نفسه. الأمر الذي يشير، من جهة أخرى، إلى مدى الأهمية الاستراتيجية لتلك المنطقة في المشروع الإيراني الساعي إلى بناء ممر بري متصل يمتد من إيران إلى حزب الله في لبنان. وتشير الضربة الأمريكية، بالمقابل، إلى مدى تصميم وزارة الدفاع الأمريكية على منع إيران من تحقيق هذا الهدف، كما إلى استهتارها بالاعتراض الروسي الحانق. فقد جاءت ضربة التنف، بعد ضربة مطار الشعيرات، لتكشف أيضاً مدى هشاشة الادعاءات الروسية حول إغلاقها للأجواء السورية أمام طيران التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة، في المناطق الواقعة خارج سيطرة داعش، وعموماً هشاشة إمساك روسيا بالملف السوري. الأمر الذي لاحظنا تعبيره الواضح في الجولة الأخيرة من مباحثات جنيف التي انتهت كسابقاتها بلا أي نتائج من شأنها تبرير التفرد الروسي بتوجيهها.
ولكن إلى أي حد يمكن لإيران أن تذهب في خيار المواجهة؟
إذا نظرنا إلى تاريخ السياسات الإيرانية سنرى أنها لن «تتجرع كأس السم» على حد تعبير الإمام الخميني، ما دامت حربها دائرة خارج حدودها وبأدوات تنفيذية غير إيرانية هي التي تدفع الثمن الباهظ للمغامرة الإقليمية لطهران، أي حزب الله الشيعي اللبناني، والميليشيات الشيعية العراقية والأفغانية والباكستانية، والمتمردين الحوثيين في اليمن. تبدو ولاية الفقيه مستعدة للتضحية بكل هؤلاء في حربها العبثية المدمرة التي تشكل أيضاً المناخ الملائم للتطرف الجهادي السني العالمي. وبهذا المعنى الأخير، لا تشكل «الحرب على الإرهاب» بنسختها الترامبية المحدّثة والملقحة بمواجهة إيران بالوكالة، إلا تأجيجاً إضافياً لنوازع الإرهابين السني والشيعي.
٭ كاتب سوري
القدس العربي
علاقة طهران بـ «حدودنا»/ حازم الامين
لاختيار واشنطن منطقة البوكمال على الحدود بين سورية والعراق مسرحاً للمواجهة مع طهران دلالة أخرى غير ميدانية هذه المرة. فقصة طهران مع الحدود، أي حدود، تنطوي على ممارسة لا تقيم وزناً للكيانات المتشكلة في مرحلة الخروج من الحقبة الاستعمارية. والوعي الإيراني المتشكل في ظل دولة ولاية الفقيه، ومنذ اليوم الأول له، أي بعد سقوط الشاه مباشرة، اعتبر أن الحدود ليست عائقاً قانونياً أو اجتماعياً لمد نفوذه. والخطوة الأولى في حينها كانت إرسال وحدات من الحرس الثوري الإيراني إلى لبنان، والمباشرة في بناء مساحة نفوذ فيه.
في سورية اليوم، لطهران طموحات حدودية جلية. هي تمسك بالحدود اللبنانية – السورية، وتسعى إلى فتح الحدود بين العراق وسورية، ولها أيضاً على الحدود بين سورية وإسرائيل حضور تقطعه الغارات الإسرائيلية المتواصلة على مواقع «حزب الله» هناك. أما الأردن فقد بدأ يشعر بأن طهران تقترب من حدوده مع جنوب سورية.
تركيا ليست دولة ناجية، فطهران حجزت نفوذاً على حدودها مع دمشق عبر علاقتها مع حزب العمال الكردستاني. وإذا كان هذا النفوذ غير مباشر، إلا أن مواظبة طهران على شق الطريق من الموصل إلى الرقة تؤشر إلى أن ما ليس مباشراً سيصبح مباشراً. والحال أن اختيار طهران الحدود بصفتها مسرحاً للعب بالكيانات لم يتم على نحو عشوائي أو أيديولوجي، إنما لإدراكها أن هذه الحدود هي من المساحات الرخوة لهذه الكيانات، فالجماعات على طرفي هذه الحدود تملك قابليات كبيرة لإعادة التموضع في خرائط سياسية وديموغرافية جديدة. وهنا تماماً تكمن أخطار الطموحات الإيرانية، وضعف حساسية طهران حيال السيادات «الوطنية» المتشكلة في الحقبة الاستعمارية.
محافظة دير الزور السورية تربط عشائرها بالعمق العراقي علاقات عاطفية ورحمية واقتصادية تفوق علاقاتها بالعمق السوري الطارئ. الحدود اللبنانية- السورية بدورها لم تكن يوماً حدوداً ثابتة، وهي مخترقة ببؤر نفوذ مذهبي كشفت عنها معارك القلمون في السنوات الفائتة. الحدود بين سورية وإسرائيل ملتبسة ومخترقة باحتلال إسرائيلي للجولان، وبعلاقات عابرة للحدود تقيمها الجماعات الأهلية هناك. أما الحدود مع الأردن فهي الأكثر وضوحاً لجهة الامتدادات العشائرية التي تخترقها. ويُشكل الأكراد في مناطق الحدود مع تركيا خاصرة رخوة لمفهوم السيادة الوطنية على طرفيها السوري والتركي. ناهيك بلواء الإسكندرون السليب تارة والمشطوب عن خريطة سورية البعثية تارة أخرى.
الدول أبقت جماعاتها الحدودية خارج طموحاتها «الوطنية»، والاستبداد الذي كان الأداة الرئيسة لهذه الوطنيات الجامحة والناقصة، ترك للجماعات الحدودية منافذ علاقات أوهنت صلتها بالمركز المستحدث. واليوم جاءت طهران لتستثمر هنا.
مساعٍ لإعادة وصل عشائر دير الزور بعمقها العراقي عبر جهود «تشييعها» من جهة وعبر محاكاة نموذج الحشد العراقي بحشد عشائري سوري موازٍ. أما الحدود مع لبنان، فالمهمة فيها أسهل، ذاك أن اهتراء الدولة على طرفيها تاريخي، والميليشيات التي تمسك بها لا تخفي طموحاتها في تبديد السيادة على مذبح السيد الإيراني. وعلى رغم الأخطار الكبرى المتولدة عن اقتراب طهران إلى الحدود السورية مع إسرائيل، إلا أن ذلك لم يثن طهران عن المواظبة على تأسيس نفوذ هناك. واليوم انضم الأردن إلى دائرة المخاوف على الحدود، فاختلطت عند حدود المملكة طموحات «داعش» في التقدم من بادية الشام، بطموحات طهران بالاقتراب من هذه الحدود عبر مدينة درعا، وانعقد على أثر ذلك مشهد شديد التعقيد في جنوب سورية.
طهران اختارت المساحات الرخوة في هذه الكيانات، وهي فعلت ذلك لأسباب شديدة البراغماتية والواقعية، إلا أن البعد الأيديولوجي ليس بعيداً عن هذه الخيارات. فالحدود في الوعي الإيراني ليست نهائية، وإعادة صياغة العلاقات الدولتية بين الجماعات لن ترتد على سيادة طهران على أرضها. فتح الحدود السورية- العراقية مغامرة ستصيب الجماعات الأهلية في كلا البلدين، لكن ارتداداتها ستكون خارج ايران بالتأكيد. والمغامرة بمصائر المجموعات الشيعية في هذه الدول لن تدفع طهران فاتورته، والانتكاسة إذا ما أصابت الموقع الإيراني في هذه الدول ستبقى خارج الجغرافيا الإيرانية المباشرة.
المواجهة بين واشنطن وطهران لن تجرى على أرضٍ إيرانية. هذه الحقيقة تُحفز طهران على الذهاب أكثر في مغامراتها، فهي في النتيجة لا تغامر برصيد إيراني، والثمن ستدفعه جماعاتها المستتبعة في هذا الإقليم المستتبع.
الحياة
حزب الله من ذراع إيران الأقوى إلى خاصرة إيران الرخوة/ علي الأمين
زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى المملكة العربية السعودية، ستشكّل معلما أساسيا في قراءة التطورات الاستراتيجية على مستوى المنطقة العربية والشرق الأوسط على وجه الخصوص، فالقمم الثلاث التي نظمتها الرياض؛ الثنائية مع واشنطن، والقمة الخليجية الأميركية، والقمة الإسلامية العربية الأميركية، سوف تؤسس لمرحلة جديدة عنوانها إعادة استنهاض الحلف الأميركي التقليدي في المنطقة الذي بدا أنه اهتز وتراجع منذ أحداث 11 سبتمبر 2001 وزاد في التصدّع مع السياسة الأميركية التي قادها باراك أوباما والتي كان من أبرز سماتها التقارب مع إيران على حساب الحلفاء التقليديين في المنطقة العربية.
نتائج القمم الثلاث التي شهدتها السعودية والتي يتقدمها توقيع عقود بمئات المليارات من الدولارات بين واشنطن والرياض، ترجمت إلى حد بعيد نوعا من الشراكة الاستراتيجية التي ضمنت للرياض دورا محوريا في السياسة الأميركية على مستوى المنطقة العربية والإسلامية يحظى بدعم واشنطن، ووفرت للإدارة الأميركية الجديدة مكسبا سياسيا واقتصاديا سيساعد الرئيس الأميركي في مواجهة خصومه داخل الولايات المتحدة الذين لا يزالون يشكّكون بأهليته في السلطة.
إلى هذين المستويين من الفوائد بين الرياض وواشنطن، يُمكن التركيز على جانب محوري يهمُّ المنطقة والعالم المتمثل في محاربة الإرهاب، فقد نجحت الرياض في بلورة رؤية مشتركة مع واشنطن حول محاربة الإرهاب المتمثل بتنظيم داعش، وفي التقدم خطوات مهمة لبلورة رؤية مشتركة تجاه النفوذ الإيراني وضرورة الحد من هذا النفوذ وامتداداته في المنطقة العربية.
صحيح أنّ ترامب تحدث بوضوح عن خطر هذا النفوذ وطالب الرئيس الجديد المنتخب في إيران بتفكيك المنظمات العسكرية والأمنية لإيران في الدول العربية، لكنه في المقابل دعا حلفاءه وفي مقدمتهم السعودية إلى أن يكونوا في مقدمة المواجهة، وألا يراهنوا على عودة أميركا عسكريا إلى المنطقة، لكنه شدد على التأكيد أنّنا معكم وسندعمكم.
الملفات المتعددة التي جرى بحثها في القمم الثلاث، تجعل المراقب أمام ما يشبه التأسيس لمرحلة جديدة على مستوى المنطقة العربية، إيران عنصر محوري فيه، فالإدارة الأميركية ومن خلال الاتفاقيات التي عقدتها، تُضيّق الخناق على إيران، فهي من جهة فتحت نافذة للتفاهم من خلال إتاحة الفرصة مجددا لها لأن تكون عنصرا من عناصر استعادة الاستقرار بشرط العودة عن سياساتها الأيديولوجية في المنطقة، ومن جهة أخرى لوّحت بصفقات التسلح ودعم خصوم إيران بقوة في حال استمرت طهران على نهجها في ما يسمى تصدير الثورة.
لذا كان ترامب حاسما تجاه تصنيف حزب الله في خانة الإرهاب وساوى بينه وبين تنظيمي القاعدة وداعش كما صنّف حركة حماس في نفس الخانة، وهذا مؤشر على أن ترامب يميز بين إيران وأذرعها ولا سيما حزب الله، فالرئيس الأميركي لم يذهب كما ذهب سلفه الرئيس الأميركي الأسبق جورج بوش الابن إلى وضع إيران في خانة محور الشر، لكنه في المقابل لم يراعِ السياسات الإيرانية في المنطقة كما فعل سلفه باراك أوباما، الذي في عهده جرت أكثر من عشرة لقاءات بين وزيري خارجية إيران وأميركا خلال أقل من سنتين وهذا ما لم يجرِ في تاريخ العلاقة بين الدولتين، بل وصل الأمر إلى أن اعتبر وزير خارجية أميركا جون كيري أن وجود حزب الله في سوريا لا يضر بالمصالح الأميركية.
القرار بضرب أذرع إيران في المنطقة العربية بالتوازي مع القضاء على “الإرهاب السني” هو الأكثر وضوحا في نتائج القمم في الرياض وفي خطاب ترامب الذي لم يميّز بينهما هذه المرة، وبالتالي فإن أهمية توقيت إعلان الرياض الأميركي السعودي، أنه رسم معالم طريق تجاه تطويق أذرع إيران بالتوازي مع ضرب الإرهاب، بحيث لم يجرِ التمييز بين الأمرين ولم يكن هناك أي محاولة لتحديد أولويات، بل يمكن توقع مجريات عسكرية على الأرض مختلفة عما سبق وستبدو هذه المرة أكثر تشددا ضد حزب الله.
أمّا لماذا حزب الله؟ فلأن الحزب كما كان خلال العقود السابقة يد القوة لإيران في المنطقة، هو اليوم الحلقة الأضعف والخاصرة الرخوة لإيران في المنطقة، فمبررات ضرب حزب الله في سوريا هو أنه أقل كلفة استراتيجية بالنسبة للأميركيين وحلفائهم سواء في المحيط العربي أو لدى الكيان الإسرائيلي، ذلك أنّ تورط حزب الله في الدم السوري، جعله بمثابة العدو الأول لمعارضي الأسد، فيما إيران التي أوصلت الرئيس حسن روحاني إلى سدّة الرئاسة مجددا، تقول من خلال هذه النتيجة أنّها تقدم خيار التسوية مع الشيطان الأكبر على خيار المجابهة معه، وبالتالي فإنّ حزب الله سيكون أقرب إلى أن يكون ورقة من الأوراق التي يمكن لطهران أن تساوم عليها وعلى طبيعة دورها ونفوذها لكي تخفف من الخسائر التي يمكن أن تطالها مباشرة.
الصورة تتضح أكثر والأرجح أن إيران وصلت إلى مرحلة حاسمة لجهة عسكرة نفوذها في المنطقة، فهي أمام خيار الإصرار على عسكرة نفوذها وبالتالي الاستعداد للمزيد من الإجراءات العدائية من محيطها ومن واشنطن، أو الذهاب نحو المساومة على هذا النفوذ عبر التضحية بأذرعها العسكرية لصالح مساحة من النفوذ السياسي وهذا قد لا يكون متوفرا على طول الخط إذا ما ضيعت إيران الفرصة المتاحة، ولم ينجح الرئيس الجديد في بلورة صفقة سياسية مع واشنطن بسبب تعنت جهات محافظة داخل النظام.
حزب الله الحلقة الأضعف في هذه المواجهة، والأرجح أن إيران اليوم هي بين خيار الاستمرار في دعم نظام الأسد وبالتالي تحمل تداعيات هذا الخيار على وجود حزب الله ليس في سوريا فحسب بل في لبنان أيضا، أو امتصاص الهجمة الأميركية السعودية بالمزيد من الانضواء تحت السقف الروسي والالتزام بشروطه، وتلقي المزيد من العقوبات الاقتصادية والمالية التي لا مناص منها على ما تشير الإجراءات الأميركية المستمرة ضده وكان آخرها إدراج الشخصية الثانية في حزب الله هاشم صفي الدين على لوائح الإرهاب الأميركية والسعودية عشية زيارة ترامب إلى الرياض.
الفخ السوري يُطبق على حزب الله وليس في وسع الحزب تحمل أي تهديد جدي إقليمي أو دولي في سوريا، ولن يجد هذه المرة أي دولة عربية مستعدة للتضامن معه في ما لو تم استهداف قواته في هذا البلد حتى لو كانت إسرائيل هي الطرف الذي يستهدفه، علما أن الضربات الإسرائيلية المحدودة له لم تتوقف في سوريا من دون أن يقابل ذلك أيّ رد فعل مستنكر من قبل أيّ جهة عربية يعتد بها ولا حتى جهة إسلامية كما كان الحال في عقود سابقة عندما كان يتعرض لضربات عسكرية إسرائيلية على الأراضي اللبنانية.
حزب الله سيعلن قريبا سحب قواته من سوريا بطلب من الحكومة السورية أو بذريعة أخرى، لكن هذا الإعلان سيكون مرتبطا بنوع من الضمانات التي لا تجعله عرضة لضربة عسكرية في لبنان قد تقوم بها إسرائيل، وتضمن حماية الحدود مع سوريا ولو بقوات دولية وهذا ما مهد له قبل أسبوعين حينما أعلن تسليم نقاط تمركزه على هذه الحدود للجيش اللبناني، في المقابل ثمة خيار آخر هو الانتحار عبر فتح المجابهة مع إسرائيل. الانتحار الذي بات يؤذي إيران هذه المرة ولا يفيدها، علما أنّ حزب الله الذي بات محاصرا بالأعداء الذين برع في صناعتهم سواء في الداخل اللبناني أو المجتمع السوري أو العرب على وجه العموم صار بحكم الوقائع الاستراتيجية رهينة إسرائيل بعدما كان ذراعا إيرانية تزعج إسرائيل قبل سنوات.
كاتب لبناني
العرب
الشرق الأوسط «الإيراني» والتنف السوري/ وليد شقير
كان من الطبيعي أن تثور ثائرة طهران وحلفائها إزاء القمة العربية الإسلامية- الأميركية في الرياض مطلع الأسبوع. فالقمة تشكل تحولاً في السياسة الأميركية التي كان يركن إليها القادة الإيرانيون في عهد الإدارة الأميركية السابقة التي هادنت سياسة هؤلاء بحجج مختلفة، العلني منها أن باراك أوباما أراد قيام توازن بين اندفاعة إيران الشيعية وتمددها الإقليمي، وبين دول الخليج العربي السنية. لكن الفاضح في هذه الحجج أن واشنطن باراك أوباما كانت تلوم دول الخليج على نشوء التطرف في المنطقة وتنسب إليها دعم الإرهاب، على رغم تعرضها بوضوح إلى أفعاله وعملياته الإجرامية في عقر دارها، لا سيما في السعودية.
تناغمت طهران مع أوباما ورجاله في الترويج لأولوية محاربة الإرهاب، على مواجهة النظام الاستبدادي في سورية، متجاوزة اتهاماتها السابقة لواشنطن بالسعي إلى إقامة «الشرق الأوسط الجديد»، تحت نفوذها، وفاخرت بدلاً من هذه التهمة، بشعار «الشرق الأوسط الإسلامي»، بعدما جاهرت بسيطرتها على بغداد ودمشق وصنعاء وبيروت وصولاً إلى شاطئ البحر الأبيض المتوسط، عبر نجاحها في تهديد استقرار هذه الدول عبر التشكيلات العسكرية التي أنشأتها فيها وتمدد نشاطاتها العسكرية والأمنية إلى دول خليجية عدة، خلال السنوات الثلاث الماضية.
ومرة أخرى يفرض السؤال نفسه: إذا كانت ذريعة بعض مؤيدي التمدد الإيراني أنه جاء نتيجة الانكفاء العربي عن ميادين الصراع على النفوذ، فلماذا لوم الدول العربية التي قررت العودة إلى ملء الفراغ الذي سعت طهران إلى تعبئته، واتهامها بالسعي إلى «الشرق الأوسط الجديد»؟ وهل اتهام العرب بالعمل من أجل «الشرق الأوسط الجديد» بالتعاون مع إدارة دونالد ترامب، يستقيم فيما السعي إلى «الشرق الأوسط الإسلامي» (الإيراني) بالتعاون مع إدارة أوباما مباح ومشروع؟ وهل أن تحديد إيران لصورة الشرق الأوسط، غصباً عن شعوب دوله، باستخدام الوسائل كافة لتفكيك الدولة في عدد من الأوطان، لإعادة تركيبها وفق المصالح والعقيدة الإيرانية، شرعي؟
لا طائل من السجال على هذا المستوى مع حاملي لواء الدفاع عن المنطق الإيراني، على رغم احتفالية هؤلاء بالانتصار الذي تمخض عنه الاتفاق على النووي العام الماضي، وبالتهافت الغربي على طهران من أجل الاستثمارات بعده…
لا جديد في موقف الدول العربية والخليجية من إيران في ما نص عليه «إعلان الرياض» بـ «التزام القادة تكثيف جهودهم للحفاظ على أمن المنطقة والعالم، ومواجهة نشاطات إيران التخريبية والهدامة بكل حزم وصرامة داخل دولهم وعبر التنسيق المشترك». الجديد هو التوقيع الأميركي عليه، بالاشتراك مع أكثر من 50 دولة عربية وإسلامية، علماً أن ترامب ومعاونيه كانوا صرحوا بهذه المواقف سابقاً. والجديد هو دعوة الرئيس الأميركي إلى عزل إيران نتيجة سياساتها، من منصة القمة.
قد لا تنجح قمة الرياض في تنفيذ بعض قراراتها الطموحة من نوع تشكيل القوة الإسلامية المشتركة من 34 ألف جندي من أجل محاربة الإرهاب بعد تصنيف «داعش» و «النصرة» و «حزب الله» على قدم المساواة… وقد تراهن طهران على عدم التنفيذ. ويفترض انتظار التطبيق العملي لهذه القرارات. وهي قد تراهن أيضاً على ما يروج بأن ترامب لن يبقى رئيساً… في وقت جدد حسن روحاني رئاسته لدورة ثانية وسط ميله لمهادنة واشنطن والتشدد مع دول الخليج. لكن ما يقلق قادة ايران، هو أن إجراءات محاصرة تمددها قد تكون أكثر سرعة وعملية من خطوات كبرى من هذا النوع.
فعين قادة «الحرس الثوري» على المسعى الأميركي لقطع طريق مقاتليه وميليشياته نحو سورية انطلاقاً من بغداد، عبر معبر التنف الواقع على المثلث العراقي- الأردني- السوري، والذي تتواجد فيه «قوات سورية الجديدة» المدربة من الأميركيين والنروجيين، الذي يتواجدون فيه كـ «خبراء»، تعزز عددهم أخيراً. فهذا المعبر شريان حياة لـ «الحشد الشعبي» العراقي الذي يقاتل بعض ميليشياته في سورية. وهو بديل الجسر الجوي المكلف مالياً والصعب عسكرياً (في ظل هيمنة الطيران الروسي والأميركي على الأجواء) لنقل العتاد والعديد الإيراني. وهو حيوي لمواجهة القوات الإيرانية والنظامية السورية أي تقدم لقوات المعارضة السورية بدعم أميركي- أردني على الجبهة الجنوبية نحو محافظة درعا… والذي يحكى عنه منذ مدة. وهو ما يفسر حشد جيش الأسد ودفع «حزب الله» مزيداً من المقاتلين نحو الطريق المؤدية إلى هذا المعبر.
وعين قادة «الحرس الثوري» على تهيؤ قوات التحالف العربي للسيطرة على مرفأ الحديدة في اليمن، للحد من تهريب الأسلحة إلى الحوثيين، تمهيداً لحصرهم في مناطق جبلية بعيدة، وعلى العقوبات التي يروج لها ضد «حزب الله» في لبنان، بسبب استمرار تدخله في سورية عبر الحدود.
الحياة
أميركا وضعت خططاً للتصدي لإيران/ راغدة درغام
حصل الرئيس الأميركي دونالد ترامب على كل ما حلم به في قمم الرياض من حفاوةٍ، وتدفق الأموال على الاقتصاد الأميركي وعلى الميزانية المطلوبة للنظام الجديد لمحاربة الإرهاب، واستعداد دول مسلمة وعربية لتوفير قوة احتياط من 34 ألف جندي لمواجهة الإرهاب في سورية والعراق، واستعداد لعلاقات طبيعية مع إسرائيل إذا وافقت على المبادرة العربية للسلام برعاية أميركية. هذه ذخيرة قيِّمة لرئيس جديد التقى قادة وممثلي أكثر من 55 دولة عربية وإسلامية في محطة واحدة قبل أن يتوجه إلى إسرائيل وفلسطين في زيارة ناجحة ثم إلى الفاتيكان وبعده إلى بروكسيل ليتلقاه الحلفاء الأوروبيون بارتياح لمجرد أنه اختار التحاور والتعاون بدلاً من خطاب المواجهة والتحجيم الذي تبناه إزاء حلف «الناتو» وأثناء الحملة الانتخابية.
خارج الولايات المتحدة بدا دونالد ترامب رئيساً يؤخذ بجدية حتى حين لاحقته أنباء الداخل الأميركي بتهم احتمال تعطيل العدالة والتعتيم على علاقات مشبوهة مع روسيا. فلا خيار آخر أمام العالم سوى التعاطي مع الرئيس الأميركي في السلطة مهما كانت أوضاعه الداخلية، لأن القبوع في انتظار المعارك السياسية المحلية أو إصدار قرارات العزل فيه مغامرة. ومع هذا، هناك فارق بين الواقعية والعملية في كيفية التعامل مع رئاسة ترامب وبين الإفراط في الاستثمار فيه وتوسيع بيكار التوقعات من الرئيس الأميركي أو من الولايات المتحدة. فلا شيء يدوم في العلاقات الأميركية مع الدول العربية خصوصاً، لأن المصالح الأميركية الأساسية الدائمة لا تشمل هذه الدول كما تشمل إسرائيل، على سبيل المثال، والتي هي جزء من السياسة الداخلية الأميركية. إيران ليست من الثوابت في الحسابات الأميركية الاستراتيجية، ولذلك فهذه الحقبة من العلاقات الأميركية- الإيرانية- العربية تستحق القراءة العميقة، لا سيما على ضوء الانتخابات الرئاسية التي أبقت الرئيس الإصلاحي حسن روحاني في الرئاسة ووجَّهت صفعة قاسية لـ «الحرس الثوري» المتطرف وأبطاله على نسق قاسم سليماني. فإبرة البوصلة في العلاقات الثلاثية لم تستقر، وهذه مرحلة التموضع في موازين التصعيد وآفاق التفاهمات.
صدرت مواقف قوية وبيانات عنيفة عن قمم الرياض طالبت إيران بالكف عن التوغل في الأراضي العربية وعن دعم الميليشيات والإرهاب. البيان الأميركي- السعودي المشترك الذي صدر عن القمة الثنائية أكد العزم على العمل معاً لاحتواء التهديدات الإيرانية لدول المنطقة والعالم وتدخلات طهران «الشريرة في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، وإشعالها الفتن الطائفية، ودعمها الإرهاب، وما تقوم به من جهود لزعزعة استقرار دول المنطقة». أكد البيان العزم على التصدي لـ «الميليشيات» التي تدعمها طهران، كما دعم الطرفان الحكومة اللبنانية لنزع سلاح «حزب الله» وحصر السلاح بالمؤسسة العسكرية الشرعية.
الثقوب في هذه التعهدات تكمن في قيود تنفيذها، فالمواجهة العسكرية المباشرة مع إيران ليست جزءاً من الاستراتيجية الأميركية نحو طهران كقرار مسبق. إنما ما أبلغته إدارة ترامب، بأفعالها، هو أن لتهديداتها طعم الصدقية والتنفيذ -كما أثبت الرئيس دونالد ترامب عندما قصف في كل من سورية وأفغانستان-. ولذلك، على طهران أن تفهم ما بين طيّات الرسالة الأميركية وأن تدرك أن الإنذار حقيقي وليس بلا صدقية.
الرجال الذين نجحوا حتى الآن في صنع السياسة الخارجية، على رغم معارضة ومحاربة زمرة المحافظين الجدد في البيت الأبيض، هم العسكريون الكبار في ما يسمى «محور الراشدين». السياسة الاستراتيجية نحو إيران تنطلق من فكر قائم على مبدأ ضخ الزخم Surge لاستعادة القوة وإبرازها ميدانياً لتكون قاعدةً للتفاهمات.
كنقطة انطلاق، إن السياسة الرئيسية لإدارة ترامب نحو إيران طبقاً لمصادر مقربة من صنع القرار هي التصعيد اللفظي والسياسي والاقتصادي بهدف «عزلها وتصنيفها دولة خارجة عن القانون طالما تدعم الإرهاب وتصنع الميليشيات» للتدخل في الدول الأخرى. الاستراتيجية الأميركية لا تنطوي على اعتزام التصعيد عسكرياً ضد إيران في عقر دارها، لكن الاستعدادات الأميركية تشمل تسهيل التصدي للميليشيات الإيرانية في سورية والعراق، وربما لـ «حزب الله» في لبنان إذا برزت الحاجة، وهي لن تبرز إذا رجحت كفة التفاهمات مع طهران.
المعادلة قائمة على مبدأ الترغيب والتهديد في فنون صنع الصفقات. فإذا فهمت القيادة في طهران أن واشنطن جدية في تطويقها وعزلها ومعاقبتها على استمرارها في سياسات التوسع الإقليمي وقررت الكف عن هذه الأنماط، ستجد أن إدارة ترامب جاهزة للعمل معها بناءً على التقدم المحرز فعلياً ميدانياً وليس على أساس حنكة الوعود العائمة. هذا يعني أن على «الحرس الثوري» أن ينسحب من سورية والعراق ويسحب «ميليشياته» معه ليتخلى عن مشروع «الهلال الفارسي». في المقابل، تحصل إيران على وعد أميركي بعدم العودة إلى سياسة العزل والتطويق وكذلك بالمكافأة عبر رفع العقوبات تدريجياً. أما إذا قررت طهران التصعيد والمواجهة، فإن واشنطن جاهزة «لرسم الخطوط في مكان ما» بحسب مصدر مطلع، مؤكداً «عندنا الآن أكثر من خيار في إطار ائتلافاتنا».
«اخرجوا بقرار منكم، وإلا سندفعكم إلى الخروج طرداً»، يقول المصدر المقرب من صنع القرار في إدارة ترامب ملخصاً السياسة نحو توسع إيران في سورية والعراق. يقول إن الاستراتيجية الأميركية تفضل إقناع روسيا بالتنصل من إيران والرئيس السوري بشار الأسد، إنما إذا فشلت أساليب الإقناع، فإن على الكل أن يفهم أن لا تعايش مع استمرار التوسع والهيمنة الإيرانية الإقليمية. وللتأكيد، فإن المسؤول لم يكن يتحدث عن قوات أميركية على الأرض، وإنما عن استراتيجية عسكرية جديدة تجمع بين القدرات الأميركية العسكرية المتفوقة وبين قوى غير أميركية في مواقع القتال.
مصادر غير أميركية توقعت أن تكون أولوية الرئيس الإصلاحي الإيراني -بعدما تلقى ولاية شعبية تمثل صفعة للمتطرفين- أن يتجنب المواجهة مع الولايات المتحدة داخل سورية والعراق ولبنان أو على الساحة الإيرانية. طهران لن تقدم على الخطوة الأولى في المواجهة، إنما السؤال هو: ماذا ستفعل إيران إذا قررت الولايات المتحدة أن تطاردها لإخراجها من سورية والعراق وكذلك لاحتواء ورقتها الثمينة وهي «حزب الله» في لبنان.
الإجابة على هذا السؤال ربما تكمن في العلاقة الأميركية- الروسية ومصيرها. فإذا انتهت العلاقة بصفقة تُلزم إيران الانسحاب من سورية والعراق وتبقي لها ورقة «حزب الله» في لبنان بضمانات تحييد وإبطال الصواريخ التي يملكها، قد يكون ذلك أفضل الخيارات في موازين التفاهمات. أما إذا أصرَّت طهران على مشروع «هلالها» ورفضت الرضوخ للتفاهمات أو للمواجهات، ستجد أن جنرالات البيت الأبيض ووزارة الدفاع قد وضعوا خطط التصدي لها في أكثر من موقع في رادارها الإقليمي.
لعل صناع القرار في طهران يقررون المماطلة والمراوغة وشراء الوقت أملاً في أن تؤدي المحاسبة الداخلية لدونالد ترامب إلى عزله عن السلطة. فهذا الرجل هو نقيض الرجل الذي كان قبله في البيت الأبيض، باراك أوباما، الذي وقع في عشق إيران وانصبّ على إرضائها. لعل طهران ترى أن مصلحتها تقتضي الانتظار إلى حين وضوح شتى المعارك في الوزارات الأميركية والبيت الأبيض بين صقور المحافظين الجدد وبين جنرالات محور الراشدين، آملة بانقضاض الصقور على الجنرالات. فكل شيء وارد في الولايات المتحدة. إنما منطقياً، حتى إذا أثبتت التحقيقات تورط دونالد ترامب مع روسيا بعلاقات مشبوهة وأدى ذلك إلى عزله، إن السياسة الأميركية الجديدة التي يتبناها نائب الرئيس ستبقى سارية. ثم إن العزل impeachment الذي بات كلمة سائدة على لسان الذين لا يفهمون عملية العزل، هو عملية معقدة وطويلة وتبريره ليس سهلاً إلا إذا وقع في خانة تهديد الأمن القومي الأميركي.
دونالد ترامب رئيس أميركي استقطب العداء مع الاستخبارات والإعلام وبات الاثنان متربصين له، ولذلك إنه في خطر. إنه في خطر لأنه أفضل أعداء نفسه، كونه مغروراً يرفض التأقلم والإقرار بالخطأ. أميركا منقسمة حقاً منذ عهد باراك أوباما، وهي أعمق انقساماً الآن، لكن الأميركيين لا يريدون لبلدهم الانهيار مهما كان. لذلك، تحرص الدول على استمرار التعامل مع إدارة ترامب بكل مهنية وجدية.
قمم الرياض أبهرت ترامب وكانت فعلاً تاريخية في أكثر من مكان ومجال. إنما واقع الأمر أنه لم يكن هناك خيار آخر لأن استعادة العلاقات الأميركية- السعودية هي في رأي الرياض العصب الأساسي لضمان الأمن القومي السعودي ولتنفيذ الرؤية التي اعتمدتها القيادة السعودية عنواناً لازدهارها.
الحياة
معركة روحاني هنا عندنا (إذا شاء)/ حازم صاغية
جُدّد انتخاب حسن روحاني رئيساً لإيران بعد أيّام قليلة على الضربة الجوّيّة الأميركيّة في المثلّث الحدوديّ السوريّ– العراقيّ– الأردنيّ.
بانتصار روحاني على ابراهيم رئيسي انتصر الخطّ الموصوف بالاعتدال على ذاك الموصوف بالتطرّف. انتصر من يؤيّده خاتمي ونزيلا الإقامة الجبريّة موسويّ وكرّوبي وشبّان المدن «الليبراليّون»على من يؤيّده «الحرس الثوريّ» و «الباسيج» والمؤسّسات العسكريّة والأمنيّة. انتصر من يراهن على اتّفاق مع العالم على من يراهن على القطيعة والعزلة. روحاني نفسه لم يقتصد في التعبير عن هذه المعاني. تتمّة الانتصار الكاسح كانت في بلديّة طهران: لائحة محسن هاشمي رفسنجاني فازت بكامل أعضائها.
التصعيد والضربة الجوّيّة الأميركيّان لم يزيدا الإيرانيّين تطرّفاً، على ما يبدو. لقد زاداهم تعقّلاً. هذه علامة صحّيّة. شعب إيران يكسر أحد «التقاليد» في منطقتنا من أنّ كراماتنا تُستنفر ضدّ الغريب وحده، فتلتفّ حول من يدوسها من أبناء جلدتنا. هذا الكسر سبق أن فعلته الثورات العربيّة.
سياسات التصعيد الأميركيّ حيال طهران، السابقة والحاليّة والمتوقّعة، لم تفعل ما كانت تفعله. هذه المرّة، مثلاً، بقيت الضربة الجوّيّة الأخيرة حدثاً عسكريّاً بعيداً، مع أنّها استهدفت موقع نفوذ استراتيجيّ تبنيه إيران، وبالتالي جسراً يصلها ببقية المشرق.
هدم هذا الجسر عمل مفيد، كائناً من كان الهادم. سبب ذلك أنّ إحكام الربط بين طهران وسائر المشرق خطر وجوديّ على الأخير وربّما على ما يتعدّاه.
هذا الجسر يعني، في الحدّ الأدنى، شيئين أيٌّ منهما كارثيّ، فكيف وقد جمعتهما رزمة واحدة:
– الحرب الأهليّة السنّيّة– الشيعيّة المفتوحة والعابرة للحدود الوطنيّة، والتي قد لا تبقى بقعة جغرافيّة في العالم الإسلاميّ بمنأى عنها. حرب كهذه ستصطبغ بمضامين ثقافيّة وقوميّة وإثنيّة واستقلاليّة في آن. يقظة العنصريّات المتبادلة لن ينافسها، والحال هذه، إلاّ حقول القتل.
– وضع المشرق العربيّ تحت رحمة الصراع على النفوذ الإقليميّ بين إيران وإسرائيل. الاحتمال النوويّ سيتمدّد فوق رؤوسنا.
بالعودة إلى روحاني (الذي قد يُوفَّق برحيل خامنئي في عهده الثاني)، فإنّ كلّ الاعتدال المنسوب إليه، والذي هو صحيح جزئيّاً، سيبقى بلا معنى ما لم يقترن بتصديع هذا المشروع الحربيّ الذي سيهدم إيران ويهدمنا معها. فمن دون انسحاباته التي بدأت بأفغانستان ووجدت تتويجها في ألمانيا، كانت بريسترويكا وغلاسنوست ميخائيل غورباتشوف لتكون عديمة المعنى. الشيء نفسه يصحّ في إضعاف الصلة بين موسكو والأحزاب الشيوعيّة التي وُظّفت أدواتٍ في مشاريع التوسّع السوفياتيّ. هذا ما يعادله، في حالة روحاني، أحزاب وشخصيّات دينيّة وطائفيّة معاً قد يكون أبرزها «حزب الله» اللبنانيّ من غير أن تقتصر عليه.
لقد عرّفنا الزميل مهنّد الحاج علي، في موقع «المدن» الإلكترونيّ، بواحد، مجرّد واحد، من هؤلاء الكثيرين: «الوجه الصاعد اليوم في العراق هو جمال جعفر محمد علي آل ابراهيم المُكنّى بـ «أبو مهدي المهندس»، نائب رئيس هيئة «الحشد الشعبيّ». يحمل المهندس السمات المطلوبة لمحظيي الإمبراطوريّة. يتحدث الفارسيّة بطلاقة، لا بل يتحوّل اسم عائلته إلى «ابراهيمي» في إيران. كان ناشطاً في خدمة الثورة الإيرانيّة منذ ثمانينات القرن الماضي، ودانته محكمة كويتيّة بالمشاركة في تفجير للحرس الثوريّ الإيرانيّ استهدف السفارتين الأميركيّة والفرنسيّة، وأودى بحياة 5 كويتيّين عام 1983، وفق صحيفة «نيويورك تايمز». وبعد سقوط نظام صدّام حسين، عاد إلى العراق حيث تبوّأ سلسلة مناصب وانتُخب في البرلمان العراقيّ. عام 2007، أثارت الإدارة الأميركيّة تاريخ «المهندس» مع الحكومة العراقيّة، فغادر إلى إيران».
«براءة» هذا «المجاهد»، على ما تدلّ سيرته، لا يحتملها مشروع روحاني. هذا إذا اختار فعلاً أن يكون له مشروع يستكمل ما بدأه ويوسّع نطاقه. وهذه، في أغلب الظنّ، رغبة أكثريّة الإيرانيّين التي صوّتت له لأنّها تريد أن تنكبّ على بلدها بدل التورّط «في لبنان وغزّة»، على ما جاء في شعارات «الثورة الخضراء» عام 2009.
هنا، في المشرق العربيّ، يكون الانتخاب الجدّيّ لروحاني أو يكون سقوطه. الاستجابة بالتصويت له بعد التصعيد والضربة الأميركيّين مؤشّر مشجّع. سنوات عهده الأوّل لم تكن كذلك.
الحياة
التحديات الأميركية لاحتواء إيران في سورية/ لينا الخطيب
حملت زيارة الرئيس دونالد ترامب الأخيرة للمملكة العربية السعودية وإسرائيل والمناطق الفلسطينية معها تصريحات متعددة حول دور إيران في رعاية الميليشيات في الشرق الأوسط، ما دفع طهران الى الرد من خلال الإشارة الى تدخلات في دول أخرى في المنطقة ولكن من دون دحض ما قاله ترامب حول رعاية إيران للميليشيات. وانتشرت هذه الرعاية على مدى السنوات الست الماضية بعد العراق ولبنان إلى اليمن وسورية، من بين أماكن أخرى.
يبقى أن نرى ما إذا كانت الولايات المتحدة ستبني على كلمات ترامب القوية ضد إيران فعلاً عملياً ضد ميليشياتها في سورية، ولكن إيران بدأت بالفعل في إعداد نفسها لمواجهة أي جهود من قبل الغرب لاحتوائها في هذا البلد. والطريقة التي تستخدمها إيران في سورية ليست جديدة. فهي تتطابق في شكل عام مع ما نفذته إيران في لبنان والعراق. إن استراتيجية إيران للسيطرة في كل من تلك الأماكن تدور حول زراعة النفوذ من الأسفل إلى الأعلى. وهذا ينطوي على احتمال استمرار عدم الاستقرار على المدى الطويل في سورية حتى لو تم التوصل إلى تسوية للصراع، وبالتالي يجب أن تشكل معالجة هذه الطريقة للسيطرة جزءاً من أي استراتيجية من قبل الولايات المتحدة تهدف إلى احتواء إيران.
كما هو الحال، فإن تركيز الولايات المتحدة في سورية لا يزال عسكرياً ويركز على المعركة ضد تنظيم «داعش». وبعد فترة من النشاط العسكري المتراجع في الجنوب، تجري الولايات المتحدة محادثات مع الأردن حول احتمال استخدام المناطق الجنوبية من سورية، حيث لا يزال وجود «داعش» محدوداً بالمقارنة مع مناطق أخرى بخاصة في شمال شرقي البلاد، كمنطلق لإطلاق حملة عسكرية تتحرك باتجاه الشمال لتحرير الرقة ودير الزور من سيطرة «داعش». وشهد جنوب سورية في الأسابيع الأخيرة نجاحاً لقوات «الجيش السوري الحر» المدعومة من الولايات المتحدة والأردن في وقف تقدم «داعش» بعد هجوم هذا التنظيم على قاعدة التنف حيث تقوم الولايات المتحدة بتدريب جماعات «الجيش الحر» استعداداً لمعركة دير الزور.
إن إعادة تفعيل عمليات «الجيش السوري الحر» في الجنوب هي أحد الأسباب الرئيسية للقلق بالنسبة إلى إيران، حيث أن التنف نقطة عبور حدودية سورية إلى العراق، حيث ترعى إيران ميليشيات من بينها قوات «الحشد الشعبي» التي تقاتل «داعش» حالياً في الموصل. وقد تقدمت الميليشيات المدعومة من إيران، بالتعاون مع الجيش السوري، نحو التنف في منتصف هذا الشهر، ما تسبب في ضرب طائرات أميركية من التحالف الدولي ضد «داعش» قافلة للدبابات الموالية للنظام. ومن المرجح أن يكون الدافع وراء تقدم القوات المؤيدة للنظام هو ربط المناطق التي يسيطر عليها بشار الأسد وحلفاؤه في سورية مع المناطق التي تسيطر عليها الميليشيات الموالية لإيران في العراق.
جاء هذا التقدم العسكري في وقت أعلن فيه بعض قادة «الحشد الشعبي» استعدادهم لدخول سورية من العراق بحجة تحرير الرقة من «داعش» بعد تحرير الموصل من التنظيم. ولكن ربط المناطق السورية والعراقية تحت مظلة إيرانية يعني إنشاء قوس من الوجود العسكري لإيران من شأنه أن يسمح لقواتها أن تغلق على الجماعات المسلحة المعارضة السورية من الشمال الشرقي وكذلك من الغرب، والذي هو في معظمه تحت سيطرة النظام. وهذا من شأنه أن يزيد من دفع المعارضين السوريين نحو التمركز في محافظة إدلب على الحدود التركية.
ولم تردع الضربة الأميركية القوات المؤيدة للنظام والتي تتألف من السوريين والإيرانيين ومقاتلي «حزب الله» الذين واصلوا تحريك صواريخ أرض- جو نحو الخطوط الأمامية مع «الجيش السوري الحر» في الشرق. وجاءت هذه الخطوة بعد وقت قصير من موافقة روسيا وإيران وكذلك تركيا ضمن محادثات آستانة على السماح لإيران بإنشاء مراكز مراقبة في ما يسمى «مناطق التصعيد» في سورية، بما في ذلك في إدلب والجنوب، تحت ذريعة تخليص هذه المناطق من «داعش» وغيره من الجماعات المتطرفة. وبعد عمليات نقل السكان التي طردت السكان السنّة من بلداتهم الأصلية بالقرب من الحدود اللبنانية إلى إدلب، ليحل محلهم السكان الشيعة الذين غادروا بلداتهم في إدلب للانتقال إلى المنطقة الحدودية، قام «حزب الله» أيضاً بسحب 3 آلاف مقاتل من المناطق السورية المتاخمة للبنان من أجل إعادة نشرهم في شرق سورية.
كل هذه التحركات التكتيكية التي تقوم بها إيران والجماعات التي ترعاها تقلق الولايات المتحدة وحلفاءها في شأن جدوى إنشاء أي نوع من المناطق الآمنة في جنوب سورية، حيث من الممكن أن إيران والنظام السوري لن يسمحا بتكوين هذه المناطق وتنفيذها، اذ يريان فيها تهديداً لمصالحهما الحيوية.
لكن هذه الديناميكية العسكرية ليست سوى جزء واحد من القصة. فالدينامية المهمة الأخرى تخص أعمال إيران داخل المناطق التي يسيطر عليها النظام. في وقت مبكر من الصراع السوري، استدعت إيران «حزب الله» لدعم نظام الأسد الذي كان بدأ يفقد قدرته في مواجهة ضغط «الجيش السوري الحر». وفي وقت لاحق، لم ترعَ إيران إنشاء ميليشيات موالية للنظام فحسب، لا سيما قوات الدفاع الوطني، لمواصلة القتال جنباً إلى جنب مع النظام، ولكنها استوردت أيضاً مرتزقة من أفغانستان ودول أخرى للمشاركة في الصراع، إضافة إلى إرسال قوات خاصة إلى سورية.
في حين أن معظم المقاتلين الأجانب قد يجبرون في نهاية المطاف على مغادرة سورية في حالة تسوية النزاع، فإن إيران لا تستطيع تحمل فقدان النفوذ في سورية لأن ذلك يعني قطع خط الإمداد لـ «حزب الله». فإيران، التي تزعم أن ميليشياتها تقوم بمكافحة «داعش» وجماعات التطرف، تهدف إلى أن يواصل «حزب الله» القيام بدور في سورية بصفة استشارية على المدى الطويل. كما أن الميليشيات التي تمولها إيران في سورية تستعد أيضاً للوجود على المدى الطويل. وقد أنشأ العديد منها منظمات غير حكومية كوسيلة لجذب السكان المقيمين في مناطق النظام التي يعملون فيها وللحصول على التمويل من خلال الحكومة السورية، بما في ذلك التمويل الأجنبي المخصص للمساعدات الإنسانية.
وتردد هذه الميليشيات والمنظمات المرتبطة بها النموذج الذي استخدمه «حزب الله» في لبنان الذي شهد تحول الجماعة من مجموعة عسكرية إلى حزب سياسي مع أجنحة اجتماعية واقتصادية وعسكرية. كما بدأت إيران شراء الأراضي في سورية وإجراء صفقات تجارية واستثمارية مع الدولة السورية بهدف إقامة وجود اقتصادي طويل الأجل في البلاد. ولكن كما هو الحال في لبنان، حيث انه في مصلحة «حزب الله» أن تبقى مؤسسات الدولة ضعيفة من أجل تبرير استمرار وجود مؤسسات الحزب الموازية، من المرجح أن تصبح الجماعات المدعومة من إيران في سورية سبباً لهشاشة الدولة على المدى البعيد.
إذا كانت الولايات المتحدة جادة في احتواء إيران في سورية، فإن التركيز على التكتيكات العسكرية الإيرانية وحدها في المعركة ضد «داعش» ليس كافياً. ما يثير قلقاً أوسع هو محاولة إيران التغلغل في سورية من أسفل إلى أعلى، الأمر الذي من شأنه أن يمكّن إيران من الحفاظ على النفوذ بغض النظر عن الشكل الذي قد تتخذه تسوية الصراع. وهذا يتطلب استراتيجية تتجاوز المسائل العسكرية وتراعي التغيرات المؤسسية والاجتماعية المهمة التي ترعاها إيران في مناطق النظام وليس التغيرات في مناطق المعارضة فقط.
* كاتبة لبنانية ورئيسة برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في معهد «تشاتام هاوس»، لندن
الحياة
عودة مظفرة للقوى الكبرى إلى الشرق الأوسط!/ د. بشير موسى نافع
واجهت الولايات المتحدة خلال العقد الأول من هذا القرن صعوبات كبيرة في ما أسمته إدارة بوش الابن «الحرب على الإرهاب» وتحولت إلى حرب شاملة على المشرق الإسلامي وشعوبه. الحرب التي بدأت بإطاحة حكم طالبان في أفغانستان، بحجة مواجهة تنظيم القاعدة، توسعت، شيئاً فشيئاً، لتطال العراق وفلسطين ولبنان واليمن وحدود باكستان الأفغانية. تعهد الأمريكيون الحرب مباشرة في بعض الأحيان، وتعهدها حلفاؤهم في أحيان أخرى. أوقعت الحرب خسائر فادحة بشعوب المشرق، وخسائر أخرى بالأمريكيين وحلفائهم، وانتهت بدون أن تحقق نتائج حاسمة. وكان طبيعياً، بالتالي، أن تتبنى إدارة أوباما مقاربة مختلفة، وأن تدشن انسحاباً ملموساً، وليس كلياً، على أية حال، من سياسة الحرب الشاملة والتدخل التي تبنتها إدارة بوش. في الوقت نفسه، وبالرغم من أن روسيا كانت تعيش حقبة انتعاش اقتصادي كبير بفعل ارتفاع أسعار موارد الطاقة، فقد أصبح أمن «الخارج القريب» الهم الرئيس لحكومة بوتين. توسع حلف الناتو الحثيث في وسط وشرق أوروبا، وسلسلة من الاضطرابات في وسط أسيا وشمال القوقاز، مثلت تحديات مباشرة لوضع روسيا الاستراتيجي ومحيطها الجيوسياسي؛ ولم يكن باستطاعة روسيا العودة إلى سياسة التدخل السوفياتية في الشرق الأوسط بينما هي مهددة في جوارها الحيوي.
في 2011، اندلعت سلسلة من الثورات العربية، التي كشفت عن وصول نظام ما بعد الحرب الأولى الإقليمي إلى نهاية الطريق، وعن مضي الشعوب العربية نحو تسلم مقاليد أمرها، بدون عقد ومرارات أو قطيعة مع العالم. لم تطلب الشعوب عوناً من القوى الدولية، ولا قبلت تدخلاً خارجياً في شأنها الداخلي. وبدا، بفعل تبلور أولويات مختلفة للولايات المتحدة روسيا، أن عصراً جديداً يولد في المشرق، عصر استقلال القرار ومبادرة دول المنطقة إلى حل قضاياها وخلافاتها بمعزل عن عبث القوى الكبرى. كانت تركيا تعيش نهضة اقتصادية وسياسية لافتة، وتعيد توكيد دورها على مسرح الإقليم والعالم؛ وهو ما وفر مثالاً لإمكانية النهوض والتجديد الذاتي واستقلال القرار. ولكن آمال السنوات الأخيرة من عقد القرن الأول والنصف الأول للعقد الثاني لم تعش طويلاً.
تحالفت دول عربية مع قوى النظام القديم في دول الثورات العربية، وأطلقت حراكاً مضاداً هائلاً وباهظ التكاليف، بداية من مصر، أكبر الدول العربية، والدولة التي جسدت عملية التحول الديمقراطي واستقلال القرار، ومن ثم تونس ولبيبا. وفي الوقت نفسه، تعهدت إيران مشروع الثورة العربية المضادة في سوريا والعراق، ومن ثم اليمن. ولكن الدور الإيراني في استدعاء الخارج كان أخطر بكثير من مجرد تقديم الدعم لنظامي الأسد والمالكي وللحوثيين. في محاولتها إيقاع الهزيمة بثورة الشعب السوري والحفاظ على نظام الأسد، رفضت إيران محاولات تركيا والسعودية وقطر (ومصر مرسي) التوصل إلى تفاهم إقليمي على مستقبل سوريا، ودفعت بحزب الله إلى قلب الساحة السورية. وعندما أصبح واضحاً أن الحزب لن يستطيع تحمل أعباء المواجهة مع الشعب وقوى المعارضة، استدعيت ميليشيات شيعية من العراق وباكستان وأفغانستان، وأخذت أعداد الضباط الإيرانيين في سوريا في التزايد. مع النصف الثاني من 2015، لم يعد ثمة شك أن حرب إيران وحلفائها ضد الشعب السوري في طريقها إلى الفشل. وهنا، قام الإيرانيون، بالتوافق مع نظام الأسد، بفتح أبواب سوريا للتدخل الروسي المباشر.
لم يكن التدخل الإيراني في سوريا هو المشكلة الوحيدة للسعودية ودول الخليج العربية. كانت حروب بوش بالغة الغباء في المشرق خلقت مناطق فراغ للقوة منذ 2001، عملت إيران، في اندفاعة متسرعة، على التوسع فيها. حاولت إيران تأسيس نفوذ لها في أفغانستان ما بعد طالبان؛ عملت، ولم تزل، على التحكم بدولة عراق ما بعد الغزو والاحتلال؛ دعمت حزب الله في سيطرته على قرار الدولة اللبنانية؛ وشجعت مشروع الحوثيين الغبي للسيطرة على اليمن. ما رأته الكتلة التي تقودها السعودية، وأغلبية الشعوب العربية، أن إيران تجاوزت حدود مصالحها المشروعة بكثير، وأن توظيفها السلاح الطائفي بات مصدر تهديد لاستقرار المنطقة ودولها. وبدأت، من ثم، معركة مواجهة مشروع التوسع الإيراني، ومحاولة تحريض الحليف الأمريكي التقليدي على خوض المعركة. لم يكن لدى إدارة أوباما الحماس أو الاستعداد للعودة إلى تعقيدات الساحة الشرق الأوسطية، وذاكرة خسائر الإدارة الأمريكية السابقة لم تزل حية. بتولي ترامب مسؤوليات الحكم في الولايات المتحدة، تنفس معسكر مواجهة إيران الصعداء. سبق لترامب أن عبر عن عداء لا يخفى لإيران وسياساتها أثناء الحملة الانتخابية الرئاسية، واختار عدداً من أبرز خصوم إيران لتولي حقائب الأمن القومي في إدارته. ولأن ترامب يحتاج دعماً مالياً خارجياً لبرامجه الاقتصادية في الولايات المتحدة، وقع التقاء المصالح المتوقع، وعادت الولايات المتحدة إلى الساحة الشرق أوسطية كما لم تعد من قبل. لم تستطع إيران، ولا استطاعت روسيا الانتصار في سوريا. حماية نظام الأسد من السقوط، لا يعني أن مستقبل النظام أصبح مؤمناً. ولكن إيران خسرت موقعها ودورها في سوريا، بعد أن أصبحت روسيا صاحب القرار، ولم يعد مستبعداً أن تقوم حتى بدفع إيران وميليشياتها خارج سوريا كلية. في الجانب الآخر، ليس هناك ما يوحي بأن العودة الأمريكية الاحتفالية للشرق الأوسط ستقدم الكثير لخصوم إيران العرب. لن تقود إدارة ترامب حرباً ضد إيران؛ وبالرغم من اللغة التي يستخدمها الرئيس الأمريكي، فإن التوسع الإيراني وصل مدة يجعل من الصعب التعامل معه بدون مواجهة فعلية. إن وقعت مثل هذه المواجهة، فعلى العرب أن يتحملوا العبء الأكبر. يرتكز النفوذ الإيراني في سوريا ولبنان والعراق والقطاع الحوثي من اليمن إلى قوى داخلية، قوى طائفية بالتأكيد، ولكنها تنتمي إلى شعوب هذه الدول؛ وهذا ما يجعل الملف الإيراني أكثر تعقيداً مما يمكن لإدارة ترامب تحمله. تحتاج مواجهة التوسع الإيراني نفساً طويلاً، أطول بكثير مما يمكن لواشنطن المثابرة عليه. بكلمة أخرى، وكما خسرت إيران من عودة روسيا إلى سوريا، فقد لا يكون مردود استثمار مئات المليارات من الدولارات في عودة الحليف الأمريكي إلى المنطقة بحجم أكثر توقعات العرب تواضعاً. هذه عودة مظفرة للقوى الكبرى إلى المشرق. في الفترة بين 2008 و2013، ولد أمل حقيقي في أن تصبح دول المشرق أكثر استقلالاً وأكثر قدرة على وقف تدخلات القوى الكبرى في شؤونها ومصير شعوبها. من يخمد هذا الأمل اليوم هو أنظمة حكم دول المشرق ذاتها؛ ليس فقط لأنها رفضت التوافق العقلاني على حل قضايا المنطقة وخلافاتها، ولكن أيضاً لأنها اختارت الانقلاب على طموحات الشعوب وسعيها إلى امتلاك مصيرها. ستعمل عودة القوى الكبرى إلى المشرق من جديد على تحقيق أهداف ومصالح واشنطن وموسكو، وليس أهداف ومصالح الأنظمة المشرقية الحاكمة. وإن كان هناك من أثر لهذا المتغير على أنظمة المشرق، فسيتجلى بالتأكيد في خسارة هذه الأنظمة لما تبقى من قدرتها على اتخاذ القرار، وعودة مصائرها إلى طاولة التفاوض ومساومات القوى الكبرى.
٭ كاتب وباحث عربي في التاريخ الحديث
القدس العربي
إيران وإرهابيوها في خندق واحد… ضد تحالف الرياض/ عبدالوهاب بدرخان
لم يسبق أن ارتبط اسم إيران بالإرهاب كما ارتبط في القمة الأميركية- العربية- الإسلامية في الرياض. ولم تكن هناك ملامح استراتيجية واضحة لمحاربة الإرهاب عسكرياً وفكرياً كما ظهرت بوادرها في الفرصة التي وفّرتها السعودية وأظهرت فيها استعداداً غير محدود لبذل كل ما تتطلّبه عودة الولايات المتحدة الى التزام ضمان أمن المنطقة، بدءاً بمحاربة جدّية للإرهاب وكذلك الحدّ من الجموح الإيراني. ولم يكن الفارق واضحاً بين توجّهات ادارتَين أميركيتَين متعاقبتَين كما أبرزته القمم الثلاث في الرياض، فالإدارة السابقة أمّنت تغطية لنهج التخريب الإيراني ودعت العرب وبالأخص دول الخليج الى قبول نتائجه والبناء عليها، أما الإدارة الحالية فلا يبدو، على الأقلّ، أنها في صدد تجاهل ما عملت عليه إيران من تعطيل للدول والحكومات، ومن تفكيك للجيوش والمؤسسات لمصلحة ميليشياتها، ومن تمزيق لنسائج المجتمعات لتغليب فئات مذهبية على فئات أخرى.
يُحسب للحدث السعودي أنه يبلور وعياً جديداً لظاهرة الإرهاب ورؤية شاملة لما يمكن أن تكون عليه أي استراتيجية لمحاربته حاضراً ومستقبلاً. كما أنه استطاع أن يسلّط الضوء على حتمية الشراكة إقليمياً ودولياً في المواجهة مع هذا الوباء الذي هزّ العقول والضمائر، ولم تعد هناك دولة قادرة على الاعتقاد أنها بمنأى عنه. ولعل هذا الحدث شكّل أيضاً إنذاراً أخيراً للدول التي اعتقدت أن تمويل الجماعات الإرهابية أو المتاجرة معها أو تقديم تسهيلات لها يمكن أن تحقّق لها مصلحةً ما في خلافاتها مع دول أخرى. فحكومات العالم الإسلامي تعلّمت الكثير من مراقبتها ومعايشتها ما آلت اليه أفغانستان، لكنها رُوِّعت مما شاهدته في سورية والعراق من التحامٍ وتبادل أدوار بين الاستبداد والإرهاب ومن توظيف للدين الإسلامي في خدمة التطرّف والإجرام.
لا شك في أن «الشراكة» المطروحة ولدت من الخلاصة التي أمكن التوصّل اليها، وهي أن التنظيمات الإرهابية ليست فقط «جماعات لا دول» وإنما دول ترعى جماعات وتحرّكها. لم تنجح المحاولات لحصر هوية تنظيم «داعش» أو لحلّ ألغازه أو لتفسير ظهوره ثم اختفائه المفاجئَين في مناطق متفرّقة من سورية والعراق بعيداً من مواقع تمركزه الرئيسية، إذ لا تعرفه سوى الأجهزة والمراجع التي صنّعته واستثمرت فيه من دون أن تكون معنيّة بمصيره بل بأجنداتها. وتكفي الإشارة الى استحالة إدارة المناطق التي يُطرد منها للدلالة الى أنه يخلف وراءه وضعاً تستطيع مراجعه استغلاله، سواء بالعودة الإيرانية عبر ميليشيات «الحشد الشعبي» الى الموصل أو بمشاريع عبور «الحشد» الحدود من العراق الى سورية، حتى لكأن «داعش» مُكِّن من الانتشار في «الدولة» المزعومة ليصار بعدئذ الى دفع الميليشيات الإيرانية لضربه ثم دحره منها.
ستحمل الشراكة بموجب قمة الرياض اسم «تحالف الشرق الأوسط» ومهمته الإسهام في تحقيق السلم والأمن، أما نواته فأصبح مفهوماً أنها تضم السعودية ومصر والأردن والإمارات، ويُفترض أن تنضم دول أخرى إليه في غضون الشهور المقبلة. سيكون هناك مسار مكمّل أو موازٍ لهذه الشراكة من خلال استعداد عدد من الدول الإسلامية المشاركة في «التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب» لتوفير «قوة احتياط قوامها 34 ألف جندي لدعم العمليات ضد المنظمات الإرهابية في العراق وسورية عند الحاجة». أما المسار الثالث المكمّل أيضاً فيتمثّل باتفاق التعاون لمكافحة تمويل الإرهاب الذي باتت دول مجلس التعاون الخليجي موقّعة عليه على أن تليها دول أخرى. يبقى المسار الرابع الذي سيتولّاه «المركز العالمي لمواجهة الفكر المتطرّف» (اعتدال) في الرياض وسيشمل عمله رصداً وتحليلاً للمضمون في المواقع ووسائل التواصل والإعلام الرقمي ومن ثَمَّ استخلاص ما تقتضي مواجهته.
كان أكثر ما يستوقف في القمة الأميركية- العربية- الإسلامية ذلك التوافق بين الملك سلمان بن عبدالعزيز والرئيس دونالد ترامب في توصيف «مرجعية الإرهاب». إذ كانا واضحَين ومباشَرين، فالعاهل السعودي اعتبر النظام الإيراني «رأس حربة الإرهاب العالمي منذ ثورة الخميني حتى اليوم» وأنه رفض مبادرات حسن الجوار «التي قدّمتها دولنا» الى أن قال: «فاض بنا الكيل من ممارساتها العدوانية وتدخلاتها كما شاهدنا في اليمن وغيرها من دول المنطقة». أما الرئيس الأميركي فاتهم إيران بتمويل الإرهابيين والميليشيات وتسليحهم وتدريبهم، واعتبرها «مسؤولة عن زعزعة الاستقرار في لبنان والعراق واليمن، كما أن تدخلاتها في سورية «واضحة للغاية، فبسبب إيران ارتكب الأسد الجرائم بحق شعبه»… وما لبث البيان الختامي للقمة أن ترجم هذه اللهجة غير المسبوقة بالدعوة الى نبذ الأجندات الطائفية والمذهبية والتصدّي لها و «لتداعياتها الخطيرة على أمن المنطقة والعالم»، وكذلك بالتزام قادة دول القمة «مواجهة أنشطة إيران التخريبية والهدّامة بكل حزم وصرامة داخل دولهم وعبر التنسيق المشترك»… وعلى الهامش كان التعليل الرسمي لعدم دعوة إيران وسورية الى القمة أنهما «راعيتان للإرهاب».
من الواضح أن قطبَي القمة لم يتوقفا عند إعادة انتخاب حسن روحاني رئيساً لإيران، فالمتوقّع هو المزيد من الشيء نفسه سواء كان المنتخَب اصلاحياً أو محافظاً، لذا أطلق الملك سلمان والرئيس ترامب أقوى الرسائل وأكثرها صراحة الى نظام طهران، لكنهما سجّلا التفاتة تجاه الشعب الإيراني. ولا شك في أن هذا الشعب عبّر عن موقفه في الحيّز المتاح له، ومع إدراكه أن المرشد هو مَن يحكم في كل الأحوال إلا أنه يخوض معركته الداخلية الطويلة بتصميمٍ وصبرٍ وعناد. بالنسبة الى كثيرين كانت النتيجة التي حققها روحاني مشابهة إنْ لم تكن حتى أقلّ من تلك التي أحرزها مير حسين موسوي في 2009 عندما تلاعبت السلطة بالنتائج للإبقاء على محمود أحمدي نجاد في الرئاسة باعتباره مرشح المرشد و «الحرس الثوري». قد يكون التلاعب تعذّر هذه المرّة بسبب ازدياد حدّة الانقسام، والأرجح أيضاً لأن المرشد و «الحرس» استنتجا أن روحاني يلعب اللعبة من دون أن يزعجهما، فمنذ انتخابه للمرّة الأولى في 2013 حصلت أسوأ التدخّلات في سورية والعراق واليمن، ودافع عنها، ولم يستطع القيام بأي مبادرة ذات صدقية تجاه الجوار الخليجي. وبناءً على مخرجات قمة الرياض لم يعد ممكناً توقّع أي حوار خليجي- إيراني هادف قبل أن تتغيّر التوازنات على أرض الواقع.
لعل الأضواء التي سلّطتها قمة الرياض على ارتباط الإرهاب بإيران أسقطت عنها آخر الأقنعة، بما في ذلك إسقاط ادّعاءاتها بمواجهة ذلك الإرهاب وترشيحها نفسها شريكاً حتميّاً في الحرب عليه. ومع انكشاف الحقيقة أخيراً، لأن في الولايات المتحدة إدارة غير معنيّة بالتستّر على ما يدين إيران، فإن الأخيرة يمكن أن تشعر بالتحرّر من قيود فرضتها عليها سابقاً ضرورات تمويه الأدوار. إذ كان يُفترض أن تفضي إدارتها للإرهاب الى ربطه بالسعودية وحلفائها وتشويه صورتهم دولياً، ثم الى استمالة أميركا- اوباما للقضاء عليه ولن تجد غير إيران وميليشياتها شريكاً قوياً وجاهزاً على أرض المعركة. وكان محسوباً أيضاً أن دمى إيران في دمشق وبغداد وصنعاء هي التي ستنتصر وأن المساحات التي انتشر فيها «داعش» ستقع في أيدي اتباع إيران لتكمل رسم «الهلال الفارسي».
هذه الخطة مرشحة لأن تنقلب على واضعيها، فعدا إجهاض مشروع إيران في اليمن انكشفت هيمنتها على العراق لتصبح عبئاً عليه، ثم أن حساباتها لدى تسليم الموصل الى «داعش» باتت تصطدم بالحسابات الأميركية لما بعد تحريرها. كما أن استعانتها بروسيا لدعم خططها قنّنت عملياً طموحاتها في سورية. ومع اقتراب معركة تحرير الرقة ودير الزور ارتسم خط أميركي أحمر يمنع على الميليشيات اختراق الحدود العراقية الى سورية، من التنف أو من سواها. وطالما أن سلاح الإرهاب الذي استثمرت فيه إيران لمدّ نفوذها أصبح مكشوفاً، وتريد أميركا ضربه لتقليم أظافرها وفرض التراجع عليها، فقد تجد إيران أن اللحظة حانت لإعادة هيكلة تنظيماتها وميليشياتها وترتيب أنشطتها، إذ أصبحت وإياها في خندق واحد ضد تحالف الرياض.
* كاتب وصحافي لبناني
الحياة
العرب وإيران وإسرائيل: عدو عدوي ليس صديقي/ حسان حيدر
الافتراض القائل أن العرب مستعدون للتنازل في خصوص التسوية مع إسرائيل لأنهم منشغلون بمواجهة التدخلات الإيرانية في شؤونهم، ثبت خطأه خلال قمم الرياض الأخيرة التي شهدت تأكيد التمسك العربي بمبادرتها للعام 2002، أي صيغة الأرض في مقابل السلام وحلّ الدولتين.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب رأى خلال زيارته إسرائيل «فرصة نادرة لتحقيق الأمن والاستقرار وإحلال السلام، عبر هزيمة الإرهاب»، ومن خلال «إدراك العرب والإسرائيليين أن لديهم قضية مشتركة في التهديد الذي تمثله إيران». ومع أنه وعد بتقديم «مبادرة سلام» بين الفلسطينيين وإسرائيل في غضون أسابيع، إلا أن ما تسرب عن مقاربته، على ندرته، يشير الى أنها حلّ «بالتجزئة» يمهد تدريجاً لإبرام تسوية «بالجملة».
من الواضح أن مفهوم ترامب للتسوية يقوم على «معالجة الأخطار الأكثر تهديداً» بما يتيح الوصول الى تلك «الأقل خطراً». وهو هنا يقدم تقييماً مختلفاً لأزمات الشرق الأوسط عمن سبقوه الى البيت الأبيض، بدءاً من النزاع العربي – الإسرائيلي، مروراً بالتهديد الإرهابي والتطرف، ووصولاً الى التدخلات الخارجية، وخصوصاً الإيرانية، في شؤون دول المنطقة العربية، ويعيد كذلك ترتيب الأولويات للوصول الى ما يصفه بـ «الصفقة الكبرى».
وهو يختلف في ذلك تماماً عن باراك أوباما الذي بدأ عهده بتأكيده للعالم الإسلامي أن قضية فلسطين هي لب مشكلة الشرق الأوسط وأن إيجاد حل لها أو وضعها على سكة الحل سيسهل التعامل مع الملفات الأخرى في المنطقة وبينها إيران والتطرف، قبل أن يعلن يأسه من القدرة على إيجاد حل بين تل أبيب ورام الله، ويتوقف عن أي جهد في هذا الخصوص منذ العام 2014.
لكن أوباما حاول في المقابل أن يعوض فشله في الملف الفلسطيني بـ «نجاح» في الملف الإيراني، ولهذا قدم كل التنازلات الممكنة لطهران من أجل إبرام اتفاق معها حول ملفها النووي، ما شكل دفعاً قوياً لسياسة النظام الإيراني القائمة على تحصيل ما أمكن من أميركا والغرب، والتدخل ما أمكن في الجوار الاقليمي. و «اضطُر» أوباما الى مسايرة هذه المعادلة الإيرانية لأن هاجسه كان أيضاً تحقيق ما يمكن تحقيقه قبل انتهاء ولايته الثانية، ولو على حساب المصالح الأميركية البعيدة المدى وحلفاء الولايات المتحدة.
وعلى رغم أن وصول ترامب الى الرئاسة عنى البدء في عكس هذا التوجه، إلا أن الثابت حتى الآن، بالنسبة الى العالم العربي، هو وجود مسارين منفصلين: مواجهة إيران والسعي الى تحقيق تسوية عادلة للقضية الفلسطينية، لأن الخلط بين الأمرين أو الربط بينهما قد يخلق أوهاماً غير مبررة، ويفتح الباب أمام مناورات لا تسهل تحقيق تقدم في أي منهما.
ويجب أن لا ننسى أن إسرائيل استغلت الى أقصى الحدود الخطاب الدعائي الإيراني الذي يتحدث عن «إزالة الكيان الصهيوني»، والحرب التي شنها «حزب الله» في 2006 لأغراض لا علاقة لها بفلسطين، كي تتنصل من أي تسوية مع الفلسطينيين، وتتهرب من ملاقاة المبادرة العربية.
ولا بد من التذكير أيضاً بأن عداء إيران المفترض لإسرائيل يتخذ من حقوق الفلسطينيين حجة لمواصلة تغلغلها في المنطقة، وأن إسرائيل أعطت بعدوانيتها ورفضها الاعتراف بالحقوق الفلسطينية الذرائع لإيران لاستمرار التخريب على السياسة الجماعية العربية. ولذا من الضروري الفصل بين الملفين والمسارين، لأن تداخلهما يصبّ في مصلحة إيران وإسرائيل كلتيهما.
الحياة
مفهوم ظريف للتدخل الخارجي/ إيمان القويفلي
يُحدّد وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، في مقالته “مستعدون لإهداء السلام إلى المنطقة” في “العربي الجديد” (20/5/2017)، الدول الإقليمية التي تعاني من التدخلات الخارجية بأنها العراق وأفغانستان وليبيا، ودول أخرى لم يُسمّها تعاني من تدخلات “بعض دول المنطقة”، بهدف قمع تطلعها إلى الديموقراطية، وبثّ الفرقة ونشر حالة عدم الاستقرار وإراقة الدماء. ومن الواضح أن مفهوم “التدخلات الخارجية” في المقالة يتحدّد ضمنياً بالتدخلات الأميركية وقوات حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وهذا ينطبق على حالة العراق وأفغانستان وليبيا، والتدخلات العربية في الدول التي مرت بتجربة الثورة والثورة المضادة، مع مراعاة أن ظريف لا يقصد كلّ الدول الداخلة عملياً في هذا التصنيف، بل يقصد دولاً محددة، أما ما يحدث في سورية واليمن والبحرين، فيعوّمه ظريف عبر وصفهِ بـ”الأزمات المزمنة”. والأزمة، كما هو دارج، حالة معقدة يصعب عزل عاملٍ واحدٍ فيها عن باقي العوامل، وهو توصيفٌ يقف على الضد تماماً من وضوح وتحديد توصيفه المشكلة في المجموعة الأولى من الدول.
في الأوقات العادية، كانت الدولة العربية تلجأ إلى رفع شعار “لا للتدخلات الخارجية” من أجل التحصين السياسيّ للديكتاتور، ريثما يُنجز مهمة الفتك بالمعارضة الداخلية أو تغيير وجه البلاد، أو انتهاك حقوق المواطنين. في الأوقات غير العادية، كما هو الحال منذ عام 2011، عندما تتحوّل الدولة العربية الهشة التي لا تحمل مشروعاً سوى مشروع التوريث إلى جبهة مفتوحة لكل القوى الإقليمية والدولية، يتحول رفض التدخلات الخارجية إلى أسلوبٍ لحصر الحقّ في التدخل الخارجي في جهةٍ بعينها ولصالح جهةٍ بعينها.
عندما بلغت الثورة السورية أوجها، وكانت على وشك إطاحة الأسد عام 2011، كان خطاب ظريف ومُعسكره مبنياً على رفض التدخل الخارجي الذي لم تكن تعني بهِ سوى تدخل المجتمع الدولي لصالح الثورة، أو من أجل توفير حماية للمدن والمدنيين من طيران الأسد، لم يكن رفض التدخل الخارجي ينطبق على التدخل الإيراني في سورية، ولاحقاً اتّضح أنه لا ينطبق على التدخل الروسي، ولاحقاً توسع التسامح مع التدخل الخارجي ليشمل حتى الشيطان الأكبر، الولايات المتحدة، عندما قادت التحالف الدولي ضد “داعش”، والذي نفذ، ولا يزال ينفذ،
“بدا مقال ظريف مُنبتّاً عن السياق، ومُتمسكاً بنسختهِ الخاصة من الواقع، وغير مُستعد حتى للخوض والجدال في مناطق الخلاف العربي – الإيراني” ضرباته الجوية في سورية والعراق، ويمارس “التدخل الخارجي” كروتينٍ يوميّ مقبول بالنسبة لمعسكر ظريف، فقبول التدخل الخارجي، أو رفضه، بالنسبة له، رهنٌ باتجاهه، فالتدخل لصالح بقاء الأسد عملٌ “من أجل السلام ووقف الإرهاب”، كما يزعم ظريف في مقاله، أما التدخل لصالح حماية الشعب فجريمة وانتهاك للسيادة.
والمُثير، في هذا المنطق، أنه، وعلى الجبهات المفتوحة، حيث يتدخّل الجميع، لا تعود المشكلة في وجود التدخل الخارجي، بل إلى الافتقار إلى التدخل الخارجي في الاتجاه الصحيح، ومن أجل الغاية الصحيحة، ولحماية الأطراف الأضعف، ولوقف المجازر والتهجير والجرائم الإنسانية، وهو ما كشفت الثورة في سورية عن فشلٍ دوليّ ذريع عملياً وأخلاقياً، في القيام به. أما بالنسبة للـمُتدخّلين، فمن الطبيعي والضروري أن يزعم كلّ منهم أن تدخلهُ كان جالباً للسلام ومحارباً للإرهاب، تماماً كما يزعم ظريف في مقالته بشأن التدخل الإيراني في الدول العربية. والطريف أنهُ لا يجد من يشهد له بهذا سوى مسؤولي الولايات المتحدة، الـمُتدخل الخارجيّ الأكبر في المنطقة.
يزعم ظريف، في مقالته، رفض الهيمنة، والإرهاب، والتدخلات الخارجية، لكنهُ يساوم في المقالة على صناعة السلام في المنطقة، وهي مساومةٌ لا قيمة لها ولا معنى، ما لم تكن إيران فاعلة على كل هذه المستويات، ومُتدخلةً في الشؤون الداخلية للدول، وتحاول أن تُهيمن على المنطقة، وداعمة لإرهاب المليشيات والأنظمة بالفعل، ويقول إن “مشروع القنبلة النووية وهم”، لكنه لا يفسر لماذا تحملت إيران سنواتٍ طويلة من العقوبات الدولية، من أجل تمسّكها المستميت بذلك “الوهم”. ويقول إن “التخويف من إيران مشروعٌ صهيوني”، على الرغم من أنهُ في حقيقتهِ مشروعٌ إيراني.
ما كان المقال ليكون غريباً لو كان منشوراً في صحيفة أميركية ليُخاطب المجال السياسيّ الغربي، غير الـمُستغرق أو غير المعنيّ بشؤون المنطقة العربية. لكن، بما أنهُ منشورٌ في صحيفة عربية، وليُخاطب المجال العربي، فقد بدا مُنبتّاً عن السياق، ومُتمسكاً بنسختهِ الخاصة من الواقع، وغير مُستعد حتى للخوض والجدال في مناطق الخلاف العربي – الإيراني، وهو ما يضرب، بصورة جذرية، عرض السلام والحوار الدبلوماسي الذي يُفترض أن المقال مكتوبٌ لطرحه.
العربي الجديد
الولي الفقيه مرشداً ورئيساً!/ محمد قواص
لا يبدو أن العالم كان مهتماً هذه المرة بما يمكن أن تحمله الانتخابات الرئاسية الإيرانية، ولم يكن يبدو أن للعواصم الكبرى مرشحاً مفضّلاً لرئاسة البلاد، وأن التجديد لحسن روحاني أو انتخاب خصمه إبراهيم رئيسي أصبح بالنسبة لهذا العالم لا يعدو كونه تمريناً شكلياً لا يغير من أداء النظام السياسي في طهران.
ولا يبدو أن العالم بعد فوز روحاني يقارب الرجل بصفته صنفاً آخر يختلف عن قماشة الولي الفقيه وحرسه الثوري. ولئن تعرّف المجتمع الدولي أثناء مفاوضات الخمس زائداً واحداً مع طهران على مناخ رئيس الجمهورية «المعتدل» وأداء وزير خارجيته محمد جواد ظريفي «المبتسم»، فإن التيار الإصلاحي المفترض أن روحاني يمثّله لم يجرؤ على اتخاذ مواقف تتباين عن السياسات الاستراتيجية الكبرى التي يشرف عليها المرشد علي خامنئي.
لم يسمح النظام السياسي الإيراني لمحمود أحمدي نجاد، الرئيس الإيراني السابق لولايتين والذي كان يمثل المحافظين والحرس والمرشد، بالترشح في الانتخابات الأخيرة. وبغضّ النظر عن ضعف حظوظ نجاد بالفوز، فإن «الدولة العميقة» أرادت لهذا السباق أن يجرى بين رئيسي المحافظ تاريخياً والذي تبوأ مواقع تدافع عن التشدد منذ الأيام الأولى لقيام الجمهورية الإسلامية، وروحاني الذي لم ينتم إلى التيار الإصلاحي يوماً ولا يمكن اعتباره ركناً أصيلاً من أركان الاعتدال الإيراني، وإن تقدم منذ ترشحه لولايته الأولى تحت هذه الصفة.
أعاد الإيرانيون انتخاب روحاني بغالبية مريحة. اعتبر الرئيس الفائز أن انتخابه يعكس رغبة الإيرانيين في «التوافق مع العالم». ولا ريب أن ذلك صحيح وأن المجتمع الإيراني توّاق لمصالحة هذا العالم والقطع مع سطوة الخطاب الخشبي الذي يصدح في سمائه. ولا شك في أن الناخب الإيراني بعث برسائل سبق أن أرسلها، فأتى برفسنجاني يوماً وبخاتمي يوماً آخر وخرج إلى الشوارع عام 2009 دفاعاً عن خياراته من دون أن يُحدث ذلك أي تبدل طفيف على سلوك الحاكم في إيران.
يوحي روحاني بأنه يمثل الاعتدال، لكن صلاحياته لا تمكّنه من تجاوز تيار التشدد. بيد أن المراقب يلاحظ بسهولة تطابق رؤية الرئاسة ومؤسسة المرشد في كافة السلوكيات التي تعاديها دول المنطقة. فلم يصدر عن روحاني ما يتناقض مع فلسفة الولي الفقيه في الانخراط المباشر في الدفاع عن نظام الأسد في دمشق، أو في توطيد السيطرة على النظام الحاكم في بغداد، أو في دعم الحوثيين في اليمن أو في رفد «حزب الله» في لبنان بكل ما يعوزه من مال وسلاح وديبلوماسية وأيديولوجيا.
تحاصر طهران رموز الإصلاح داخل السجون وبالإقامة الجبرية، فيما تطلق يد الرئيس «المعتدل الإصلاحي» حسن روحاني وتتيح له تولي رئاسة البلاد لولاية ثانية، وتقدم الأمر بصفته ثمرة معركة انتخابية مصطنعة بين محافظين ومعتدلين كشفت المناظرات التلفزيونية خواءها.
شن المرشحون المحافظون، قبل أن ينحصر أمرهم بإبراهيم رئيسي، حملة ضد أداء حكومة الرئيس المرشح الإنمائية والاقتصادية. تبادل المرشحان اتهامات الفساد والتلويح بكشف ملفات من دون أن يصدر عن روحاني، للدفاع عن حكومته، أي تساؤل (وليس اتهاماً) عن مصير الثروات الإيرانية التي يتم تبذيرها على ورش الحرس الثوري في ميادين المنطقة.
كان صوت الناخب الإيراني في أن «إيران أولاً» أقوى من صوت مرشحه الفائز. وبدا أن روحاني، الرئيس في ولايته الجديدة، بات مكلفاً، وفق شروط الفوز، بتولي شن الهجمات على قمم الرياض الثلاث مع الرئيس الاميركي دونالد ترامب واعتبارها «استعراضية»، ليستدرك لاحقاً، على رغم «استعراضية» نتائجها أن «لا استقرار للمنطقة من دون إيران».
تدرك طهران بجدية انتهاء «مواسمها». ولئن لمّح الرئيس الأميركي إلى أن ما بعد قمم الرياض يختلف عما قبلها، فإن طهران للمفارقة تدرك ذلك أيضاً. تراقب إيران تحوّلاً دولياً إقليمياً يجوّف طموحها الإمبراطوري وينهي سيطرتها على أربع عواصم عربية، وفق ما بشّر علي يونسي الذي للمفارقة كان يشغل منصب مستشار الرئيس «المعتدل» حسن روحاني.
وقد لا يكون صدفة أن تقويض النفوذ الإيراني في المنطقة يجرى متوازياً ومتواكباً مع اجتثاث تنظيم «داعش» من المنطقة ذاتها. تبدو العلاقة حميمة بين التطرفين السني والشيعي اللذين يتبادلان المصالح والخدمات، ويبدو أن القضاء الجاري على تنظيم البغدادي لا يستقيم، كما أملت طهران، مع ازدهار نظام ولاية الفقيه.
قد تكون الانتخابات الرئاسية تفصيلاً إيرانياً، وقد يكون فوز روحاني بالرئاسة وفوز الإصلاحيين بالانتخابات المحلية شأناً داخلياً صرفاً. وقد تمثل حيثيات الحدث مزاجاً اجتماعياً في إيران، لكنها تكشف من دون شك مأزق ولاية الفقيه عقيدة ومؤسسة واستراتيجية، وتكشف أيضاً انسداد أفق الاستمرار في التذاكي على المنظومتين الاقليمية والدولية لشراء البقاء في شكل مجاني. ولا ريب أن تفاصيل أخرى قد تميط اللثام عن سرّ التجديد لروحاني، ذلك أن المرشد أراده قبل أربع سنوات جسراً للعبور نحو الاتفاق النووي، وقد لا نفاجأ بأنه أراده هذه المرة لرسم خريطة طريق مضنية للنزول عن شجرة ارتفعت نهاياتها.
نجحت قمم الرياض الثلاث في إرساء إجماع يدين السلوك الإيراني. بمعنى آخر، فإن العالميْن العربي والاسلامي يبتعدان نهائياً عن خيارات طهران على نحو يقلق إيران ويدفع وزير خارجية لبنان جبران باسيل، المتحالف مع «حزب الله»، إلى التغريد: «لم نكن نعلم». بدا واضحاً أن التهاني التي صدرت عن عواصم أوروبية لروحاني بالفوز باتت تطالب طهران بتغيير سلوكها وفق الرؤى التي يفرضها خطاب ترامب وكامل إدارته. وأن ما يفترض أنه تباين بين أوروبا وواشنطن حول مصير الاتفاق النووي يميل نحو الخضوع للقواعد التي أرستها قمم الرياض.
ربما مثّل روحاني في ولايته الأولى عبقاً سياسياً مختلفاً عن تيارات التشدد في إيران، لكنه في ولايته الجديدة لا يمثل أي اعتدال بل يمثل إرادة الولي الفقيه في موقعَي المرشد والرئاسة، ذلك أن النظام السياسي برمته، في اعتداله وتشدده، بات خارج مزاج العصر.
الحياة
من نجاد إلى روحاني: دعم الأسد في سوريا من ثوابت السياسة الخارجية لطهران/ رائد الحامد ووائل عصام
تتفق كل التيارات أو الأجنحة في إسرائيل، كما هي في إيران، على التنافس في خدمة الاستراتيجية القومية الثابتة لدولهم، لذلك لا يعني الكثير فوز تيار الإصلاح في إيران على منافسه التيار المحافظ في رسم الاستراتيجيات في التعاطي مع الملفات العالقة والأزمات التي تشهدها بلدان الشرق العربي، التي تشكل إيران العامل الأقوى في تأجيجها أو اخمادها حين ترى ما يحقق مصلحة مشروعها الذي لم يعد خافيا على أحد، والذي يتجسد بشكل واقعي ليس مهما ان وصفه قائد عصائب أهل الحق قيس الخزعلي المبايع للمرشد الإيراني الأعلى بانه لم يعد هلالا شيعيا انما بدرا شيعيا مكتملا، وتشكل سوريا الجزء الغربي منه بشواطئها المطلة على البحر الأبيض المتوسط. في قمم ترامب الثلاث شدد الخطاب العام على وجود خطر إيراني وان دعم طهران لنظام الرئيس السوري بشار الأسد شجع الأخير على ممارسته انتهاكات جسيمة ضد مئات آلاف السوريين. وأبعد من ذلك شمل اعلان الرياض لنتائج القمم الثلاث تشكيل قوة احتياط من 34 ألف مقاتل من دول عربية وإسلامية مؤطرة تحت مسمى «التحالف الإسلامي» بأهداف معلنة للحرب على الإرهاب دون الإشارة إلى إيران صراحة، لكن إشارات ترامب حددت أربعة مسميات شملها توصيف الإرهاب وهي تنظيم الدولة والقاعدة وحزب الله اللبناني وحماس فلسطين، مع تكرار الحديث عن التدخل الإيراني الضار في بلدان المنطقة.
في واقع ما نرى، قد لا نشهد متغيرات مثيرة في خريطة الصراع السوري المقولب مُنذ ست سنوات سواء كان الإصلاحيون هم من يمسك رأس السلطة أو المحافظون. كانت بدايات الانخراط الإيراني في الصراع السوري إبان حكم أحمدي نجاد المحافظ لنحو عامين أعقبه حسن روحاني لأربعة أعوام تم التجديد له مرة ثانية هذه الأيام لأربع سنوات مقبلة.
ولم تكن إيران تعلن بوضوح عن تدخلها في سوريا بشكل مباشر طيلة فترة حكم أحمدي نجاد المحافظ، ومع مجيء الإصلاحي حسن روحاني في 2013 بات الحديث عن الملف السوري جزءا من أولويات السياسة الإيرانية. كما ان دول العالم أصبحت أكثر قبولا باشراك إيران في ترتيب أوضاع سوريا ما بعد انتهاء الصراع المسلح.
وستظل الولايات المتحدة والدول العربية الحليفة تحاول تحدي التدخلات الإيرانية في الملفات المشتركة والأزمات في بلدان ذات اهتمام مشترك مثل العراق وسوريا واليمن.
تخضع التيارات السياسية التي تصل إلى سدة الرئاسة في إيران لسلطات المرشد الأعلى علي خامنئي الرجل الأقوى القادر على وضع أسس التوازنات وضبطها في مؤسسات الدولة الإيرانية وسياساتها الداخلية واستراتيجياتها الخارجية مع هامش مناورة يتحرك فيه الرؤساء ضمن السقف المحدد.
بعد فوز الرئيس روحاني جدد موقفه الداعم للرئيس السوري بشار الأسد في الحرب على «الإرهاب» في سوريا، كما أبرق الرئيس السوري مهنئا روحاني بفوزه لمرة ثانية بمنصب الرئيس في «تجديد لثقة الشعب الإيراني به لمواصلة تعزيز المواقف الإيرانية ودورها» مع التأكيد على مواصلة العمل المشترك والتعاون بين البلدين «لتعزيز الأمن والاستقرار في سوريا وايران والمنطقة والعالم».
أرسلت إيران مُنذ بداية الصراع السوري مئات أو آلاف المستشارين والمقاتلين من الحرس الثوري ودعمت عشرات الميليشيات الشيعية العراقية والأفغانية وغيرها إضافة إلى حزب الله اللبناني للقتال إلى جانب قوات النظام سواء في عهد الرئيس المحافظ احمدي نجاد أو الرئيس الإصلاحي حسن روحاني في دورته الرئاسية الأولى والثانية، وتشير تقديرات إلى مقتل اكثر من 2100 إيراني مُنذ اندلاع الصراع السوري في 2011.
وأدى استمرار الدعم الإيراني للنظام السوري إلى الحفاظ على وجوده، قبل ان تعصف بها موجة الاقتتالات الداخلية وتبني الأجندات الخارجية لبعض الدول على حساب مصلحة الثورة.
وتزامن فوز حسن روحاني مع جولة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في المنطقة وتشديده على التدخلات الإيرانية ودعم جماعات إرهابية ومتطرفة مثل حزب الله اللبناني، لكن الانشغال بنتائج الانتخابات والترتيبات المرافقة لها لم تشغل الرئيس روحاني عن تبني موقف رافض للموقف الأمريكي ومؤيد لحزب الله متهما أمريكا بانها هي من ترعى التطرف والإرهاب.
وفي أول مؤتمر صحافي له أكد روحاني على تجديد دعمه لحزب الله اللبناني المنخرط في الصراع السوري رافضا وصف الرئيس الأمريكي له بالإرهاب ومؤكدا على ان طهران ستظل تلعب دورا دبلوماسيا وعسكريا في مجمل الصراعات الإقليمية كما ستواصل عملها في العراق وسوريا وهو خلاف ما توقعه مراقبون باحتمالات ان تبدي إيران موقفا أكثر ليونة على الأقل في خطابها الإعلامي مقابل التصعيد الأمريكي العربي ضد الأدوار الإيرانية.
لذلك لا يبدو ان التجديد لحسن روحاني بالتزامن مع الموقف الأمريكي والشركاء ضد إيران واتهامها برعاية الإرهاب سيكون له أي اثر على السياسات الخارجية لإيران وعلى الدور المباشر الذي تلعبه في الملف السوري بشقيه العسكري من خلال دعم النظام والقوات الحليفة، وفي الشق السياسي من خلال كونها الدولة الثالثة إلى جانب روسيا وتركيا في رعاية اتفاقات استانة لتثبيت وقف اطلاق النار وخفض التصعيد تمهيدا للوصول إلى وقف كامل الأعمال العدائية بين قوات النظام والمعارضة المسلحة.
لكن ثمة متغير ما في خطاب روحاني وهو خطابه القديم الجديد بان عسكرة الحل في سوريا لن تؤدي إلى إحلال السلام، ومع متغيرات في توازن القوى على الأرض يمكن التعويل قليلا على تغليب أولويات الحل السياسي طالما ان قوات النظام باتت تسيطر على المدن والمناطق ذات الأهمية الاستراتيجية لمصلحة بقاء النظام ورعاية المصالح الروسية وتأمين المشروع الإيراني في الوصول إلى شواطئ البحر الأبيض المتوسط مرورا بالعراق الذي تهيمن فصائل الحشد الشعبي الحليف لإيران على أجزاء واسعة من محافظة نينوى ونفوذ وسيطرة شبه كاملة في غرب الأنبار على الطريق بين بغداد ودمشق.
القدس العربي
أوهام ظريف عن السلام/ بدر الراشد
غالبا ما واجه الإيرانيون التصعيد الأميركي ضدهم بتصعيد مقابل، ضد أميركا بصورة مباشرة، أو ضد دول مجلس التعاون الخليجي، خصوصاً أن طهران تملك كثيراً من أوراق اللعب والمساومات التي تجعل الوصول إلى نقطة الإنفجار مع الولايات المتحدة مؤجلة دائما، خشية الدخول في مواجهةٍ محسومة سلفاً لمصلحة الطرف الأقوى.
أكثر ما يثير الانتباه في مقال وزير الخارجية الإيرانية محمد جواد ظريف “مستعدون لإهداء السلام إلى المنطقة” في “العربي الجديد” (20 مايو/أيار الماضي)، أنه يجدّد تأكيد حصاد إيران لسياسات أميركا المضطربة في المنطقة، بعد أحداث سبتمبر/ أيلول 2001، من خلال اعتبار دور إيران في أفغانستان والعراق إيجابيا. أي في الدول التي احتلتها الولايات المتحدة العقد الماضي.
وكأن ظريف يريد أن يقول إن ما تزرعه أميركا تحصده إيران، على الرغم من أن الأوضاع ما زالت كارثية في هذين البلدين، فأفغانستان مضطربة، وشبح “طالبان” يحوم في أجوائها. أما العراق، فعدد المليشيات الإرهابية فيه أكبر من أن يحصى.
فالنماذج “البراقة” التي يطرحها ظريف للتعاون في مواجهة الإرهاب تظهر فشلاً إيرانياً ذريعاً في صناعة الاستقرار، وأن طهران نفسها طرفٌ في زراعة الإرهاب في المنطقة، ولم تحصد مما زُرع العقد الماضي، إلا الأعاصير.
تتطابق تجربة إيران في المنطقة مع تجربة المنظمات الإرهابية، مثل القاعدة وتنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، التي لا تنمو ولا تترعرع إلا في أجواء انهيارات الدول، والخلافات الطائفية، وغياب المجال السياسي، والتحول إلى سياقات مسلحة بالكامل. فإيران تتوسع عبر المليشيات، وعبر الطائفية، وهذان نقيضان للدولة، الأمر الذي فعلته المنظمات الإرهابية في العراق وسورية، وحاولت فعله في الخليج بالتسلل عبر العمليات الطائفية التي استهدفت مساجد الكويت والسعودية في 2014 و2015.
وهنا يأتي السؤال، أيّ معنى للسلام في حديث ظريف؟ وسيكون الجواب قطعا أنه مجرد لغو، يردّده الإيرانيون توازيا مع محاولاتهم مد نفوذهم في هذه الدولة، أو صناعة مليشيا جديدة في تلك.
موقف السعودية من إيران أوضح من موقف إيران تجاه المملكة، فالرياض عندما تتحدّث عن “علاقات حسن الجوار” لا تموّل مليشيات تضرب الداخل الإيراني. كما أن موقفها الأكثر وضوحا، والذي كرّره وزير الخارجية عادل الجبير، يؤكد على “علاقات إيجابية مع الشعب الإيراني” والاستعداد لعلاقات أفضل “حال توقف إيران عن زعزعة استقرار المنطقة”، فمطالب الرياض أكثر تحديداً ووضحاً.
لا يمكن الحديث عن تفاهماتٍ، في ظل تورط إيران الدامي في العراق وسورية، ودعمها مليشيات في اليمن ولبنان. لم تقم إيران بأي خطوة إيجابية تجاه الخليج منذ هيمنتها على العراق، وخوضها حرباً أهلية فيه. وبدلاً من التفاهم مع جيرانها لنزع فتيل أزمتها النووية، ذهبت إلى التفاهم مباشرة مع الولايات المتحدة في عهد الرئيس الأميركي باراك أوباما الذي كانت مقاربته للملف الإيراني مختلفة.
اليوم تلوم إيران دول مجلس التعاون الخليجي، ودولاً عربية وإسلامية، على السير باتجاه عزلها، بالتعاون مع الولايات المتحدة، الطرف الذي تجاهلت إيران المنطقة، وذهبت إلى التفاهم معه في أزمة الاتفاق النووي.
لا يوجد أحد في المنطقة، خصوصا في الرياض، يرغب بمواجهة مباشرة مع إيران. وحديث وسائل الإعلام الإيرانية أن “أميركا لن تحارب إيران نيابة عن الخليج” محض لغو، فلا يريد ولا يتوقع أحد، أن تحارب أميركا إيران في منطقةٍ غير مستقرة بقدر منطقتنا.
يتعلق الأمر كله بإعادة الاستقرار للدول التي انهارت فجأة في المشرق العربي، وتلك التي أصبحت أشباه دول، من العراق وسورية إلى لبنان واليمن. الأمر الذي لا يحدث إلا من خلال مواجهة إيران في تلك الدول، والتوحد على رؤية واحدة في المنطقة، ضمن تفاهماتٍ مع قوى دولية بالتأكيد.
العربي الجديد
صراع إيراني أمريكي للسيطرة على الحدود العراقية السورية
بغداد – عمر الجنابي – الخليج أونلاين
على وقع المعارك التي تشهدها مدينة الموصل منذ أكثر من 7 أشهر، تشهد الحدود العراقية السورية الممتدة عبر صحراء الأنبار وصولاً إلى مدينة الموصل، سباقاً وصراعاً محتدمين بين القوات الأمريكية من جهة ومليشيا الحشد الشعبي من جهة أخرى، وذلك للسيطرة عليها.
مليشيا الحشد الشعبي (شيعية) وبعملية خاطفة وسريعة تمكنت من تحرير مدينة القيروان العراقية، غرب مدينة الموصل (400كم شمال غرب بغداد)، وإعلانها السيطرة على الحدود العراقية السورية وإغلاقها بوجه تنظيم “داعش”.
وقال المتحدث الرسمي باسم هيئة الحشد الشعبي، النائب أحمد الأسدي، في تصريح صحفي: إنّ “أكثر من 10 مناطق تم تحريرها في جزيرة غرب محافظة نينوى التي تشكل عمقاً استراتيجياً لداعش”، لافتاً إلى أنّ “مدينة القيروان تشكل محطة وسطية بين الحدود السورية وشرق وشمال نينوى، وبتحريرها تكون القوات قد اقتربت من الحدود السورية”.
وأضاف: إنّ “القيروان مدينة استراتيجية مهمة، والسيطرة عليها تمهد لغلق الحدود السورية أمام عناصر داعش وإنهاء جيوبه”.
من جهته، قال مصدر مقرب من مليشيا الحشد، فضل عدم الإفصاح عن اسمه: إنّ “انطلاق معركة القيروان المحاذية للحدود السورية، وإعلان تحريرها بهذه السرعة، يوازيها تقدم فصائل الحشد الأخرى الموجودة في سوريا نحو الشريط الحدودي بين العراق وسوريا، جاءت نتيجة تنسيق عالٍ بين قادة فصائل الحشد؛ وذلك لإحكام السيطرة على الشريط الحدودي من الجانبين”.
وأشار المصدر، في حديث لمراسل “الخليج أونلاين”، “إلى أن الهدف من ذلك ليس قطع إمدادات داعش القادمة من سوريا إلى مدينة الموصل فقط، وإنما لتأمين طريق بري من إيران مروراً بالعراق إلى سوريا، لا سيما بعد سيطرة القوات الأمريكية على الحدود السورية مع محافظة الأنبار”.
وأشار إلى أنّ “قادة الحشد لم يستبعدوا فرضية المواجهة مع القوات الأمريكية، التي ترفض بشدة وجود فصائل الحشد الشعبي على الشريط الحدودي بين العراق وسوريا”.
وكان نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي، أبو مهدي المهندس، قد قال في حديث صحفي: إن “حرب الحدود قد تدفع بالحشد نحو سوريا”، كما تحدث عن احتمالية الاشتباك مع القوات الأمريكية.
من جانبه، قال القيادي في الحشد الشعبي وزعيم مليشيا بدر، هادي العامري، في تصريح صحفي سابق: إن “معركة الحدود مستمرة بوتيرة متصاعدة، وإننا أطلقنا عليها تسمية (معركة الحدود)؛ لأننا نعتقد أنه بالسيطرة على الحدود ممكن أن نضمن أمن العراق”.
وأضاف: إنّ “معركة الحدود هي معركة معقدة”، مدعياً بقاء الحدود العراقية تحت سيطرة وحماية فصائل الحشد الشعبي.
صراع السيطرة على الحدود بين الولايات الأمريكية من جهة ومليشيات الحشد الشعبي التي تعلن ولاءها لإيران، ليست عسكرية فحسب وإنما تحمل أبعاداً سياسية وتوسعية في المنطقة، بحسب ما يراه مراقبون في الشأن العراقي.
وقال المحلل السياسي جاسم المشهداني، في حديث لمراسل “الخليج أونلاين”: إنّ “إيران وبعد سيطرتها على العراق وبشكل تام، لا سيما المناطق الشمالية والغربية التي كانت تشكل عائقاً أمام أطماعها التوسعية في المنطقة؛ لكونها مناطق ذات غالبية سنية، باتت تنظر إلى ضرورة سيطرتها على الحدود العراقية السورية عبر مليشياتها في العراق وسوريا؛ وذلك لإعلانها الهلال الشيعي الذي تحدثت عنه كثيراً بشكل رسمي”.
وأضاف: إنّ “بوادر الصراع بين إيران التي تسعى لإيجاد طريق بري بينها وبين حليفتها سوريا عبر العراق، وبين الولايات المتحدة الأمريكية التي تعمل على منع سيطرة المليشيات الموالية لإيران على الشريط الحدودي بأي ثمن، بدأت تتصاعد”، متوقعاً أنّ “تكون الحدود العراقية الميدان الجديد للصراع الأمريكي الإيراني في العراق”.
وكان ناشطون قد تداولوا على مواقع التواصل الاجتماعي، الأسبوع الماضي، تسجيلاً مصوراً يظهر لحظات استهداف طائرات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، رتلاً عسكرياً لمليشيا شيعية عراقية، تقاتل إلى جانب قوات الأسد، خلال محاولتها التقدم إلى معبر التنف الحدودي للعراق الذي يتخذه التحالف الدولي قاعدة عسكرية.
تقويض نفوذ طهران في سورية/ جوش روجن
على رغم تردد الإدارة الأميركية في التورط في الحرب الأهلية السورية، تجد واشنطن نفسها في معركة محتدمة في جنوب البلاد أدت الأسبوع الماضي إلى اشتباك بين قوات أميركية وقوات موالية للنظام السوري تدعمها إيران. وإذا انتهز الفرصة السانحة، في وسع الرئيس الأميركي توجيه ضربة إلى النفوذ الإيراني الإقليمي والمساهمة في إنقاذ سورية. وتصريحات إدارته توحي بأن ضربة التحالف الدولي في 18 الشهر الجاري على مقربة من قاعدة التنف على الحدود السورية مع الأردن والعراق هي ضربة يتيمة لن تتكرر. ولكن الاشتباك على مقربة من التنف ليس حادثة معزولة. فوفق مسؤولين وخبراء وقادة معارضين ميدانيين، ثمة مواجهة في تلك المنطقة تتسارع وتيرتها رداً على هجوم ميليشيات تدعمها إيران. فهذه تسعى إلى بسط نفوذها الاستراتيجي على أراض في سورية لتشق ممراً يمتد من لبنان وسورية عبر بغداد إلى طهران.
وإذا أفلحت إيران في مسعاها، غيرت الموازين الأمنية في المنطقة رأساً على عقب، وقوضت مكافحة «داعش» في دير الزور ومساعي أميركا لتدريب قوات سنّية عربية وتسليحها. ودور مثل هذه القوات حيوي في إرساء استقرار طويل الأمد. وخلاصة القول إن أميركا لا يسعها تجنب هذه المعركة، وعليها أن تخوضها. فهي الجسر إلى بلوغ ما ترمي إليه الإدارة الأميركية: الرد على التوسع الإيراني والعدوانية الإيرانية.
ولكن البيت الأبيض لا يرى، إلى اليوم، الأمور على هذا المنوال. فقرار ضرب قوات النظام وقوات تدعمها إيران الأسبوع الماضي، اتخذه قادة عسكريون ميدانيون. فهؤلاء القادة يملكون صلاحية توجيه ضربة أينما واجهت القوات الأميركية خطراً، يقول مسؤول أميركي. وعلى رغم أن السياسة الأميركية على حالها في سورية، غيّرت الضربات هذه حسابات طهران. ويرى الباحث في معهد الشرق الأوسط، شارلز ليستر، أن الضربة استهدفت ميليشيات «كتائب الإمام علي»، التي يدعمها الحرس الثوري. وبعد الضربة، أعلنت وكالة «فارس» أن إيران سترسل 3000 مقاتل من «حزب الله» إلى منطقة التنف «للتصدي للمخطط الأميركي». ويقول قائد معارض سوري يعمل مع القوات الأميركية إن الإيرانيين يقودون الحملة ضد النفوذ الأميركي، ويشرفون على خليط من قوات النظام السوري والميليشيات والقوات الإيرانية في منطقة التنف. وتتصدر أولوياتهم السيطرة على مثلث أمني يطلق يدهم بين بلدات شرق سورية في تدمر ودير الزور وبغداد. ويرمي الإيرانيون كذلك إلى الحؤول دون تقدم المعارضين السوريين الذين تدعمهم أميركا نحو دير الزور. وفتحت مجموعتان سوريتان معارضتان جبهة ضد القوات التي تدعمها إيران قبل أسبوع رداً على العمليات الإيرانية. وإحدى المجموعتين تعمل مباشرة مع القوات الأميركية، والثانية يدعم عملياتها العسكرية مركز الـ «سي آي أي» والحلفاء في الأردن.
وتحسب مجموعات المعارضة السورية أن واشنطن تدعمها ضمناً للحؤول دون سيطرة إيران والنظام السوري على المنطقة. وهذا الحسبان ساهم في رص صفوف المجموعات المعارضة المقاتلة. ويلاحظ مؤيدو المعارضة السورية في واشنطن انعطافاً في مقاربة واشنطن مواجهة إيران في سورية. ويبدو أن ترامب يتجه في سورية- ولو كان الاتجاه هذا غير مقصود- إلى سياسة أكثر تشدداً مع إيران ونظام الأسد، وبدأ الانعطاف هذا يخلف آثاراً ميدانية ملموسة. ومعركة جنوب سورية بدأت، وعلى الإدارة الأميركية حسم أمرها والبت في ما إذا كانت أميركا ستلعب دوراً بارزاً هناك أم لا.
* معلق، عن «واشنطن بوست» الاميركية، 21/5/2017، إعداد منال نحاس
الحياة
مسار ممر إيران إلى المتوسط يتغير/ مارتن شولوف
غيرت طهران وجهة أو مسار ممر بري إيراني كان من المفترض أن يصلها بسواحل المتوسط 140 ميلاً الى الجنوب لتفادي القوات الأميركية المتجمعة في شمال شرقي سورية لمحاربة «داعش». وهذا التغيير يأتي، إثر تعاظم مخاوف مسؤولين عراقيين وإيرانيين من تعاظم المرابطة العسكرية الأميركية في شمال شرقي سورية. ويبدو أن مسار الممر القديم صار متعذراً. وسيعبر الممر الجديد بلدة الميادين التي يحتلها اليوم «داعش»، في شرق سورية لتفادي المرور في شمال شرقي سورية الكردي، والمنطقة هذه كان القادة الإيرانيون يعتبرون أنها حلقة حيوية في ممرهم إلى المتوسط. وأمر بالتغييرات هذه الجنرال قاسم سليماني، قائد فيلق القدس، وحيدر العامري، زعيم «جبهة الحشد الشعبي» في العراق. ومقاتلو «الحشد» يقتربون من بلدة باعج العراقية، وهي حلقة بارزة من حلقات مشروع الطريق الإيرانية إلى المتوسط، وهي كانت مقر أبو بكر البغدادي في شطر راجح من السنوات الثلاث الأخيرة.
وقبل الحرب على «داعش» الإرهابي وفي خلالها، كانت إيران تسعى الى إرساء مناطق نفوذ لها في العراق وسورية. ولكن حين بدا أن وجه المشروع هذا ارتسم، ساهمت فصول النزاع السوري في تعذر ضمان أمن هذا الممر. والحشد الأميركي في شمال شرقي سورية أقلق بغداد وطهران. وأبلغ مسؤول عراقي بارز هذه الصحيفة أن القادة الإيرانيين يرون أن تعاظم الوجود الأميركي هناك يرمي الى ردع الطموحات الإيرانية. «لذا، يسرِّع الإيرانيون وتيرة فتح الممر (لبديل) في أقرب وقت». وهذا يقتضي تحرير باعج على وجه السرعة ثم طرد «داعش» من الميادين ودير الزور قبل وصول الأميركيين اليهما. وبرزت أهمية باعج مع بلوغ الحرب على «داعش» في العراق مراحلها الأخيرة. ومع تطويق القوات العراقية والجيش العراقي الموصل، بدأت الميليشيات الشيعية التي رابطت في تل عفر في الأشهر السبعة الأخيرة، ثاني أكبر مدينة في شمال غربي العراق، التقدم في الأيام الاخيرة الى أطراف باعج وصارت بعيدة منها 3 كلم فحسب.
ويقول مراقبون إن مقاتلي «داعش» يدافعون عن المدينة دفاعاً شرساً، وهي كانت معقل المقــــاتلين «الجهاديين» منذ اجتياح العراق قبل 14 عامـاً. وسقوط باعج يوجه ضربة أليمة الى التنظيــــم، فتتقلص رقعته في العراق، ويتقهقر إلى مناطق في الأنبار. ومع خسارة «داعش» الأرض في العراق، تتجه الأنظار الى الفصل الأخير في هذه الحرب: السعي الى السيطرة على معاقله في سورية، أي الرقة ودير الزور. ولم تتضـــح بعـــد بنية القوات التي ستسترجع المــدينتين، في وقت يواصل الأميركيون دعم القـــوات الكردية لتعاسة الأتراك – وهؤلاء يدعمون وحدات عربية للدخول الى الرقة ودير الزور.
والتزاحم السياسي في ساحات المعارك السورية فاقم تعقيد مشروع إيران، وحمل طهران على تغيير مسار أبرز أهدافها الطويلة الأمد. وكان الممر البري يعبر من الحدود الإيرانية إلى جلولاء في محافظة ديالى، ومن جنوب الموصل الى تل عفر. ولكن الإستدارة الى الغرب وتجاوز سنجار، ألقيا بالقوات الإيرانية ووكلائها في مرمى قتال «داعش». وصارت هذه تسعى الى ضرب عصفورين بحجر: المشاركة في الحرب على «داعش» وإرساء أركان الممر الجديد. وتقود الميليشيات الشيعية -وإيران توجه دفتها- المشروع، وهو عزز نفوذ أقليات تحمي مناطق على طريق الممر الإيراني. فمقاتلو «حزب العمال الكردستاني» قدموا من تركيا، ولعبوا دوراً بارزاً في تأمين شطر من الطريق يعبر جبل سنجار الى الحدود السورية، ولكن تغيير مسار الممر نقله الى الجنوب.
ويقول مسؤولون عراقيون إن الطريق الجديدة تمتد من دير الزور الى السخنة ومنها الى تدمر ثم دمشق ومنها الى الحدود اللبنانية، حيث يعزز نفوذ «حزب الله» من طريق التبادل (التقايض) السكاني. ومن الحدود هذه يعبر الممر من اللاذقية الى البحر المتوسط، فتحوز طهران طريق إمداد في منأى من مياه الخليج حيث الرقابة مشددة.
* مراسل، عن “ذي غارديان” البريطانية، 16/5/2017، إعداد منال نحاس.
الحياة
طهران وتمويل مواجهة المعارضة السورية المسلحة/ نورمان بايلي
يرجح أن طهران تنفق على الحرب السورية ما يساوي قيمة عجز الموازنة الإيرانية، أي 9.3 بليون دولار سنوياً. وأرى أن توسيع إيران إنفاقها العسكري وثيق الصلة بالطموحات الصينية والروسية الجغرافية السياسية والمخاوف الإيرانية والصينية والروسية. والنظام الإيـــراني يرجح كفة طموحاته في سورية على كفة حاجات الاقتصاد الإيراني الداخلية. فطهران تقلص الإنفاق على التنمية الى ثلث المستوى المحدد في مشروع الموازنة. وهي باعت من النفط الخام ما قيمته نحو 29 بليون دولار فــي الأشهر التسعة الأخيرة من العام الماضي. وعائدات الحكومة من النفط بلغت 11 بليون دولار، أي ما قيمته 70 في المئة من التوقعات الرسمية، وعائدات الـضرائب بلغت 17.2 بليون دولار، أي أدنى بـ15 في المئة من التوقعات.
والفوضى في نظام إيران المالي تحول دون مراكمة الحكومة عجزاً أكبر في المالية العامة. والمصرف المركزي الإيراني يقدر الــعجر بـ9.3 بليون دولار، أي أكثر بقليل من 2 في المئة من الناتج المحلي. وهذه نسبة غير مرتفعة في الظروف العادية. ولكن هذا الرقم لا يشمل فواتير الحكومة الضخمة وغير المسددة. ووفق تقرير صندوق النقد الدولي في شباط (فبراير) المنصرم، الحكومة مدينة للنظام المصرفي الإيراني بمتأخرات نسبتها 10.2 في المئة من الناتج المحلي. وكتب المبعوث الإيراني الى الصندوق هـــــذا، جعفر مجرد، أن نسبــــة الدين العام الإيراني الى الناتج المحلي تعاظمت من 12 في المئة الى 42 في المئة في 2015-2016. ويعود التعاظم هذا في معظمه الى الإقرار الحكومي بالمتأخرات هذه والسندات المالية، ويتوقع أن تنخفض نسبة الدين العــام الى الناتج المحلي الى 35 في المئة في 2016-2017 والى 29 في المئة في 2018. ولكنها قد ترتفع الى 40 في المئة من الناتج المحلي، إثر الإقرار بمجمل متأخرات الحكومة والسندات والأوراق المالية الصادرة لرسملة المصارف. فالبنوك الإيرانية تملك كمية كبيرة من الديون السامة، وهذه الكمية تقتضي إصدار الحكومة سندات إضافية لرسملة هذه الديون من جديد. وترى الصحافة الإيرانية أن الأصول السامة تبلغ 45 في المئة من ديون المصارف الإيرانية.
فالنظام المالي الإيراني هو صنو ثقب أسود، وطهران عاجزة عن تمويل متأخراتها، وإعادة رسملة المصارف المفلسة، وتمويل عجز كبير في الموازنة، في آن واحد. ولا تمس الحاجة الى إرساء بنى تحتية مالية جديدة فحسب، فهذه الحاجة وجودية وحيوية. وأزمة المياه في إيران تهدد بإفراغ مدن من سكانها ونزوح ملايين من الإيرانيين، وهم مزارعون على وجه التحديد يستهلكون أكثر من تسعة أعشار (90 في المئة) موارد المياه. وعلى رغم دعوة علماء البيئة في إيران الحكومة الى التحرك لجبه هذا التحدي، قلصت الحكومة الإنفاق على البنى التحتية الى ثلثي الحاجة اليه في السنة الضريبية الأخيرة.
ولا شك في أن الحرس الثوري له اليد الطولى في المحفظة الإيرانية العامة. وهو لا يتوانى عن سفك الدماء، وبلغت أعداد قتلى القوات الإيرانية في سورية 473 إيرانياً على الأقل، و583 أفغانياً و135 باكستانياً و1268 مقاتلاً شيعياً من العراق. ويقدر عدد قتلى «حزب الله» بـ1700 مقاتل على أقل تقدير. وقوات الحرس الثوري الأجنبية مؤلفة من متطوعين من أفغانستان وباكستان، وميليشيا «الفاطميون» التي تجند اللاجئين الأفغان من الشيعة الهزارة- وعدد مقاتليها (الميليشيا هذه) يتراوح من 12 الى 14 ألف مقاتل، ينتشر منهم في سورية حوالى 4 آلاف مقاتل. والإيرانيون يمسكون بمقاليد ميليشيا «زينبيون» المؤلفة من مقاتلين باكستانيين، و1500 منهم يقاتلون في سورية. وعدد قتلى روسيا في سورية يقتصر على 28 قتيلاً. فالصفقة الروسية مع إيران رابحة، على رغم عدد قتلى الحرس الثوري المرتفع. ووراء إقدام إيران على سفك هذا القدر من الدماء، عوض الإنفاق على حاجات داخلية ماسة، طابع النظام الإيراني المتطرف وهشاشة المجتمع الإيراني (40 في المئة من الشباب عاطلون من العمل) من جهة، والاعتماد الكبير على الصين وروسيا، من جهة أخرى.
ومنذ 2010، تضاعف الاستيراد الصيني النفطي من إيران، واستدارت بكين الى روسيا في شراء النفط، وارتفعت مشترياتها النفطية منها من 5 في المئة الى 15 في المئة من مجمل المشتريات الصينية النفطية. وتستورد طهران ربع السلع المستوردة من الصين. ويتوقع أن تستفيد إيران من موقعها الجغرافي في وسط طريق الحرير الصيني، «حزام واحد، طريق واحد».
وتخشى موسكو وبكين انبثاق مقاتلين سنّة من حطام العراق وسورية وليبيا. وتشير كريستينا لين الى أن الخبراء الروس والصينيين رأوا أن المقاربة الأميركية لتغيير النظام في سورية هي مسعى لزعزعة استقرار روسيا والصين. وتخشى بكين عودةَ آلاف المقاتلين الأويغور الصينيين الذين التحقوا بمجموعات مقاتلة سنّية في سورية – وعناصر في «الحزب التركستاني الإسلامي» حازوا صواريخ مضادة للمدرعات والمقاتلات الجوية واشتروا طائرات «درون» لتسجيل الهجمات الانتحارية على الجيش السوري- (وتخشى) وما يترتب على تمويل عربي لإسلاميين سنّة قد يزعزعون الاستقرار في جنوب شرق آسيا. وثمة محور روسي – صيني يبصر النور في آسيا يمتد من تايلندا الى تركيا. وشجعت موسكو وبكين على عسكرة الحزام الشيعي الممتد من لبنان عبر سورية الى إيران وأفغانستان. فالمسلمون الصينيون سنّة، شأن 90 في المئة من المسلمين الروس.
والحق يقال إن إيران هي أكثر الدول الممولة للإرهاب، ولكنها لا تمول ضرباً من الإرهاب تخشاه موسكو وبكين. وليس الحرس الثوري الإيراني قوة سياسية واقتصادية مهيمنة في إيران فحسب، بل هو ورقة تفاوض أساسية في صفقات السلاح والنفط بين طهران وموسكو بكين. وإمداد إيران ووكلائها الشيعة في لبنان والعراق وأفغانستان وباكستان بالسلاح لا ينقطع من أجل ترجيح المصالح الصينية والروسية في سورية والعراق. ويعود الفضل الى الدعم الاقتصادي الصيني في مواصلة إيران حملاتها العسكرية مواصلةً كانت قدرات اقتصادها الداخلي المفلس والمهمل لتعجز عن تحملها.
* باحـث، مستشار اقتصادي بارز، عن «إيجيا تايمز» الهونكونغية، 14/3/2017، إعداد منال نحاس.
الحياة
عن رسائل ظريف وسياسات إيران/ مروان قبلان
يوحي عنوان المقالة التي نشرها وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، في “العربي الجديد” (20 مايو/أيار الجاري) “مستعدون لإهداء السلام إلى المنطقة” بأمرين: اشتماله على اعترافٍ ضمني بأن إيران تنشر الخراب والدمار في أرجاء المنطقة، وإلا كيف يمكن فهم عرضها “إهداءنا السلام”، لولا أنها تصنع الحرب؟ والإيحاء الضمني بإمكانية إجراء مقايضة لتغيير هذا السلوك. إذا ابتلعنا كل شكوكنا وهواجسنا، وقرّرنا تلقف مبادرة الوزير ظريف، وأخذها على محمل الجد، نجد أنفسنا أمام سؤال كبير بشأن قدرة “الواقعيين” الذين تمثلهم إدارة الرئيس الإيراني، حسن روحاني، على تجاوز سيطرة المرشد والحرس الثوري على سياسة إيران الخارجية، والدخول من ثم في هذا النوع من المقايضات الكبرى (Grand Bargains) مع جيرانهم العرب، على غرار مقايضة البرنامج النووي.
لكن، قبل الوصول إلى هذه النقطة، هناك مقدمات ينبغي الوقوف عندها وتوضيحها، حتى لا يكون لبس بشأن ما بعدها. أولها، أن العرب والإيرانيين محكومون “بحتمية” جغرافية، لا يد لهم فيها، لكنهم ليسوا محكومين بالضرورة بحتمية صراع أزلي، نتيجة أوهام الهيمنة التي ملأت بعض الرؤوس الفارغة إلا من بعض الأساطير التاريخية والأحلام الإمبراطورية، خصوصا بعد أن بينت السنوات الأخيرة عدم قدرة أي طرفٍ على إلحاق هزيمة كاملة بالآخر.
ثانياً، على الرغم من أصواتٍ هامشية “نشاز”، وعلى الرغم من كل ما فعلته وتفعله إيران في عموم المشرق العربي، هناك رفض عربي، لا بل وخليجي، واسع، على مستوى الشعوب والنخب، للحديث، أي حديث، عن “تحالف” أو “تعاون” عربي مع إسرائيل لمواجهة إيران، علماً أن الأخيرة استعانت بأسلحة إسرائيلية لمواجهة العراق خلال حرب الثماني سنوات (فضيحة إيران- كونترا). فوق ذلك، هناك وعي مطلق بأن إسرائيل تستثمر الخوف العربي من سياسات التغوّل الإيرانية لدفع العرب إلى القبول بها، كما تستغل الصراع العربي- الإيراني لإضعاف الطرفين، وتكريس هيمنتها على المنطقة، وإيران من خلال سياساتها إنما تخدم الأجندة الإسرائيلية، وتسهّل مهمتها.
ثالثاً، كما نريد العيش بسلام وأمان، وتعزيز جهدنا لمواجهة تحديات التنمية ومحدودية الموارد والتغيرات البيئية والمناخية التي تمثل التهديدات الكبرى التي تواجه دولنا ومجتمعاتنا، نريد لإيران الشيء نفسه. نريد لها أن تكون دولةً طبيعية في مجتمع الدول، وأن تتمتع بأفضل العلاقات مع العالم، وأن تنفق مواردها على بناء مجتمعها، بدلا من إنفاقها على تدمير مجتمعاتنا، وأن يكون لها نظامها الذي يختاره شعبها، كما نريد لها أن تتركنا نختار النظام الذي نريده لأنفسنا. هنا، على إيران أن تكون منسجمةً مع ذاتها، ومع تاريخ ثورتها التي أسقطت الشاه والسافاك، لكنها تدعم اليوم قرينه السوري في السياسات والممارسات.
رابعاً، نرفض كل أشكال المواجهة الطائفية مع إيران، وبواعث هذه المواجهة سياسية، لا مذهبية، كما كانت عبر التاريخ، لأنها بلا أفق، وتهدّد بدمار العرب والإيرانيين معا. في المقابل، على إيران أن تكفّ عن اعتبار نفسها مسؤولةً عن كل شيعي في العالم، وأن تحترم سيادة الدول الوطنية، وأن تتوقف من ثم عن التدخل في شؤونها الداخلية. خامساً، أي مراقب بسيط، على الرغم من كل محاولات التعمية والتضليل ونظرية المؤامرة والأقاويل عن دور أجهزة الاستخبارات، بات يدرك أن “داعش” هو الابن الشرعي للسياسات الإيرانية، وظهوره يمثل رد فعل طبيعيا على ممارسات الهيمنة والإقصاء والطائفية التي تنهجها في سورية والعراق. وإذا أرادت إيران، كما قال ظريف، أن تكون شريكاً كاملا في محاربة الإرهاب، عليها أن تحرمه مبرّرات التجنيد والتمويل، وتشل قدرته على الحركة من خلال تغيير سياساتها، وهنا تكون مساهمتها الكبرى.
بهذا يحصل التغيير الذي ينشده ظريف، لا من خلال ممارسات دعائية، أو “شطارات” بروتوكولية ظريفة، أو مقالاتٍ صحفية، باعثها الأساسي القلق من تفاهمات عربية- أميركية. وهذا التغيير إن صدق يجب أن يبدأ من سورية، ويمكن لظريف وروحاني أن يستخدما التفويض الشعبي الذي حصلا عليه، أخيرا، للدفع بهذا الاتجاه، وإثبات أنهما جادّان في ذلك. إذا حصل هذا، سيجد ظريف من هو مستعد لملاقاته على الضفة الأخرى.
العربي الجديد
ليس بإيران وحدها يحيا الإرهاب/ مازن عزي
خلصت اجتماعات القمم في الرياض، إلى أن إيران هي مصدر الإرهاب، وسبب زعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط. مجموع القمم السعودية والعربية والاسلامية مع الإدارة الأميركية الترامبية، وفي قراءة لأبرز عناوينها، فشلت في مقاربة أسباب الإرهاب العميقة، إذ لجأت إلى المشجب الأسهل؛ إيران.
صحيح أن لإيران دوراً تخريبياً من العراق وسوريا ولبنان إلى اليمن والبحرين، مروراً بفلسطين. ولكن، هل تملك إيران فعلاً هذه القدرة السحرية على زعزعة منطقة أساسية من العالم، من دون توافر أسباب الخلل الذاتية؟
لإيران أذرع مليشياوية طائفية في الشرق الأوسط تستقوي بها على الدول، أو ما تبقى منها، وتعيد تشكيل الجغرافية السكانية لها، وتهندس لعمليات التهجير القسري، والتغيير الديموغرافي، والتطهير العرقي. شبكة علاقات إيران المليشياوية تمتد من “حزب الله” اللبناني إلى “العمال الكردستاني” التركي، وما بينهما من مليشيات في سوريا والعراق واليمن. جرائم الإبادة ضد السوريين، وتدمير حواضرهم وأريافهم، باسم الدفاع عن زينب “كي لا تسبى مرتين”، قد تكون من نافل القول. ولكن، من أين امتلكت إيران هذه القوة؟ وكيف أمكنها اختراق المنطقة مثل سكين حام في قالب زبدة؟
المشرق العربي، خاصة العراق وسوريا، ومنذ تأسيسه السياسي، بعيد الحرب العالمية الأولى، كان ميداناً متواصلاً للعنف. فمن كيانات سياسية مُختلقة مفروضة بقوة الانتداب الغربي، إلى مرحلة الدول الوطنية المستقلة، لم تتمكن النخب السياسية البرجوازية من ترسيخ شرعية لها، ولم تصمد أمام جيوشها التي انقلبت عليها مؤسّسة لحكم راديكالي، باسم الشعب. الجيش كحارس الأنظمة القديمة من شعوبها، بدأ بالانقلاب عليها، بعد نكبة العام 1948، محملاً اياها العار الذي لطخ شرف الأمة. ومع صعود القومية العربية، كعقيدة تبناها العسكر الشباب، كان الحلم بإعادة هندسة الدول القُطرية على أسس التكامل العربي، سعياً وراء الوحدة. وكلما ازداد الهاجس الخطابي الوحدوي، ازدادت النزعة القُطرية، وازداد الفصام بين الخطاب والفعل، وازداد العنف. حملات التطهير ضمن الجيش والسلطة، وحملات العنف ضد مكونات المجتمع المختلفة، من الأكراد والإسلاميين واليساريين، كانت سمات مرحلة الاستقرار. عسف الأجهزة الأمنية، والعنف البربري، صارت شكل الحكم الرمزي.
ومع فشل القومية العربية الحاكمة في تحقيق ما ادعته، بدأت الدعوة إلى السلفية الجهادية بالتمدد أفقياً في هذه المجتمعات. فمن حسن البنا إلى سيد قطب، قطع الإحياء الديني مساراً وعراً، ظل فيه مهمشاً ومستثنياً من السلطة. إحياء الفريضة الغائبة؛ الجهاد، كان الحلّ لإقامة العدل في الأرض، بعدما انتشر الفساد، على هيئة دول “علمانية” قومية.
القومية العربية بوجهها الفاشي، والإحياء الإسلامي بوجهه السلفي الجهادي، كانا الصورة والنقش للعملة ذاتها. استبطان العنف، وانتهاجه، كوسيلة وحيدة للحكم، وللإطاحة به. المتخيّل العنفي في الخطاب العروبي والإسلامي، صار نهجاً للقادم من الصراع بين الطرفين.
على هامش هذا الصراع، كان صعود حركة الكفاح المسلح الفلسطيني، كرد على الاحتلال الإسرائيلي. منذ أواخر الستينيات، بدأ الكفاح الفلسطيني ينهل من العنف اليساري لردع إسرائيل وإجرامها. الكفاح الفلسطيني، المطرود من الأردن وسوريا، وجد أرضاً خصبة في لبنان، وانقلب إلى طرف مقاتل ضمن حرب أهلية مريرة، صارت ميداناً للتدخل الإقليمي والدولي. خطف الطائرات وقتل المدنيين في الستينيات والسبعينيات، كانت أول الأفعال التي ستوسم عالمياً، بالإرهاب، رغم عدالة القضية.
الإرهاب الإسرائيلي، كان وما زال، محفزاً لجميع الحركات العنفية في العالم العربي، والتي لم تجد بديلاً في ظل انعدام التوازن، وقوة إسرائيل. عدالة القضية، صارت المشجب الذي يغذي الصراعات الداخلية ضمن المجتمعات العربية، وباباً للمزاودة، والحصول على الشرعية. من خطاب المظلومية هذا، ولد “حزب الله” كذراع إيرانية في لبنان.
قبل ذلك، اندلعت الثورة في إيران على نظام الشاه القمعي “العلماني”. الخامنئي، وعدا عن إيديولوجية “ولاية الفقيه” “الثورية” التي طورها على الضد من التنوع المجتمعي الإيراني، شنّ حرباً ضروساً في الداخل الإيراني على معارضيه، ومن ثم المختلفين عنه، وحتى ناقديه. “الجمهورية الإسلامية”، قامت على العنف الداخلي، وسرعان ما دخلت في حرب إقليمية مع العراق “البعثي”. في الصراع الإيراني/العراقي، بدأ أول تكريس سياسي معاصر للنزاع الهوياتي الديني؛ سني/شيعي، والذي لم يتوقف عن النمو والتصلب.
الأنظمة الملكية السلالية في الخليج العربي، كانت قد حققت نوعاً من الاستقرار الداخلي، بسبب الثروات النفطية. لكن القاسم بين الملكيات والجمهوريات في المشرق العربي، كان تضخم الدولة، بحيث أصبحت ميداناً لسياسات الضمّ والتهميش للقوى الاجتماعية والسياسية. وإذا كان الضمّ يتناسب مع زيادة الموارد، فالاقصاء دائماً ما يحدث في فترات العجز والانكماش الاقتصادي. الاقصاء غالباً ما يطال في البداية الشرائح الاجتماعية الأضعف، والأطراف السياسية المناوئة. اقصاء الشيعة في الخليج سياسياً، وضمهم اقتصادياً، ظل شكلاً لسياسة التنفيس المجتمعي. إلا أن دولة كسوريا، والتي تحولت مع الوقت إلى جامعة جوائز ومصدر متاعب إقليمي تعتمد في اقتصادها على المعونات الخارجية، رفضت ضمّ سنّة الأرياف سياسياً واقتصادياً، وابقتهم خارج “الدولة”. ومن هنا بدأت السلفية الجهادية تجد أرضاً خصبة لها. الأمر ذاته معكوساً حدث في العراق، رغم الموارد المالية النفطية الهائلة.
أحداث الثمانينيات وحرب الإخوان في سوريا، والتدخل العسكري في لبنان، وسط حالة قمع داخلية مرعبة، حولت سوريا إلى دولة يحكمها العنف، ولم يعد احتكار وسائل العنف هو التعريف الأسلم للسلطة فيها، بل اخترقت الدولة المجال الرمزي للعنف، وصارت سياستها العادية الدولة تجاه المحكومين في أوقات السلم، وإرهاب الدولة هي الفيصل عند المفاصل التاريخية.
حرب الخليج الأولى والثانية، والاحتلال الأميركي للعراق في العام 2003، كانت خطوات إضافية لتحويل “الإرهاب” شكلاً يومياً للسياسة، في المشرق العربي. انهيار نظام صدام حسين، وتحول بقايا السلطة السنية إلى “المقاومة” الإسلامية، كانت فاتحة دخول “القاعدة” إلى البلاد. من “قاعدة الجهاد في بلاد الرافدين” إلى “مجلس شورى المجاهدين” إلى “الدولة الإسلامية في العراق” كانت السلفية الجهادية تحفر مسارها التاريخي. في المقابل، كانت إيران تدعم وتسلح وتمول المليشيات الشيعية، وتستنهض الشيعة، لتقاتل بهم الاحتلال الأميركي الذي جلبهم للحكم، وتقاتل بهم للسيطرة على كامل العراق. مليشيا بدر والإمام كانتا مفتاحاً لمئات المجموعات المسلحة الأخرى، والتي لا تقل تطرفاً وإرهاباً عن أخواتها في الرضاعة من السنة.
لكن “القاعدة” ليست وليدة البارحة، فالاحتلال السوفياتي لأفغانستان، والدعم الأميركي والعربي لـ”مجاهدي الحرية” كان تأسيساً لـ”القاعدة” على أرضية أفكار سيد قطب وأبو الأعلى المودودي وعبدالسلام فرج، وهي التي نقلها “المجاهدون العرب/الأفغان” معهم، في رحلة هروبهم إلى أفغانستان، والتي شاركت فيها جميع الاستخبارات العربية. عبدالله عزام وأبو مصعب السوري وغيرهم، هم تلاميذ الحرب الأفغانية، ومعلمو الجيل الجديد من الجهاديين في الجزائر وبعدها العراق وسوريا.
العنف صار مدخلاً للسياسة، كوسيلة رفض المهمشين الإسلاميين للسلطة، وطريقتهم الوحيدة للدخول في “الدولة” من باب قلبها. العنف الذي قادته الدول العربية والإسلامية ضد التيارات الإسلامية المعتدلة فيها، وتفضيلها الحركات الصوفية وإسلام الأنظمة، تحول إلى تبني المهمشين لأكثر الأفكار تطرفاً، والقائمة على تكفير الأخر والمجتمع، واستباحة دمه. فعل إرهاب الدول ضد مواطنيها الكافرين بها، سرعان ما انقلب ضدها، والتقى النقيض بالنقيض.
رعاية النظام السوري لتدفق المتطرفين إلى العراق، حوّل سوريا إلى مجمع عالمي مستقطب للسلفيين الجهاديين. وما كان سجن صيدنايا إلا أكاديمية حقيقية، يتم فيها انتقاء الأفكار الأشد تطرفاً، وتطويرها، قبل أن يتم إرسال خريجيه إلى الدول المحيطة. النظام السوري برعايته السلفيين الجهاديين، حاكى بذلك ما قام به من رعاية الحركات اليسارية المتطرفة في السبعينيات، من أمثال كارلوس وأبو إياد ومنظمة أيلول الأسود، أثناء “وصايته” على القضية الفلسطينية. حتى لـ”العمال الكردستاني” كانت له معسكرات تدريب في سهل البقاع اللبناني.
وكما سجن صيدنايا العسكري، كان سجن بوكا في العراق، برعاية أميركية. هناك اختلطت أصفى السلالات السلفية الجهادية، قبل أن ينتج عنها “الدولة الإسلامية في العراق” الأم الحنون لـ”داعش” لاحقاً.
“حزب الله” اللبناني والسوري والعراقي، ومئات المليشيات الشيعية في سوريا والعراق، ومنها الأفغانية والباكستانية وتضم عناصر عربية من السعودية والبحرين، لن تمثّل بدورها سوى معادلٍ لـ”العرب الأفغان”. وسرعان ما سينتشر التطرف الشيعي إلى خارج المشرق العربي، محمولاً على راية “ولاية الفقيه” بانتظار خروج المهدي.
الرئيس عبدالفتاح السيسي، أحد أهم المشاركين في افتتاح “مركز اعتدال لمكافحة الفكر المتطرف” كان قد قام بانقلاب عسكري باسم الجيش، أطاح فيه بحكومة منتخبة. السيسي أمر بفض اعتصام ميدان رابعة، وقتل فيه آلاف المعتصمين العزل. نظام السيسي طارد “الإخوان المسلمين” وطهّر الدولة منهم، واعتقل منهم عشرات الآلاف. أحكام الطوارئ التي ينفذها النظام المصري، ليست في الواقع سوى محاولة لمنع انهيار الدولة، الغارقة في الفقر والفساد والفوضى. نظام يخوض حرباً مدمرة ضد سكان سيناء، من دون تمييز، ويستثمر في المقتلة ضد الأقباط وسكان المدن، للاستمرار في السلطة. وعلى النقيض، ففي تركيا، وبعد الانقلاب الفاشل، شنّت حكومة “العدالة والتنمية” عملية تطهير واسعة في صفوف الدولة والجيش، وطالت المؤسسات الخاصة والمجتمع المدني. العنف ضد “العمال الكردستاني” في تركيا، ليس العنف الوحيد ضد المجتمع.
صحيح أن لإيران دوراً هائلاً في الإرهاب في المشرق العربي، لكنها، ليست وحدها من زرع بذور الشقاق والأزمة. فدول المشرق العربية الهشة حد الضراوة، لم تمتلك يوماً شرعية، أبعد من شرعية إرهاب مجتمعاتها.
المدن
إيران في سورية/ فاطمة ياسين
أضافت غارة التوماهوك على قاعدة الشعيرات للرئيس الأميركي الجديد دونالد ترامب قبولاً في الشارع، فقد أنذر، تحت عنوان “عدم التغاضي”، روسيا وحليفها السوري من أي هجومٍ قد يحصل بالسلاح الكيماوي، وردَّ على ما تم تناقله إعلامياً عن محادثاتٍ وصداقةٍ له مع بوتين والنظام الروسي، الإنذار الثاني والأهم وجّهه ترامب لإيران، وأكّدته الغارة الأميركية التي حصلت، أخيرا، في الجنوب الشرقي السوري على قافلةٍ عسكريةٍ تحوي مكوناً إيرانياً وجد تحت شعار القوى المتحالفة مع الجيش السوري. وكانت إسرائيل قد شنت عدة هجماتٍ على ضواحي دمشق ومناطق القلمون ضد أهدافٍ قالت إنها مستودعاتٌ تخص حزب الله، أو منقولات عسكرية له، متحركة عبر الحدود. تظهر هذه الهجمات حجم التورط الإيراني في سورية، ومدى تمدّده العسكري على الجغرافيا السورية، وقد وصل إلى قلب حلب شمالاً، وإلى الحدود الجنوبية الشرقية التي قصفتها الطائرات الأميركية.
أطلق ترامب، خلال حملته الانتخابية، صيحاتٍ كثيرة ضد السعودية وإيران وكوريا الشمالية وحتى المكسيك، ولكنه بعد أن تبوأ الرئاسة، بدا رجلاً عملياً أكثر، وتعامل مع الموقف بواقعية، وأنزل عن كاهله بضع حمولاتٍ، مبقياً على أكثرها تأثيراً وخطراً، وهي إيران. لم يلغ ترامب الاتفاق النووي الذي وقعه أوباما وحلفاؤه في أوروبا مع إيران، فهو أمرٌ يتعلق بآخرين، يبدو أنهم متمسّكون به، ولكنه أحاط نفسه بمستشارين لا يكنّون لإيران أي ود، وبعضهم مستعد للذهاب أبعد من مواجهتها إعلامياً، واختار أن يذهب، في أولى جولاته العالمية، لزيارة المملكة العربية السعودية التي تكن لها إيران عداوةً خاصة، وهذه الزيارة خُصصت لتوقيع اتفاقيات عسكرية ضخمة بمئات المليارات، وتمتد صلاحيتُها إلى أكثر من عشر سنوات، وهي مدة تتجاوز فترة ترامب الرئاسية الحالية والمقبلة، فيما لو أعيد انتخابُه، ما يعني أن الحلف القوي بين السعودية والولايات المتحدة مرشّح ليعمر فترة طويلة مقبلة.
حاولت إيران أن تفتعل تصعيداً مقابلاً في مواجهة الموقف الحاد الذي أظهره ترامب، فأخرج خامنئي من جرابه السحري أحمدي نجاد، وهو أحد عناوين إيران المتطرّفة، ثم طواه لصالح وجه جديد هو المرشح إبراهيم رئيسي، ونشر على نطاق واسع بأنه مرشّح المرشد الأعلى، والتطرّف إحدى صفاته الرئيسية، ولكنْ بشكل واقعيٍّ يبدو أن إيران تسير في طريق المهادنة وكسب الوقت، فأكثرت من الحديث عن الاتفاق النووي وتمسّكها به، بل ذهبت إلى أبعد من ذلك، بإظهار فوز كبير للرئيس “الإصلاحي”، حسن روحاني، الذي يعتبر في إيران عرّاب هذا الاتفاق. هذا لا يعني أن إيران ستخفّف من طموحها، أو تقلص من محاولة وجودها، فقد كانت قافلتها العسكرية تبعد بأقل من ثلاثين كيلومتراً عن الأردن عندما تعرّضت للقصف، وقد لا يكون هذا الوجه “الإصلاحي” الذي اختارت أن تُظهره للسنوات الأربع المقبلة كافياً لتغيير خطط ترامب، وهو يستعد ليلتقي بزعماء محليين يحيطون بإيران، وسيحاضر فيهم عن الإسلام، بغياب إيران قبل أن يتوجه إلى إسرائيل.
الوجود الإيراني في سورية واسع وكثيف، وهو من عوامل استمرار الحرب، والضربة الإنذارية قرب الحدود الأردنية هي أحد الخطوط التي ترسمها الولايات المتحدة، ومن الممنوع تجاوزها، ولكن ذلك غير كافٍ لإلغاء الوجود الإيراني أو تخفيفه في سورية، وتأثيره المر على مسار الحرب. قد تمنع نشاطات ترامب الحالية، مع شركائه، إيران من التحرّك لكسب المزيد، ولكن من غير المعروف كيف ستؤثر على ما تستولي عليه إيران أساساً، خصوصا بوجود الحليف الروسي.
تعيد زيارة ترامب السعودية إلى الميدان لاعباً رئيسياً ومؤثراً، وبمساندة أميركية وإقليمية، ولكن الحسم بوصفه كلمة سحرية وخياراً نهائياً قد لا يكون حاضراً، بحسب مفردات الاتفاق الموقع بين الطرفين، خصوصا أن فترته طويلة نسبياً، ومن غير المعروف أيضاً ما إذا كانت طبيعة السلاح أو العلاقة الجديدة هي للردع فقط، أم لكسب المعارك أيضاً.
العربي الجديد
هل أميركا وإيران على مسار تصادم في سوريا؟
علقت فورين بوليسي على الغارة الجوية الأميركية ضد مقاتلين مدعومين من إيران في جنوبي سوريا الأسبوع الماضي بأنها تمثل مرحلة جديدة ملتهبة في الصراع يمكن أن تسبب مواجهة أوسع بين الولايات المتحدة وإيران وحلفائهما على الأرض.
وأشارت المجلة إلى أن البلدين، حتى الغارة الأخيرة، نجحا في الابتعاد عن مواجهة مباشرة في العراق وسوريا، حيث يوجد لهما مئات المستشارين العسكريين العاملين مع القوات المحلية على الأرض.
وفي العراق يتقاسمان عدوا مشتركا هو تنظيم الدولة الإسلامية. وفي سوريا يخوض الطرفان حربين مختلفتين يعمل فيها الطيران والعمليات الخاصة الأميركية على دحر مقاتلي التنظيم، بينما تدعم إيران النظام السوري ضد قوات المعارضة في حرب متعددة الجوانب.
وترى المجلة أنه مع تضييق قبضة التنظيم على الأراضي يزداد الخلاف بين الولايات المتحدة وإيران مع تنافس شركائهما المحليين للسيطرة على التضاريس الرئيسية على طول الحدود السورية العراقية.
وأضافت أن التوترات المتزايدة بين واشنطن وطهران في سوريا تزامنت مع الخطاب المتشدد الذي وجهه ترمب لإيران عندما وصفها الأسبوع الماضي في السعودية بأنها مصدر “التدمير والفوضى”، ودعا دول المنطقة لتشكيل جبهة موحدة ضد طهران.
وأردفت المجلة أنه رغم وعد ترمب بتبني موقف عدواني مع طهران، لا يزال البيت الأبيض يقوم بمراجعة سياسته تجاه إيران، ولم تحدد الإدارة بعد أهداف الولايات المتحدة على طول الحدود السورية العراقية.
وختمت بأنه مع وجود قوات أميركية على الأرض وتحرك المستشارين مع الوحدات المحلية الصغيرة يظل هناك خطر من الثأر الإيراني، وهذا ما كان واضحا خلال الاحتلال الأميركي للعراق حيث زودت طهران المليشيات الشيعية بقنابل وصواريخ أودت بحياة مئات الأميركيين.
فورين بوليسي
ترجمة الجزيرة