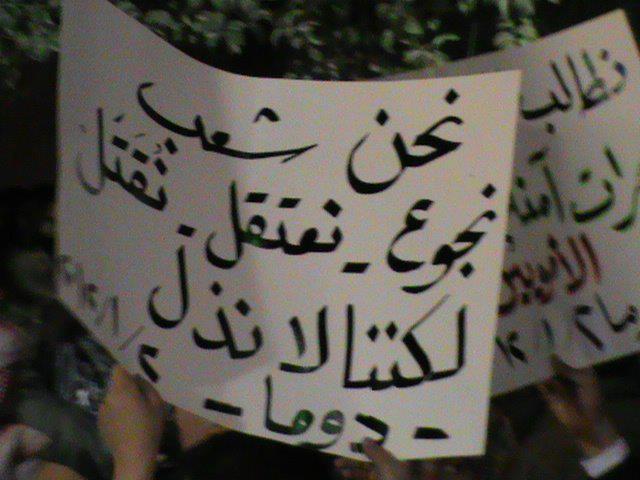هل ستحدد الغوطة الشرقية مستقبل سوريا؟ -مقالات مختارة-

الغوطة آخر المعارك/ بشير البكر
يبدو من ضراوة الحملة الروسية على الغوطة أن موسكو عازمة على إسقاطها عسكرياً، وتمكين قوات النظام السوري من العودة إليها، بعد أكثر من أربعة أعوام من خروجها عن سلطته في سياق الاحتجاجات الثورية التي بدأت في مدينة دمشق في 15 مارس/ آذار 2011. ولم تُخفِ روسيا أنها تعمل على استنساخ مخطط حلب في الغوطة بكل تفاصيله، ولذلك عطلت قرار مجلس الأمن 2401، وطرحت بديلاً عنه هدنةً يومية خمس ساعات، من أجل السماح للمدنيين بمغادرة المنطقة، وباتت على قناعةٍ بأن سياسة الأرض المحروقة والتجويع ومنع دخول مواد الإغاثة سوف تؤدي، في النهاية، إلى إجبار المدنيين، وغير المدنيين من الفصائل المسلحة، على مغادرة الغوطة.
المصير الذي ترسمه روسيا للفصائل العسكرية الموجودة في الغوطة هو المصير نفسه الذي حددته للفصائل التي كانت تسيطر على شرق حلب، وتحاول استنساخ السيناريو نفسه الذي ينتهي بالتهجير، وتقوم بتنفيذ العملية، مستخدمة المراوغة نفسها التي تميزت بها سياستها في الشأن السوري، والتي تعتمد على قدر كبير من التضليل وتغيير المواقف، من دون شعور بالحرج، سواء في مجلس الأمن الدولي، أو على صعيد آلية أستانة التي اعتبرت الغوطة منطقةً مشمولةً بعملية خفض التصعيد، وتسوق موسكو ذلك كله تحت غطاء عالٍ من النيران.
الوضع المأساوي الذي تعيشه الغوطة، وما ينتظرها من عملية تطهير طائفي، واضحان قبل سقوط حلب. ويعرف أصحاب الحل والربط في المنطقة أنهم سيواجهون اليوم الذي عليهم أن يختاروا فيه بين الموت والرحيل من ديارهم، مثلما رحل أهل حلب الذين تشردوا في ريف حلب وإدلب وتركيا. وقبل أن تغيب الشمس، كان الجنرال الإيراني، قاسم سليماني، يتجول في قلعة حلب، ولا شك أنه ينتظر نهاية العملية الروسية ليقوم بجولة مماثلة في غوطة دمشق التي تشكل بالنسبة للسوريين آخر حاضنات الثورة السورية الأولى التي بقيت تقاوم، ولذلك سيكون لسقوطها وقع معنوي كبير.
ستكون الغوطة المعركة الأخيرة لاعتبارات كثيرة، يظل أهمها أن نجاح الروس في السيطرة عليها سوف يعني نهاية الوجود العسكري المحسوب على الثورة في منطقة ريف دمشق التي شكلت، بالنسبة للنظام، أهم عقبة في الطريق، وليس مصادفة أن منطقة ريف دمشق تتصدر عدد الشهداء خلال سبعة أعوام من المواجهة، ثم إن النظام لم يتمكن من استعادتها أو تركيعها، على الرغم من كل الوسائل التي استخدمها والدعم الإيراني الكبير، ومشاركة المليشيات الطائفية من حزب الله والعراق، وحتى أفغانستان، في القتال الدائر على أرضها.
على الرغم من ضراوة الحملة على الغوطة، هناك مسألة مهمة، وهي أن أهالي الغوطة لم يتجاوبوا مع الهدنة الروسية التي فتحت أمامهم طرق الخروج، ويرفضون تكرار خطأ شرق حلب. ومن هنا، ليس هناك أي مؤشر إلى الاستسلام، وهذا يحيل إلى أحد أسباب الثورة في ريف دمشق على النظام، وهو مواجهة مشاريع استيلاء ضباط ومتنفذين وأقارب عائلة الأسد على أراضي الأهالي، ومنهم ذو الهمّة شاليش ابن خالة الأسد الذي استولى على مساحات واسعة من أراضي الغوطة بالاحتيال، واستثمرها عقارياً. ويدرك أهل الغوطة أن خروجهم منها يعني أن لا عودة إليها. ولذلك تبدو المعركة مفتوحة ليس مع النظام فقط، وإنما مع إيران التي تعتبر مدينة دمشق ومحيطها من حصتها، ضمن عملية تقاسم النفوذ الجارية على الأرض السورية، وتسربت في أكثر من مرة معلومات عن نية إيران ربط ريف دمشق بجنوب لبنان، والامتداد حتى ريف حمص في القصير.
تقاتل الغوطة وحدها، ويدافع عنها أهلها، بغض النظر عن تسميات الفصائل العسكرية التي تحمل السلاح هناك، الأمر الذي يحاول الروس أن يستغلوه، لوصمها بالإرهاب، كونها ذات مسميات إسلامية، مثل جيش الإسلام وفيلق الرحمن.
العربي الجديد
جحيم آستانة في سورية ورسائل روسيا إلى العالم/ سميرة المسالمة
لم تشكل موافقة روسيا على القرار 2401 أي عائق أمام متابعة قصف طيرانها قرى الغوطة الشرقية، كما لم تتسبب في أي مواجهة مع المجتمع الدولي في سعيها إلى تصحيح بعض الحقائق التي تم تجاهلها، أو القفز فوقها، خلال الترويج لنص القرار وبنوده، الذي يتيح لموسكو التعاطي معه أساساً من خلال قاموسها الخاص، وخبرتها في إدراج مصطلحات مرنة، قابلة لأكثر من تأويل للقرارات الدولية، بدءاً من بيان جنيف1، إلى القرار ٢٢٥٤، ومروراً بكل ما تم التوافق عليه في ما يتعلق بالصراع في سورية، وذلك وفق الحاجة الروسية وجهة الالتزام بها ونطاق تنفيذها، ما يؤكد اليوم عجز المنظمة الدولية بواقعها الحالي، وحاجتها إلى استيلاد وسائل دفاعية فاعلة تحمي من خلالها مهماتها وأولوياتها في الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين.
أرادت موسكو أن تعرّف المجتمع الدولي من جديد بحقيقة دورها في سورية، وأن القرار يعود إليها وحدها بخصوص وقف إطلاق النار من عدمه، وليس إلى المجتمع الدولي، الذي تراه يتعامل بقفازات بيضاء في عملية جراحية تستلزم الغوص بالدماء والدمار السوريين، فهي من تحدد متى وأين ولمن تكون تلك الهدن. ولعل قرار موسكو وضع بداية ونهاية يومية للهدنة يعني أنها تعيد تعريف عمليتها العسكرية في سورية بأنها صاحبة الفضل في إطعام الناس بيد وقتلهم باليد الأخرى، متى تشاء. وضمن ذلك التعريف فهي طرحت مسبقاً تسمياتها لأطراف الصراع، بين مؤسسة حاكمة يمثلها النظام، وبين جماعات إرهابية تريد قلب حكم هذا النظام، وعلى ذلك فإن ما يمثله القرار من وجهة نظرها هو زيادة في إطلاق يدها داخل الصراع وليس للجمها وتحجيمها.
ولعل من قبيل المصارحة مع الذات أن نسأل هل كان تمرير القرار الأممي 2401 السبت 24 شباط (فبراير) المتعلق بوقف إطلاق النار في سورية لمدة 30 يوماً، محرجاً لموسكو حقاً؟ هل كانت روسيا فعلياً تستطيع استخدام الفيتو بوجه المجتمع الدولي، وخسارة ما حاولت أن ترسمه لنفسها من دور في صياغة حل سياسي للقضية السورية، وذلك من خلال جهودها في عقد مؤتمر سوتشي، على رغم ما مني به من فشل، شارك حليفها النظام بصناعته، عبر تحويله إلى تجمع أقل من شعبي، وأقرب إلى مشهد هزلي غير متقن، وهل ستنسى موسكو له هذه الخطيئة؟
إن كنا نوقن أن موسكو لا تتعاطى مع القضايا المتعلقة بمصالحها وفق مبدأ المحاباة، فإننا ندرك أنها استثمرت بتعاطيها «الإيجابي»- أو في شكل أكثر دقة غير «التعطيلي»- مع المجتمع الدولي، بما يتعلق بموافقتها على القرار 2401، حول وقف الأعمال العدائية في سورية من جميع الأطراف، على صعد عدة: داخلي روسي، ومحلي سوري، وخارجي دولي، حيث وجهت، من خلال مسايرتها المتحمسين لاستصدار القرار، رسائل عديدة.
فمثلاً، ثمة رسالة إلى الشعب الروسي مفادها أنها لا تزال ضمن منظومة العمل الدولي الجماعي، مبددة بذلك ادعاءات بعض أحزاب المعارضة الروسية، بأن الرئيس فلاديمير بوتين، المقبل على انتخابات رئاسية في 18 الشهر الحالي، جرَ البلاد إلى عزلة خانقة، ومواجهات دولية واسعة مع الولايات المتحدة وأوروبا الغربية، ما قد يحمّلهم المزيد من الانعكاسات الاقتصادية الضاغطة على حياة المجتمع الروسي، الذي يعاني أساساً نتيجة العقوبات التكنولوجية والاقتصادية عليه.
أما رسائلها إلى الداخل السوري، أي إلى النظام والمعارضة المسلحة، فأكدت عبرها بأنها الطرف الفاعل في المعادلة الدولية سواء لجهة الحرب واستمراريتها، أم للسلام وآلياته. وعلى ذلك فهي مهّدت من خلال الشروط «التقييدية» التي طرحتها للمساومة على اتخاذ القرار، وكذلك بما استطاعت تضمينه كبنود في القرار فعلياً، على أن الانتقال الفعلي إلى عقد الهدنة المأمولة من المدنيين السوريين، يجب أن يتضمن ضغطاً على الفصائل المسلحة، للانخراط الكامل في المسار الروسي في آستانة، تجنباً لتصنيفها «بالإرهابية»، حيث استطاعت تضمين القرار 2401 ما يوسّع هوامش التلاعب الروسي بالفصائل، ويضعها تحت التهديد المباشر بالتصنيف، ضمن حيثيات البند الثاني من القرار، المتعلق بعدم شمولية وقف الأعمال العدائية ضد النصرة وداعش والقاعدة والأفراد والكيانات المرتبطة بهم.
كما أن الرسالة الأقوى كانت إلى النظام الذي لا يزال يلعب بورقة حصة إيران في الكعكة السورية، حيث ينزع هذا القرار عنه الحصانة في اللحظة التي تراها موسكو، وليس إيران أو المجتمع الدولي، مناسبة. فالقرار يتحدث عن وقف كامل لإطلاق النار، وليس عن تخفيض تصعيد، ومفاتيح الاستثناءات بيد موسكو، فقط، ما يعني أن ما كانت تتيحه له «هوامش» الخلافات الروسية- الإيرانية، حول الحل السياسي في سورية للنظام قد تقلصت ربما إلى الصفر، عندما تحين الفرصة لموسكو بعقد صفقاتها مع الولايات المتحدة من جانب وأوروبا الغربية من جانب آخر، حتى إذا تعارضت هذه المصالح مع إرادة النظام السوري والرغبة الإيرانية. ويدل على ذلك متابعة موسكو تشكيل اللجنة الدستورية التي أقرتها في سوتشي وعارضها النظام بجلسة معلنة في مجلس الأمن.
أما الاستثمار الأهم في القرار 2401 فهو في علاقة روسيا مع تركيا وإيران شريكتيها في مسار آستانة، إذ يهدد القرار في شكل فعلي اتفاقات خفض التصعيد التي عقدت برعاية ثلاثية روسية تركية إيرانية من جهة، وقد يكون المنقذ لها من جهة أخرى، ويعود ذلك إلى درجة الجدية الدولية في مراقبة تنفيذ القرار، والتزام الدول المتصارعة به، أو في التماشي الدولي مع الرغبة الروسية، ومنحها فرصة إعادة إحياء اتفاقات خفض التصعيد في المناطق الأربع، وفق خريطة تمنح تركيا غرب الفرات كاملاً، والنظام شرقه، مع ضمانات للوجود الأميركي في الشمال والشرق والجنوب، وبسط النفوذ الإيراني وسط العاصمة بما لا يجعلها في تماس مع أي نقطة حدودية تهدد أمن إسرائيل، والتمدد الأميركي في مناطق اقتصاد سورية، أي أن روسيا صاحبة كلمة السر في ضمان المصالح التركية من جهة، إذا قررت المضي في مسار آستانة، والتغاضي عن العملية التركية في عفرين وصولاً إلى منبج، مقابل منح النظام كامل الأحياء التي كان الأكراد يسيطرون عليها في حلب، وقد وقّع فعلياً مقاتلو قوات سورية الديموقراطية في فخ سحب قواتهم من تلك المناطق للانضمام إلى معركة عفرين ضد تركيا، أي أنه بالمحصلة فإن خرق القرار الأممي لا يمكنه أن يحدث في شكل فردي من تركيا ما لم تتوافق مع روسيا وإيران والنظام على ذلك.
وتشترك إيران مع روسيا في قطف ثمار تمرير هذا القرار الإنساني، حيث يغيب التصعيد الإعلامي عنها لرجحان كفة التصعيد ضد العملية الروسية في كل من الغوطة وإدلب، ما يخفف الحملة الدولية على إيران، ويضعها من جهة ثانية تحت الوصاية الروسية، وهو ما يجعل كلاً من الدولتين، تركيا وإيران، «أقل من شريك وأكثر من تابع» للمصالح الروسية في المنطقة، كما يجعل من برودة مسار آستانة جحيماً يعايشه الشعب السوري تحت نار موسكو وشركائها.
* كاتبة سورية.
الحياة
هذه البيئة الإكراهية للقرار 2401/ غازي دحمان
اشتغلت ورشة لتدوير الزوايا في كواليس مجلس الأمن ثلاثة أيام، على مشروع القرار بشأن الغوطة الشرقية في ريف دمشق، والذي تقدمت به الكويت والسويد، من أجل ملاقاة الروس في منتصف الطريق، وإخراج القرار السبت رقم 2401. فقد تم انتزاع كل ما يشير إلى الإلزام بوقت محدد لوقف إطلاق النار، وإلى آليات تنفيذية وأطراف ضامنة، وكيفية الرد على خرق الاتفاق، فظهرت الصياغة واسعة وغير دقيقة، فجاء القرار مهلهلاً مليئا بالثقوب، خصوصا وأنه ترك الباب مفتوحاً لاستكمال هجمات النظام البرية، بسبب عدم تحديده وقت سريان الهدنة، كما ترك لروسيا ونظام الأسد إمكانية استهداف المناطق التي يتذرعون بوجود جبهة النصرة فيها.
لكن، على الرغم من كل ما سبق، يمكن القول إن صدور القرار عطّل عملية اجتياح كبرى جهزت لها روسيا والمليشيات، بعد تجهيز أعداد كبيرة من المقاتلين، عشرات الألوف من قوات نخبة النظام والمليشيات الإيرانية والعراقية وكتائب من حزب الله، مدعومة بأحدث أنواع الأسلحة الروسية التي لم يسبق استخدامها بعد في الحرب السورية، وقد تم التمهيد للعملية بطوفان ناري، شاهده العالم، ويفوق طاقة ال 90 كيلومترا (المساحة التي تحت سيطرة الفصائل في الغوطة) على الاحتمال.
أرادت روسيا وحلفاؤها تغيير المعطيات بشكل كبير في الحرب السورية، من خلال تأمين حزام العاصمة، وإبعاد خطر المعارضة نهائيا، وكشف وزير الخارجية الروسية، سيرغي لافروف، عن سقف ما تريده بلاده في الغوطة، عبر إعادة تجربة حلب التي أفضت إلى خروج
“سيشكل القرار باباً لنزاع غربي – روسي جدي في سورية”
المعارضة نهائياً، بناء على تقدير الكرملين أن الوقت قد حان لتنفيذ هذا الأمر. وبالفعل، وفّرت روسيا الموارد اللازمة لتطبيق ذلك، إلى درجة أن بعض الإعلام الغربي ذهب إلى اعتبار الغوطة ساقطة، ولم يعد مفيداً العمل على إنقاذها.
وفي مقدمة خلفيات قرار روسيا السيطرة على الغوطة إضعاف الموقف الغربي في المفاوضات بشأن سوربة، وفرض أمر واقع تجعله يعمل تحت سقف ما تريده روسيا. وقد تسرب، عبر تقارير دولية، أن روسيا أرادت لنظام الأسد السيطرة على حزام دمشق، لإعلان بدء مرحلة إعادة الإعمار وإيجاد حالة من التنافس بين الشركات الإقليمية والدولية، من أجل الحصول على حصة. وبالتالي، وضع الدول الغربية أمام خيارين، العزلة والابتعاد عن الموضوع السوري، أو الرضوخ لضغط شركاتها التي ستتسابق على كعكة الإعمار، على اعتبار أنها فرصة ثمينة، لا يجوز التفريط بها.
وفي المقابل، ثمّة عوامل أضعفت الموقف الروسي، أهمها فشل عملية اقتحام الغوطة في وقت سريع، حيث كان مقدراً للعملية أن تنتهي في أيام معدودة، بالنظر إلى الاستعدادات الهائلة والموارد الكبيرة التي تم توفيرها، وإذا تعثر الاختراق والسيطرة البرية الكاملة، على الأقل السيطرة على مواقع استراتيجية حاكمة تجعل منطقة الغوطة ساقطة عملياً، ويتم إجبار الفصائل على الاستسلام، وطلب الخروج مع عائلاتهم، وفق المخطط الروسي الذي أعلن عنه لافروف.
وعلى الرغم من الإسناد الناري الكثيف، لم تحقق القوات المهاجمة أدنى اختراق، حيث تكشّف أن الفصائل استعدت جيداً عبر تحصين المواقع، وبناء الأنساق الدفاعية جيدا. وعلى الرغم من احتمالية تحقيق القوات المهاجمة خروقا هنا أو هناك، ما زالت ممكنة حتى بعد صدور قرار مجلس الأمن، إلا أنها لم تعد كافية، لتغيير المعطيات بشكل كبير، وقد أدركت روسيا هذه الحقيقة، وأدركت معها أن تقييمها الوقت المطلوب لتحقيق أهدافها لم يكن دقيقاً. وثمة حاجة لوقت أطول بكثير، لم يكن ممكناً في ظل ضغوط دولية غير مسبوقة عليها.
وقد شكّل الضغط الدولي، وتحديداً، ضغوط أميركا وبريطانيا وفرنسا، عاملاً حاسما في الموافقة الروسية على وقف إطلاق النار، كما أنها شكّلت معطيات جديدة في الحرب السورية، دفعت روسيا إلى إعادة حساباتها، أقله بالنسبة للغوطة، وفي هذا التوقيت تحديدا.
وكانت دعوة بعض الإعلام الغربي إلى قصف مطارات نظام الأسد تشير إلى تبلور اتجاه
“ثمّة عوامل أضعفت الموقف الروسي، أهمها فشل عملية اقتحام الغوطة في وقت سريع”
محدّد، قد يتحول إلى توجه وسياسة، كما أن تحذيرات مندوبي الدول الغربية إلى احتمال تفعيل مبدأ مسؤلية الحماية الدولية الذي أقرّه مؤتمر القمة العالمي سنة 2005، ويقضي بحق السكان المدنيين في أي دولة بالحماية، إذا ما واجهوا تهديدا بالإبادة، حيث ينطبق هذا الوضع على سكان الغوطة بشكل كبير.
وبالطبع، قلل هذا التطوّر في الموقف الغربي الخيارات الروسية، وحصرها في التفاوض على تحسين شروط القرار، وليس إلغاءه، كما حصل في حلب سابقاً، وقد كانت واضحةً مخاوف المندوب الروسي من احتمال استغلال الدول الغربية هذا القرار واتخاذه وسيلة لضرب النظام، أو حتى إسقاطه، وقد عبر لافروف عن هذه المخاوف، حينما قيّم القرار، قبل تعديله، أن الدول الغربية ترغب من خلاله بإسقاط نظام الأسد.
من الواضح أن هذا القرار، وعلى الرغم من كل التحريفات التي أدخلتها روسيا عليه، سيشكل باباً لنزاع غربي – روسي جدي في سورية. وإذا كانت روسيا قد رضخت تحت ضغوط الدول الغربية والموافقة على تمريره، فالمؤكد أنها ستعمل بكل جهدها على تفريغه والالتفاف عليه، بذرائع كثيرة، وحتى ألعاب استخباراتية قذرة، وهو ما يضع المجتمع الدولي أمام اختبار قدرته على فرض وقف إطلاق النار في سورية، كما يضع المعارضة السورية أمام ضرورة اجتراح أفكار وأساليب خلاقة لتفنيد الذرائع الروسية، وكشفها أمام العالم.
العربي الجديد
غوطة دمشق بلون الدم/ سلامة كيلة
جاء دور الغوطة. كل من اعتقد أن روسيا تريد الحل السياسي في سورية، وأن خطواتها في تخفيض التصعيد كانت من أجل ذلك، عليه الآن أن يكتشف وهمه، وأن يتلمس كم آذى الثورة. ينطلق جوهر الإستراتيجية الروسية من سحق الثورة، وتدمير كل مواقعها، وهذا يتوافق مع إستراتيجية إيران والنظام، على الرغم من أنهما يعزوان “الانتصارات” لقواتهما وليس للقوات الروسية، ليس بالطيران فقط، بل بقيادة عمليات وجنود ومرتزقة أيضا. ويتفرّغ وزير الدفاع الذي يمتلك مخططاً لتحقيق هذا “الانتصار الكبير”، سيرغي شويغو، لهذا الغرض. لكن المشكلة أن قوات النظام المتبقية وقوات إيران وأدواتها لم تكن قادرة على الحسم، حتى بحماية الطيران الروسي، كما ظهر في الأشهر الأولى من التدخل الروسي. لهذا، عاد الروس إلى خطة النظام وإيران، بتقطيع مناطق الثورة وحصارها بأقسى ما يمكن. وكانت قوات النظام وإيران قد فشلتا، على الرغم من ذلك في السيطرة على أي من هذه المناطق المحاصرة. لكن، نتيجة عدم وجود قوات قادرة على الحسم، لجأت روسيا إلى سياسة “مناطق تخفيض التصعيد”، حيث اقترحت أربعة ثم ارتفعت إلى سبعة. ولقد دفعت لتحريك جبهة النصرة للسيطرة على بعض هذه المناطق، خصوصاً في الشمال الغربي (إدلب وريفها) التي نجحت في السيطرة على مناطق واسعة، هي التي سلّمت معظمها لقوات النظام وإيران وروسيا، مع بدء الهجوم على ريف إدلب الشرقي. وما زالت تلعب بهذه الجبهة في تلك المنطقة.
“تهدئة الجبهات” في الجنوب السوري، وريف دمشق، وريف حمص، وريف حماة الجنوبي، وإدلب وريفها، سمح لروسيا التي تريد حسم الصراع بالقوة الاستفراد في هذه المناطق، واحدة وراء أخرى. فهي تستطيع، بهذه الإستراتيجية، تجميع قوى عسكرية كافية كما تعتقد. وبالتالي، تستطيع السيطرة على هذه المناطق واحدة بعد الأخرى. هذا ما فعلته في حلب، لكن بعد صفقة مع تركيا أضعفت إمكانية الدفاع عنها، وقامت به قبل ذلك في داريا ووادي بردى والمعضمية وغيرها. ولهذا، لم تكن مستغربة إشارة وزير الخارجية، سيرغي لافروف، إلى تطبيق ما جرى في حلب في الغوطة.
يتعلق الأمر هنا بفهم منظور روسيا القائم على حسم الصراع بالقوة، وإخلاء المناطق التي خرجت عن سيطرة النظام من سكانها، وتدميرها قبل ذلك، وهو منظور النظام وإيران أيضا، فعلى الرغم من أن روسيا فاوضت “جيش الإسلام” في أستانة فهي تتعامل معه باعتباره مجموعة إرهابية، وكذلك كل من تمرَّد على النظام وأراد التغيير، بينما تتخذ جبهة النصرة، كما كانت تتخذ “داعش”، شماعة من أجل تحقيق ذلك. فقد سلمت “داعش” بادية تدمر مناطقها بعد أن انتهت مهمتها، وسلمت جبهة النصرة جزءاً من مناطقها في ريف إدلب، بعد أن بات النظام بحاجة إلى استرجاعها، وهكذا. و”داعش” وجبهة النصرة اللتان تسيطران على مخيم اليرموك والحجز الأسود وغيرها من المناطق في جنوب دمشق بعيدتان عن أي هجوم.
إذن، جاء دور الغوطة، حيث يجب أن تعود إلى سيطرة النظام، بعد أن يكتمل تدميرها وتهجير ساكنيها. أتحدث عن روسيا، لأنها التي باتت تقرّر كل شيء في سورية. ولهذا كان سيرغي شويغو هو الذي أعلن وقف إطلاق النار ساعات (مخالفاً قرار مجلس الأمن)، وهو الذي يفاوض، والذي يهدئ أو يقصف، وطائراته الأحدث يتم تجريبها على رؤوس أهالي الغوطة، فهل هناك أفضل من هذا المكان لتجريب سلاح جديد؟ ولقد أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وكبار قادة في جيش بلاده عن تجريب أكثر من مائتي سلاح جديد على رؤوس السوريين، فقط ليتأكدوا أنهم يبنون جيشاً جديراً بإمبريالية ناهضة، تستحق أن ترث الإمبريالية الأميركية.
ما يتناساه الروس، كما النظام وإيران، أنه ليس من الممكن سحق الثورة، وكل حديث عن انتصار هو وهم، فقد ظنّ النظام أنه سينتصر وحده وفشل، وظنت إيران أنها سوف تنتصر له وفشلت، حتى روسيا ستلاقي المصير نفسه.
العربي الجديد
ما الذي يمنح اقتحام الغوطة كل هذه الأهمية؟/ بكر صدقي
قد يبدو السؤال الوارد في العنوان ساذجاً، بالنظر إلى قرب المنطقة التي تتعرض لحرب إبادة من عاصمة النظام الكيماوي، ومن البديهي أن يسعى المذكور وحلفاؤه إلى استعادة السيطرة عليها. ولكن ألم تكن الحال كذلك طوال السنوات السابقة التي أمضاها السكان في حصار خانق وقصف دائم؟ لماذا صدر الآن فقط قرار الحسم بشأنها؟
للجواب على هذا السؤال لا بد من تركيز النظر على روسيا، لا على النظام. فالروسي الذي تصرف بانتشاء المنتصرين، بعد نجاحه في اجتياح حلب الشرقية، وأطلق مسار آستانة، بالاشتراك مع إيران وتركيا، ثم أعلن تحقيق النصر، على لسان الرئيس بوتين، من قاعدة حميميم قرب اللاذقية، تلقى، بعد ذلك، سلسلة من الصفعات أعادت إليه الرشد من سكرة النصر الزائف، فبات ينظر إلى الغوطة كلقمة سائغة يمكنه ابتلاعها بسهولة، على أمل أن يعود إلى إعلان النصر مرة أخرى.
فقبل كل شيء اتضح للعالم أن ما أعلنته روسيا، مع شريكيها السوري والإيراني، من مناطق خفض التصعيد، لم يكن سوى خدعة لمواصلة قضم المزيد من الأراضي الخارجة عن سيطرة النظام، وفقدت تلك «الخطة» كل ما رافق صدورها من تعويم إعلامي. أضف إلى ذلك أن تقسيم سوريا وتقطيع أوصالها بتلك الطريقة، قد شكل أرضية مناسبة لتعلن واشنطن أيضاً عن منطقة نفوذها شرقي نهر الفرات، بعد انتهاء الهدف الأصلي المعلن للانخراط العسكري الأمريكي في سوريا، أي محاربة تنظيم «الدولة» (داعش)، منطقة نفوذ محمية بالقوة الفظة، كلما اقتضت الحاجة، ولفترة غير محددة.
وبين إعلان النصر على لسان بوتين، قبل أشهر في حميميم، ومعركة تدمير الغوطة، أغارت طائرات بلا طيار «مجهولة المصدر» على قاعدتي حميميم وطرطوس الروسيتين، ثم أسقطت طائرة سوخوي متطورة جنوب إدلب بمضادات طيران حرارية محمولة على الكتف، وقتل أكثر من مئة مرتزق روسي بصواريخ أمريكية قرب مدينة دير الزور، إضافة إلى عدد غير معروف من مقاتلي ميليشيات الأممية الشيعية التابعة لإيران.
وكانت الترجمة السياسية لهذه الخسائر الميدانية في «مؤتمر الحوار الوطني» في سوتشي الذي انتهى بفشل مدوٍ أزال كل أوهام النصر السريع من رأس الثنائي بوتين ـ لافروف.
وهكذا اتضح أن «النصر» على حلب قد فقد كل بريقه وطواه النسيان أمام الانتكاسات الروسية المتتالية. وإذ فشلت الحملة العسكرية باتجاه دير الزور حين اصطدمت بتصميم الأمريكيين على الدفاع عن منطقة نفوذهم، لم يبق أمام بوتين سوى البحث عن نصر عسكري جديد يعيد الاعتبار إلى حصرية الإمساك الروسي بالملف السوري. فلم يكن أمامه سوى خيارين: الغوطة أو إدلب. وبما أن تعقيدات كثيرة تحيط بموضوع إدلب (تركيا، وغزوها لعفرين المجاورة، وإقامتها لنقاط مراقبة وصولاً إلى جنوب مدينة حلب، والصراع الدامي بين الفصائل..)، فضلاً عن توقف زخم تقدم قوات النظام هناك من الجنوب، فلم يبق إلا الغوطة الشرقية المحاصرة منذ أكثر من خمس سنوات، هدفاً «سهلاً» للعدوان الروسي.
أما مرد سهولته المفترضة فهو عدم اهتمام الولايات المتحدة، وحلفائها الغربيين، بتلك المنطقة المتروكة لمصيرها. العقل الإجرامي لبوتين المتشكل على مقاس الحرب على غروزني، لا يحسب حساباً، بطبيعة الحال، لا لسكان الغوطة المدنيين ولا للفصائل المسلحة المسيطرة عليها. هو يكتفي بمراقبة الدول المتدخلة، فيحدد، بناء على ذلك، مدى سهولة ابتلاع الهدف أو صعوبته. لذلك فهو، على الأرجح، لم يشاهد مظاهرات أهل الغوطة الذين هتفوا قائلين إنهم لن يرحلوا، وسخروا من باصات الترحيل الخضراء.
لم يرفع الروسي الفيتو، هذه المرة، في مجلس الأمن، عند التصويت على مشروع القرار رقم 2401 القاضي بهدنة فورية وشاملة على الأراضي السورية، لمدة 30 يوماً، لأن في نيته استخدام هذا القرار لتحقيق نصره على الغوطة باستسلام أهلها وترحيلهم. فباحتقار شديد لمجلس الأمن وقراره، واصل الطيران الروسي غاراته المدمرة على الغوطة، منذ لحظة إعلان قرار مجلس الأمن، ثم أعلن، في اليوم التالي، عن «هدنة يومية لمدة خمس ساعات» لإجلاء السكان المدنيين! كأنما ليقول: أنا مجلس الأمن، وأنا من يقرر تفاصيل الهدنة وتواتر القصف والهدوء! ملقياً قفاز تحديه في وجه الدول الأعضاء، وخاصةً الولايات المتحدة التي أذلته في الأشهر القليلة الماضية، واثقاً من أنها لن تكترث للمزيد من الضحايا المدنيين وأشلاء الأطفال الممزقة بالقنابل الروسية.
بنظرة إجمالية، يبدو «الدب الروسي» في سوريا، مثل الفيل الشهير، في المثل الإنكليزي، الذي دخل متجر الزجاجيات، يحطم كل شيء، بقصد أو برعونة خرقاء، ولكن بلا أي جدوى. ولن يستطيع، طبعاً، أن يعيد ترتيب المتجر ليصبح قابلاً للاستخدام من جديد.
إذا حدثت المعجزة وتمكن أهل الغوطة من كسر العدوان الروسي، سيكون بوسع الروس، الشهر المقبل، إعادة انتخاب رئيس تمرغ أنفه في الوحل والدم. فهنيئاً لهم به.
٭ كاتب سوري
القدس العربي
مناطق القتل الأقل في الجحيم السوري/ هوازن خداج
حدود القتل والاقتتال التي سادت خلال السنوات السابقة بين الميليشيات المعارضة المختلفة وبين النظام السوري وحلفائه المتحكمين في مسار الصراع، انتقلت بسرعة لافتة إلى خانة اشتعال حدود بعض مناطق خفض التصعيد أو “القتل الأقل” التي صاغتها روسيا في مناطق مثل حمص وإدلب وعفرين والغوطة التي تعيش جحيم القصف والتدمير، وسط عجز دولي على فرض هدنة إنسانية دائمة وشاملة.
سعت روسيا منذ تدخلها في الصراع السوري لدعم النظام والحفاظ على موقعها، مع محاولة الإمساك بكافة الملفات العسكرية والسياسية والاقتصادية، لكن حساباتها في إظهار براعتها بتقديم الحلول لسوريا لم تنتج إلا المزيد من التخبط، ليبدو كل ما قدمته خلال سنوات تواجدها مجرد ارتجال عشوائي يتضمن حقيقة واحدة هي تعميم الموت وإدارة حدوده عبر مسار أستانة، وتقسيم سوريا إلى أربع مناطق نفوذ ضمن حيز التفاهمات مع الدول الضامنة والمتنافرة، إيران وتركيا، والذي لم يجعلهم يكسبون الكثير بسبب رفض القوى المحلية الواقعة في بعض مناطق خفض التصعيد لرؤية روسيا وحلولها التي باتت تسير في الآونة الأخيرة نحو الانهيار الكامل وسط جملة من المتغيرات الدولية، أبرزها إعلان أميركا بقاء قواتها في وادي الفرات والمنطقة الشرقية الحدودية، المناطق الأغنى في سوريا بالنفط والغاز، حتى الانتهاء من تسوية الأزمة السورية والحدّ من التمدد الإيراني. أي السير بعيدا عن معطيات روسيا وتهديدها بخسارتها مكتسباتها، وأن زمن التفرّد الروسي بإدارة الصراع في سوريا قد انتهى.
هذه الرسالة التي فهمتها روسيا في المواجهة المحدودة مع واشنطن كانت أولى بوادرها التدمير الذي طال الطائرات الروسية في قاعدة حميميم، وما تلاه من مقتل نحو 200 مرتزق روسي من شركة فاغنر الأمنية باستهداف الطيران الأميركي لقوات موالية للنظام السوري قامت بقصف مراكز لوحدات سوريا الديمقراطية على مسافة نحو ثمانية كيلومترات شرق نهر الفرات، والتي باتت عمليا تحت إدارة أميركية.
اعتقدت روسيا خلال الفترة السابقة أنها انتصرت في مسارها، وامتلكت أوراقا تفاوضية تؤهلها لتكون شريكا ضامنا في إدارة مناطق خفض التصعيد التي أيدتها أميركا في حينها رغم تحفظها على دور إيران كدولة راعية لهذا الاتفاق، وأنها تستطيع من خلالها توسيع دائرة التفاهمات مع واشنطن حول مستقبل سوريا، متجاهلة أن تجميد القتال وتأجيل عملية الانتقال السياسي عبر جنيف وتحت مظلة الأمم المتحدة لن يدوم، فروسيا والدول الضامنة لمخرجات أستانة لن يكونا منفردين بإدارة الصراع وبتقرير مصير سوريا عبر تقاسم النفوذ، ما جعل هذه الدول التي استنزفت قوتها في سوريا أكثر ارتباكا وأكثر اندفاعا نحو المزيد من التصعيد للحفاظ على المكتسبات وتمتين الحدود لضمان السلامة والاستمرار لقواتها وقواعدها الموجودة على الأرض السورية.
وفق خطوط الخرائط والتفاهمات الغامضة لصياغة المعالم النهائية لمناطق النفوذ المقررة، تحولت سوريا إلى دويلات تحت الاحتلال ووصاية دول تستعجل الانتهاء من مناطق النزاع المحتملة خشية تصاعد قوى محلية تزيد تكلفة الصراع كما في عفرين وإدلب ومؤخرا في الغوطة.
فمناطق النظام والضامن الروسي تضم معظم المحافظات السورية والساحل ومعظم ريف دمشق وحمص وحماة وجزءا من محافظة إدلب، لذلك تشهد مناطق إدلب وريف حمص الشمالي هجمات ضارية لضمها إلى سيطرة النظام، لتكون أكثر الهجمات شراسة من نصيب الغوطة الشرقية آخر المعاقل الهامة للمسلحين في ريف دمشق التي تتعرض للقصف المستمر منذ خمسة أعوام ضمن استراتيجية النظام المتوافقة مع أهداف إيران وروسيا في السيطرة على مناطق “سوريا المفيدة” التي أطلقها عام 2013، والقاضية بتأمين حزام العاصمة دمشق التي باتت فعليا تحت الوصاية الإيرانية، والتخلص من أي أثر للمسلحين في كافة المناطق المحاذية لدمشق عبر الحصار والتجويع والمصالحات أو تحويلها إلى جحيم كما يحدث في الغوطة التي لم يتمكن مجلس الأمن من إيجاد حل دائم وفعال لإيقاف سيل الدماء فيها. فقرار مجلس الأمن بالتصويت على الهدنة المؤقتة لا يشكل خطوة نوعية للحد من القتال أو تجدده بعد حين.
الحلف القائم على تنفيذ مناطق “القتل الأقل” أصبح أكثر إصرارا على تثبيت حدوده، فحجم الخوف من التقلبات الدولية المرافقة للحالة السورية بما يشكله من خطر على مكتسبات هذا الحلف حتى الآن، حوّل سوريا إلى ذبيحة على طاولة التشريح لتمزيق جغرافيتها بين الدول المتداخلة وإدارة سلطة الأمر الواقع، عبر صبّ الويلات على الشعب السوري على الرغم من إدعائهم الحفاظ على وحدة سوريا والبحث عن مصالح السوريين وحقوقهم.
كاتبة سورية
العرب
سورية… “الترانسفير” الأخير/ مروان قبلان
مع احتدام التنافس بين الولايات المتحدة وروسيا، خصوصا في سورية، تتجه الأمور في المرحلة المقبلة إلى مزيد من التصعيد، فقد أدت العودة الأميركية إلى الساحة السورية، سواء ميدانيا، من خلال التمسك بمناطق شرق الفرات، عبر مليشيات قوات سورية الديمقراطية (قسد)، بعد اندحار تنظيم الدولة الإسلامية، أو سياسيا، عبر تشكيل لجنة خماسية، تضم إليها فرنسا وبريطانيا والسعودية والأردن، لمواجهة ثلاثي أنقرة- موسكو- طهران، أدت إلى إسقاط ما تسمى مناطق “خفض التصعيد”. ويمكن القول إن مسار أستانة الذي انشأته موسكو، بالتعاون مع تركيا بعد سقوط شرق حلب في ديسمبر/ كانون الأول 2016، وانضمت إليه طهران لاحقا، قد انهار فعليا.
كانت الغاية من إنشاء مناطق خفض التصعيد تجميد القتال في المناطق الأربع الرئيسة التي تسيطر عليها المعارضة (الغوطة الشرقية، إدلب، شمال حمص، وجنوب سورية الغربي)، ريثما تتوصل الدول الثلاث إلى تفاهم ينهي الصراع بضمان مصالحها. استفادت روسيا لتمرير هذا المشروع من غياب واشنطن عن المشهد، نتيجة تركيزها على هزيمة تنظيم الدولة الإسلامية في المثلث المتصل بحدود تركيا والعراق إلى الشرق من نهر الفرات. وقد جعل عدم مبالاة واشنطن بما يجري غرب النهر (من صراعات وتفاهمات بين حلفاء النظام وحلفاء المعارضة) موسكو تتحكم، عبر شريكيها الإيراني والتركي، بمسار الصراع في سورية.
لكن انتهاء الحرب على تنظيم الدولة الإسلامية رافقه تغير كبير في الاستراتيجية الأميركية، وبدل أن تنسحب واشنطن من المنطقة، كما توقعت موسكو، قرّرت البقاء. ليس هذا فحسب، بل ربطت انسحابها بالتوصل إلى حل في الصراع الدائر غرب النهر، وشرعت تحضر لوجود طويل، عبر بناء قواعد عسكرية، وإطلاق مشاريع لإعادة الإعمار، وتشكيل جيش محلي، قوامه وحدات حماية الشعب الكردية، رصدت له موازنةً كبيرة تصل إلى 550 مليون دولار.
استفزّت الخطوة الأميركية التي استأثرت لنفسها بثلث سورية الأغنى موسكو وطهران، كما أزعجت تركيا المتخوفة من التوجه الأميركي إلى بناء قوة كردية كبيرة على حدودها الجنوبية. وزاد الأمر سوءا بالنسبة إلى موسكو أن واشنطن بدأت تسعى إلى الانتقاص من “نصرها” في مناطق غرب النهر، في هجماتٍ طاولت قاعدتها الجوية في حميميم عشية السنة الجديدة، ثم إسقاط طائرة لها فوق إدلب، وأخيرا الضربة الموجعة التي وجهتها قوة أميركية إلى قوات المرتزقة الروس (جيش فاغنر) قرب دير الزور في السابع من فبراير/ شباط الجاري.
لكن كيف قاد هذا إلى انهيار مناطق خفض التصعيد؟ واقع الحال أن كل دولة من الدول المنخرطة في الصراع السوري بدأت تستعجل تأمين مناطق نفوذها، قبل أن تظهر تأثيرات العودة الأميركية على الساحة السورية على نطاق أوسع، فتغيرت الاستراتيجية من تجميد الصراع، ريثما يتم التوصل إلى اتفاق على تأمين مصالحها، إلى تأمين مناطق نفوذها تحسبًا من تغير المعادلات.
ليس ما يجري في الغوطة الشرقية، إذا، إلا محاولة “لتطهير” المنطقة من أي وجودٍ للمعارضة وحاضنتها، باعتبارها تقع ضمن مناطق النفوذ الروسية – الإيرانية. في الشمال الغربي تعمل تركيا على إخراج وحدات حماية الشعب الكردية إلى مناطق شرق الفرات، حيث حلفاؤهم الأميركيون. ويحتمل جداً لهذا السبب تحديدا، أن تشتعل بعد ذلك مناطق ريف حمص الشمالي، لاستكمال ترحيل فصائل المعارضة وحاضنتها إلى إدلب (منطقة النفوذ التركية). من غير الواضح ما إذا كان هذا سيشمل ترحيل البلدات والمليشيات الموالية لإيران الموجودة في إدلب (كفريا والفوعة) إلى مناطق النفوذ الإيرانية في الجنوب، وهو مقترحٌ إيراني في الأصل، تم طرحه في العام 2015 لتبادل السكان مع الزبداني قبل التدخل العسكري الروسي. ما يجري إذا هو عملية إزاحة (أو ترانسفير) لكتل سكانية كبيرة بين مناطق النفوذ التي تسيطر عليها القوى المتنافسة في سورية، بحيث تخلو من أي وجود معارض لها.
بقصدٍ أو من غير قصد، أسقطت واشنطن مناطق خفض التصعيد، من دون أن توفر، في المقابل، آلية بديلة لحماية المدنيين من وحوشٍ على هيئة بشر، ولا يبدو أنها مهتمة بتوفيرها، بدليل المسرحية التي تقودها في مجلس الأمن المندوبة الأميركية، نيكي هيلي، التي ترفع الصوت في وجه نظيرها الروسي، لكنها توافق، في نهاية المطاف، على سياسات بلاده، كما حصل في التعديلات على قرار مجلس الأمن 2401 والتي جعلت الهدنة عديمة الجدوى.
العربي الجديد
هل أسقطت الغوطة العيش السوري المشترك؟/ سميرة المسالمة
واجه المجتمع الدولي أزمة سقوط قيمه الإنسانية في الأمم المتحدة خلال جلسة مجلس الأمن يوم الجمعة، 23 فبراير/ شباط الجاري، والتي أجل التصويت خلالها مرات عديدة على قرار بمنع القتل للمدنيين شهرا واحدا فقط، حيث قبل الأعضاء أن تتحول جلسة لمناقشة الواقع المأساوي في الغوطة، لتصبح جلسة مساومة وابتزاز روسية ليس فقط للسوريين، من أهالي مئات الضحايا الواقعين تحت القصف الروسي – الإيراني، المحاصرين غذائياً ودوائياً من النظام السوري، وإنما هي ابتزاز ومراهنة على ضعف موقف المجتمع الدولي الذي يتحدث بلغة لينة وممزوجة بالرجاء من قاتلٍ يشاهد العالم جريمته، عبر بث حي ومباشر من الغوطة الشرقية بكل مدنها وحاراتها.
ولا تقف الجريمة الروسية بحق السوريين عند ارتكاب المجازر وتوزيع المآسي على مساحة سورية، حيث يصل الطيران المحمل بأنواع الأسلحة الجديدة التي تختبر على أجساد السوريين الحية، بل أيضاً بالقفز إلى ما بعد هذه الوحشية العسكرية، وصولاً إلى تدمير ممنهج لأي تعايش مستقبلي بين السوريين، حيث يغذّي مندوب روسيا في الأمم المتحدة فكرة أن ما يحل بمناطق دمشق من سقوط لقذائف تستهدف المدنيين يتحمل ضحايا الغوطة المحاصرون مسؤوليتها، ما
“درس واضح، تريد موسكو أن تلقنه للجميع، دولاً ونظاماً ومعارضة، أن وباء التوحش قابل للتطوير بين جميع من هو حاضر في المقتلة السورية”
يعني التأهيل للقبول بمخططات إيران في عملية التغيير الديمغرافي التي اتبعتها منذ بداية تدخلها في سورية في العام 2011، ومفاعيل واقعة المدن الأربع التي رعتها إيران وحزب الله مع جبهة النصرة لا تزال مستمرة، وقبلها ما حدث في حمص من تغيير ديمغرافي، تلا المجازر الوحشية التي قامت بها مليشيات إيرانية وحزب الله.
وإلى هنا، يبدو المشهد بكل ما فيه من ألم، لم يخرج عن المألوف، عند السوريين الذين عايشوا الحرب المعلنة عليهم منذ الأسابيع الأولى من انطلاقة صيحات الحرية، ومواجهتها بالرصاص الحي وكامل عتاد الجيش السوري، إلا أن ما يزيده استغرابا ووجعاً كان التمظهر الحقيقي لانقسام المجتمع السوري، وقدرة هذه السنوات السبع على إزاحة ستار الوحشية، عما يخالج المصطفين إلى جانب الآلة العسكرية الروسية والإيرانية، ومعهم النظام، التي تسحق أرواح أطفال الغوطة ونسائها وشيوخها، من دون تمييز بينهم وبين حاضنتهم الغوطة موقعا مكانيا لهم، أي أننا أمام حالة من انفصام إنساني تجعل من سوريٍّ يرى في جريمة قتل طفل إنقاذاً لحياته، ولا يرى في وجوه الضحايا ما يحفّزه على استنكار مدى الوحشية في أسلوب قتلها على أقل تقدير إنساني، ما يستوقفنا اليوم أمام فاجعات علينا مواجهتها والتفكير إنسانياً في سورية ما بعد المجازر، قبل التعاطي مع سورية دولة واحدة محتملة الاستمرار قانونياً.
ومن تلك الفواجع المؤسفة أننا أمام سؤال جاد، عن حقيقة مشاعرنا، نحن السوريين تجاه بعضنا بعضاً، وإمكانية أن نستمر في طلب العيش المشترك ضمن دولةٍ يسودها قانون واحد، وحكومة واحدة لا نعرف إلى أيٍّ من الانقسامات السورية تميل، وقد انقسمنا بين مؤيد ومعارض لجرائم ترتكب بحقنا، على اختلاف القتلة، و تنوع الضحايا بانتماءاتهم المذهبية والإيديولوجية والمناطقية والقومية؟
وهل يمكن التبرير للعنف السائد من النظام بأنه أزاح اللثام عن حجم المدفون سورياً، من مشاعر رفض للآخر، سواء كان هذا الآخر من جماعة تتحد في موقفها إيدولوجياً، أو مصلحياً، أو مذهبياً، في مواجهة آخر يرفض سلوكاً سلطوياً؟ وكيف يمكن الجمع بين متناقضات سلوكية وأخلاقية في الحاضنة الواحدة نفسها التي تقبل بقتل طفل “سنّي” من حاضنة الثورة، بينما ترفض قتل طفل آخر من حاضنة النظام، بمبرّر أن من يقتل السني في الغوطة وإدلب وحوران هو من قوى السلطة الحاكمة، بينما تلقى التهم جزافاً على كل المعارضة بأنها مسؤولة عن قذائف مجهولة الهوية، بينما واضح الهدف الذي يزيد عمق الشرخ المجتمعي؟
وعلى الجهة المقابلة وبالمواجهة الصريحة، لا بد من السؤال: كيف نفهم أن الحاضنة الشعبية للثورة يمكن أن تتفهم جرائم بحق أطفال من كرد سورية في عفرين، بينما تدين وتطالب بلجم إرهاب النظام وروسيا وإيران في الغوطة؟ هل تحول الانتماء السوري من انتماء إلى الوطن الذي يعني المواطنين الذين يتشكل منهم ذلك الوطن الذي يبدو جزءا من خيال حكايات الجدات ليس إلا، إلى الانتماء إلى القاتل ومذهبه وسياسته وداعميه، وحتى خياناته؟
في الغوطة، ثمّة درس واضح، تريد موسكو أن تلقنه للجميع، دولاً ونظاماً ومعارضة، أن وباء التوحش قابل للتطوير بين جميع من هو حاضر في المقتلة السورية، لأنها تستطيع تعويمه وتدويله والتأسيس لقبوله، ليس بالصمت الدولي فقط، ولكن أيضاً بالقرارات الدولية “المرنة” المعدة سابقاً لمصلحة التفسيرات المتناقضة بين المتوافقين عليها، وقد حدث ذلك منذ بيان جنيف1، وصولاً إلى كل القرارات الأممية من 2218 حتى 2254 والبيانات اللاحقة من عواصم مختلفة غربية وأميركية، وحتى عربية.
وفي اجتماعات مجلس الأمن، ثمّة دروس دولية للسوريين على ضفتي الصراع، أن هذا المصير القابل للتصعيد ليس خارجاً عن السيطرة، بل هو يسير ضمن سياقه المرسوم عبر
“المطلوب أكثر من العودة إلى حضن الاستبداد كرعية مهزومة، بل القبول والتسليم بأن القاتل هو الضحية، وأن الضحايا أعداد لم تكن إلا ضالة”
إخضاع كل الأطراف لمعادلات دولية دقيقة الحسابات والتكلفة، ناتجها الأخير القبول بالتسليم وليس الاستلام، التسليم بأننا، نحن السوريين، أدوات مخطوفة بيد دول عدوة وصديقة، وأن حجم تعاطفنا مع قضايانا، ولو كلامياً، يمر من مصفاة تلك الدول الراعية للصراع واستمراريته، والتي ترى في قتل السوريين السنة في الغوطة وإدلب وحماة وحلب مكافحةً لإرهاب مستقبلي، يهدّد علمانية النظام الفئوي القائم، وفي الوقت نفسه، هناك من الضحايا من يبرّر قتلاً آخر على أساس قومي ومذهبي، وحتى نوعي!
وعلى ذلك، فإن الاستسلام للنظام بشكله الحالي ليس حلاً مطلوباً، حتى من النظام الحاكم، لأن ما هو مطلوب أكثر من العودة إلى حضن الاستبداد كرعية مهزومة، بل القبول والتسليم بأن القاتل هو الضحية، وأن الضحايا أعداد لم تكن إلا ضالة.
نعم، من تلك الفواجع أن وحشية القاتل التي يدافع عنها مندوب موسكو في جلسة مجلس الأمن ليست أكبر فواجعنا، وإنما بقبول أن يمارس بعض ضحايا الاستبداد من السوريين دور المتفرج والمتفاعل والمنفعل بهذه الجرائم، من الغوطة الشرقية حتى إدلب وعفرين، ليس إلى جانب الضحية الإنسان، وإنما إلى جانب القاتل، وقد تعددت تسمياته، وتنوعت جنسياته، ويتحول هؤلاء الضحايا من المؤيدين لأي قاتل في سورية، أيضاً، إلى جوقة من المصفقين، كلما ازداد صوتها ارتفاعاً عرفنا أن سورية الواحدة الموحدة شعباً التي نأملها، تنازع أمام خيار الحفاظ على حياة بعض طفولة مغدورة، فهل أسقطت الغوطة آخر ما تبقى من حديثٍ عن حياة مشتركة بين السوريين؟
العربي الجديد
روسيا ومسؤولية تقسيم سورية/ محمود الوهب
يندهش المواطن السوري، ومن يقف إلى صفه، من هذا التوحش الروسي/ السوري غير المسبوق في غوطة دمشق الشرقية، إضافة إلى المماطلة الديبلوماسية الروسية، وعرقلتها قرار مجلس الأمن ذا المحتوى الإنساني أولاً، وكذلك محاولتها كسب الوقت، وابتزازها المجتمع الدولي لمكاسب سياسية، إذ لم يصدر القرار، في النهاية، إلا بعد إدخال عبارات مطاطية عليه، وما كان له أن يخرج لولا ضجيج حملات الإدانة الدولية الواسعة، وربما التهديد المحتمل من دول أكثر قدرة.. ومع ذلك، استمر الطرفان: روسيا والنظام بقصف المدنيين، وقتل الأطفال. ولعلَّ السوريين يتساءلون، أيضاً، عن الأسباب العميقة لتلك الحملات العسكرية الروسية الهمجية.
بدايةً، لا بد من الإقرار، وخصوصاً ممن لا تزال تغطي بصرهم وبصيرتهم غشاوة ما، بأن روسيا اليوم، وبعد المتغيرات الدولية الحاصلة في العالم مع القرن الحادي والعشرين، قد غدت، وبوضوحٍ لا ينقصه أيُّ دليل، الوَجْهَ الآخرَ لأميركا فيما يتعلق بالعدوانية تجاه الشعوب الأخرى، وفي البحث عن مناطق نفوذ جديدة، وأسواقٍ لبيع الأسلحة الفتاكة، وأخذ “خوَّات” من حكومات الشعوب القادرة على الدفع، إضافة إلى البحث عمَّا يمكِّن المافيات المالية المتكوِّنة خلال العقدين الماضيين، من عقود استثمار، وشراكاتٍ تنافس سواها من شراكات دول العالم العظمى.. لا بل إن الوحشية الروسية جعلت أميركا تُزايِد على روسيا اليوم بمواقفها الإنسانية، انطلاقاً مما يرتكب في سورية من مجازر.
أما ما يفسر صمت العالم اليوم تجاه سلوك روسيا، وعدم اتخاذه موقفاً عملياً، فليس “الفيتو”
“روسيا والنظام وحدهما مسؤولان، لا عن القتل فحسب، بل عما يجري من أعمالٍ تقود إلى التقسيم”
الروسي الذي أطال أمد المأساة السورية، فجعل منها حرباً دولية يتحمل السوريون وحدهم أوزارها، بل لأن روسيا، وعلى الرغم من سعيها إلى كسب حصص أكبر لها ولشريكيها، النظام وإيران، فإنها لا تتجاهل نصيب الآخرين.. فها هي ذي الجيوش الأجنبية ومرتزقتها تتناهش الأراضي السورية من أطرافها كافة، بينما لا ترى روسيا غير مدنيي غوطة دمشق، لتهدمها فوق رؤوس أهلها. بسبب مائتي مسلح من جبهة النصرة يمكن إخراجهم بألف وسيلة غير قتل الناس.
ما يراد قوله هنا إن روسيا والنظام وحدهما مسؤولان، لا عن القتل فحسب، بل عما يجري على الأرض من أعمالٍ تقود إلى تقسيم سورية، فالقادة الروس الذين يعرفون الوضع السوري أكثر من غيرهم لم يتعاطوا مع المبادرات السلمية، سواء ما جاءت بها جامعة الدول العربية أو الأمم المتحدة، بل أخذوا بالمماطلة والتذرع بأسباب واهيةٍ لا تصمد أمام الواقع الذي كان، ودافعهم الوحيد لفت الانتباه إليهم قوة عظمى جديدة لا علاقة لها بالقيم الإنسانية، بل بالمصالح المتعارف عليها بين الدول.. إضافة إلى أنها تريد الانتقام لنفسها من أميركا والغرب عموماً الذين غدروا بها، حين تعاطوا مع الكعكة الليبية (أعلنت ذلك صراحة). وتدرك روسيا جيداً أنَّها لا تستطيع التفرد بسورية وحدها، وأن الفيتو المعطل في مجلس الأمن لا ينفع بمفرده. ولذلك تستطيع هي، وبما تملكه من قوة ونفوذ في سورية، ومن فهم لطبيعة نظامها السياسي، أن تكون الشريك الأقوى للأطراف الأخرى، وخصوصاً للولايات المتحدة، وهي إذ تدرك خبث السياسة ومكرها، وضلوعها في ذلك عميق، تراها لم تفسح في المجال لوجود المتطرفين الإسلاميين في سورية فحسب، بل ساهمت بوجودهم الأممي، وعملت، على نحو غير مباشر، وبما لا ترغب به، ولا تشتهيه. وأعني بذلك إدخال الولايات المتحدة الأميركية شريكاً لا تعوزه خبرة الدخول ومبرّراته.. أميركا التي لم يكن لها موطئ قدم واحدة على الأرض السورية طوال عقود الصراع على سورية، باستثناء شركات تنقيب عن النفط، وعبر عقود رسمية جاءت بمبادرة من حافظ الأسد.. ومن هنا، يدرك المتابع أنَّ إدارة أميركا الظهر للمسألة السورية منذ البداية، مكتفية بمكنتها الإعلامية، وتصريحات سياسييها. ولعلها لم تعمل جدياً إلا في حدود مصلحة إسرائيل وادعاء أمنها، و(جريمة الكيميائي الأولى خير مثال). وحتى حين تدخلت روسيا عسكرياً في سبتمبر/ أيلول من العام 2015 لم تحرّك ساكناً.. بل لعلّهاَ رغبت في دفعها إلى المستنقع الذي هو الأقرب إلى مستنقع أفغانستان، مع عدم إغماض العين عن حصتها المرتقبة، ولعلَّ الدولتين متفقتان، سراً، على الرغم من اختلاف النيات.
اليوم، وبعد أن اتضحت الصورة، يتحدّث الإعلام السوري عن تقسيم دول المنطقة، بدءاً من تقسيم فلسطين ومروراً بالعراق، وليس انتهاء بالسودان.. ويلقي أسباب ذلك على الاستعمار من دون أي إشارةٍ إلى الأسباب العميقة المتعلقة بحكام تلك الدول، ولا إلى ما قد حدث ويحدث في سورية.
وإذا كان لفلسطين وضع خاص، فإن أمْرَيْ العراق والسودان، وربما القادم إلى سورية يختلف، إذ إنَّ مردّ ذلك يعود، بالدرجة الأولى، إلى الحكام المستبدين الذين صادروا الحريات السياسية، وعملوا على إشاعة الفساد ونهب المال العام، بأيدي شركائهم من المقربين، وكانوا أبعد ما
“بعد أن اتضحت الصورة، يتحدّث الإعلام السوري عن تقسيم دول المنطقة، بدءاً من تقسيم فلسطين ومروراً بالعراق، وليس انتهاء بالسودان..”
يكون عن بناء دولٍ يتساوى فيها المواطنون من دون أي تمييز.
أذكر أنني كتبت في أكتوبر/ تشرين الأول 2014 مقالة عنوانها “دمشق تكفيني”، في إشارة إلى التقسيم الذي لاحت معالمه، وجاء فيها: “من يدقق فيما آلت إليه الأمور يدرك أن لسان حال النظام هو أن لا عودة عن الحل الأمني بالمطلق، وإن أضحت البلد يباباً، ولا رجعة عن التمسك بكرسي الحكم، وإن كان على كومة أحجار، وبقايا مدن. وحتى إذا غدا الوطن أوطاناً، وهو هكذا في الواقع العملي الآن، فماذا يعني أن تقطّع أوصال المدن، أو فيما بينها، على نحو قطعي، وأن تسافر، مثلاً، من حلب النظام إلى حلب المحرّرة (التسميات المستخدمة آنئذ) في مدة تتجاوز عشر الساعات، وأن تدفع عشرة أضعاف الأجرة الفعلية؟! إن ذلك يشير إلى أمر واحد هو: شبح التقسيم، أو شكل من أشكاله الذي يخيم على أجواء البلاد، وماذا يعني هذا القصف الجهنمي لمنطقة الوعر حيث يقيم ما تبقى من سكان حمص الذين دُمرت أحياؤهم وهُجِّروا قسراً؟ ثم بماذا نفسر ما يجري حول دمشق تحديداً من حرب ضروس لا تبقي ولا تذر، يشنها الجيش على قاعدة ما يعرف بسياسة الأرض المحروقة، غير المضي نحو قرارٍ كهذا؟ وبماذا نفسر، كذلك، ما يحدث في المحافظتين الساحليتين من تحصين وترحيل لمنشآت صناعية حلبية وحمصية ودمشقية أيضاً إليهما؟”
يتباكى النظام اليوم على وحدة البلاد التي أوصلها برعونته، وبالأجنبي الطامع الذي استعان به، إلى حافة التقسيم، وبعد أن تحدث رأسه عن مصطلح “التجانس”، (تجانس مواطنيه) الذي لا يلتقي مع مفهوم المواطنة، ولا يؤكد إلا نفي المواطن الآخر الذي لا يقبل أن يكون عبداً في وطنٍ تحوَّل إلى مزرعة خاصة.
كاتب وصحفي وقاص سوري، له عدد من المؤلفات والمجموعات القصصية
العربي الجديد
سؤال الغوطة الكبير/ إياد الجعفري
سألني صديق يقطن في الغوطة الشرقية، إلى أين تتجه الأمور في رأيك؟.. قلت له، ببساطة، “أنتم من سيقرر إلى أين ستذهب الأمور”.
قد يكون سؤال الغوطة الكبير، الذي يشغل تفكير المراقبين للتطورات في شرق دمشق: هل ستكرر الغوطة تجربة شرقي حلب؟
وتنقسم الإجابات في اتجاهين، كل اتجاه يستشهد بمؤشرات تؤكد وجهة نظره. فأولئك الذين يعتقدون أن الغوطة لن تكون حلب ثانية، يؤكدون أن مقومات الصمود المتاحة لفصائل الغوطة، ولمدنييها، أكبر بكثير من تلك التي كانت متاحة في حالة شرقي حلب. وفي الاتجاه نفسه، يتحدث البعض بتفاؤل عن تعاظم الضغوط الغربية على الروس، ويغمز أحدهم من قناة وصول حاملة طائرات أمريكية إلى المتوسط، رغم أن الأخيرة وصلت إلى المنطقة في إطار مناورات مشتركة مع الإسرائيليين، محددة الموعد سلفاً، وتجري للمرة التاسعة منذ العام 2001. لكن تزامن وصول حاملة الطائرات تلك، مع تصريحات أمريكية وأوروبية داعية لمعاقبة الأسد لاستخدامه الكيماوي، رفع من رهان البعض على تدخل غربي، أو تلويح بتدخل، قد يلجم الهجمة على الغوطة.
في هذه الأثناء، لا يبدو أن الأمريكيين قريبون من أي تحرك عسكري جاد. فهاهم يفتتحون حراكاً دبلوماسياً جديداً في مجلس الأمن، لإقرار مشروعي قرارين دوليين، أحدهما بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، بهدف إعادة إحياء التحقيق الدولي بخصوص استخدام السلاح الكيماوي في سوريا، ومعاقبة الفاعلين. قراران من المرتقب أن تعرقلهما روسيا مجدداً، بالفيتو، إن لم يقبل الغرب إجراء تعديلات جوهرية في بنودهما، كالعادة.
هذا الحراك الدبلوماسي الأمريكي، الذي سيخوض معارك تفاوضية ماراتونية قد تدوم لأسابيع مع الروس، وقد يُجهض في نهاية المطاف، بفيتو روسي جديد، إنما يؤكد أن الأمريكيين يراهنون بصورة رئيسية على القوة الناعمة، في صراعهم البارد مع الروس والإيرانيين، في سوريا. وأنهم يريدون فقط تسجيل النقاط على الروس، لإحراجهم في مجلس الأمن، أو توريطهم في قرارات دولية، ضعيفة، على المدى المتوسط، لكن لها تداعياتها على المدى البعيد. وهكذا يبدو حراك الأمريكيين في مجلس الأمن، حراكاً بارداً جداً، مقارنة بسخونة المعركة في الغوطة.
هل يعني ذلك أن الأمريكيين، لا تعنيهم الغوطة؟.. أيضاً، من سيقرر الإجابة على ذلك، هم أولئك القابعون في الغوطة ذاتها، من مدنيين، وفصائل مقاتلة. فالغوطة، لا تملك قيمة استراتيجية ملحة في أجندات الأمريكيين، في الوقت الراهن. لكن أولئك القابعين في الغوطة، قد يفرضونها على أجندات الأمريكيين، حتى ولو على مضض من الأمريكيين أنفسهم.
الأمريكيون يحترمون القوي، ويعقدون معه الصفقات، وإن كان بينهم وبينه خلافات، فهم مستعدون للتفاوض معه، لحلها، أما إن كانت بينهم وبينه مصالح مشتركة، فأهمية التحالف معه تزداد. في حالة الغوطة، فإن صمود الفصائل المقاتلة، والمدنيين، وتحوّل الغوطة إلى غصّة في حلق بوتين، قبيل الانتخابات الرئاسية في روسيا، سيرفع من أسهمها في نظر الأمريكيين. ويجعلها ذات قيمة استراتيجية أكبر. وترتيب تفاهمات وعلاقات وطيدة مع فصائلها المسلحة، سيكون في قائمة أجندات الأمريكيين، حينها، دون شك.
يهتم الأمريكيون بإحراج بوتين، وهو يخوض أسابيعه الأخيرة، من حملته الانتخابية الرئاسية. لكن ذلك لا يهمهم إلى الدرجة التي تدفعهم للتدخل العسكري المباشر، والاقتراب من مخاطرة التصادم مع الروس. لذلك، لا يمكن لأحد أن يراهن على تدخل أمريكي مباشر من أجل الغوطة، إلا في حالة واحدة فقط، أن تحصل مجزرة كبرى، جراء استخدام الكيماوي، تحديداً، على غرار ما حدث في العام 2013.
وكلما ارتفع حجم الخسائر البشرية في الغوطة، من المدنيين، كلما ازدادت الضغوط على الروس، وكلما أصبح الأمريكيون أقرب للتدخل المباشر. لذلك نلاحظ أن عدّاد القتلى اليومي انخفض نسبياً، في الغوطة، بعد صدور القرار الدولي الأخير، 2401، الذي نص على ترتيب هدنة في كامل الأراضي السورية.
القرار لم يُحترم من أحد. لا من الأتراك شمالاً، ولا من الروس والإيرانيين والأسد في الغوطة. لكن، معدل الخسائر البشرية في أوساط المدنيين، أصبح أقل نسبياً، مقابل تصاعد محاولات التوغل البرّي للنظام داخل الغوطة. أي أن النظام والروس، خففوا من وتيرة القصف العشوائي، الذي كان يهدف أساساً إلى تحطيم معنويات الحاضنة الشعبية للفصائل المسلحة، ودفعها للضغط على مقاتليها وقياداتها، باتجاه الوصول إلى تسوية، أياً كان الثمن. تخفيف وتيرة القصف العشوائي، كانت نتيجة للقرار الدولي. وفي المقابل، بات النظام مضطراً، بغطاء جوي روسي، لأن يُوغل برياً في الغوطة، وينتقل من القصف العشوائي إلى القصف المركز على الجبهات التي يتم فيها القتال المباشر.
وحتى الآن، لم تنجح هدنة الساعات الخمس، التي أعلنتها روسيا، في دفع المدنيين للنزوح. وهنا يطرح البعض سيناريو محتملاً بقوة. أن يكثّف الروس من جديد، استراتيجية القصف العشوائي على المدنيين، خارج ساعات الهدنة الخمس، كي يدفعوا بالمدنيين، في نهاية المطاف، إلى النزوح خلال ساعات الهدنة. لكن ذلك سيتطلب رفع عدّاد القتلى المدنيين، من جديد، وتصاعد الضغوط على الروس دولياً، بالتزامن مع موعد مراجعة تنفيذ القرار الدولي، 2401، الأسبوع القادم. الأمر الذي سيعرض الروس لضغوط شديدة. يأتي ذلك بالتزامن أيضاً، مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية في روسيا، التي ستجري منتصف الشهر الجاري، والتي لا بد أن بوتين، لا يحبذ خوضها، وصور القتلى المدنيين، المؤلمة، تملأ وسائل الإعلام والتواصل، حول العالم.
لذلك من المرجح أن يراهن الروس، في الأيام القليلة القادمة، على تحقيق توغل برّي نوعي داخل الغوطة، بدلاً من استراتيجية القصف العشوائي، التي تسيء للغاية، لصورة روسيا، دولياً.
في الساعات الأخيرة، سُجل تراجع ميداني نوعي، لفصائل المعارضة، في الشيفونية، بالغوطة. لكن ما يزال من المبكر الجزم بمسار المعارك الميدانية. فالمنطقة مرشحة، وبامتياز، لأن تكون وكر استنزاف مكثّف لمقاتلي النظام والميليشيات الداعمة له.
وباختصار، سيقرر أهالي الغوطة، وفصائلها، مصيرها، وربما مصير جزء كبير من مستقبل سوريا. فصمودهم، وقدرتهم على صد توغل النظام، وإفشال الهجمة الراهنة، سيمثّل خسارة نوعية لنظام الأسد وحليفيه الإيراني والروسي. وسيمثّل صفعة قاسية لـ بوتين، قبيل الانتخابات في بلاده. وسيرفع من أسهم فصائل الغوطة، في حسابات الداعم الغربي، وحلفائه الإقليميين.
أما خلاف ذلك، فهو يعني انعطافة نوعية جديدة، باتجاه تصفية الحراك المعارض المسلح، وحاضنته الشعبية، لصالح مشهدين رئيسيين في سوريا، الأسد وحليفيه الإيراني والروسي، والأكراد وحليفهم الأمريكي.
المدن
أبعد من عفرين وسوتشي والغوطة/ محمد ديبو
يكاد التدخل التركي الحالي في سورية يكون بؤرة مكثفة للحال الذي وصلت إليه قضيتنا السورية، خصوصا أن الفشل الذريع لمؤتمر سوتشي (للحوار الوطني السوري!) جاء ليضيف الكثير عن صورة أحوالنا التي تزداد قتامة، وكأن قطار سورية يجري عكس التاريخ، ويوغل في الابتعاد عن أحلام السوريين وحقهم العادل في الحرية والكرامة.
أول ما يقوله التدخل التركي إن حال التقاسم الإقليمي والدولي لسورية مازال قائما، على الرغم من أنه يكاد يصل إلى سكّته الأخيرة، بعد أن أخذت تركيا، بتدخّلها الراهن، ما كانت تطالب به دائما، أي النفوذ في الشمال ومنع الأكراد من التمدد غرب الفرات، وربما منطقة آمنة ذات نفوذ تركي مستقبلا. هكذا يكتمل التحاصص الدولي الإقليمي، إيران وروسيا في “سورية المفيدة”، وأميركا في غرب الفرات، فيما يقطع التركي حصته اليوم من اللحم السوري الحي أيضا، متغاضيا عن القصف الروسي لإدلب وجوارها، وأيضا عن العنف الوحشي في الغوطة الشرقية. هذا يؤكد، مرة أخرى، ما بات مؤكدا منذ زمن، أن سورية اليوم ملعب مفتوح لكل القوى، وأن الجميع يلهو بالدم السوري، لتحقيق مصالحه لا غير، ما يعني أن مقاربة المسألة السورية من باب الحرية والكرامة والديمقراطية فقط، لم يعد أمرا قابلا للتداول والتصريف السياسي، ما لم يتبع بالتحرّر من هذه الاحتلالات كافة، وهذا يستلزم رؤية واستراتيجية
“إزالة الاستبداد شرط أساس للبناء لكنه ليس كافيا”
جديدتين، لا يبدو اليوم أبدا أن المعارضة السورية بكل أطيافها تملكها أو تسعى إلى امتلاكها حتى، ما يعني أن أحوالنا مرشحة لمزيد من التدهور، خصوصا أن المنطقة كلها اليوم تذهب باتجاه إعادة إحياء الإمبراطوريات والاستعمار بشكله الأكثر رثاثةً، أي الاحتلال المباشر.
وسيوضح تأمل التدخل التركي، من هذه الناحية، لنا أن تركيا الأردوغانية اليوم وضعت اللبنة الأولى في مشروعها الإمبراطوري العثماني الذي يسعى أردوغان إلى إعادة إحيائه، وإن تأمل هذا التدخل، بالتوازي مع القواعد العسكرية التركية التي تأسست في الإقليم، يبين أن المارد التركي عاد ليكون لاعبا محوريا بعد انكفاء طال قرنا، وهذا ما يطمح له أردوغان، أن نكون أمام تركيا مختلفة كليا في عام 2023، توازيا مع الذكرى المئوية للجمهورية التركية.
ما سبق يجعل المهمة السورية صعبة وشاقة، لأن السؤال هنا: من الصديق ومن العدو للسوريين اليوم، من هذه القوى (روسيا، أميركا، تركيا، إيران)؟ إن تأملا في هذا الأمر يوصلنا إلى أن لكل فئة سورية أصدقاءها الذين هم أعداء للفئة السورية الأخرى، ما يستدعي سؤالا آخر: كيف يمكن بناء استراتيجية تجمع السوريين والحال كهذه؟
من جهة أخرى، أضاف التدخل التركي مزيدا من الملح على الجرح الكردي العربي، وهو جرح بقي مفتوحا طوال القرن الماضي، من جرّاء عدم قدرة الكرد على بناء دولتهم القومية، وعلى وقوعهم تحت نير أنظمة استبدادية أذاقتهم الويلات، فكانت الثورة المناسبة التي يمكن أن تعيد إلى العدل قوته. إلا أن قوة التأثيرات الخارجية والداخلية (الضدية للتغيير)، باعدت بين
“المارد التركي عاد ليكون لاعبا محوريا بعد انكفاء طال قرنا”
العرب والكرد، وأبعدت الاثنين عن إمكانية تحقيق أي شيء، حيث كان الآخرون المستفيد الوحيد من خلافهما، من دون أن يتعلم أي منهما من دروس التاريخ. والأكثر ألما هذا الإصرار على التجريح والتخوين والأبلسة، بعيدا عن محاولة البناء بحثا عن مشتركات للعيش سويا، أو حتى للانفصال بسلام، لنصبح أمام جسد اجتماعي متهتك: علوي سني، سني شيعي، كردي عربي، أقلية أكثرية.. وكأن كل مفردات الديمقراطية والعلمانية والتعايش والمواطنة ليست أكثر من حبر على ورق، ما يطرح أسئلة أخرى: لماذا فشلنا في بناء المواطنة؟ ولماذا لم نتمكّن من إيقاف هذا الجرح حتى بعد تضعضع قوة الاستبداد؟ وهل عدم ثقة المكونات ببعضها بعضا يعود إلى المستبد وحده، أم الأمر أبعد من ذلك حقا؟
يمكن القول إن مقاربة مسألة البناء والسعي إلى إيجاد مشتركات وطنية أو مشتركات للتعايش لا تختزل بمسألة الاستبداد فحسب، فإزالة الاستبداد شرط أساس للبناء، لكنه ليس كافيا، لأن حجم القوى والأفكار الضدية التي نحملها، والموروثة منذ قرون طويلة، تشكل أحد أسباب الإعاقة التي نرقد في هوّتها اليوم، وهي الأفكار التي ساعدت المستبد والقوى الدولية والإقليمية على الفتك بنا، وضللتنا عن السير نحو أهدافنا، إذ لا يمكن فهم ما يحصل في عفرين اليوم بعيدا عن إيمان بعض الكرد بأن قوةً ضديةً، كحزب الاتحاد الديمقراطي، يمكن أن تحمل أملا لقضيتهم، وهو ما يوازيه إيمان بعض العرب أن تشكيلاتٍ، مثل فتح الشام وأحرار الشام والجبهة الإسلامية، يمكن أن تحمل خيرا لقضيتهم في الحرية والكرامة. علينا أن نمتلك شجاعة الاعتراف بأن هذه الأفكار والطرق التي سلكنا ساهمت في إيصالنا إلى ما نرقد فيه، ما يستدعي رؤيةً مركبةً تعرف كيف تواجه الاستبداد، باعتباره سلطة غاشمة، بالتوازي مع مواجهة سلطة تلك الأفكار التي نحملها في رؤوسنا وضديتها، وهي الأفكار التي تشكل عائقا أمامنا، فالمعركة ليست ضد المستبد وعلى المستوى السياسي فحسب، بل أيضا على مستوى الوعي والقيم والتنوير، أي على مستوى المجتمع، وبالتوازي أيضا.
العربي الجديد
معركة الغوطة الشرقية.. دوافعها وعوامل الصمود
2018-03-01 | المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات
تتعرّض غوطة دمشق الشرقية، منذ مطلع شباط/ فبراير 2017، لهجوم عنيف، في ما يبدو محاولةً من النظام وحلفائه لاقتحامها والسيطرة عليها، عبر الاستهداف الناري الكثيف للحاضنة الشعبية؛ من أجل الضغط على الفصائل المسلحة، حتى تقبل بالخروج منها. وقد أدى القصف الجوي والمدفعي، حتى الآن، إلى سقوط أكثر من 600 شهيد، أكثرهم من الأطفال والنساء. ويسعى النظام، كما صرح مندوبه الدائم في الأمم المتحدة، بشار الجعفري، إلى تكرار سيناريو شرق حلب؛ إذ أدى القصف الجوي الروسي الكثيف إلى إجبار الفصائل المسلحة على مغادرة المدينة، وإجلاء أهلها عنها. فهل يتكرر سيناريو حلب في غوطة دمشق الشرقية؟ أم هل يمكنها الصمود والاستمرار في المقاومة؟ وما هي عوامل الصمود في هذه الحالة؟
حصار الغوطة
تقع الغوطة الشرقية، كما يدل اسمها على ذلك، في شرق مدينة دمشق، وسُميت بهذا الاسم لأنها بساتين غنّاء من أشجار مثمرة تحيط بمدينة دمشق، وقد كانت تشكّل تاريخيًا جزءًا من حزامها الأخضر (إلى جانب الغوطة الغربية)، وسلّة غذائها الرئيسة، وتبلغ مساحتها نحو 110 كيلومترات مربعة، وتضم مجموعة من المدن والبلدات، أكبرها دوما التي تُعد عاصمة إدارية للمنطقة، وحرستا وغيرها من المدن والبلدات التي يصل عددها إلى عشرين مدينة أو بلدة. يشتغل معظم أهلها، وقد كان عددهم قبل الثورة أكثر من مليوني نسمة، في الزراعة. اشتهرت غوطة دمشق بمقاومتها الشديدة للاحتلال الفرنسي. وبالنظر إلى أنها غطاء أخضر متصل بالبادية، مثّلث ملجأً آمنًا للثوار على مر العصور. كانت غوطة دمشق من أوائل المناطق التي ثارت على النظام في آذار/ مارس 2011، بسبب الظلم الذي لحق بها من سياساته الزراعية، وتمليك الأراضي لمشاريع رجالات النظام، واتباع سياسة الاستيراد لبضائع تنتج فيها مثل الأثاث وغيرها. وقد سيطرت عليها المعارضة بداية من عام 2012، وهي تخضع، منذ ذلك الوقت، لحصار شديد من قوات النظام الذي حاول اقتحامها من محاور مختلفة أكثر من مرة خلال السنوات الخمس الماضية، إلا أن كل محاولاته باءت بالفشل. يعيش في الغوطة اليوم، بحسب أكثر التقديرات، نحو 400 ألف نسمة، رفضوا الخروج من أراضيهم وبيوتهم، على الرغم من إجراءات الحصار التي أوصلتهم، في بعض الأوقات، إلى حافة الجوع.
أسباب التصعيد
كانت الغوطة الشرقية تمثّل إحدى مناطق خفض التصعيد الأربع الرئيسة إلى جانب إدلب، ريف حمص الشمالي، ومنطقة جنوب سورية الغربي (درعا والقنيطرة) التي نشأت نتيجة اتفاق
“جاء الإعلان عن استراتيجية أميركية جديدة، بعد انتهاء الحرب على داعش بمنزلة ضربة كبيرة لجهود روسيا”
روسي – تركي، فتَح الباب أمام ظهور مسار أستانة، بعد سقوط الجزء الشرقي من مدينة حلب بيد روسيا وحلفائها في كانون الأول/ ديسمبر 2016. وقد تم التوصل إلى تفاصيل شمول الغوطة بنظام الهدنة في اتفاق وقعته روسيا، بوساطة مصرية، في القاهرة، في تموز/ يوليو 2017، مع جيش الإسلام (أحد فصيلَي المعارضة الكبيرين اللذين يسيطران على الغوطة الشرقية)، ثم انضم إليه فيلق الرحمن في الشهر التالي. وقد وافقت روسيا على ترؤس أحد قياديي جيش الإسلام (محمد علوش) وفد المعارضة السورية في اجتماعات أستانة، على الرغم من معارضة إيران والنظام لهذه الخطوة.
كانت فكرة مناطق خفض التصعيد تهدف إلى الإعداد لمسار سياسي للحل؛ وفق الرؤية الروسية التي برزت بعض ملامحها خلال جولات أستانة الثماني التي عقدت على امتداد عام 2017، وتوجت بمؤتمر سوتشي في 29 كانون الثاني/ يناير 2018، وكانت روسيا تريده بديلًا من مسار جنيف الذي لم تساعد في إيصاله إلى أي نتيجة، على الرغم من اضطلاعها بدور رئيس فيه من خلال مشاركتها في إصدار قرار مجلس الأمن رقم 2254، والذي غدا مرجعيةً رئيسةً للحل في سورية. لكن سلسة من التطورات الأخيرة أدت إلى إفشال هذه الجهود، واتجاه روسيا إلى الموافقة على توجهات إيران والنظام، إلى التخلي عن فكرة مناطق خفض التصعيد، والذهاب في اتجاه الحسم العسكري، ابتداءً من الغوطة الشرقية (هذا إذا لم تكن مناطق خفض التصعيد تكتيكًا مؤقتًا أصلًا يهدف إلى الاستفراد بمناطق المعارضة المسلحة، والتخلص منها واحدة بعد الأخرى). فقد تعرّضت روسيا لسلسة من النكسات الميدانية والسياسية التي تنتقص من “النصر” الذي أراد الرئيس، فلاديمير بوتين، استثماره إلى الحد الأقصى في انتخابات الرئاسة التي تجري في 18 آذار/ مارس 2018.
فبعد مرور أيام قليلة على زيارةٍ قام بها الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إلى قاعدة حميميم الجوية الروسية على الساحل السوري، في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، وإلقائه ما بدا كأنّه خطاب “النصر” أعلن فيه عن بدء خفْض القوات العسكرية الروسية في سورية، تعرّضت القاعدة نفسها لهجماتٍ صاروخيةٍ، أدت إلى إعطاب سبع طائرات كانت في أرض المطار، ثم تعرّضت القاعدة نفسها لهجمات منسقة، قامت بها طائرات من دون طيار (درونز)، عشية رأس السنة، لم تتمكن وسائط الدفاع الجوي عن القاعدة من رصدها، قبل أن يتم في مطلع
“حاولت روسيا الالتفاف على نص قرار مجلس الأمن 2041 عبر اقتراح هدنة يومية مدتها خمس ساعات”
شباط/ فبراير 2018 إسقاط طائرة “سوخوي” روسية فوق إدلب بصاروخٍ يعتقد الروس أنه محمول على الكتف. وقد اتهمت موسكو الولايات المتحدة الأميركية بوجود دور لها في هذه الهجمات المنسقة للانتقاص من “الإنجاز” الروسي في سورية. ثم جاءت الضربة الأخيرة، عندما وجهت طائرات أميركية معزّزة بالمدفعية ضربة كبيرة إلى مليشيا مرتبطة بشركة أمنية روسية خاصة (كانت تعمل في أوكرانيا قبل أن تنقل مسرح عملياتها إلى سورية)؛ عندما حاولت مهاجمة مقار عسكرية تابعة لقوات سورية الديمقراطية (قسد)، يوجد فيها جنود أميركيون قرب مدينة دير الزور شرق سورية. وقد أدى الهجوم الأميركي إلى مصرع عدد كبير من عناصر المرتزقة الروس، الأمر الذي تسبب بضجةٍ كبيرة في روسيا، وإحراج شديد لنظام الرئيس بوتين الذي حاول، أول الأمر، تجاهل الحادثة كليًا، قبل أن تضطر وزارة الخارجية الروسية إلى الاعتراف، فقط، بمصرع خمسة مواطنين روس في العملية، قالت إنهم غير مرتبطين بالقوات الروسية العاملة في سورية.
من جهة ثانية، جاء الإعلان عن استراتيجية أميركية جديدة في سورية، بعد انتهاء الحرب على تنظيم الدولة الإسلامية، واستعادة أكثر الأراضي التي يسيطر عليها، بمنزلة ضربة كبيرة لجهود روسيا من أجل الاستئثار بقيادة الحل في سورية. ففي 17 كانون الثاني/ يناير 2018، أعلن وزير الخارجية الأميركية، ريكس تيلرسون، في خطاب مخصص للسياسة الأميركية في سورية، أن الولايات المتحدة قرّرت عدم تكرار خطئها في العراق، عندما انسحبت منه بعد القضاء على تنظيم القاعدة، وتركته للنفوذ الإيراني، وأن الولايات المتحدة قرّرت، من ثمّ، الاحتفاظ بوجود عسكري لها شرق سورية، بعد طرد تنظيم الدولة الإسلامية. وحدد تيلرسون خمسة أهداف رئيسة، تسعى واشنطن إلى تحقيقها، من خلال الاحتفاظ بهذا الوجود، هي:
- عدم السماح لتنظيم الدولة الإسلامية، أو القاعدة، بالانبعاث مجددًا، وعدم السماح بأن تعود سورية لتصبح قاعدة أو منطلقًا للتخطيط أو تجنيد أو تمويل أو شن هجمات ضد الولايات المتحدة، أو ضد مصالحها أو حلفائها.
- إيجاد حل للصراع في سورية، من خلال عملية سياسية تقودها الأمم المتحدة، وفق نص القرار 2254، للوصول إلى دولة سورية مستقرة وموحدة ومستقلة، تحت قيادة جديدة لا يكون الأسد جزءًا منها.
- تحجيم النفوذ الإيراني، ومنع إيران من إنشاء قوس نفوذ لها في المنطقة، ومنع تحول سورية إلى قاعدة لتهديد استقرار المنطقة والدول المجاورة.
- توفير الظروف التي تسمح بعودة اللاجئين والنازحين داخل سورية إلى بيوتهم وبلداتهم.
- إخلاء سورية من كل أسلحة الدمار الشامل.
اعتبرت روسيا الاستراتيجية الأميركية الجديدة عملًا عدائيًا يستهدف جهودها ومصالحها في سورية؛ إذ رفضت الولايات المتحدة حضور مؤتمر سوتشي، حتى بصفة مراقب، ومارست ضغوطًا على الهيئة العليا للمفاوضات المعارضة لمقاطعة المؤتمر، وأنشأت الولايات المتحدة لجنة خماسية تضمها، إلى جانب بريطانيا وفرنسا والسعودية والأردن، لمواجهة ترتيبات روسيا مع تركيا وإيران في سورية، وقدمت للمبعوث الأممي، ستيفان دي ميستورا، ورقة تتضمن رؤية اللجنة الخماسية للحل في سورية، في مواجهة مقررات مؤتمر سوتشي.
من أجل كل هذه الأسباب، قرّرت روسيا التي رأت أن استراتيجيتها السياسية والعسكرية في سورية تتداعى، مع تدهور علاقتها بالولايات المتحدة إلى مستوىً غير مسبوق، أن تنحو في اتجاه حل عسكري في الغوطة الشرقية، في خطوةٍ يكون الهدف منها هزيمة المعارضة كليًا ودفعها إلى الاستسلام، بدلًا من التفاهم معها على حل؛ مثلما كانت الفكرة، عندما انطلق مسار أستانة. ولهذه الأسباب بدأ التصعيد في الغوطة.
القرار 2401
بعد مفاوضات طويلة، وتعطيلٍ، ومحاولات كسب الوقت، على الرغم من الضغوط السياسية والإعلامية التي تصاعدت مع انتشار آثار الدمار والموت؛ بسبب القصف الروسي لمناطق
“يتمتع المقاتلون بخبرات قتالية كبيرة ولديهم كل الأسباب للبقاء والمقاومة”
المدنيين في الغوطة، وافقت روسيا على مسودة مشروع قرارٍ مشترك، تقدمت به السويد مع الكويت التي كانت ترأس دورة مجلس الأمن، خلال شباط/ فبراير 2017، لإطلاق هدنة إنسانية في سورية، مدتها ثلاثون يومًا، وفتح ممرات لإيصال المساعدات الإنسانية إلى المناطق المحاصرة. صدر القرار رقم 2401 في وقت متأخر من يوم الجمعة 23 شباط/ فبراير 2017، لكن روسيا لم توافق عليه إلا بعد تعديلات جوهرية؛ إذ حذفت منه فقرةً توجب بدء الهدنة خلال 72 ساعة من تبني القرار، وأصبحت، بدلًا من ذلك، “من دون تأخير”. ومن بين التعديلات، أيضًا، أن تشمل الهدنة سورية كلّها، بدلًا من الغوطة فقط، وأن تستثنى منها الجماعات المتشددة التي يصنفها مجلس الأمن إرهابية (أي تنظيم داعش وجبهة النصرة)، على الرغم من أنه لا وجود لداعش في الغوطة الشرقية، أما جبهة النصرة فأعربت الفصائل المقاتلة عن استعداد هذه الجبهة إخراج قواتها المحدودة من الغوطة، لكن روسيا وحلفاءها طالما استخدموا هذه الحجة للاستمرار في القصف وإخضاع المعارضة.
من جهة ثانية، حاولت روسيا الالتفاف على نص القرار الذي يسمح بتوفير معابر إنسانية لإدخال المساعدات، واقترحت، بدلًا من ذلك، هدنة يومية مدتها خمس ساعات تبدأ في التاسعة صباحًا وتنتهي في الثانية بعد الظهر، للسماح للمدنيين بالخروج من المنطقة؛ في محاولة واضحة لتهجير سكان المنطقة تحت القصف الذي يبدأ في الدقيقة الأولى بعد انتهاء مهلة الخروج، ويستمرّ 19 ساعة يوميًا.
مقومات الصمود
مستفيدةً من تجربة شرق حلب، وسحبًا للذرائع، اقترحت فصائل المعارضة داخل الغوطة،
“تمكن أهالي المنطقة، خلال سنوات من الحصار والقصف، من بناء شبكة كبيرة من الأنفاق، حتى إنه يمكن القول إن بلدات بكاملها تعيش تحت الأرض”
إخراج عناصر جبهة النصرة الذين تتخذهم روسيا ذريعةً لاستمرار القصف، مع أنّ عددهم لا يتجاوز 250 شخصًا مع عائلاتهم (بين 400 ألف نسمة). وعلى الرغم من أن روسيا رحبت بالمقترح، فإنها عرقلت تنفيذه حتى الآن؛ إذ تسعى عمليًا إلى القضاء على آخر جيوب المعارضة المهمة الموجودة حول دمشق، وكانت قد تمكنت، خلال العامين الأخيرين، نتيجةً للقوة الغاشمة والحصار وكثافة القصف الذي مارسته على المدنيين، من إخراج فصائل المعارضة، وتهجير السكان من أكثر مناطق الغوطة الغربية؛ من أقربها إلى دمشق (داريا والمعضمية وقدسيا ووادي بردى) إلى أبعدها عنها (الزبداني ومضايا.. إلخ). وقد عبرت روسيا، صراحةً، على لسان وزير خارجيتها، سيرغي لافروف، عن أنه من الممكن التوصل إلى اتفاقٍ لخروج فصائل المعارضة السورية من الغوطة الشرقية؛ على غرار الاتفاق الذي جرى في حلب عام 2016 وسمح للمقاتلين بالخروج نحو إدلب.
لكن تحقيق الأهداف الروسية ربما لا يكون بالسهولة نفسها التي تحققت في حلب، قبل أكثر من عام؛ ويعود ذلك إلى أن إمكانات الصمود في الغوطة الشرقية أفضل منها في حلب، على الرغم من أن المنطقة تعيش تحت حصار كامل منذ خمس سنوات. فمعظم (إن لم يكن جميع) مقاتلي المعارضة، من أهالي المنطقة؛ ومن ثمّ فإنهم يعرفون جغرافيتها جيدًا، ولن يكون من السهل على أي قوة عسكرية مهاجمة أن تتقدم. ومن أبرز الأدلة على ذلك أن النظام لم يتمكّن بعد خمس سنوات من القتال الضاري أن يتقدم، ولو مسافة قليلة في حي جوبر، على أطراف مدنية دمشق، والذي يُعد خط الدفاع الأول عن الغوطة، ثمّ إنّ مقاتلي المعارضة كثيرو العدد؛ فوفق أدنى إحصاء لهم، يصل عددهم إلى عشرة آلاف مقاتل، مجهزين بأسلحة ثقيلة غنموها من معسكرات النظام خلال سنوات القتال السابقة، كما أنّ هؤلاء المقاتلين يملكون مخزونًا كبيرًا من الذخيرة يكفي المقاومةَ فترةً زمنية طويلة. وفضلًا عن هذا، يتمتع المقاتلون بخبراتٍ قتالية كبيرة، ولديهم كل الأسباب للبقاء والمقاومة؛ فهم يدافعون عن أرضهم وأهلهم، والخيارات التي أمامهم، إنْ قرروا القبول بالخروج، ليست مشجعة، خصوصا أنّ من سبقوهم من فصائل المعارضة وأهاليهم يتعرّضون اليوم للمستوى نفسه من القصف في إدلب. زيادةً على ذلك، تمكن أهالي المنطقة، خلال سنوات من الحصار والقصف، من بناء شبكة كبيرة من الأنفاق، حتى إنه يمكن القول إن بلدات بكاملها تعيش تحت الأرض، كما أن طبيعة المنطقة الزراعية، وخبرة أهلها في هذا المجال، أمران يسمحان لهم بالصمود، ذلك أنّ المنطقة قادرةٌ على تحقيق الاكتفاء الذاتي في هذا المجال. وما يمكن أن يمثل فرقًا حقيقيًا هنا، هو، وحدة الفصائل في التعامل مع الهجمة العنيفة التي تواجهها الغوطة، وتجنب ما كان من تناحر واقتتال، لم يعد لهما من مبرّر مقبول للاستمرار في مثل هذه الظروف.
العربي الجديد
روسيا تقود الإبادة في الغوطة أم يقودها الأسد والإيرانيون؟/ عبدالوهاب بدرخان
كانت معضلة روسيا في مجلس الأمن أن الدول الكبرى عرضت عليها «قراراً إنسانياً» ولم تعرض عليها شيئاً آخر يشجعها على «شرائه». قالوا لموسكو أنهم يعوّلون على «ضميرها»، ولمّا لم تعرف عما يتحدّثون فإنها لم تجد أمامها «صفقة» تستوقفها، ولما زادوا الضغوط زادت الشروط للتخلّص من أي مسؤولية والتزامات. فكان لهم القرار الذي جهدوا للحصول عليه حفاظاً على ماء الوجه، وكان لروسيا ما أرادت، أي لا شيء يتغيّر، فهي لم تتدخّل في سورية لتبرهن إنسانيتها بل لتساوم الأميركيين والأوروبيين على ملفات أخرى ليس بينها الشأن الإنساني. منذ ما قبل الغارة الأولى لمقاتلاتها وهي تقترح هذه المساومة، لكنها لم تلقَ من الآخرين سوى آذان صماء. كلّما أوغلت روسيا في الجرائم ارتفعت أصواتهم لتوبيخها وشيطنتها في مجلس الأمن، وكلّما فعلوا ذلك تيقنت بأنها تفعل الصواب، فإمّا أن يرضخوا ويلبّوا توقّعاتها وإمّا أن تعاود لاحقاً وضعهم أمام عجزهم، فهي غير معنية بـ «القانون الإنساني الدولي» وغير قلقة على سمعتها بالتالي فهي لا تجزع إذا شهروه في وجهها، بل تعتبرهم شركاء لها في قتل الشعب السوري.
لا تزال أطراف «المجتمع الدولي» تعامل روسيا باعتبارها دولةً كبرى ملتزمة القانون الدولي، وعلى هذا الأساس تطالبها بأن تحترم – في الأقل – التزامات أعلنتها هي نفسها بالنسبة إلى سورية. لكن روسيا لا ترى سوى الولايات المتحدة وتعتبرها مساوية لها أو متفوّقة عليها في عدم احترام القانون الدولي. وإذا كانت موسكو اضطرّت للموافقة شكلياً على القرار المعدّل لمجلس الأمن فإن لعبة توزيع الأدوار في سورية أخرجت إيران من الكواليس لتصبح طرفاً علنياً يؤكّد أنه ونظام بشّار الأسد يرفضان أي هدنة، في الغوطة الشرقية أو في سواها. لا بدّ من أن الروس استحسنوا هذه الخطوة لأنها توضح حقيقة موقفهم، إذ لم تعد هناك فوارق بينهم وبين الإيرانيين والأسديين وباتوا متوجّهين جميعاً نحو «الحل العسكري». وما اكتفى المندوب الروسي في مجلس الأمن بقوله تلميحاً تكفّل مندوب الأسد بتوضيحه للمتسائلين، فـ «الغوطة، نعم، ستكون حلب الثانية، وإدلب ستكون حلب الثانية أيضاً»، وفق ما قال.
هذه هي خريطة الطريق للشهور المقبلة، ولم تكن هناك أي خريطة سواها، لكن انعدام الخيارات لدى الأطراف الأخرى جعلها تأخذ بالأوهام التي نثرتها موسكو تارةً عن حل سياسي وطوراً عن «مناطق خفض التصعيد». ولعل الوهم الأكبر أن تلك الأطراف لا تزال تُوصف بأنها «تدعم المعارضة»، إنها تستخدمها أو بالأحرى لا تحسن استخدامها في مواجهة مع روسيا وإيران. أما «الحل السياسي» الروسي فقد فشل، وما كان له أن ينجح في أي حال، هذا إذا افترضنا أنه وُجد أصلاً. فلا أصحابه الروس عملوا عليه بجدّية وواقعية، ولا الحليفان الإيراني والأسدي ساعداهم بل بذلا كل شيء لإفشاله، لأنهما منذ إسقاط شرق حلب دأبا على المطالبة باستكمال الحسم العسكري، لكن الروس فضّلوا آنذاك اجتذاب تركيا إلى محورهم على استجابة رغبة الحليفين. ثم إن الأولوية كانت حينذاك لمنافسة التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة على ضرب «داعش» وطرده من مناطق سيطرته، وفي المقابل، أسّس الروس مسار آستانة للدول الثلاث «الضامنة» بأجندة خفية/ علنية مفادها: احتواء الفصائل المقاتلة ضد النظام، استخدامها لنسف مسار جنيف وبلورة حل سياسي معها خارج المفاوضات، وترتيب «مصالحة» ما بينها وبين النظام…
كانت تلك تركيبة غبيّة أثبت طابخوها ومروّجوها أنهم لا يعرفون جيداً أيّاً من المعارضة وفصائلها أو النظام وميليشياته، أو يعرفونهم لكن الغطرسة الروسية جعلتهم يواصلون تصديق الكذبة، إلى أن صُدمت موسكو بالفخ الذي نُصب لها في «حوار سوتشي»، إذ أرسل النظام ما يقرب من ألف ومئتي مشارك بينهم نحو عشرون ممن ليسوا «شبيحة» ولم يكن عددٌ منهم راغباً في الذهاب لكنه أُرغم. حتى الآن لا يزال أحدهم مذهولاً بما حدث له، إذ يقول أنه لم يعرف يوماً معنى «سقط المتاع» إلى أن رأى بعينيه «الرفاق» الآخرين في الرحلة. فالمفروض أنه وإياهم من الموالين للنظام، وهو يؤكّد ذلك، لكنه لم يستطع أن يفهم كيف يُرسل أناساً بمواصفات مريبة شخصياً ومعيبة اجتماعياً إلا بأن النظام كان في الوقع يستهزئ بالمؤتمر وبفكرته وأهدافه.
بالطبع، تلاشت كل قيمة سياسية لمؤتمر سوتشي، إذ اضطرّت موسكو لتسليم «نتائجه» إلى ستيفان دي ميستورا الذي لا يعرف كيف يدمج «اللجنة الدستورية» المقترحة بصيغة جنيف، ولعل رفضها من جانب النظام يساعده على تجاهلها، فالنظام لا يحبّذ أي لجنة لا يشكّلها بنفسه. لكن المرارة لا تزال في حلق موسكو، بل انعكست لاحقاً على خياراتها الثأرية، بعدما أُسقطت طائرتها «سوخوي 25» فوق إدلب وتعرّض مرتزقتها لمذبحة في دير الزور. وقبل ذلك، كانت «سوتشي» كلّفت الروس «صفقة عفرين» مع الأتراك، وهي ما قلب المقاييس عند النظام والإيرانيين ودفعهم عمليّاً إلى إظهار ما يشبه التحدّي لموسكو، خصوصاً في إصرارهم على إرسال ميليشيات إيرانية (تابعة للنظام!) إلى عفرين، ثم في الإصرار على إقحام الفوعة وكفريا في التعديلات على قرار الهدنة (من أجل الغوطة)، فالإيرانيون يتصرّفون بالبلدتين (خلافاً لإرادة أهلهما الشيعة) في كل مساوماتهم من الزبداني إلى عفرين والغوطة.
لكن «التحدّي» قفز إلى العلن بعدما لاحظ الإيرانيون والنظام أن ثمة اختلالاً في التخطيط الروسي في مواجهة ما يثبّته الأميركيون من وقائع على الأرض، تحديداً في شمال شرقي سورية، وما يوشك الأتراك على إحرازه في غرب الفرات. وقد لاحظت طهران ودمشق أن هناك تمايزاً بين عسكر موسكو وسياسييها، فعلى رغم أن القرار لفلاديمير بوتين الذي عهد بالملف إلى المستوى العسكري إلا أن المستوى السياسي يسترشد أيضاً بالخط الذي رسمه لهم بوتين نفسه. وفي الفترة الأخيرة، بعد مؤتمر سوتشي وما تلاه، انزعج سياسيو موسكو من اللهجة التصعيدية لدمشق، إذ لم تعد ترضى بأقلّ من «استكمال النصر العسكري» ولم تعد تقبل بالقرار 2254 أساساً لأي حلّ، وهو ما حاضرت به بثينة شعبان، مستشارة الأسد، في «منتدى فالداي»، وهي كانت استُثيرت بمغادرة سيرغي لافروف القاعة برفقة زميله محمد جواد ظريف مع شروعها بمداخلتها.
لكن سياسيي موسكو أدركوا أن القيادة تدعم معركة الغوطة الشرقية، بدليل النسبة الكبيرة من الانسجام بين النظام وقاعدة حميميم في إدارة المعركة سواء بدفع سهيل الحسن إلى قيادتها أو بإفشال التفاوض مع الفصائل لتبرير إشعالها، لأن الهدف بات القضاء على المقاتلين في الغوطة تمهيداً لإسقاطها. وكان واضحاً من تعليقات المندوب الروسي في مجلس الأمن أن المطلوب كسب الوقت لا أكثر، وأن أي قرار حتى بموافقة موسكو لا يعني أن الهدنة ستكون نافذة. والواقع أنها لم تحترم إطلاقاً، بل تكرّر استخدام غاز الكلورين في يومها الأول من قبيل تأكيد النيات. وعلى الرغم أن ممثلين لـ «جيش الإسلام» و «أحرار الشام» شاركوا في اجتماعات آستانة، وأن «هدنات» عدة تمّ التفاوض عليها سابقاً بين الروس وممثلين عن «فيلق الرحمن»، إلا أن مقتضيات الحسم جعلت موسكو تعتبر هذه الفصائل مستهدفة جميعاً بسبب تعاونها مع «هيئة تحرير الشام – جبهة النصرة سابقاً»، فالأخيرة مصنّفة إرهابية وتُستخدم ذريعة لاستهداف الغوطة، علماً أن مواقعها هي الأقل عرضة للقصف الجوي والمدفعي.
لا يريد النظام استعادة أي منطقة مع أهلها، لذلك يفضّل إنزال الدمار الشامل بها وجعلها أرضاً محروقة ليضمن تفريغها من السكان وتسليمها إلى الإيرانيين ليستولوا على «أملاك الغائبين». ليس في الغوطة مقاتلون أجانب ولا لاجئون أو غرباء، فجميع الـ400 ألف الذين بقوا فيها هم من أهلها ويملكون بيوتهم وأراضيهم، لذلك فإن مطاردة المدنيين وضرب المستشفيات والأسواق والأحياء السكنية تعني أن «الحسم العسكري» الذي يسعى إليه الثلاثي الإجرامي، الروسي – الإيراني – الأسدي، هو قرار مسبق بالإبادة الجماعية لأهل الغوطة.
* كاتب وصحافي لبناني
الحياة
عن إخراج العرب من سورية/ وليد شقير
يرمز الإصرار السوري الإيراني الروسي على الخلاص من المعارضة في الغوطة الشرقية إلى الكثير من الأهداف، بدءاً بضمان الحماية لدمشق إزاء احتمال تحريك الجبهة الجنوبية في اتجاه العاصمة، مروراً بتعميق التغيير الديموغرافي في محيطها بتهجير أهلها منها في ما يشبه حرب ابادة المدنيين، وبتقليص فرص الحل السياسي على أساس قرار مجلس الأمن 2254 عبر انتصار جديد للنظام يثبت رأسه في السلطة بموازاة توسيع سيطرته الميدانية مع حلفائه.
من أهداف موسكو حكماً الانتقام من المعارضة التي رفضت التسليم بالهندسة الروسية للحلول في سوتشي.
لعل أحد أوجه ما يجري في الغوطة الشرقية، سواء كان هدفاً أم جاء نتيجة للهجمة عليها، هو استكمال عملية إخراج العرب من المعادلة في بلاد الشام. وعلى رغم التركيز الروسي على محاربة «جبهة النصرة» (هيئة تحرير الشام) فيها، فإن الفصائل الرئيسة في الغوطة بعيدة من «النصرة». بل هي فصائل قامت على الدعم العربي من دول عدة عربية مدتها بالإمكانات كي تصمد في وجه وحشية النظام وحلفائه. والخلاص من هذه الفصائل السورية غير المصنفة إرهابية يعني استكمال إنهاء الوجود العربي الميداني بالواسطة على الأرض، بعد حلب وغيرها.
ومع أن الحضور العربي في سورية تراجع إلى أدنى مستوى في التأثير منذ التخلي العربي عن حلب، ومنذ الافتراق العربي التركي في الأهداف في سورية، فإن هذا الانكفاء انعكس بعد واقعة حلب استبعاداً للمشاركة العربية في مسار آستانة الذي أراده تحالف موسكو- أنقرة- طهران، وسيلة لتقاسم النفوذ على الساحة السورية. انكفأ العرب لمصلحة الوجود الأميركي المباشر انطلاقاً من الشمال والشرق في سورية، والذي اعتمد على الأكراد. وانكفأ منذ أن نجحت الحيلة الروسية بإغواء بعض الدول العربية بإمكان الاستعانة بالعنصر العربي في مواجهة التطرف السني، ثم تراجعت. وثمة من يؤرخ لانكفاء العرب بفشل مبادرة الجامعة العربية بداية عام 2012 في تحقيق أي تقدم في الحل السياسي وفي ولوج مرحلة انتقالية نحو حكم يتفاوض السوريون عليه.
لم يكن استبعاد الدول العربية عن عبث. بل إن دورها بلغ مستوى الانعدام نتيجة مسار انحداري متواصل بحيث تأتي حرب الغوطة لتقضي على أي وزن محتمل لها في الملعب السوري. حتى التوهم بإمكان تحريك الجبهة الجنوبية ضد النظام بات قراره أميركياً بحتاً، فالمواجهة على تلك الجبهة باتت بين إيران وإسرائيل ومعها أميركا. والمواجهة الأميركية الروسية في الميدان السوري أخذت بعداً جديداً يتعلق بالثروة الغازية والنفطية السورية كما برهنت عملية القصف الأميركي لقوافل الميليشيا الروسية المتجهة نحو شرق الفرات في محافظة دير الزور، للتمركز فوق حقول الثروة الطبيعية في أوائل شباط (فبراير) الماضي. وبات الأميركيون يستخدمون شعار الروس نفسه لتغطية التنافس على تلك الثروة ولإبقاء قواتهم في سورية، أي شعار مواجهة «داعش» والإرهاب، على رغم أن الدولتين الكبريين تنافستا على نسبة الانتصار على تنظيم «الدولة الإسلامية» قبل 3 أشهر لكل منهما.
لم يبقَ للدور العربي في الإقليم سوى المواجهة الدائرة مع أذرع إيران في اليمن، حيث تخوض المملكة العربية السعودية الحرب ضد تمدد الحرس الثوري. وفي هذه المواجهة لا تفوت موسكو مناسبة من أجل الإيحاء بأنها ستخرج عن حياديتها عبر رفضها إدانة التدخل الإيراني في اليمن كما فعلت في مجلس الأمن قبل يومين.
ولم يبق للدور العربي في أزمات الإقليم سوى السعي لتأمين حضور في الأزمة الأم، أي القضية الفلسطينية، حيث أظهرت إدارة دونالد ترامب ازدراء مكشوفاً له حين ضربت عرض الحائط حساسية القدس بالنسبة إلى العرب. فهل تقف الدول العربية فعلاً لا قولاً وراء الرئيس الفلسطيني محمود عباس وتشبثه بالثوابت وبالمبادرة العربية للسلام مقابل الصفعة التي تلقتها تباعاً من ترامب ومن روسيا في سورية وفي فلسطين؟ وهل تصدق أنباء عودة الدعم للسلطة الفلسطينية في المواجهة المصيرية التي تخوضها؟ ولم يبق للدور العربي سوى العودة إلى ضمان الحضور في لبنان لمنع مصادرته وجعله امتداداً لتقدم الدور الإيراني في بلاد الشام، ولإعانته على الصمود في انتظار اتضاح المعادلة في سورية، فاستعادة الدور في الحلول تحتاج إلى حضور في إدارة الأزمات بدل إدارة الظهر لها.
الحياة
تمرين روسي بالذخيرة الحية في الغوطة الدمشقية/ حامد الكيلاني
حبر حملة الأقلام كحبر السيل الأعظم المتدفق بدماء الأبرياء، عليه ألّا ينضب أو يجف في أعماق حراس المثل العليا الذين في مقدمة مهماتهم رفض السير مع المشيعين لجنازة الأمل بمقاومة الشعوب وثورات أغصان الزيتون البكر. تلك الجنازات التي تجيد تنظيمها أجهزة الأمن والقمع وشُعَب الاستخبارات الضليعة بفنون التعذيب وتشويه الحقائق واستدراج الموت والقتل بالجملة لتوجيه أصابع الاتهام واللوم إلى من أطلق غضب نظام حاكم كالنظام في سوريا، رغم أن الجميع يدركون سلفاً مخاطر إقلاق نوم وراحة الوحش الجاثم فوق أنفاس أمة السوريين.
إطالة أمد الصراع في سوريا والمماطلة بتنفيذ قرارات جنيف وما صدر عن منظمة الأمم المتحدة تمت تحت مظلة الدروع الواقية للاتحاد الروسي، وبمساعدة مخلفات الفكر الفاشي لأقبية الباسيج النازية وخبرتها على مدى عقود من حكم الملالي بتغول إجرامها ضد الشعوب الإيرانية، كل ذلك منح النظام الحاكم في سوريا طاقة البطش وهو المتمرّس وراثيا بمهنة المكائد وتسقيط الخصوم واحتكار شعار المقاومة لإسكات أي صوت وطني.
فلسطين بالنسبة للنظام الحاكم في سوريا لا تقل عن هوس النظام الإيراني في تدمير الأمة العربية “حبا” في الشعب الفلسطيني وقضيته، حتى أن الملالي أطلقوا اسم “القدس” على فيلقهم التابع لحرس ثورة الخميني بمهامه التوسعية وألويته الميليشيوية ذات الاستخدام المزدوج بهيمنة السلاح ومصادرة القرار السياسي في الدول المغدورة بالتمدد الطائفي الإيراني.
ما الذي دفع السلطة الحاكمة في العراق إلى إعلان الجنرال قاسم سليماني قائد فيلق القدس مستشارا أمنيا لمجلس الوزراء منذ عدة سنوات، في إشارة يفهم منها كما أكدت إحدى نائبات البرلمان العراقي مؤخرا إن سليماني تلتقي به جميع الشخصيات والقوى السياسية المشاركة في الانتخابات ودون استثناء، بما يرسخ مرجعيته في تقرير مصير الانتخابات، إضافة إلى توجيه دفة الصراعات الدولية الواردة جداً في المنطقة لصالح ولاية الفقيه باستراتيجية الاعتماد على الدم العراقي والسوري في توظيف شعار محور المقاومة من أجل فلسطين والقدس.
يكفي أن تذكر كلمة فلسطين في سوريا النظام حتى تتجلى أمام الشعب السوري خارطة الطريق إلى شعبة فلسطين في دمشق، والتي تحولت بعد ثورة الشعب السوري إلى مقرات ميدانية مفتوحة لـ”هولوكوست” متكرر على مسرح عروض الفرجة الدولية إما بالتواطؤ الضمني بأنصاف الاعتراف بالحقائق أو أرباع الشك من مصالح دولية متشابكة وإما بأجزاء من ارتباك في لحظة تشوّش للضمير الإنساني الذي كان ينتصر سابقا للحرية والعدالة وحق الشعوب في غد أفضل.
الضمير الذي بات اليوم يتقبل الأمر الواقع، ويرتضي إدانة صمود البنادق في ميادين يتشرف بها الموت وذلك لأسباب تتعلق بمهنية أجهزة الأمن المتمرسة على تفريغ محتوى الصراع وإقحام العناصر الدخيلة لتشويه وإحراق كتاب الثورة الشعبية، لم يتبق منه ربما سوى شيء من العنوان والمقدمة مع شيء من خاتمة مفتوحة تحاول وتجتهد ألّا تستسلم وهي تتطلع إلى المدن المسبيّة مقابل كومة حقائب وزارية ترمى إلى المعارضة السورية في عملية انتقال سياسي داخل نفق مظلم وعفن مليء بجثث الشعب السوري لإعادة تأهيل شعبة فلسطين وفيلق القدس، ولتجهيز منصة دمشق لسياسة روسيا الخارجية وافتتاح السوق العالمية الحرة لأكثر من 200 سلاح وتقنية مجربة من إنتاج شركات الصناعات الحربية الروسية.
لا يمكن خذلان الثورة السورية بمنتجات فرعية للإرهاب بدأت في العام 1979 في أفغانستان مع دخول قوات الاتحاد السوفييتي واستمرار اغتنام ذلك الإنتاج بثورة الخميني، إلى غاية الحاضر حيث كارثة الاحتلال الأميركي للعراق التي فتحت هاوية النسيان لسقوط أكثر من دولة عربية وبما طعنت من مفاهيم تضامن الشعوب ومواقف وحدتها لمناصرة التقدم وثوابت حقوق الإنسان.
احتلال أفغانستان من الاتحاد السوفييتي إلى احتلاله من قبل القوات الأميركية، ثم الاحتلال الأميركي للعراق وبعدها احتلال روسيا لسوريا، تلك التداعيات كانت فرصة ثمينة لنظام ملالي إيران المتخلف لاستغلال الفراغ في المنظومة العربية نتيجة للأحداث المعروفة والتي أدت إلى اهتزاز القناعات بالمشروع العربي كضامن لمواجهة التحديات السافرة، خاصة بعد تفكك العراق وتبعثر وتشظي والتباس وسائل التغيير والتحديث ووقوعها فريسة لمشاريع بذات خط إنتاج النظام الإيراني.
الطامة الكبرى كانت استجداء إدارة الرئيس الأميركي السـابق باراك أوباما توقيع الاتفاق النووي مع إيران الذي نشر الوباء الطائفي كسلاح متعدد الأغراض وبتصاميم مختلفة؛ لكنه أطلق باتجاه آخر ورطة التصريح بمخزونات أتباعه ومقلديه كنماذج من بالونات دعايته السياسية للترويج إلى انتهاء مرحلة وبداية مرحلة تنفيذ المشروع الإمبراطوري بالجيوش الميليشيوية.
لكن الخسائر تبدو أكبر وأعمق بعد إشهار الملالي لتشكيلاتهم القتالية وفصائلها وأسماء قادتها ومصادر تمويلها ونقاط حركتها التي لم تعد مجرد بيانات على ورق، إنما انتقلت إلى اغتيالات وتجارة مخدرات ومافيات وعمليات إرهابية وزرع خلايا صاحية في أفريقيا ونائمة في أوروبا وغسيل أموال وميليشيات وطموحات بالاستيلاء على دول بعد العراق، إلا أن وجهتهم دائماً، ودون تردد وكتمان، صوب احتلال مكة.
تنظيم الدولة الإيرانية إن كان مفيدا للعالم، فهو بقدر فائدة تنظيم الدولة الإسلامية لإشارات مرور القطعات العسكرية الدولية نحو أهدافها في السيطرة والاستيلاء على مواطئ أقدام مستقبلية لحماية استراتيجياتها وأيضاً مناوراتها الأمنية في التقارب والتباعد مع جغرافية حدودها، وفائدته أيضاً بقدر تصريف البضائع العسكرية وهي بالنسبة لبعض الدول من مرتكزات دخلها القومي.
بمعنى أن التنظيمين الإرهابيين يعملان وفق رؤية محدودية الواجبات المتاحة، وإن اختلفت في حجمها وصلاحياتها بين النظام الإيراني الراعي الأول للإرهاب في العالم، وبين منتجاته من تنظيمات متشددة إن بالدعم المباشر أو عن طريق وسطاء أو بدفع المجاميع إلى زاوية التطويق بسياسة أن لا حياة إلا بالإرهاب.
عمليات القصف العشوائي بالمدفعية والدبابات والقصف بالبراميل والأعتدة الأخرى المجربة في الغوطة الشرقية تنافي منطق استمكان مصادر إطلاق النار حيث تتواجد الفصائل المسلحة بالتعميم مع التذكرة بالتقنيات الحديثة التي يروج لها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بفخر واعتزاز كأساليب في الرصد والتحقق وبما يعرف بالأسلحة الذكية والصواريخ الموجهة.
لكنها حرب عشواء وخبط سياسة عشواء لروسيا وإيران والنظام الحاكم في سوريا، والهدف واحد هو تشييع ما تبقى من أحلام ثورة الشعب السوري أو ثورة الإنسان السوري.
تشييع لن تشارك فيه دماء الأبرياء وبنادق المقاتلين الشرفاء، وأكيد وحتماً لن تشارك في تشييعه أقلام القرارات الإنسانية الدولية وكذلك الأقلام الحرة التي طالما لاحقت قلوب وأدمغة الطغاة بالجلطات.
كاتب عراقي
العرب
ثلاث جبهات في سورية … ووصاية روسية مسمومة/ ألان فراشون
غالباً ما تلي السلام الحرب. ولكن يبدو أن السلام أثر بعد عين في سورية. ففصول الحرب فيها تحتدم وتشتد. ويعود الفضل إلى إيران وروسية في بقاء نظام بشار الأسد والحؤول دون سقوطه. ولكن يومياً يقتل عشرات السوريين، ويصاب مئات منهم، وآلاف منهم يضطرون إلى النزوح والهجرة. وإلى وهج نيران النزاع الأساسي بين دمشق وفلول معارضة يغلب عليها الإسلاميون، يدور نزاعان: المعركة التركية– الكردية من جهة، والمواجهة الإيرانية– الإسرائيلية، من جهة أخرى. وتجتمع تعقيدات المنطقة كلها في هذه الجبهات الثلاثية «السورية». وروسيا هي قوة وصاية في سورية، وهي اليوم الفيصل هناك. وهي تغامر بإفلات الأمور من عقالها، وأن يعصى عليها التحكم في القوى المحلية ويتعذر. والجبهة الأولى بين النظام والمعارضة، هي الأكثر دموية: سيل من النيران يتدفق منذ أسابيع على آخر جيوب الثوار في الغوطة الشرقية، على مقربة من دمشق، ومنطقة إدلب، في شمال غربي البلاد. والقصف الجوي الروسي والسوري لا يكل، والقذائف المدفعية تنهمر على المنطقتين، والمستشفيات في مرمى النيران وهدف لها، والمدنيون في المصيدة. «هي مجزرة. معاناة انسانية لا تعقل، وهي أسوأ أزمة إنسانية منذ 2015»، قال بيان «أممي» (الأمم المتحدة).
ففي شهر كانون الثاني (يناير) الماضي، قتل 744 مدنياً- من الرجال والنساء والأطفال. ومن وسعهم الخروج من حصار الغوطة حيث المجاعة تنهش الاجساد، لجأوا إلى إدلب، ولكن المحفاظة هذه كذلك غير آمنة والقصف لا يهدأ. وتكر فصول المأساة وتتكرر على منوال واحد منذ 2012، ومثل هذه المأساة نزل بالموصل العراقية حيث سوغت مرابطة «الجهاديين» قتل المدنيين معهم.
وفي المعركة هذه، يساند الروس والايرانيون بشار الاسد. والنظام استعاد المدن الكبيرة كلها، أي نصف البلاد، ويقيم فيها 60 في المئة من السكان. وأراد الكرملين أن يفتتح مرحلة سياسية، ورعى الحوار بين دمشق وشطر من المعارضة. ولكن في غياب إجماع على تمثيل المعارضة، أخفق مؤتمر سوتشي في نهاية الشهر الماضي. وبدا أن موسكو عاجزة عن التأثير في دمشق وحملها على التفاوض والمساومة.
وبادرت تركيا إلى فتح الجبهة الثانية في كانون الثاني المنصرم. فأنقرة تخشى نشوء منطقة كردية متصلة على طول حدودها مع سورية، تُعرف بروجافا. وكان الأكراد السوريون، وميليشيات «وحدات حماية الشعب» تحديداً، سعوا في الحروب التي مزقت البلد منذ 2011، إلى قيام روجافا. وترى تركيا أن المنطقة هذه قد تتحول ملاذاً آمناً للميليشيات الكردية التركية، «حزب العمال الكردستاني». فـ «وحدات حماية الشعب» مقربة من «الكردستاني»، وتجمعها روابط تاريخية به. ورواجافا منقسمة إلى شطرين: عفرين في شمال غرب سورية- ويفصلها عن كوباني والجزيرة منطقة تسيطر على قسم منها دمشق، ويمسك بمقاليد شطرها الآخر ثوار عرب تدعمهم تركيا. وتريد أنقرة الحؤول دون الربط بين عفرين وكانتونات الغرب الكردية. وتسعى الدبابات التركية وسلاح الجو التركي وميليشيات عربية إسلامية مقربة من «القاعدة» منذ 3 أسابيع إلى احتلال منطقة عفرين. وهذه الحرب تفاقم التباس الامور في المنطقة: فثمة ألفا جندي أميركي يساندون الحلفاء الاكراد السوريين في شمال شرقي البلاد. ولكن على رغم مرابطتهم في جزء من «روجافا»، لن يتدخل الأميركيون في عفرين، فهم لا يريدون قطع العلاقات مع حليفهم التركي في «الاطلسي»، ولو كانت العلاقات اليوم متوترة بين واشنطن وأنقرة. والروس هم أسياد الأجواء السورية، وسمحوا لسلاح الجو التركي بدخولها، في وقت تعارض دمشق العملية التركية وتدعم الأكراد، على رغم أن هؤلاء متحالفون مع الأميركيين.
وفي الجبهة الثالثة تتواجه اسرائيل مع إيران وميليشياتها التي نشرتها في سورية («حزب الله» اللبناني، والشيعة الافغان والباكستانيين والعراقيين). ولم يكن ليسع موسكو بلوغ مساعيها في سورية من دون هذه الميليشيات: إنقاذ نظام الأسد من دون خسائر روسية كبيرة، وفرض عودته إلى الشرق الأوسط. والروس لا يتدخلون حين يقصف الاسرائيليون في سورية شحنات السلاح الايرانية إلى «حزب الله». ولكن الإيرانيين يريدون حصتهم من سورية، وجني ثمار تدخلهم من طريق عقود تجارية وأخرى عسكرية تنشر قواعد عسكرية دائمة على الأراضي السورية، وتقوي شوكة «المتشددين» في طهران. وترى إسرائيل أن مثل هذه القواعد الإيرانية «خط أحمر. وفي 11 شباط (فبراير) الجاري، وقعت مواجهة مباشرة بين الإيرانيين والإسرائيليين، إثر تجاوز طائرة درون إيرانية الحدود السورية إلى الإسرائيلية. فردت المقاتلات الإسرائيلية بقصف مواقع الجمهورية الإسلامية الإيرانية العسكرية في سورية. وفي طريق العودة، أصابت صواريخ الدفاع الجوي السوري طائرة «أف 16» إسرائيلية. وروسيا وقفت موقف المتفرج، ولم تقيد يد السوريين ولا الإيرانيين ولا الإسرائيليين. ولكنها ستضطر إلى حسم أمرها عاجلاً أم آجلاً: هل تكون الفيصل بين أنقرة ودمشق في القضية الكردية إذا رجحت كفة تركيا. وما هي فاعلة إذا تجاوزتها طهران وغامرت بنزاع إيراني– إسرائيلي يطيح مكتسبات موسكو في سورية؟ ناهيك عن احتمالات وقوع حوادث بين الأميركيين والروس، سواء كانت حوادث عمدية أو عرضية. هذه كلها ثمار الوصاية الروسية المسمومة في سورية.
* محلل، عن «لوموند» الفرنسية، 23/2/2018، إعداد منال نحاس
الحياة
يحدث في غوطة الشام/ عبد اللطيف السعدون
يبدو أننا بحاجة للذهاب إلى دوستويفسكي، ليكون حكما فيصلا بيننا وبين كتّابٍ وسياسيين يتنازعون الرأي في ما جرى ويجري في غوطة الشام، إذ يجزم دوستويفسكي بأن دمعة صغيرة لطفل بريء تظل أكبر قيمةً من أي حربٍ أو أي ثورة، وفي مواجهتها تسقط كل المبرّرات والأعذار. نحيل هذا الحكم إلى الذين يكابرون، ولا يريدون رؤية ما يجري بالعين المجرّدة، والمجرّدة عن الهوى. لكن باستطاعتهم أن يحسبوا عدد الأطفال الذين استشهدوا على أرض الغوطة، ومقادير الدموع المنسابة من عيونهم، وهم يودعون أهلهم وأحباءهم. هذا وحده فقط يكفي لتوجيه الإدانة للذين أغرقوا سورية بالدم، أو كانوا السبب في ذلك، ففي سبعة أيام فقط لك أن تحسب أكثر من خمسمئة مدني سقطوا جرّاء القصف بمواد حارقة، بينهم 123 طفلا، كما أصيب أكثر من 2500. هنا الأرقام تعطي دلالاتها، فهي في غوطة دمشق ليست مجرد أرقام، إنها نساء وأطفال وشباب وشيوخ، وحكايات ممزوجة بالدمع والدم. لك أيضا أن تستعيد ما قاله المدير الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، خيرت كابالاري، أن ليس ثمة كلمات في وسعها أن تصف الأطفال القتلى، وأمهاتهم وآباءهم وأحباءهم. ولك أيضا أن تضع عينيك على مئات الصور التي سجلتها الصحافة، والفضائيات العالمية، ومواقع التواصل، كي تكتشف حجم الدموع التي ذرفت، وقبل ذلك كمية الدماء التي أريقت!
لك أيضا أن تتعرّف على حجم الدمار الذي عانته المدينة، بعد تعرّض عشرات المساكن والمشافي ومراكز الإسعاف الطبي والأسواق والمخابز، وكل وسائل العيش المادية إلى القصف المتواصل. وبحسب ما وثقته الصور وتقارير شهود العيان، فإن قدرا غاشما اختزل مساحة المدينة التي بلغت، في غابر الأيام، مئات الكيلومترات إلى حد العشرات، وأن سكانها الذين وصلت أعدادهم، زمانا مضى، إلى مليونين ومئتي ألف، لا يتجاوز عددهم اليوم الأربعمئة ألف، إذ فعلت حروب المدينة فعلها فيهم، وأخرجت مئات الألوف منهم عن الخدمة. ويمكنك أن تكتشف كيف يعيش هؤلاء الذين فضلوا البقاء في المدينة على النزوح خارجها، من خلال ما ثبتته المنظمات العالمية عن الحال. يقول برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة إن غوطة دمشق تعاني من كارثة إنسانية، ثمّة نقص حاد في المواد الغذائية الأساسية والأدوية، إلى درجة أن بعضهم كان يبحث عن الطعام في أكياس القمامة، وقد يتعرّض إلى فقدان الوعي بسبب الجوع، وإن أسرا فقيرة تجبر أطفالها على التناوب على تناول وجبات الطعام.
كل هذا الذي حدث ويحدث في غوطة الشام لم يستنفر شعورا بالتعاطف لدى عديد من أعضاء
“في إطار صراع النفوذ وتقاسم المصالح، صدر القرار اليتيم الذي لا يحمل دلائل الاستمرارية والصمود”
مجلس الأمن الذين تأخر على أيديهم إصدار قرار وقف إطلاق نار مؤقت، يلتقط عبره الضحايا أنفاسهم، ويحصل الجياع على ما يقيم أودهم، ولو إلى حين. لكن عندما تدبر الطرفان، الأميركي والروسي، أمرهما، وأمن كل منهما لنفسه موطئ قدم في ما يمكن أن يستجدّ من مساوماتٍ وتسوياتٍ في إطار صراع النفوذ وتقاسم المصالح، صدر القرار اليتيم الذي لا يحمل دلائل الاستمرارية والصمود، وسارعت إيران لتؤكد أنها هي وسورية ستواصلان ضرب المجموعات “الإرهابية”، وأن القرار لا يعني التوقف عن ذلك. وهكذا عادت غارات الطائرات وراجمات الصواريخ إلى الفعل، وجرت محاولة توغل بري في المدينة، وقالت مراسلة “سي إن إن” إنها شاهدت آباء وأمهات يقبلون أطفالهم، لأنهم قد لا يرونهم أحياء مرة أخرى.
هذا يعني أن حرب الغوطة لن تنتهي، وأن الصراع على سورية سيتواصل فصولا، ترجح ذلك عوامل عدة، فنظام دمشق يعاني من الارتباك، ولا يبدو قادرا على بلورة دورٍ له، بعد ما تآكلت شرعيته، ودخل في لعبة الدم مع معارضيه الذين هم أيضا يعانون من الارتباك، ومعظمهم مرتهنون لقوى خارجية، تفقدهم إمكانية توحيد رؤاهم وأطرهم التنظيمية، فيما تسعى القوى الدولية الفاعلة في الساحة إلى الحصول على مواقع قوة على أرضٍ مفتوحةٍ في كل الاتجاهات، وهي تناور وتحاور، إلى حين أن يكون في مقدورها تشكيل الخريطة الإقليمية على النحو الذي تراه. في الوقت نفسه، يسعى كل من القطبين الإقليميين، تركيا وإيران، إلى إحراز مكاسب تخدم مشروعه الخاص، في إطار استعادة مجد أمبراطوري غابر، أما الدول العربية فقد باتت خارج الحساب، بعد أن تفرقت أيدي سبأ، ولم تعد في وارد التأثير، لا هنا ولا هناك.
العربي الجديد
نهج إسرائيلي في الغوطة/ معن البياري
تحتاج إلى أرطالٍ من بلادة المشاعر، عندما تطالع أن مستشفياتٍ وعياداتٍ في الغوطة الشرقية في ريف دمشق تتعرّض للقصف مرتين وأكثر، من النظام والطيران الروسي، فضربة واحدةٌ لا تكفي للإجهاز على أيٍّ من هذه المنشآت الطبية، يلزم أن تستهدفها الصواريخ الارتجاجية الروسية مراتٍ، لضمان خروجها من الخدمة تماما، كما تم النجاح السديد في هذا بشأن مستشفى عربين. وعندما تقرأ أن مراكز للولادة تعرّضت لاستهداف عسكري نشط، فإن أي كلامٍ في السياسة، بعد إصدار مجلس الأمن الدولي قراره الليلة قبل الماضية البدء بهدنةٍ إنسانية مدة شهر (في كل سورية!) يصبح ترفا ذهنيا، وتمرينا في الكلام الساكت، بتعبير إخوتنا السودانيين. ذلك أن قوة الاحتلال، الممثلة بالنظام الذي يقبض على السلطة في سورية، لا تجد نفسها مضطرةً للامتثال لذلك المطلب الإنساني (أو لعله الإنسانوي، بلغةٍ متثاقفة)، والذي جهر به قرار مجلس الأمن، وألحّ عليه مسؤولون في الإغاثة في الأمم المتحدة، فالحملات العسكرية التي نشط فيها النظام، وبإسنادٍ روسي جوي، وتدعيمٍ مليشياوي إيراني، في غير محافظةٍ ومدينةٍ وبلدةٍ في عموم سورية، مضت في تفاصيلها، من دون اكتراثٍ بالضمائر الرهيفة لدى أولئك الموظفين المختصين في الأمم المتحدة. قُتل، في سبع سنوات، آلاف الناس، ودمّرت مدارس ومستشفيات ومساجد وكنائس وأفران خبز، ثم لم تنطبق السماء على الأرض (مع الاعتذار من نيكي هيلي)، وإنما تواصلت بياناتٌ وقراراتٌ ونداءاتٌ في مجلس الأمن، وفي اجتماعاتٍ في عواصم عديدة.
كان مفهوم مناطق خفض التصعيد احتيالا لغويًا غير تقليدي، ابتدعه الروس، ثم نجحوا في قصة الضامنين البائسة، فأشغلونا، نحن المعلقين في الصحافة، بتحليلاتٍ سياسيةٍ في أمر هؤلاء الضامنين (أهمهم روسيا وإيران)، وفي الاستثناءات التي لا يشملها “خفض التصعيد”، من قبيل الإرهابيين في جبهة النصرة و”داعش”. وبينما نحن الآن في أثناء محدلة القتل والتهديم الكارثية في الغوطة الشرقية، نتابع جلسات مجلس الأمن التي عقدت بطلب روسي (!)، ثم التصويت على مشروع القرار الكويتي السويدي. وبينما المشاهد المروّعة من الغوطة على الشاشات لا تتوقف، يكاد يفلت من التفاصيل المتواترة أن اتفاقا خاصا بوقف إطلاق النار في الغوطة (وريف حمص) تم التوقيع عليه في القاهرة، في يوليو/ تموز الماضي، برعايةٍ مصرية (وضمانة روسية أيضا!). ولا مجاملة لسامح شكري في القول هنا إن بنود ذلك الاتفاق أفضل مما نص عليه القرار الجديد لمجلس الأمن، فهو يؤكّد على وقفٍ كاملٍ للقتال وإطلاق النار من جميع الأطراف، وعلى عدم دخول أي قواتٍ عسكريةٍ للنظام، أو قوات حليفة له، الغوطة.
ولكن، من قال إن النصوص أوْلى مما في النفوس؟ .. استرشادا بالنهج الإسرائيلي الذي يواظب عليه، اعتبر نظام دمشق اتفاق القاهرة مجرّد مجاملةٍ روسيةٍ (وسعودية) لنظام عبد الفتاح السيسي، من أجل أن يشعر بأن له، كما غيرُه، قرصٌ في العرس السوري الدامي، أما ما انكتب في الاتفاقية فتولّت أمرَه القذائف والصواريخ التي استأنفت مهماتها، في اليوم التالي لحفل التوقيع في العاصمة المصرية، وبعد ساعاتٍ من غبطة أحمد الجربا الفائضة به. تماما كما فعلت الصواريخ والقذائف التي اشتدّت، أمس في حرستا وغيرها، مع مقذوفاتٍ مضاعفةٍ بالنابالم الحارق على أحياء سكنية كيفما اتفق في شرقي الغوطة عموما. وذلك كله لتأكيد حزمة بديهياتٍ، أولها أنه لا يجوز أن يتدخل أحدٌ بشأن الحرب على الإرهاب، الموظفون الإنسانيون في جنيف في الأمم المتحدة وغيرهم، وعلى القنوات التلفزيونية المُغرضة أن تعرف أنه لا مطرح للعواطف، في غضون هذه الحرب. وثانيها أن النظام في سورية مبدئيٌّ في ثباته على نهجه الإسرائيلي الذي لا يتقادم، فعندما أراد، في مثل هذه الأيام قبل 36 عاما، في حماه، أن يُجهز على ثلاثمئة من “الإخوان المسلمين”، قتل نحو ثلاثين ألف مدني (الأرقام كما العادة متأرجحة)، ودمّر حواضر ومساجد ومدارس وكنائس في غضون المذبحة المشهورة. ولذلك، من عاديّ الأمور، في سبيل أن يقضي على مسلحين معدودين، يراهم إرهابيين، أن يقضى على آلافٍ في مهاجعهم ومنازلهم ومستشفياتهم. وثالث البديهيات أن لمن يريد أن يُشهر عواطفه تجاه بشرٍ يُنتشلون من بين الحطام فليفعل، أما بشأن النابالم والقذائف والصواريخ فما تصنعه متروكٌ للنابالم والقذائف والصواريخ.
العربي الجديد
أخيرا.. الجحيم السوري على المسرح الدولي/ حامد الكيلاني
اختفت العديد من المهن التي كانت البعض من حياتنا اليومية، ومنها تصليح مواد المنزل البسيطة كالأثاث القديم أو حتى إبريق الشاي المكسور أو خياطة صحون الطعام المحطمة، وربما نتعجب في حاضرنا من تغيير المقتنيات باستمرار لأسباب تتعلق بمفاهيم الجمال والتجديد أو التحديث لمقاومة الملل؛ يرتبط ذلك بنوع المكان وطبيعة العمل وما طرأ على وسائل الإنتاج.
أحياناً نتفاجأ من عدم اندثار مثل تلك المهن في المدن المتقدمة، ولا نعني بها ترميم اللوحات الفنية أو تصليح التحف الثمينة، إنما الأشياء البسيطة بما تحمله في طياتها من ذاكرة تحاول الصمود لوقت أطول كميراث لأشخاص وعلاقات وعوائل أو على نطاق أوسع، ومقابل التصليح تدفع أموالا أكثر بكثير من سعر الأصل، والغاية دائما في كيفية إعادة ما نحبه إلى سابق عهده ومكانته في نفوسنا.
لكن ما بين التصليح والتصحيح والإصلاح من يُعيد بيتنا المهدم إلى ما كان عليه؟ وماذا عن الأبرياء الذين قُتلوا، وماذا عن نسخة المأساة المكررة بالملايين في مخيمات النازحين والمهجّرين؛ كيف سيتم تصليح هذا الكم من الانكسار في النفوس؟
لا يمكن تأهيل التحفة التي نسميها الوطن وهي تحت خط الانسحاق والتهشيم المتعمّد بمجرد استحضار تقنيات الانتخابات أو الإصرار بتوظيف الانتصار على تنظيم الدولة لافتتاح مشروع دولة الميليشيات المقبلة في العراق، أو تأهيل الحاكم في سوريا لأن إرادة دولة كبرى كروسيا أو دولة إقليمية كإيران وجدتا فيه ما يستحق الإبقاء عليه رغم انتهاء صلاحيته منذ سنوات بعيدة.
أي نظام حكم سوي أو حاكم فيه بقايا انتماء إلى شعبه لا يمكن أن يرتضي استمراره في السلطة جالساً على تلال من الجماجم، إلا في حالة واحدة لا غيرها يمكن إيجازها باختصار سلطته في ديمومة حمايته لعدم وجود مفر سوى كرسي الحكم.
ذلك ما يفسر ممارسات ديمقراطية الأحزاب الطائفية في العراق، أو انتهاكات النظام الحاكم في سوريا وكلاهما بمرجعية الاحتلال الإيراني ومناهجه الموحدة في سياسة التخريب والإبادة، وشواهدها في التغيير الديموغرافي وأيضاً في استغلال الطرف الآخر المحسوب على النظام بمرجعيته الطائفية التي أصبحت فاصلة عملية نتيجة لتطبيقاتها على الأرض، وشحذ حالة اللاتراجع بتقرير توقّع الانتقام المسبق المقابل عند انهيار النظام.
مع بداية ثورة الشعب السوري السلمية ارتفعت بعض الأصوات في الإعلام مطالبة، ودون أي اعتبار لمكانتها ولو الشخصية، بسحق التظاهرات بقوة السلاح وعدم الرأفة حتى بالنساء والأطفال وحجّتهم إنهم ابتكروا لأول مرة طاقة نقد النظام الحاكم.
ما آلت إليه الأوضاع في سوريا وفي الغوطة الشرقية هو ما خطط له في ذهن وعقل المخربين الحقيقيين الذين ارتسمت أمامهم الأهداف ومبرّرات العنف وطرق الاحتماء بمظلة المشاريع الدولية، وأهمها ضمان مصادرة أي قرار دولي رادع يصدر عن مجلس الأمن.
القرار 2401 بتعديلاته الروسية ومشاوراته الإيرانية خلف الكواليس جاء بعد تأجيل متكرر في وقت كان فيه الجحيم على حد تعبير الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس يتخذ من الغوطة الشرقية مسرحاً للفرجة يحترق على خشبته الأبرياء دون أن تنجدهم أي قوة للتدخل السياسي أو العسكري السريع.
النظم الديمقراطية في العالم من بعض تجلياتها الفكرية إنقاذ الحاكم من مخاطر السلطة، وذلك بإعادة إنتاجه إنسانيا كجزء من الشعب مع أفراد أسرته وطاقمه المقرب وعدم التفريط به أو بهم في معادلة “أن أكون حاكما أو لا أكون”.
الرهان على الكتلة الطائفية ومعهم قطيع الخدمة والصمت والخوف لن يجدي وإن بدا في فترة ما وسيلة قمع تضمن تمدد الإرهاب العقائدي الإيراني وإطالة أمد البقاء للحاكم السوري أو سلطة عملائهم في العراق. التناقضات في حسابات المحاصصة السكانية الطائفية وحساباتها وفق الرؤية الخاصة لنظام الملالي يتم التعاطي معها لخلق موازين التفاضل العددي في سياسة الرعب والتهجير وفي الاستبدال السكاني وإحلال جماعات أخرى بنزعات قصيرة النظر تضع كل البيض في سلة أنظمة آيلة للسقوط، ولو بعد حين لعدم امتلاكها جينات مواكبة العالم المتمدن وقدرة التعايش بسلام مع الأسرة الدولية.
برامج ترويض الشعوب في مهزلة السيرك الإيراني تحت مظلة مهرج واحد مازال يعتقد أن الشعوب زائلة وبالإمكان تعويضها بأحزابه وسياساته أو مقايضتها بأقل العطاءات برفقة تنظيم الدولة الذي أدى واجباته كصديق في تدمير وتآكل النسيج المجتمعي وما اجتهدت عليه تضحيات حقب زمنية لجعله حقيقة ماثلة للعيان في التعايش والإيخاء. النظام الحاكم في سوريا وبرعاية ومشاركة روسية وإيرانية يكرر طباعة المنهج المكرر في الإبادة السكانية لأغراض سياسية وطائفية باعتماده تعميم الإرهاب ضد المناطق والأحياء المطلوب تهجيرها.
الهدف هو حزام دمشق، كما هو حزام بغداد، في إستراتيجية تطويق تؤتي ثمارها على المدى البعيد في تطويع الإسكان بمناطق بعيدة بالترحيل القسري، أو بالقبول بمناطق آمنة محتملة في المستقبل، وتسليم من تبقى على قيد الحياة بالأمر الواقع بديلا عن الموت.
بعض المدن لا تتجاهل حاجتها إلى إعادة “تصليح” ما تهدم منها خارج دعوات مزايدات الإعمار المسيّسة، لكنها بكل تأكيد ستحتاج إلى زمن ليس بالقصير لتلتفت بعدها إلى “إصلاح” سياسي قد يأتي لها بالأمل والاستقرار أو لا يأتي وذلك هو الأرجح.
الإرهاب في واقعنا لا ينتهي، والميليشيات تروّج مجدداً له بما يشبه نداء استغاثة لتنشيطه، ذلك لأنها لم تنته من مشروعها، إذ كلما أخفقت أخرجت لنا إرهابا على مقاساتها وضرورات مرشدها في قمع الشعوب الإيرانية التي جرّبت عنصرية نظام الولي الفقيه وهوس هيمنته على المنطقة الذي أدى إلى تداعيات الانتفاضة وزحزحة الكتل السكانية المتباينة في نسيجها بما عبّرت عنه من اجتياز حاجز الخوف أيضا.
شعب العراق تغيرت ملامحه وفقد كثيرا من سماته، وكذلك شعب سوريا ومعهم شعوب أخرى تحت خط الإرهاب الإيراني، ولا نستثني منهم الشعوب الإيرانية التي لا يمكنها إصلاح ذات البين بينها وبين حكامها وأنظمتها.
الأمل أن لدينا ما هو مشترك من أوطان نحب ونسعى أن نعيدها رغم الحطام والانكسار إلى سابق عهد تحفتها الإنسانية.
كاتب عراقي
العرب
النظام السوري بوصفه محمية روسية
مرة أخرى يثبت مجلس الأمن الدولي عجزه الفاضح حيال القرارات التي يصدرها وتبقى حبراً على ورق، حتى عندما تتخذ بالإجماع وبعد تقديم تنازلات تفرغ النصوص من آليات تطبيقها على الأرض. والمثال الأحدث هو القرار 2401، حول وقف إطلاق النار في سوريا لمدة لا تقل عن شهر، والذي صوت عليه المجلس بالإجماع بعد مفاوضات شاقة مع روسيا الاتحادية.
تحالف النظام السوري وروسيا وإيران تابع استهداف الغوطة الشرقية وكأن شيئاً لم يكن، متذرعاً بالفقرة الثانية من القرار، والتي تنصّ على أنّ «وقف الأعمال العدائية لا ينطبق على العمليات العسكرية ضد «تنظيم الدولة» (داعش) و«القاعدة»، و«النصرة»، وجميع الجماعات الأخرى، والمشاريع والكيانات المرتبطة بـ «القاعدة» أو «داعش»، وغيرها من الجماعات الإرهابية، كما حددها المجلس». ولا أحد سوى أطراف هذا التحالف يملك سلطة التفريق بين 400 ألف مدني محاصرين في الغوطة الشرقية، وعشرات من مقاتلي «داعش» و«النصرة» و«القاعدة»، وبالتالي فلا أحد يستطيع اتهام طيران التحالف الثلاثي بخرق وقف إطلاق النار.
وبعد ساعات قليلة أعقبت التصويت على القرار 2401، أشارت تقارير ناشطين على الأرض في الغوطة الشرقية، ومنظمات طبية وإنسانية، إلى مقتل العشرات من المدنيين، بسبب مئات الطلعات الجوية، التي ألقت مئات الصواريخ والقذائف والبراميل المتفجرة. إلى هذا، لم يشف استئناف أعمال القصف الوحشي غليل النظام السوري، فلجأ إلى قصف منطقة الشيفونية بغاز الكلور السام. من جانبه استأنف الطيران الحربي الروسي مهامه القتالية فقصف بلدة دوما، مما أسفر عن مقتل 16 مدنياً بينهم عشرة أفراد من عائلة واحدة.
ويلفت الانتباه أن موسكو وطهران لم تعد تتمسك حتى بالشكليات الدبلوماسية في التعامل مع الصفة «السيادية» للنظام السوري، فبات وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف هو الذي ينفي استخدام غاز الكلور ويصنف التقارير التي أشارت إليه في باب «الاستفزاز»، كما أعلن رئيس هيئة الأركان الإيراني محمد باقري أن وقف إطلاق النار في الغوطة الشرقية لا يشمل «جبهة النصرة»، وإن الحرب عليها لا تزال مستمرة.
في المقابل يتابع مسؤولون أوروبيون، من أمثال المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل والرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون، مناشدة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كي يضغط على النظام السوري للالتزام بوقف إطلاق النار، وكأن الأسلحة الروسية الأحدث والأشد فتكاً التي تُجرب على المدنيين السوريين ليست بإمرة الكرملين. وليس أدل على سخرية موسكو من مجلس الأمن الدولي سوى الأمر الرئاسي الذي صدر أمس عن بوتين وقضى بتطبيق «هدنة إنسانية» بين الساعة 9 والساعة 14 يومياً، وكأن القرار 2401 لا ينص بدوره على الوصول الآمن لقوافل الأمم المتحدة وشركائها التنفيذيين الإنسانيين، بما في ذلك الإمدادات الطبية والجراحية، إلى جميع المناطق والسكان.
وفي زمن مضى، ولكنه لم ينقض بعد، كانت دولة الاحتلال الإسرائيلي هي المدللة في مجلس الأمن الدولي بسبب تعنت الولايات المتحدة في الدفاع عن ربيبتها. لكن العالم يشهد اليوم تمتع النظام السوري بمزايا مماثلة، ليس لأي مقارنة بين علاقات واشنطن وتل أبيب بالطبع، ولكن لأن هذا النظام حوّل سوريا إلى محمية روسية، فاقتضى أن تتولى موسكو شؤون الحماية في الداخل السوري كما في أروقة الأمم المتحدة.
القدس العربي
الحسم العسكري يطوي صفحة آستانة ويثأر لسوتشي/ جورج سمعان
نادت موسكو مجلس الأمن لإيجاد حل للغوطة. لا تريد تحمل تبعات الجرائم التي ترتكب شرق دمشق. وسواء شاركت فيها أم صدق نفيها عدم المشاركة تظل مسؤولة مسؤولية النظام وحليفه الإيراني عما يحصل. بل الأرجح أنها قررت الرد على إحباط مشروعها السياسي في سوتشي، بعد التجرؤ عليها عسكرياً بضرب صورة «الانتصار» الذي تباهى به الرئيس فلاديمير بوتين قبل أشهر من قاعدة حميميم. وجرّ بعدها سلسلة من العمليات المؤلمة ضد قواته في أكثر من موقع. كان متوقعاً أن سيد الكرملين لن يسكت مع اقتراب الانتخابات الرئاسية. وعد شعبه باستعادة ما كان للإمبراطورية القيصرية ثم السوفياتية، فكيف له أن يرضى بتقويض كل ما بناه في سورية؟ دفع بأسلحة جديدة جوية وبرية ليس لاختبار مدى فاعليتها فقط. وليس هذا هدفه الأساسي. رسم المنخرطون في الحروب السورية خطوطاً حمراً سياسية وعسكرية، فقرر انطلاقاً من الغوطة وريف حمص بعدها وربما الجبهة الجنوبية لاحقاً، السيطرة على كل ما يقع تحت مرمى قدراته. وعلى المجتمع الدولي أن يهتم بالأزمة الإنسانية التي تخلفها الحرب المتنقلة. لن ينتظر سعي «مجموعة الخمسة» حتى التوصل إلى فرض «اللاورقة» تسوية سياسية تحت مظلة الأمم المتحدة. فهو جهد منذ انخراط جنوده مباشرة إلى جانب النظام لتقويض كل ما قررته المنظمة الدولية. واستطاع العمل من خارجها في آستانة بالتفاهم مع طهران وأنقرة. وفرض «مناطق خفض التوتر». وكاد ينتزع شرعية دولية لمشروعه السياسي. لكن حسابات البيدر في «مؤتمر الحوار الوطني» لم تطابق حسابات الحقل. وكان قبل «الشراكة الثلاثية» في العاصمة الكازاخية، أبرم عشرات الاتفاقات مع فصائل مسلحة لإخماد جبهات ومدن ودساكر ليتيح انتشار قوات النظام الذي استعاد المبادرة وحقق «إنجازات» على الأرض بدعم من إيران وميليشياتها.
أطراف كثيرة أسقطت مشروع سوتشي. الولايات المتحدة ودول أوروبية ومجمل الفصائل العسكرية الرئيسية و «الائتلاف الوطني» للمعارضة. لم يعد هناك تالياً مبرر لبقاء «مناطق خفض التوتر». فقد لجأت موسكو إلى هذه الهدنات توطئة أو رافعةً التسوية السياسية التي كانت ترسمها خدمة لأهدافها أولاً وأخيراً. لم تفلح هذه المحاولة في الالتفاف على دور الآخرين المعنيين بالأزمة السورية والقفز فوق القرارات الدولية. ولم يبق مفر أمامها سوى رفع التحدي والذهاب إلى خيار الحسم العسكري. ولا شك في أن معركة الغوطة تستهدف أولاً توفير الأمن في العاصمة دمشق ومحيطها. لكنها تؤشر أيضاً إلى بداية حرب واسعة لإسقاط كل مناطق التهدئة، أي إنهاء سيطرة الفصائل «المعتدلة» على هذه المناطق. علماً أن هذه حظيت باعتراف «ثلاثي آستانة» ووافقت على الهدنات. يعني ذلك أن روسيا نقلت الأزمة إلى مرحلة جديدة أشد شراسة. ستحرص على عدم التفريط بـ «الشراكة الثلاثية». فلا غنى لها عن القوى التي تخوض المواجهات على الأرض. إيران وميليشياتها وتركيا و «فصائلها». وقد غضت الطرف عن عملية «غصن الزيتون». وأتاحت لحكومة أردوغان أن تحتفظ بمناطق نفوذها المحاذية لحدودها، مقابل أن تسكت هذه على إنهاء سيطرة كل الفصائل القريبة منها، سواء كانت لـ «الجيش الحر» أو لقوى إسلامية معتدلة تنتشر في مناطق أخرى بعيداً من الحدود.
جاءت العودة الصارخة لموسكو إلى الحرب في سورية – وهي لم تتوقف أصلاً – في توقيت دقيق. جميع المتصارعين على هذا البلد يخوضون مناوشات ميدانية مباشرة تنذر بحرب واسعة. من روسيا إلى الولايات المتحدة مروراً بإيران وتركيا وإسرائيل. وحفلت الأسابيع الأخيرة بمفاجآت عسكرية منذ أكثر من شهر بلا توقف. وشكلت توكيداً صارخاً على أن الأزمة في بلاد الشام دخلت مرحلة جديدة. وبدا الرئيس بوتين أمام تحد مفصلي. ثمة نزاع على مستقبل مشروعه ودوره وقراره. تعرضت قواته لهجمات دموية. ولم يفلح مؤتمر سوتشي في دفع التسوية السياسية. فقد طرحت إدارة الرئيس دونالد ترامب بالتفاهم مع فرنسا وبريطانيا والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة رؤية مختلفة للحل السياسي والإصلاحات المطلوبة التي يجب أن تبقى تحت عباءة الأمم المتحدة. ولم تعد طهران تجول وتصول بلا رقيب أو حسيب. وحتى إسرائيل اندفعت بعيداً في غاراتها التي لم تعد أيضاً نزهة. وتركيا المتخبطة في سياسات متغيرة تخوض حرباً في شمال سورية يكتنف الغموض مآلها ومستقبلها ميدانياً وسياسياً. هذه المفاجآت كلها شكلت تهديداً لمشروع الكرملين وطموحاته واستراتيجيته.
أمام خطورة الانزلاق إلى حرب واسعة بين كل هذه القوى، وأمام انهيار قواعد اللعبة أو الاشتباك التي نسجها الكرملين طوال شهور، كان لا بد من نهج مختلف وسياسة أخرى أكثر صرامة تؤكد عبرهما موسكو أنها قادرة على التعامل مع المتغيرات. وهي تسعى على جبهة شمال سورية، كمثل طهران أيضاً، إلى المواءمة بين حرصها على التفاهم مع أنقرة وإرضاء الكرد. وإلى ترتيب تسوية تجنب القوات التركية الغرق في مستنقع عفرين. كل ذلك من أجل الحفاظ على الرئيس أردوغان بعيداً من واشنطن. وليس سراً أن ثمة باباً مفتوحاً بين أجهزة الأمن في كل من سورية وتركيا التي تتريث حكومتها أو تتورع الآن عن فتح خط سياسي مع جارتها الجنوبية. مع أن موسكو لا تنفك تذكرها بأن انتشار قواتها في الشمال السوري غير قانوني، تماماً كما هي حال القواعد الأميركية المنتشرة في الشرق والشمال السوريين. من جهة أخرى، قد لا تجد روسيا مشكلة عميقة مع إيران ما دامت انحازت إلى خيار الحسم العسكري. ولن يضير طهران، مرحلياً في الأقل، العمل تحت مظلة موسكو. فهي تحتاج إلى قوة دولية تساندها لمواجهة ضغوط القوى الغربية عليها هذه الأيام، وتهديدات بنيامين نتانياهو. ولا يستبعد أن ينجح الرئيس بوتين في نزع فتيل التوتر بين الجمهورية الإسلامية وإسرائيل التي دعا رئيس وزرائها موسكو إلى التدخل لوقف التصعيد بعد إسقاط «طائرة إف 16»، خصوصاً أن طهران فتحت باباً بردها على اتهامه إياها بالسعي إلى فتح جبهة الجولان، بالقول أنها جاءت إلى سورية لمواجهة الإرهاب. وإذا تعذر على سيد الكرملين اجتراح معجزة تؤدي إلى «تطبيع ما» بين الدولتين، فيمكنه أن يشكل مظلة توفر ضمان الهدوء على جبهة الجولان. ومثل هذا الاحتمال قد يخفف من وتيرة قوافل السلاح والصواريخ الإيرانية إلى سورية ولبنان أيضاً. ويبرد التهديدات المتبادلة بين طهران وكل من تل أبيب وواشنطن.
على جبهة الجنوب، تدفع روسيا نحو التفاهم مع الأردن من أجل دفع الفصائل في حوران إلى المصالحة مع النظام. وإذا فشلت المساعي قد لا تنجو هذه المنطقة من خيار الحسم، كما هي الحال اليوم في الغوطة. فيما يكثر الحديث عن معركة مقبلة في ريف حمص التي يمكن الفصائل هناك أن تصمد أكثر حيث لا مشكلة إنسانية حادة كما هي الحال في دوما وحرستا وشقيقاتهما. أما شرق البلاد فقد أكدت الولايات المتحدة حضورها بالحديد والنار اللذين لم يوفرا قوات النظام وحليفيها الروسي والإيراني. حازت القوات الأميركية وحليفتها «قوات سورية الديموقراطية» منطقة استراتيجية لا تقل أهمية عن الساحل السوري الذي تقيم فيه روسيا قاعدتيها ومواقع انتشارها، غير عابئة بأصوات دمشق وطهران وموسكو أن وجودها احتلال ما دام لم يحظ بموافقة حكومة الرئيس بشار الأسد. في الشرق الشمالي معظم الثروة النفطية والمعدنية ونحو نصف إهراءات الزراعة والغذاء.
خلاصة القول، إن الكرملين الذي فشل في إلزام الشركاء والخصوم، في السنتين الماضيتين، احترام قواعد اللعبة التي رسمها، وحدود النفوذ التي «وزعها» على هذا الطرف وذاك، يجد نفسه مجبراً على خوض حرب واسعة لن تكون هينة. ففي الغوطة المحاصرة منذ أكثر من أربع سنوات قرابة عشرين ألف مقاتل، فهل يستسلمون بيسر وسهولة؟ ناهيك ببضعة آلاف في ريف حمص وجبهة الجنوب الواسعة. وهل ينجح الرئيس بوتين في تطبيق نموذج الشيشان في سورية؟ وإذا نجحت سياسة الأرض المحروقة في تطويع السوريين ماذا سيقدم لهم حتى تهدأ النفوس والقلوب؟ أعاد إعمار غروزني وجعلها نموذجاً أنفق عليه الكثير إلى حد أثار حفيظة الروس. فهل يهدي إلى أهل الشام رأس النظام، ملقياً عليه المسؤولية عن جرائم الحرب التي ترتكب يومياً ويغسل يديه متبرئاً؟
الحياة
النيران تستعر في الغوطة والأميركيون عاجزون/ عدلي صادق
يؤشر احتدام القصف الجاري لغوطة دمشق الشرقية في سوريا على احتمالات اصطدام بالوكالة، بين روسيا والولايات المتحدة الأميركية، لا سيما وأن الأخيرة تعرضت لمسلسل من خيبات الأمل التي دلت على تخبط ورعونة سياسة الرئيس دونالد ترامب وطاقمه، اللذين يطلقان التهديدات ثم لا يقويان على فعل شيء، كلما تجاوز النظام السوري ومن ورائه الروس والإيرانيون، الخطوط الحمراء التي يحددها الأميركيون.
فلا تزال المحرقة تتفاقم، ويُقتل السوريون بالجملة، بينما الرغبة الحقيقية للرئيس ترامب وإدارته، هي نفسها رغبة بنيامين نتنياهو والفريق الذي معه، وهؤلاء يريدون لكل الأطراف في سوريا أن تستكمل تدميرها وتشريد شعبها.
تنم سياقات الأمور على الأرض، عن أن جميع الأطراف تكذب ولا تحترم تعهداتها، وأن خطابها المعلن في توصيف مقاصدها من الانخراط في الصراع، لا علاقة له بحقائق المقاصد والأهداف.
فعلى الرغم من كل الفظاعات في الغوطة الشرقية، لم تجرؤ واشنطن على القول إن لديها ورقة تفاهم مع أصدقائها وحلفائها، لوقف التدمير وشلال الدم. لذا تعمدت تسمية مقاربة التفاهم مع بريطانيا وفرنسا وألمانيا والسعودية والأردن بــ“اللاورقة”، وقوامها أو تمنياتها أن تستهل هذه الدول مجتمعة والقابلة للتكاثر، تدخلا سياسيا ودبلوماسيا وعسكريا لفرض حل على أساس تغيير النظام.
وكان فحوى تلك “اللاورقة” يعكس الرؤية الأميركية الفضفاضة، التي أفصحت عنها واشنطن في منتصف شهر يناير المنقضي، وأرادت أن تجعلها المقابل المضاد لمسار “سوتشي” العقيم والمراوغ.
غير أن القراءة الموضوعية لكل هذه الصيغ أنها تعزز ازدحام الأجندات السياسية التي تحاول التغطية، كقنابل دخان، على معطيات الواقع الدامي للشعب السوري، وممارسات الجيوش الضالعة في قتل السوريين وتدمير ما تبقى من بلادهم.
ويتّبع الأميركيون في سلوكهم على الأرض منطق التذكير بأنهم موجودون وحسب. فهم يتواجدون بالفعل من خلال ثماني قواعد عسكرية شرق الفرات، وبؤر في بادية شرق سوريا حيث يوجد مخزون للطاقة. وهؤلاء ومعهم حلفاؤهم، يتحدثون عن تغيير قواعد اللعبة، وصياغة دستور تتحدد فيه وتتقلص صلاحيات رئيس الجمهورية، ويؤكد على النظام البرلماني ومبدأ الفصل بين السلطات، والتداول على السلطة من خلال الانتخابات بالمعايير الدولية، وضمان حقوق المواطنة المتساوية وإعادة بناء الجيش والأجهزة الأمنية.
الروس بدورهم تطيّروا من التعاطي الغربي معهم على افتراض أن دورهم، ومعهم الإيرانيون والنظام، قد انتهى. فقد رأوا أن الغرب من خلال حلفائه في المنطقة، يتطلع إلى الدخول للإعمار ووضع اليد على ثروات سوريا، التي يُقدر مخزون الغاز في باطن أرضها وعلى ساحلها، بما يعادل حجم المخزون الروسي إن لم يزد عليه. من هنا احتدمت الأجندات واحتدمت النيران، التي وقودها الناس والحجارة.
أما تركيا الأردوغانية فإن أمرها لا يتخطى دور الكومبارس الذي يكفيه الأجر الضحل، بعد أن تخبّطت وتقلبت وجمعت بين المتناقضات في علاقاتها بدول الإقليم النافذة وروسيا.
وعلى الرغم من ذلك تزداد المصاعب التي تواجهها تعقيدا وصعوبة، واحتقنت علاقاتها مع حليفها الطبيعي، الأميركي، بجريرة حساباتها الإقليمية، وتحالفاتها الظرفية التي لجأت إليها اضطرارا، ولا تتسم بالملـمح الاستراتيجي الراسخ والدائم. فعلاقاتها مع الإيرانيين، أعدائها في الساحة السورية، متأرجحة ومصلحية، ليس ثابتا فيها سوى العلاقات الاقتصادية، الماضية بحجم كبير، في موازاة التناقض بين الطرفين، في المقاصد والأهداف على الأراضي السورية.
ومن بين استثناءات التوافق ميدانيا بين أنقرة وطهران، على الأراضي السورية، أن العاصمتين توافقتا في الموقف من الأكراد، ولم تتقبل أنقرة بسعادة اتفاق وقف التصعيد، ما جعلها معنية بالتركيز على منطقة إدلب، لكي تظل خالية إلا من نفوذها، وينغص عليها وجود جبهة النصرة التي يتفق الإقليم والعالم على كونها إرهابية، وحزب العمال الكردستاني في عفرين، الذي تراه تركيا إرهابيا.
وتلعب إسرائيل دورا رئيسا، بقليل من الكلام وكثير من الفعل، وتشتغل على حصة معتبرة من ترتيبات ما بعد الحرب. فقد نجحت عبر مراحل الصراع في إبعاد القتال عن حدودها، وما اتفاقية وقف التصعيد، التي أبرمتها واشنطن مع موسكو وطهران، إلا محصلة هذا السياق. كما توصلت تل أبيب مع الروس إلى تفاهم لإزاحة أي تواجد للإيرانيين وحلفائهم على مقربة منها، ولضمان ذلك تأسست بين الروس والإيرانيين منظومة تنسيق عال على المستوى الميداني برا وفي الأجواء. ولم تنقطع زيارات نتنياهو لموسكو، لضمان فاعلية الاتفاق.
بالإضافة إلى ذلك باشرت إسرائيل بنفسها عملا عسكريا متقطعا لكنه مؤثر وموجع. فهي تشن بين الحين والآخر مجموعة غارات على مفاصل الانتشار الإيراني والجيش النظامي السوري وحزب الله، في وسط وجنوبي سوريا، لضمان أمنها راهنا ومستقبلا، واخترقت الخارطة العملياتية للفصائل المعارضة وأنشأت علاقات لوجستية مع بعض مجموعاتها وفصائلها المقاتلة، وعقيدتها في ذلك كله هي أن يتأذى الجميع، وأن تُدمر سوريا وأن تصبح عندما تنتهي الحرب معنية بلعق جراحها، وعاجزة عن أي حراك لعشرات السنين.
الأطراف الضالعة في التدمير والقتل وإيقاع الفتن، لا تزال معنية باحتدام النيران واحتدام التلاعبات السياسية، وبدا الروس والإيرانيون حتى الآن في موقف أفضل بكثير، بالمقارنة مع رعونة الأميركيين وتركهم عن عمد، النيران تستعر.
كاتب وسياسي فلسطيني
العرب
قيصر روسيا وسوريا وسياسة المكايد/ جلبير الأشقر
في النصح التي أسداها ماكيافِلّي لهواة السلطة والنفوذ في كتابه الكلاسيكي «الأمير» تحتل المكيدة مكانة بارزة، إلى حد أن سياسة المكائد والنفاق باتت تُسمّى باسم صاحب الكتاب، وإن اختلفت الآراء حول قصده الحقيقي، أكان فعلاً نصح الأمراء أو تحذير الشعوب من مكايدهم. وإذا كان ثمة مجال للجدال حول الشهرة التي سوف تطغى على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في ذاكرة الإنسانية، فإن ما لا شك فيه هو أن مرتبته في سجلّ الماكيافِلّية التاريخي سوف تكون عالية للغاية.
إن الرئيس الروسي، الذي يحكم بلاده منذ سنة 2000 وقد حوّلها إلى نسخة روسية من «الجملوكيات» التي اعتدنا عليها في منطقتنا العربية، بل فاق رؤساء جملوكياتنا بتقليده أشكال الحكم المَلَكية بحذافيرها بحيث استحق لقب قيصر روسيا الجديد وبامتياز، هذا الرئيس/القيصر غدا منذ عقد من الزمن يستخدم في العلاقات الدولية المكيدة والمكر والنفاق بكثافة لا تني تتزايد. وبما أن الساحة الشرق أوسطية بوجه عام هي المسرح الدولي الذي يشهد أعلى كثافة من المكايد على اختلاف أنواعها، فلا عجب من أن يترافق تصعيد روسيا لتدخّلها في المنطقة وانتقالها منذ عام 2015 إلى الانخراط المباشر في الحرب الدائرة في سوريا بتكثيف لسياسة المكيدة بلغ مستوىً قياسياً منذ عام 2016.
فبعد أن دخل الطيران الروسي المعمعة السورية في خريف 2015 بحجة محاربة الإرهاب، ولاسيما تنظيم «الدولة» (داعش)، وهي حجة لم تنطلِ ظاهرياً سوى على من أراد إخفاء تقاعسه وراءها مثلما فعلت إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما التي رحّبت بالتدخّل الروسي على ذلك الأساس الوهمي، وبعد أن تبيّن بما لا يترك فسحة للشك أن روسيا دخلت المعركة لفرض وصايتها على النظام السوري وتولّي أموره وإدارة المعركة عوضاً عنه وعن حماته من أعوان إيران الإقليميين الذين فشلوا جميعاً في دحر المعارضة السورية المسلحة بالرغم من حشر هذه الأخيرة بين ناري النظام وربيبته الداعشية، فإن بوتين رأى بدوره أن القضاء على تلك المعارضة لن يكون ممكناً بالقوة العسكرية وحدها، بل يقتضي خنقها من خلال تغيير موقف دعامتها الاستراتيجية الرئيسية، ألا وهي الدولة التركية.
فقد تمكّن بوتين أن يقلب الرئيس التركي من خصم شامت إلى شريك صامت بعد أن نبّهته موسكو إلى المحاولة الانقلابية التي حيكت ضده عام 2016، فكانت المقايضة التي تمكّنت موسكو بفضلها أن تقضي على المعارضة في شرقي حلب بعد أن تخلّت أنقرة عنها لقاء ضوء أخضر روسي أمام تدخّل الجيش التركي في الشمال السوري ليحول دون استكمال القوات الكردية وحلفائها من العرب سيطرتهم على الشريط الحدودي بين سوريا وتركيا. ثم رتّبت موسكو الأمور قبيل نهاية العام 2016 وانتحلت صفة الحَكَم بدون أن تتوقف عن لعب دور الطرف المقاتل، فجمعت في أستانة ممثلي النظام وحماته الإيرانيين والمعارضة وأوصيائها الأتراك كي تستعد لصفقة كبرى مع الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب، وهي تريد إقناعه وسائر العالم أن سوريا قد أصبحت مسرح دمى باتت كل خيوطه بيد موسكو.
ومع تعثر الأمور بسبب الصعوبات التي واجهها ترامب في واشنطن حول الملف الروسي والتي لا زالت تتعقد يوماً بعد يوم، ومع تأكد عزم البنتاغون على إبقاء قواته في الشمال السوري شرقي نهر الفرات للحؤول دون وضع طهران يدها عليها بمؤازرة من موسكو، قررت روسيا المضي قدماً في الاستيلاء على سائر الأراضي السورية من خلال تكرار سيناريو شرقي حلب في جيوب المعارضة المتبقية في إدلب والغوطة الشرقية. فمنحت ضوءً أخضر جديداً لأنقرة كي تجتاح الأراضي السورية في منطقة عفرين مقابل شنّ المحورالروسي/الإيراني/السوري هجوماً مدمّراً على المنطقتين، يتركّز حالياً على الغوطة الشرقية بغية القضاء على المعارضة المسلحة فيها حتى ولو اقتضى الأمر القضاء على آلاف المدنيين.
كل ما تبقى كذبٌ ونفاق، لاسيما المماطلة في مجلس الأمن الدولي. فالولايات المتحدة تدّعي الحرص على المدنيين في الغوطة وهي تعلم أن قراراً لمجلس الأمن لن يغيّر في الأمر شيئاً، لاسيما أنه يستثني «الإرهابيين» من وقف إطلاق النار، الأمر الذي يُبطل مفعوله. ذلك أن معظم الفصائل المتواجدة في الغوطة، إن لم تكن كافتها، من «الإرهابيين» في تصنيف موسكو ودمشق. فمن، يا تُرى، تودّ مندوبة واشنطن في المجلس أن تغشّ حينما تصرّح، بسذاجة قصوى ظاهرياً، أنه لو تم تبنّي ذلك القرار قبل أيام، لوفّر الأمر العديد من الضحايا؟
أما روسيا فبعد أن بذلت جهدها كي يأتي القرار بلا جدوى، سعت لتبيّن للعالم أنها وحدها سيدة الموقف في سوريا وأن القرارات الدولية بلا طائل. فأمر بوتين، قيصر روسيا وسوريا، بتوفير بضع ساعات كل يوم لانسحاب المدنيين وكأنه تغمّد هؤلاء المدنيين المساكين بواسع رحمته بعد أن ناشد ضميره الرئيس الفرنسي والمستشارة الألمانية. والكل يعلم أن ذلك التدبير «الإنساني» لن يستطيع حل المأساة العظيمة التي تدور في الغوطة الشرقية تحت أنظار العالم. والحال أن ما تطمح إليه موسكو ودمشق بمنتهى الجلاء، وبما لا يستطيع أحد إغفاله سوى بالتغافل عنه عمداً، إنما هو تكرار سيناريو الاستيلاء على شرقي حلب، بانتظار استكمال المهمة ذاتها في منطقة إدلب.
٭ كاتب وأكاديمي من لبنان
القدس العربي
تعالوا نعرب عن «القلق البالغ» أيضاً/ موسى برهومة
أعربت الخارجيتان الأميركية والفرنسية عن «القلق البالغ» نتيجة التصعيد في الغوطة الشرقية، وشاركهما التعبير عن «القلق البالغ» الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، الذي «حضّ جميع الأطراف على التزام المبادئ الأساسية للقانون الإنساني، بما في ذلك حماية المدنيين».
وانبرت بعد ذلك دول غربية وعربية في تأدية دورها، فقامت، من دون إبطاء، بواجب «الإعراب عن القلق البالغ»، لأنّ ما يحصل في الغوطة الشرقية التي يقصفها نظام بشار الأسد بلا هوادة بمختلف الأسلحة المحرّمة، يستدعي «القلق البالغ»، ويجعل القلق أمراً لا غنى عنه، لا سيما وأنّ الضحايا المدنيين المحاصرين في الغوطة الشرقية الذين يتعرضون للمذابح، قد بلغ عددهم خلال أسبوع واحد فقط أكثر من 460.
وبعد أن نشرت صحف غربية تقارير مهنية رصينة وموثقة من قلب الحدث في الغوطة الشرقية، ووصفت ما يحصل على الأرض بأنه «يرقى إلى عملية إبادة جماعية»، أعرب منسق الأمم المتحدة الإقليمي للشؤون الإنسانية في سورية بانوس مومتزيس عن قلقه البالغ، معتبراً أنّ استهداف المدنيين هناك «لا يمكن تصوره، ويجب أن يتوقف حالاً».
صحيفة «الغارديان» شبّهت ما يجري في الغوطة بما حدث في سربرنيتسا في البوسنة، بعدما تعرضت لحصار وقصف من قبل الجيش الصربي عام 1995، وصنفت العمليات آنذاك بأنها «إبادة جماعية». بل إنّ الصحيفة، ولهول ما رصدته من فظائع في الغوطة، قالت إن ما يحصل هناك يشبه «إلى حد بعيد أسوأ جريمة ارتكبت على الأراضي الأوروبية منذ 1945».
وبالتزامن مع نشر التقرير في «الغارديان» أعرب وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون عن قلقه و «صدمته لما يتكبده أهالي الغوطة الشرقية على أيدي نظام الأسد، إذ إنهم يعانون جحيماً من صنع النظام وداعميه».
صحيفة «دير شبيغل» الألمانية أكدت أنّ أكثر من 350 ألفاً محاصرون من قبل القوات الحكومية في الغوطة الشرقية لا يجدون أية إمدادت، فهناك نقص في الأغذية والأدوية والمحروقات. وعنونت «إذا كنت تبكي للحصول على مساعدة، لن يسمعك أحد». وجاء رد فعل وزير الدولة بالخارجية الألمانية، ميشائيل روت، مليئاً بالغضب والتعبير عن القلق، واصفاً ما يحصل في الغوطة الشرقية بأنه «جحيم على الأرض». وفي دلالة على صدق تعبيره عن قلقه، تعهد بعشرة ملايين يورو إضافية للمساعدات المقدّمة لسورية.
والقلق، في ميادين السياسة والعلاقات الدولية، أمر مهم وضروري، وثمة أشخاص يتقاضون رواتب فلكية نتيجة أداء هذا الدور. وكان ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا نكاتاً كثيرة عن الأمين العام السابق للأمم المتحدة بان كي مون الذي قيل إنه كان يتقاضى زهاء 35 ألف دولار شهرياً، لقاء تعبيره المتواصل عن القلق، حيث عبَّر كي مون عن قلقه في 2014 نحو 180 مرة، أي بمعدل «قلقة» واحدة كل يومين.
وحين مغادرته موقعه في 2016 عنونت صحفٌ: «العالم يودع أمين عام القلق»، لكنّ تلك الصحف استدركت بأنّ بان كي مون، لم يُفصح خلال تعليقه على اختيار غوتيريس عن مستقبل القلق في تصريحات الأمين العام الجديد. ومن المؤكد أنّ البرتعالي كان خير خلف لخير سلف، فمضى على نهج القلق ذاته، وربما يتخطى كي مون في مرات التعبير عن القلق، لأنّ الأزمات تزايدت، والحروب انتشرت، ومهددات الإنسانية بمصائرها ووجودها وحياتها وطعامها وشرابها ومسكنها، تتناسل بشكل هستيري، ما يجعل القلق حاضراً، وغبّ الطلب!
وفي غمرة هذه التطمينات التي تبديها الأسرة الكونية، لا مبرّر أبداً لقلق أطفال الغوطة الشرقية الذين ينامون في القبور، وعليهم أن يستروا عظامهم النحيلة التي ينخرها البرد والجوع والرعب برداء الطمأنينة والرضا. وليهنأ القلق بنومه الرغيد، ليجدّد حيويته وبلاغته!
* كاتب وأكاديمي أردني
الحياة
أزمة الغوطة تظهر تراجع التأثير الأمريكي في الأسرة الدولية
وائل عصام
من تابع كلمات نيكي هالي في مجلس الأمن، خلال جلسة التصويت على قرار وقف إطلاق النار في الغوطة، لظن أن الولايات المتحدة الأمريكية مصرة وقادرة على وقف مجزرة الغوطة، مستفيدة من موقعها في الأسرة الدولية، لكن ذلك كله تبخر مع أول صاروخ يسقط على الغوطة، بعد ساعات قليلة من التصويت على القرار الدولي.
الموقف الأمريكي المتحمس للقرار الدولي، تحول لسراب، لكن اللافت هذه المرة أن الولايات المتحدة الأمريكية مؤيدة للقرار الضائع وليست معارضة له، كما جرت العادة في القرارات الهوائية السابقة في منطقتنا، بينما لعب الروس دوليا، والإيرانيون إقليميا دور المعطل لتنفيذ القرار مستفيدين من نفوذهم الراسخ في سوريا. وتبدو الولايات المتحدة غير مستعدة وغير مهيأة للدخول في صدام مع القوى النافذة في الإقليم، إن كانت روسيا أو إيران، ولأن موسكو وطهران تدركان ذلك، فقد تجرأتا وبسرعة لافتة على الاستخفاف بالقرار الاممي، وفي اليوم التالي لإصداره، عندما شهدت الغوطة مجزرة جديدة، بعد القرار بساعات فقط!
تجارب الشد والجذب هذه بين القطبين الدوليين، تمنح كل منهما قدرة على قراءة حدود أفعال خصمه، واختبار مدى جديته وقدرته، وآخر اختبار بين روسيا وأمريكا في سوريا، كان عندما قصفت الولايات المتحدة الأمريكية رتلا لقوات النظام وقتلت معه جنودا روسيين مرتزقة، لكن دعونا نتذكر أن الأمريكيين قصفوا قبل نحو عام وبمشهد مماثل، رتلا لقوات ميليشياوية للنظام تتقدم نحو معبر التنف، لكن النتيجة كانت وبعد شهور من الإصرار الروسي الإيراني على أهمية هذا المحور، بأن حوصر الأمريكيون وحلفاؤهم في دائرة ضيقة في التنف، قبل ان يواصل جنود النظام التقدم لدير الزور والبوكمال.
هذا لا يعني في أي حال أن مهمة النظام والروس ستكون بالسهولة نفسها في عبور الفرات والوصول لحقول النفط شمال شرق دير الزور، ولكنه سيناريو غير مستبعد على المدى الطويل، والأهم أن هذه المصادمات تمثل اختبارات لقوة وقدرة كل طرف في تنفيذ إرادته في سوريا، وهكذا كان قرار مجلس الأمن إشارة جديدة أظهرت تراجعا مستمرا في التأثير الأمريكي على الأحداث في سوريا، يتواصل بالوتيرة نفسها منذ سنوات، مقابل صعود للدور الروسي.
في بداية ولاية ترامب، أطلق عليه البعض من جمهورنا العربي، «الفاتح ترامب» بعد سريان توقعات بالتصدي لإيران، ومع تنفيذ أول ضربة صاروخية لمطار النظام في حمص بعد الهجوم الكيميائي، استعرت الآمال بأن «ابو ايفانكا» يحمل الوصفة السحرية لمواجهة النظام، وبعد انقشاع غبار القصف، تبين انها كانت ضربة «رفع عتب» هامشية وغير مؤثرة، بل الأهم من هذا كله ان واشنطن أبلغت موسكو بها، وأبلغوا النظام ليقوم بسحب طائراته!
لذلك فإن أقصى ما يمكن ان تقوم به ادارة ترامب هو تكرار ما فعلته في قصفها الذي كان لمجرد ذر الرماد في العيون، وبراءة ذمة من دم ابناء الغوطة، وهكذا كان القرار الاخير، إبراء ذمة دولية من المسؤولية قبل المزيد من عمليات خنق الغوطة، حملت رسائل تحد مباشر وعلني ضد واشنطن ومكانتها الدولية المتداعية في الاقليم.
كاتب فلسطيني من أسرة «القدس العربي»
القدس العربي»
الغوطة مرآة لانتظام عالمي جديد/ وجيه قانصو
لا بد لمجازر الغوطة الشرقية لكي تصبح قضية دولية من ان تحوز على نصاب رقمي معين، وإلا عُدَّت حدثاً يومياً عادياً. فالنصاب هو 500 قتيل و 150 طفلاً على الأقل. ولا بد للقتل أن يحصل بطرق إجرامية خالصة، مثل قصف طيران حربي لمدنيين ومنشأت صحية، أو إطلاق غازات سامة أو مواد كيماوية أو بيولوجية. أي لا بد للقتل أن لا يحصل بظروف قتالية أو أسباب موت طبيعية أو حالات تلوث، بل لا بد من مأساة قاسية ودرجة وحشية عالية خارجة عن مألوف الموت، ليستحق القتل الجماعي انتباه وسائل الإعلام والشفقة الإنسانية والاستنفار السياسي.
هذا راهن مرّ ومؤلم لا ولن نقبله، لكن علينا أن نفهمه. بمعنى أن تعقيد مشهد الغوطة وتداخل الفاعلين فيه، يوفر لنا معطيات حية عن الطريقة التي يدار بها عالمنا المعاصر.
التلكؤ الغربي في الحد من مأساة الغوطة لا يعتبر ازدواجية في المعايير، لجهة التفاوت بين قيمة الإنسان الغربي وغير الغربي. فالتردد الرسمي الأميركي في معالجة مسألة حيازة الأسلحة الفردية رغم تسببها بمجازر متكررة داخل الولايات المتحدة، بين أن الذي يحكم صناعة القرار السياسي ليس أولوية حياة الإنسان وأمانه (مواطناً كان أم أجنبياً) وفق تباشير الحداثة الأولى (هوبس، لوك) التي انعكست في صياغات الدستور الإميركي، إنما هو الرغبة الجامحة بالإنتاج الذي لا يتوقف، ومنطق السوق الذي حوّل العقل إلى قوة لتلبية غايات الاستهلاك. وهي رغبة تقف ورائها شبكة تحكمات عميقة ولدت لا مبالاة تجاه الإنسان نفسه مهما كانت جنسيته أو لونه أو دينه. فالغوطة ضرورة لتصدير السلاح الثقيل إلى العالم، والحاجة إلى الأمان وسيلة تحفيز لإنتاج السلاح الفردي في الداخل الأمريكي. بات الخوف وسيلة فعالة لتحفيز الإنتاج.
ما زلنا في زمن رأسمالية مسعورة لا تنشد سوى شدتها (intensity)، ولا تريد سوى نموها، ولا تهدف إلى تكثيف تدفق رأس المال. وهو وضع يفرغ كل الأشياء من معناها، ويحولها إلى مادة تبادل، أي تكميمها (quantized) وتدويرها عبر نظام تبادل، يكون فيها الإنسان عنصراً تبادلياً متجانسا وقيمة عمل يمكن قياسه، تتحول معه طاقة الإنسان ورغباته وعلاقاته وحتى معتقداته وطقوسه إلى وحدات متماثلة ومتساوية يكون المال قيمتها الأساسية. نحن أمام حياة إنسانية مأسورة بالكامل لرغبة رأسمال، جامحة وخالية من أي متعة، في أن ينتج أكثر فأكثر.
حوّلت الصناعةُ الحديثة الفكرَ إلى أداة، والإنسان إلى شيء بعد أن جردته من صفاته وخصوصيته ولم تعد تبالي بسمات ولادته وظروف نشأته الخاصة، وفككت (decoded) كامل شيفرته فجعلته أكثر توقعاً وأكثر قابلية للتحكم. ما أجبر الناس على أن يكونوا نسخات طبق الأصل جد متناسقة، تحولوا معها إلى قطيع، إلى رقم قابل أن يكمم (quantized) وخاضع لقانون حتمي تختزله المعادلة الرياضية الصارمة. نحن أمام تقنية حديثة تقوم على التحكم لأجل التحكم، وهاجسها الأول انتاج أجساد مطيعة للعمل يضمن استمرار الزيادة في الإنتاج.
ماذا يعني هذا؟
يعني أولاً أن الأخلاق المعممة على السطح في العالم، هي أقرب إلى مسرحيات، عمليات نصب تمارسها مؤسسات السلطات الدولية، الموضوعة بتصرف منظومة التقنية الصناعية الجديدة وأدوات السوق المعولم، التي يزداد تشكيلها للنظام العالمي الجديد وللحياة المؤسساتية يوما بعد يوم ، ويزداد تلاعبها بوعي الناس وإيهامهم بأن أشكال الانتظام الحالية ومنطق السوق وطرق الإنتاج وقواعد التوزيع مفضية إلى حريتهم وسعادتهم.
ويعني ثانياً أن أزمة العالم لا تحل بانتزاع نوايا حسنة واعترافات متبادلة وتوافق مشترك حول قيم مشتركة أو موقف سياسي جامع، بل في تأمين شروط إمكان القيمة الإنسانية، نضع فيها أخلاقنا بدل الخضوع لأخلاق ومعتقدات تحشرنا مع القطيع، وتكون المعرفة فيها خادمة لنا لا أن نكون خدما لها أو وسيلة تحكمٍ كاملٍ بمصائرنا وتفاصيل حياتنا.
هذا يتطلب، بدلا من البحث عن مثل عليا بديلة، التعرف إلى المؤسسات الفعلية التي تقف وراء صناع القرار، والأرضية الراسخة التي تنتج ذهنيات ومسلكيات وقيم العالم المعاصر. هذا يكون بالكشف عن أدواتها وتقنيات دعايتها واستراتيجيات إقناعها ومنطق خطابها، التي تخفي جميعها دوافع هذه المؤسسات واغراضها وتلبسها لبوساً منطقياً وأخلاقياً. القضية ليست قضية مثال أخلاقي بديل، بل قضية شبكة قوى جديدة تنتج أخلاقاً بديلة. فالأخلاق لا تقاس بخيرها وشرها، وإنما بجودة أو رداءة نظامها وجهازها ومنطق توزيعها.
ويعني ثالثاً: أن لا نتوقع تغيراً نوعياً في الموقف الغربي، الأميركي خاصة، تجاه ما يحصل في سوريا، طالما أن الصراع لم يخرج عن تحكم السوق وبنية الإنتاج العالميين. بل لعل في الإطالة الأمريكية المقصودة لهذا الصراع توريط منهِك لقوى طامحة، مثل إيران وروسيا، اعتقدت واهمة، أن أيديولوجية تعبئة رديئة أو إرث صاروخي قديم سيعوض ترهل بناها الإنتاجية وهشاشتها الإقتصادية، ويمكنها من تغيير قواعد الانتظام العالمي.
المدن،
الغوطة بين سوتشي وجنيف/ عبد الرحمن شلقم
مجزرة القرن. الغوطة الشرقية السورية حلقة الدم التي اهتزت لها الإنسانية هي العنوان الكبير لمرحلة سياسية دولية جديدة. ترتيب العمليات العسكرية الجديدة في سوريا، معمل عسكري وسياسي جديد. أعلن الروس أنهم جربوا أكثر من مائتي نوع من أسلحتهم الجديدة في سوريا، واكتشفوا أن بعض تلك الأسلحة ضارة لمستخدميها من جنودهم وليس فقط للمستهدفين بها. سوريا اليوم هي معمل سياسي وعسكري دولي جديد. غابت الحرب الباردة بين المحورين الكبيرين في العالم، اليوم نحن أمام حرب دولية لا باردة ولا ساخنة، لكنها حرب من درجة حرارة جديدة سياسيا وعسكرياً.
تم خروج الدولة السورية من أرضها سياسيا وعسكرياً، القرار في يد قوى دولية وإقليمية. روسيا والولايات المتحدة الأميركية وإيران وتركيا يتقاسمون القرار السوري. المعمل السوري يصنع ملامح القوى الدولية الجديدة، وكذلك الإقليمية. الولايات المتحدة تسيطر عسكرياً على أجزاء من شرق سوريا، الاتحاد الروسي قوة عسكرية في أغلب مناطق سوريا، إيران بقواتها العسكرية والسياسية والبشرية تعيد تركيب النسيج الاجتماعي السوري بما يحقق لها وجوداً دائماً على الأرض تنطلق منه لترسيخ وجودها الطائفي في المنطقة. تركيا فرضت نفسها كقوة إقليمية فاعلة تقفز بها إلى التأثير الأوسع عبر العالم.
النظام السوري، يعتبر أن استمراره فوق كرسي السلطة هو النصر المؤزر، زوال سيادة الدولة لا يعني شيئا، حجم الضحايا وأنهار الدم لا قيمة لها. ألم يعلن النظام السوري بعد حرب يونيو (حزيران) واحتلال الجولان أنه انتصر فعلاً، لأن تلك الحرب لم تحقق هدفها وهو إسقاط النظام البعثي في دمشق.
إيران كان ردها سريعاً، ستستأنف تفعيل برنامجها النووي. لماذا؟ بعد معاركها في سوريا وإبادة آلاف السوريين ترى أنها أعادت إنتاج قوتها الإقليمية والدولية وبإمكانها أن تنقلب على التزامها السابق مع القوى الدولية حول برنامجها النووي.
اتفق الإيرانيون والروس على أن الحل العسكري هو الخيار الوحيد في سوريا، وأن المسار السياسي الممتد من جنيف إلى سوتشي قد غرق في بحر الدماء بالغوطة الشرقية. أما تركيا فلها حساباتها الخاصة. الأكراد الأتراك وامتدادهم في سوريا شكّل ولا يزال الشوكة الدائمة، الدعم الأميركي لهم بالشمال السوري فتح ملفاً ملتهباً بين تركيا وأميركا، بعد قرار الرئيس إردوغان التحرك عسكرياً نحو عفرين أصبحت المواجهة المباشرة بين الطرفين تلوح في العقل والأفق. العلاقة التي يختلط فيها التحالف بالمواجهة لوَّثت كيمياء الخطاب والتعامل بين الطرفين. إردوغان مثل بقية اللاعبين على الأرض السورية وظف أوراقه محلياً ودولياً. أراد رفع صوته إلى مستوى أصوات الدول الكبرى. روسيا وأميركا، يناور مع هاتين الدولتين عبر المنصة السورية السياسية والعسكرية. إردوغان لا يرى شرعية للرئيس بشار الأسد، وأن السلام لن يقوم في سوريا طالما بقي بشار فوق كرسي الرئاسة، وهو في ذلك يتناقض مع روسيا وإيران، لكن رغم ذلك استطاع أن ينسج خيوطاً سياسية نوعية تتيح له التواصل والمناورة معهما.
تركيا غير موجودة عسكرياً في الغوطة الشرقية التي أمطرتها روسيا بالصواريخ والقنابل، لكنها تطل عليها عبر المشهد السوري العام. ملفات العلاقات الأميركية التركية متعددة ومعقدة، ملف – غولن – الذي تتهمه تركيا بتزعم محاولة الانقلاب وإصرارها على ترحيله إلى أنقرة، ملف الأدوار والقرار في تحالف الناتو الذي له قاعدة أنجرليك في تركيا ورقة يرفعها إردوغان من حين لآخر في وجه أميركا، تلقي بظلها على تداخل الطرفين فوق الأرض السورية.
السؤال الذي يكبر كل يوم هو: إلى أين ستصل شلالات الدم السوري المتدفقة على امتداد البلاد؟ وكيف ستكون القماشة السورية التي تتجاذبها أيدٍ دولية مسلحة مختلفة الأهداف والتحالفات؟ روسيا وأميركا تخوضان حرباً بحرارة جديدة فوقها، مساحة التفاهم تتراجع كل يوم ونقطة الاستحالة الكاملة يتحرك نحوها الطرفان. السوريون بمختلف فرقهم هم الرابحون من المسار السياسي إذا توفرت الإرادة الوطنية. وهم الخاسرون من الخيار العسكري. المأساة أن القوى الأجنبية العسكرية الفاعلة على الأرض تحرك التشكيلات المسلحة كل وفق مخططاتها. لم تعد هذه التشكيلات تتحرك وفق قراراتها أو آيديولوجيتها. تتقاتل هذه التشكيلات فيما بينها وفقاً لدفع مبرمج من القوى الدولية التي تتحرك نحو أهداف مرسومة وثابتة. تركيا لها تشكيلات مسلحة تأتمر بأوامرها، وقل ذلك عن روسيا وإيران والولايات المتحدة الأميركية.
الحقائق الجيوبوليتيكية تفعل فعلها على الميادين السياسية والعسكرية. محافل المفاوضات السياسية من جنيف إلى سوتشي، مروراً بآستانة أوراقها ملونة بقوس قزح به الكثير من ألوان الدم والتراب السوري، غاب عنها الصوت السوري الذي يمتلك أوراقاً بغض النظر عن ثقلها. دماء الغوطة الشرقية هي الناقوس الأحمر الدامي الرهيب الذي يجعل من منصات التفاوض ضرباً في حديد بارد. لم يعد الحل السياسي السوري سورياً أو الدولي له فاعلية الاختراق نحو إيقاف دفق الدم. عندما نقول – سوريا – يتداعى إلى الذهن مساحة من الأرض فوقها شعب تربطه أواصر تاريخية وهوية ناظمة. اليوم لم يعد ذلك العنوان يعني سوى الموت والدم والدمار والجوع والمرض. ضمرت سوريا اسما وأرضاً وهوية. الغوطة القتيلة هي الصراخ الذي يرفع صوت الوطن، لعلَّه ينحت صورة للوطن يلوح منها بقايا خريطة تنجو من حرائق العراك الكوني.
الشرق الأوسط
الغوطة: الإبادة هي السياسة الوحيدة المسموح بها/ عروة خليفة
لا يبدو أن وتيرة القصف اختلفت بعد يومين من إصدار قرار مجلس الأمن 2401 مساء يوم السبت الفائت، الذي طالب بفرض هدنة على كامل الأراضي السورية «بأسرع وقت ممكن»، لكن ما الذي يمكن أن يوقف عمليات الإبادة هذه؟
يبدو أن لا أحد سيقوم بالمزيد بعد قرار مجلس الأمن سالف الذكر، في الحقيقة من الواضح أن لا أحد يملك خطة للتصرف حيال ما يجري في سوريا اليوم، ويبدو أن «دولة إمارة الحرب» في موسكو تمتلك خطة وحيدة الآن؛ الإبادة طالما كانت بالإمكان.
تقع الغوطة اليوم في قلب خارطة معقدة من التحالفات والنفوذ الدولي والإقليمي، خارطة من التدخل والتجاهل، إذ يتم تقسيم سوريا إلى مناطق نفوذ دائمة ومشاريع سياسية محددة عبر تفاهمات أمرٍ واقع، أصبحت شبه معلنة بين الجهات «الفاعلة» في الملف السوري، وضمن هذه الخطوط تقع الغوطة الشرقية في هامش التجاهل من الولايات المتحدة ومن الحلفاء التقليديين للمعارضة في المنطقة، فالغوطة الواقعة شرق العاصمة دمشق قد خسرت حسب فهمهم موقعها الاستراتيجي في صراعهم على النفوذ، بعد أن أصبحَ هدفُ إزاحة الأسد عن السلطة أمراً غير مفيد ضمن حساباتهم الجديدة.
أما بالنسبة لموسكو فهي اليوم بحاجة إلى نصر عسكري جديد، تؤكد به إمساكها زمام الأمور في سوريا، بعد أن أخذ مسار الأحداث اتجاهاً لا يمنح حكومة بوتين النفوذ الذي طمح إليها في سوريا، وخاصة بعدما بات جلياً أن الولايات المتحدة لن تمنح سوريا بسهولة لشرطي المنطقة السكران، في ذات الوقت لا يبدو أن واشنطن تمتلك أي استراتيجية حول ما يجب فعله، فالغوطة تقع في اللامكان الأمريكي والإقليمي اليوم.
أكثرُ من 540 شهيداً من المدنيين في الغوطة خلال الأسبوع الفائت فقط، وأوضاعٌ يعيشها سكانها، لا يبدو أن وصف «الجحيم» الذي أطلقه الأمين العام للأمم المتحدة البارحة يستطيع التعبير عن حقيقتها.
كان قصف قوات النظام وحلفائه الروس قد تصاعد منذ بداية العام على الغوطة، إلا أن الأسابيع الماضية منذ بداية شهر شباط كانت الأعنف، بصورة مشابهة لما حدث لأحياء حلب الشرقية نهاية عام 2016. تصريحاتُ المسؤولين الروس أكدت ذلك عندما قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن «تجربة حلب قابلة للتطبيق في الغوطة»، وغضُّ الطرفِ الدولي والاستجابةُ المخجلة أحياناً كانت مؤشراً واضحاً على أن الأمر ممكنٌ سياسياً بالنسبة لموسكو، لكن تخبط تحركات النظام العسكرية خلال اليومين الماضيين، وخساراته المرتفعة على جبهات الغوطة، أظهرت أن الخطة الروسية قد تكون مُرتجلة، وأن أعمال العنف هذه التي تقودها موسكو قد تكون مجرد تكتيكات آنية في معركة فقدت أُفقها الواضح بالمعنى السياسي على الأقل.
إعلانُ بوتين عن هدنة لمدة ساعات تمدد بشكل يومي، وتصريحُ وزير دفاعه سيرغي شويغر عن فتح ممرات إنسانية لخروج المدنيين، هي وسيلتهم الوحيدة لاستعادة زمام المبادرة بعد أن فشلت مشاريع موسكو السياسية في سوريا. في الحقيقة، الإبادةُ كانت سياستهم الوحيدة حتى الآن.
لا يملك أهالي الغوطة كثيراً من الخيارات تحت نيران مئات غارات الطيران والقصف المدفعي المكثف ضمن هذه الصورة، فالممرات «الإنسانية» التي تكلم عنها شويغر قد لا تعني سوى الانتقال من سجن الغوطة الجماعي إلى أحد أقبية مخابرات النظام في دمشق. وفي الوقت الذي ينخرط فيه الدبلوماسيون الغربيون بنقاشٍ حول شكل إدارة أطراف سوريا «الموجودة» (بالنسبة لهم)، لا يبدو أن أي قلق يساورهم حول الوضع في الغوطة، حتى تصريحاتهم كانت تتسق بشكل أو بآخر مع ما تراه روسيا ممكناً، وهو خروج قوات المعارضة من الغوطة.
أصبحت السيناريوهات الممكنة غير معقولة، كيف سيخرج قرابة النصف مليون من الغوطة، أو حتى نصفهم؟ وإلى أين؟ وهل تقبل الأردن مثلاً باستقبالهم في درعا؟ ترانسفير مثل هذا سيكون الأكبر منذ عشرات السنين في العالم كله، جريمةٌ أخرى لا يمكن تصورها.
البقاء تحت نيران القصف والإبادة غير معقول، لا يجب أن يكون المشهد هذا الذي نراه في دوما وحرستا وحمورية وعربين معقولاً، لكنه ممكنٌ ويحدثُ الآن، هذه الثنائية القاتلة؛ تقاسمُ النفوذ الدولي والإقليمي، النظام وحلفاؤه، جعلوا من الممكن في هذا العالم أن يتم إبادة نصف مليون إنسان دون أن يكون ذلك مدعاةً لأي تحرك عالمي.
لكن لا يكفي أن نقرأ استراتيجياتهم في سوريا لتكون هذه المقتلة مفهومة. لا شيء يجعلها كذلك.
الأمم المتحدة والفشل في إنقاذ طفل واحد في الغوطة/ مرزوق الحلبي
أرجح أن النشر عن تقرير سريّ للأمم المتحدة يؤكّد إرسال كوريا الشمالية إلى سورية مستلزمات لبناء منشأة كيماوية يندرج في إطار الضغط على كوريا الشمالية في شأن مشروعها النووي، لا في إطار الحديث عما هو حاصل من تقتيل في الغوطة وعموم سورية. بمعنى، إن وجهة الاهتمام الأميركية هي الشرق الأقصى لا الشرق الأوسط. وهذا بالتحديد يقول أكثر من شيء واحد عن المنظومة الدولية وتعاطيها مع الأزمة السورية باعتبارها مقتلة مستمرة منذ قرابة سبع سنوات.
محصّلة المسألة أن هيئات الأمم المتحدة لم تستطع إنقاذ طفل واحد من أطفال الغوطة الشرقية في الأسبوعين الأخيرين. وهو استمرار «طبيعي» لعجزها عن إنقاذ حلب. بل أظن أن «ملصقات» الفنان السوري منير الشعراني عن حلب والغوطة أثّرت في الواقع أكثر بكثير من مواقف وأداء هذه الهيئات.
إذا ما نظرنا إلى البند السابع لنظام مجلس الأمن سنجد أنه ينطبق على الأزمة السورية المفتوحة، لجهة اقتراف النظام وحلفائه جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية مثل التطهير العرقي والإبادة، ولجهة استعمال أسلحة محرّمة دولياً كالأسلحة الكيماوية، ما يدخل منها في القانون الدولي وما لا يدخل. ومع هذا لم يحصل التدخّل ولو في حدود إقامة المناطق الآمنة أو فتح ممرات آمنة للمدنيين للخروج من مناطق القتال والعمليات العسكرية. بمعنى أن مجلس الأمن كآلية لوقف المجزرة لم يعمل أبداً. في تحليل نقدي لـ «أداء» مجلس الأمن الدولي في الأزمة السورية – وفي أزمات أخرى – سنجد أنه تمّ شلّ عمل المجلس بأيدي روسيا والصين كآلية لإدامة التقتيل والأزمة ليلعب «المجلس» دوراً معاكساً لغايته.
من هنا تبدأ سلسلة هزائم هيئة الأمم في سورية. فما دامت الذراع الفاعلة عاجزة وتعمل عملاً معاكساً لوظيفتها، فقد تعطّلت أعمال الإغاثة الإنسانية أيضاً أو أنها تمّت جزئياً من خلال دفع الخوة لرجالات النظام وعصاباته أو من خلال تسليمها لهم ليتاجروا بها في السوق السوداء. حتى مثل هذه المهمة تعذرت على الهيئة الأممية، الأمر الذي عكس وضعها العالمي كإرث تقادم لنظام ما بعد الحرب العالمية الثانية. مكانة تستوجب إعادة ترميمها في ضوء التحولات الكُبرى. أقول هذا مشكّكاً في ذلك راهناً على الأقل.
لقد تغيّرت خارطة المصالح الدولية بشكل جذري منذ الحرب العالمية الثانية بفعل الزمن، وأكثر بفعل العولمة وسيرورتها الكاسحة. كما تمّ انهيار «العُرف الدولي» بوصفه قانوناً ومواثيق وتفاهمات كان هدفها، في ضوء ويلات تلك الحرب وجرائمها، تقليص مساحة النزاعات ومنع الحروب ومآسيها. صحيح أنها لم تُلغ رسمياً لكن أُرْجِئت عملياً أو وُضعت في الأدراج لأنها في ماهيتها وغايتها شكّلت منظومة من الكوابح والقيود على استعمال القوة العسكرية في داخل الدول وفي ما بينها.
يبدو أن الدول الأقوى في المنظومة الدولية غير منزعجة من هذا الهبوط والتراجع في مكانة هيئات الأمم المتحدة بل تستفيد منه وتستثمره لتعزيز ما يُمكن أن تعتبره مكاسب وطنية أو فرصة لاعتراض مشاريع تعتبرها مضادة. بل ردود الفعل الدولانية على الانهيارات التي تسببت بها العولمة تأتي على حساب الشعوب وبدمها. ومع هذا، فإن تعزيز دور الأمم المتحدة في المرحلة القريبة يستدعي ثلاثة تغييرات فورية من شأنها وقف النزيف في كثير من المواقع بما فيها سورية.
الأول – أن تتمّ زيادة عدد الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن من خمس دول هي العُظمى غداة انتهاء الحرب العالمية الثانية إلى 9 دول على الأقلّ.
الثاني – زيادة عدد الدول غير الدائمة العضوية إلى 25 دولة في كل دورة.
الثالث – أن تكون القرارات في حال حصول جرائم الحرب بالغالبية لا بالإجماع، أي لا مناص من إلغاء حق النقض (الفيتو) باعتباره المنفذ الذي يتسلّل منه النظام السوري وحلفاؤه إلى تنفيذ المقتلة.
مثل هذه التغييرات لازمة كجزء من التعامل مع زيادة عدد الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بالعشرات، منذ إقرار دستور الهيئات الأممية، من أجل خلق توازنات عالمية جديدة توقف الجرائم ضد الإنسانية وتمنع الحروب. وهي تطرح سؤالاً فلسفياً أساسياً وهو: لماذا تعمل الديموقراطية في الدول ذاتها (داخلها) وفق مبدأ الأكثرية مقروناً بمنظومات الكبح والتوازنات، بينما مجلس الأمن يقوم على مبدأ القرار بالإجماع؟ صحيح أن الأمر في بدايته كان انعكاساً لتوازن قوى في حينه، إلا أن آلية الإجماع هذه التي خدمت ردحاً من الزمن صارت تعمل بشكل معاكس لغايتها الأولى – فصيغة العمل هذه هي التي صارت مقصلة فوق رقاب الشعوب، وسورية مثل.
الحياة
كيف ستحدد الغوطة الشرقية مستقبل سوريا؟
نشرت صحيفة “اكسبرت أونلاين” الروسية، مقالة للكاتب غينادي بيتروف، قال فيها إن معركة الغوطة الشرقية ستحدد مستقبل وأفق التسوية في سوريا، خصوصاً وأنها واحدة من الجبهات الرئيسية المناهضة للنظام في سوريا. كما أن واشنطن لن تكترث لنتيجة المعركة، إذا ما تم سحب ذرائع سقوط القتلى المدنيين نتيجة العمليات العسكرية.
ويقول بيتروف، إن الغوطة شهدت سلاماً غير مستقر حتى نهاية العام الماضي، لعدم مقدرة الطرفين المتصارعين على حسم الصراع بينهما. فالقوات الحكومية، برغم الدعم الروسي والإيراني لها، لم تكن قادرة على كسر سيطرة المعارضة على الغوطة الشرقية، وفي المقابل لم يكن لدى معارضي الرئيس السوري بشار الأسد في تلك المنطقة، وتقدر أعدادهم بنحو 30 ألفاً، القدرة على الهجوم لتوسيع مناطق نفوذهم وحمايتها لاحقاً.
ذلك الوضع استغله الوسطاء الدوليون من أجل إنشاء منطقة “خفض تصعيد” في الغوطة. لكن مع ذلك، لم يكن هناك استقرار واضح ودائم، والحرب كانت تعود بين الفينة والأخرى، ما دفع أولئك الخبراء مجدداً إلى التحذير من التصعيد والمواجهات العنيفة بين الأسد ومعارضيه. إلا أن الوضع انفجر بالفعل في يناير/كانون الثاني وأصبح القتال على نطاق واسع ما دفع الحكومة السورية إلى تعليق هجوم إدلب، في فبراير/شباط، واستقدام التعزيزات لتسلم زمام المبادرة في الغوطة.
ويقول الكاتب إن كثيرين يتحدثون عن أوجه شبه بين ما حصل في حلب وما يحصل في الغوطة حالياً، معتبراً أن هناك فرقاً جوهرياً بين المنطقتين. ففي حلب فتحت ممرات إنسانية، وانتهت الأمور بسيطرة الجيش الحكومي على المدينة وكان المسلحون أمام خيارات مفتوحة للرحيل، لكن الغوطة تحمل اختلافاً مهماً كونها جيباً مغلقاً، فضلاً عن الأهمية الاستراتيجية والسياسية التي تعطيها للطرف المسيطر عليها. وطرد معارضي الأسد السهل من حلب، ليس من السهولة أن يتكرر في الغوطة، لأن المقاتلين في الغوطة لا منفذ آخر لهم للخروج، وسيقاتلون حتى النهاية لحماية معاقلهم.
ويرى الكاتب أن لمعركة الغوطة مساراً آخر يثار الضجيج حوله في وسائل الإعلام، وهو وجود عدد كبير من السكان المدنيين في المنطقة. ويعتبر أن الإعلان الروسي عن فتح ممرات إنسانية في غاية الأهمية من أجل إخراج المدنيين، ووقف الضجيج حولهم على وسائل الإعلام، خصوصاً وأن موقف واشنطن التصعيدي ضد الحكومة السورية يقوم على أساس وجود مدنيين يقتلون نتيجة العمليات العسكرية في الغوطة الشرقية.
الرئيس الأميركي دونالد ترامب انتقد روسيا وإيران وسوريا على ما يرتكبونه من “فظائع ضد الإنسانية” في الغوطة الشرقية. لكن، وفقاً للكاتب، لا يبدو أن واشنطن ذاهبة لما هو أبعد من إطلاق الخطب، أو البيانات الغاضبة من وزارة الخارجية، حول منطقة الغوطة؛ وبمجرد إنهاء ملف المدنيين وإجلائهم ستغلق واشنطن عيونها عن هذه المعركة مهما كانت نتيجتها، لأن التكتيك الأميركي تم تحديده بالفعل مسبقاً: لقد أخذ الأميركيون حصتهم في سوريا من السيطرة على المناطق الواقعة شمال نهر الفرات. وذلك الجزء من سوريا يكفي واشنطن تماماً من أجل إثارة المتاعب للحكومة السورية، والتفاوض في ما بعد على المسائل الرابحة في التسوية بعد الحرب.
المدن