هنيئاً للديكتاتوريّة بهكذا صحافييّن وشعراء وكتّاب…/ عارف حمزة
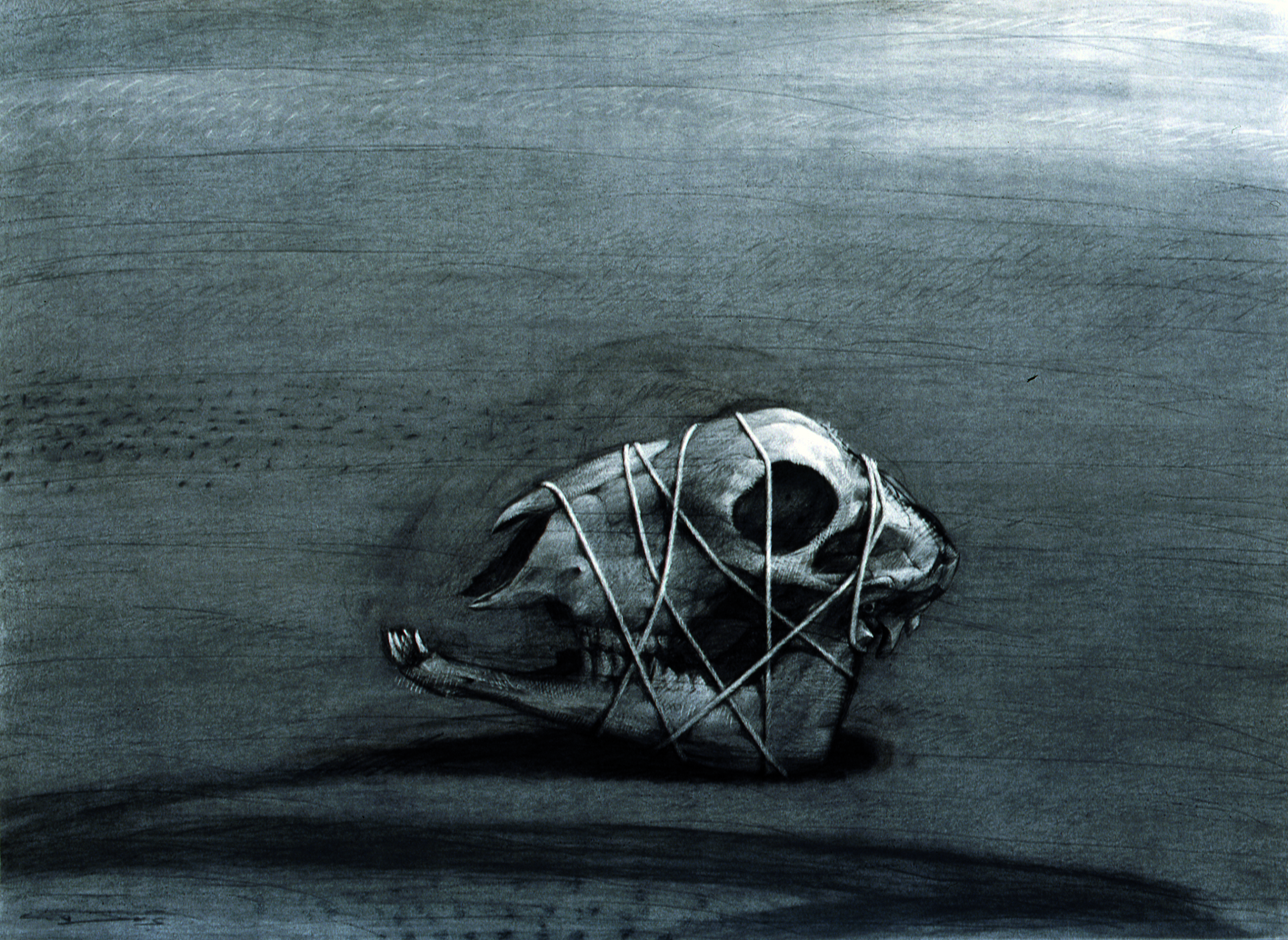
لا مشكلة عندي، وليس من حقّي أصلاً، أن يضع صحافي ومترجم، ويدلّعونه كشاعر، صورة لسماحة الشيخ حسن نصرالله في صدر مكتبته؛ فهو في النهاية لبنانيّ مثله، وهذا شأنه الحزبيّ والشخصيّ. رغم أنّني كنت أريد أن أعرف رأي الكتب التي حجبتها الصورة الضخمة لفاتح فلسطين. ورغم أنّني تساءلت في نفسي: لماذا لا توجد ولا صورة للصحافي اللبناني اسكندر حبش مع كتبه التي تلغيها صورة سماحته؟ وهل يُري الشعراء والكتّاب الأجانب، الذين يلتقيهم بكثرة في المهرجانات التي يداوم فيها تلك الصورة؟ لا أريد أن أقول بأنّه التقى مع شعراء إسرائيلييّن، في تلك المهرجانات، بل، على الأقل، مع مناصرين لفكرة وجود “إسرائيل”، وبأنّه أفصح لهم عن رأيه وشاهدوا تلك الصورة له، مع سماحته وكتبه، إن كان لديه صورة معهما مشتركين؟ بما أنّه قد ينال جائزة نوبل في الأدب يوماً ما.
ولا مشكلة كبيرة عندي عندما ذهب مع ممثّلين سورييّن، موالين للنظام السوريّ، إلى الاعتصام الذي نظّموه في أعلى جبل قاسيون، ضد الضربة الأميركيّة التي كانت محتملة في تلك الأيام. نعم كان السيّد حبش هناك. وسنقول بأنّه يقف مع سوريّا كلّها ضد الضربة الأميركيّة التي قد تدمّر سوريّا، وتلحقها بـ”المشروع الأميركي المرسوم للشرق الأوسط”. ولا أعلم إن كان صرّح لأحد بأنّه ذهب إلى هناك مع مناصريّ النظام السوريّ، للإعتصام الذي نظّمته أجهزة المخابرات السوريّة، للتأثير على الرأي العام الغربيّ. اعتصام لممثّلين أنهوا الاعتصام وعادوا بسرعة إلى الأماكن التي هربوا إليها خارج البلاد منذ بداية الأزمة السوريّة، ليُكملوا حياتهم هناك كمخبرين مأجورين.
ولكن المشكلة بدأت، عندي، عندما قام حبش، بتاريخ 3/11/2013، بنشر صورة لعائلة هانئة حول طاولة عشاء، في صفحته على الفيسبوك، ويكتب فوقها باللغتين العربيّة والكرديّة(!): “السهرة في داريا، بعد السكرة في حمص”! وهو يقصد بأنّه كان يتعشّى مع تلك العائلة في داريّا، وقبلها كان يسْكر في حمص ابتهاجاً بمناسبة ما.
لن أناقش الكتابة باللغة الكرديّة على هكذا تعليق وهكذا صورة؛ فسمّها واضح، ولكن يعرف جيّداً السيّد حبش بأنّ مدينة داريّا صارت مدمّرة، ولا توجد فيها عائلات، وبأنّ 80 في المئة من مدينة حمص قد تمّ تدميره. وأصبح لدى المدينتين، خلال ذلك، عشرات الآلاف من الضحايا والمعتقلين والمفقودين، وتمّ تهجير ما تبقّى من الأحياء منهم إلى أماكن قد لا يجدون فيها الخبز ليُطعموا أطفالهم.
والسيّد حبش يعرف جيّداً بأنّه لم يكن في داريّا، هذه الأيام، ولا في حمص. ولكن الكتابة هكذا تدلّ على أنّه ذهب في ذهاب “جيش سماحته” إلى هناك لقتل السورييّن. وعليه أن يعرف جيّداً بأنّه يقف كـ”شبّيح” إلى جانب الديكتاتور وأعوانه من القتلة، تحت يافطة الطائفيّة البشعة. وبأنّ الدم السوريّ ليس مزحة، ولا نكتة، كي يحتفل به على هذا النحو الوضيع. وهو يعرف بالتأكيد بأنّ طفلاً واحداً من داريا، أو حمص، أكثر شجاعة منه في الوقوف ضد طاغية. وهو يقوم، بذلك، بأكثر ممّا يقوم به زميله الشاعر والسياسيّ الطارئ غسّان جواد، الذي أتحفني ناصحاً في رسالة منه بأن لا أكون معارضاً للنظام السوريّ وعلى الأقل، لرئيسه المفدّى بشّار الأسد. يكتب لي من آلاف الكيلومترات كي أفهم ما يحصل في بلدي، ولكي أقف إلى جانب مَن يقتل أبناء بلدي! ناسياً ما فعله الأمن السوريّ بنا نحن الموقعين على بيان المثقفين السورييّن الذي طالب بخروج القوات السوريّة من لبنان كونه دولة، ولها سيادتها.
وقبل ذلك بأشهر كثيرة صنع الشاعر العراقي سعدي يوسف تلك العاصفة من التشاؤم في الإيمان بنجوم الإبداع العربيّ. هو الذي عاش وعاصر البعثييّن عندما كانوا يسحلون الشيوعييّن، والشيوعييّن عندما كانوا يسحلون البعثييّن، في شوارع العراق، عند تبادل أدوار السلطة وليس الأفكار. هو الشاعر المشرّد وقف ضد مطالبة السورييّن بالحريّة والعدالة ورحيل الديكتاتوريّة.
وقبل ذلك، وبعده، وقف الكاتب “الكبير” أدونيس ضد الثورة السوريّة؛ لأنّ التظاهرات خرجت من الجوامع. رغم أنّها كانت تخرجُ من هناك بسبب تشييّع الجنازات، بعد الصلاة على المتظاهرين السلمييّن، الذين قتلهم الأمن بسبب الهتافات وحريّة التعبير هناك، إلى المقابر. وعندما خرجت التظاهرات من الجامعات السوريّة، وقام الأمن باعتقال الطلاب وقتلهم في حرم الجامعات، لم يكلّف خاطره برؤية المعنى. وعندما خرجت التظاهرات من مدارس الطلاب لم يغيّر رأيه. وعندما قام النظام بقتل واعتقال وهدم بيوت العشرات من الشعراء والنقّاد والفنّانين والصحافييّن… لم يكلّف نفسه وحشة التضامن مع وحشتهم. لقد بقي ثابتاً، هو المادح للمتحوّل، على موقفه المساند للديكتاتوريّة.
وقتها آلمني الأمر، ولكنّني لم أتفاجأ. وكتبتُ على صفحتي الشخصيّة: ” إن وقوف شخصيّات مثل سعدي يوسف وأدونيس إلى جانب الثورة السوريّة هو نقصان لها”.
أمّا الشاعر نزيه أبو عفش فقد أعلن موقفه المتضامن مع السلطة، وربّما كان يقصدها كمضطهدة ومظلومة عندما كتب نصوصه عن الحريّة والمنفى والمسيح والهلاك. هو الذي كتب مقالة طويلة، في الآداب اللبنانيّة، يتوعّد فيها اللبنانييّن الذين يعتدون على العمّال السورييّن الضعفاء هناك، قلنا لا بدّ سيقف ضد السلطة التي نشرت ذلك الفساد، وخنقت الحياة السياسيّة والثقافيّة والاجتماعيّة والاقتصاديّة في البلاد. لا بدّ سيفضح أجهزة المخابرات والقضاء الأمنيّ. لا بدّ أنّ له صديق معتقل واحد على الأقل حكى له عن أقبية الأمن، عن مجازر حماه وجسر الشغور، عن الجلاد والضحيّة، عن الأطفال الذين ذُبحوا أمام آبائهم وأمهاتهم…. لا بدّ أنّه سمع صرخة ألم واحدة بسبب هذا النظام.
أبو عفش لم يوقّع على بيان واحد، من البيانات التي صدرت عن مثقفين سورييّن في الداخل السوريّ، من بيان حصار درعا والضغط على السلطات لإدخال حليب الأطفال لأطفالهم على الأقل، حتى بيان المطالبة بإسقاط النظام. على الأقل لم يوقّع على بيان حليب الأطفال. أو على بيان إطلاق سراح كاتب سوريّ واحد. فظلّ أبو عفش وفيّاً للصمت الأبديّ. حتّى عندما اتصلتُ به في يوم عيد ميلاده، تبيّن بأنّ مكالمتي “محظورة” عنده! بسبب أنّني أناصر الثورة.
الممثّل السوريّ يظلّل “ممثّلاً” حتى في حياته الشخصيّة والعامّة. ولو أنّ دريد لحّام كان شخصاً حقيقيّاً، كي لا نقل سويّاً، لتأثّر بجملة واحدة على الأقل من ملايين الجمل التي قالها، على لسان الشاعر محمد الماغوط، في أعماله المناهضة للإقطاع والفساد والاستغلال والأمن والمخابرات… الخ. ولكنّه ظلّ وفيّاً لخلاف ما كان يقوله ويتدرّب عليه ويعمله.
من ماذا كان يخاف هؤلاء النجوم السوريّون الذين أصبحوا في السبعينات والثمانينات من أعمارهم؟ من الاعتقال؟ من إسقاط الجنسيّة؟ من القتل؟ لا. بل هناك أفكار وتعريفات عن المثقف ما عادت تنطبق على كثير من المثقفين العرب. إذ مهما كان تحصيله العلمي، ومهما كان منجزه في الكتابة، ومهما كانت كتاباته وأفكاره حول العدالة والحريّة والخير وبقيّة القيم، تراه يعود فجأة إلى طبيعته العشائريّة والدينيّة والأثنيّة والعرقيّة والطائفيّة… إذ تراه، عند هكذا محن كبرى، يعود فجأة إلى ما قبل كلّ تلك الأفكار والكتابة والتحصيل. والثورات العربيّة هي التي ألقت هذه الأضواء القويّة على هؤلاء الأشخاص الذين ما كنّا نعرفهم على حقيقتهم.
كان الشباب، الذين خرجوا في التظاهرات، قد قرأوا لهؤلاء الشعراء والصحافييّن والكتّاب، بل حفظوا كثيراً من أقوالهم في محنة الإنسان نحو الحريّة، وشعروا بسوء التفاهم، ثمّ الأسف لموقفهم السخيف هذا. ولكنّهم بقوا على شجاعتهم في الوقوف ضد الظلم والديكتاتوريّة، وليس في حسبانهم جوائز أو نجوميّة أو دولارات. كانوا يحلمون بوطن صغير فيه شعب لا يشبه آباءهم المضطهدين والسّاكتين والخائفين من الذين يكسرون بيوت الناس ويدخلون، ويأخذون أطفالاً في سن العاشرة ويُعيدونهم مذبوحين. كانوا يريدون سوريّا الحرّة والمتعدّدة والمتمدّنة والمتقدّمة حتى في لعبة كرة القدم.
عند قراءة أعمال هؤلاء الناس وقراءة مواقفهم نصاب بسوء تفاهم كبير؛ إذ كيف يكتب الشاعر عن الضحايا والموتى والمظلومين والمهجّرين وعنف الديكتاتوريّة، ومنع الحياة الجديدة من دخول بلدانهم الغضّة… ثمّ يقفون، صفّاً واحداً، مع الديكتاتور وليس مع الشعب؟ مع القاتل وليس مع القتيل؟ مع المجرم وسافك الدماء وهادم البيوت على رؤوس أصحابها.. مع حرق البلد، كلّ البلد، من أجل شخص واحد لا يستطيع أن يحكم إلا بالقتل والدمار؟
من الممكن تبرير عدم اتخاذ موقف من العامة والناس البسطاء، ويمكن فهم سكوتهم أمام الآلة الوحشيّة الجبّارة، رغم عدم حدوث ذلك، ولكن لا يمكن تبريره من المثقف والشاعر والكاتب. لا يمكن تبرير عدم اتخاذ موقف واضح منه للوقوف مع المظلوم ومعتقل الرأي ودم البريء. أما ما لايمكن المسامحة عليه أبداً فهو وقوف المثقف إلى جانب الطاغية. هذا ما لا يمكن المساومة على تبريره نهائياً.
المستقبل


