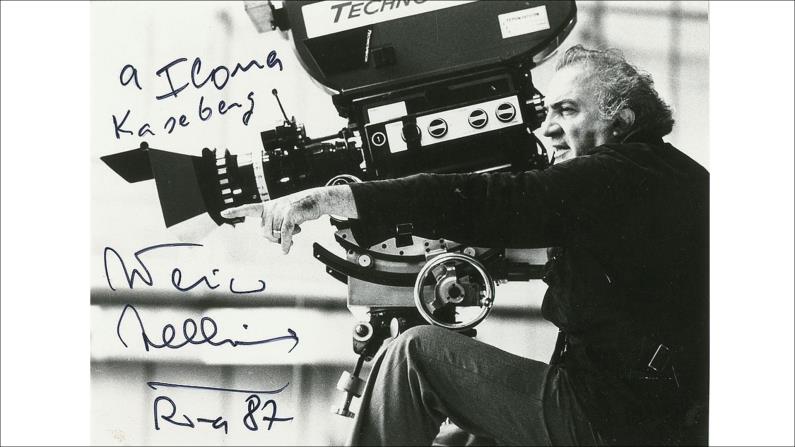ياسين الحاج صالح : الانقلاب في مصر أنقذ الإسلاميين من الفشل …

وانقلاب سورية إلى دولة «سلالية» نزع عنها صفة الوطنية
بيروت – ريتا فرج
كان لنا مع الكاتب السوري ياسين الحاج صالح أكثر من مقابلة تمحورت حول الثورة السورية وأزمتها. هذه المرة اختلف الحوار مع صاحب «بالخلاص يا شباب» حيث اختلـــط الســــياسي مع الثـــــقافي.
غالباً ما يقدم المعارض اليساري مطالعات نقدية حول الإسلام والعلمانية والدين والثقافة في كتبه ومقالاته. يصفه البعض بأنه من أشدّ المعارضين السوريين إتقاناً للخطاب الثوري الذي لا يهادن ولو إنهار العالم. اعتاد على تجاوز المخاطر وعلى اختراق المحظورات السياسية قبل الثورة وتصاعدت ثوريته ضد «السلالة الأسدية» بعدما تفجّر ربيع السوريين المأزوم….
يقول الحاج صالح إن المجتمعات العربية تحتاج الى «ثورة ثـــقافية» ينهض جزء منها «عبر الصراع مع الدين». ولا يتوانى عن تقديم الجديد في مقاربته لما يسميه المفكر السوري صادق جلال العظم «الكتلة الصلدة من الغرانيت» قاصداً بذلك النظام البعثي الأمني.
تكتشف عن الحاج صالح لغة متصاعدة لا تهدأ رغم المخاوف التي تخالج كثيرين حول الانسداد السياسي الذي تعاني منه الأزمة السورية. لا يستكين كأنه مسكون بالقلق الثوري العتيق.
وفي الوقت الذي تمر «سورية الثورة» بأخطر مراحلها وسط الحديث عن تخلي العالم عنها، ربما حتى تنضج التسويات الاقليمية والدولية، تشهد «دول الربيع العربي» أزمات اجتماعية وسياسية لا تقلّ خطورة عن الملف السوري كما هي الحال في مصر بعد عزل الرئيس محمد مرسي وفي تونس وليبيا. الحركة الارتدادية التي أنتجتها الثورات، العصبيات، القبلية، التمذهب، الصراع السني الشيعي، الاسلام والحداثة، الاصلاح الديني، الثورة المعرفية، مأزق الإسلام السياسي العربي.
هذه النقاط وغيرها شكلت محاور الحوار الذي أجرته «الراي» مع ياسين الحاج صالح، وفي ما يأتي نصه:
• ثمّة حاجة إلى تشكيل مؤسسة إسلامية مرجعية تحد من فوضى الفتاوى
• النظام الأسدي يريد مجتمعاً منحلاً بلا قيم… ومنكشفاً بلا حماية
• إن لم نحلّ مشكلاتنا فإما أن ننحلّ ونخرج من العالم الحديث أو يحل مشكلاتنا غيرنا وبما يلائمه
• الطغيان يحتل الحاضر فتستنفر مقاومته الماضي فلا يبقى ثمة مستقبل
• لدينا منذ ربع قرن كهول وشيوخ يُقرِّعون مجتمعات لا يعرفونها ولا يتعاطفون معها
• الاحتجاجات الشعبية المصرية على حكم «الإخوان» كانت تستحق ما هو أفضل من انقلاب عسكري
• لدى إيران مشكلات كبيرة بفعل طبيعة نظامها الاستبدادي وسياستها الخارجية العدوانية
• تتوافر في إيران نخبة وطنية متبدلة لكنها ضيقة بحكم أن القرار السيادي بيد الولي الفقيه
• إن كان لسورية أن تتشكل كدولة وطنية فأول ما يلزم تحرير الدولة من «السلالة الأسدية»
• دفْع الأمور إلى صراع سني – شيعي كارثة تاريخية تفسد تطلع المجتمعات العربية إلى التحرر
• ليست لديّ عواطف سلبية تجاه الشعب الإيراني لكن لا بد من إلحاق الهزيمة بمشروع الهيمنة الإيرانية في المشرق العربي
• ينبغي تعطيل المضخة الإيرانية التي هي اليوم منبع بعض أخطر ظواهر الطائفية والتمزق الاجتماعي والسياسي في منطقتنا
• في ظل الظروف المضطربة التي تمر بها دول الربيع العربي، تفجرت ظواهر لها طابع ارتدادي، فشهدنا تفاقم التعصب الديني والقبلية والعنف ضد النساء والأقليات. ما تفسيرك لذلك؟
– أعتقد أن مجتمعاتنا في حالة فوران لا يحتمل أن يهدأ قريباً، وكل شيء فيها اليوم أكثر ظهوراً، المشكلات الاجتماعية والسياسية المعقدة، لكن أيضا أشكال الانتظام الجديدة والتجارب الجديدة للتجمع والاحتجاج والتعبير. خرجت مجتمعاتنا التي تفجرت فيها ثورات من ثلاجة نظم الطغيان التي دامت عقوداً، حُرمت خلالها من تجميع قواها ولو على نطاقات محلية ضيقة، ومن الكلام والتعبير عن الرأي، ومن محاولة اجتراح حلول ومعالجات لمشكلاتها الموروثة والمكتسبة. بل إن صورة الثلاجة ليست ملائمة بقدر كاف. فالأمر يتعدى تجميد المجتمعات المحكومة ومنع الناس من التعاون والعمل معا إلى اشتغال النظم الطغموية كقوة فاعلة في إثارة الانقسامات داخل المجتمعات. لدينا في سورية أمثلة لا تحصى توضح الفاعلية التخريبية للنظام الأسدي، أذكر منها اثنان كاشفان. في العام 2003 حاول شبان وفتيات من داريا القريبة من دمشق العمل معا على تنظيف شوارع البلدة ومكافحة الرشوة والتدخين وتشجيع السكان المحليين على القراءة. قاموا بذلك علناً ومن دون خلفية سياسية أو إيديولوجية محددة. لم يكد نشاطهم يبدأ حتى اعتُقلوا، وقضى الشبان منهم في السجن سنوات.
وروى صديق وسجين سياسي سابق لأكثر من مرة ومناضل معروف أنه في سنوات مطلع العقد الأخير من القرن الماضي كان معتقلاً في فرع المنطقة برئاسة هشام اختيار حينها (قتل قبل عام في حادثة «خلية الأزمة»)، وكان معتقلا لدى الجهاز الأمني نفسه رجل وابنه من حي الميدان الدمشقي، متهَمان بالانتساب إلى جماعة الإخوان المسلمين. كان اختيار يعذب المعتقل، ويسأله ساخراً: تريد أن تبني خلايا للإخوان يا فلان؟ أنا بدي يكون بكل بيت في الميدان عاهرة ومخبر!
هذه هي السياسة الاجتماعية الثقافية للنظام الأسدي. يريد مجتمعاً منحلاً بلا قيم، ومنكشفاً بلا حماية.
الآن، التعصب الديني والقبلية والتمييز ضد النساء ليست أشياء غريبة على مجتمعاتنا، ولم تكن غريبة يوماً، وبعدما أُهدرت جهود أجيال من المكافحين من أجل التحرر الاجتماعي والمساواة والمواطنة، منذ العقود الأخيرة من الحكم العثماني حتى بعد سنوات من الحكم البعثي على مذبح سياسة «مخبر وعاهرة في كل بيت»، نجدنا في مواجهة هذا النكوص الذي تتكلمين عنه. يغدو الفصل بين الجنسين فعل تماسك اجتماعي، إن لم يكن فعل مقاومة، وقد تغدو القبيلة إطار احتماء، والتشدد الديني بناء لعصبية وجهداً لامتلاك السياسة. أفعال نكوصية وانحطاطية دون ريب، لكنها ردود فعل اجتماعية على اختراق عدواني خشن، لا تستطيعين أن تنسبي له مضموناً قيمياً أو وظيفة تاريخية إيجابية. يحتل الطغيان الحاضر، فتستنفر مقاومته الماضي، فلا يبقى ثمة مستقبل.
وتعلمين أيضا أن انقلاب سورية إلى دولة سلالية تُورّث من أب لابن يتوافق مع الظواهر الاجتماعية التي ذكرتِ، وينزع عن المجتمع والدولة معا الصفة الوطنية، ويوظف في الانقسامات الاجتماعية، ويلعب لعبة الأقليات والأكثريات العمودية.
ومن هذا الباب أجد أن إدراجك تهديد الأقليات ضمن سلسلة تشمل التشدد الديني والقبلية وعزل النساء غير سديد. للأمر ديناميكية خاصة ومختلفة، في سورية والدول العربية كلها. هذه نظم أقلية تكوينياً، أوليغارشية، وهي تولد مشكلة أكثرية اجتماعية مهمشة، وتولد مشكلة أقليات عمودية كعاقبة لذلك. حيث هناك أكثرية اجتماعية مهمشة، تتململ وتثور بين حين وآخر، لا يمكن لأي أقليات إلا أن تبقى في قلق. وفي سورية الوضع أسوأ لأنه فوق الأوليغارشية التي تولد مشكلة أكثرية أفقية (أكثرية تتدهور أوضاعها ومقدراتها الاجتماعية)، لدينا الطائفية كأداة حكم أساسية للنظام ونواته الصلبة، وهي تولد مشكلة أكثرية عمودية (سنيون يشعرون بالاستلاب)، ما يفتح الباب لاختلاط المشكلتين، وما يناسب مناضلين طائفيين سنيين.
• ما حدث في الربيع العربي أدى الى تحول في بنية السلطة السياسية، ألا تحتاج المجتمعات العربية الى ثورة معرفية تواكب التحولات السياسية؟
– أُفضِّل الكلام على ثورة ثقافية، أي ثورة على مستوى الضمير والأخلاق، وعلى مستوى الحساسية والمخيلة، فضلاً عن مستوى المعرفة والتفكير، وبمحصلتها يمكن أن تتحقق القطيعة الضرورية مع الماضي، وخفض مرتبة العتاد الثقافي الموروث منه. وبدل الكلام الكثير على المعرفة، أفضل أيضاً أن نبذل جهودا لمعرفة شيء ما من الحياة الواقعية في مجتمعاتنا المعاصرة. لدينا اليوم ومنذ نحو ربع قرن كهول وشيوخ قاتمو المزاج، نكدون ومتشائمون غالباً، يتكلمون كثيراً على التنوير والحداثة، ويُقرِّعون مجتمعات لا يعرفونها ولا يتعاطفون معها، ويغلب ألا يعيشوا فيها أيضاً، على قلة تنوُّرِها. ولا تجدين عند تفحص أعمالهم لا قيماً معرفية مضافة، ولا حساً بالعدالة، ولا حضوراً للشاغل الأخلاقي النظري والعملي، ولا نفساً جميلة أو روحاً ودودة، ولا انشغالاً مثمراً بقضايا الفن والجمال، ولا نتاجاً فلسفياً، فضلاً عن صمتهم السياسي المشين. العقل، إن تكلمنا بلغة هيغلية، ليس العقل المجرد أو الفهم، إنه تملك العالم معرفياً وأخلاقياً وفنياً، الفكر الذي يعي نفسه ويراجع نفسه ويحدد نفسه.
الثورة الثقافية أهمّ من الثورة السياسية فعلاً، وهي لا تتحقق في تقديري إلا عبر الصراع مع الدين، مع الظاهرة الكلية للدين، في تجلياتها الاجتماعية والسياسية والفكرية والأخلاقية والجمالية. الثورة السياسية تضعنا في قلب صراعات متنوعة تكسر بنى الطغيان الذي يلغي جهود الناس لتغيير أوضاعهم. هذا هو المهم في الثورة السياسية. يجب كسر الطغيان والعمل على منع تشكل طغيان جديد ولو اقتضى ذلك امتناع الحكم ذاته. لا ينبغي أن يكون الطغيان خياراً ممكناً. سورية غير قابلة للحكم هي خياري الشخصي، إن كان الخيار المقابل هو الطغيان، أسدياً كان أو إسلامياً.
• ما أهمية الإصلاح الديني في الإسلام اليوم وخصوصاً أننا نشهد حضوراً كثيفاً للسلفيات والأصوليات على ضفتيْ الإسلام الشيعي والسنّي؟
– مهم جداً في رأيي. لكن لا اراه مناسباً أن نقارب المسألة من زاوية التقلبات السياسية الظرفية من جهة، ولا أن نضع الإصلاح الديني في تقابُل مع الأصوليات ونتوقع منه أن يدرّ لنا ترياقاً شافياً من الأصولية الدينية، من جهة ثانية.
ورأيي أن الإسلام، بصيغتيه السنية والشيعية معاً، مندرج في عملية إعادة هيكلة مستمرة تحت ضغط الطلبات والضغوط الاجتماعية التي يتعرّض لها من المسلمين المعاصرين، الخواص منهم والعوام. من ذلك مثلاً أن يُكتشف في سبعينات القرن العشرين في مصر أن الجهاد «فريضة غائبة»، ومن ذلك أن يتكشف لبعض مناضلي حزب التحرير الإسلامي أن الخلافة هي الفريضة الغائبة لأنه ما لا تتم الفرائض إلا به فهو أولى الفرائض. ومنه أيضاً عقيدة الحاكمية الإلهية التي طلع بها أبو الأعلى المودودي قبل ستة عقود أو سبعة، وتأثر بها سيد قطب، وتُشكل اليوم الركيزة الأساسية الجامعة لفكر الإسلاميين السياسي بمختلف تياراتهم. ومنه الأصولية ذاتها، أي الفهم الحرفي والتطبيقي للمتون النصية الإسلامية، وهو فهم يتوافق مع التشدد الديني ومع طلب السلطة العامة.
لا نستطيع القول، إذن، إن الإسلام لا يتغيّر ولم يتغيّر. إنه لا يكف عن التغير في واقع الأمر. تجري باستمرار إعادة هيكلة غير واعية له، تحركها حاجات المسلمين، وهي تبرز مبادئ منه كانت أقل ظهوراً، وتُنحي مبادئ أخرى كانت هي السائدة. تعلمين على سبيل المثال أنه كان يؤخذ على الإسلام في وقت مضى النزعة القدرية التسليمية، اليوم ما يؤخذ عليه هو نقيض ذلك تماماً، النزعة التمردية أو الخروجية، علماً أن التسليم والخروج عنصران موجودان فعلاً في التعاليم الإسلامية وفي التاريخ الإسلامي.
وبما أن كل إصلاح إسلامي جدير باسمه ينبغي أن يستند إلى مفهوم للصلاح مستمد من الإسلام ذاته، فإن السؤال المهم هو: في أيّ شروط تتقارب مقتضيات الصلاح الإسلامية التي لا تكف عن الانضباط بها عمليات إعادة الهيكلة المستمرة مع مقتضيات الصلاح الحديثة والمعاصرة من حرية ومساواة وإنسانية ومواطنة…، بحيث يكون مزيد من الإسلام متوافقاً مع مزيد من الحداثة المنتجة؟
أفترض أنه كلما كان المسلمون أكثر تحكماً بشروط حياتهم، السياسية والاقتصادية والاجتماعية، كان احتمال تقارب الصلاحين أكبر. وحين يحصل ذلك الاقتران السعيد يمكن أن تسمى عملية إعادة الهيكلة الموفقة هذه الإصلاح الديني الإسلامي.
وأرى أن لأمثالنا دوراً مهماً في هذه العملية، يتمثل بخاصة في المساهمة في الثورة الثقافية، في تحرير الإبداعية المعرفية والأخلاقية والجمالية والفلسفية. ليس فقط لأننا لا نستطيع منافسة الإسلاميين بعتاد ثقافي هزيل مثل عتاد الشيوخ السوداويين الداعين للتنوير (التنوير الأوربي كان متفائلاً تاريخياً، أصحابنا هؤلاء ليسوا متشائمين فقط، وإنما هم مناضلون من أجل التشاؤم)، بل أيضاً من أجل توفير موارد ثقافية، مفاهيم ورموزاً وقيماً، يستفيد منها الجميع، بمن فيهم الإسلاميون، وقد تدفعهم إلى خارج الدوائر الضيقة لثقافتهم الدينية.
• هل تعتقد أن الإسلام كبنية دينية ومجتمعية يتصدى اليوم للحداثة عبر العودة الى التراث وعبر استحضار الماضي لمواجهة المستقبل؟
– التصدي للحداثة يقع داخل الحداثة وليس خارجها، فليس للحداثة خارج. أو لنقل إن القائمين على المجمل الإسلامي، و«الإسلام» نتاجهم بقدر ما هم نتاجه، يستندون حتما إلى جملة الأوضاع والممارسات والمؤسسات والمبادئ التي نطلق عليها اسم الحداثة، لكن يحاولون التحكم بها سياسياً ورمزياً، «أسلمتها». لا ينجحون في ذلك، ولن ينجحوا. والحداثة لا تكف عن تفجير الإطار الإسلامي الذي يُفرض عليها، ونحن نرى منذ الآن، ولعلنا سنرى في السنوات والعقود المقبلة، تفجرات أشد هولاً. إعادات الهيكلة التي أشرت إليها قبل قليل سيطاح بها ولن تصمد، لأنها لا توفر لعموم المسلمين صلاحين أو خيرين يتطلعون إليهما على حد سواء.
المشكلة في علاقتنا بالحداثة أن الزمن سريع لجوج ولا ينتظر أحداً، وأنه إن لم نحلّ مشكلاتنا، فإما أن ننحلّ ونخرج من العالم الحديث، أو يحل مشكلاتنا غيرنا وبما يلائمه. ونحن نرى كلتا العمليتين أمامنا اليوم: بعضنا هنا وهناك يخرجون فعلياً من العالم الحديث نحو عوالم خيالية يعتبرونها إسلامية (طالبان، القاعدة، دولة العراق الإسلامية التي تعمم بركاتها اليوم صوب سورية، مجاهدون في مالي، بوكو حرام النيجيرية…)، لكن ميزتها الجوهرية أنها تعود عليهم بسلطة سيادية من صنف سلطة الدولة الحديثة: عنف، بما في ذلك الحرب والقتل، وولاية عامة؛ وبعضنا تتولى المراكز الدولية المؤثرة ضبط مشكلاتهم بأدوات أمنية ومالية وغيرها، دون أن يعالجوا الجذور الاجتماعية والثقافية لهذه المشكلات. وهذا حال أكثر دولنا.
• يطرح الإسلام السياسي العربي علامات استفهام كثيرة خصوصاً في التجربة المصرية (تجربة الاخوان المسلمين في الحكم). لماذا فشل الإسلاميون العرب إذا جاز التعبير ونجح الإسلاميون في تركيا وايران؟
– أعتقد أن ما جرى في مصر أساء كثيرا للثورة المصرية وعقّد التطور السياسي والفكري المصري، وكان انقلاباً لا على الإخوان وحدهم، بل أيضا على الملايين الذين اعترضوا على حكمهم في ساحات مصر. بل هو انقلاب على الأخيرين أكثر من الأولين، فقد كان الإسلاميون المصريون في سبيلهم إلى الفشل، لكن الانقلاب أنقذهم من ذلك. ثم أنه أعادهم إلى موضع الضحية، وهو في سبيله إلى تنشيط مظلومية إسلامية كان المكسب الأهم من حكم الإسلاميين المصريين هو تآكلها بتحول موقعهم من مظلومين إلى ظالمين. كانت الاحتجاجات الشعبية المصرية على حكم الإخوان تستحق ما هو أفضل من انقلاب عسكري، ومن أداء سياسي وإيديولوجي غير مشرف للمعارضة المصرية.
ويبدو لي أن التجربتين التركية والإيرانية تشيران إلى أن الأولوية في التطور الاجتماعي والسياسي في مجتمعاتنا تعود إلى بنى الدولة ونمط ممارسة الحكم. في تركيا دولة قومية، تعاني مشكلات كبيرة، لكن تتوافر فيها نخبة سياسية وطنية، ويتوافر فيها أيضاً آليات تغيير فاعلة، كان من أهمها الانقلاب العسكري في وقت مضى، والحزب السياسي والإعلام المستقل والاحتجاج العلني، وقبل الجميع الانتخابات الحرة المتعددة الأحزاب، اليوم. والفضل الكبير في ذلك لمصطفى كمال أتاتورك الذي أرسى أسس هذه الدولة، ودافع بنجاح عن كيانها، وجدد أساسها الثقافي. ولا ريب أن العضوية في الحلف الأطلسي قد حمت تركيا من تهديدات كيانية، ومنحتها وجهة تاريخية نحو الغرب أو ثبتت هذه الوجهة، ولا يبدو أن حكم العدالة والتنمية يفكر مجرد تفكير بمراجعتها، على ما يشهد كتاب احمد داود أوغلو: «العمق الاستراتيجي». يدير الحزب الإسلامي التركي اليوم ومنذ عشر سنوات دولة قوية الشخصية ومتينة الأسس، ولا مجال لإعادة النظر في علمانيتها كمؤسسة حكم، وإن يكن عمل على إظهار شخصيتها الإسلامية ككيان سياسي تاريخي. وما قاله أردوغان قبل سنتين في القاهرة دفاعاً عن العلمانية، وأثار غضب الإسلاميين المصريين، يستند إلى تجربة تركية حققت نجاحات فعلية كبيرة.
إيران بدورها دولة قومية، وليس المذهب الشيعي غير واحد من أسس شخصيتها القومية. يوفر هذا المذهب رمزية تضفي الشرعية على الجمهورية الإسلامية وصراعاتها المستمرة، ويمثّل أداة للسياسة الخارجية التوسعية لدولة قومية صاعدة. في الواقع هو أداة، أداة عزيزة، لكن مجرد أداة. وفي إيران أيضا تتوافر نخبة وطنية مستقلة، وهي نخبة متبدلة، وإن بحدود ضيقة، بحكم أن القرار السيادي بيد الولي الفقيه. لدى إيران مشكلات كبيرة بفعل طبيعة نظامها الاستبدادي وسياستها الخارجية العدوانية التي نرى مثالاً إجرامياً عنها في سورية، وتعاني حصاراً يتسبب لها بمشكلات اقتصادية وأمنية صعبة، لكنها عموماً غير مهددة الكيان، وتوفر أسباباً قوية لتُمسك أكثرية سكانها بها.
الأمر مختلف في أكثر دولنا العربية. ليس بينها مَن كانت مركزاً لكيان سياسي قديم غير مصر، وبدرجة ما المغرب وتونس، وأكثرها دول فتية لا تشعر قطاعات مهمة من سكانها بارتباط خاص بها، بل يحصل أن توالي على نحو صريح دولاً غيرها. وتعقدت شروط تطور المشرقية منها بفعل قيام الكيان الإسرائيلي ودور الريع النفطي المشوه للهياكل الاقتصادية والتوزانات الاجتماعية والنفسية. وفيها عموماً نخب سياسة متواضعة المستوى، وغير وطنية، ترتد غالباً إلى شخص واحد. وتعرفين أن الدول التي تفجرت فيها ثورات كانت تتجه إلى التحول إلى دول سلالية، أي ما قبل وطنية. سورية هي المثال الكارثي على نجاح هذا النكوص. وفي هذا النجاح كُتبت استعانة السلالة الأسدية بدولة أجنبية معادية، إيران الشيعية التوسعية، وفيه أيضا كتب الاستعانة بميليشيا الحزب الإيراني في لبنان. نحن هنا حيال نخبة غير وطنية جوهرياً، يمكن أن تحاكم في أي مكان آخر بالخيانة العظمى.
السوريون يدفعون اليوم الثمن الباهظ لنجاح وزير دفاع 5 حزيران في تشكيل سلالة حاكمة، ما يضع بلدهم في حال أسوأ بما لا يقاس من البلدان التي قطعت الثورات فيها مسار هذا النكوص، وأسوأ من البلدان القائمة سلفاً على حكم سلالي. لماذا؟ لأن السلالات الحاكمة في بلدان الخليج والمغرب والأردن ظهرت مع ظهور الكيان الوطني ذاته، وهذا يمنحها شرعية مرتبطة بالكيان (الشرعية المرتبطة بالحكم تقتضي التحول إلى ملكيات دستورية)، ثم لأن الصفة السلالية الوراثية للحكم هناك معترف بها، ومقررة مؤسسياً ودستورياً (حيث وجدت دساتير)، وليست واقعة يجري تمويهها بكل السبل على ما هو الحال في «الجمورية العربية السورية». تأسيس السلالة الأسدية في سورية هو في نظري أسوأ بما لا يقاس من خسارة الجولان، ويقارن بإقامة إسرائيل.
فإن كان لسورية أن تتشكل كدولة وطنية، فأول ما يلزم هو فصل الدولة عن السلالة، أو تحرير الدولة من السلالة. هذا هو معنى الثورة السورية.
بخصوص مصر كنت أكثر تفاؤلا قبل النكسة الأخيرة التي أدخلت البلد في نفق لا يُعرف إلى أين يؤدي. ولا أزال أكثر تفاؤلا بخصوص تونس على المدى الأطول. ينبغي أن نقارب ثوراتنا من زاوية تشكل الأمم، وهذه عملية صعبة وشاقة ومكلفة، وإيقاعها بطيء.
• يبدو أن الصراع السني الشيعي في المنطقة آخذ في التمدد. كيف يمكن قراءة هذا الصراع في ضوء المراحل الحرجة التي يمر بها العالم العربي؟
– بداية، ليس هذا تطوراً يمتنع اجتنابه. كان يمكن اجتنابه دونما صعوبة كبيرة.
وهو ليس مكتوباً في تمايز إسلامي قديم، أو في واقعة وجود المذهبين الإسلاميين بحد ذاتها.
إنه صراع سياسي بكل معنى الكلمة، تحركه أطراف سياسية، إقليمية ومحلية، في العديد من بلداننا، وبخاصة الطموحات الامبراطورية الإيرانية. تسهل الأمر الأوضاع الضعيفة فكرياً وسياسياً في العالم العربي، وافتقارنا، عالماً ودولاً منفردة، إلى مشروع أو وجهة تاريخية.
ودفْع الأمور في اتجاه صراع سني شيعي هو بمثابة كارثة تاريخية، تفسد تطلع المجتمعات العربية إلى التحرر السياسي والاجتماعي، وتغرقها في أشكال منحطة من الصراع الاجتماعي والفكري والسياسي.
ليس لدي عواطف سلبية تجاه الشعب الإيراني، لكن لا بد من إلحاق الهزيمة بمشروع الهيمنة الإيرانية في المشرق العربي، ومن تعطيل المضخة الإيرانية التي هي اليوم منبع بعض أخطر ظواهر الطائفية والتمزق الاجتماعي والسياسي في منطقتنا.
• هل يمكن الحديث عن إسلامات، إسلام سني مقابل إسلام شيعي، إسلام حداثوي (لدى النخبة) مقابل إسلام ماضوي؟
– يمكن الحديث عن إسلامات متعددة دائماً في تصوري، لكن ليس لنا أن نلتقط هذه الإسلامات من التداول الجاري، وعلينا أن نبني مفاهيمها عبر تحليل نقدي مدقق.
قبل كل شيء، ليس هناك إسلامات غير حداثية، بمعنى أنها متشكلة بالحداثة وبالصراعات فيها وعليها وبها، وتتضمن دوما قولا في شأن الغرب وفي شأن النخب الحاكمة، وفي شأن التيارات الفكرية والسياسية الأخرى في بلداننا، وفي شأن تكوين مجتمعاتنا المعاصرة ودولنا، أقوال مجملة، وغثة في الغالب، وقريبة في مضمونها مما كان يتداول في أوساط اليمين القومي والديني في الغرب حتى قبل الحرب العالمية الثانية (محافظة اجتماعيا وتسلطية سياسيا، ومتمركز حول الذات، وتعتنق نظرية بالمؤامرة…).
هناك إسلامات كثيرة لأن الإسلام متشكل دوما بالحاجات والمطالب الاجتماعية التي تختلف باختلاف المجتمعات، وفي المجتمع الواحد باختلاف المراحل الزمنية. نميز مثلا بين إسلام توفيقي إخواني (يصف نفسه بالوسطية) وإسلام سلفي وإسلام سلفي جهادي. وهذه كلها تيارات حديثة، وإن قامت شرعيتها على مصادرة التطابق مع «الأصل» الإسلامي. والطلب الاجتماعي عليها متغير أيضاً. الإسلام الإخواني مثلا قاعدته الاجتماعية في سورية اليوم مدينية، بينما قاعدة الإسلام السلفي ريفية عموماً، والسلفي الجهادي «أممية». ويمكن التكلم أيضا على إسلام شعبي غير منظم وإسلام عالم أو معياري، إسلام حكومي «مشايخ السلطان» وإسلام متمرد يثور بعضه على المجتمع وليس على الحكم وحده، إسلام صوفي وإسلام فقهي.
يمكن الكلام كذلك على إسلام تركي وإسلام سعودي وإسلام سوري، وحتى على «سعودة» بعض الإسلام السوري. وأظن أنه بوسعنا القول إن إسلام مجتمعات تتقدم يتقدم هو ذاته، وإن إسلام مجتمعات تتدهور لا ينجو من التدهور.
• ألا ترى أن الاسلام اليوم يتعرض الى التذرير الداخلي بسبب الانشطارات وصداماته المتكررة مع الحداثة؟
– نعم، أرى. وهذا ما أشرت إليه من تفجر الإطارات الإسلامية الضيقة للحداثة بفعل دينامية (وديناميت) الأخيرة. لكن هذا التفجر يعكس أيضا خاصية عريقة للإسلام كدين: عدم وجود مركز إسلامي معترف له ويحظى بشرعية عامة، وخاصة في الإطار الإسلامي السني. في الإطار الشيعي الوضع أفضل نسبياً بفعل دور النجف، واليوم قم.
ليس لدينا مركز إسلامي مرجعي في مكة أو في القاهرة أو في أي مكان، وليس هناك ولم يوجد يوماً مؤتمر إسلامي سني عام، يشكل مرجعية لعموم المسلمين السنيين، أو يتداول في شؤونهم الدينية المشتركة. يكاد يكون كل شيخ أو دارس شاب للشريعة اليوم مرجعاً يفتي فتاوى ملزمة لمستفتين كثيرين… وهذا منبع لفوضى هائلة اليوم أكثر مما هو منبع لتحرر فكري وتعددية فقهية. في بعض عملي قبل سنوات بدا لي أن هناك حاجة كبرى إلى تشكل مؤسسة إسلامية مرجعية، تحد من الفوضى في هذا المجال، وتعقلن الشريعة والممارسة الدينية، وتشكل بحد ذاتها خطوة كبرى في عملية الإصلاح الإسلامي المرجوة. ورأيي أن العلمانية أيسر في حال وجود مؤسسة مرجعية مما هي في حال التناثر الديني الهائل اليوم. وبالعكس كلما كان التناثر الديني أكبر تعذرت أكثر العلمانية والعقلنة.
• كثر الحديث في الآونة الأخيرة عن ظاهرة التشيع ويبدو أن ثمة مخاوف حقيقية في مصر من الحراك الشيعي الذي ربما تعمل على تضخيمه التيارات السلفية بدعوى اختراق الشيعة المدعومين من ايران للعالم السني إذا صح التعبير. ما رأيكم في ذلك؟
– معلوماتي لا تكفي للحكم في هذا الشأن، لكن ربما ينبغي التمييز بين وجهين للأمر. وجه مرتبط بالثورة الإيرانية المعتمدة على الإسلام الشيعي كمذهب مشرِّع ومنبع للرموز، رموز ليست غريبة على الوجدان السني، وإن كان لا يمنحها المكانة الي يمنحها لها الشيعة؛ ثم وجه مرتبط بسياسة دؤوبة صبورة لدولة قومية عدوانية هي إيران، تبذل جهوداً وأموالاً لنشر مذهبها ونخر العالم العربي لاستتباعه أو تمزيقه.
يحيل الوجه الأول إلى الإشعاع المعنوي لمشروع يقاوم «الاستكبار العالمي»، وكان التجسد الأهم لهذا المشروع عربياً، حزب الله اللبناني، يعرض تماسكاً جذاباً في ظل تبعثر شامل عربياً، وفي سجله إنجازات تبدو حقيقية (هذا قبل انخراطه الإجرامي في تثبيت حكم السلالة الأسدية). الوجه الثاني يحيل إلى سياسة متعمدة، تعمل على تكوّن مؤسسات لنشر التشيع وتمويل العملية والدعاية للمذهب وربطه بالحكومة الإيرانية. وتتولى ذلك السفارات والقنصليات الإيرانية في غير بلد عربي.
وبينما لا أجد مشكلة في الوجه الأول الذي يرتبط بظرفية تاريخية محددة، ويقبل التسويغ بمبدئي حرية الاعتقاد الديني والتسامح، وهو في النهاية موجة تاريخية عارضة، فإن الوجه الآخر مرفوض وينبغي أن يُحارب لكونه مندرج في مشروع تمزيقي واستتباعي لدولة قومية عدوانية.
أفهم أن السلفيين السنيين لا يناسبهم التمييز بين الأمرين، ولا يريدون رؤية الوجه الأول، لكن ليسوا هم مَن اخترع الوجه الثاني، ولا أجد مفهوماً أو مقبولاً أن يتعامى أمثالنا عنه.
الرأي الكويتية