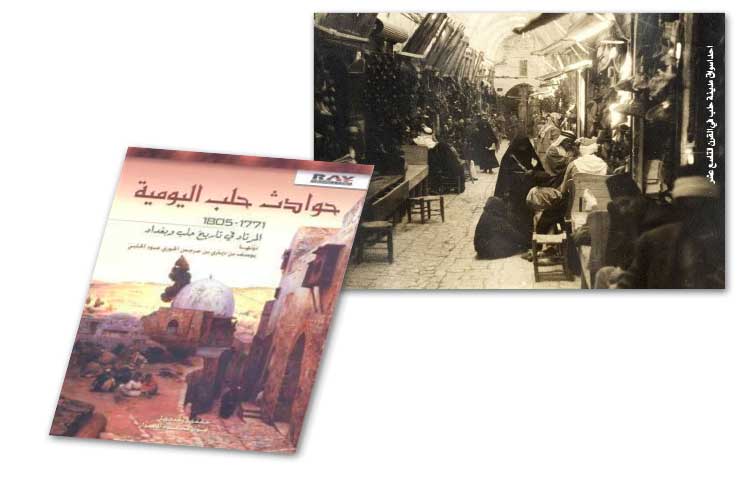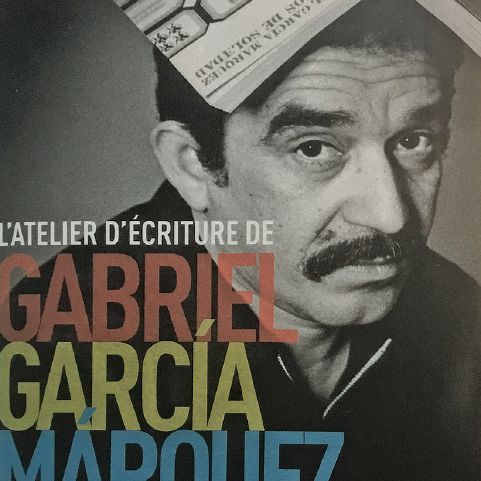العلوم السياسية والشرق الأوسط الدامي: في انتظار موت «فرانكو» العربي/ محمد تركي الربيعو

يرى مارك لينش، أستاذ العلوم السياسية في جامعة واشنطن في سياق تقديمه لكتاب «شرح أسباب الانتفاضات العربية» الصادر عن جامعة كولومبيا سنة 2014 (ترجم للعربية سنة 2016)، أن علم السياسة الأمريكية لم يكن معداً للتعامل مع الخضة الكبيرة التي شهدها الشرق الأوسط، ذلك لأن كتابات العلوم السياسية التي تناولت المنطقة العربية، بقيت تركز على قدرة النظام الاستبدادي الراسخ في استرجاع السيطرة، وفي العجز النسبي للمجتمع المدني وفي الأثر المحدود الظاهر لنشر آراء وأعراف جديدة عبر وسائل الاتصال والإعلام التقنية. ورغم أن الانتفاضات العربية لم تزعزع – وفق لينش- أنظمة الحكم في حد ذاتها، بل أيضاً نتائج كتابات متقدمة، ظهرت على مدى العقد السابق، للتعقيب على طبيعة الدول العربية الاستبدادية.
غير أن قدرة الأنظمة على التعلم، وإعادة تنظيم أدوات واستراتيجيات تكوينها من جديد، بعيد الانتفاضات العربية، دفع الباحثين في العلوم السياسية الأمريكية من جديد للهروب من تطورات المحلي وديناميات الأحداث السياسية اليومية، لصالح الأخذ بنظرية ما بعد التحولات، التي تقوم على دمج وفهم وتفسير مستقبل الانتفاضات العربية، من زاوية مسار التجربة التاريخية لبعض الدول في أمريكا اللاتينية وأوروبا، على مستوى الانتقالات السياسية والعسكرية، ومن ثم محاولة إسقاط نتائج هذه التجارب وخلاصاتها على ما هو حادث اليوم في الشرق الأوسط، أو بالأحرى قراءة ما يجري اليوم من منظور هذه التجارب، خاصة بعد فشل الإطاحة ببعض الأنظمة العربية، مثل النظام اليمني أو السوري، ومن ثم القول إن تحولات الديمقراطية، في تجارب بعض الدول، نتجت على الأرجح بعد توصل «حمائم» الأنظمة العسكرية بالتعاون مع المعتدلين في صفوف المعارضة، إلى صوغ رؤية أو برنامج من أجل التغيير السياسي. وبالتالي في ظل التعثر الحالي في الربيع العربي الدامي، لا بأس من البحث عن مخرج نظري آخر، يتمثل في إجراء تعاون بين «حمائم» من داخل هذه الأنظمة، وقوى المعارضة المعتدلة. ولعل ما يدعم صحة هذا التحول في المقاربة لدى لينش، هو ما بتنا نلاحظه في العديد من الكتابات السياسية الأمريكية والغربية وحتى الدبلوماسية، التي أخذت بعد سنة 2013 في حالة سوريا مثلاً تختصر شكل الصراع من خلال التركيز على «شخص الأسد» بوصفه أساس المشكلة، وأن غيابه حتى في ظل بقاء كافة الأجهزة الأمنية المتوحشة هو كفيل بالانتقال نحو عملية سياسية جديدة في البلاد بالتعاون مع بعض القوى الإسلامية «المعتدلة». من هنا فإن موت «فرانكو» العربي (كما في حال إسبانيا) كفيل وفقاً لهذه الرؤية في إحداث توازن تقريبي بين القوى السياسية، لإيجاد حل سلمي للصراع الذي تعيشه المنطقة منذ ست سنوات وأكثر.
نجد أنفسنا أمام هذه الرؤية، وفقاً لدانيال برومبرغ (جامعة جورج تاون) الذي يشير إليه مارك لينش في أكثر من مناسبة، أمام نظرية ليست معدة للتعامل مع القوى المحلية، وتفاعل هذه القوى مع العديد من الشبكات الدينية والعسكرية والاقليمية، بل أكثر ما تفعله هذه الرؤية هو أنها تتغاضى عن دراسة كل ديناميات الصراع اليومي لصالح رؤية تبشيرية، تقحم العالم العربي مثلاً في نظريات استنتاجية أعم، وهو ما ينتج تصورات دائمة البلاغة نظرياً، لكن تبقى مضللة تجريبياً.
وأمام السؤال والتشكيك الذي طرحه لينش حيال دارسي السياسة المقارنة، ومحاولة إخراج ما حدث ويحدث في الشرق الأوسط خارج سياق بعض النظريات الجاهزة حول فترة ما بعد التحولات، حاول الأخير مع مجموعة من الباحثين والعلماء في حقل السياسة الأكاديمي الأمريكي تحديداً (ستيفن هايدمان، راينود ليندرز، ناثان براون، دانيال برومبروغ ، كليمنت م. هنري وغيرها من الأسماء) من خلال كتاب «شرح أسباب الانتفاضات العربية» إعادة رسم صورة جديدة لديناميات الانتفاضات العربية، ليس كمحاولة لإعادة النظر وحسب في بعض أدبيات الاقتصاد السياسي والإعلام التقليدية، التي حاولت تفسير ما حدث في الشرق الأوسط، من خلال الحديث مثلاً عن سخط الشباب والبطالة، أو ارتفاع أسعار المواد الغذائية، وربط ذلك بظاهرة الاحتباس الحراري، أو عبر ربط ما جرى في سردية الشاب ذي السروال العلماني، الذي قاد جموع الجماهير في الميادين، من خلال صفحات الفيسبوك ووسائل التواصل، بل الأهم من هذه العودة في شرح شبكات المنتفضين المبكرين الاجتماعيين، هي في محاولة هؤلاء الباحثين تجاوز القراءات المقارنة، التي حاولت لي عنق مسارات الحراكات الاجتماعية في الشرق الوسط، لتتلاءم مع نماذج وتجارب حدثت في الماضي، وهو ما يعني – بحسب هؤلاء الباحثين- فشل النظرية السياسية في خلق مقاربات ونظريات جديدة، دون أن يكون الهدف من ذلك أيضاً محاولة خلق «استثنائية عربية أو إسلامية» جديدة على مستوى فهم الحراك الاجتماعي، وكأنه بعيد عما يجري من تحولات عالمية، بل هي محاولة للبحث في اتجاه «محدود» يدقق في الطريقة التي يكون التغيير السياسي وعمليتا التخاصم والتفاوض، رهن قوى محلية وقومية وإقليمية، ومن هذه القوى يشكل دور صراع الهوية متغيراً حاسماً، فيستأهل وضع تصور له بطريقة أكثر جدية ضمن نظرية تغيير أشمل.
ومن بين الدراسات المهمة في هذا الكتاب، التي حاولت دراسة الاختلافات المنهجية بين الوضع الشرق الأوسطي وبعض النماذج في أمريكا اللاتينية أو أوروبا، يمكن الإشارة إلى دراسة روبرت سبرينغبورغ (الجيوش العربية) التي خصصها من ناحية لتفسير التباين الحاصل في ردود الجيش على اندلاع الانتفاضات العربية، ومن ناحية أخرى لاكتشاف الفوارق بين المناخ المحيط بالانتقال العسكري في بعض البلدان مثل (إسبانيا، والبرازيل، وبلدان أوروبا الشرقية) والمناخ الذي يعيشه الشرق الأوسط اليوم، وهو مناخ يعج بالصراعات والحديث عن محاربة الإرهاب، بشكل بات يضمن شرعيات وأدوات جديدة للإبقاء على سيطرة المؤسسات العسكرية.
ويرى الأخير (سبريغبورغ) أنه من المفيد، قبل البحث في مقارنات بين التجارب العسكرية، البحث بشكل دقيق في السياقات المحددة التي تعمل فيها الجيوش العربية مثلاً، والسمات التي تميز كل جيش عن الآخر، خاصة أن العالم العربي رغم أنه شكل منطقة أساسية للبحث في العلاقات المدنية – العسكرية طوال العقود التي أعقبت الانقلاب العسكري، الذي أتى بجمال عبد الناصر وزملائه الضباط الأحرار إلى السلطة عام 1952. مع ذلك، فقد تفادى محللو سياسات العالم العربي اختيار المؤسسات العسكرية موضوعاً لدراساتهم.
وبالنسبة للاختلافات بين الجيوش العربية، يرى الباحث أنه يمكن أن نفرق بشكل أولي بين جيوش تابعة لأنظمة ملكية وجيوش تابعة لجمهوريات استبدادية، من خلال عدة عناصر تتعلق بالنمط والتكوين العسكري ووسائل السيطرة ودور السياسة والاقتصاد. فمثلاً في موضوع التكوين العسكري، نجد أن الجيوش العربية سواء في الأنظمة الملكية أو الجمهوريات الاستبدادية، لطالما حصلت على مساعدات واسعة النطاق من الجيوش الأجنبية، فيما يتعلق بتدبير السلاح والتدريب على القتال والخدمات اللوجستية والصيانة، إلا أن ثمة اختلافاً في درجة التدخل في هذه الناحية أيضاً: ففيما تعتمد الجمهوريات، ومنها مصر، على عملاء عسكريين أجانب، نراها تنزع أكثر من الأنظمة الملكية، إلى تقييد حركة دخولهم إلى أماكن مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بطبيعة عملهم من الناحية السياسية. هذا الاحتضان اللامحدود للعملاء العسكريين الأجانب، خاصة الأمريكيين في الأنظمة الملكية، يعكس اعتماد هذه الأنظمة الكبيرة على هذه القوى من أجل بقاء النظام، ويعكس أيضاً تمتع الأنظمة الجمهورية بقدر أكبر نسبياً من الاستقلالية الذاتية. وثمة فرق آخر بين جيوش الدول الملكية والجمهورية، ويكمن في ميل أكثر لدى الأخيرة إلى الانخراط مباشرة في الاقتصاد المنتج، إما على شكل مؤسسة مشتركة وإما ضباط أفراد، في حين نشهد غياباً نسبياً للجيش – باستثناء الأردن- عن اقتصادات الأنظمة الملكية الثرية.
من ناحية أخرى، يرى الباحث أن هناك اختلافات وفروقات أيضاً داخل الأنظمة الملكية على مستوى مأسسة كل جيش. فالمغرب والأردن وسلطنة عمان وبدرجة أقل الكويت، تتسم مؤسسة الجيش بداخلها بمؤسساتية، أكثر من جيوش السعودية والبحرين والإمارات العربية المتحدة وقطر، على مستوى عدم بسط الأسرة الحاكمة نفوذها على المناصب الرئيسية في وحدة الضباط. كما نجد أن جيوشا مثل الجيش المغربي والأردني بشكل خاص، يقوم بدور أساسي في إبراز هوية الدولة، عن طريق المشاركة في أنشطة الدعم السلمي العالمي، بينما نجد أن الجيوش في الملكيات الأكثر تسلطاً ليست معتادة على إبراز الرموز الوطنية، فهذا امتياز محفوظ للأسر الحاكمة. وفي حال نشوء تحديات خطيرة في وجه الأنظمة الملكية، فمن المرجح أن يسعى الجيش في كل من الأردن والمغرب إلى إنقاذ دولته إذا تعرض لخطر الانزلاق مع عاهل المملكة، بينما من المحتمل أن تكرر جيوش الأنظمة الملكية في مجلس التعاون الخليجي، الأكثر تسلطاً، سلوك الجيوش في الجمهوريات القمعية، فينحاز الضباط الذين تجمعهم صلات القرابة بالسلاطين الحكام إلى النظام وليس إلى الدولة أو على الأقل إلى أفراد من العائلة المالكة في النظام.
بعد هذا التوضيح لطبيعة الفروقات السابقة، ينتقل الباحث لمناقشة بعض المقارنات التي يجريها بعض الباحثين الأمريكيين بين تجربة الانتقال العسكرية في بعض البلدان مثل (إسبانيا، البرازيل، دول أوروبا الشرقية) وإمكانية أو «اشتهاء» القيام بها داخل جيوش بلدان العالم العربي، بعيد الانتفاضات العربية. وفي هذا السياق يعتقد الباحث أن أغلب هذه المقارنات التبسيطية أهملت نقطة جوهرية تتمثل في أن تجربة الجيوش في أمريكا اللاتينية وبعض الدول الأوروبية مثلاً، تميزت بنسبة عالية من الخصخصة، وكان للأنظمة الحكومية تجارب سابقة في شبه الدستورية ودولة القانون على الأقل، وفي غالبية الحالات تمتعت المجتمعات المدنية فيها بقدر كبير من النفوذ والقوة، قياساً بمثيلاتها في الدول العربية. بالإضافة لذلك فقد توفرت في تلك التجارب قواعد ومؤسسات إقليمية داعمة، وأبرزها الاتحاد الأوربي في الحالة الأوروبية، وقد لعبت هذه المؤسسات دوراً حيوياً في رفع مستوى الوعي السياسي، وتوفير المعلومات الضرورية من أجل رقابة مدنية فاعلة على القوات المسلحة، بينما نجد الأمر مختلفاً في بلدان الشرق الأوسط اليوم، التي بقيت الأولوية الأساسية للقوى الدولية، وحتى للسلطات المحلية فيها، تركز على البعد الأمني، بدلاً من تركيز اهتمامها على المؤسسات السياسية المدنية، بعكس تجربة الاتحاد الأوروبي في التعامل مع دول أوروبا الشرقية، أو مع تركيا التي ساهمت في إعادة صياغة العلاقة بين المدني – العسكري.
وبناء على ذلك نجد أنه ليس بإمكان دارسي الانتفاضات العربية الاهتداء بسهولة إلى خرائط طرق تؤدي إلى ترجيح كفة الديمقراطية وهيمنتها على القوات المسلحة، في الكتابات الموجودة، ولن تكون مهمتهم المتمثلة بترسيخ مثل هذه الهيمنة سهلة. فالقوى الإقليمية والعالمية لا تدفع بالاتجاه ذاته، وما زالت المؤسسة العسكرية تدافع عن امتيازاتها واستقلالها عن الرقابة المدنية. وبالتالي فإن محاولة البعض اشتهاء نموذج فرانكو «العربي» تبقى محاولات تبشيرية أكثر ما تتعلق بالواقع ودينامياته الديموغرافيا والوحشية في الشرق الأوسط الدامي.
كاتب سوري
القدس العربي