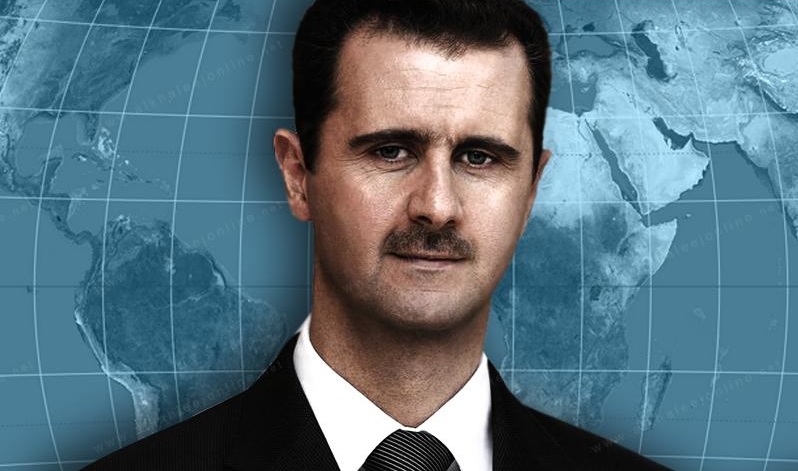سوريا ومعضلة الخطاب الطائفي

منذر خدام
ما أكثر القضايا التي شغلت بال السوريين قبل أن ينتفضوا على نظامهم المستبد، من فلسطين إلى العراق إلى لبنان، إلى القضايا الداخلية، من لقمة الخبز إلى الحرية وما بينهما. غير أن الخوف من أن ينزلق بلدهم وتنحرف ثورتهم إلى صراع داخلي طائفي يشكل هذه الأيام الهاجس الأكبر لديهم.
لقد استحوذت قضايا الصراع المسلح الجاري اليوم بين جيش النظام وقواته الأمنية وشبيحته من جهة والمتظاهرين السلميين والجيش الحر والمسلحين المحليين من جهة أخرى على اهتمامات السوريين، حتى كادت تسمرهم أمام التلفاز، ووسائل الإعلام المختلفة، وهم، في حقيقة الأمر، يضمرون هواجس، وإحساسات بالخوف تجاه بلدهم ومجتمعهم، الذي بدأت تتهدده الأخطار من كل صوب. لقد أخذت تنزاح لغة الحياة، لغة الحب، لغة العمل، لغة الاجتماع، لتحل محلها لغة الخوف، لغة الموت التي يحاول النظام تعميمها، باحثة لها عن مستقر في النفوس التي فقدت حس الرؤية السياسية السليم. لقد صار من مألوف الحياة اليومية، استخدام مفردات المنطق الطائفي في التحليل السياسي للظواهر السياسية، بدعوى «الموضوعية» و«الواقعية». ولم يعد يقتصر ذلك على الجمهور العادي، بل أخذ يتسلل إلى عقل النخب السياسية والثقافية، وهنا مكمن الخطورة. فعندما يفقد العقل السياسي والثقافي العارف منطقه السليم، فتأسره اللغة اليومية، بما فيها من تسطيح، وتعمية، وانسياق وراء الهوبرة الإعلامية، تصبح المفردات الطائفية، والمذهبية، والأقوامية، من قبيل «مكونات الشعب السوري»، أو «الأقليات السورية»، أو «الطوائف والمذاهب السورية»، أو «الحكم الطائفي»، أو تخفيفاً، «الحكم الفئوي»، أو «الطائفة الحاكمة» أو «المنتفعة»، و«الطوائف المقموعة» أو «المظلومة والمستغلة»، و«الطائفة الكبيرة، والطوائف الصغيرة»، و«المحاصصة» و«التوافقية الطائفية» وغيرها كثير، هي مفرداته في التحليل السياسي. وإذ يسود المنطق الطائفي ومفرداته في التحليل السياسي، وبالتالي في الممارسة السياسية، فإن الجوهر السياسي للمشكلات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي ثار الشعب السوري بسببها، يصبح من المستحيل مقاربته، والقبض عليه معرفيا، ليصار، في خطوة لاحقة، إلى وضعه في السياقات السياسية الطبيعية لسيرورته، في إطارها الوطني الجامع. في ضوء ذلك تصبح الطوائف والمذاهب، بل العشائر والعائلات والانتماءات الأقوامية المختلفة هي التي ترسم حدود الأوطان، ومصالح السكان. منطق كهذا يصنع الخنادق، يولد الفرقة والاقتتال، يكسر الجسور، يخلق العزلة، يسيجها بأوهام يستحضرها من التاريخ، أو يستولدها من تقيات المكبوت، وحراسه المعممين، ليخسر الجميع بالضرورة، في البداية والنهاية.
وبطبيعة الحال ليست هذه الظاهرة بلا أساس واقعي، فما يجري في لبنان والعراق والبحرين وفي غير مكان من الوطن العربي، وكثافة الحضور الأيديولوجي الديني في وسائل الإعلام المختلفة، واحتلال رجال الدين مساحات كبيرة من المشهد الإعلامي والثقافي والسياسي الراهن، يضاف إلى ذلك، بل قبل ذلك، غياب الحياة السياسية والنقابية الطبيعية، وثقافتها، وأطرها المجتمعية المدنية، لزمن طويل، وانسداد الآفاق أمام حياة سياسية كهذه، يولد مثل هذه الانتكاسات في العقل السياسي. ولا يجوز أن ننسى، بطبيعة الحال، فشل المشاريع القومية واليسارية، التي شغلت النصف الثاني من القرن العشرين، وانزياحها من المشهد السياسي، وكذلك غياب أية فعالية ليبرالية أصيلة ومتأصلة، كل ذلك أفسح الطريق سالكة أمام الإسلام السياسي ليتقدم الحركة المجتمعية، مع كل المرفقات المفهومية الضرورية له كعدة شغل سياسية.
وإذ يتصدى الإسلام السياسي لقضايا الثورة السورية، فإنه يتصدى لها، وهو مستند إلى أطره الطائفية والمذهبية، بغض النظر عن التلوينات المختلفة، الليبرالية منها على وجه الخصوص، في خطابه السياسي. فالسياسة المستندة إلى الأطر الطائفية والمذهبية، هي سياسة طائفية بالضرورة في المنطلق وفي المآل النهائي. هذا لا يعني أن نضع جميع فئاته وألوانه في سلة واحدة، وان نتجاهل الاختلافات العميقة والجدية القائمة بينها. لكن مع ذلك، بل رغم ذلك، ثمة جامع عام بينها وهو أنها أسيرة تموضعاتها الطائفية والمذهبية، وهي لا تستطيع التخلي عنها. هنا يغيب للأسف البعد الوطني في عملية الإسناد المجتمعي، وفي عملية التعبئة، وفي الممارسة التنظيمية والسياسية.
في مواجهة استحقاقات الراهن، لا بد من الاعتراف بأن ثمة مشكلة نظرية غير محلولة، تواجه الإسلام السياسي، هي ذاتها التي واجهت، في حينه، التيارات القومية واليسارية، الموصوفة بالعلمانية، ولم تستطع حلها، أعني مشكلة تحقيق مشروع تنموي شامل، تكون إحدى مهماته المحورية، مهمة بناء الدولة الحديثة، والحداثية، التي تدخل مجتمعاتنا في العصر الراهن، عصر الحرية والديموقراطية وحقوق الانسان، عصر أنماط الحياة المنفتحة والمتسامحة.
وإذا كانت القوى السياسية القومية واليسارية التي تصدت لحل هذه المشكلة، مدعومة برهانات كبيرة من قبل القوى المجتمعية الأساسية، وأحيانا من قبل الجماهير العريضة والواسعة، وهي بطبيعة الحال الأقرب إلى روح العصر الراهن، قد فشلت فشلا ذريعا. وبدلا من بناء الدولة الحديثة، وتأصيل المفاهيم المرتبطة بها مثل: مفهوم الفرد، والمواطن، والوطن، والنقابة، والحزب السياسي، والديموقراطية، والحرية، والمجتمع المدني، وغيرها كثير، فإنها قد نجحت في بناء دولة جهازية استبدادية مغلقة، كل شيء فيها هش، وقابل للكسر، يسهل الارتداد عنه إلى ما قبله، وليس إلى ما بعده. فمن حقنا أن نشك في قدرة الإسلام السياسي على إنجاز مهمة كهذه، وهو في رؤيته للحاضر، وفي تطلعه نحو المستقبل، يستحضر الماضي، روحا، وثقافة، ونمط حياة. قد ينجح في التعبئة والحشد للظفر بالسلطة السياسية، لكن من المشكوك به أن يستطيع تأصيل قيم الحرية والاختلاف والتعددية ربما إلا في نطاق الاتجاه الواحد، وهو لا يستطيع توليد ديناميكيات تطورية مجتمعية على المدى البعيد. فهذه الديناميكيات لا تكون بدون الحرية والديموقراطية والاختلاف والتعددية، واحترام حقوق الإنسان الفرد وخياراته ومصالحه، كمحركات لها.
في سوريا لطالما افتخر السوريون بوحدتهم الوطنية، وبتعايشهم بعضهم مع بعض، ومشاركتهم في جميع الصراعات السياسية سواء في الداخل، أو مع القوى الخارجية، بغض النظر عن انتماءاتهم الطائفية والمذهبية، تحركهم روح وطنية، أو قومية، أو طبقية عالية، لا يزال الرهان عليها صائبا لحماية سوريا، رغم كل محاولات النيل منها، من خلال تعميم مناخات الفساد والنهب والعوز، التي عمل النظام عليها طيلة أربعة عقود من السنين، وتستفيد منها القوى الخارجية في حماية مصالحها، عبر الترويج الإعلامي والسياسي الطائفي والمذهبي. لكن هذا الرهان بحاجة ماسة لتجديد أساساته وتقويتها، بمزيد من اليقظة الوطنية وعدم السماح للنظام بجرنا إلى ساحة الصراعات الطائفية.
إن الصراعات التي تشهدها سوريا وغيرها من الدول العربية هي صراعات بين الحرية والاستبداد، وهي صراعات سياسية بامتياز، يراد لها من بعض القوى الداخلية والخارجية أن تأخذ شكل صراعات طائفية ومذهبية. لهذا الغرض يتم نبش التاريخ وإعادة إحياء بعض أمواته، وتوظيفه لتحقيق مكاسب سياسية آنية. وإن أحد المداخل المجربة إلى ذلك هو السيطرة على العقل السياسي والثقافي العارف، واستبدال لغته السياسية في التحليل ومقاربة المشكلات السياسية بلغة طائفية ومذهبية. إن قضايا الثورة السورية هي قضايا الشعب السوري في تطلعه نحو الحرية والديموقراطية واستقلال الإرادة السياسية، وإنجاز مشاريع تنموية حداثية نهضوية تخرجه من دائرة التخلف إلى دائرة التقدم، ولذلك فهي تحتاج إلى اللغة السياسية لمقاربتها، وليس إلى اللغة الطائفية.
السفير