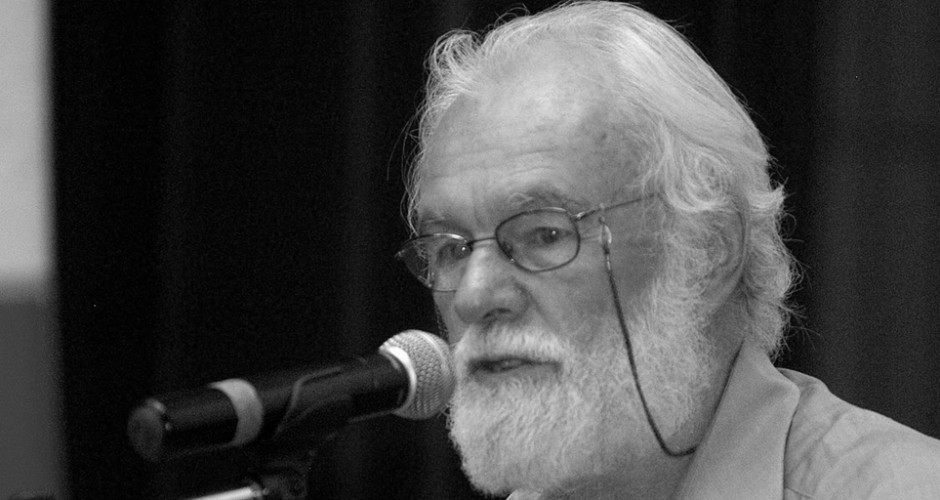إيلينا فيرّانتي الكاتبة – اللغز: كل العالم نابولي!

لم يتطلّب الأمر سوى كتابٍ واحد لتصير الكاتبة الإيطالية إيلينا فيرانتي، الّتي لم يكن يعرفها أحد قبل سبعة أعوام، واحدةً من الشخصيات الأكثرَ شهرةً في العالم مع بداية الألفية الثالثة. إنّها ظاهرة غريبة بالنسبة لمؤلّفة سلسلة روائية ذات طموحٍ أدبي لا يمكن إنكاره (وليست كاتبة رواية لليافعين مثلما حدث مع سلسلة “هاري بوتر”). هذه الرواية المتسلسلة الناجحة، المعروفة بعنوان “صديقتي المذهلة”، وبرغم أنّها تحمل العديد من الإشارات للتاريخ الإيطالي وللموقع الجغرافي، المحصور في حيٍّ من أحياء مدينة نابولي، لم يمنعها ذلك من استيفاء كامل شروط النجاح خارج الحدود. لكن ما ساعد هذا النجاح أيضًا هو أنّ كاتبة الرواية لم تكلّف نفسها عناء التّرويج لها بأيّ شكل من الأشكال. فهي كاتبة مجهولةٌ بلا ملامح، لا يعرف صورتها وهويّتها الحقيقية سوى ناشرها الإيطالي، ويعتبرها البعض من عباقرة الكتابة الروائية لهذا القرن رغم أعمالها القليلة نسبيًا. اختارت اسمًا مستعارًا هو “إيلينا فيرانتي”، ولم يفلح أحد في كشف هويتها حتّى الآن، برغم المحاولات الحثيثة والتحقيقات الصحافية الكثيرة اليائسة.
قبل أقل من أسبوعين فقط، صدر الجزء الرابع من روايتها “صديقتي المذهلة”. ولأنها متكتمّة جدًّا ونادرًا ما تصرّح بأيّ شيء للإعلام، نقدّم هنا ترجمة كاملة لآخر حوارٍ حصريّ مع هذه الكاتبة/اللّغز:
لا أعلم من أين تأتي الحكاية
*هل تتذكّرين بالضّبط متى جاءتك فكرة كتابة “صديقتي المذهلة”؟
– لا يمكنني إجابتك على وجه الدقّة. ربّما كانت نقطة البداية وفاة صديقة، أو حضوري لحفلِ زفاف كبير، أو الحاجة للعودة إلى مواضيع وصورٍ وردت في أحد كتبي السابقة، خصوصًا “الدمية المسروقة”. لا نعلم من أين تأتي الحكاية، إنّها ثمرة مصادر استلهام متعدّدة، بما فيها مصادر يظلّ اللاوعي هو محرّكها، لكنّها تثير خيالنا.
*لكنك كنتِ على علمٍ منذ البداية بأنّ الرواية ستطول إلى أربعة أجزاء؟
– لا. الصيغة الأولى من حكاية “ليلا ولينا”، بما أنّها نوعٌ من الرواسب، كان بالإمكان سردها في مجلّد واحد كبير. فقط حينما شرعتُ في العمل على هذا النص الأوّل، اكتشفتُ أنّه ستكون له تتمّة في جزأين، ثمّ ثلاثة فأربعة.
*قبل الشروع في كتابة هذه الحكاية، هل كان في ذهنك مخطّط عام للكتاب؟
– كلا. لا أخطّط أبدًا لحكاياتي بشكلٍ مسبق. لأنّ وضع مخطّط مفصّل يفقدني مباشرة أيّ اهتمام بالحكاية. وحتّى التّلخيص الشّفوي لما يدور في رأسي، بشكلٍ مختصر، يفقدني الرّغبة في الكتابة. أنا أنتمي لطينةٍ من الكتّاب يشرعون في الكتابة وهم لا يعرفون سوى الخطوط الضّرورية للحكاية المزمع روايتها. أكتشفُ البقية سطرًا بعد سطر.
*حدّثينا عن الجدول الزمني لكتابة ونشر هذه الرواية؟
– بدأتُ في سنة 2009، بينما تطوير الحبكة مع كلّ التّعديلات اللّاحقة عليها تطلّب مني عامًا تقريبًا. بعدها، حين قمتُ بمراجعة النص، اكتشفتُ بفرحٍ كبير أنّه أخذ منذ الصفحة الأولى أبعادًا جديدة، سيظلّ ينمو وينمو إلى أن يصير شيئًا آخر. في نهاية 2010، وبالنّظر إلى حجم الصفحات التي تراكمت فقط من أجل سرد طفولة ومراهقة “ليلا ولينا”، قرّرت بمعية دار النشر أن تصدر الرواية في أكثر من جزء.
*هل كان من الصّعب سردُ حكاية على حلقات عدة؟
– كانت هذه تجربة جديدة تمامًا بالنّسبة إليّ. حين كنتُ طفلة، كنت أحبّ سرد الحكايات. كنت أحبّ أن أستحوذ على اهتمام جمهوري الصغير من الأطفال المتحلّقين حولي، وهذا كان مثيرًا حقًّا، بحيث كان عليّ أن أُبقي مستمعيّ في حالة تشوّق ورغبة في أن أُكمل، أن أستأنف الحكي في الغد، أو الأسبوع القادم. هذه التّجربة، والمسؤولية، كأنّها كانت تنقلني من مكانٍ إلى آخر، وتُثير عواطفي بشدّة. أظنّ أنّني عشتُ شيئًا مماثلًا لهذه الحالة في الفترة ما بين 2011 و2014. وبمجرّد أن هدأ الضّجيج الإعلامي – وقد كان هذا ممكنًا بالنّسبة لي بفضل وضعية الغياب الّتي أتبنّاها منذ 1990-، عثرتُ من جديد على تلك الرّغبة الطفولية في سرد الحكايات، في كامل امتلائها، ما دام الجمهور قد صار أكثر عددًا وأكثر انتباهًا، ويطالبني بسرد تتمّة الحكاية مرارًا وتكرارًا. وعندما كان القرّاء يقرؤون الجزء الأول من الرواية، كنتُ بصدد إنهاء الجزء الثاني، وحين كانوا يقرؤون الجزء الثاني، كنتُ أُنهي وأصقل الجزء الثالث، إلخ.
*إذا نظرنا إلى الوراء، كيف ترين الطريقة التي كُتبت بها الرواية؟ هل كانت سلِسة منذ البداية؟ هادئة؟ هل مررتِ بلحظات شكّ؟ هل كتبتِ أكثر من نسخة، مع تغييرات وتشطيبات كثيرة؟
– في الماضي، كنتُ أجد صعوبة كبيرة في الكتابة. كنتُ أكتب دائمًا منذ سنّ المراهقة، لكن بصعوبة، وعمومًا لم أكن راضية عن النتيجة. لذلك نادرًا ما نشرتُ كتاباتي. لكن مع هذه الحكاية الطويلة جدًا، كان الأمر مختلفًا. كتبت المسوّدة الأولى دفعةً واحدة، دون أن أواجه صعوبات: كانت متعة السرد أقوى من كلّ شيء. وحتّى الكتابة في السنوات اللّاحقة فاجأتني بخفّتها، كان الأمر أشبه بحفلة دائمة. وفي العمق، ظلّ العمل على الأجزاء الأربعة والتّحسينات الطارئة عليه استعدادًا للنشر وفيًّا للجانب المضطرم للمسودة الأولى، مع إثراء وإغناء مادّته الأساسية. وباختصار، لم أواجه أيّ أزمة، أو شكّ، فقط بعض التعديلات والإضافات الموسّعة. كان لديّ إحساس كما لو أنّ فيضًا عارمًا يغمرني ويحملني معه، وكنت سعيدةً بأنّني بقيتُ على قيد الحياة بعد مروره.
*في رسالة إلى المخرج ماريو مارتوني، تُصرّين على هشاشة الكتابة، وتُشيرين على الخصوص إلى أنّ أيّ تسلية قد تُخرّب طابع الكتابة الأساسي. ومع ذلك، لا يُوجد كاتب مطمئنّ تمامًا لقدرته على بناء عملٍ ضخم. هل تعتقدين أنّ هذه المزاوجة بين القدرة والهشاشة أساسية في عملك؟
– إنّ أكبر مخاوفي هو الإحساس فجأةً بأنّ تكريس حياتي بالكامل للكتابة لم يكن له معنى. إنّه إحساسٌ داهمني في كثير من الأحيان، وأخشى أن يداهمني اليوم. أنا في حاجة إلى تصميم قويّ، أن أكون مركّزة بشكلٍ كامل على ورقتي، بعنادٍ وشغفٍ كبيرين، ما دمتُ لا أترك لنفسي مجالًا للترفيه، أو القيام بأشياءٍ مستعجلة تكون بشكل ما أكثرَ نفعًا في حياتي. بهذا المعنى، نعم أنا هشّة، وأتفهُ شيءٍ بإمكانه أن يذكّرني بضروريات أخرى ويُشعرني بالذنب. ما أحتاج إليه أكثر من القوّة، هو الاعتزاز: عندما أشتغل، أكون في حاجةٍ للاعتقاد أنّني مكلّفة بمهمّة كتابة هذه الحكاية أو تلك، وأنّ التملّص أو عدم استثمار كلّ قدراتي في إكمال هذا العمل سيكون خطًأ فادحًا.
*ما مصدر هذه الطاقة الحيويّة التي نلمسها في كتابتك؟
– لا أعلم إن كانت لكتابتي طاقة، كما تقول. ولكن إن كانت لها فعلًا، فلأنّها طاقة لم تجد لها منافذ، أو لأنّني رفضتُ أن أمنحها فرصًا، بوعيٍ أو بدونه. ما هو أكيد، أنّني حين أكتبُ، أستعين بجوانبَ هاربة وغامضة من ذاتي وذاكرتي، وهذا يُشعرني بعدم الارتياح. وبالنّسبة إليّ، تكون الحكاية جديرة بأن تُكتب فقط حين يكون هذا مصدرها.
العالم بأكمله هو نابولي
*الطريقة الّتي ترسمين بها مدينة نابولي قاسية، عنيفة، وغير سارّة. وهذا واضحٌ أكثر في النصف الثاني من الجزء الرابع، حيث يتعيّن على ليلا ولينا مواجهة عنفٍ حاضر في كل مكان. هل كنتِ شاهدة على أعمال عنفٍ شديد في نابولي؟ كيف تعايش سكّان نابولي مع هذا العنف، على مرّ السنين؟ هل تعتقدين أنّهم قاموا بتربية حكمةٍ خاصة في فهمهم للعنف، وهذه الحكمة قد تشاركينهم إيّاها؟
– في نابولي، يجب أن تكون محظوظًا جدًّا لكي لا يطاولك العنف بأيّ شكل من الأشكال. لكن ربّما هذا هو الحال في نيويورك، لندن أو باريس. نابولي ليست بأسوأ حالٍ من أيّ مدينة أخرى في إيطاليا أو في العالم. لقد استغرقتُ وقتًا طويلًا لأستوعب ذلك. سابقًا، كنتُ أعتقد أنّها المدينة الوحيدة الّتي تفقد فيها الشّرعية معالمها وتختلط باللّاشرعية، والمدينة الوحيدة الّتي تتحوّل فيها المشاعر فجأةً من الأجمل إلى الأسوأ، هكذا بدون لحظة انتقالية. اليوم لديّ إحساس أنّ العالم بأكمله هو نابولي. على الأقلّ، كانت لنابولي دائمًا جدارة أن تقدّم نفسها دون أيّ حجاب. وبما أنّها مدينة ذات جمال مذهل، فإنّ القبح سرعان ما يبدو للعيان أكثر من أي مكان آخر- سواءٌ أكان جريمة، عنفا، فسادا، تواطؤا، الخوف العدواني للسكّان العزّل، أو استنزاف الديموقراطية.
*ليلا ولينا تعانيان كثيرًا، على امتداد الرواية. لماذا اخترتِ لهما المرور بكلّ هذه التجارب، من خلال أحداث مأساوية من كلّ نوع؟
– لا أعتقد أنّ مشاكلهما بعيدة عن المشاكل الّتي عرفتها النساء يوميًّا في كلّ مكان من العالم، وخصوصًا أولئك اللّاتي ولدن فقيرات. ليلا ولينا تقعان في الحبّ، تتزوجان، تتعرّضان للخيانة، وتردّان بالخيانة، تبحثان عن موقعٍ في العالم، تعانيان من التّمييز، لديهما أطفال وتسهران على تربيتهما، سعيدتان أحيانًا وتعيستان أحيانًا أخرى، وتمرّان بتجربة الفقدان والموت. وبالتأكيد أستخدمُ أسلوبًا روائيًا، لكن مع بعض التقشّف. وعمومًا الروابط العاطفية الّتي تجمعنا بالشخصيات هي الّتي تُظهر لنا حكاياتهم وكأنّها مصائب متتالية. في الحياة كما في الروايات، لا نُدرك ولا نشعر بمعاناة الآخرين إلّا حين نتعلّم كيف نحبّهم.
* لماذا وصفتِ في الجزء الرابع نينو بأنّه شخص تافه وسطحي؟
– أردتُ أن احكي عن آثار السطحية حين تكون مرتبطة بثقافة متينة وذكاء واثق. نينو رجل سطحيّ من طراز رفيع. وهذا النّوع أعرفهُ جيدًا.
*في الجزء الأخير من السلسلة تأخذ الأحداث منحى مأساويًا للغاية، مع اختفاء طفل. هل كان هذا العنصر ضروريًا في الحبكة؟
– هنا سأمتنع عن الإفصاح عن أسبابي، أفضّلُ أن يشقّ القرّاء بأنفسهم الطريق داخل النص. أوضّح فقط أنه حتى قبل أن أبدأ الكتابة، كان هذا الحدث دائمًا من بين الخطوات الوحيدة المؤكّدة في مسار السرد الّذي كان في ذهني.
*تُغذّي ليلا نوعًا من الحماس تجاه الأجهزة الإلكترونية، الحواسيب وغيرها. إنّ استيعابها للتكنولوجيا، في أبعادها المنطقية، يبدو مفاجئًا بالنسبة لبطلة بمثل هذه البداهة؟ هل كانت تصرّفات ليلا غير قابلة للتنبؤ أكثر من لينا، أم أنّهما على نفس القدر؟
– لم يكن في نيتي أبدًا أن أرسم ليلا مفعمةً بالحماس. إنّها تستعين بذكائها، لسبب أو لآخر، في وجه كلّ ما يدخل في مجال الفعل الّذي تسمح به لنفسها، انطلاقًا من اللّحظة الّتي منعوها من إكمال الدراسة. ذلك لأنّ أباها كان إسكافيًا يزيّن الأحذية. وحين شرع إينزو في متابعة دروس من أجل الالتحاق بشركة “إ. ب. م”، بدأت هي تهتمّ بالإعلاميات. وعكس لينا، الّتي تستخدم معارفها لتخطّي الحدود والهروب من الحيّ حيث تقيم، مراهنةً بحماس على الكتابة، فإنّ ليلا تواجه ما يحدث لها في كلّ مرة بعبقرية، لكن من دون أن تذهب أبعد من إمكانياتها في هذا المسعى. ولتوضيح هذه الصفة أكثر، يمكن القول إنّ المشروع الوحيد الّذي يحمّس ليلا حقًّا على المدى الطويل هو حياة صديقتها.
في الغرب ما تزال الهيمنة
الذّكورية متجذّرة
*في “صديقتي المذهلة” تتصارع النساء، بينما يستفيد الرجال من هذا الصراع. كيف تنظرين إلى قضية واينستين والحركة الاحتجاجية التي وُلدت في تويتر من خلال حملة هاشتاغ “أنا أيضًا”؟
– أظنّ أنّ قضية واينستين ألقت الضوء على ما عرفته النساء دائمًا، أو على الأقلّ صمتنَ عنه. وبعيدًا عن المظاهر، حتّى في الغرب ما تزال الهيمنة الذّكورية متجذّرة. لقد عانينا منها جميعًا، في أماكن مختلفة كثيرًا وتحت أشكال عدة، خضعنا يومًا بعد يوم لمذلّة أن تكون المرأة ضحيّة بكماء، متواطئة مرعوبة أو متمرّدة صامتة، حين يرفضون النّظر إليها باعتبارها ضحية بدلًا من اتّهام المغتصبين. ومن المفارقة أنّني لا أرى اختلافات كبيرة بين نساء حيّ نابولي اللّاتي تحدّثتُ عنهن وبين ممثلات هوليوود أو النساء المثقّفات والراقيات اللّاتي يشتغلن في أعلى درجات نظامنا السوسيو- اقتصادي. لهذا فإنّ رفع الصوت وترديد شعار “أنا أيضًا”، يبدو لي شيئًا جيدًا، لكن فقط إذا حافظنا على معنى القياس، لأنّ التجاوزات قد تضرّ بالقضايا العادلة. إنّ قوّة هؤلاء الـ”واينستين” الصغار والكبار، سواء كانوا في مركز العالم أو في مكان هامشي، ليست في أنّهم لا يشعرون بأيّ خزي تجاه كل أشكال الاغتصاب المختلفة الّتي يسلّطونها علينا، ولكن في أنّهم يشعروننا أكثر، عبر آلية مثيرة للاشمئزاز، بأنّنا من يجب أن يُلصق بهنّ العار جرّاء ذلك.
*هل تؤمنين بولادة حركة نسوية جديدة، وُلدت من هذه الموجة من الاحتجاج العالمي، تستجيب لأمنياتك؟
– في السنوات الأخيرة، ثمّة بعض الازدراء ينتشرُ بين أجيال جديدة من النساء تُجاه نسوية أمهاتهن وجداتهن. هؤلاء الشابات لديهنّ اقتناع بأنّ الحقوق القليلة الّتي يتوفّرن عليها هي مكاسب طبيعية، وليست ثمرة معركةٍ ثقافية وسياسية صعبة. آملُ أن تتغيّر الأمور، أن يدركن أنّنا نعيش في وضع الدّونية منذ آلاف السنين وأنّ علينا أن نواصل الكفاح. إذا رمينا السلاح، سوف يمكنُ لأقلّ شيء أن يعصف بكلّ ما حقّقته أربعة أجيال من النساء، نظريًّا على الأقل، عبر تضحيات جسام.
*في رأيك، روايتك تنتمي إلى تقليد الأدب الشعبي، وذلك سيرًا على خطى ألكسندر دوما، غنيّة من حيث المغامرات والشخصيات، على خلاف المقاربة الحداثية، الأكثر اختزالية من حيث الخيال؟
– لا. أنا ألجأ أحيانًا إلى بعض أدوات الأدب الشعبي القوية. ومع ذلك، شئتُ أم أبيت، أعلمُ أنّنا نعيش في فترة مختلفة تمامًا عن تلك الّتي أدّى فيها هذا الأدب وظيفته. وبصيغة أخرى – رغم أنّ هذا مخيّب للآمال- لن أعرف بأيّ شكلٍ من الأشكال أن أكون ألكسندر دوما. فاستلهامُ التّقليد العريق للرواية الشعبية لا يعني ببساطة أن تكتب هذا النوع من النصوص السردية – سواءٌ كان ذلك أمرًا جيّدًا أو سيئًا -، ولكن ببساطة أن تضع هذا التّقليد كمرجع من خلال تعديله، وانتهاك قواعده وتضليل انتظارات القارئ، وكلّ هذا من أجل صياغة حكاية تنتمي لعصرنا. وحسب رأيي، الاغترافُ من الذخائر الأدبية العظيمة سواءٌ من الرواية أو الرواية المضادة هو معبرٌ واجب على كلّ شخص يدّعي أنّه كاتب. وعليه، نجد أنّ ديدرو كتب “الرّاهبة” لكنّه كتب أيضًا “جاك القدري”. ويمكننا أن نمحو خطوط الحدود بين التّجارب الأدبيّة المتباعدة عن بعضها البعض، واستعمالها بالتّناوب من أجل وضع شكلٍ مناسب للّحظة التاريخية الّتي نعيشها. وسواء كنّا نفضّل ثراء الأحداث أو الشخصيات أو الاختزالية، كما اقترحت، فإنّه إذا سلكنا فقط طريقًا واحدًا من هذه الطرق، سوف لن نذهب بعيدًا. يجب أن نخرج من الأقفاص عديمة الفائدة.
*لقد اعترفتِ أنّك اكتشفت فلوبير وأنت صغيرة السنّ في نابولي. متى إذن وقعتِ في حبّ كتاب أو شخصية، أو في حب الأدب بشكل عام؟
– نعم، أحببتُ مدام بوفاري كثيرًا. كنت طفلةً أمزج بين الحكايات الّتي أقرأها وشخصيات من قراءاتي بالعالم الّذي أعيش فيه، ولا أعلم لماذا، لكن “إيما” بدت لي قريبة من نساء كثيرات في عائلتي. لكن قبل ذلك بفترة طويلة، أحببتُ ” فتيات الدكتور مارش الأربع”، وخصوصًا “جو”. وهذا الكتاب هو الأصل في محبّتي للكتابة.
*هل تأثّرتِ بكاتبات، فرنسيات ربّما، مثل كوليت أو دوراس؟
– حين كنتُ طفلة، كنت أقرأ كلّ شيء، دون أيّ نظام ودون الوقوف عند أسماء الكتّاب، ولم يكن يهمّني إن كان الكاتب رجلًا أو امرأة. كنتُ معجبة بـ”مول فلاندرز”، “الماركيز دو مورتويل”، “إليزابث بينيت”، “جين إير”، و”أنا كارنينا”، لكن لم أكن أعير انتباهًا لجنس الكتّاب. لم أهتمّ بكتابات النساء إلّا لاحقًا، في نهاية السبعينيات. ولكي نقتصر على الكاتبات الفرنسيات، لقد قرأتُ تقريبًا كلّ ما كتبَت مارغريت دوراس. والكتاب الّذي اشتغلتُ عليه طويلًا هو كتابها “اختطاف لول في. ستاين”، إنّه الأكثر تعقيدًا من بين كتبها، لكنّه الكتاب الّذي بفضله نتعلّم الكثير.
*ما رأيك في الكتابة النسائية؟ هل هذا الصنف من الكتابة موجود حقًا؟ هل يمكن أن نضعه مقابل الكتابة الذكورية، مثلًا إلزا مورانتي في مواجهة إرنست هيمنغواي؟ وبالنسبة لأسلوبك في الكتابة، هل ترين أنّه يمزج بين القطبين، الذكوري والأنثوي؟
– بالتّأكيد، توجد كتابة نسائية، لأنّ الكتابة هي قبل كلّ شيء مشروطة بقوّة بهذا البناء التاريخي- الثقافي الّذي يسمّى “النوع”. ومع ذلك، يتشكّل النوع من شبكات تتّسع أكثر فأكثر، ومعاييره بدأت في التّراخي، ودائمًا من الصّعب إعادة بناء ما تأثّرنا به أو ساهم في تكويننا باعتبارنا كتّابًا. أنا مثلًا تعلّمت الكثير من الكتب الّتي أحببت ودرست، سواءٌ كتبها رجال أو نساء. ويمكنني أن أستعرض أسماء، لكنّني تأثّرت أيضًا وعميقًا بتلك الجمل الّتي أجهل مصادرها، الّتي يمكن أن يكون قائلها رجلًا أو امرأة. وباختصار، من الصّعب فهمُ كيف نتعلّم كتابة الأدب. هكذا أتفادى دائمًا القول بأنّ الكاتب الفلاني أو غيره هو من أثّرَ في تكويني. أتفادى خصوصًا القول بأنّ نصوص الكاتبات كان لها تأثيرٌ عليّ، رغم أنّني أحببتها كثيرًا وما زلت، مثل ” كذبٌ وسحر” لإلزا مورانتي. نحن نعيش فترة تحوّلات كبرى، وخطاب النّوع هنا لا يجازف فقط بأن يكون غير مقنع، بل يجازف بأن يستند على أسسٍ هشّة.
*ما الّذي يعجبك أكثر في الكتاب الذي تقرئين؟
– الأحداث غير المتوقّعة، عدم الاتّساق الحامل للمعنى، المسافات اللّامتوقعة داخل اللغة أو داخل نفوس الشخصيات.
*في الرواية، نجد أنّ الأمومة عدوّة للكتابة (لينا مشغولة بتربية طفلتها بحيث تفقد التّركيز الضروريّ للكتابة). ما هي أفضل شروط الكتابة؟ في العزلة؟ بعيدًا عن العالم؟ أم على العكس، تستلهمين من اللّقاءات، أو الوقوع في الحب، ربما؟
– حين نقع في الحب، نكتب بشكل جيّد! وبشكلٍ عام، إذا لم تخترقنا الحياة، عن ماذا سنكتب؟ أن تكرّس وقتك فقط للتّركيز على الكتابة هو طموح مراهقين، ومراهقين تعساء أيضًا. الحياة لا تكفّ عن خلخلة الكتابة، وبدون هذه الاضطرابات تصير الكتابة أتفهَ من رسمِ دوائر على صفحة الماء. ومع ذلك، للحياة أحيانًا قدرة تسونامي وبإمكانها أن تلتهم الوقت المخصّص للكتابة. وحسب تجربتي، من المؤكّد أنّ الأمومة لها القدرة على نفي الحاجة للكتابة. أن تخطّطي لولادة طفل، وتضعيه في العالم وتربيه هي تجربة رائعة ومقلقة، خلال فترةٍ ليست بالقصيرة، بحيث بإمكانها أن تسلب الفضاء والمعنى من كلّ ما تبقّى، خصوصًا إذا لم تكوني تملكين مالًا لشراء وقتِ وطاقة نساءٍ أخريات. ثمّ، بطبيعة الحال، إذا كانت حاجتنا للكتابة قويّة بما فيه الكفاية، سننتهي عاجلًا أم آجلًا إلى تنظيمٍ يمنحها قليلًا من الفضاء. لكن هذا يصحّ بالنسبة لكلّ التجارب الأساسيّة في الحياة: إنّها تطيح بنا وتأخذنا بعيدًا، ثمّ، إذا لم نسقط صرعى في ركنٍ ما، فإنّنا نكتب.
*هل انتهت حكاية ليلا ولينا؟ هل يبدو الأمر كما لو أنّك منحتِ حياة، ثم فجأة تشعرين بالفراغ، بالهجران؟
– استعارة الولادة الّتي تُطبّق على الأعمال الأدبية لم تُقنعني يومًا. تبدو لي استعارةُ النّسج أكثر توافقًا. الكتابة هي جزءٌ من مجموع هذه الأطراف الصناعية الّتي تجعل جسدنا أكثر قوّة. الكتابة هي مهارةٌ، وسيلة لتجاوز حدودنا الطبيعية. ويتطلّب الأمر تدريبًا طويلًا لاستيعاب هذه التقنيات، واستعمالها بحذقٍ متزايد دومًا، وأيضًا لابتكار تقنيات جديدة إذا اقتضت الحاجة. والنّسج يستحضر كلّ ذلك. نشتغل شهورًا وسنوات من أجل نسجِ نصٍّ واحد، بحيث نمنحه أفضل ما تستطيع ذواتنا في لحظة معينة. وحين ننتهي منه، ها هو هنا، متطابقٌ مع ذاته إلى الأبد، بينما نحن نتغيّر وسنتغيّر مرارًا، في وضع استعدادٍ لأن نخوض تجاربنا من جديد مع أعمالٍ أخرى.
*هل تفكّرين في كتابة تتمّة للرواية، أو حكاية موازية للمتن الأصلي؟
– لا، حكاية ليلا ولينا انتهت. لكن لديّ حكايات أخرى في ذهني، وأتمنّى أن أوفّق في كتابتها. ونشرها ربّما، لست أدري.
الصّداقة تشبه الحبّ
ولا تتعرّض مثله للتدهور
*روايتك هي مرافعة دفاعًا عن الصداقة أكثر من الحبّ نفسه، الّذي يبدو غير متوقع وسريع الزوال. في الحياة الحقيقية، هل تضعين الصداقة أيضًا فوق كلّ اعتبار؟
– نعم. الصّداقة تشبه الحبّ مع أنّها لا تتعرّض مثله للتدهور… هي ليست في موضع خطر بسبب الممارسات الجنسية، وبسبب هذا الخلط المحفوف بالمخاطر بين المشاعر واستعمال الجسد لمنح المتعة أو استقبالها. حاليًا صارت الصداقة الجنسية أكثر شيوعًا من الماضي، إنّها لعبة تقحم الأجساد والتجاذبات المنتخبة في محاولة لإبعاد سطوةِ الحب وروتين الجنس غير النّاضج. لكنّي لا أعرف ما هي عواقب ذلك.
*أسأل دائمًا كتّاب العالم أجمع عن المكان الذي يكتبون فيه، وآخرهم توم وولف الذي حدّثني عن اللّون الأزرق الخفيف الّذي يزيّن جدران مكتبه. هل يمكن أن تحدّثينا قليلًا عن ذلك، أو أن تذكري لنا بعض الأشياء العزيزة الّتي تضعينها بالقرب منك حين تكتبين؟
– أكتبُ حيثما أتواجد، ليس لديّ مكان محدّد. في الواقع، أحبّذ كثيرًا أن تكون الغرفة خالية، بجدرانٍ بيضاء أو عارية. ولكنّه أشبه بحلمٍ خياليّ أكثر منه ضرورة جمالية. حين أشتغل بشكلٍ جيّد، لا أتأخّر في نسيانِ المكان حيث أوجد.
[أجرى الحوار ديديه جاكوب ونشر في مجلة “لوبس”
الفرنسية بتاريخ 18 يناير/ كانون الثاني 2018]
المترجم: نجيب مبارك
ضفة ثالثة