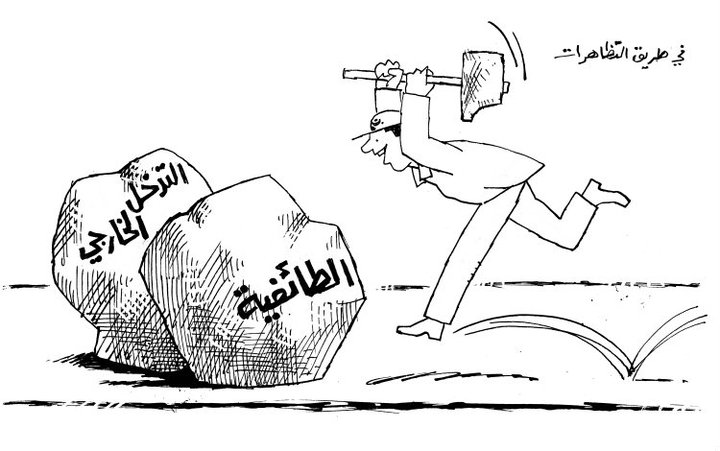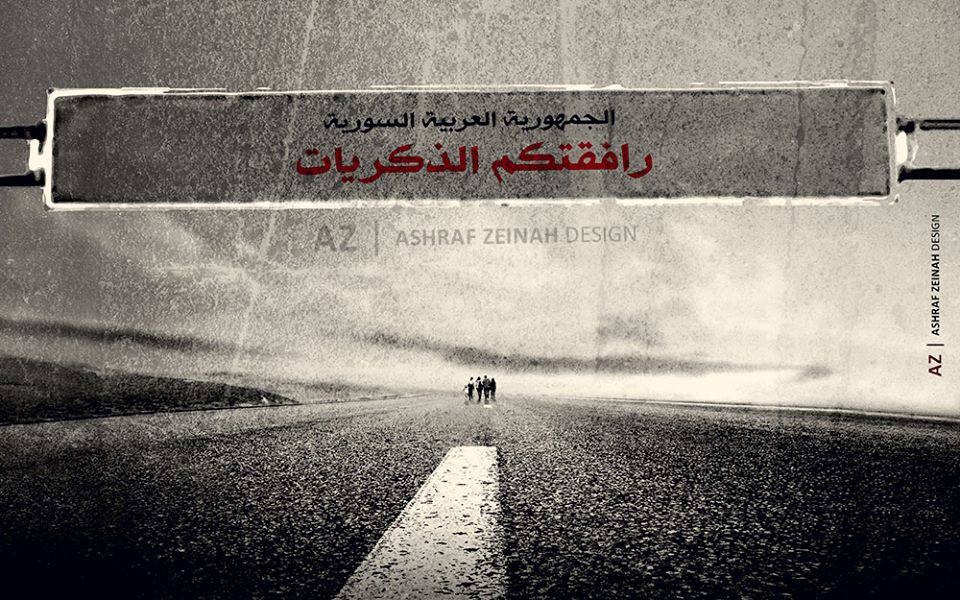الاحتلال الروسي والثورة السورية –مقالات مختارة-

لنجرّب الاحتلال/ عمر قدور
لم يكد مجلس الدوما الروسي يصوت بالموافقة على وجود روسي عسكري دائم في سوريا حتى أعلن نائب وزير الدفاع العزم على تحويل المنشأة البحرية الروسية في طرطوس إلى قاعدة دائمة. تصويت مجلس الدوما كان على اتفاقية غير محدودة المدة وقع عليها النظام السوري بالتزامن مع التدخل الروسي العسكري، لكن لهذا التصويت، في هذا التوقيت، دلالاته التي تذهب تحديداً إلى ترسيخ وجود روسي مستدام في سوريا، تحت ستار من “الشرعية” التي تمنحها الاتفاقية المذكورة.
هي الشرعية ذاتها التي كان يتحدث بموجبها مندوب النظام في مجلس الأمن، ويصل به الاستهتار لينسب لنفسه العضوية الدائمة، رداً على انسحاب أعضاء دائمين من الجلسة. لكن ما هو مطلوب من المعارضة يتعدى القول بعدم شرعية النظام، وتالياً عدم شرعية الاتفاقيات التي عقدها منذ اندلاع الثورة. فمثل هذا القول لا قيمة له طالما لم يُسند بجهد دؤوب لتجريد النظام من شرعيته القانونية أمام المجتمع الدولي، واستخدام حتى أقوال مندوبي الدول الغربية دائمة العضوية كحجج من أجل إثبات عدم أهليته وعدم تمثيله السوريين. ففي جلستي مجلس الأمن الأخيرتين كانت هناك اتهامات صريحة باستخدام الأسلحة الكيماوية، وحتى اتهام واضح بالاستهداف المتعمد لقافلة مساعدات أممية، فضلاً عن اتهام النظام بتغذية الإرهاب، وجميعها تصب في الطعن بأهلية النظام من حيث الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين، بوصف الأخير شرطاً أساسياً من شروط عضوية المنظمة الدولية.
بالطبع هناك ملف ضخم من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية يمكن استثماره لتبيان واقع حرب النظام على السوريين، وعدم أهلية تمثيله لهم. ولأن الطعن بأهلية المعارضة سهل أيضاً، جراء عدم سيطرتها المستدامة والآمنة على الأراضي، وتالياً عدم تحقيقها شروط ملء المقعد، لذا ينبغي أن تتوجه المعركة إلى تعليق عضوية سوريا في الأمم المتحدة ووكالاتها. وبحكم الوجود العسكري الروسي ومساهمته الحثيثة في الحرب على السوريين لا بأس في العمل على تحميل قوات الاحتلال مسؤولياتها القانونية، من خلال العمل على توصيفها كقوة احتلال بموجب القانون الدولي.
لا شك أن العضوية الروسية الدائمة في مجلس الأمن لن تجعل هذه المعركة سهلة على الإطلاق، لكن يمكن العمل بإصرار من خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة، ولو لم تمتلك قراراتها صفة الإلزام. المسألة تتعلق هنا بتجريد اتفاقية الاحتلال الروسي من الشرعية التي تمتلكها طالما بقي النظام يحظى بها، وعليها فإن كافة ممارسات الاحتلال الروسي محمية بموجب الاتفاقية التي تمنح كافة الجنود الروس حصانة من الملاحقة القانونية. المقارنة، ولو كانت نظرية بدءاً، هي بين قوة حليفة للنظام تحظى بحماية تامة بموجب قوانينه وبين قوة احتلال مسؤولة بموجب القانون الدولي، ويترتب عليها الالتزام المستقل بمسؤولياتها كقوة احتلال، وأيضاً بمسؤولياتها بموجب اتفاقيات جنيف المتعلقة بحالة الحرب.
مثل هذا السعي لن يخلي مسؤولية النظام عن جرائمه، فأن يصبح في موقع العمالة لمحتل لا يلغي مفاعيل الجرائم التي ارتكبها بقرار مستقل سابقاً، أو التي يرتكبها بالتنسيق مع قوات الاحتلال. ومع أن العديد من الحروب الأهلية قد شهد تدخلات أجنبية إلا أن الاحتلال الروسي الحالي لا سوابق له إلا في الحالات التي جرى توصيفها بالاحتلال، سواء على صعيد اللغة المتداولة دولياً أو على الصعيد الحقوقي. هكذا، على سبيل المثال، كان يوصف الوجود السوفيتي في أفغانستان، وهذا ما ارتضته الحكومة الأميركية ذاتها إثر غزوها العراق، على رغم أن نظام صدام حسين كان يشغل مقعد بلاده في منظمة الأمم المتحدة حتى سقوطه.
إن واحداً من المشاكل التي أحاطت بالقضية السورية يكمن في ذلك التهرب من إخضاعها لأي أساس قانوني، وما يترتب على هذا من التزامات. على سبيل المثال، منذ الأشهر الأولى للثورة بدأت أوساط قرار غربية بوصف ما يحدث بالحرب الأهلية، لكن لم يترتب على هذا الكلام السياسي اتخاذ خطوات جادة تجبر النظام على الالتزام بالبروتوكولات الإضافية لاتفاقيات جنيف، تحديداً المتعلقة بحالات الحروب الأهلية. بدورها تهربت المعارضة من هذا التوصيف وواظبت على إنكاره، فلم تسعَ إلى إحراج أصحابه بحثّهم على إقراره مع تبعاته في المنظمات الدولية، مع أن مثل هذه الخطوة تنال على الأقل من شرعية تمثيل النظام لمؤيدي الثورة.
الآن، لا تبشر الظروف كما يرغب البعض بحرب عالمية، لكنها أيضاً قد تكون مواتية لعمل سياسي مختلف عما قبل، عمل يطوي صفحة وعود الحل السياسي البائس، فضلاً عن انتفاء معنى الحل بوجود قوة احتلال شبه رسمية وقوة أخرى عبر ميليشياتها العديدة. العمل من أجل اعتراف المجتمع الدولي بوقوع سوريا تحت الاحتلال يغير من طبيعة حقوق السوريين نفسها، لأنها ستكون محمية وفق القانون الدولي بحق تقرير المصير، وبشرعية استخدام الوسائل السلمية والعسكرية لتحقيقه.
لقد دفع السوريون طويلاً ثمن خلط الأوراق من قبل العالم، فلا هو تعاطى معها كثورة شعب محقة تُقابل بوحشية منقطعة النظير، بل جرى خلطها عمداً مع قضية الإرهاب لتحويل الأنظار عن مشروعيتها. أيضاً، كان الحديث عن حرب أهلية سورية مجرد ذريعة لإثارة موضوع “حماية الأقليات”، فلم تنعقد النية أبداً لإيقاف “الحرب الأهلية” وحماية جميع أطرافها، أو تهديد مرتكبي جرائمها بمحاكمة دولية. اليوم يسعى الروسي أيضاً إلى خلط الأوراق، بتكريس احتلاله تحت زعم اتفاقية معقودة مع “حكومة شرعية”، أي يريده احتلالاً بلا أي ثمن وبالمقارنة تبدو سلطات الانتداب القديمة معتبرة جداً إذ كانت توثق استعمارها في عصبة الأمم. ضمن هذا الخلط المركب والمتعمد لن يعلن أحد عن وقوع سوريا تحت الاحتلال، ولا ضير في أن تبادر المعارضة إلى إعلان ذلك ومحاولة تثبيته كواقع قانوني حتى رحيل كافة القوات الأجنبية، أما رحيل المافيا العميلة فهو في جميع الحالات المشابهة مُتضمَن في رحيل الأولى لا العكس.
المدن
قيصرية بوتين: بربرية سكرى… يُراق على جوانبها الدم!/ صبحي حديدي
رغم أنّ شرائح واسعة في الشارع الروسي تعتبر فلاديمير جرينوفسكي مجرّد مهرّج يستخدمه الكرملين لتسخين الرأي العام الروسي، أو لجسّ نبض الاحتجاج والرضا، والحراك والركود، في الأوساط الشعبية الفقيرة بصفة خاصة؛ فإنّ حزبه القوموي المتطرف (وأولى العجائب أنّ اسمه «حزب روسيا الليبرالي الديمقراطي»!)، حلّ ثالثاً في الانتخابات التشريعية الروسية الأخيرة. جرينوفسكي، إلى ذلك، حليف موثوق/ تابع أمين لحزب «روسيا الموحدة»، الذي حلّ أوّلاً، ويُعدّ عملياً حزب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ومطية «الديمقراطية» الروسية ما بعد الرئيس الروسي الأسبق بوريس يلتسين (1931 ـ 2007)، وانتهاج بوتين مبدأ التناوب على الرئاسة مع ظلّه الطيّع ديمتري مدفيديف.
وجرينوفسكي لا يهدد خصوم «روسيا العظمى» بما هو أقلّ من السلاح النووي: قنبلة ذرية تبيد اسطنبول عن بكرة أبيها (أيام التوتر الروسي ـ التركي، السنة الماضية)؛ قنبلة أخرى تمحو، تماماً، جزيرة دونباس على الجبهة الأوكرانية (200 ألف نسمة)؛ وإذا لم يكن الدرس بليغاً بما يكفي لردع أمريكا وأوروبا، فإنّ برلين على مرمى الرؤوس النووية الروسية…! وهو لا يحثّ أمريكا على انتخاب دونالد ترامب، وليس هيلاري كلنتون، فحسب؛ بل يهدد بالويل والثبور: «فليدرك الأمريكيون الذين سيصوتون في 8 تشرين الثاني (نوفمبر)، أنهم يصوتون من أجل السلام على الكرة الأرضية إذا انتخبوا ترامب. لكنهم إذا انتخبوا هيلاري، فإنها الحرب. سيكون فيلماً قصيراً. ستكون هناك هيروشيما وناغازاكي في كلّ مكان».
ثمة بُعد تهريجي في سلوك، ومواقف وتصريحات، جرينوفسكي، لا ريب في هذا؛ غير أنّ الرجل، بما ينبش من أحقاد قوموية وانحيازات عنصرية، يزرعها في أذهان شرائح غير قليلة من الروس؛ وما يثيره في النفوس من نوستالجيا إمبراطورية (نموذجه الأعلى هو القيصر ألكسندر الثالث)؛ وما يترجم، على نحو فجّ وشعبوي وغوغائي، من سياسات بوتين… كلّ هذا، وسواه، يجعل منه ظاهرة تتجاوز، بكثير، مستوى التهريج والتنفيس وجسّ النبض. إنه ممثّل قطاع غير بسيط من أبناء روسيا المعاصرة، ممّن لا يكفيهم اليقين بحقّ الروس في استعادة أمجادهم السالفة وإحياء الرفعة الإمبراطورية القيصرية؛ بل تتناهبهم رغبات جارفة، متقاطعة ومتناقضة ومتصارعة، في تحقيق هذا الغرض عبر القوة والجبروت والهيمنة والتوسع…
وفي الخلفية الاجتماعية ـ الإيديولوجية، ثمة معركة حامية الوطيس، تحتدم في الخفاء تارة أو في العلن طوراً؛ بين استقطابين عملاقين تتمحور من حولهما وتلتقي فيهما، أو على النقيض منهما، جملة التيارات الشيوعية، والليبرالية، والاشتراكية الإصلاحية، و»اشتراكية السوق»، والنزعات القومية المعتدلة أو تلك المتطرفة. وكانت المعركة تصنع كلّ يوم، وتُبلور أكثر فأكثر، تيّارين مركزيين باتا جزءاً لا يتجزأ من الفسيفساء المعقدة التي رسمت قسمات روسيا ما بعد الحرب الباردة: الاستقطاب الاستغرابي (نسبة إلى الغرب)، والاستقطاب الأورو ـ آسيوي (نسبة إلى موقع روسيا الفريد على التخوم الحاسمة لقارّتين شهدتا وتشهدان أعمق الصراعات الحضارية على مرّ التاريخ).
ولكي لا يخوض المرء على الفور في المستنقعات العكرة لأطوار ما بعد الحرب الباردة (خصوصاً بعد أن تكفّل التاريخ ذاته بإلحاق الهزيمة النكراء بالنهايات التي سارع إلى تلفيقها أمثال فرنسيس فوكوياما)، تجدر الإشارة إلى أن هذين التيارين لم يولدا على حين غرّة. والباحث الروسي فلاديمير بيلينكين رصد الأجنّة الأولى منذ السبعينيات، في الأوساط الإيديولوجية والفكرية القريبة من المكتب السياسي للحزب الشيوعي السوفييتي والأجهزة البيروقراطية العليا، فضلاً عن الـKGB. وغنيّ عن القول إن هذين الاستقطابين كانا يتناميان في حاضنة مناسبة للغاية، أبرز عناصرها:
ـ قوّة عظمى تملك ثاني ترسانة نووية في العالم، ولكنها تنزلق رويداً رويداً إلى مصافّ المقاييس التقليدية لدولة عالمثالثية، في المستويات الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية، فضلاً عن سمات عديدة على صعيد الثقافة.
ـ إقتصاد نهض على التصنيع الثقيل، ولكنّ أساسه الوطني صار يعتمد على تصدير المواد الخام واستيراد المنتجات الغذائية المصنّعة، فتزايد ارتهانه للرأسمال الأجنبي والاستثمارات المتعددة الجنسيات.
ـ تباين صارخ في التوزيع الاجتماعي للثروة القومية، وشروخات حادة بين الأغلبية الأكثر فقراً وبؤساً، والأقلية المنعمة المنشطرة بدورها إلى كومبرادور رأسمالي متحالف مع الشركات الغربية العملاقة، وقطاعات طفيلية متحالفة مع المافيات الداخلية ومجموعات الضغط القوموية.
لكنّ المرتكز العقائدي للاستقطاب الاستغرابي الروسي بدأ من إعادة النظر في الثورة الروسية والطور السوفييتي بوصفهما إجهاضاً للمسار التاريخي الكوني الطبيعي الذي كان سيفضي بروسيا إلى النظام الرأسمالي، كما هي حال أوروبا والغرب إجمالاً. من هنا دعا هؤلاء إلى تصحيح ما أسموه بـ»الخطأ التاريخي» الفادح، والعودة بالاقتصاد السياسي والنظرية الاجتماعية إلى «الينبوع»: إلى آدم سميث ومفهومه للمجتمع المدني المنظّم ذاتياً، وإلى مدرسة شيكاغو الاقتصادية في أقصى تمثيلاتها اليمينية (جورج شولتز، وأضرابه). وبالطبع، لم يكن من هامش عند هؤلاء للتفكير في الديمقراطية بمعزل عن الليبرالية والسوق المنفلت من كل عقال، ولا مجال أيضاً لأية عقلنة في اقتباس الأنساق الثقافية السائدة في النماذج المعاصرة من المجتمعات الرأسمالية. وهكذا كان يتمّ استيراد الليبرالية والثاتشرية والريغانية والتفكيكية وما بعد الحداثة، تماماً كاستيراد سيارات المرسيدس والأوبرا الصابونية والـ»سيكس شوب» وعنف شوارع لوس أنجليس والبغاء المخملي.
ولكن خطّ التدهور الموضوعي الملازم لهذا الانفتاح البربري كان كفيلاً باستيلاد القطب الأخلاقي النقيض له، أي ذاك الذي يدغدغ «روح روسيا» وماضيها الأدبي والفكري والفنّي والعلمي. وهكذا فإنّ دعاة هوية روسيا الأورو ـ آسيوية لم يتورعوا عن وصف الحضارة الغربية بـ»الظاهرة الكولونيالية الإثنو ـ ثقافية»، التي تستخدم الاقتصاد والسياسة والثقافة والجيوش لإخضاع الحضارات الأخرى، وإجهاض مسارات تطورها الطبيعية. أكثر من ذلك، وبدل الذهاب إلى آدم سميث، توقف الأورو ـ آسيويون عند الأنثروبولوجيا الثقافية لكي يشددوا على أن الروس جزء رائد في عائلة الشعوب التي حكمت وجودها، وصنعت حضارتها، قيمٌ أخرى مختلفة عن تلك التي أشاعتها وفرضتها أوروبا «الرومانية ـ الجرمانية».
وفي الحصيلة، كانت أطروحات المستغربين تقرّب بيوتات المال والمافيا، وتنفّر عامة الشعب؛ وكانت أطروحات الأورو ـ آسيويين تفضي إلى العكس: إثارة حفيظة المستثمرين والصيارفة والليبراليين والتكنوقراط، واجتذاب سلسلة التناقضات العقائدية التي تجمع الحزب الشيوعي والحزب الزراعي وحزب جرينوفسكي القوموي العنصري… وفي القياس على الموقف من البربرية الروسية في حلب، على سبيل المثال الراهن الحيّ، ثمة إجماع عريض لدى غالبية واسعة، من أبناء العامة وأبناء الصفوة، الـ»موجيك» مثل الشاعر والسينمائي والتشكيلي، رجل الأعمال أسوة بالأكاديمي العالِم… أنّ القاذفات الروسية تدافع عن مجد روسيا، ولا ضير ـ هكذا حرفياً: نعم! ـ أن يُراق دم السوريين على مخاض تلك القيصرية البوتينية البربرية؛ ولا مشكلة، أخلاقية هذه المرّة، في أن يكون العنوان العريض هو خدمة نظام بدأ من الاستبداد والفساد، ويترنح وينتهي في غمرة جرائم الحرب بحقّ مئات الآلاف، وممارسة التطهير العرقي، وتشريد الملايين، وتسليم مقدرات البلد إلى دول وقوى وميليشيات خارجية.
هي قيصرية بوتينية تسكرها حال المتفرج مكتوف اليدين، التي تتخذها القوة العظمى الأولى، أمريكا. الأمر الذي لا يُسقط عن الكرملين صفة مخلوق ديناصوري نووي، مغترب عن هويته، رهين توصيف اختصره الجنرال ألكسندر ليبيد هكذا، ذات يوم غير بعيد: «روسيا ضائعة حائرة بين فكرتين: واحدة قديمة أسالت أنهاراً من الدماء، وأخرى جديدة لم تتحقق إلا على نحو رديء». يلزمها، استطراداً، المزيد من الدماء والجثث والأشلاء!
٭ كاتب وباحث سوري يقيم في باريس
القدس العربي
فيتو العار الروسي/ بشير البكر
صورة المندوب الروسي في مجلس الأمن الدولي، فيتالي تشوركين، وهو يرفع يده بإشارة فيتو ضد مشروع القرار الفرنسي الإسباني بخصوص معاناة حلب، لن ينساها السوريون، ومهما طال الزمن، وتغيّرت الأحوال، فإنها لن تسقط بالتقادم، بل ستبقى محفورةً في الذاكرة، شاهدا على إمعان الروس في قتل السوريين مع سبق الإصرار.
حسب الحسابات كافة، لا يوجد أي سبب يدفع الروس إلى اتخاذ هذا الموقف ضد شعبٍ أعزل محاصر، يعاني الموت جوعاً ومرضاً، لا يجد الماء ولا الدواء، وهناك 100 ألف طفل بلا حليب منذ عدة أشهر، حسب تقارير الأمم المتحدة التي أكدت أن من سوف يبقى من هؤلاء على قيد الحياة سيكون في وضعٍ صحيٍّ هش، وعرضةً دائمةً للأمراض.
يتحجّج الروس بأن الفيتو الخامس الذي اتخذوه، ليل السبت الماضي، ضد مشروع القرار الفرنسي الإسباني، هو من أجل محاربة الإرهاب. ولنفترض أن هذه الحجة صحيحة، فهل يبيحون لأنفسهم قتل 300 ألف مواطن في حلب، وتدمير المدينة من أجل معاقبة 900 من جبهة النصرة، حسب الأرقام التي أوردها مبعوث الأمم المتحدة ستيفان دي ميستورا؟. إذا كانت دولةٌ عظمى تمتلك حق الفيتو، مثل روسيا، تعطي نفسها حقّ التصرف على هذا النحو البلطجي، فهل يستقيم القانون الدولي، ويسري على الجميع، أم أنها ترتكب سوابق خطيرة، عن سابق تصميم، تجعل من المرجعيات الدولية لعبةً بيد من يمتلك القوة؟ وبالتالي، لا أهمية لأي قانون أو عدالة دولية، ولا مكان لأي أخلاق في حسابات البشر، ولا حاجة للأمم المتحدة، طالما أن قوة مارقة وضعت نفسها فوق كل مقياسٍ ومرجعيةٍ وحساب.
يقدّم الروس في سورية نموذجاً غير مسبوق على عدة مستويات، خصوصا في العنف الذي أوصلوه إلى مصاف من الوحشية، يتفوق على جرائم “داعش”. ويكشف منهج القتل والتدمير الاستعراضي في حلب عن عقليةٍ اجراميةٍ يقف العالم حيالها مصدوماً، حتى أنه يجد مقارنتها بالنازية أمراً لا يشفي الغليل، وقد أصبحت هذه القضية، منذ عدة أسابيع، الشاغل الأول للصحافة والمنظمات الإنسانية العالمية، فالمقارنة بين حلب وغروزني صارت منتشرةً على نطاق واسع، ونشرت الصحف العالمية بورتريهات لرئيس الأركان الروسي، فاليري غيراسيموف، الذي يطبق في حلب منهجه الذي استخدمه في غروزني، حين كان قائداً للحملة الروسية لإخضاع المدينة الشيشانية، وهو منهجٌ يقوم ببساطة على إلحاق أكبر قدر من الدمار بالمدينة، وضرب البنى التحتية، واعتبار كل ما يتحرّك على الأرض هدفاً عسكرياً، ووصفته صحيفة الفيغارو ب”البارع في أساليب القتل البدائية”.
وتقود أسلحة القتل البدائية إلى مسألة أخرى، لا تقلّ فداحةً من القتل، وهي احتقار الروس الشعب السوري، من خلال العمل على إعادة تمكين بشار الأسد وعصابته من حكم سورية، بعد أن كان قد أصبح خارج الحساب منذ عام على الأقل، وبدلاً من أن يُساق هؤلاء إلى محاكم جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، تقوم روسيا بإعادة تعويمهم، وكأن شيئاً لم يحصل، غير عابئةٍ بأرواح قرابة 600 ألف قتيل ومليوني معاق وعشرة ملايين نازح ومهجّر. لا يمكن وصف ذلك بأقل من مشاركة للنظام في الجريمة. ولذا بات السوريون يضعون فلاديمير بوتين بمصاف الأسد، ويتعاملون مع روسيا قوة احتلالٍ بدأت، في الأسبوعين الأخيرين، بتعزيز وجودها العسكري باتفاقاتٍ، وبناء قواعد بحرية وجوية، لتستمر إلى أمد طويل.
اللافت أنه ليس جهاز بوتين السياسي والعسكري وحده من يبدو مصمماً على قتل السوريين حتى النهاية، بل تقف إلى جانبه ترسانة من المحللين السياسيين الروس على الفضائيات العربية، أغلبهم ضباطٌ سابقون في جهاز كي جي بي، إلى حد أننا نجد أنفسنا أمام نسخةٍ جديدةٍ من الاتحاد السوفييتي السابق الذي كان حليفاً للأنظمة الاستبدادية في العالم.
العربي الجديد
سورية واحتمالات ما بعد الفيتو الروسي/ سميرة المسالمة
لا مفاجآت تذكر في الجلسة التي عقدها مجلس الأمن الدولي السبت الماضي، فكلا المشروعين الفرنسي والروسي كان على قائمة الرفض بين الفريقين المتضادين في الرؤية والهدف. ولعل هذا ما عبر عنه صراحة ممثل روسيا، وهو رئيس الدورة الحالية للمجلس، في وصفه الجلسة بأنها «واحدة من أغرب الجلسات التي تعقد»، إذاً يعلم المجتمعون سلفاً أنهم لن يقرّوا أي مشروع مقترح.
فبينما سعى الطرف الفرنسي ومن سانده إلى فرض هدنة في حلب قد يمكن لها أن تمتد لتشمل باقي سورية، بحيث تكون معبراً للدخول إلى حلبة التفاوض السياسي مجدداً، كان الطرف الروسي يسعى إلى فرض شروطه داخل حلب لتمكين النظام من العودة إليها للاستحواذ على طاولة تفاوض شبه خالية من طرف متعادل معها بالقوة العسكرية أو الديبلوماسية.
رغم ذلك، لا بد من المصارحة بأن النقاط المشتركة بين المشروعين كانت أكثر من نقاط الخلاف في مضمونهما، إلا أن حال الاستقطاب من جهة، والتعالي والغطرسة الروسية والتسلط، والشعور بالشبه وحتى التماهي بين النظامين الروسي والسوري، وكسر الثاني (السوري) لإرادة الولايات المتحدة والدول الأوروبية بدت بمثابة رسالة للأول أي (الروسي)، أبعدت تماماً فكرة الوصول إلى مشروع مشترك كان من شأنه أن يعيد لمجلس الأمن بعضاً من تسميته في الحفاظ على ما تبقى من الأمن الدولي وأمن المنطقة.
أمام هذا الواقع الأممي الجديد، تعود الخيارات المفتوحة على كل الاحتمالات إلى الواجهة، والتي يأتي من ضمنها تراجع الإدارة الأميركية عن سياساتها التي أوحت بتركها منطقة الشرق الأوسط، ومنها سورية، للروسي مع بعض المساحات للشرطي الإيراني، فيما اعتبر بمثابة استدارة منها إلى مناطق جديدة أكثر مردودية عليها من الناحية الاستراتيجية، اقتصادياً وسياسياً وأمنياً. ويفهم من ذلك أن ما اعتبر بمثابة استدارة أو تخلّ عن المنطقة من قبل الولايات المتحدة كان موضع جدل، إذ ثمة من رأى أن في ذلك نوعاً من الاستدراج أو التوريط لروسيا لدفعها إلى الانغماس في مستنقع الحرب السورية لاستنزافها وإنهاك قواها العسكرية والديبلوماسية، فيما الولايات المتحدة تراقب من بعد من دون أن تتكلف شيئاً.
وفي هذا الإطار تحديداً، فإن وجهة النظر هذه تعتقد بأن هذه الاستراتيجية (الأميركية) وصلت حدّها الأقصى، أو أنها استنفدت أغراضها، بحيث بات ينبغي التعامل بطريقة مختلفة عن السابق، لا سيما ما يتعلق بتحجيم الدور الأوروبي في الصراع السوري لمصلحة الاستفراد الروسي، أو أن رغبتها في مزيد من الوقت لاستمرار الصراع لن تتحقق في ظل التورم السرطاني للرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي يرى إمكان الحسم العسكري سريعاً للقضاء على معارضة مدعومة بالصمت الأميركي فقط، أي من دون دعائم حقيقية تقوي واقعها العسكري، ما من شأنه خروج الوضع على السيطرة ووضع الموقف الأميركي ومعه الأوروبي في مكانة حرجة أمام الغطرسة الروسية التشبيحية.
بناء عليه فإن الافتراق الأميركي – الروسي، بخاصة صلف بوتين وتصعيده العسكري على الأرض، يبدو أنه وضع الإدارة الأميركية أمام لحظة الحقيقة، في بحثها على انتهاج خيارات أخرى غير التي عودتنا عليها سابقاً، وإن كانت ستبقى في دائرة الردود المحدودة عسكرياً، على ما أعتقد، ومن ضمنها:
أولاً: إبداء مزيد من الضغط على روسيا بالوسائل السياسية والديبلوماسية، وربما تذهب بعيداً من مجلس الأمن الدولي الذي تملك روسيا مفاتيحه بالتساوي مع الدول الأعضاء الدائمة، عبر التوجه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة لاتخاذ قرار تحت بند «الاتحاد من أجل السلام» بغرض انتزاع موافقة أكثر من ثلثي الأعضاء، على ما تريده في سورية، وبهذا تكون الإدارة الأميركية أيضاً استرجعت الدور الأوروبي في الملف السوري، وربما تذهب نحو فرض مزيد من العقوبات الاقتصادية على روسيا تجعل موقفها أكثر ضعفاً أمام الرأي العام الروسي.
ثانياً: التعامل بجدية مع متطلبات «الجيش الحر» تأمين سلاح نوعي محدود من شأنه تشكيل تهديد حقيقي لقوات النظام وروسيا وإيران، وإعادة بعض التوازن إلى الصراع الدائر. وبداهة أن هذا تحديداً يستوجب إجراءات مقابلة من فصائل «الجيش الحر» وبعض الفصائل الإسلامية المعتدلة المدعومة من جهات عربية أو غيرها، تتمثل بتلبية النداءات التي وجهتها إليها المعارضة السياسية المتمثلة بالائتلاف وبعض مكونات الهيئة العليا للتفاوض بتوحيد قواها والانضواء في «الجيش السوري الحر»، متجاوزين بذلك سياسة الفصلنة والشعارات المتنوعة لمصلحة السعي إلى دولة سورية ديموقراطية متعددة للمواطنين الأحرار تحت علم الثورة معلنين وقوفهم مع القيادة السياسية في رؤيتها للحل السياسي المنشود.
ثالثاً: ضمن حملة المراجعات في الموقف الأميركي تجاه القضية السورية لا يمكن للولايات المتحدة تجاهل القوى الإقليمية والعربية وضرورة إشراكها في صناعة الحل السياسي لأن الصراع الدائر بات أوسع من كونه قضية داخلية سورية، فهو الآن قضية إقليمية عربية ودولية بامتياز وصلت شظايا انعكاساتها إلى الجميع بلا استثناء.
رابعاً: مع استبعاد تدخل أميركا في حرب مباشرة على النظام، فإن التطورات الأخيرة من شأنها أن تشجع الولايات المتحدة على القيام بتحرك ولو محدود يلحق خسائر مؤلمة بالنظام ومن خلفه روسيا، وهو الأمر الذي حاولت الولايات المتحدة تجنبه، رغم أنها دأبت في تصريحات متضاربة على عدم نفيه بالمطلق، علماً أن ذلك قد يستدرج في المقابل رد فعل روسياً، ربما يأتي بدوره بتصعيد أميركي. وعموماً فإن ذلك كله سيتوقف على الأرجح على ردة الفعل الروسية إزاء التغييرات في الموقف الأميركي.
خامساً: طي ورقة التفاوض (في جنيف) بينما تستنزف كل القوى إمكاناتها عسكرياً وديبلوماسياً بحيث تكون أكثر استعداداً لقبول خيار المبعوث الدولي للمشاركة في حكومة انتقالية تبقي على النظام أو تعيد إنتاجه، حتى مع إنهاء حكم بشار الأسد شخصياً، علماً أن هذه مسألة من المبكر التحدث بتداعياتها، إذ إن ذلك يعتمد على مآلات التجاذب بين الرؤيتين الأميركية والروسية، كما يعتمد على كيفية إنهاء حكم الأسد.
أمام هذه الاحتمالات كلها ومردوداتها الكارثية، باعتبارها تثقل على الثورة السورية، بعد كل المداخلات التي أحاطت بها، يبقى هناك مجال لحركة المعارضة السورية، إن أقلعت عن الجمود، وأحسنت التصرف، بحيث تسعى إلى حسم أمرها وترتيب بيتها، وتشكيل قيادة سياسية – عسكرية تستحوذ على ثقة أوسع قطاع من السوريين لفرض حل سياسي عادل لا يهدر تضحياتهم ولا يبدد حلمهم بإقامة دولة الحرية والعدالة والمواطنة المتساوية والديموقراطية.
هكذا تبدو خيارات السوريين معارضة ونظاماً شبه معدومة، على ما نلحظ، فالمعارضة بفعل العوامل الذاتية والمداخلات الخارجية تبدو قدراتها أقل من محدودة، وتتمثل في خيار واحد لا ثاني له هو تجاوز حال الانقسامات السياسية والعسكرية وتوضيح مواقفها من كل دخيل على ثورتها، بحيث لا يصبح ذلك عبئاً عليها وتتحمل كوارث ارتباطاته مع مشاريع غير سورية، ويجبرها على فتح جبهة جديدة إضافة إلى جبهتيها مع النظام و «داعش». وعليه يتوجب أن تحمل المصارحة بين قوى المعارضة مشروعاً سياسياً واقعياً يبعد كل العناصر غير السورية ويوفر خيارات الانضواء للسوريين في جيش حر واحد، وفي مشروع واحد يستعيد الأهداف الأولى للثورة السورية كثورة وطنية ديموقراطية تفتح على دولة مواطنين أحرار ومتساوين.
في المقابل أيضاً فإن النظام في تعنّته ورفضه تقديم أي بوادر لحل سياسي مقبول، ومضيه في تسليم البلاد لقوى روسية وإيرانية وميليشيات طائفية، يبدو فاقداً للخيارات ليبقى مقيّداً بمزاجية بوتين الذي لن يتوانى في لحظة المقاربات المقبولة روسياً تركه يتهاوى عسكرياً وديبلوماسياً كما الحال اليوم اقتصادياً.
الحياة
لماذا تعثّر البديل السوري روسياً؟/ ميشيل كيلو
في واحدة من زيارات المعارضة السورية إلى موسكو، كان وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، يسأل من يقابلهم: هل لديكم علاقة مع الجيش والأمن تمكّنكم من ضمان ولائهما لكم؟ وهل يمكنكم إدارة البلاد بطرق منظمة وشرعية، إذا قرّرنا التخلي عن الأسد؟ هل لديكم، في المقابل، “مونة” على الجيش الحر ومقاتلي التنظيمات المتطرّفة تمكّنكم من إقناعهم بِ، أو إرغامهم على، احترام نظامكم الجديد، واستعادة الأوضاع الطبيعية في البلاد، وحماية جميع مكونات شعبكم، وصيانة مؤسسات الدولة ورعاية المجتمع، وحماية جيرانكم والعالم من فلتان القوى المسلحة المتناقضة والمتصارعة التي، إن تصارعت على السلطة، انخرطت في صراعٍ سينتج حالات عنفٍ قد تجدّد الحرب في سورية، وتفجّرها في البلدان المجاورة ثم في العالم، إذا ما رجحت كفة التنظيمات المتطرّفة، ووجد الجوار السوري نفسه مجبراً على العودة من جديد إلى سورية، وتسبّب في مشكلاتٍ يصعب حلها، ستكونون أول من يدفع ثمنها الفادح الذي ستنتجه مصالحها المتناقضة وخلافاتها؟
لم يتوقف لافروف عند الجانب الحقوقي من الحدث السوري، الخاص بشرعية ثورة الحرية وحق الشعب السوري في تقرير نمط نظامه، ولم يكترث لضياع شرعية النظام، ورأى الوضع السوري بعين بلاده وبدلالة مصالحها. لذلك، وبدل أن ينطلق في موقفه من الإقرار بحقوق السوريين، وشرعية ثورتهم، نظر إلى النظام البديل الذي يطالبون به بمنظارٍ يرى مصالح (وصراعات) الدول الكبرى وحدها. لذلك أخبر محادثيه أنهم لن يحافظوا على مؤسسات النظام، في حال وقع التغيير الذي يطلبونه، الأمر الذي ستترتب عليه مشكلاتٌ خطيرة بالنسبة
“تقاسمت واشنطن الهموم الروسية، في ما يتصل بقدرة الثورة على تقديم بديل فاعل للأسدية، وبالموقف منها جهةً تضمن مصالح دولية، يرجّح أن تضيع، في حال تسرّع العالم في التخلي عن الأسد، أو مكّن الثورة من إسقاطه” لمن يحتاج إليها، وخصوصاً روسيا التي تواجه تحدياتٍ خطيرة، بينما تمر بمرحلة تحولاتٍ هيكليةٍ تتحدّى استقرارها، وتنقلها من نظام اقتصادي/اجتماعي/سياسي إلى نقيضه، في ظروفٍ تتعثر فيها بناها الجديدة، وتواجه ظروفاً دولية غير ملائمة، ذات نتائج بعيدة المدى، وغير مسيطر عليها، بالنسبة إلى أوضاعها، بما أن من يصنعها هم خصومها الغربيون.
بميلنا إلى رؤية الخارج، بدلالة الطابع الشرعي لثورتنا ووضعنا الذاتي، وميل لافروف إلى رؤية أوضاعنا بدلالة تناقضات وتشابكات تمسّ، في رأيه، بمصالح الخارج عموماً، وروسيا خصوصاً، تحول كل حديث مع لافروف إلى حوار طرشان. يتحدّث عن موضوعين مختلفين أشد الاختلاف. ومع أن بعض المعارضة عرض عليه تعاوناً مفتوحاً يعطي روسيا الحق في استخدام الموانئ السورية، وفي بناء جيشها الوطني الجديد، وإعادة إعمارها، فإن عروضه لم تلق آذاناً صاغية لدى وزير الكرملين الذي كرر دوماً أن مشكلات سورية ستستمر وتتصاعد، في حال انتصرت الثورة، وستمثل تهديداً للوضع الدولي، ولعلاقات بلاده بالدول الغربية، وستنزل بها قدراً كبيراً من الضرر، وستضرّ بقدراتها وعلاقاتها الخارجية، وما تنتهجه من سياسات. كان لافروف يخشى أن تضعف أية خطوةٍ يقوم بها لصالح الثورة مكانة روسيا في سورية، المضمونة بنظام أسدي يخدم مصالحها القومية، عبر محافظته على مؤسساتٍ لعبت دوراً مهماً في بنائها، تخشى موسكو أن يقوّض غيابها قدرتها على استعادة الموقع الذي ستخسره بتخليها عن الأسد، في ظل منافسةٍ شرسةٍ مع أميركا والدول الغربية التي يرجّح أن تحتل مكانتها في دمشق، فليس في وسعها التخلي عن نظامٍ قاتل، لكنه يخدمها، في وضع دوليٍّ ليست موسكو الطرف الذي يضبط توازناته، ويوجه تطوراته، ويرجّح أن تزيده خسارة سورية ضعفاً على ضعف. من جانبها، تقاسمت واشنطن الهموم الروسية، في ما يتصل بقدرة الثورة على تقديم بديل فاعل للأسدية، وبالموقف منها جهةً تضمن مصالح دولية، يرجّح أن تضيع، في حال تسرّع العالم في التخلي عن الأسد، أو مكّن الثورة من إسقاطه.
والنتيجة، وازنت روسيا بين مصالحها وحقوق الشعب السوري، فتمسّكت بالنظام الأسدي، وزاد من دعمها له أن المعارضة لم تقم بأي جهدٍ لكسب جيش النظام وأمنه، أو لاختراقهما، وبناء بديل لهما، إلى جانب إلزام الجيش الحر بخياراتها وقبوله بقيادتها، وإضعافها التنظيمات المتطرّفة وتهميشها، ووضع حد للخلافات التي استهلكت قواها، ودار معظمها حول محاصصاتٍ تتصل بتياراتٍ متناقضةٍ أرادت السيطرة على مؤسستها الرسمية، المعترف دوليا به، مؤسسة الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية التي لعبت انقساماتها وصراعاتها دوراً خطيراً في ما أصابها من شلل وعطالة، وعزلةٍ عن الشعب. بسلبيتها حيال مشكلات الثورة، تعزّزت الهوة بين المعارضة والداخل، وتفاقمت مشكلاتها مع الخارج، وزاد طينها بلةً اعتقادها أن القبول بالحل السياسي ومفاوضات جنيف هما كل المطلوب منها ، وأن القرارات الدولية الخاصة بالحل تعطيها السلطة، وإن كان العالم غير مقتنع بأهليتها، ومؤمناً بعجزها عن نقل سورية إلى نظام بديل، وبأن أي حل سياسي سينقلب إلى مشكلة دولية، وسيطلق صراعاتٍ لا مصلحة لأحد فيها. لذلك ابلغ المعارضين مرات عديدة أن بلاده قرّرت عدم الموافقة عليه، ولتذهب حقوق السوريين وثورتهم إلى الجحيم.
لم تقبل روسيا إغراءات المعارضة الوهمية، وفضّلت التعامل مع النظام، باعتباره حليفاً يجب دعمه ضد معارضيه الذين فشلوا في تحويل أنفسهم إلى بديل له، وانحازوا إلى خصمها الأميركي، وعجزوا عن توحيد الجيش الحر والفصائل العسكرية، وعن إخضاعهما لقيادة سياسية/ ميدانية مشتركة، فلا عجب أن موسكو لم تجد نفسها مجبرةً على تغيير مواقفها
“توهمنا أن روسيا التي قطعت علاقاتها بالشيوعية صارت حقاً نصيراً للديمقراطية، سيضع حريتنا فوق مصالحه” وخياراتها منا، وعلى أخذنا بجديةٍ وقبول مطالبنا، وبالتالي، تغيير موقفها من النظام الأسدي، تحت ضغط خطواتٍ تستكمل من خلالها شرعية الثورة الوطنية والديمقراطية القانونية التي سيكون من الصعب عليها تجاهلها، وإلا خسرت مكانتها في بلادنا ومصالحها فيها، بانتقالنا من سياسةٍ تستند على فكرة الحق إلى واقعٍ نتحكّم بمفاصله، ونسيطر عليه، يقنع العالم بقدرتنا على تحقيق مطالبنا، وبأننا الطرف الذي يضمن مصالحه.
بالقطع مع طريقةٍ ألفنا النظر إلى أمورنا من خلالها، غربتنا عن واقعنا، وحالت بيننا وبين القيام بأفعال منسقة ومنظمة، قادرة على ردم الهوة بيننا وبين مجتمعنا، وتصحيح أولوياتنا، فلا يأخذنا تفكيرنا الحقوقي إلى خارج السياسات الدولية وواقعنا في آنٍ معا، ونخرج مما نحن فيه كشكّائين شكاكين، يكتفون بمواقف تنوس بين إدانة العالم وتجريمه وبين شتمه بأشنع الألفاظ، كما نفعل كل يوم.
أدرك الروس عجزنا، فتجاهلوا حقوقنا. وكنا نتوهم أن معسول وعودنا سيقنعهم بتأييدنا، وحين بانت عبثية سلوكنا التي أقنعتنا أننا ما زلنا نتعامل مع الاتحاد السوفييتي، أو مع شيوعيين يؤمنون بحق الشعوب في اختيار نظامها السياسي/ الاجتماعي، وتقرير مصيرها بنفسها، لم نراجع أنفسنا، ربما لأننا لم نفهم أن الدول تسيرها السياسات التي تعود بأقل ضرر على مصالحها، وفاتنا أن العالم أدار ظهره قرناً وربع القرن لحقوق الفلسطينيين ولقراراته الدولية بشأنها، وتوهمنا أن روسيا التي قطعت علاقاتها بالشيوعية صارت حقاً نصيراً للديمقراطية، سيضع حريتنا فوق مصالحه. وحين تبين لنا أنها لن تفعل، قاطعناها وأعلنا العداء لها، بدل أن نرسي حقوقنا على أرضيةٍ ثوريةٍ، لا تترك لها خياراً غير مراجعة موقفها بما يخدم أهدافنا، لأن تحقيقها يخدم مصالحها، بعد أن صار لها أنياب توجع من يتجاهلها.
بدل أن نصحح، نحن في المعارضة السورية، أخطاءنا التي انتقدتها أميركا مراراً وتكراراً، طالبنا الروس بالتخلي عن مصالحهم وتبني مواقف من النظام مطابقة لموقفنا، وحين رفضوها، توطّدت ورطتنا التي لم نخرج منها إلى اليوم.
العربي الجديد
إمبريالية بالتأكيد/ سلامة كيلة
أتحدّث عن روسيا، حيث كل ما تفعله في سورية يؤكد هذه السمة التي باتت تحوزها، فقد استخدمت أرقى الأسلحة التي تحوزها، وأكثرها فتكاً وتدميراً، وهي تقتل المدنيين بشكل مقصود، وتدمر المشافي والمدارس وتقصف الأسواق الشعبية. وتتمسّك بسلطةٍ تعرّضت لثورةٍ شعبيةٍ هدفت إلى “إسقاط النظام”، بعد أن نهب واعتقل ودمّر التعليم وفرض سيطرة فئة عائلية مافياوية على الاقتصاد. وشارفت على تغييره، قبل أن تتدخل إيران وأتباعها، وقبل أن تغزو هي سورية.
تهدف أحدث الأسلحة التي تستخدمها في قتل الشعب إلى تخويف العالم، وهي باستعراضها العسكري الوحشي تريد أن تُظهر قوة سلاحها ومقدرته على الفتك، وذلك كله ليس فقط من أجل الحفاظ على نظامٍ رفضه الشعب فقط، بل من أجل تسويق أسلحتها، وزيادة تصدير السلاح أساساً في تحقيق ربح شركات السلاح الخاضعة للدولة، حيث إنها تقوم بإظهار قدرة التكنولوجيا المتطوّرة التي تستخدمها من أجل إيجاد زبائن لهذا السلاح. وقد أظهرت السنة الأخيرة أن مبيعها من السلاح قد زاد، وأنها باتت الدولة الثانية في بيع السلاح بعد أميركا، حيث ارتفع مبيعها إلى 15 مليار دولار (و36 ملياراً لأميركا). وهي تنشط كإمبريالية لتوسيع سوقها، خصوصاً في ما يتعلق بالسلاح الذي هو الإنتاج الأهم في منظومتها الصناعية، وهو السلعة الوحيدة التي يمكن أن تنافس بها في السوق العالمي، والذي يفتح لها أسواقاً تستفيد منها في تحقيق التراكم المالي، فهي تعاني من ضعف الصناعة، وعدم قدرتها على المنافسة في السوق العالمي، حيث لم تسعَ دولة بوتين إلى دعم تحديث الصناعة، بل اكتفت بتصدير النفط والغاز، وتسعى إلى تصدير السلاح، وتصدير الرأسمال كذلك، حيث تنشط المافيا التي نهبت الاقتصاد السوفييتي.
“قرّرت روسيا أن بقاء بشار الأسد ضرورة، ولا يمكن التخلي عنه، وهي تسعى، كإمبريالية، إلى فرض ذلك بكل القوة التي تستطيع”
قال بوتين مرة إن ما يقوم به في سورية هو “تدريب” عسكري، ما يعني أنه يدرّب جيشه بـ “اللحم الحي” للشعب السوري، وهو بذلك يمارس أقسى ما تمارسه إمبرياليةٌ لا تأبه لوضع الشعوب، ولا يهمها كم قتلت، بل يهمها أن يظهر جيشها بكامل جاهزيته. هل من وحشيةٍ أسوأ من ذلك؟ ربما فعل هتلر ذلك، وربما فعلتها الدول الإمبريالية، وهي تحتل الأمم المتخلفة. حيث كانت المصالح فوق البشر. الربح فوق الشعب، كما أشار نعوم تشومسكي في عنوان كتاب له. لهذا، تدرّب روسيا جيشها في مواجهةٍ مباشرة مع الشعب السوري، وبالتالي، تجرِّب كل أسلحتها الجديدة والمستجدّة، وتراقب كل عمليات التدمير والقتل التي تطاول الشعب السوري، فهي تريد “التدريب”، لكي يكون جيشها قادراً على السيطرة على العالم.
كل هذه الدموية التي تمارسها الإمبريالية الروسية، والتي فاقت ممارسة الإمبريالية الأميركية في العراق، هدفها “التدريب” إذن. لكنها في الواقع هدفت إلى إظهار “تفوّق” السلاح الروسي في الاستعراض العالمي لبيع السلاح، فبدل أن ترسل طائراتها وصواريخها إلى المعارض الدولية، نجدها تقوم بذلك بـ “الرصاص الحي” في سورية. ولهذا، تهافتت عليها دول عدة، تريد تدمير شعوبها من أجل شراء السلاح “فائق التطور”، بالضبط لأنه يقتل عشوائياً، ويدمر المشافي والأسواق والمدارس. تميل النظم إلى شراء السلاح الأكثر فتكاً، وروسيا تُظهر هذه السمة في سلاحها. وبالتالي، ربما تتجاوز أميركا في مبيعات السلاح، بعد أن ظهر أنها لا تنتج سلعاً قابلةً للتصدير غير السلاح، وأنها تمارس كل الوحشية التي يريدها رأسمالٌ مأزوم، وعلى حافة الهاوية.
ولكي تُظهر قدرتها، ولكي تخيف العالم، كي يقبل بها القوة المهيمنة بلا منازع (أو ربما بالتوازي مع أميركا)، تسعى روسيا لكي تقرّر وتفرض ما قرّرته، تسعى إلى أن يعلم العالم أنها تفرض ما قرّرته، وبالتالي، لا تقول ما لا تفعله. قرّرت أن بقاء بشار الأسد ضرورة، ولا يمكن التخلي عنه، وهي تسعى، كإمبريالية، إلى فرض ذلك بكل القوة التي تستطيع، من أجل أن تُفهم العالم أن قرارها هو الذي يجب أن يُنفَّذ، وأن ما تقوله هو الذي لا بد من الالتزام به، فهي القوة العظمى (وربما تتوهّم أنها الوحيدة). إنها تتمسك ببشار الأسد، ليس لأنها تخاف انهيار النظام الذي بات قراره بيدها، بل تريد أن يعرف العالم أنها التي تقرّر وتفرض. وذلك كله في إطار منظورها، لكي تصبح الإمبريالية المهيمنة بعد أن ضعُفت أميركا، وتراجع وضعها. ولهذا، نجدها مصممةً على حسم الصراع بالقوة، حتى وإنْ كلّف ذلك دمار مدن وقتل مئات آلاف الأطفال والنساء.
هذا ما يظهر واضحاً في حلب، حيث عادت لتمارس كل وحشيتها، ولتستخدم أسلحةً جديدة أكثر تدميراً، بعد أن كانت قد بدأت في استخدام أسلحةٍ أكثر فتكاً. إنها إمبريالية الأرض المحروقة والمدمرة التي ولا شك تخيف وحشيتها شعوب العالم، ولا شك في أنها ستوضع جانب الإمبريالية الأميركية في الوحشية لتحقيق مصالح مافيات حاكمة.
بالتالي، كل ما تمارسه في سورية هو هذه العنجهية التي باتت تحكم طبقة مافياوية مسيطرة، لكنها ضعيفة في إطار التكوين الإمبريالي العالمي، نتيجة عجزها عن المنافسة في السوق، كما تفعل الصين. ولهذا، تميل إلى التشدّد ومحاولة فرض رؤيتها بالقوة، وتريد الاستحواذ على الأسواق وفرض مصالحها على الشعوب، من دون أن تكون في وضعٍ يسمح لها بذلك. إنها إمبريالية مافياوية بالضبط. وإمبريالية المافيا لا تنتصر.
العربي الجديد
الإنتلجنسيا الروسية والمثقفون السوريون: شَبَهٌ ظاهريّ/ ثائر ديب
يبدو المثقفون السوريون الديموقراطيون منذ نصف قرن إلى الآن أشبه ما يكونون بالإنتلجنسيا الروسية في القرن التاسع عشر وصولاً إلى «ثورة أكتوبر» 1917، الأمر الذي يغري بمقارنةٍ مدقِّقة.
«الإنتلجنسيا» هي فئة اجتماعية منخرطة في عمل ذهني معقّد، يهدف إلى لعب دور قيادي في ثقافة المجتمع وسياساته. وهم غالباً أهل فنّ وكلمة لديهم مبادرة ثقافية وسياسية، سواء أكان دورهم الاجتماعي إيجابياً تقدمياً أم رجعياً متخلفاً.
عادةً ما يقيم «الإنتلجنسيون» مسافة واضحة بينهم وبين الجمهور، بخلاف «المثقفين» الذين هم أَمْيَل الى مجاملة العامة والشعب. والإنتلجنسي ذو معرفة أولاً، وذو قدرة على صوغ هذه المعرفة في رؤية للعالم بديلة للوضع القائم، ما يجعله، بالضرورة، أقلية في المجتمع، ويؤهّله لأن يتخلّص من شعبوية عموم المثقفين، فلا يتنازل عن معرفته العلمية برغم انحيازه للقيم الديموقراطية ومصالح الناس.
لعبت الإنتلجنسيا الروسية أدواراً فلسفية ودينية وسياسية وواجهت مصائر مريعة، قتلاً ونفياً وسجناً وانتحاراً، كما حظيت بانتصارات عزّ نظيرها. لعلّ السبب في ذلك كلّه يكمن في تاريخ روسيا الاجتماعي الثقافي، وموقع هذه «الإنتلجنسيا» فيه، تحديداً لناحية الانشقاق الحادّ بين الفئة الحاكمة وهذه الإنتلجنسيا بعد بطرس الأكبر (1672-1725) وإصلاحاته الكبرى. علماً أن الأمر أضيف إلى مشكلة وَسَمَتْ تاريخ روسيا منذ بطرس الأكبر فصاعداً، ألا وهي انقطاع الصلة بين ثقافة الإنتلجنسيا الرفيعة وبين الثقافة الشعبية البسيطة المنتشرة التي كانت في أخفض مستوياتها.
هكذا شهد التاريخ الروسي فئةً لا مثيل لها في التاريخ من حيث التهاب نشاطها، مع أنَّ الاستبداد القيصري الرهيب ورقابته المُحْكَمة كانا يحدّان من قدرتها على إيصال أفكارها لمن يجب أن تصل إليهم؛ فئة تُطْلِق أجرأ الأفكار في بلد إمبراطوري ليست لديه أيُّ تقاليد راسخة في الحرية؛ وفئة ترنو إلى الاستقلال مع أنها ليست في الغالب سوى جزء من الطبقة المعوزة في المدن.
أفضى ذلك كلّه إلى نشوب صراع هائل بين الإنتلجنسيا والحكم المطلق دام أكثر من قرن وعرف آلاف الشهداء والضحايا. ولعلنا نقرأ تاريخ روسيا في القرن التاسع عشر بوصفه سلسلة من محاولات المثقفين، اليائسة والمحزنة غالباً، للاتصال بالشعب. وليس السؤال «ما العمل؟» الذي تطرحه سونيا في رواية دستويفسكي «الجريمة والعقاب» سوى سؤال مصيري يتردد في الأدب والفكر الروسيين محاولاً تهيئة جواب، من شاداييف إلى لينين، مروراً بتشيرنيشيفسكي وروايته الموسومة «ما العمل؟».
قيل عن الروس إنّهم يتناولون الأفكار عاطفياً، فلا يكتفون بدراسة الفلسفة بل يعيشونها، ويرمون من وراء المعرفة النظرية إلى نتائج عملية، ويبحثون في أيٍّ نظرية عن طريقة حياة. أمّا الأدب، فيكاد يشكّل جماع حياة روسيا الفكرية والثقافية. ففي بلدٍ حُرِمَ من المنافذ المتاحة في سواه من البلدان، خاصةً الغربية منها، كان العمل الأدبي حدثاً اجتماعياً وسياسياً على الدوام. وكان تأثيره الأخلاقي والعاطفي أعظم منه في أيّ مكان آخر في أوروبا، حتى إنَّ القصة أو الرواية، التي هي في الغرب وسيلة من وسائل تصوير السلوك البشري، باتت تمتلك في روسيا إيقاع العاطفة النبوية والتغييرية وطرائقها.
ما أراه هو أنّ المثقفين السوريين الذين يُبْدُون للوهلة الأولى شبهاً كبيراً بالانتلجنسيا الروسية، لم يكونوا كذلك في كتلتهم الأساسية إلا سطحياً. ولعلّ السبب في ذلك كلّه يكمن في تاريخ سوريا الاجتماعي الثقافي الذي ستكون لنا مع معالمه الرئيسة وقفة عمّا قريب.
السفير
روسيا.. سنة أولى استعمار/ علي العائد
في خمس سنوات، استخدمت روسيا حق النقض خمس مرات لإنقاذ نظام بشار الأسد في مجلس الأمن الدولي، لكنها استغرقت أربع سنوات ونصف السنة من التردد حتى قررت التدخل بشكل مباشر في سوريا، بطائراتها وأساطيلها المتحفزة في البحر المتوسط.
مضى أكثر من عام بقليل على تدخلها المباشر، دون تحقيق نتائج ترجح كفة النظام على الفصائل المعارضة المسلحة، أو الفصائل السياسية.
مع ذلك، لا يزال لدى روسيا بعض الوقت في الأشهر القليلة المقبلة، فالأمم المتحدة، والولايات المتحدة، بطتان عرجاوان في ما تبقى من ولايتي رأسيهما. كما أن الرهان على موقف الرئيس الأميركي المقبل، أو المرشح الأبرز للأمانة العامة للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، سيكون رجما للغيب، ما يعني كسب شهور أخرى.
كسب الوقت لن ينقذ نظام الأسد، ولن ينقذ روسيا من الهزيمة المحتومة، فتمديد وقت الحرب في غير مصلحتهما، على الرغم من عدم اليقين إن كان هذا الوقت نفسه في مصلحة الفصائل المعارضة، والهيئة العليا للمفاوضات، والائتلاف السوري المعارض، فقد يخسر الطرفان.
الرهان على الهزيمة الروسية في سوريا يستند إلى تاريخها الاستعماري المتواضع، حيـث لم تحقـق سان بطـرسبورغ، أو موسكو، نصرا صريحا إلا في المحيـط الحيوي لروسيا القيصرية، أو الاتحاد السوفييتي.
تحتل روسيا الاتحادية الآن، المرتبة الأولى عالميا من حيث المساحة (17.075 مليون كيلومتر مربع)، مع عدد سكان تناقص بشكل حاد منذ انفراط عقد الاتحاد السوفييتي من 155 مليون نسمة إلى ما لا يتجاوز 143 مليون نسمة حاليا.
روسيا (الاتحاد السوفييتي) لم تنتصر في كوبا أو في أفغانستـان، بالقدر نفسه الذي لم ينتصـر عليها نابليون، ثم هتلر، لأنها تستطيع الـدفاع عـن نفسهـا في محيطها الحيوي القريب، أما أن تغزو وتستعمر وتستقر، فهذا ما لم يحدث حتى بدخولها على خط الحرب الأميركية في فيتنام، التي انتهت بهزيمة أميركا وروسيا معا.
عموما، لم تحقق حتى الدول المستعمرة الكبيرة استقرارا مديدا، بالرغم من خبرتها ومن امتلاكها كل الأسباب البعيدة للعب دور الدولة المستعمرة. فبريطانيا لم تستطع الاحتفاظ بدرة تاجها في الهند، كما أن فرنسا لم تستطع ضم الجزائر من تحت المتوسط حتى بعد 132 من استعمارها.
روسيا بوتين تحاول أن تتسلل من بين ثقوب الهشاشة الأوروبية، بعد أفول “مجد” الاستعمار المباشر ابتداء من منتصف القرن العشرين. وتتنمر، الآن، مستغلة فوبيا أميركا أوباما من الحرب، بعد تجنبه الشراسة التي أبداها أسلافه، من ريغان إلى “البُوشيْن”، الأب والابن.
لن تستغرق روسيا ثماني سنوات حتى تفوز بهزيمة جديدة، كما حصل في أفغانستان، لكـن سنة من تدخلها في سوريا لا تؤشر على بداية النهاية. مع ذلك يشير الجدل السياسي في مجلس الأمن، بين الولايات المتحدة وروسيا، بمساندة فرنسية، ودعم ألماني من بعيد، إلى شيء ما يعد للتفاوض أو التصعيد، خاصة أن شرق البحر المتوسط أصبح غابة من حاملات الطائرات، والمدمرات، والبارجات، والغواصات: روسية وأميركية وبريطانية وفرنسية.
هنالك اليوم ست سفن حربية روسية في المياه الدولية، والإقليمية، غرب سوريا، وجنوب تركيا، تساندها أربع سفن إمداد. يقابلها العدد نفسه أميركيا، في عرض البحر، “تساندها” مدمرة فرنسية، وغواصتان أميركيتان، وغواصة بريطانية، بينما تتجه حاملة طائرات وست سفن حربية أميركية إلى البحر الأحمر.
وشهد سبتمبر الماضي حركة عبور غير عادية لسفن روسية حربية عبر مضيق البوسفور الإجباري، احتلت فيه شرق المتوسط، ومنها حاملة الطائرات “أميرال كوزينتسوف”، بينما تكررت أخبار عن تحليق طائرات أميركية قرب قاعدة حميميم الروسية في سوريا، وأخبار تحرش طائرات روسية بسفن أميركية في المتوسط منذ أواسط يونيو الماضي.
بالطبع، تواجد الأساطيل الأميركية في المتوسط شيء عادي، وحركتها عبر المضائق المشرفة على البحر المتوسط والبحر الأحمر ومضيق هرمز، تتكرر أحياناً بشكل اعتيادي، لغرض التدريب، أو المناورات، أو الاستطلاع، لكن حركتها اليوم مرتبطة بالتحرك الروسي المستفز لدول أعضاء في حلف الناتو على خلفية التورط الروسي المتصاعد في الحرب على سوريا.
الجديد هو عبورها عبر مضيق البوسفور، الذي يشطر إسطنبول بين آسيوية وأوروبية. فإسطنبول شبه عاصمة لتركيا، وتركيا عضو في حلف الناتو.
بعد العرض الهزلي في مجلس الأمن، مساء السبت، فإن زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لتركيا يـوم 10 أكتوبر الجاري ستكون حلقة جديدة في زيادة الغموض عن العلاقة الأطلسية الأميركية – الروسية. فتركيا التي تعلن لسانيا دعمها للثورة السورية فضلت في عهد رئيس الوزراء بن علي يلدريم مصالحها الحيوية عبر الممر الروسي، بعد أن يئست من خذلان أميركا لها منذ 2011، بعدم دعم المقترح التركي بإنشاء منطقة حظر جوي شمال سوريا تخفف عنها عبء اللاجئين السوريين الذين يزيد عدد من استقر منهم في تـركيا على 2.7 مليون سوري.
وبينما لا توجد مؤشرات على ميل المعركة البرية في حلب إلى الحسم، وبعد فشل فرنسا وأسبانيا وحلفائهما في تمرير قرار بحظر الطيران فوق حلب، ستروج شائعات عن سلاح وصل، أو سيصل، إلى الجيش السوري الحر.
هذا منطقي، فاللهجة الحادة التي قابل بها مندوب بريطانيا استخدام روسيا للفيتو ضد مشروع القرار الفرنسي لن تكون بلا تبعات. ويأس أميركا وحلفائها من الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن من جدوى العمل السياسي مع روسيا سيدفع هؤلاء إلى إجبار روسيا على التراجع بوسيلة ما، دون التورط معها في معركة عسكرية مباشرة.
روسيا تدرك ذلك، ولذلك استبقت جلسة مجلس الأمن بتهديد مزدوج يحذر من استهدافها، أو استهداف مواقع قوات النظام السوري.
المؤشرات ترجح استمرار حرب أميركا وأوروبا ضد روسيا في سوريا بالوكالة، فأي حرب مباشرة بين الطرفين تعني حربا نووية، فروسيا قطعت نصف الطريق في ورطتها، وما دامت روسيا تعطي الأمان لإسرائيل لا يوجد سبب كي تتورط أميركا وحلفاؤها في مواجهة صريحة مع روسيا، حتى لو قُتل خمسة ملايين سوري آخر.
العرب
موسكو أسقطت هدنة حلب: تريد سوريا كلها لا ‘المفيدة’ فقط/ علي الأمين
المأساة السورية مستمرة ولا مؤشرات على وقف الموت الذي يزدحم على أرض الشام منذ سنوات ولا يزال. مشروع الهدنة الذي رفضته روسيا في مجلس الأمن الدولي، كانت فرنسا تقدمت به في محاولة لوقف العمليات العسكرية في حلب، وتثبيت اتفاق هدنة بين المعارضة المسلحة في حلب الشرقية من جهة، وبين روسيا والجيش السوري والميليشيات الإيرانية والطائفية التابعة لها من جهة أخرى. ماذا يعني رفض الروس وحلفائهم الهدنة في حلب؟
روسيا ظهرت كطرف معزول دوليا في مجلس الأمن الدولي بسبب إصرارها على تجاوز كل المعايير الإنسانية التي تضمن الحدّ من استهداف المدنيين، في حين كان ممثل الأمم المتحدة في سوريا ستيفان دي ميستورا يطلب من جيش الفتح (جبهة النصرة سابقا) سحب مقاتليه من حلب الشرقية إلى خارج المدينة بعد توفير ممرات آمنة لألف عنصر وهو عدد مقاتليها بحسب قوله.
هذا العرض أرفق بكلام فيه الكثير من الاستفزاز والوقاحة، حين قال دي ميستورا إن عدم الانسحاب سيعرض 250 ألف مدني إلى مخاطر كبرى بسبب إصرار الطائرات الروسية على استمرارها في توجيه صواريخها إلى هذا الجزء الشرقي من مدينة حلب.
الإصرار الروسي على استمرار العمليات العسكرية ضد المعارضة المسلحة كشف عن استراتيجية تكمن في دعم نظام الأسد في إعادة سيطرته على كامل الأراضي السورية، من دون احترام القرارات الدولية التي تحدثت عن تسوية سياسية تتضمن مرحلة انتقالية للحكم الحالي في سوريا إلى حكم آخر يقوم على قاعدة مشاركة المعارضة في السلطة بصلاحيات كاملة. وذلك تمهيدا لإجراء انتخابات ديمقراطية لن يكون فيها الأسد بطبيعة الحال، لكن اليد الروسية مطلقة في سوريا: أكثر من 34 ألف ضحية سورية سقطت خلال عام من العمليات العسكرية الروسية، وملايين إضافية جرى تهجيرها بالقوة النارية أو بقوة الحصار التي تنشط إيران وأداتها حزب الله في تنفيذها على امتداد مناطق سوريا المفيدة، ولا سيما محيط دمشق والمناطق المحاذية للبنان على طول حدوده الشرقية.
قوة روسيا في سوريا تتأتى من غياب أي محاسبة داخلية روسية للجرائم التي يرتكبها الروس في سوريا، ومن انكفاء مستمر للدور الأميركي الـذي كان له دور فاعل في إطلاق اليد الروسية هناك. وتأتي قوتها بسبب التقارب الأميركي – الإيراني، الذي يمكن القول إنه العصر الذهبي للعلاقة منذ الثورة، لا سيما غداة توقيع الاتفاق النووي الإيراني مع الدول الخمس زائدا واحدا.
وترجم هذا الاتفاق بالمزيد من التعاون الإقليمي بين الطرفين سواء في العراق بمواجهة تنظيم داعش والتدخل التركي والعربي، أو في سوريا من خلال التغطية الأميركية للتدخل الإيراني عبر الميليشيات الشيعية، ولا سيما حزب الله.
وزير الخارجية الأميركية كان صريحا خلال لقائه ممثلي المعارضة السورية في نيويورك قبل عشرة أيام، بقوله إن حزب الله المصنف على لائحة الإرهاب الأميركية لا يعادي بلاده في سوريا ولا يستهدف مصالحها، لذا لا تستهدفه. علما أن حزب الله الذي يشارك في تنظيم الحشد الشعبي العراقي تدريبا وتنظيما، وتحت إشراف الجنرال في الحرس الثوري قاسم سليماني، يقوم عمليا بتنسيق الجهود مع القوات الأميركية بطريقة غير مباشرة وعبر القنوات العراقية الرسمية في وزارة الدفاع. كل هذا التناغم الإيراني مع النفوذ الأميركي والتنسيق المشترك في سياق مواجهة الإرهاب، وفر إلى حد بعيد نوعا من الحصانة الأميركية للتمدد الإيراني، الذي نجح في الاتفاق على وضع قواعد تعاون في اليمن من خلال الحوثيين. وهم أظهروا المزيد من الانسجام مع الموقف الأميركي، مقابل وضع واشنطن خطوطا حمراء تمنع التحالف الإسلامي الذي تقوده السعودية من تحرير صنعاء، فضلا عن التزام واشنطن بمنع هزيمة الحوثيين وضمان نفوذ إيران بحيث لا تخرج من معركة اليمن بلا مكاسب ولو بالحدّ الأدنى.
روسيا التي تدرك مساحة التلاقي والتعارض بين واشنطن وطهران في المنطقة وتحديدا في سوريا، دخلت المسرح السوري استجابة لحاجة إيرانية تريد من خلالها منع انهيار نظام الأسد، بل شخص الأسد الذي يشكل الحليف الوحيد لإيران على امتداد الأراضي السورية. وهناك استجابة لواشنطن التي أكدت مجريات الأحداث أنها ليست في وارد السماح بسقوط نظام الأسد لأسباب إسرائيلية بالدرجة الأولى، ولعدم تكرار تجربة العراق بالنسبة إليها ثانيا.
كما أن الأزمة السورية وفرت مساحة تصفية حسابات لعدد من الدول التي وجدت واشنطن أن غرقها في المستنقع السوري سيجعلها أكثر طواعية في ملفات إقليمية ودولية وعلى صعد أخرى. روسيا التقطت الحاجة الأميركية والإيرانية، من دون أن ننسى أن لها مصالح تاريخية في سوريا.
وهي بذلك أيضا نجحت في بناء علاقة استراتيجية مع إسرائيل، وتحولت إلى طرف ضامن للعلاقة بين إيران وإسرائيل على قاعدة حماية حدود إسرائيل في مقابل عدم تدخلها في أي عملية دعم لإسقاط نظام الأسد أو التعرض للقوات الإيرانية ولحزب الله في قتالهما في سوريا.
روسيا مستمرة في رفض الهدنة، وتعد بالمزيد من الدمار والموت لمعارضي الأسد في حلب. هو سلوك همجي. وإن كان يتسم به الدور العسكري الروسي بشكل عام، إلا أنه ينطوي على قلق روسي من خسارة ما يعتقد أنه كسبه خلال عام في سوريا. لذا يستعجل اتفاقا مع واشنطن، ليس أقل من إطلاق يده بالكامل في سوريا. وهذا ما بدا أن واشنطن غير مستعدة له حتى الآن.
ظهر ذلك من خلال سقوط اتفاق الهدنة في حلب الذي صاغه وزيرا خارجية البلدين مطلع الشهر الماضي، لكن البنتاغون كان له رأي آخر في الرسائل العسكرية التي وجهها إلى جيش الأسد في الرقة. بعد ذلك ذهب اتفاق الهدنة إلى خبر كان. لذا روسيا تذهب إلى النهاية في المواجهة أي النهاية التي تضمن لها إطلاق يدها في سوريا وبدعم واشنطن. أي اتفاق هدنة لا ينطوي على تسليم أميركي بالهدف الروسي، تعتبره القيادة الروسية مصدر خطر لها. ذلك أن عمليات تسليح المعارضة السورية تقررها واشنطن بعدما نجحت روسيا في تحييد تركيا إلى حدّ بعيد، وفي ظل التسليم العربي والخليجي تحديدا بألا تخرج سياسة دعم المعارضة عن تحكم واشنطن بشروطها وتوقيتها.
وسط غياب أي سياسة عربية واضحة المعالم في سوريا، ستبقى موسكو وطهران تدمران أي مظهر معارض لنظام الأسد، وفي اعتقادهما أن واشنطن ليست طرفا غير قابل بمباركة وجودهما، بينما أي سياسة عربية تنطلق من نظام المصالح القومي، ستواجه بالضرورة النفوذ الإيراني ولن تستطيع، بحكم نظام المصالح هذا، أن تعطي روسيا شرعية القتل والتدمير والنفوذ.
كاتب لبناني
العرب
أهداف روسيا والنظام السوري من التصعيد في حلب/ يزيد صايغ
ثمة مقولة شهيرة لكارل فون كلاوسفيتز، الاستراتيجي العسكري البروسي البارز في القرن التاسع عشر، أن «الحرب امتداد للسياسة بوسائل أخرى». هذه المقولة تنطبق أكثر ما تنطبق الآن على التصعيد الهائل للعنف في حلب وأجزاء أخرى من سورية، منذ انهيار الهدنة الجزئية في 19 أيلول (سبتمبر) الماضي. فأبرز أسبابه سعي روسيا إلى مساعدة نظام الرئيس بشار الأسد على تحقيق مكاسب عسكرية راسخة وتحصينها بموقف سياسي متين، قبل أن تتحرّك الإدارة الأميركية القادمة لاستئناف جهود التسوية الديبلوماسية للأزمة السورية.
بيد أن الهدف الاستراتيجي للعنف المستمر بالنسبة إلى نظام الأسد لا يتصل فقط بتأمين أفضل شروط التسوية السياسية، بل يذهب أيضاً إلى انتزاع الموارد المالية والاقتصادية التي سيحتاج إليها ليتمكّن من الحفاظ على وجوده عند الانتقال من الحرب إلى السلام. فبات واضحاً أن الإدارة الأميركية قد خَلُصت إلى أنها لا تستطيع منع الأسد من البقاء في السلطة خلال مرحلة انتقالية تنتج من اتفاق سياسي. هذا علاوة على أن وزير الخارجية الأميركي جون كيري يعتقد أيضاً، وفق نشطاء سوريين ألتقوه في 22 أيلول الماضي، أن الأسد سيخوض انتخابات الرئاسة التي قد تجرى في نهاية المرحلة الانتقالية.
وهكذا، حين تستأنف الإدارة الأميركية الجديدة وروسيا حوارهما حول سورية، سينتقل مربط الفرس نحو رفع العقوبات المالية والاقتصادية عن نظام الأسد، أو تمكينه من الحصول على مصادر أخرى من الرساميل والسلع. وفي هذه الأثناء، سيواصل النظام استخدام وسائل العنف إلى حين توفير وسائل مادية بديلة لإعادة بناء مقومات سلطته السياسية وهيمنته الاجتماعية.
بيد أن معضلة نظام الأسد لا تكمن فقط في أنه غير مستعد لإبرام تسوية سياسية للنزاع، بل لأنه أيضاً غير قادر على ذلك. فقدرته على الإمساك بالسلطة، سواء خلال حقبة السلام قبل العام 2011، أو خلال النزاع المسلّح المستمر منذ ذلك الوقت، اعتمدت دائماً على الشبكات غير الرسمية التي يديرها في كل أجهزة السلطة والقوات المسلحة وأجهزة الأمن، وأيضاً في القطاعين العام والخاص في المجال الاقتصادي. وتستند قبضة النظام على هذه الشبكات بدورها إلى السيطرة على الأصول الاقتصادية الرئيسة، خصوصاً المداخل إلى القروض والعقود والأسواق، وعوامل الإنتاج كالطاقة والأرض.
لكن النظام خسر في خضم النزاع معظم هذه الموارد والوسائل. ولم يستطع الحفاظ على قبضته على الشبكات الموالية سوى من خلال تشجيعها على الانخراط بعمق في اقتصاد الحرب، وتطوير أنماط بديلة لتحصيل المداخيل ولإعادة إنتاج علاقات التواطؤ ما قبل الحرب بين أجهزة الأمن ومؤسسات الدولة وكوادر حزب البعث وأرباب السوق السوداء. وفي الوقت نفسه، عمل النظام على توجيه الائتمانات المالية والعقود التجارية الإيرانية نحو المحظوظين من أتباعه في قطاع الأعمال.
مع ذلك، كل هذا لن يكون كافياً لتعويم النظام حال انتهاء النزاع، ما لم يكن قادراً على وضع اليد على مصادر جديدة للرساميل وإعادة ربط الاقتصاد المحلي بالأسواق الخارجية المهمة. صحيح أن النظام يتوقع أن يخرج ظافراً، سواء من خلال تسوية سياسية بالتفاوض أو عبر نصر عسكري شامل، إلا أنه سيقبع على عرش بلد مدمّر اقتصادياً وأسواق ممزّقة. ولن تتوافر لديه سوى سبل ضئيلة لتوفير الرساميل اللازمة لإعادة البناء في مجالات الإسكان، والمرافق الاقتصادية، والبنى التحتية، ناهيك بإعادة اللاجئين إلى وطنهم واستيعاب النازحين داخلياً، وترميم قطاعات التعليم والصحة والخدمات العامة الأخرى، وإعادة بناء الروابط التجارية الخارجية.
قد يلجأ النظام إلى التوفير اقتصادياً، من خلال تأخير عودة زهاء 4،8 مليون لاجئ يُقدّر الآن أنهم خارج سورية، وعبر وضع عمليات إسكان وإعادة دمج نحو 6،5 مليون نازح داخل البلاد في آخر سلّم أولويات إنفاقه. لكن لن يكون في وسعه الاعتماد فقط على افتعال النقص في السلع الرئيسة والخدمات أو على قمع الأجهزة الأمنية، لاحتواء حنق ملايين المواطنين الذين دعموا المعارضة في السابق. سيتعيّن عليه أن يزيّن هذه «العصي» ببعض ألوان «الجَزَر»، لأن القمع أكثر كلفةً من الاحتواء حتى في الأنظمة السلطوية.
وما هو أهم من منظور النظام، أن توقعات قواعده الموالية للتعويضات والعائدات المادية، مقابل الثمن الباهظ الذي تكبّدته دفاعاً عنه، لن تكون أقل إلحاحاً. فالفشل في الاستجابة لها ستكون كلفته السياسية أعلى بكثير. ورغم أن النظام حفّز العديد من رجال الأعمال الذين بقوا داخل البلاد على دعمه مالياً، إلا أن إغراء رؤوس الأموال الهاربة والمبادرين الاقتصاديين والمهنيين من الطبقة الوسطى الحائزين على المهارات الضرورية للنهوض الاقتصادي، للعودة إلى البلاد، سيكون مهمة شاقة فعلاً.
لذلك، لا يزال النظام في حاجة إلى الحرب بوصفها وسيلته الأنجع لإرجاء دفع الأكلاف الكاملة لعملية إعادة البناء، واستيعاب المواطنين المُعادين، وتنفيس الضغوط المنبثقة من داخل صفوفه، عبر استمرار تعبئتهم لمواجهة الخطر الوجودي المفترض ودفعهم نحو توفير حاجاتهم المادية من خلال اقتصاد الحرب. لكن، وعلى عكس من يفترض أن النظام يوظّف العنف لمجرد الحفاظ على هيمنة بشار الأسد، فإن هدفه الاستراتيجي سيتغيّر في الواقع، إن لم يكن قد تغيّر بالفعل. وهذا الهدف، منطقياً، لا يمكن أن يكون سوى استعادة المداخل إلى رؤوس الأموال والأسواق الخارجية، والعمل على رفع العقوبات عن كاهله.
نظرياً، لا أمل تقريباً للنظام في تحقيق هذا الهدف بالطرق الديبلوماسية. فروسيا وإيران غير قادرتين على توفير الرساميل والأصول على النطاق الواسع المطلوب، لا بل هما امتنعتا عن القيام بذلك حتى في ذروة حاجة النظام إليها إبّان تصاعد وتائر الحرب. بيد أن الأطراف التي تحوز على أكبر المزايا والقدرات المالية والاقتصادية (الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي وتركيا) ستتردد، إن لم تكن سترفض كلياً، رفع العقوبات الثنائية أو السماح للنظام بالدخول غير المقيّد إلى الأسواق العالمية. ولذا، سيواصل هذا الأخير انتهاج مسلك الحرب داخل سورية، مُستخدماً الحاجات الإنسانية وخطر نزوح موجات جديدة من اللاجئين إلى البلدان المجاورة وما وراءها، كأداة لحمل القوى الخارجية على الرضوخ إلى مطالبه.
الأرجح أن روسيا ستتواطأ مع مثل هذا السيناريو، ولو على مضض. فهي تريد إبرام صفقة سلام والوصول إلى خواتيم واضحة للنزاع، لكنها تفتقد إلى ما يكفي من النفوذ لحمل نظام الأسد على قبول حتى الشروط الملائمة له والمُتضمنة في الاقتراح الروسي للتسوية السياسية. وبالتالي، بدلاً من الانخراط في تنافس عقيم مع النظام، من المحتمل أكثر أن تتبنى روسيا مطالبه حول رفع العقوبات وتوفير المساعدة المالية، حين تستأنف المحادثات مع الإدارة الأميركية الجديدة. ولتحقيق هذا الهدف، ستجادل روسيا بأنه ليس في وسع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وباقي أطراف المجتمع الدولي أن تطالب بمرحلة انتقالية في سورية فيما هي تقوّض في الوقت نفسه فرص نجاحها، من خلال مواصلة فرض العقوبات والحظر التجاري. كما أنها قد تضغط على دول مجلس التعاون الخليجي بدعوى تعويض النظام نتيجة دعمها «الإرهابيين» الذين يزعم أنهم دمّروا سورية.
لن يراوح النظام السوري مكانه بانتظار حصول هذه النتائج، بل هو بدأ يستعد بالفعل لطرق أبواب مداخل أخرى إلى الرساميل. فقد أصدرت الحكومة السورية منذ أواخر 2015، ما وصفه المحلل الاقتصادي السوري جهاد يازجي بـ «سعر» من القوانين الجديدة لاجتذاب الاستثمارات، شملت إعفاء الشركات من متأخرات الضرائب، والقيمة المضافة (VAT) ومدفوعات الضمان الاجتماعي. كما تضمنت تأسيس هيئات جديدة لتطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، ولتشجيع الإنتاج المحلي والتصدير، وفرض زيادات كبيرة على ضريبتي الدخل والعقارات، وتغيير قواعد التخطيط المديني للسماح باستبدال الإسكان غير الرسمي في المناطق المتمردة بمشاريع عقارية تجارية مرتفعة القيمة. هذا علاوة على تشريعات تتعلّق بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، هدفها منح رجال الأعمال حصة كبيرة في المشاريع التي تموّلها الحكومة وحقوق استخدام الأراضي المملوكة للدولة، وتأسيس «المجلس السوري للحديد والصلب» توقعاً لطفرة إعمار ضخمة.
مثل هذه التوجهات لا تستهدف المستثمرين السوريين وحدهم. فعلى رغم الحملات الكلامية العنيفة بين تركيا وسورية، إلا أن للأولى مصلحة اقتصادية كبيرة في طرق أبواب العودة إلى السوق السورية. وكذا الأمر بالنسبة إلى لبنان والأردن اللذين عانيا أكثر من غيرهما اقتصادياً، ويتحرقان الآن لإعادة اللاجئين السوريين إلى ديارهم، وإنعاش قطاعات المصارف والأعمال فيهما من خلال عودة الانفتاح على سورية. هذا إضافة إلى أن إيران، وربما بلداناً أخرى كالصين، قد توسّع استثماراتها في سورية، من دون انتظار رفع العقوبات الغربية أو الخليجية، أو حتى قبل توقف النزاع المسلّح.
تواجه الحكومات الغربية والحليفة معضلة. فهي تسعى إلى وقف سيل الدم وتدفق اللاجئين السوريين، ولكن نفوذها محدود حيال نشاطات البلدان الأخرى والجهات الفاعلة الخاصة. فقد يجد الساعون إلى دعم الجبهة الديبلوماسية ضد نظام الأسد أنهم يواجهون معركة صعبة للإبقاء على العقوبات الاقتصادية والمالية. وبالفعل، بدأ مبعوثون غربيون ووكالات ومنظمات إغاثة دولية والبنك الدولي يركزون في شكل مضطرد على الحاجة إلى الاستعداد لإعادة البناء الاقتصادي في سورية.
* باحث أول في مركز كارنيغي للشرق الأوسط، بيروت.
الحياة
مؤشرات على تأزم استراتيجي أكثر منها على ندية عظمى/ د. بشير موسى نافع
مستخدمة مبررات واهية، أطلقت الطائرات الروسية حملة جديدة من القصف الوحشي على مدينة حلب وأهلها. لم يبرز ثمة دليل واحد على أن القصف الروسي طال وحدات من جبهة فتح الشام (النصرة، سابقاً)، بصورة خاصة، التي تعتبرها روسيا جماعة إرهابية. في أغلبه، اتسم القصف الروسي بالعشوائية، مدمراً أحياء بأكملها وناشراً الموت والرعب بين من تبقى من سكان المدينة المنكوبة. في بداية الحملة، استهدفت الغارات الروسية قافلة معونات دولية؛ وخلال الأسبوعين الأولين من الحملة، أخرج القصف مستشفيات بأكملها من العمل، وأوقع شللاً بمحطة ضخ المياه الوحيدة في المدينة. هذه طريقة الحرب الروسية في أبلغ صورها، الطريقة التي طبقت من قبل أثناء الحرب العالمية الثانية، وخبرها العالم في الاجتياح الروسي لغروزني في 1996: تركيع المدينة والمدافعين عنها بالتدمير الشامل وإحراق أهلها.
ليس ثمة غموض في الحرب الروسية على حلب، لا في طريقة الحرب، لا في وسائلها، ولا أهدافها. وإن كان هناك من لم يستطع رؤية حقيقة ما يحدث، فقد وفرت الأِشرطة المصورة لكبار محطات التلفزة وعدد من المراسلين الشجعان تأريخاً مؤلماً لما تشهده أقدم مدينة حاضرة في العالم، سردية قاهرة للروح، تظهر عجز المجتمع الإنساني عن حماية أبسط الحقوق الإنسانية: حق الحياة. ولكن المدهش أن البعض أراد صناعة سردية أخرى من ركام المدينة وجثث أهلها وصرخات أطفالها: أن نكبة حلب ترمز، في الوقت ذاته، إلى بروز روسيا، من جديد، قوة عظمى، قوة تناهض الولايات المتحدة وتتدافع معها على مناطق النفوذ. ألم تسيطر روسيا على سوريا، أليست القوة الروسية هي من يحافظ على نظام الأسد ويحرس مقعده الرئاسي، أليست روسيا من يحرس الأجواء السورية، ألم تؤسس روسيا لقواعد عسكرية دائمة في بلاد الشام، وتحصل على حصانة كاملة لجنودها المحتلين، أليست روسيا وحدها صاحبة القرار في سوريا؟
روسيا الآن هي قوة محتلة، كاملة الأركان، وليس باستطاعة الأمريكيين، أو غير الأمريكيين فعل شيء ملموس في مواجهة هذا الاحتلال. وأكثر من ذلك، أن روسيا تفكر الآن بإحياء سياسة إقامة قواعد عسكرية في بلدان أخرى حول العالم.
حقيقة الأمر، أن روسيا اليوم قوة كبيرة متأزمة؛ وليس هناك من مؤشر جاد واحد على عودتها إلى الموقع والدور الذي تعهده الاتحاد السوفياتي أثناء عقود الحرب الباردة الأربعة. لم تخسر روسيا محيطها السوفياتي، وحسب، عند انتهاء الحرب الباردة، ولكنها خسرت أيضاً حلف وارسو، وواجهت توسعاً أطلسياً حثيثاً في العقدين الماضيين، بات يهدد الأسس المستقرة للأمن الروسي منذ الحروب النابليونية.
ما فهمته موسكو، وجادلت الإدارات الأمريكية المتعاقبة، منذ إدارة بوش الأب، بعدم صحته، أن تفكيك حلف الناتو وانهيار الاتحاد السوفياتي لن يتبعه توسع لحلف الأطلسي في الدول الشيوعية السابقة. ولكن هذا ليس ما حدث. توسع الأطلسي إلى دول البلطيق، بولندا، معظم دول يوغسلافيا السابقة، رومانيا، وبلغاريا. وفي أغلب الحالات، سار الاتحاد الأوروبي على خطى حلف الأطلسي. هذا في الجوار الروسي الأوربي الغربي وفي البلقان. أما في بوابة روسيا الجنوبية، فقد أطاحت ثورة شعبية بالنظام المرتبط بموسكو في جورجيا، ووضعت في مكانه نظاماً موالياً للغرب. وفي أعقاب ثورة شعبية مفاجئة، أخرى، خسرت موسكو النظام التابع لها في أوكرانيا، البوابة الغربية لروسيا والأرض التي اعتبرت، دائماً، ثقافياً ودينياً، قدس أقداس الأمة الروسية. وتكشف نظرة سريعة إلى تموضع القوى في جوار البحر الأسود، منفذ روسيا الوحيد إلى المتوسط، أن وضع روسيا الاستراتيجي، اليوم، أسوأ بكثير عما كان عليه في نهايات القرن التاسع عشر. هذا، إضافة إلى نشر الدرع الصاروخي الأمريكي في أوروبا، التي يؤكد المسؤولون الروس أنه سيصنع خللاً كبيراً في توازن قوى القارة.
حاولت روسيا، كما هو معروف، احتواء خسارة جورجيا بتوفير دعم وحماية لكيانات إثنية جورجية انقسامية. كما حاولت احتواء الخسارة الاستراتيجية الثانية، والأفدح، في أوكرانيا، بالسيطرة على شبه جزيرة القرم، التي كانت في الأصل جزءاً من روسيا وتستضيف القاعدة الروسية البحرية الرئيسية على البحر الأسود، وتشجيع المطالب الانشقاقية في مقاطعات الأغلبية الروسية في الشرق الأوكراني. ولكن، وبينما طالبت موسكو، ولم تزل، بتعهدات غربية لبقاء كل من جورجيا وأكرانيا محايدتين؛ والاعتراف بشرعية الضم الروسي لشبه الجزيرة القرم، ترفض الدول الغربية الرئيسة تقديم مثل هذا التعهد. إضافة إلى ذلك، ومنذ اندلعت الأزمة الأوكرانية، فرضت الولايات المتحدة ودول الوحدة الأوروبية عقوبات ثقيلة الوطأة على روسيا، المتهمة بالتدخل العسكري لصالح الانشقاقيين في شرق أوكرانيا. كانت كلفة هذه العقوبات، ولم تزل، باهظة، سواء في أثرها على الاقتصاد الروسي، بصورة عامة، أو على النظام الروسي البنكي. كان الارتفاع الكبير في أسعار موارد الطاقة قد ساعد على إطلاق ازدهار روسي اقتصادي في الفترة منذ نهاية التسعينات إلى 2014، وتحقيق وفرة مالية ملموسة. ولكن العقوبات الغربية، من ناحية، والتراجع الفادح في أسعار موارد الطاقة، تسببت في ركود اقتصادي روسي، وفي معدلات نمو سلبية لعامين على التوالي. تعيش روسيا، اليوم، ضائفة مالية عامة، وضائقة اقتصادية، لا تقل سوءاً عن تلك التي عاشتها في أعقاب الانهيار السوفياتي، عملت خلال العامين الماضيين على استنزاف غير متوقع للاحتياطات المالية.
ثمة دول عرفت، تقليدياً، بعدم وجود صلة وثيقة بين وضعها الاقتصادي ورفاهية شعبها، من جهة، وتكاليف سياستها الخارجية، بما في ذلك تكاليف الحرب، من جهة أخرى. وروسيا هي المثال الأبرز على هذا الصنف من الدول. خاض الحكام الروس أغلب حروب بلادهم، سواء في عهدها القيصري، أو الحقبة الشيوعية، في ظل بؤس اقتصادي واسع الانتشار. ومن الخطأ، اليوم، تصور نكوص القيادة الروسية عن السياسة العدوانية في سوريا لأن أوضاع البلاد الاقتصادية تشهد تراجعاً. ولكن مشكلة روسيا ليست هنا، أو ليست هنا على وجه الخصوص. تتبع موسكو سياسة هجومية في سوريا، بلا شك، بل وسياسة عنف وإبادة هوجاء، ما كان للقيادة الروسية ارتكابها لولا أنها تعرف أن جريمتها السورية لا تختلف عن الجرائم الأمريكية في العراق وأفغانستان. مهما كان الأمر، على أية حال، فقد كانت الولايات المتحدة أعلنت، منذ أخذت الأدلة على توحش النظام الأسدي في التعامل مع الحراك الشعبي في التزايد، أن سورية ليست منطقة نفوذ أمريكي وأن ما يحدث في سورية لا يمثل تهديداً للأمن القومي الأمريكي، بحيث يسوغ تدخلاً أمريكياً ملموساً في الأزمة السورية.
لم تواجه روسيا الولايات المتحدة في سوريا؛ وبالرغم من مبالغات التصريحات الروسية ضد واشنطن وسياساتها، ومن ادعاءات موسكو الوهمية بوجود مستشارين عسكريين أمريكيين في حلب، فليس ثمة معركة روسية ـ أمريكية في سوريا. ما تشهده سوريا ليس سوى جريمة روسية بشعة، جريمة حرب مستمرة منذ شهور، وضغوط شرق أوسطية وعالمية، في المقابل، على الولايات المتحدة، بصفتها الدولة العظمى الأهم، للتدخل ووضع حد للجريمة الروسية.
وما يبدو واضحاً، حتى الآن، على الأقل، أن إدارة أوباما لن تتخذ قراراً بتدخل ملموس في سوريا. وإن كانت هذه القراءة صحيحة، فلماذا، إذن، ترتكب روسيا مثل هذه الجريمة في سوريا. والإجابة، على الأرجح، أن روسيا تريد استخدام سورية ورقة لإجبار الولايات المتحدة على التفاوض على الملفات الأكثر أهمية وحيوية لموسكو، ملفات مثل مصير أوكرانيا وجورجيا وشبه جزيرة القرم. المأساة في كل هذا أنه ما دامت إدارة أوباما تنظر إلى سوريا باعتبارها مسألة ثانوية على جدول أولويات الأمن القومي الأمريكي، فإن واشنطن لن تفتح باب المساومة على أوكرانيا وجورجيا. وستظل روسيا، بالتالي، تدك المدن السورية بحمم أزمتها الاستراتيجية الممتدة.
٭ كاتب وباحث عربي في التاريخ الحديث
القدس العربي
بوتين يخيب أمل أردوغان في سوريا/ عبد القادر عبد اللي
منذ أسبوع تقريباً والجميع يترقب بفارغ الصبر، الاجتماع بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، وما يمكن أن يفضي إليه على الصعيد السوري، خاصة أن هذا الاجتماع يأتي بعد اجتماعات عديدة للّجان الثلاث، الخارجية والمخابراتية والعسكرية، التي انبثقت عن الاجتماع الأول الذي عقد بين الرئيسين في سان بطرسبورغ.
لعل المفاجأة الوحيدة التي حدثت في الاجتماع هي حضور رئيس هيئة الأركان التركية خلوصي أكار للاجتماع الثلاثي المغلق. ولكن هذه المفاجأة سرعان ما بددها البيان الصحافي الذي صدر عن الرئيسين بعد الاجتماع. فالكلام الدبلوماسي الصادر عن الاجتماع يمكن تلخيصه في ثلاث نقاط، باتت لا تجذب انتباه حتى الأطفال.
النقطة الأولى: “الطرفان يريدان حقن الدماء في سورية، والانتقال إلى حل سياسي!”
النقطة الثانية: “العمل على إيصال المساعدات الإنسانية إلى حلب”، ولكن الرئيس الروسي أكد على استحالة تنفيذ هذه النقطة لأن الولايات المتحدة لم تستطع، ولا ترغب إبعاد المعارضة عن طريق الكاستللو المنفذ المؤدي إلى المنطقة المؤدية إلى حلب الشرقية بحسب رأيه.
النقطة الثالثة: “البحث في إمكانيات التعاون بين البلدين في إطار عملية درع الفرات”.
الحقيقة أنه مهما بلغ التفاؤل، لا يمكن لأحد أن يجد في هذه النقاط التي طرحها البيان الصادر عن الرئيسين اللذين قضيا ساعة وأربعين دقيقة، خصصا معظمها للحديث عن القضية السورية، أي بارقة أمل يمكن التعويل عليها.
فأي دم يريد الطرفان حقنه؟ هل هو دم المقاتلين العقائديين الذين يرسلهم الإمام الفقيه دفاعاً عن محافظته الخامسة والثلاثين التي اسمها سوريا، والتي دخلت رسمياً بقرار من الدوما الروسي تحت الاحتلال العسكري المباشر؟ أم دم من يعتبرهم بوتين حاضنة للإرهاب وتقصفهم قواته الجوية منذ سنة ونيف في الأسواق والمخابز والمشافي؟ أم دم عناصر “داعش” الذين يعبرون الصحارى السورية على مرأى من الطيارين الروس والأميركان ويحمون أجواءهم عند الانتقال؟ ويمكن تعداد كثير من الأسئلة من هذا النوع، وإجاباتها كلها تؤدي إلى ترجمة واحدة لهذه العبارة: “الاستمرار بقتل السوريين، وإراقة المزيد من الدماء”…
بالنسبة إلى إيصال المساعدات الإنسانية، فلم يكن العالم يعرف بأن طريق الكاستللو تحت سيطرة المعارضة السورية، ولعل هذه المعلومة لا يعرفها في العالم كله سوى بوتين، وهذه المعارضة تمنع المساعدات الإنسانية من الوصول إليها، لذلك اتفقت مع الولايات المتحدة الأميركية على البقاء في معبر الكاستللو من أجل عدم مرور هذه المساعدات. نعم، لقد وصلت القضية السورية إلى هذا المستوى من الهزل، نعم، المعارضة السورية “أو الإرهابيون بلغة بوتين” هم الذين يمنعون وصول المساعدات الإنسانية إليهم، وبوتين يبذل جهوداً مضنية مع الأميركان للضغط على هذه المعارضة من أجل السماح لها باستلام المساعدات الإنسانية، والأميركيون لا يردون.
النقطة الثالثة: “بحث آفاق التعاون بين البلدين حول عملية درع الفرات!”
لعل هذه العبارة هي الوحيدة التي يمكن إيجاد تفسير أو ترجمة منطقية لها، ويمكن صياغة هذه الترجمة على النحو الآتي: “عدم تدخل روسيا في العملية التي تدعمها تركيا تحت اسم درع الفرات”.
هناك احتمالان للتدخل الروسي إن حدث في هذه العملية. الأول أن تقاتل روسيا إلى جانب “داعش”. صحيح أن روسيا حمت “داعش” في بعض الأحيان، ولكنها لم تقاتل إلى جانبها إلى الآن، وهذا يبدو حالياً ضرباً من المستحيل يصعب على العقل استيعابه.
الثاني: هو طلب تركيا أن تقدم لها روسيا دعماً في المرحلة الأخيرة من مراحل “درع الفرات”، وهو إبعاد “قوات سوريا الديموقراطية” التي تشكل “وحدات حماية الشعب” الكردية عمودها الفقري، والمدعومة من الولايات المتحدة وروسيا من منطقة منبج إلى شرقي الفرات. وهذا الخيار أيضاً لا يخلو من طرافة، فعندما طلب الرئيس التركي من بوتين إغلاق مكتب حزب “الاتحاد الديموقراطي” الكردي في موسكو، تظاهر بوتين بعدم معرفته بوجود مكتب لهذا الحزب في موسكو، ولعله لم يعلم به حتى الآن لأنه مازال مفتوحاً. ووفق هذه المعطيات من الصعب أن يحظى الرئيس التركي بدعم روسي في طرد قوات “الاتحاد الديموقراطية” من منبج إلى شرق الفرات.
وهكذا، فإن نتيجة اجتماع الرئيسين التركي والروسي حول الموضوع السوري لا شيء. ولكن للحقيقة والتاريخ فإن الرئيس الروسي مازال يأمل بالوصول إلى نتيجة على صعيد المساعدات الإنسانية في الاجتماع اللاحق الذين سيعقد بين الطرفين الروسي والأميركي. أي يمكن أن تُقنع الولايات المتحدة الأميركية المعارضة السورية أن تستلم المساعدات الإنسانية التي ستسمح روسيا بمرورها.
يبدو أن ما كان غير متوقع من اجتماع الرئيسين التركي والروسي كان محتماً بالنسبة إليهما. ولعل تحريك الجبهات في حماة والساحل لم يحدث بمعزل عن خيبة الأمل التركية من الاجتماع بين الرئيسين قبل أن يبدأ.
ولكن السؤال الأهم، هل ستلعب خيبة الأمل هذه بفتح جبهة حلب من جديد لطرح ورقة ضغط جديدة على الجانب الروسي لتغيير مواقفه؟ إذا لم تفعل تركيا هذا، وتضع تلك الورقة على طاولة المفاوضات، فليس أمامها خيار آخر إلا الاستسلام. وفي السياسة كما الحروب كل شيء ممكن.
المدن
العجز الدولي بمثابة «اعتراف» بالاحتلال الروسي/ عبدالوهاب بدرخان
… «ترقى إلى جرائم حرب»، ماذا يعني ذلك؟ لا شيء. مجرد كلام وتلويح بالاتهام مع إدراك مُسبق لصعوبة المضي به، فالنظام الدولي عُطّل بـ «فيتو» الدول الخمس الكبرى يوم أنشئ مفترضاً أن هذه الدول لا يمكن أن ترتكب جرائم كهذه. لكن ما يحصل في حلب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية يقف العالم بإزائها عاجزاً تماماً. أكثر من ذلك، كان مجرم الحرب، أو ممثله، مترئّساً جلسة مجلس الأمن يوم السبت 08/10/2016 ليرفض مشروع قرار يطلب وقف إطلاق النار وإيصال مساعدات إنسانية مع آلية دولية للمراقبة. ولماذا يرفض؟ لأن المقترح يمنعه من مواصلة القتل والتدمير. أما مشروعه المضاد فلا يجيب عن سؤال منطقي بسيط: كيف تكون الهدنة ممكنة مع استمرار القصف الجوي؟ ما يعني بوضوح أن روسيا، ونظام بشار الأسد بالتبعية، يرفضان أي وقف لإطلاق النار.
كانت حلب في تاريخها المديد تعرّضت للكثير من الغزوات والاعتداءات، ولم تشهد دماراً إلا في زلزال العام 1138 ثم في الغزو المغولي عام 1260 الذي أتبع التدمير بمذابح وحشية للسكان. بعد سبعة قرون، ها هو فلاديمير بوتين يسير على خطى هولاكو. كان السفاح المغولي يعيث دمويةً في عالمٍ بلا قيم أو أعراف إنسانية، ولا قوانين فيه سوى الغزو والغنائم، أما السفاح الروسي فلا يستعيد أسوأ ما في الحقبة السوفياتية بل يستخدم ترسانته المتطورة بنوازع بالغة المغولية ليعيد العالم إلى ما قبل الحضارة، حتى أن أميناً عاماً بائساً للأمم المتحدة وصف ما يجري في حلب بأنه «أكثر من مذبحة»، أما مبعوثه إلى سورية، وهو أكثر تعاسة، فأورد تفاصيل مستندة إلى مصادر ميدانية لا يمكن أن تكون سوى أدلّة إثباتية لجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
أن يُتّهم بوتين بالإجرام فهذا لا يقلقه، بل على العكس يؤكّد له أن دمويته «سياسة» تنجح وتكسب وتحقّق الأهداف، بل إنه ينذر متّهِميه بـ «عواقب قانونية» إن لم يخرسوا. وأن يصبح قرين علي خامنئي وبشار الأسد وحسن نصرالله وقيس الخزعلي وبنيامين نتانياهو فهذا يعني أن لديه زبانية لا تقتصر على هؤلاء وقد نال مشروع قراره في مجلس الأمن أربعة أصوات بينها صوته وصوت مصر. منذ «الفيتو» الأول أدرك بوتين أنه يتقدّم وأن ورقة سورية تلمّع زعامته الدولية في مقابل دولة عظمى وحيدة استطاع أن يجعل منها مهزلة كبرى وحيدة. ومع «الفيتو» الخامس أصبح متيقّناً بأن طريقه إلى المجد وإلى تكريس تلك الزعامة يمر بالركام وبأنهار الدم في حلب. أما أن يفشل المجتمع الدولي في عقلنة بوتين، اعتماداً على وازع إنساني أو أخلاقي أو حتى سياسي لديه، فهذا لا يترجم عنده إلا بالعجز العسكري عن تهديده وردعه.
قبل عام أرسل بوتين طائراته إلى سورية واستعدّ لإنقاذ نظام الأسد، وقبل أن يطلق صاروخه الأول ذهب إلى نيويورك للقاء باراك أوباما على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة لعرض تنازلات في سورية مقابل تقاسم في أوكرانيا مع رفع العقوبات المفروضة على روسيا، وأثار أيضاً ضرورة التفاهم على ملفات عسكرية موضع خلاف في أوروبا. لم يحصل على صفقة فشرع في جولة أولى من القتل والتدمير في سورية ثم وجد مصلحة في الظهور كباحث عن حل سلمي وسياسي، وفيما تلاعب بالهدنات وبشروط التفاوض السياسي أكسبته الثنائية الروسية – الأميركية «اعترافاً» عالمياً بأنه صاحب قرار الحرب والسلم في سورية، وكان مستعداً لأي من الاحتمالَين، مهدّئاً ومصعّداً، شرط الحصول على تلك «الصفقة» مع أوباما. ومع اقتراب ولاية الأخير من نهايتها وجد بوتين أنه لم يعد هناك ما يمكن توقّعه من واشنطن فانتقل إلى ذروة التصعيد لتغيير وقائع الملف السوري، عسكرياً وسياسياً، استباقاً للإدارة الأميركية المقبلة.
مع «الفيتو» الخامس ذهب بوتين بعيداً في الاستهانة بالمجتمع الدولي، وفي إذلال إدارة أوباما دائمة التخبّط في تحديد خياراتها. وما دام أحداً لا يستطيع ردع «الدبّ الروسي» فإن الجلوس معه وهو يرفع يده وحيداً لرفض الإرادة الدولية شكّل «اعترافاً» بالأمر الواقع، الذي لم يعد تدخّلاً بطلب من نظام تأكّد إجرامه في حقّ شعبه بل غدا احتلالاً روسياً ناجزاً لسورية، بالتكافل والتضامن مع احتلال آخر تمارسه إيران وميليشياتها. ففي الأسابيع الأخيرة تضاعفت الترسانة الروسية على نحو غير مسبوق، وصادق مجلس «الدوما» الجديد على «اتفاق» يجعل الوجود الروسي في سورية دائماً. نسي الجميع الطابع «الموقّت» والمتعجل للتدخّل، كما قدمها بوتين قبل عام، وأصبحت المهمّة طويلة ومفتوحة ومرتبطة بـ «الأمن القومي» وفقاً لسيرغي لافروف في تحليله لتدهور العلاقة مع الولايات المتحدة واحتمال موافقة أوباما على ضرب قواعد ومطارات لنظام الأسد.
لن تقع مواجهة مباشرة بين الدولتَين الكبريين، إذ أنهما تتحاربان بسورية وشعبها فيما يقول خطابهما الإعلامي أنهما «تحاربان الإرهاب». أما الحاصل الآن فهو سقوط الأقنعة التي تبادل الأميركيون والروس التنكّر بها، وكان السؤال دائماً: أيّهما يستفيد أكثر من تواطئهما، ولم يكن يوماً: أيّهما يعمل حقّاً من أجل سلام في سورية؟ المؤكّد أن لدى بوتين حلفاء مستفيدين، فيما يندر وجود مستفيدين مع أوباما. والحاصل الآن أيضاً هو أن العجز الدولي يُطلق يد روسيا لتدمّر كما تشاء في سورية من دون أن تكون قادرة على الحسم عسكرياً ولتغرق في المستنقع من دون أن تكون قادرة على الحسم سياسياً. لكن الحاصل تحديداً هو سقوط سورية ووشوك احتمال اختفائها من الخريطة، وإذا حصلت مواجهة فإن نظام الأسد سيحتفل لاقتناعه بأنها من أجله وبسبب الأهمية التي يتمتّع بها، ولن يشاركه الاحتفال سوى الإرهابيين، إرهابييه الذين عوّل عليهم لإطالة عمره ويعوّلون عليه في بقائهم.
واقعياً أبلغ الروس إلى الفرنسيين والإسبان أنهم غير معنيّين بالعمل معهم أو حتى مع الأمم المتحدة، لكنهم أبلغوا أيضاً إلى الأميركيين أنهم غير مستعدين للتعاون/ التكاذب إلا معهم وإذا أرادوا أن تستمر «اللعبة» وتنجح فقد أصبحوا يعرفون ما المطلوب منهم. أي أنهم جعلوا الشعب السوري وقضيته رهن تناغمهم أو تنافرهم، مخيّرينه بين «داعش» وبوتين، وقبل ذلك بين الأسد و «داعش». أي أنهم يدفعون به دفعاً إلى التطرّف، تدعّشاً أو تأفّغناً أو تصوّملاً، على رغم أن لا مصلحة له في ذلك. لكن هذا ما يفرضه عليه الوجود الروسي «الدائم»، فالاحتلال الخارجي (الروسي والإيراني) يستدعي المقاومة والمواجهة كما استدعاهما الاحتلال الداخلي (الأسدي). أما معركة الحرية والكرامة فغدت معركة من أجل الاستقلال.
في أي حال كان الأسد والإيرانيون هم المستفيدون من «التعاون» الأميركي – الروسي لكنهم كانوا يخشون مقايضاتٍ بين الدولتَين، إذ لمسوا أن روسيا متمسّكة بأميركا لأن «الشراكة» معها توفّر لها «مشروعية» دولية تحتاج إليها، بمقدار ما كانت متمسّكة ولا تزال بالبحث عن «حل سياسي» ولو بالتلفيق ليشكّل تغطية لتدخّلها. أما وقد سقطت الأوهام والتمويهات فإن بوتين استعاد طبعه الإجرامي ليندفع نحو التدمير كحلّ عسكري، ولن يحصل عليه، فسورية ليست الشيشان والعالم الذي تعامى عن تدمير غروزني لن ينسى جريمته في حلب. هل يتطلّب الأمر حرباً عالمية لإعادة إنتاج المجتمع الدولي وإنهاء العجز والشلل في مجلس الأمن، طالما أن «الفيتو» يمنع معاقبة نظام الأسد على استخدامه السلاح الكيماوي، كما أنه يساعد روسيا نفسها على تعطيل إدانتها على جرائم الحرب في سورية؟
* كاتب وصحافي لبناني
الحياة
التجاذب الروسي الأميركي في الصراع السوري/ ماجد كيالي
تطورات الموقف الروسي
لماذا تقاتل روسيا؟
احتمالات التجاذب الثنائي
انهار التوافق الروسي الأميركي على وقف إطلاق النار في سوريا، بإعلان النظام انتهاء الهدنة، وبشن الطيران الروسي غارات وحشية بالقنابل الارتجاجية، على المناطق الشعبية الآهلة بالسكان في حلب، والخارجة عن سيطرة النظام، بحجة استهداف جبهة فتح الشام (النصرة سابقا)، وبدعوى عدم انفصال فصائل المعارضة “المعتدلة” عن تلك الجبهة.
في المقابل وردا على هذه التطورات، التي أعقبت الخلاف على تنفيذ بنود الاتفاق المذكور، بسبب رفض روسيا فرض حظر على طلعات الطيران السوري، وإصرارها على إدراج العديد من جماعات المعارضة العسكرية في قائمة الاستهداف، باعتبارها جماعات إرهابية، ومنعها دخول قوافل المساعدات الإنسانية إلى المناطق المحاصرة في حلب، واستهداف طيرانها قافلة مساعدات إنسانية أممية (21/09)، أعلنت الولايات المتحدة على لسان وزير خارجيتها وقف التعاون مع روسيا في الموضوع السوري، والبحث عن وسائل أخرى لوقف القتال؛ علما أن هذه هي المرة الثانية التي يفشل فيها اتفاق كهذا في هذا العام، إذ كان الأول في فبراير/شباط الماضي.
تطورات الموقف الروسي
بدت روسيا متفاجئة من التحول في الموقف الأميركي، إذ تسارعت التطورات بعده بإعلان وزارة الدفاع الروسية نشر صواريخ “أس 300 و400″، في قاعدتها البحرية في طرطوس ومطار حميميم، باعتبارها مجرد صواريخ دفاعية، علما أن هذه الصواريخ بإمكانها اعتراض وتدمير الصواريخ الباليستية متوسطة وبعيدة المدى التي تحلق بسرعة 4500 متر في الثانية، والصواريخ المجنحة وصواريخ “توماهوك”، وطائرات التجسس والتوجيه العملياتي؛ أي أن الغرض منها ليس مواجهة أي من جماعات المعارضة العسكرية، في رسالة ذات مغزى للولايات المتحدة.
فوق ذلك فقد اتبعت روسيا تلك الخطوة بإرسال المدمرتين سيربوخوف وزيليوني والسفينة الصاروخية ميراج إلى البحر المتوسط، وبإلغاء اتفاقيتيها مع واشنطن حول التخلص من البلوتونيوم الصالح لصناعة الأسلحة النووية وحول البحث النووي، في حين كان الطيران الروسي يكثف غاراته على حلب ومحيطها.
لم يقف الأمر عند هذا الحد إذ ترافقت هذه التحركات العسكرية بالتهجم على سياسة الولايات المتحدة، واتهامها بدعم الجماعات التي تنعتها روسيا بـ “الإرهاب”، فضلا عن التشكيك بصدقية موقفها إزاء انتهاج الحل السياسي للصراع السوري. بل إن روسيا وصلت إلى حد توجيه التهديدات إليها باحتمال التصادم، إن عن طريق اعتراض طائراتها من قبل صواريخ شبكة الدفاع الجوي الروسية، وحتى باعتبار أي استهداف لجيش النظام بمثابة استهداف للجيش الروسي من خلال عناصره العاملة في القطعات العسكرية السورية، إذ لوح الناطق باسم وزارة الدفاع إيغور وكلاشينكوف برد قوي من جانب الجيش السوري والقوات الروسية العاملة في سوريا في حال تعرضت مواقع النظام لضربات عسكرية.
كما دعا من وصفهم بـ “الرؤوس الحامية” في واشنطن إلى تذكر أن روسيا نشرت صواريخ “أس-300” في طرطوس و “أس400” في قاعدة حميميم باللاذقية، داعيا للتنبه إلى أن “مدى النظامين وقدراتهما ستحمل مفاجآت تنتظر من يفكر في الهجوم على سوريا”، وأن طواقم الأنظمة الروسية “لن يكون لديها الوقت الكافي لرصد مسارات الصواريخ بدقة أو من أي اتجاه تم إطلاقها”. وطبعا فقد تصاعد الأمر أكثر مع موافقة مجلس “الدوما” (البرلمان الروسي) على الإبقاء على وجود عسكري روسي دائم في الأراضي السورية.
ومعلوم أن التدخل العسكري الروسي، الذي بدأ قبل عام (أيلول/سبتمبر 2015) غير كثيرا من موازين القوى ومن معادلات الصراع في سوريا، بل منع النظام من الانهيار، وقوى موقفه على الأرض، كما حد من قدرة جماعات المعارضة العسكرية على التمدد، وكلف السوريين ثمنا باهظا في الأرواح والممتلكات، إلا أنه أسهم في تراجع نفوذ إيران في سوريا، واعتبار روسيا بمثابة صاحبة القرار الأول في الشأن السوري أمام العالم، كما أنها استطاعت من خلال ذلك فرض ذاتها كلاعب رئيس في المنطقة وكند للولايات المتحدة، بحسب ما تعتقد.
مع ذلك وبمعزل عن رأينا بما يجري، وبعدم أخلاقيته، سواء من طرف روسيا أو الولايات المتحدة، بالنسبة للسوريين، فإن هذه السياسة الروسية تعبر عن ضيق أفق، وتسرع وتبسيط، إذ تبدو روسيا كأنها استدرجت تماما للصراع السوري، لاستنزافها وإنهاكها، من دون أن تكون لها قدرة على استثمار ذلك سياسيا أو اقتصاديا، فلا إمكانيات سوريا ولا إمكانيات روسيا تسمح، في حين أن هذا الأمر لا يؤثر كثيرا على الولايات المتحدة، التي تبدو غير مبالية لما يجري، وهي تنظر لمزيد من غرق روسيا، ومن تصارع كل الأطراف، في سوريا.
لماذا تقاتل روسيا؟
يبدو واضحا من كل ذلك أن روسيا بوتين تخوض معركة كسر عظم مع الولايات المتحدة، أو أن هذا هو منظورها الإستراتيجي للانخراط في الصراع السوري، إذ من غير المعقول أن تغامر روسيا إلى هذا الحد في بلد صغير بموارده وبحجمه، بدعوى رفضها التدخل الخارجي ودفاعها عن سيادة دولة أخرى، أو بدعوى أن وجودها شرعي كونها مدعوة من قبل النظام، علما أن هذا النظام بات فاقدا للشرعية والسيادة في آن معا، طالما أنه لا يحفظ أمن واستقرار شعبه، بحسب المعايير الدولية، بل ويستهدفه بالقتل ويدمر عمرانه، ويشرده في أنحاء الدنيا.
لكن على ماذا تقاتل روسيا في سوريا إلى هذه الدرجة إذن؟ في الحقيقة ثمة عديد من ملفات الاشتباك بين روسيا والولايات المتحدة، من ضمنها: أولا، محاولتها استعادة مكانتها كدولة عظمى في العالم، أو كند للولايات المتحدة الأميركية، وهذا هو هاجس بوتين المهووس بداء العظمة وميله لاستعراض القوة. مثلا، ففي خطابه في مجلس الدوما (6/10) رفع بوتين شعار: “بناء روسيا القومية” وقال: “قوتنا في داخلنا، في شعبنا وتقاليدنا وثقافتنا واقتصادنا، وفي أراضينا الشاسعة وثروتنا الطبيعية وقدرتنا الدفاعية، والأهم في وحدة شعبنا”.
ثانيا، النزاع على أوكرانيا بعد خروجها من النفوذ الروسي، الأمر الذي رأى فيه بوتين أن الولايات المتحدة نجحت في تحجيم روسيا في فنائها الخلفي، وهو أمر يصعب على شخص مثله هضمه أو تمريره. ثالثا، غضب القيادة الروسية من تراجع أسعار النفط، والذي تحمل مسؤوليته للسياسة التي تنتهجها الولايات المتحدة والقوى الحليفة لها بغرض الضغط على روسيا وإضعافها. رابعا، إيجاد الأوراق التي تسمح ببذل الضغوط على الولايات المتحدة الأميركية لدفعها إلى التراجع عن العقوبات التي فرضتها على روسيا بخصوص حظر الصادرات التكنولوجية إليها.
خامسا، اعتبار المعركة ضد جماعات الإرهاب أو ضد القوى الإسلامية المتطرفة في المنطقة جزءا من الأمن القومي الروسي، ونوعا من حرب وقائية للحيلولة دون تمدد هذه الجماعات إلى جمهوريات آسيا الوسطى الإسلامية. سادسا، الرد على سعي الولايات المتحدة نشر شبكة “الدرع الصاروخي” في دول الجوار الروسي وبعضها كان ضمن الاتحاد السوفييتي السابق، وهذا أمر يؤرق القيادة الروسية ويثير مخاوفها. سابعا، ترويج السلاح، إذ تعتبر روسيا ثاني مصدر للسلاح في العالم بعد الولايات المتحدة، حتى أن بوتين ذاته روج بصفاقة للسلاح الروسي باعتباره أثبت فاعليته في سوريا.
احتمالات التجاذب الثنائي
بدورها حملت الولايات المتحدة على روسيا التي تستهدف المدنيين بوحشية، وبارتكاب جرائم حرب -كما باتهامها بقصف قافلة الأمم المتحدة والمستشفيات- مؤكدة ضرورة حظر القصف الجوي على الطيران السوري وإدخال المساعدات الغذائية إلى المناطق المحاصرة وعدم استهداف الجماعات المعتدلة، كشرط للتعاون معها في سوريا في مواجهة الجماعات الإرهابية (تنظيم الدولة وجبهة فتح الشام)، وأنها ستضطر إلى استخدام وسائل أخرى لفرض سياساتها.
في هذا الإطار بدا لافتا توجه الرئيس أوباما لدعوة كل مساعديه الأساسيين للاجتماع في البيت الأبيض لدراسة الخيارات الممكنة حول سوريا على ضوء التعنت الروسي، ما يفيد ربما بتولد قناعة جديدة في البيت الأبيض بضرورة اعتماد خيارات أخرى.
ومع الميل للاعتقاد بأن الإدارة الأميركية ستمارس ضغوطا سياسية ودبلوماسية هائلة لوضع حد للغطرسة الروسية، وهذا ما جرت محاولته في اجتماع الدول الخمس (الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا) لمناقشة الموقف الروسي (6/10)، وفي اجتماع مجلس الأمن الدولي (7/10)، ومع التلويح بفرض عقوبات على روسيا وسوريا من خارج مجلس الأمن الدولي، فإن كل ذلك لا يستبعد لجوء إدارة أوباما إلى استخدام نوع من القوة في الصراع السوري.
وبحسب التسريبات الصحفية فإن البيت الأبيض يدرس جملة من الخيارات: الأول، وينطوي على مراقبة الأجواء والقيام بدوريات روتينية والتعامل مع التهديدات المحتملة والمشاركة في عمليات البحث والإنقاذ. ولا تتوقف عملية فرض منطقة الحظر الجوي عند حد إسقاط الطائرات التي تحلق من دون إذن بل تعني أيضا، تدمير الأنظمة العسكرية التابعة للجيش السوري. وهي مهمة، ستكلف الولايات المتحدة، أربعين طائرة مقاتلة إضافية لتأمينها وتنفيذها.
الثاني، ويشمل إقامة وفرض مناطق آمنة حيث يمكن لمئات الآلاف من المدنيين البقاء فيها مما سيخفف من موجة تدفق اللاجئين على الدول المجاورة. وقد أوصى الكثير من القادة العسكريين بإنشاء منطقة كهذه على الحدود التركية وأخرى على الحدود الأردنية في الجنوب على أن تكون عملية حمايتها مؤمنة من قبل دول التحالف ودول الناتو إضافة إلى استخدام صواريخ باتريوت في الأردن وتركيا.
الثالث، اعتبار أن الحل الأسهل والأرخص لوقف عمليات القصف هو استهداف القواعد الجوية والمطارات العسكرية وغيرها للنظام السوري وتدميرها. مؤيدو هذا الخيار يعتمدون في دفاعهم عنه كونه خيارا من الممكن أن يتم بسرعة شديدة جدا، في غضون أربع وعشرين ساعة فقط، بالإضافة إلى أن تدمير القوة الجوية السورية، لا يتطلب الكثير من الموارد مقارنة بالخيارات الأخرى.
الخيار الرابع: تسليح المعارضة، إذ الممكن والمطروح هو خيار توفير أنظمة مضادة للطائرات لمسلحي المعارضة، وهي أسلحة متطورة وأنظمة صاروخية ستخولهم إسقاط الطائرات الروسية والمقاتلات السورية. ومن الأسلحة التي من الممكن أن تحصل عليها المعارضة وفق هذا الخيار، صواريخ مضادة للطائرات تطلق من الكتف. وهناك خيار خامس، ويتمثل ضرورة تدمير طائرات النظام فقط، فلا داع لتحصل معارضة لا تحبها واشنطن على مضاد طيران قد تضطر لإعطائه وبالتالي يشكل هذا المضاد خطرا عليها لاحقا. وبالتالي تدمير آخر شوكة للنظام أي يصبح الروس والأميركيون حصرا أصحاب السيادة الجوية.
يستنتج من ذلك أن كل الاحتمالات مفتوحة، مع أو بدون وجود جنود أميركيين على الأرض، علما أن هناك مئات من الجنود الأميركيين كقوات خاصة في شمال شرق سوريا، وثمة العديد من الجماعات العسكرية التي تعمل بإشراف أميركي، أي أن الولايات المتحدة ليست بحاجة لأكثر من ضربات صاروخية، وأجهزة تشويش على نظم الإدارة والتوجيه السورية والروسية لشل قدراتهما العسكرية، وفرض الحل السياسي الذي تريده.
طبعا سيكون هذا -ربما- بمثابة رد محدود ومحسوب، وكرسالة ذات مغزى من البيت الأبيض، لكن لا أحد يستطيع التكهن بردة الفعل الروسية، سيما بوجود شخصية مثل بوتين كرئيس متفرد في روسيا، مع شعور بالعظمة وتوهم بالجبروت، وميل لاستخدام القوة واستعداد للقتل، ما يعني أن كل الاحتمالات تبقى مفتوحة، من اشتباكات محدودة، إلى احتمال الانزلاق نحو حرب محدودة، أو ربما حرب عالمية ثالثة، خاصة مع اعتقاد بوتين أن العالم لا يستطيع إزاءه شيئا، وأن الولايات المتحدة أضعف من أن ترد.
على ذلك يبدو أن روسيا وريثة الاتحاد السوفييتي السابق الذي لم يتفكك بسبب الحرب، وإنما بسبب الإنهاك الاقتصادي الذي تعرض له، وبسبب خسارته في المباراة في مجال التكنولوجيا والعلوم، وبسبب سوء الإدارة، والافتقاد للحريات، معرض لتكرار ذات التجربة، بسبب الطريقة التي يدير فيها بوتين روسيا؛ وهذا ما ستبينه المغامرة البوتينية في سوريا على الأرجح.
الجزيرة نت
فلاديمير بوتين وصياغة المعادلة الدولية الجديدة من البوابة السورية/ د. خطار أبودياب
من عامه العسكري الثاني في سوريا إلى التوتر مع حلف شمال الأطلسي والتدخل في الانتخابات الرئاسية الأميركية، يعتمد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين استراتيجية القوة الهجومية في مسعاه لصياغة معادلة دولية جديدة تتبوأ فيها بلاده موقعا متميّزا عبر الاستفادة حتى آخر الخط من الانكفاء الأميركي في عهد باراك أوباما وضعف أوروبا. لكن المخاطر الكامنة وراء هذه العجلة واستسهال الكلام عن بدء الحرب العالمية الثالثة في التلفزيون الروسي الرسمي، يكشفان عن حدود لا يمكن لهذه الاستراتيجية أن تتجاوزها، وعن احتمال تفاقم الاضطراب الاستراتيجي والشكل الجديد من الحرب الباردة بعد تمركز الإدارة الأميركية الجديدة.
في الميدان السوري، الحقل الأساسي لتطبيقات “استراتيجية القوة الروسية”، لم تكن نجاحات موسكو لتتحقق من دون مراعاة ترتيبات عقدتها مع واشنطن بين سبتمبر 2013 (اتفاق إزالة الترسانة الكيميائية)، وسبتمبر 2015، موعد التدخل العسكري الروسي الكثيف.
من هنا بدأ الخلل لأنه مقابل عاصفة “السوخوي” وأفضل أنواع السلاح الروسي، أتت توافقات المايسترو جون كيري والعرّاب سيرجي لافروف لصالح وجهة النظر الروسية حول سيناريو الحل في سوريا، ولذلك كان مصير اتفاق التاسع من سبتمبر الماضي الفشل، لأنه كان منحازا وغطاء لتسهيل الحسم لصالح النظام.
تبعا لذلك ازدادت حملة التدمير خصوصا في شرق “حلب الشهيدة”، كما وصفها فرنسوا هولاند. ونظرا لانسحاب كيري “المؤقت”، سعت باريس من جديد إلى أخذ زمام المبادرة في الملف السوري، ليس من أجل تسجيل موقف أخلاقي فحسب، بل من أجل هدف سياسي يقضي بمنع سحق الحراك السوري واستكمال التدمير في الأسابيع الأخيرة لولاية أوباما وسط صمت دولي أو موافقة ضمنية، ولم يتردد وزير الخارجية الفرنسي وذهب إلى موسكو في محاولة لتمرير قرار من مجلس الأمن الدولي لوقف إطلاق النار ومنع استمرار التدمير المنهجي لشرق حلب، وتنازلت باريس عن البعض من نقاط المشروع مثل التلويح بالعقوبات، لكن روسيا التي تصر على لعب دور الخصم والحكم، قامت جريا على عادتها، منذ العام 2011، واستخدمت حق النقض الفيتو للمرة الخامسة في مجلس الأمن الدولي، ولكن هذه المرة لم تنحز إليها الصين في فرض الفيتو واكتفت بالامتناع عن التصويت، ولم تجمع موسكو وراء خيارها إلا أربع دول، ممّا يعني شبه عزلة وعدم تأييد غالبية العالم لموقفها المتمادي في سوريا.
في ظل التلكؤ الأميركي واستمرار التفتيش عن خيارات بديلة تبرز تساؤلات عن جدوى الخطوة الفرنسية. بالطبع لا يكمن هدف فرنسا في كسب مبارزات دبلوماسية داخل أعلى سلطة في النظام الدولي (حصل ذلك أيضا ضد واشنطن عشية حرب العراق وذلك في 14 فبراير 2003، أثناء جلسة الخطاب الشهير لوزير الخارجية الفرنسية الأسبق دومينيك دوفيلبان) وهي التي تستنتج أن فيتو الخمسة الكبار أصبح عقبة بوجه حفظ السلام، لكنها، على الأقل، تسعى من خلال هذا الضغط إلى إحراج موسكو وتحميلها مسؤولية الجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في سوريا.
ومن هذه الزاوية تمكن قراءة السبب الفعلي لإلغاء زيارة الرئيس فلاديمير بوتين الخاصة إلى باريس التي كانت مقررة في التاسع عشر من هذا الشهر. وينبري البعض للقول إن هذا الموقف الفرنسي “الأخلاقي” لا محل له من الإعراب في قاموس التوازنات الدولية، وإنه يندرج ضمن حملة علاقات عامة للتستّر على عجز فرنسا وأوروبا والغرب عن مواجهة الاستراتيجية الروسية، لكن رب قائل إن اختفاء القيم والأخلاق في الحسابات والاستراتيجيات يقودنا إلى شريعة الغاب، والأهم أن “الديك الفرنسي” نجح في التشويش على “الدب الروسي” وأزعج اندفاعته وأطلق العنان لحراك إعلامي وسياسي في الوقت المناسب.
بالتزامن مع لقاء لوزان الذي يجمع السبت 15 أكتوبر كلا من لافروف وكيري إلى جانب وزراء خارجية المملكة العربية السعودية وتركيا وقطر وإيران، وعشية اجتماع ما يسمى “النواة الصلبة لأصدقاء سوريا” في لندن بين كيري ونظرائه من أوروبا، يبرز سباق بين الفرصة الدبلوماسية الأخيرة قبل نهاية ولاية أوباما، واحتدام القتال مع التلويح باحتمال عمل أميركي عسكري محدود أو بتقديم المزيد من الدعم للمعارضة العسكرية للنظام.
إزاء هذه التطورات، يبدو القيصر الجديد محاربا مختالا “واثق الخطوات” ويتصرف كأنه لا يأبه بالضغوط والتداعيات لأنه قبل أن يصبح رئيسا للاتحاد الروسي لأول مرة في العام 2000، حذر في العام 1999 من تراجع موقع روسيا العالمي للمرة الأولى في تاريخها، وفي يناير 2007 هاجم بوتين في مؤتمر برلين للأمن، النظام الدولي أحادي القطب والهيمنة الأميركية على شؤون العالم. وبدأت مسيرة استرجاع الموقع مع حرب جورجيا في 2008، وذلك بالتوازي مع تحديث القوات المسلحة وإعادة هيكلتها بشكل تام، وبينما كانت دول حلف الناتو تقلص من الإنفاق الدفاعي (باستثناء الولايات المتحدة) أصبح الجيش الروسي في الوقت الحالي مجهّزا بشكل أفضل ويملك قدرات قتالية هائلة، لم يملكها منذ انهيار الاتحاد السوفيتي. وتزامنت عودة بوتين إلى الرئاسة في 2012 مع بدء الولاية الثانية لأوباما، وانتهز سيد الكرملين فرصة السبات الغربي وتمكن من خلال البوابة السورية والأزمة الأوكرانية من فرض معادلة دولية جديدة يغلب عليها التعطيل والسلبية، وجرت ترجمتها عبر التوتر مع حلف شمال الأطلسي من الجوار القريب إلى البلطيق، سواء بالسعي إلى نشر القوة البحرية عبر مناورات مع الصين في آسيا، أو استعراضات في البحر الأبيض المتوسط، وتمدد استراتيجي من همدان إلى طرطوس، بالموازاة مع دبلوماسية الصداقة مع إسرائيل أو دبلوماسية خطوط الطاقة مع تركيا.
من خلال استخدام الأدوات الدبلوماسية والاقتصادية والتهويل بالقوة الاستراتيجية الصاروخية والنووية تحاول روسيا خلق الانطباع بإمكانية العودة إلى زمن الثنائية القطبية، وهي من خلال الحرب الإلكترونية وأساليب الترهيب من الإرهاب والفوضى العالمية، تراهن على وصول دونالد ترامب إلى البيت الأبيض عله يكون بوريس يلتسين الولايات المتحدة الأميركية.
لا تدلل استراتيجية فلاديمير بوتين الهجومية حكما على تعاظم قدرات موسكو التي يعتمد اقتصادها في الغالب على إنتاج الطاقة وتجارة الأسلحة، بل إن سر قوة روسيا في هذه الحقبة يكمن في ضعف الآخرين.
أستاذ العلوم السياسية، المركز الدولي للجيوبوليتيك – باريس
العرب
بوتين أم البغدادي؟/ غسان شربل
القصة أخطر من حلب على رغم فظاعة ما يجري فيها وحولها. والقصة أكبر من الموصل على رغم أهميتها بالنسبة إلى المكون الذي تنتمي إليه والتوازنات الإيرانية – التركية على أرض العراق المريض. القصة أكبر من تفكك دولة هنا وهناك. ومن النزاع السني – الشيعي الفادح الخطورة. ومن أمواج القتلى واللاجئين. القصة أكبر من «داعش». إننا في بدايات مبارزة روسية – غربية تعني أمن العالم واستقراره واقتصاده. ولا جدوى من عقد المقارنات مع أزمات شهدها عالم المعسكرين وبينها أزمة الصواريخ الكوبية لأننا نعيش اليوم في عالم مختلف تماماً.
لن نتسرع في إصدار الأحكام والترويج لسيناريوات مثيرة. سنتوقف عند ما قاله رجل مسؤول لم يعرف بالتسرع أو التهور أو التشدد. إنه وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير. قال: «من الوهم الاعتقاد بأننا أمام الحرب الباردة السابقة. الفترة الحالية مختلفة، أكثر خطورة».
كلام ألماني آخر لولفغانغ أشنجر الذي عمل وسيطاً لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا في الأزمة الأوكرانية. قال: «إن خطر المواجهة العسكرية كبير. هذا الخطر لم يكن بمثل هذا الحجم منذ عقود والثقة بين الغرب والشرق لم تكن بتاتاً ضعيفة إلى هذا الحد».
ما شهدته قاعة مجلس الأمن خلال مناقشة مشروعي القرارين الفرنسي والروسي في شأن حلب يعطي التصريحات الألمانية قيمة إضافية. ليس بسيطاً أن توجه دول غربية كبرى إلى روسيا اتهامات بارتكاب «جرائم حرب» في حلب. وأن ترد روسيا بأن المشروع الفرنسي يمكن أن يوفر حماية للإرهابيين والتكفيريين.
لم تسمح روسيا برسم خطوط حمر لتحركها في حلب وسورية. قطع مندوبها فيتالي تشوركين عنق المشروع الفرنسي بسيف الفيتو. رفع تشوركين أصبعه وأسقط المحاولة الغربية. تذكرت الدول الغربية، أنها المرة الخامسة التي يرفع فيها تشوركين أصبعه ضد مشروع قرار يتعلق بسورية. الأولى كانت باكراً في 2011. وأصبع تشوركين هو أصبع بوتين الذي يهدد الغرب متظاهراً بأنه ينصحه أو يكتفي بانتقاده.
ارتفاع أصبع بوتين للمرة الخامسة دفع الدول الغربية إلى إعادة فتح دفاتره. حين تدخل بوتين عسكرياً في سورية لم يثر الغرب. ولعل بعض عواصمه فضلت رؤية سورية روسية على رؤية سورية إيرانية أو «داعشية». وهناك من توهم أن الرجل سينقذ النظام من السقوط ليرغمه في اليوم التالي على السير في حل سياسي استناداً إلى بيان جنيف أو ما يشبهه.
كان خيار أوباما في سورية واضحاً وقاطعاً. لن ينزلق إلى المستنقع السوري. اعتبر أن سورية لا تستحق دم الأميركيين وأموالهم وتحمل مسؤولية إعادة إعمارها لاحقاً. اغتنم فرصة تنازل النظام السوري عن ترسانته الكيماوية وابتعد. اليوم يشعر الغرب بأن الخدعة الروسية كانت كبيرة.
يفتح الغرب اليوم دفاتر السياسة «العدوانية» لبوتين. من القرم إلى أوكرانيا إلى سورية. من الطائرة الماليزية إلى قيام القاذفات الروسية باستفزاز دول أطلسية. وصل الخوف من روسيا إلى حد القلق من اختراقات قراصنتها للتأثير في سير الانتخابات الرئاسية في أميركا.
واضح أن الغرب يعيد حساباته. في دوائر القرار من يعتقد أن ارتفاع أصبع بوتين في مجلس الأمن كان يرمي إلى إطالة الحرب السورية بانتظار استكمال ظروف التدخل العسكري. وأن بوتين يتسلق أهرامات الجثث السورية بحثاً عن انتصار لا عن حل. وأنه يريد إطالة موسم إذلال الغرب وإغراق أوروبا باللاجئين وإرباك الاتحاد الأوروبي ومعه الأطلسي. يريد أيضاً أن لا يبقي أمام الرئيس الأميركي الجديد غير الاعتراف بالانتصار الروسي في سورية والقبول بتعديل جدي في موازين القوى بين «القوتين العظميين».
من هو العدو الأول للغرب بوتين أم أبو بكر البغدادي؟ يبدو السؤال غريباً لكن ما يجري يُجيز طرحه.
ما فعله البغدادي شديد الخطورة. هبط من كهوف التاريخ واستولى على الموصل. ألغى الحدود السورية – العراقية وأطلق انقلاباً مدوياً على اتفاقات سايكس – بيكو. أرسل مفاعل «داعش» إشعاعاته في كل الاتجاهات. عبرت سمومه حدود الدول والقارات. ارتكابات صارخة. وضربات فظة. وخلايا نائمة. وذئاب منفردة. ألهب العلاقات السنية – الشيعية. وسكب الزيت على نار الأقليات وجروح التعايش.
أقلق البغدادي العالم واحتل سريعاً موقع العدو الأول. في العواصم الغربية اليوم من يسأل أيهما أخطر بوتين أم البغدادي. وظف بوتين إطلالة البغدادي واستيلاء المتشددين على الثورة السورية لإطلاق برنامج الثأر الكبير. الثأر من الغرب الذي دمر الاتحاد السوفياتي من دون إطلاق رصاصة. والثأر من حلف الأطلسي الذي يحاول تطويق روسيا وإذلال صورتها وسلاحها. إذا استنتج الغرب أن موعد تقليم أظافر القيصر قد حان فإن سورية مرشحة لما هو أدهى ومعها المنطقة أيضاً.
الحياة
هل فات الوقت على إنقاذ حلب/ روزانا بومنصف
استخدم الغرب إحدى أبرز الوسائل الكفيلة بإحراج روسيا وحربها الجارية في سوريا، وخصوصا مساهمتها القوية في تدمير حلب ومساعدة النظام السوري من أجل استعادة السيطرة عليها من خلال إعلام قوي لكبريات الصحف تتهم روسيا الى جانب الديبلوماسية الاوروبية بارتكابها جرائم حرب في سوريا. والاتهام نفسه يسري بالنسبة الى النظام السوري، إلا أن التركيز هو على روسيا بحيث لا يعتقد ان النظام وحلفاءه على الارض يستطيعون استعادة حلب من دون الغطاء الجوي الروسي، وفق ما أظهرت محاولات عدة لهم في هذا الاطار خلال العام الماضي. ووازت هذه السياسة أو واكبتها مواقف تساهم في عزل روسيا في المجتمع الدولي، على غرار إلغاء الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند استقبالا للرئيس الروسي في فرنسا كان مقررا في 19 من الجاري على خلفية انتقاد فرنسا مساهمة روسيا في قصف حلب ومواقف اميركية واوروبية ديبلوماسية حادة لم تنجح الديبلوماسية الروسية التي رمت الكرة في ملعب ما سمته رعاية اميركا لـ”جبهة النصرة”، لرفض واشنطن الفصل بين المعارضين في حلب، في ان تبرر قصف المدينة وتدميرها بذريعة ان هناك فصائل مصنفة ارهابية في المدينة. ومع ان بعض الديبلوماسيين يعتبرون ان حركة هولاند تتصل باعتبارات فرنسية داخلية من ضمن الانتخابات التي يتم الاستعداد لها، ودفاعا عن موقف فرنسا دوليا إزاء سوريا، باعتبار ان اتصالا هاتفيا جرى بين هولاند وبوتين وميركل حول سوريا لاحقا، فإن ذلك محرج للرئيس الروسي الذي كان يستعد لزيارة فرنسا ورعاية افتتاح كنيسة هناك. حتى ان استخدام روسيا للفيتو على مشروع القرار الفرنسي الرامي الى وقف الحرب على حلب، كان نقطة لم تصب في مصلحة روسيا، علما أنه الفيتو الخامس الذي تستخدمه موسكو حماية للنظام في سوريا، مما دفع الامور في اتجاهين، أحدهما مبادرة سعودية – قطرية تمثلت في توجيه رسالة الى الجمعية العمومية تطالب بحماية المدينة والمدنيين، والثاني مشروع قرار اعدته نيوزيلندا ووزعته على اعضاء مجلس الامن يدعو الى وقف كل الهجمات، فيما وجهت كندا وليشتنشتاين خطابا الى رئيس الجمعية العمومية تطلبان فيه عقد جلسة خاصة الاسبوع المقبل لمناقشة الوضع المتدهور في سوريا. وفي غضون ذلك، أعلن عن إجراء محادثات دولية حول سوريا في سويسرا غدا السبت، تجمع الوزيرين جون كيري وسيرغي لافروف ووزراء خارجية عدد من الدول الاقليمية، قبل ان يعقد اجتماع آخر في لندن الاحد لمجموعة أصدقاء سوريا.
هل فات الوقت على إنقاذ حلب؟
الواقع أن كل المواقف الديبلوماسية في مجلس الامن قد لا تكون مجدية عملانيا، لأن أي مشروع في مجلس الامن يمكن ان يقابله فيتو روسي، فيما قرارات الجمعية العمومية غير ملزمة، حتى لو نالت إجماعا كليا من كل الدول، في حين ان اتهام روسيا بجرائم الحرب جنبا الى جنب مع النظام السوري يفترض ان يؤدي بهما الى المحكمة الجنائية الدولية، فيما ليس هناك آلية تؤدي الى ذلك. فالمجتمع الدولي محرج لجهة إظهار عجزه عن وقف العنجهية الروسية الداعمة لوحشية نظام بشار الاسد في قصف المدن وحصارها. ويتوقع ديبلوماسيون متابعون ألا تكون الاجتماعات المرتقبة نهاية هذا الاسبوع سوى محاولة من موسكو لكسر عزلتها، وسعي الى إظهار رغبتها في وقف الحرب، وتاليا دحض الاتهامات التي توجه اليها، في حين أن الديبلوماسية الاميركية محرجة بإنهاء أوباما ولايته، في ظل انطباع بأنها استسلمت كليا لروسيا في سوريا وسلمتها الوضع هناك نتيجة سلبية الادارة الحالية. وإذا لم تشارك ايران ايضا في الاجتماعات، في الوقت الذي ستشارك فيه السعودية وتركيا وربما دول اقليمية أخرى، فمن غير المرتقب أن يكتسب البحث عن حل، بعدا شموليا، حتى لو كان الامر سيقتصر على وقف النار. وإذ استبق الرئيس الروسي الاجتماع المرتقب غدا بالاعلان انه يصعب التحاور مع الادارة الاميركية الحالية، فإنما يشي ذلك بالنسبة الى الديبلوماسيين المعنيين بأنه من غير المتوقع ان يعطي بوتين ادارة راحلة اي شيء، وان كل من يكون مكانه سيقوم بالمثل، خصوصا لجهة محاولة فرض أمر واقع في سوريا يصعب على الادارة الاميركية المقبلة عدم أخذه في الاعتبار، خصوصا إذا كانت المرشحة الديموقراطية هيلاري كلينتون هي من ستفوز في الانتخابات الرئاسية الاميركية، وما اتخذته من مواقف من موضوع سوريا يمكن اعتبارها متقدمة على ادارة الرئيس الحالي. وتقول مصادر ديبلوماسية أخرى إن رفع بعض الدول سقف التهديدات أمام روسيا التي دعت مثلا الى عدم تزويد المعارضة السورية مضادات للطائرات، يوحي ان هذا الاحتمال وضع على الطاولة في حال عدم توقف روسيا عن تأمين غطاء جوي للنظام يمكن ان ينجح، باعتبار ان روسيا تعرف جيدا ان استعادة السيطرة على حلب تقوي أوراق بشار الاسد، لكن لا تنهي الحرب، في حين يمكن ان تستعر هجمات انتقامية ضد روسيا كما حصل في افغانستان. أضف الى ذلك أن أساليب المواجهة لا تقتصر على دعم المعارضة السورية، بل ان هناك مصالح نفطية ومصالح استراتيجية يمكن استخدامها كضغوط تحول دون سقوط حلب التي تبقي التوازن الاقليمي قائما رمزيا بحد معقول في فترة الفراغ المتصلة بزمن الانتخابات الرئاسية الاميركية. إلا أن التقاط روسيا اقتراح الموفد الدولي الى سوريا ستافان دو ميستورا حول استعداده لمرافقة عناصر النصرة الى خارج حلب تفاديا لتدميرها ربما يكون ما يلوي ذراع واشنطن والدول الاخرى من اجل المساومة على وقف قصف حلب، فيكون الغرب أنقذ ماء وجهه.
النهار
النفوذ الروسي ـ الإيراني باق ويتمدّد؟
رأي القدس
تشهد مدينة لوزان السويسرية غدا السبت لقاء يجمع الولايات المتحدة وروسيا ومجموعة من الدول الإقليمية هي تركيا وإيران والسعودية وقطر يتبعه اجتماع آخر في لندن في اليوم التالي (الأحد) في لندن يضم الروس والأمريكيين مجدداً وبعض الدول الأوروبية.
يأتي ذلك بعد المعركة الدبلوماسية التي جرت السبت الماضي (9 تشرين أول/ أكتوبر) في مجلس الأمن والتي شهدت نزالاً بين قرارين مقدّمين من فرنسا وروسيا، حيث تم إسقاط الأول بفيتو روسي والثاني برفضه من قبل تسعة أعضاء من أصل 15 عضواً لمجلس الأمن.
معلوم أن إحدى المفاجآت التي تمخّضت عن الاجتماع كان تصويت مصر لصالح القرار الروسيّ وهو ما أدّى إلى أزمة غير مسبوقة في العلاقات السعودية ـ المصرية تفاعلت على ضوء وقف الرياض إمداد القاهرة بالنفط ونشوب معركة إعلامية بين الطرفين إضافة إلى خضّات ملحوظة تمثّلت بتراجع سعر الجنيه وتفاقم أزمة النفط في السوق المصرية.
الروس من جهتهم تابعوا التصعيد العسكري والسياسيّ من خلال إلغاء اتفاقيتين حول البلوتونيوم والبحث النووي مع نظرائهم الأمريكيين، والإعلان عن إمكانية التصدي لأي هجمات على جيش النظام السوري، كما طلبوا، للمرة الأولى، من «شركائهم» (وهو تعبير جديد يلمّح بالطبع إلى تركيا والأردن) عدم تزويد المعارضة السورية بأسلحة مضادة للطيران، كما قاموا بإرسال مزيد من السفن الحربية إلى المتوسط، ولكن موسكو، هذه المرّة، وجّهت هذه السفن ليس إلى سواحل سوريا فحسب بل كذلك إلى السواحل المصرية، وهي خطوة لا تخفى دلالاتها الواضحة.
الأمريكيون الذين أعلنوا وقف مباحثاتهم مع روسيا حول سوريا ما لبثوا أن عدلوا بسرعة عن ذلك فاتصل وزير خارجيتهم جون كيري بنظيره الروسي سيرغي لافروف وتنازلوا مجددا لروسيا فطلبوا اللقاء مجدّدا معهم في لوزان ولندن، وهو أمر يصعب ألا يفهمه الروس على أنه استعداد لتنازل أمريكي جديد.
نشهد في الوقت نفسه مزيداً من الاستعدادات العسكرية في العراق لبدء معركة الموصل، وتواصل وكالات الأنباء العالمية إرسال صور للحشود العسكرية المتوجهة إلى جبهة الموصل تحمل رايات شيعيّة وتصريحات علنيّة لقادة الميليشيات تضع كل ما يجري في إطار خدمة مصالح إيران وتحت إشراف قائدها العسكري قاسم سليماني. يجري ذلك برعاية أمريكية عبر إعلانات عن تزايد «مستشاريها» العسكريين وتزويد القوات العراقية بأنظمة سلاح جديدة، تقابله تأكيدات متكررة أن تركيا «ليست جزءاً من التحالف» المشارك في «تحرير» الموصل.
وكما تصعّد موسكو فتتراجع واشنطن، يحصل الأمر نفسه مع طهران وحلفائها في المنطقة. لا يتعلّق الأمر بخطابات «البروباغاندا» المعروفة عن «الموت لأمريكا وإسرائيل»، بل يتجاوز ذلك إلى قيام الحوثيين (حلفاء إيران في اليمن) بإطلاق صواريخ مرّتين على المدمرة الأمريكية «ماسون» ثم قيام طهران بعد ذلك بإرسال سفن حربية إيرانية إلى سواحل اليمن. رد الدولة العظمى على ذلك تمثّل بتعطيل ثلاثة رادارات للحوثيين شمال مضيق المندب وقد اقتضى ذلك قرارا من الرئيس الأمريكي باراك أوباما وتوصية من وزير الدفاع أشتون كارتر ورئيس هيئة الأركان المشتركة جوزيف دانفورد وفوقها تبرير أمريكي يقول إن ما حصل كان «دفاعا عن النفس»!
لا يتعلّق كل ما يجري بعطالة أمريكية أو عجز عن الرد ولكنه، بالأحرى، قرار استراتيجي بتسليم المنطقة لروسيا وإيران للقيام بما يسميه الأمريكيون «العمل القذر».
يستند هذا القرار إلى أسس استراتيجية تمخّضت عن سقوط الاتحاد السوفييتي، وهي شديدة التقارب بين واشنطن وموسكو في النظرة إلى دور الإسلام السنّي الخطير، كما يستند، حاليّا، إلى حاجة أمريكية لتوظيف الجهد الروسي ـ الإيراني لإضعاف مكوّنات هذا الإسلام السنّي وتشكيلاته، ولا يهم ضمن هذه النظرة الاستشراقية «الاستراتيجية» الأمريكية أن تركيّا تدار بنظام ديمقراطي ذي أسس غربية، أو أن السعودية كانت حليف واشنطن الموثوق طوال عقود طويلة.
في هذه الأثناء، لا عجب، أن النفوذ الروسي ـ الإيراني باق ويتمدّد!
القدس العربي
روسيا الضعيفة/ حسين عبد الحسين
تكاد روسيا تسجل حضورها في كل ملف حول العالم. في حلب، مقاتلاتها تقصف السوريين. في الأمم المتحدة سجلت اعتراضها ضد مهاجمة المرشح الجمهوري دونالد ترامب، قبل أن تنقض قراراً لفرض وقف الحرب السورية. في الانتخابات الرئاسية الاميركية، اوعزت لـ”ويكيليكس” بنشر البريد الالكتروني التابع لمدير حملة المرشحة الديموقراطية هيلاري كلينتون لتشتيت الانتباه عن فيديو اطلق فيه ترامب تصريحات مشينة بحق النساء.
لكن موسكو لا تدرك أن مشاغبتها المتواصلة لا تجدي. في واشنطن، كشفت وكالات الاستخبارات الدور الروسي في اختراق الحسابات الاميركية. القدرة الاميركية في السيطرة على الانترنت تفوق نظيرتها الروسية، والاستخبارات الاميركية سبق أن زرعت برامج في الشبكة الروسية تكشف المشاغبة الروسية، على الرغم من اعتقاد الروس انهم يقومون باختراقاتهم سراً.
في نشر “ويكيليكس” للبريد الالكتروني التابع لجون بودستا مدير حملة كلينتون، يبدو جلياً أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وصاحب “ويكيليكس” جوليان اسانج لا يفهمان العقلية الاميركية، وإلا لأدركا أن العبارة التي اعتقدا انها ستؤذي كلينتون، في قولها إنها بعيدة عن الطبقة الوسطى، لا تؤثر في رأي الناخب الاميركي. لم يلاحظ بوتين واسانج ان آخر مرشحين للحزب الجمهوري، ميت رومني ودونالد ترامب، هما من اصحاب الثروات الطائلة، وهو ما لا يمانعه الاميركيون.
كما لا يبدو أن “ويكيليكس” تتابع المشهد الاميركي، لأنها لو تابعته لأدركت ان قول كلينتون إن تعقّب زعيم تنظيم القاعدة الراحل أسامة بن لادن جرى عبر مخابرة هاتفية، ليس سراً كشفته كلينتون، بل هو معلومة عامة متوفرة حتى في أفلام هوليوود التي تصور عملية قتل بن لادن.
وفي الأمم المتحدة، يبدو ان موسكو اخطأت في تقدير مدى نفوذها في مجلس الأمن، إذ لم يصوت على مشروعها سوى الصين وفنزويلا ومصر، والصين كانت وعدت فرنسا وبريطانيا بعدم نقض القرار الغربي مع موسكو، وهو ما حصل، فبدت ديبلوماسية موسكو بقيادة بوتين شبه عارية، واضطرت لاستخدام الفيتو لوقف القرار الغربي.
على أن كل مكامن الضعف الروسي هذه لا تظهر في سوريا، حيث تبدو موسكو صاحبة الكلمة الاخيرة، وتحذر الاميركيين من مغبة تلويحهم بالخيار العسكري، وتعلن تعزيز منظومة الدفاع الصاروخية التي نشرتها في سورية سابقاً “اس-400″، بمنظومة أضعف منها “اس-300″، وهي خطوة اثارت سخرية الخبراء العسكريين، فيما أعلنت اسرائيل قلقها علنا. ولو كانت روسيا اقفلت السماء السورية بمنظومة “اس-400” حسبما أعلنت قبل أشهر، لكانت خطوة نشر “اس-300” لم تثر الاسرائيليين.
بيد أن الاميركيين يعلمون أن كلا المنظومتين الصاروخيتين لا تعملان في سوريا، وأن كل تصريحات المسؤولين الروس هي من باب استعراض فارغ للقوة، لعلم موسكو ان واشنطن بقيادة الرئيس باراك أوباما لن تتدخل عسكرياً غرب الفرات، ولعلم موسكو ان أوباما ينوي مواجهة الروس بتسريباته الاعلامية لا غير.
ربما يعلم بوتين أيضاً أن أوباما قارب الخروج من الحكم، وأن الاستياء الاميركي من استفزازته بلغ أقصاه. حتى المرشح لمنصب نائب رئيس عن الجمهوريين مايك بنس خالف رئيسه ترامب، وقال إن الوسيلة الوحيدة للتعامل مع موسكو هي “القوة”.
أما خيارات الولايات المتحدة في زعزعة الروس فكثيرة، وتتضمن اختراق حسابات روسية، بما فيها حسابات بوتين ومناصريه المالية، ونشرها حتى يتفرج العالم على فساده وثروته. كذلك يعتقد الاميركيون أن بامكانهم فرض عقوبات مالية قاسية تؤذي نظام بوتين وتمنع المقربين منه من استخدام ارصدتهم في بريطانيا والاستمتاع باجازاتهم في اوروبا الغربية وأميركا.
وفي سوريا، يعتقد الاميركيون أن بإمكانهم القضاء على سلاح الجو للرئيس السوري بشار الأسد في ساعات، ونشر بطاريات صواريخ تجبر المقاتلات الروسية على وقف غاراتها ضد مناطق المعارضة.
في الماضي، حاولت الصين اختراق حسابات اميركية لسرقة اسرار صناعية. واجه الاميركيون الصينيين، وهددوا بعقوبات مالية على المسؤولين وهجمات الكترونية مضادة. ادرك الصينيون فداحة الموقف وتراجعوا واوقفوا تحرشهم الالكتروني بأميركا.
الاميركيون يشكّون اليوم أن بوتين سيدرك، كالصينيين، مدى إمكاناتهم. ربما يعرف بوتين أن أمامه مهلة حتى خروج أوباما من الحكم، فبوتين لم يكن على هذه العنجهية في الماضي القريب، لكن ارتباك أوباما وتردده في سياسته الخارجية هو الذي دفع بوتين الى مغامراته الالكترونية ضد اميركا والعسكرية ضد السوريين، او على قول المثل المشرقي الشائع “يا فرعون من فرعنك، قال لم اجد من يردّني”.
العرب
حربان «روسيتان» في أوكرانيا وسورية… من غير نصر
غازيتا
العملية الروسية في سورية، والتي كانت محاولة لتحويل الأنظار عن الأحداث في شرق أوكرانيا، صارت بعد عامها الأول واحدة من أكبر وأوسع الأعمال العسكرية الروسية، في مرحلة ما بعد انهيار الاتحاد السوفياتي. لكن الحرب في سورية لم تتوج بالنصر، كما لم ينسَ المجتمع الدولي الأحداث التي وقعت في أوكرانيا، خصوصاً أن الذكرى الأولى للعملية الروسية تزامنت مع صدور التقرير الأولي للتحقيق في كارثة الطائرة الماليزية فوق شرق أوكرانيا. وتوالى حدثان في غاية الأهمية في السياسة الروسية الحديثة بفارق بضعة أيام. أولاً، خلص المحققون إلى أن الطائرة أسقطت بصاروخ «بوك» الروسي الذي أطلق من الأراضي التي يسيطر عليها الانفصاليون الأوكرانيون. وثانياً، وقع تصعيد جديد في سورية يهيء لجولة جديدة من التوتر مع الولايات المتحدة. فيما انتشرت أنباء تفيد بأن واشنطن تنوي وقف التعاون الديبلوماسي مع موسكو حول سورية.
وقبل عام، عندما بدأت موسكو عملياتها في سورية، كان أبرز أهدافها هو السعي إلى نقل أنظار العالم واهتمامه عن الأزمة في الدونباس الأوكراني. واتفق هدف موسكو، وهو محاربة تنظيم «داعش»، مع الهدف الأساسي للكرملين أي دعم نظام الأسد، الذي تدرجه واشنطن في سلم الأعداء في موقع أدنى ببضع درجات من المتطرفين الإسلاميين. ويشير التدخل الروسي في الصراع السوري إلى عدم اكتفاء موسكو بصفة القوة الإقليمية في فضاء الاتحاد السوفياتي السابق. واليوم، القوات الموالية للأسد، بدعم من القوات الروسية تتقدم على جبهة حلب – ثاني أكبر مدن سورية، والتي قبل خمس سنوات، في بداية الصراع، كانت مسرح «أم المعارك». وإذا نجح الهجوم، مالت كفة التوازن الاستراتيجي، للمرة الأولى منذ بداية الأزمة، إلى الأسد. وهذا لا يعجب الولايات المتحدة التي تتهم روسيا بأنها لا تقاتل الإسلاميين بل معارضي الأسد. وتعتبر موسكو أنّ فصل المعارضة «المعتدلة» عن الإرهابيين عسير بلّ متعذر، في وقت أعلنت واشنطن ولندن استعدادهما لفرض عقوبات جديدة على روسيا.
ولا شك في أن الصراع في سورية لم يرص صفوف القوى العالمية على شكل «الحلف الدولي ضد هتلر» الذي تحدث عنه بوتين، بل فاقم التوتر والشقاق. أما صدور التقرير الأولي للتحقيق في حادثة الطائرة الماليزية فوق شرق أوكرانيا فأظهر أن العالم لم ينسَ تلك المأساة بعد.
والمشكلة ليست في أخطاء السياسة الخارجية الروسية، بل في عقيدتها. فالعقيدة العسكرية الروسية تحسب أن ثمة مؤامرة عالمية على رأسها الدول الغربية بقيادة الولايات المتحدة تسعى إلى احتواء روسيا. ولا يتقبل الكرملين ببساطة حقيقة أن تقلص النفوذ الروسي الاستراتيجي ليس نتيجة محاربة قوى خارجية لنا فحسب، بل هو ناجم كذلك عن المشاكل الكبيرة في اقتصادنا وعدم جاذبية المشروع الروسي في أوساط النخب الأجنبية ومعظم الروس. لذا، تتدخل روسيا في كل أزمة لحماية «حقوق روسيا التاريخية» ومصالحها، كما يرى الكرملين. ولكن من الجانب الاستراتيجي، وبحسب تجربتي أوكرانيا وسورية، تواصل روسيا زرع الاضطراب، ثمّ تغرق نفسها فيه. والسابقة الوحيدة الناجحة للخروج السريع من الصراع هي المواجهة التي حصلت مع تركيا. ولكن التجربة هذه، وإلى حين الانتهاء من مد خط أنابيب «التيار التركي»، لا يمكن اعتبار أنها انتهت وطويت. والقتال على جميع الجبهات محكوم بعواقب لا تحمد عقباها.
وإذا انتصر الأسد في حلب، لم يترتب على الانتصار أي شيء غير تصريحات صاخبة لمسؤولينا وديبلوماسيينا. فالانتصار هذا ليس ضمانة شيء، في وقت ثبت، بعد عام على هذه الحملة، أنّ لا حلفاء لروسيا في المنطقة. وحتى طهران، التي راهنت عليها موسكو، تجنبت إبداء الدعم للقوات الروسية، (لم تمنح قاعدة للطائرات الروسية، ولم تمدها بقوة بشرية على أرض المعركة). وترددت إيران في الدخول في تحالف مع لاعب لا يمكن التنبؤ بمواقفه (روسيا) في لحظة استئناف علاقاتها مع دول العالم.
وعليه، صمود نظام الأسد بالاعتماد فحسب على الدعم العسكري الروسي، غير كافٍ، في منطقة تختزن المصالح، وهي منطقة مشبعة أو متخمة بالأسلحة، مثل الشرق الأوسط. والروس يرون أن الانسحاب من سورية أو وقف دعم الجمهوريات الانفصالية في شرق أوكرانيا هو مؤشر ضعف. فأبرز الأهداف غير المعلنة لسياسة الدولة العدوانية هو إظهار الكرملين كالمدافع الأول عن «العالم الروسي»، وإبراز روسيا كـ»قوة عظمى». ويبدو أن الخوف في نفوس وأذهان السياسيين من إظهار الضعف أمام الروس هو أكبر من أي شيء آخر. وهو عامل راجح. ولا يخفى أنّ الروس تعبوا من القتال الذي طال أمده، في وقت تفرغ الثلاجات في منازلهم. وتشير استطلاعات الرأي الرسمية إلى أنّ اهتمام الروس بالأحداث في سورية انحسر من 73 في المئة في آذار (مارس) الماضي إلى 60 في المئة في تموز (يوليو) الماضي.
ويرى الروس أن مبررات العملية الروسية في سورية ضعيفة. ولكن إذا توقفت العملية من دون تحقيق أي نصر هام، خلفت أثراً سلبياً في الداخل الروسي. وبما أن النصر هو، مع مرور الوقت، أقرب إلى الوهم، يبث الدوران في هذه الحلقة المفرغة القلق في صدر السلطات الروسية. وعليه، ربما حان الوقت لندرك أنّه في اللعبة الجيوسياسة الكبرى يتعذر الانتقال إلى الجولة التالية من دون الانتهاء من سابقتها. فالأزمات تتراكم والظروف ضد مصالحنا.
* هيئة التحرير، عن «غازيتا» الروسي، 29/9/2016، إعداد علي شرف الدين
الحياة
مستنقع سوري لا يثقل على جيب روسيا/ ليز سلاي
ساهم التدخل الروسي في سورية، إثر مرور عام من العمليات الروسية الرامية الى دعم الحكومة السورية، في بلوغ موسكو أبرز هدفين من أهداف حملتها العسكرية. فسيطرة الرئيس الأسد على دمشق صارت في منأى من تهديد المتمردين الذين ثاروا عليه في السنوات الخمس الأخيرة. ورسخت موسكو دورها قوة إقليمية ودولية، وبرزت لاعبــاً حيوياً في تسوية الحرب السورية. لكن الهدف الثالـــث من التدخل الروسي لا يزال أثراً بعد عين. ولا يبدو أن الدعم العسكري الروسي للأسد يوجه ضربة قاضية وقاصــمة الى الثوار المعادين للأسد، ولا يرجح كفة موسكو في اتفاق تسوية. وعلى خلاف ما تنبأ الرئيس باراك أوباما حين شنّ الروس تدخّلهم قبل عام، لا مؤشرات الى غرق موسكو في «المستنقع» السوري. ولم تظهر علامات الوهن على الجيش الروسي. واليوم، تنفخ روسيا في زخم دعمها العسكري للأسد، ويتعاظم العنف وتكر سبحته.
والمفاوضات مع الولايات المتحدة انهارت على وقع تنديدات غاضبة، وبرزت شكوك تطعن في الجدوى المرتجاة من التعاون بين موسكو وواشنطن في سورية وتعبيده الطريق أمام طي النزاع. والمقاتلات الجوية الروسية تدعم دعماً شرساً عملية استعادة شرق حلب، وهي نواة دموية للنزاع على مقاليد سورية. وأمطرت القوات الروسية أحياء سكنية ومستشفيين في حلب بقنابل فوسفورية وعنقودية. وأعلنت منظمة الصحة العالمية أن 338 شخصاً – منهم مئة طفل – قتلوا في غارات الأسبوع الماضي. وعدد الضحايا الى ارتفاع. وأعلن الكرملين أن روسيا لا تنوي تخفيف تدخّلها في سورية. وقال الناطق باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، أن ثمار التدخل الروسي انعقدت. فتنظيمات إرهابية مثل «داعش» و»جبهة النصرة» المتحدرة من «القاعدة»، أخفقت في السيطرة على دمشق.
لكن وتيرة التقدم في مواجهة الثوار كانت أبطأ خارج دمشق. فالمعارك في شمال غربي محافظة اللاذقية مضت قدماً، لكنها تعثرت في جوار الحدود التركية. ومساعي إطباق الحصار على الجزء الذي يسيطر عليه الثوار في حلب – وهذا ما ترمي إليه الحكومة السورية منذ سيطرة الثوار على شطر المدينة الشرقي في 2012 – على حالها من البطء منذ عام. ويتكبد خسائر هذه العمليات مئات الجنود السوريين وعناصر ميليشيات لبنانية وعراقية تدعمها إيران.
وعلى رغم التضييق عليهم في حلب، يتقدّم الثوار في محافظة حماه، فهم سيطروا على سلسلة من البلدات ويتقدمون على بعد ستة أميال من مدينة حماه، التي كانت مركز احتجاجات سلمية ضد الأسد قبل أن تقمع. وتقدُّم الثوار يسلّط الضوء على مسألة بارزة: هل يسع الحكومة السورية والدعم الروسي إلحاق الهزيمة بالثوار؟ ويرى جيف وايت من معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى، أن الفوز العسكري لا يزال بعيداً، لكن موسكو ترمي الى إحرازه تدريجاً. ويشير الى أن مواقع المعارضة السورية العسكرية لم تتحسن منذ ربيع 2015، والنظام لم تنزل به خسائر جسيمة مذاك. ويقول روبرت فورد، السفير الأميركي السابق الى سورية، أن لحظة طلب روسيا مخرجاً من سورية لم تحن بعد، على خلاف ما توقعت إدارة أوباما. فهذه حسِبت أن موسكو ستغرق في سورية وستطلب مخرجاً من المأزق السوري.
ولا شك في أن عدد القوات الروسية في سورية قليل، وشطر راجح منها من المستشارين. ومعظم العمليات ينفذها سلاح الجو الروسي. وكلفة التدخل الروسي في سورية تبلغ 3 ملايين دولار يومياً، أي شطر يسير من مجمل الموازنة العسكرية الروسية، ومقدارها 55 بليون دولار سنوياً. فسورية قد تكون «مستنقعاً، لكنها مستنقع (كلفته) مُحتمل(ة)»، يقول فورد.
وتسعى روسيا، على أقل تقدير، الى السيطرة على حلب قبل بدء مفاوضات جدية مع الولايات المتحدة. وخسارة حلب تقصم ظهر المعارضة السورية وتسلبها السيطرة على مدينة سورية بارزة.
* مراسلة، عن «واشنطن بوست» الأميركية، 30/9/2016، إعداد منال نحاس
الحياة
لا وصفة غربية لردع الروس في سوريا/ روزانا بومنصف
ردت روسيا على بعض اصوات في واشنطن تحدثت عن امكان توجيه ضربات محدودة لمواقع النظام السوري لردعه عن تدمير حلب بالقصف الجوي والبراميل المتفجرة بمساعدة الطيران الروسي بمجموعة اجراءات يتفق اكثر من مصدر ديبلوماسي على اعتبارها اجراءات مغالية ازاء ما تعرفه روسيا جيدا وتوظفه ألا وهو المرحلة الانتقالية التي تجتازها الادارة الاميركية عشية انتخابات رئاسية من المرجح ان تترك واشنطن من دون قرار اساسي لاربعة اشهر على الاقل خصوصا مع ادارة باراك اوباما الذي رفض طوال سنوات القيام باي خطوة عملانية ازاء الوضع السوري. فقبيل استعدادات منذ اسبوع من اجل قرار دولي في مجلس الامن تحضره فرنسا مع اسبانيا من اجل وقف تدمير النظام لحلب بمساعدة روسيا، صدرت مواقف عن مسؤولين روس يحذرون من ان اي ضربات عسكرية ضد قوات الاسد ستعتبر اعتداء على روسيا. وهو موقف متقدم في تقديم الحصانة للنظام السوري ابعد من الفيتو الذي استخدمته روسيا قبل يومين للمرة الخامسة من اجل منع اتخاذ قرار دولي حول سوريا يلجم وحشية النظام وداعميه. وفي موازاة هذا الموقف صادق مجلس النواب الروسي الجمعة الماضي على الاتفاقية التي وقعتها موسكو مع نظام الاسد في 26 آب من العام الماضي والتي تقضي ببقاء القوات الروسية في سوريا الى اجل غير مسمى وبحصانة ديبلوماسية للجنود الروس ازاء ما يقومون به فضلا عن منع النظام من دخول القواعد العسكرية للقوات الروسية، وذلك في خطوة ترمي الى صد الغرب وسعيه الى مواجهته انفلات روسيا في مساعدة النظام على تدمير حلب وضمها الى سيطرته مجددا بتدعيم موقفه وموقعه في سوريا، عبر مجلس النواب الروسي من جهة وبدعم النظام من جهة اخرى. وهناك الاهم وهو ارسال صواريخ اس 300 الروسية المضادة للطائرات الى طرطوس غرب سوريا علما ان القواعد الروسية غير مستهدفة ولا يملك اي من فصائل المعارضة ما يهدد روسيا كما ان الولايات المتحدة ليست في هذا الوارد. هذا الاستعراض السياسي – العسكري من جانب روسيا واكب الاستعراض الديبلوماسي في مجلس الامن لجهة السعي الى افشال مشروع قرار فرنسي – اسباني لوقف تدمير حلب بفيتو روسي على القرار وبمحاولة طرح مشروع بديل يتبنى بعض بنود المشروع الفرنسي ولكن لا يطلب وقف الضربات الجوية فوق حلب، ويطلب التمييز والفصل بين المعارضين في حلب على نحو يقفل عمليا ابواب الحل الديبلوماسي راهنا وتحديد الارجحية للخيار العسكري من خلال السعي الى فرض امر واقع في سوريا في تمكين النظام وحلفائه من السيطرة على ما يسمى سوريا المفيدة قبل وصول الادارة الاميركية الجديدة.
بعض المصادر الديبلوماسية لم تر في مشهد مجلس الامن محاولة ناجحة لردع روسيا خصوصا بعد فشل زيارة وزير الخارجية الفرنسي جان مارك ايرولت الى روسيا ومحاولة اقناع موسكو بوقف العمليات العسكرية ضد حلب خصوصا ان روسيا لا تزال تقول بالاتفاق على الهدنة الذي وقعته مع واشنطن في 9 ايلول الماضي . اذ ان تعليق واشنطن محادثاتها مع روسيا حول واشنطن واستعانة الاخيرة بالحلفاء الاوروبيين ليس بالضرورة وصفة ناجحة لاقناع الروس في الوقت الذي يشعر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين انه في موقع قوة، في حين ان واشنطن محرجة وما لا تستطيع اللجوء اليه مباشرة لن تحصل عليه بالواسطة. ولا تعتقد هذه المصادر ان الدول الغربية كانت تأمل في نجاح المشروع الفرنسي بل ثمة حاجة لهذه الدول ان تحاول من جهة ان تظهر للرأي العام لديها او الخارجي انها لم تتخل عن حلب وعن المعارضة السورية وتتركهما لمصيرهما في الوقت الذي لا تقدم للمدينة والمعارضين السوريين مساعدة كبيرة. ولا تعبر هذه الدلالات فقط عن اتساع الخلاف الاميركي – الروسي الذي اشتد حول سوريا اخيرا عقب فشل اتفاق الهدنة الذي وقع بينهما او تعبر ايضا عن النية في حشر روسيا دولياً من خلال عزلتها في موقفها على رغم ان مشروعها نال دعم تصويت دولة عربية هي مصرعلى نحو لافت، علما ان مصر تجاهر منذ بعض الوقت بمواقف اقرب الى موسكو من الدول العربية الخليجية الداعمة للقاهرة، بل تعبر ايضا عن تضاؤل الهامش المتاح امام الدول الغربية ازاء تعميق روسيا سيطرتها في سوريا وتعزيز موقعها فيها وتاليا امتلاكها القدرة على انتزاع ما تراه من حلول لسوريا في المرحلة المقبلة وفق رؤيتها او قواعدها للحل.
هل لا يزال الخيار العسكري الذي فكرت به واشنطن بصوت مرتفع قائما او انه لم يكن واردا اصلا في الوقت الذي لم تكن ادارة اوباما تخاطر بأي ضربة للنظام في عز التعاون مع موسكو، فكيف بلحظة خلاف كبير؟ المصادر الديبلوماسية المعنية لا ترى ذلك خصوصا غداة تسريب محضر اجتماع لوزير الخارجية الاميركي جون كيري مع وفد من المعارضة السورية قال فيه انه لم ينجح في اقناع ادارة اوباما بتوجيه عمل عسكري ضد النظام . فالحرب متى كانت جدية لا تخاض اعلاميا على نحو سابق للخطوة التي يعتزم اتخاذها وفق ما جرى الحديث عن خيارات موضوعة على الطاولة امام اوباما. كما لا ترى هذه المصادر خيارات ديبلوماسية متاحة على رغم المحاولات للاشارة الى ان الجهود لا تهدأ على هذا الصعيد. لكن يخشى ان استسلام واشنطن لروسيا في الموضوع السوري منذ زمن ليس بقصير اقفل الاحتمالات على الحصيلة التي تؤول اليها الامور راهنا في سوريا ما لم تحدث مفاجأة تقلب الاوضاع ، وهذا لا يبدو محتملا.
النهار
ما الذي تريده روسيا في سوريا/ ماجد كيالي
مع شخصية مثل فلاديمير بوتين، مفعم بداء العظمة واستعراض القوة والتقليل من قيمة الآخر، والاستعداد للقتل “كما حدث في غروزني”، يمكن توقع كل شيء، من حرب محدودة إلى حرب عالمية ثالثة ربما، إذ أنه الحاكم بأمره في روسيا، ووافق مجلس الدوما، مثلاً، على قرار بوتين بشأن تواجد عسكري روسي دائم في الأراضي السورية. علما أن هذا التطور حصل بعد نشر روسيا صواريخ اس 300 وإرسالها بوارج حربية إلى المتوسط، مع تهديدات معلنة بإمكان استهداف الطائرات الأميركية، واعتبار أي اعتداء على جيش النظام السوري اعتداءً على القوات الروسية، وهي كانت قبل أيام استهدفت قافلة مساعدات إنسانية للأمم المتحدة في حلب.
بوتين الذي صاغ روسيا على قياسه، بنى إدراكاته السياسية والعسكرية على اعتبار أن أميركا مجرد بلد ضعيف، أي أنه لم يفهم أن قوة الولايات المتحدة تتجلّى في مجال القوة الناعمة “العلوم والتكنولوجيا والاقتصاد والإعلام ووسائل الاتصال”، أكثر من القوة العسكرية المباشرة، وأن قوتها العسكرية من حيث العدد والنوع ووسائل التوجيه والاتصال أقوى من القوة العسكرية الروسية، ناهيك عن الفارق في القدرات الاقتصادية والتكنولوجية والعلمية بين البلدين.
لكن لماذا تذهب روسيا للانتحار؟ أو لماذا تقاتل في سوريا؟ في الواقع فإن روسيا تتحرك في الصراع السوري باعتباره بمثابة مفتاح للضغط على الولايات المتحدة أو على النظام الدولي في عدة ملفات أهمها: أولاً، استعادة مكانتها كدولة عظمى في العالم، أو كندّ للولايات المتحدة. ثانياً، تعزيز موقفها في النزاع على أوكرانيا. ثالثاً، التعبير عن الغضب على السياسة التي تنتهجها الولايات المتحدة وحلفاؤها والتي أدت إلى تدهور أسعار النفط وتكبيد روسيا خسائر فادحة. رابعا، بذل الضغوط على الولايات المتحدة لحملها على وقف الحظر التكنولوجي الذي فرضته على روسيا. خامساً، اعتبارها الحرب ضد الإرهاب في المنطقة جزءاً من الأمن القومي الروسي. سادساً، الرد على نشر الولايات المتحدة شبكة “الدرع الصاروخي” في دول الجوار الروسي. سابعاً، ترويج السلاح إذ تعتبر روسيا ثاني مصدّر للسلاح في العالم بعد الولايات المتحدة.
في المقابل، ورغم اللامبالاة التي تعاملت بها إدارة باراك أوباما مع روسيا، ربما وفق رؤية تتأسس على استدراجها لها وتوريطها في الصراع السوري، إلا أنه من غير المرجح أن تواصل هذا النهج، لأن الأمور باتت تخرج عن سيطرتها. لذا بدا لافتا للانتباه توجه الرئيس الأميركي وبشكل معلن لاعتماد إستراتيجيات جديدة في التعامل مع الصراع السوري، وهو ما تجلى في دعوته خلال اجتماع مجلس الأمن القومي، واجتماع الدول الخمس الكبرى “الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا” الأربعاء الماضي.
وحسب التسريبات الصحافية فإن البيت الأبيض يدرس مروحة من الخيارات: الأول، مراقبة الأجواء والتعامل مع التهديدات المحتملة والمشاركة في عمليات البحث والإنقاذ. ولا تتوقف عملية فرض منطقة الحظر الجوي عند إسقاط الطائرات التي تحلق من دون إذن بل تعني أيضا تدمير الأنظمة العسكرية للجيش السوري.
الثاني، يشمل فرض مناطق آمنة حيث يمكن لمئات الآلاف من المدنيين البقاء فيها مما سيخفف من موجة تدفق اللاجئين على الدول المجاورة، على أن تكون حمايتها مؤمنة من قبل دول التحالف ودول الناتو.
الثالث، اعتبار أن الحل الأسهل لوقف عمليات القصف هو استهداف القواعد الجوية والمطارات العسكرية للنظام السوري.
الخيار الرابع هو تسليح المعارضة، إذ الممكن والمطروح هو خيار توفير أنظمة مضادة للطائرات لمسلحي المعارضة، وهي أسلحة متطورة وأنظمة صاروخية ستخول لهم إسقاط الطائرات الروسية والمقاتلات السورية. وهناك خيار خامس، ويتمثل في ضرورة تدمير طائرات النظام فقط.
يستنتج من ذلك أن كل الاحتمالات مفتوحة، حتى مع عدم وجود أي جندي أميركي على الأرض، وأن هذا سيكون، ربما، بمثابة ردّ محدود ومحسوب، وكرسالة ذات مغزى من البيت الأبيض، أما ما سيأتي بعد فيصعب التكهن بتداعياته.
كاتب سياسي فلسطيني
العرب
لماذا تحدث بوتين عن “الدمار الاقتصادي”؟/ راجح الخوري
منذ الرابع من تشرين الأول ٢٠١١ الى اليوم استعملت روسيا الفيتو في مجلس الأمن خمس مرات لحماية بشار الأسد، المرة الأخيرة حملت مدلولاً خطيراً، اولاً لأنها أكّدت التمسك بالمضي في تدمير حلب ولهذا أسقطت موسكو بحق النقض مشروع القرار الفرنسي الإسباني، الذي يدعو الى وقف الغارات، وثانياً لأنها كشفت ان فلاديمير بوتين متمسك بالحل العسكري منذ البداية، يوم أرسل قواته الى سوريا معلناً ان كل معارض للأسد هو إرهابي!
سيرغي لافروف يبالغ كثيراً عندما يتّهم اميركا بالوقوع في هوس الخوف العدواني من روسيا، لأن التهديد الأميركي بالذهاب الى بدائل من الديبلوماسية في سوريا، لا يعني ان صواريخ كروز ستتساقط غداً على النظام السوري، على الأقل لأن مركزية القرار في واشنطن مكبلة تماماً وهي الآن في مرحلة السبات الإنتخابي قبل شهر من موعد الإنتخابات في الثامن من الشهر المقبل!
ولأن لافروف يعرف كل هذا فإنه يتعمّد التضخيم، لكي يُظِهر في النهاية ان التهديد الأميركي مجرد فقاعات كلامية لا معنى لها، وهو طبعاً ما سينعكس سلباً على صورة أميركا وصدقيتها المتراجعة على صعيد السياسة الخارجية، وخصوصاً لدى حلفائها الخليجيين وفي المنطقة العربية.
يصف لافروف الموقف الأميركي بأنه “ليس هوساً بلاغياً تجاه روسيا وإنما خطوات عدوانية تضر فعلاً بمصالحنا القومية وتمثل تهديداً لأمننا”. لكن التدقيق في خلفيات البيانات الأميركية منذ انهيار هدنة حلب وإنخراط روسيا والنظام في عملية تدمير منهجية للمدينة ستجعلها في النهاية ستالينغراد العصر، لا يمكن ان يجد هوساً في كل الإنشائيات الأميركية.
ثم لست أدري اين وجد لافروف تلك الخطوات العدوانية الأميركية، التي تضرّ بمصالح روسيا القومية وتمثّل تهديداً لأمنها، خصوصاً انه في نهاية حديثه يقول إنه مقتنع بأن باراك اوباما لن يوافق على السيناريو العسكري! هل كان كلام لافروف الذي أدلى به الى وكالة الإعلام الروسية، موجهاً الى الداخل لتبرير التصاعد المستمر في الأزمة الإقتصادية المتنامية، خصوصاً ان بوتين أصدر الاسبوع الماضي مرسوماً بتعليق الإتفاق مع أميركا على تقليل إنتاج البلوتونيوم بكميات عسكرية الى ان “حتى توقف واشنطن العقوبات الاقتصادية وتعوّض الدمار الإقتصادي”؟
“الصنداي تايمس” تنقل عن المستشار السابق للكرملين غليب بافلوفسكي أن مطالب بوتين تمثل إشارة الى الضعف ومحاولة لإلقاء كل اللوم على أميركا في مشاكل روسيا الاقتصادية، والحديث عن “الدمار الإقتصادي” يؤكد ان أميركا لن تنجرّ الى عمل عسكري في سوريا، لكنها كما ينخرط بوتين مع الاسد في تدمير مدينة حلب والإصرار على الحل العسكري ويُفشل مشروع القرار الفرنسي لوقف النار في مجلس الأمن، يمكنها ان توسّع مروحة عقوباتها، وسط تصاعد ملامح حرب باردة جديدة يريدها بوتين غطاءً يبرر مصاعبه الاقتصادية!
النهار
هولاند وبوتين… ورد ستالين على البابا/ خيرالله خيرالله
يبقى الموقف الذي اتخذه الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند من الحملة الوحشية التي يشنّها سلاح الجو الروسي بدفع من الرئيس فلاديمير بوتين، على حلب، مجرّد موقف أخلاقي. السياسة شيء والأخلاق شيء آخر. أين يمكن صرف المواقف الأخلاقية والمبدئية في المجال السياسي، خصوصا عندما يتعلّق الأمر بمأساة لا سابق لها مثل المأساة السورية؟ ما الذي ستجنيه حلب نتيجة المواقف الجريئة لرئيس فرنسي عاجز يعاني، في السنة الأخيرة من ولايته، من فقدان التأييد الشعبي في فرنسا نفسها؟
المسألة السورية ليست مرتبطة بفرنسا وحدها. أين أوروبا مما يدور في هذا البلد؟ كشفت سوريا أوروبا. كشفت عمليا الإفلاس السياسي والعسكري لأوروبا. لم يعد لأوروبا وزن على الصعيد العالمي. ليس أمام أوروبا سوى التزام موقف المتفرّج، للأسف الشديد، والعمل في الوقت ذاته على الحدّ من تدفق اللاجئين السوريين في اتجاهها.
هذا كلّ ما تستطيع أوروبا عمله بعدما تبيّن أن إدارة باراك أوباما تصعّد كلاميا وتسير عمليا في الخط الروسي. صار وزير الخارجية الأميركي، جون كيري، مجرّد مهزلة مقارنة بوزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف الذي يعني كلّ كلمة يقولها. أكثر من ذلك، تبيّن أن على أوروبا السعي، في الخفاء أحيانا وعلنا في أحيان أخرى، إلى مراضاة إيران بوجود إدارة أميركية لا همّ لديها سوى حماية الاتفاق في شأن الملفّ النووي الإيراني. هذا الاتفاق الذي يعبّر عن تواطؤ لإدارة أوباما مع إيران تدفع ثمنه سوريا.
من أصل تسعة مستشفيات في حلب، قصف سلاح الجو الروسي ستة منها ودمّرها تدميرا كاملا. ممنوع على أهل حلب حتّى معالجة جروحهم. عليهم الاستسلام للنظام السوري، وهو نظام أقلّوي، يحظى بغطاء جوّي روسي، تمثّله على الأرض مجموعة من العصابات المسلحة مضاف إليها ميليشيات مذهبية عراقية ولبنانية وحتّى أفغانية أتت بها إيران إلى محيط حلب ودمشق والمدن ذات الأكثرية السنّية مثل حمص وحماة.
وضع هولاند شروطا على بوتين من أجل زيارة باريس. رفض بوتين هذه الشروط واللغة التي استخدمها الرئيس الفرنسي. كلّ ما يريده الرئيس الروسي هو تدمير حلب وذلك بالتنسيق الكامل مع إيران. ليس بالكلام وحده يمكن حماية حلب، إحدى أقدم الحواضر في العالم. ليس بالأخلاق يمكن ضمان حق الشعب السوري في تقرير مصيره.
كلّ الكلام الجميل الذي صدر عن فرنسا بقي كلاما جميلا. في المقابل، عندما وجد فلاديمير بوتين أن النظام السوري سيسقط نهائيا، وأن بشّار الأسد سيجد نفسه مضطرا لمغادرة دمشق حيث تحميه إيران، تدخل مباشرة. كلّ كلام عن تناقضات بين إيران وروسيا هو كلام في غير محله، أقلّه في الظروف الراهنة. لدى الجانبين مصلحة واحدة في المحافظة على النظام، على الرغم من أنّه صار في مزبلة التاريخ، وأنّ لا مهمّة له في المدى المنظور سوى الانتهاء من سوريا التي عرفناها. يبدو أن ذلك هدف بشّار الأسد، كما هو هدف إيران وروسيا وإسرائيل وتركيا والإدارة الأميركية. لا تستطيع أوروبا أن تفعل شيئا في مواجهة هذا الواقع. لذلك، يبدو كلام هولاند أقرب إلى لعب في الوقت الضائع في انتظار إدارة أميركية جديدة يصعب التكهّن بأنّها يمكن أن تغيّر شيئا في الواقع السوري.
تشبه تصرفات فلاديمير بوتين في سوريا تصرّفات ستالين. عندما قيل للزعيم السوفياتي الراحل إن بابا الفاتيكان يشكو من القمع الذي يتعرّض له الكاثوليك في الاتحاد السوفياتي، كان ردّه “البابا؟ كم فرقة عسكرية يمتلك البابا؟”… يستطيع الرئيس الروسي السؤال حاليا عن تأثير فرنسا في سوريا ومدى قدرتها على ممارسة أي ضغوط من أيّ نوع على بلده. ما دام ليس لدى فرنسا سوى الكلام، يمكن لزيارة باريس أن تنتظر طويلا. لم تعد الزيارة تقدّم أو تؤخّر في شيء.
في النهاية، كم فرقة عسكرية تمتلك أوروبا؟ الجواب أن أوروبا تمتلك قدرات عسكرية، لكنّها ليست قادرة على التدخل في سوريا. تستطيع فرنسا التدخل في مالي أو في أحد البلدان الأفريقية. تبقى سوريا شيئا آخر مختلفا جدّا. هناك لعبة كبيرة تدور في سوريا حيث قررت أوروبا، على رأسها ألمانيا، الاستسلام لروسيا وإيران مع ما يستتبع ذلك من كوارث تحلّ بالمنطقة. كوارث تحل باليمن والعراق، وصولا إلى لبنان الذي تستخدمه إيران منبرا لمهاجمة المملكة العربية السعودية، فيما تتابع جهودها لفرض هيمنتها عليه.
يظلّ السؤال الكبير هل هناك من يريد بالفعل مساعدة سوريا والسوريين، أم أنّ كل ما يفعله فرنسوا هولاند يندرج في خانة رفع العتب من جهة، والسعي إلى استعادة موقع في فرنسا نفسها من جهة أخرى.
هناك الأشهر الأخيرة من ولاية باراك أوباما. هذه فرصة لا تعوّض لوضع الإدارة الأميركية الجديدة أمام أمر واقع. والأمر الواقع هو تفاهم روسي – إيراني على تقاسم للنفوذ في سوريا. يحصل ذلك بموافقة إسرائيلية يعبّر عنها التنسيق المستمرّ بين بوتين وبنيامين نتانياهو الذي ازدرى دائما باراك أوباما. فكيف يمكن لشخص عرف حجم الرئيس الأميركي باكرا أن يتعاطى باحترام مع رئيس لفرنسا مثل فرنسوا هولاند؟
يبقى أن هناك من يراهن على الموقف التركي وأن الرئيس رجب طيب أردوغان لا يمكن أن يبقى مكتوفا لفترة طويلة حيال ما يدور في حلب. هل هذا رهان في محلّه؟ من الصعب الذهاب بعيدا في مثل هذا النوع من الرهانات لا لشيء سوى لأن روسيا استطاعت، بالتنسيق مع إيران، تدجين تركيا أسيرة عقدة الورقة الكردية. تلعب روسيا وإيران مع تركيا لعبة العصا والجزرة. يأتي بوتين إلى إسطنبول للمشاركة في مؤتمر ينعقد فيها ولقاء أردوغان، فيما يقاطع الرئيس الإيراني حسن روحاني المؤتمر!
من الواضح، أن تركيا تعاني من حال ضياع، خصوصا في الموضوع السوري. الأكيد أنّها لم تستطع، إلى الآن، رسم سياسة واضحة تجاه بلد لديها معه حدود مشتركة يزيد طولها على تسعمئة كيلومتر. لو كانت لدى تركيا سياسة مدروسة تجاه سوريا، لكانت عملت بدورها على فرض أمر واقع. كان مفترضا أن تفعل ذلك باكرا. كان عليها إقامة “منطقة آمنة” في الأراضي السورية، لكن إدارة أوباما لم تسمح لها بذلك.
يظل مشروع “المنطقة الآمنة” المشروع الوحيد ذا الطابع العملي. كلّ ما يمكن لتركيا أن تفعله هو السعي منذ الآن إلى إقناع الإدارة الأميركية الجديدة به. تستطيع الاستعانة بفرنسا وغير فرنسا لتحقيق هذا الغرض من جهة، وإبلاغ فلاديمير بوتين وإيران أن هناك ردّا على مشروعهما الهادف إلى تقاسم النفوذ في سوريا بغطاء إسرائيلي من جهة أخرى.
في غياب القدرة على ترجمة الكلام الجميل إلى واقع على الأرض، يبقى الكلام الجميل مجرّد كلام. يبقى أن على فرنسوا هولاند، قبل أن يقول كلاما كبيرا عن بوتين، أن يتذكر رد ستالين على البابا…
إعلامي لبناني
العرب
موقف فرنسي شجاع/ عبدالرحمن الراشد
هناك مواجهة دبلوماسية قوية بين فرنسا من جانب، ونظام الأسد وإيران وروسيا من جانب آخر، ورغم التهديدات ضدها، فإن الحكومة الفرنسية تصر على موقفها المتكرر، والمتضامن مع الشعب السوري، بعد أن تخلى عنهم معظم القوى الدولية.
وقد استنكرها الروس قائلين، إنهم يعجبون لماذا تصر فرنسا على الوقوف ضد مشروعهم في سوريا، واصفين هجومهم، وحصارهم، وتشريدهم لملايين السوريين بأنها حرب على الإرهاب، وأن فرنسا لا تخالفهم فقط، بل تخالف التوجه الأوروبي بمواقفها.
ومشروع القرار الفرنسي، الذي دعا لوقف قصف حلب، وقصفه الروس بالفيتو، وتسبب في مواجهات كلامية بين سفراء القوى الأعضاء في مجلس الأمن الأسبوع الماضي، لم يكن العمل الوحيد الذي رعته الحكومة الفرنسية. فرنسا من الدول الراعية للثورة السورية منذ البداية، وبخاصة في دعم الجهود السياسية للائتلاف والمجالس المختلفة، وهي من أكثر الدول التي استهدفتها العمليات الإرهابية التي نفذتها تنظيمات مشبوهة مثل «داعش»، التي تدلل كل أفعالها على أنها تنفذ مشروًعا لصالح الأسد والإيرانيين، ويستهدف الدول التي وقفت ضد جرائم نظام دمشق وحلفائه. ورغم تكرار العمليات الإرهابية التي أدمت فرنسا، فإنها استمرت تقف
ضد الحرب الوحشية التي تشن على الشعب السوري.
َلم تعاِن فرنسا من إرهاب «داعش» وحده، بل واجهت أزمة داخلية لا تقل خطورة، وهي تنامي العنصرية ضد الأجانب وضد الفرنسيين من أصول إسلامية، التي تتغذى على جرائم التنظيمات الإرهابية المرتبطة بالأزمة السورية، وبسبب طوفان المهاجرين الذي أغرق غرب أوروبا من سوريا وغيرها. وهذه المواقف السياسية، التي قد لا تحظى بشعبية وتستخدم لإضعاف الحكومة والحزب في الانتخابات التي بدأت مهرجاناتها.
على المستوى السياسي والدبلوماسي بشكل خاص، حكومة فرنسا تقود دعوة لمحاسبة الدول المتورطة في حصار وتدمير حلب وبقية المدن السورية، ومحاكمتها بجرائم حرب، وتفعيل المؤسسات الدولية ضدها.
نحن أمام هذه المواقف المتعددة، والمستمرة لسنوات، لا يمكننا إلا أن نذكر بالتقدير ما يفعله الفرنسيون. وسياستهم العادلة والمنصفة في القضية السورية هي امتداد لمواقفهم ضد نظام الأسد في لبنان، عندما ساندت فرنسا رئيس الوزراء اللبناني الراحل رفيق الحريري، وكان موقفها أساسًيا وفاعلاً بعد جريمة اغتياله من قبل نظام الأسد. وموقفها استمر أيًضا يواجه محاولات التغيير في لبنان، وقامت بدعم القوى الرافضة لهيمنة «حزب الله».
والرؤساء الفرنسيون عموًما استمروا على هذا النهج إلا في مرحلة قصيرة، خلال رئاسة ساركوزي الذي تولى مهمة تبييض صفحة الأسد، بالتعاون مع بعض القوى الإقليمية، وفشل في النهاية.
قد لا يجد البعضفي المواقف الفرنسية القيمة الكافية لتغيير الأوضاع على الأرض، ففرنسا دولة كبرى لكنها ليست الولايات المتحدة ولا روسيا، القوتين العظميين، مع هذا تلعب دوًرا كبيًرا، وتقود قاطرة المواجهة، في وقت فضلت معظم الدول الأخرى تحاشي مواجهة «محور الشر».
وِفي ظل العربدة والاستهانة بالقيم والقوانين الدولية التي يمارسها حلفاء الأسد، فإنه ليس بالقليل أن تقف دول، مثل فرنسا، هذه المواقف المتكررة، والتي يمكن ونرجو أن توصلنا إلى مرحلة الحل السياسي المعقول.
فالحرب الإيرانية الروسية في سوريا فشلت حتى هذا اليوم في القضاء على انتفاضة الشعب السوري، وفشلت في تثبيت حكم الأسد حتى في نصف سوريا التي باتت تحت حكمه، ولن يجدوا في الأخير إلا بلًدا مثل فرنسا، لدعم حل سياسي يخرجهم من هذا المستنقع.
الشرق الأوسط
بوتين وأردوغان يدفنان الأحقاد/ موناليزا فريحة
حرص الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على المشاركة شخصياً في منتدى الطاقة العالمي في اسطنبول. لم يرسل وزيراً يمثله كما فعل رؤساء دول أخرى. ردُّ الزيارة للرئيس التركي الذي زار بطرسبرج في آب أكثر من واجب، ويخدم أهدافاً عدة في هذا الوقت تحديداً، على رغم الحملة الشرسة التي تشنها مقاتلاته على حلب وهي من المفترض عزيزة على قلب الرئيس رجب طيب أردوغان.
ولم يخيّب أردوغان “صديقه العزيز”. خصه بحفاوة بالغة، متناسياً اتهامه إياه بطعنه من الخلف ودعم الارهابيين قبل أشهر. وعندما تطرق في كلمته الى أطفال حلب الذين يشاهدون في الأفق مقاتلات وطائرات هليكوبتر تقصفهم، تجاهل على الأرجح تحديد جنسية تلك المقاتلات، حرصاً على مشاعر الضيف، على الأرجح.
في الواقع، يتقاسم الرجلان براعة توجيه الرسائل الى الخارج والداخل، وإن يكن أحدهما يوجهها بصوت عال، فيما اعتاد الآخر العمل بصمت. ولكن في كلا الحالين باتت أميركا وجهتهما الأولى، وقت بلغ التوتر بين موسكو واشنطن حداً أخطر مما كان إبان الحرب الباردة، على حد قول وزير الخارجية الألماني فرانك – فالتر شتاينماير، ولم تنفع حتى الان محاولات رأب الصدع بين الادارة الاميركية وأردوغان.
الواضح أن تلاقي المصالح أدى دوراً كبيراً في هذا التقارب الغريب بين روسيا وتركيا الناشطتين في جبهتين متضادتين في سوريا. وهكذا غضت روسيا النظر عن دخول تركيا شمال سوريا، وردّ أردوغان بالامتناع عن اللجوء الى خطابه الحاد خلال الحملة الروسية على حلب. وخلافاً للدور الذي اضطلعت به تركيا خلال الصيف لفك الحصار موقتاً عن المدينة، رد أردوغان أخيراً على مناشدة المعارضة السورية التحرك ضد الغارات الروسية، بوعد بالاتصال ببوتين لاعادة احياء اتفاق وقف النار المنهار.
ليست الديبلوماسية الجديدة التي تنتهجها أنقرة منذ محاولة الانقلاب في تموز الماضي كافية لتبرير الصمت المريب لحكومة أردوغان حيال ما يحصل في حلب. وثمة من ذهب أخيراً إلى إعادة إحياء الحديث عن صفقة روسية – تركية تقضي بتخلي أنقرة للنظام السوري وروسيا عن حلب مقابل اطلاق يدها في شرق سوريا لتصفية حساباتها مع الأكراد.
لن يكون سهلاً على أردوغان الذي أرسى في السنوات الاخيرة السياسة الخارجية لبلاده حيال سوريا على فكرة إطاحة الاسد، أن يتخلى تماماً عن دعم المعارضة السورية، الا أن الرئيس التركي الذي دخل بقواته سوريا بهدف محدد يعرف تماماً أن بوتين يمكن أن يعرقل مهمته هذه ويحبطها. لذا يبدو أن الرجلين قررا أن يدفنا أحقادهما، أقله على المدى المنظور، في حلب، جنباً الى جنب مع جثث ضحايا الغارات والقصف للمدينة.
النهار
مشنقة الكاوبوي»… من سورية إلى البحر الأحمر/ زهير قصيباتي
قد يكون مبكّراً استخلاص نتيجة وحيدة من قمة القيصر- السلطان في اسطنبول: بوتين صاحب القرار الأول في سورية وجحيمها يحاول «شراء» حياد رجب طيب أردوغان إزاء معركة تصفية كل الفصائل السورية المعارضة في حلب، لكي يتمكّن النظام في دمشق من ادعاء انتصار، يمكّنه من تجديد سيناريو الحل الجاهز: طاولة الحوار أمامنا، وأمامكم (معارضي الداخل) صك «الوفاق» والاستسلام.
يغري بوتين الشريك الجديد في تركيا بجزرة تطبيع كامل، بكل ما يعنيه من تبادل مصالح اقتصادية فضلاً عن التعاون الأمني- الاستخباراتي، ورغبة أردوغان في مدماك روسي لأول مفاعل نووي في بلاده. لذلك دلالاته بالطبع في صراع النفوذ الإقليمي بين أنقرة وطهران، فيما القيصر يجمع أحجار الدومينو، مستغلاً التبلُّد الأميركي أمام «انتفاضة» بوتين على مرحلة ما بعد الحرب الباردة وانهيار الاتحاد السوفياتي.
على طاولة أحجار الدومينو، يمسك الثعلب الروسي بشراكة أمنية مع إسرائيل، وتحالف مصالح مع إيران، وأخيراً شراكة تجارة واستخبارات مع تركيا لـ «مكافحة الإرهاب» على رغم الفارق الكبير بين تعريفَيْ موسكو وأنقرة للإرهاب.
حتى الآن، لا يعاتِب السوريون الذين بالكاد يستطيعون إحصاء أرقام شهدائهم في «محرقة» حلب، حليفهم السلطان الذي يخاطب قاتلهم بكلمة «صديقي». وبين هؤلاء مَنْ يعتبر أن ما تفوّه به أردوغان في المؤتمر الصحافي مع ضيفه الروسي في اسطنبول، إنما يختصر حرب إبادة في حلب بمسألة الإغاثة التي لن تعطّل- إذا تأمّنت للمحاصرين- الخطة الروسية.
وطاولة الدومينو الرباعية، إن عنَتْ شيئاً فلن يكون سوى شطب القرار العربي، وإلحاح موسكو على تحييد الدور التركي في سورية حيث «تتدخّل واشنطن في شؤوننا»… والعبارة لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الذي حذّر إدارة الرئيس باراك أوباما من التفكير في قصف القواعد الجوية والمطارات السورية، لأن في ذلك «لعبة خطرة جداً».
ولم يتردّد الوزير في التلويح بردّ، لأن روسيا تدخّلت في سورية استجابة لطلب من «حكومتها الشرعية، ولدينا هناك أنظمة دفاع جوي في قاعدتين، لحماية أصولنا». والأصول لا تعني أموالاً ولا مصارف ولا منشآت نفطية، بل جنوداً وقاذفات وأنظمة صاروخية، للدفاع عن نظام الأسد، والأهم تسريع مشروع بوتين لنشر قواعد عسكرية في المنطقة العربية.
وإن كان بعضهم يذكر تجارب السوفيات في مصر جمال عبدالناصر، وفي عدن، فهل من المصادفة تسريب الصحافة الروسية نبأ السعي الى استئجار مواقع عسكرية في مصر، وهو ما نفته القاهرة؟ وهل مجرد مصادفة عزف حلفاء موسكو في طهران على وتر التصعيد ضد السعودية، واقتداء شركاء إيران الحوثيين بالنهج الإيراني ضد المملكة (استهداف أراضيها بصواريخ باليستية)، وبأسلوب استفزاز البحرية الأميركية (في البحر الأحمر)؟
كله تنويع على الوتر الروسي الذي انقلب 180 درجة، ليلتف على أعناق ضحايا المحرقة في سورية ويؤسس لإمبريالية يريدها بوتين انتقاماً لانهيار الاتحاد السوفياتي الذي كان مناصراً لقضايا العرب. ببساطة ينتقم الكرملين من الغرب «الشرير» باستباحة بؤر التوتر والحروب في المنطقة العربية، مدخلاً لإعادة التفاوض بعد شهور على مناطق النفوذ مع الإدارة الأميركية الجديدة. ولا يشذّ عن السيناريو ذاته، الطموح إلى تجديد القواعد «السوفياتية» التي أُغلِقت في فيتنام وكوبا.
يردّ الكرملين على «تسلُّل» الحلف الأطلسي إلى أوكرانيا والحديقة الخلفية للحدود الروسية، بعقيدة إحياء «الحق التاريخي لروسيا في أن تكون قوية»… في كل مكان، من البحر الأسود إلى البحر الأبيض، ومن قزوين إلى البحر الأحمر.
قبل أيام قليلة، تبنّى البرلمان الروسي طمع الكرملين بوجود عسكري دائم في سورية. تجاوزَ الدوما الحلم التوسُّعي لدى طهران بجعل البلد العربي المنكوب بأكثر من ثلاثمئة ألف قتيل وملايين المشرّدين «محافظة إيرانية»، رايتها «الحرس الثوري».
ولسان القيصر، بعدما رمّم طاولة الدومينو، أن الشراكة مع تركيا مرحلية، فتحييدها أولوية، مثل إلهائها بورقة «الإرهاب» الكردي… وأما إسرائيل وإيران، فالأولى مطمئنة إلى أمنها «اليهودي» بضمانة روسية، والثانية جندي على الأرض في معركة «روسيا العظمى» والأقوى، إلى أن تحين لحظة الحقيقة مع الغرب الحائر بأميركا الكسيحة.
موسكو، يردّد إعلامها أن «لا مفاوضات قبل حسم معركة حلب»، ولا يجد حرجاً، على هامش الاشتباك بـ «الفيتو» في مجلس الأمن، في وصف الوزير جون كيري بأنه «الكاوبوي الذي لفّ حبل مشنقته وسلّمه إلى روسيا».
الحياة
الشعب السوري لا أصدقاء له/ د. مدى الفاتح
في ظل الاستهداف المتعمد للمستشفيات والمنشآت المدنية لم يعد حديث الروس عن مكافحة «الإرهابيين فقط» في حلب مقنعاً لغالب دول العالم وهو ما ظهر بوضوح في مناقشات مجلس الأمن الأخيرة.
التقارير المتواترة التي تتحدث عن استخدام كوكتيل من الأسلحة المحرمة، إضافة إلى الصور المباشرة اليومية للقصف والتدمير الوحشي، كل ذلك قد وضع المجتمع الدولي في حرج كبير، حيث بات من الواضح أن المدنيين هم المستهدف الأول، إما بغرض إخافتهم وكسر شوكة صمودهم، أو بغرض إقناعهم بالمغادرة من أجل إفراغ المدينة وتسهيل عملية إبدال طائفي مشبوهة.
بهذا لم تعد روسيا مجرد مساعد لبشار الأسد عبر ضربات انتقائية ومركزة كما كانت تعلن في أول الأمر، بل أضحت لاعباً رئيساً عبر تنفيذها سياسة أرضٍ محروقةٍ مروعة، وعبر استنزافها لموارد السكان المحدودة بتنسيق مع النظام وجماعاته الموالية على الأرض، والذين يحجبون بدورهم ما استطاعوا إليه سبيلاً من ماء أو غذاء أو دواء. إن دور روسيا ومشاركتها في عملية إبادة الشعب السوري بغالبيته السنية لا يفوقه إجراماً سوى الدور الإيراني الذي دفع بعشرات الآلاف من مقاتليه المهووسين وبأبناء الشيعة المغرر بهم من كل مكان في العالم من أجل التقرب إلى الله بالقتل والاغتصاب والتعذيب والتهجير القسري للمدنيين.
هذه العلاقة التعاونية على الإثم والعدوان تستحق وقفة ودراسة، وقد عرضت لها في مقال سابق بعنوان: «روسيا وإيران، جدل الواقع والتاريخ» ولا أريد أن أعيد هنا ما قلته هناك، بل أدلف من ذلك لحقيقة أخرى هي أن انتقاد الحلف الروسي الإيراني لا يعني الوقوع في حب وجهة النظر الأخرى التي يمثلها الغربيون، الذين يدعون الحرص على الشعب السوري. ذلك المعسكر الذي يمثله الرئيس أوباما بشخصيته المتلونة التي قالت مرة إن على بشار الأسد أن يرحل قبل أن يستدرك بالقول إن رحيلاً مفاجئاً للرجل قد يشكل فراغاً، وإنه من الضروري وجود فترة انتقالية ممتدة بشكل يكفي للحفاظ على «الدولة السورية».
الغربيون ليسوا على قلب رجل واحد فيما يتعلق بحل القضية السورية، فهناك المتطرفون المعادون بشكل هيستيري للإسلام والذين يعتبرون أن أي شيء هو أفضل من سيطرة إسلاميين على سوريا. أصحاب هذه النظرة يرون أن سيطرة المجموعات الإسلامية على تلك المنطقة قد يعني تمددها إلى بقية دول الشام، كما قد يعني إعلان الحرب على أوروبا التي لن تصمد طويلاً أمام الفتح الإسلامي الجديد. هذه الصورة التي لا تخلو من مبالغة عبر عنها كثيرون وبدوا مقتنعين بها كالسيناتور ريتشارد بلاك عضو مجلس الشيوخ عن ولاية فيرجينيا، الذي يصف سوريا بمركز الثقل الذي إن سقط بيد الإسلاميين فإن ذلك سيعني سقوط أوروبا الحتمي. لكن بداخل الولايات المتحدة نفسها من يرى أن الخطر الحقيقي الداهم إنما هو خطر النظام، الذي بزواله سوف تزول مبررات تنظيم «الدولة» وغيره من الجماعات المتطرفة التي على الأرجح ستختفي أو تعود عن ممارساتها الفوضوية الحالية والتي لا تصب في الواقع إلا في مصلحة النظام الذي يتخذ من وجودها مبرراً للقمع والتدمير.
هذه الرؤية يشاركها مع أولئك معظم الثوار الذين يرون أن حل المشكلة يكمن في إزاحة بشار الأسد وهم قادرون بعد ذلك على تجفيف هذه الجماعات وملاحقتها بشكل أكثر موضوعية مما يفعل الروس أو الأمريكيون أو غيرهم من المتنافسين على التدخل بهذه الحجة في الأرض السورية.
لكن رؤية أولئك الثوار ليست مهمة ولا مؤثرة، وكذلك ما يقوله بعض المثقفين الغربيين عن ضرورة البدء بتنحية الأسد قبل كل شيء. كل ذلك لا وزن له ما لم يكن مقنعاً للقيادة الأمريكية التي أخذت سنوات من التردد ووقتاً أطول من اللازم لدراسة طريقة التعاطي مع الأزمة. وفي ذروة احتياج الجميع لمبادرة أمريكية حاسمة خرجت علينا تلك الإدارة باستراتيجية جديدة سمتها عدم التدخل في شؤون الشرق الأوسط، وكانت تلك حجة مقنعة نظرياً للاكتفاء بدور المتفرج ولإلقاء عبارات دبلوماسية فارغة من حين لآخر. لكن ما فات على أولئك المنظرين هو أن عدم التدخل، في حالة القدرة، يعد تدخلاً، فالمتفرج على جريمة يستطيع منعها يعتبر مشاركاً، أو في أحسن الأحوال متستراً عليها. أما السوريون فهم لم يطالبوا الأمريكيين ولا غيرهم بالتدخل العسكري لصالحهم، بل تمحورت طلباتهم في التزود بمصدات طيران تمنع عنهم القذائف والبراميل المتفجرة، كما طالبوا بمنحهم بعض الأسلحة الدفاعية الخفيفة، أو في حالة العدم محاصرة التمويلات الدفاعية وتدفقات الأسلحة التي كانت تأتي للنظام بانسياب لا يعوقه شيء من قبل جهاته الداعمة. حتى هذا الطلب الأخير لم يقبل به أحد وأدخلنا المنظرون مرة أخرى في متاهة فلسفية حول السيادة والشرعية الدولية وهي حيلة دبلوماسية يستخدمها الأمريكيون حين يرغبون في تضييع الوقت، لأننا نذكر تماماً كيف كانوا يقفزون على كل ذلك حين يرغبون في توجيه سهامهم إلى هذا البلد أو ذاك!
شهد عام 2012 مقترحاً من مجلس الأمن القومي الأمريكي لتسليح المعارضة وآخر من المخابرات الأمريكية التي وضعت تصوراً لكيفية تنحية الأسد. كان ذلك هو عام الأمل بالنسبة للثوار ولدول المنطقة التي وصلتها رسائل توحي بجدية الأمريكيين في دعم الثورة مما يعني انتصارها الوشيك. لكن كل شيء قد تغير مع الخدمة الكبرى التي قدمها ما بات يعرف بتنظيم «الدولة» للتحالف الأسدي عبر أسلوبه الدعائي الذي أساء به للمسلمين عامة وللثورة السورية خاصة. وجدت الإدارة الأمريكية بعد ذلك مسوغات كثيرة للتراجع عن دعم الثورة أهمها الخشية من مساعدة المتطرفين، ذلك بالطبع قبل أن تتدخل بقوة من أجل ضرب ما ستسميه بـ»معاقل الإرهاب». هذا الوضع الدولي السائل هو الذي شجّع بشار الأسد على استخدام السلاح الكيميائي وعلى التوسع في ابتداع طرق القتل والتنكيل بدون أن يحاسبه أحد من الذين غرقوا في متاهة فلسفية جديدة حول تعريف الإرهاب والمجموعات الإرهابية. لكن، مرة أخرى، فإن هذا لم يكن سوى مجرد تحايل لتضييع الوقت ومنح النظام فرصة التمدد أكثر، فمن الواضح أن أولئك المستضعفين من الأطفال والنساء والعائلات لا يمكن أن يكونوا إرهابيين بغض النظر عن المعيار الذي نستخدمه. كل ذلك أدى إلى نتيجتين مؤسفتين، الأولى هي توحش تنظيم «الدولة» وإغراقه في الفوضوية في ظل مجتمع دولي يستفيد من تعاظمه لتصويره كشبح قادر على التمدد وعلى توجيه الضربات في أكثر من مكان، والثانية هي ظهور مشكلة الهجرة بتداعياتها المختلفة من الموت غرقاً إلى الوقوع ضحية شبكات الاتجار بالبشر والاستغلال.
إن الحديث بعد كل هذه السنوات عن معسكرين أحدهما يقف مع الشعب السوري وآخر مع النظام هو حديث خادع ومجافٍ للواقع. لنتذكر أن مقترح الأمم المتحدة لحل مأساة حلب الذي عبّر عنه دي ميستورا كان خروج الجماعات المسلحة الأقوى من المدينة من أجل إحراج روسيا التي لن تجد حينها ما تتذرع به لمواصلة حربها العبثية. حينها بدا دي ميستورا متواطئاً، وكذلك أممه المتحدة التي أعلنت عجزها عن إيقاف روسيا، فقد تجاهل القرار وجود المئات وربما الآلاف من الميليشيات الأجنبية التابعة للنظام ولحلفائه في الجوار وتناسى أنه ببقاء أولئك وتحييد عناصر المقاومة الأقوى في المنطقة، فإن هذا لن يقود سوى إلى مزيد من التنكيل بالمدنيين. نعلم اليوم أن أهم أسباب ما سمي خلال الأعوام الأخيرة بـ»الارتباك الأمريكي» في سوريا يرجع للتفاهمات التي جرت بين إيران والولايات المتحدة التي حرصت فيها إدارة أوباما على توقيع الاتفاق النووي مع شريكتها الجديدة بأي ثمن كان، ولو أدى ذلك إلى إطلاق يد الأخيرة فيما ترى أنه مناطق نفوذها.
أما علاقة الأمريكيين بالروس، فهي كذلك على النحو ذاته تحكمها المصالح والتقاطعات والتنافس الإقليمي وهو تنافس لم يمنع التنسيق الحربي جواً وأرضاً بين الطرفين، رغم ما يظهر من اقتتال لفظي بينهما. الواقع الذي يجب ألا نتعامى عنه هو أن رؤى الطرفين وأولوياتهما متشابهة. كيف يمكن الخروج من هذا النفق المظلم ومن تلك الحلقات الجهنمية للتواطؤ والخيانة وغدر القريب؟ إن الإجابة تكمن في العبارة المختصرة التي رددها المتظاهرون منذ أول يوم والتي تنفي كل تعويل على أمريكا أو روسيا أو غيرها من الدول التي تدعي بشكل أو بآخر صداقة الشعب السوري. عبارة تقول بإيمان: «ما لنا غيرك يا الله».
كاتب سوداني
القدس العربي
بوتين فرض شروطه: الأسد يبقى!/ راجح الخوري
بعدما استعملت موسكو الفيتو للمرة الخامسة دفاعاً عن النظام السوري، وأسقطت مشروع القرار الفرنسي الإسباني الذي يدعو الى وقف النار، لست أدري ماذا يمكن الإجتماعين اللذين سيعقدان اليوم في لوزان وغداً في لندن، ان يغيّرا من المسار الواضح الذي قرره فلاديمير بوتين، أي إستعجال الحسم في حلب قبل وصول الإدارة الأميركية الجديدة الى البيت الأبيض.
إجتماع لوزان اليوم سيكون مراوحة أو بالأحرى مراوغة داخل الدائرة المفرغة، يقدمها الثنائي جون كيري وسيرغي لافروف امام عدد من وزراء خارجية دول المنطقة المهتمة بالأزمة السورية، لكن هذا في النهاية لن يغيّر شيئاً من الواقع في حلب، والحديث عن مقاربة متعددة الطرف لوقف النار وإستئناف توزيع المساعدات الإنسانية وحل النزاع، يأتي في سياق الأمنيات التي لن تتحقق، والدليل ان النظام السوري أكد أمس استثناء أحياء حلب الشرقية من وصول المساعدات.
أهم من كل هذا ان محاولات واشنطن الحديث عن بدائل من الحل الديبلوماسي والتلويح الشكلي بقصف مناطق النظام، جبهت بتصعيد التدمير الروسي في حلب وبتهديدات صريحة بأن هذا يمكن ان يزلزل المنطقة وبالإسراع في نصب صواريخ “أس ٣٠٠” في طرطوس، ولأن النظام يتقدم في حلب من الطبيعي ان يلتف لافروف على أي محاولة لوقف هذا الزخم خوفاً من إعادة المعارضين ترتيب وضعهم في حلب.
ولأن الكلمة في حلب للميدان ستكون الكلمة في لوزان للافروف، بمعنى ان يكون أي اتفاق لوقف النار مشروطاً بتنفيذ اتفاق جنيف وفق الأجندة الروسية التي لا تتمسك ببقاء بشار الاسد في السلطة فحسب بل تتيح له الإشتراك في الانتخابات المقبلة، وهذا المخرج يلقى بالطبع تأييداً ايرانياً.
قياساً بالتسجيل الصوتي الذي بُثّ على موقع صحيفة “النيويورك تايمس” في ٣٠ ايلول، والذي كشف ان جون كيري اجتمع مع ٢٠ شخصية من المعارضة في ٢٢ أيلول الماضي، في مقر البعثة الهولندية في الأمم المتحدة، وأبلغهم حرفياً “ان أميركا لن تتدخل عسكرياً لأن الكونغرس يعارض هذا، وأنه اذا تدخلت بشكل أكبر سيرتفع سقف المراهنات وسيتم القضاء على المعارضة جميعها، وان أفضل أمل للسوريين القبول بخوض إنتخابات يشارك فيها الأسد وترك القرار للشعب السوري”، قد يكون إجتماع اليوم مقدمة لوضع الدول الإقليمية وخصوصاً السعودية وتركيا وقطر في هذا الجو، وقد يكون اجتماع كيري غداً مع نظرائه الأوروبيين للغرض عينه.
ليس في هذا الإفتراض أي مبالغة، يكفي التأمل في تراجع الموقف الأميركي من التلويح العسكري الى لحس التهديد في خلال يومين، ويكفي أيضاً ان نتأمل في هذا المسلسل الطويل والفاضح من لهاث كيري وراء لافروف، لكأننا امام طوم وجيري يركضان على جثث السوريين!
النهار
روسيا تسترضي السنّة؟/ أحمد مغربي
هل تستطيع روسيا تحمّل أن تكون الدولة الغربيّة (ربما قرأ البعض أنّها الأرثوذكسيّة أو المسيحيّة الغربيّة) التي تقتحم بجيشها (حتى لو اقتصر على الطيران) مدينة عربيّة سنيّة في سوريا؟ هل تتحمّل إيران أن يكون جيشها أو ما يشبهه، سيفاً يفتك بمدينة عربية- سنيّة في سوريا، أي خارج حدودها؟
إذاً، هل يسعى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عبر قمته مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إلى بدء جهد استراتيجي لاستدراج “رضى” سنّي و/أو سنّي عربي، على “تحالف أقليات” في المنطقة العربيّة؟ هل يكون ذلك التوازن- المعجزة (بمعنى إمكان عدم تحقّقه أيضاً) هو المدخل لاستعادة استراتيجيّة لنفوذ روسي واسع في المنطقة؟ هل تكون حلب نقطة اختبار لمدى تحمّل أميركا وجود قوة دوليّة اخرى في الشرق الأوسط الذي استقلت عن نفطه كما صارت أكثر اهتماماً بشرق آسيا منه؟
إذا صحّ ذلك، مع إمكان عدم تحقق تلك المقاربة الاستراتيجيّة، فربما يكون مدخلاً لزيادة وزن القطب الروسي دوليّاً يرفع تأثيره في النظام الدولي، إلى حدّ زيادة قربه من أوروبا: الحليف الأميركي الثابت منذ وقت طويل. ولا يعني ذلك بالضرورة أن تكون روسيا قطباً موازياً لأميركا التي ما زالت قوة كبرى وحيدة عالميّاً. واستطراداً، الأرجح أنّ قمة بوتين- أردوغان ستترك مفاعيل أوسع من أوكرانيا وحربها وعقوباتها (بدأ ذلك فعليّاً، مع “تركيش ستريم”)، وكذلك أبعد من الحديث الغائم حتى الآن عن حلف ثلاثي روسي- إيراني- تركي.
حلب التي لا تغيب…
الأرجح أنّ تعبير “تحالف أقليات” ليس موفقاً، ببساطة لأنه لا وجود لذلك التحالف، بل يُستخدم المصطلح هنا بمعنى مجازي بات شائعاً. إذ يُقصد منه أنّ صعود إسلامويّة تكفيريّة متطرفة (ثم أضيفَ الإرهاب إليها عبر “داعش”) جعل “نسيجاً ما” يسري بين مكوّنات عربيّة دينيّة، سالت منها دماء كثيرة بطرق مرعبة، على أيدي “داعش” و”النصرة”، بمزاعم إسلامويّة فائقة الشطط. واستطراداً، يشير المصطلح أيضاً إلى حال تفارق وتنافر بين مشاريع المكوّنات الدينيّة في المنطقة العربيّة ومجتمعاتها، مع استثناءات قليلة.
وكذلك ربما لا يكون تعبير “نظام دولي متشابك” مريحاً، لكنه يستأهل التفكير فيه. هناك دولة تركيا الأطلسيّة، تعلن أنها تتجاوز الأطر التقليديّة، لتنسج علاقات استراتيجية مع روسيا التي “تتصارع” (بمعنى أنها تتلاقى أيضاً، ولا تتناحر) مع حلف الأطلسي. وتلك مجرد نقطة صغيرة في بحر التشابك.
وقبل ملاحقة الخريطة المعقّدة التي يعمل بوتين على نشر نفوذ روسيا فيها، ضروري التذكير بأن خلفية المشهد العام تتضمّن انتقال النظام العالمي من الأحادية القطبيّة الأميركيّة إلى نظام من التشابك الدولي بين أطراف ليست متساوية، لكنها ليست متناحرة. ومن المهم التشديد على ذلك، للخروج من المقارنات الممتدة من “سايكس- بيكو” التي رسمت خريطة المنطقة العربيّة، و”الحرب الباردة” بين الدب الروسي والنسر الأميركي وغيرها. لقد تغير العالم، ولعله من المهم التفكير في متغيراته، مع الأخذ بعين الاعتبار التاريخ الذي يحضر في ثناياه باستمرار.
إذاً، ذهب بوتين إلى أنقرة، بعد تقارب قوي (خصوصاً، الاتفاق على وضع سقف لإنتاج النفط مع موافقة سعوديّة لافتة) مع دول الخليج العربي التي يفترض أنها تشارك تركيا في دعم مقاتلي الثورة السوريّة، بل ربما قوى إسلامويّة متطرفة تساهم هي أيضاً في تعقيد صورة الثورة السوريّة. من الواضح وجود تقاطع دولي واسع حول التخلّص من الجغرافيا السياسيّة لإرهاب “داعش” (وهو لا يعالجها كإرهاب)، لكن التقاطع أقل كثيراً حول مسار ذلك، وكذلك ما بعده، وكذلك الحال لا يشمل ذلك التقاطع الدولي قوى الثورة السوريّة أيضاً. في ذلك المعنى، تفيد وساطة تركيا في تعزيز الوزن الروسي استراتيجيّاً في المنطقة التي يمسك القطب الأميركي بها بقوة، على رغم متغيّرات في العلاقات مع دولها الرئيسيّة المؤثّرة.
ويعني ذلك أيضاً أن معركتي “دابق” و”الباب”، تعنيان تقاطع تركيا مع روسيا وأميركا سويّة، وتنافرها مع أميركا في المعطى الكردي، وحضور تركيا في سوريا ما بعد “داعش”، واستمرار العلاقة القويّة بين تركيا والقوى الأساسيّة للثورة السوريّة، ومعظمها يعادي روسيا. هل تلعب تركيا دور الوسيط بين روسيا والثورة السوريّة؟ هل تكون المساعدات إلى حلب بداية تلك الوساطة؟ في تلك الخيوط المتشابكة، تنفتح مساحة صغيرة للقول بوجود سعي روسي لنيل نوع من الموافقة (أو الرضى أو التسليم بالأمر الواقع)، من المكوّن العربي/العربي- السنّي على المشهدية الجديدة لتوازع النفوذ الدولي في المنطقة. واستطراداً، من الواضح أن دول المشرق العربي ستعاني مستقبلاً هشاشة داخلية واسعة ومستمرة، إلا إذا ظهر مشروع سياسي ضخم يعبر المكوّنات الدينيّة فيها بصورة إيجابيّة، ويستطيع أن يتعامل إيجابيّاً أيضاً مع المكوّنات القوميّة، خصوصاً الكرد. وتستمر تلك المعاناة، حتى لو تفتت تلك الدول، بل ربما كانت ثمناً لمنع تفتت الجغرافيا السياسيّة في المنطقة.
الموصل: لا حلف مع إيران
تملك تركيا علاقة خاصة مع الدول العربيّة التي “ولدت” من رحم سقوط الإمبراطوريّة الإسلاميّة في مرحلتها العثمانية، ظهّرته ـ”اتفاقية سايكس- بيكو”، وقبلها “معاهدة كوتاهيا” وغيرهما.
وحينها، كانت روسيا عدواً لدوداً تاريخيّاً لتركيا، خصوصاً في حروب القرم، فيما كانت بريطانيا وفرنسا حليفتين مفترضتين لتركيا، وهما متفقتان على تقاسمها. ولم يكن ذلك بعيداً من مسألة الأقليات التي شكلت مدخلاً رئيسيّاً لتدخل الدول الغربيّة في الإمبراطوريّة الإسلاميّة. شمل ذلك أساساً الأقليات الدينيّة، وامتد إلى القوميتين الأرمنيّة والكردية، وهما تحتاجان نقاشاً منفصلاً.
وفي خلفية مشهد بوتين- أردوغان، يحضر الانقلاب الفاشل في تركيا الذي أشار إلى نهاية التدخل الواسع في البلدان العربيّة، لمصلحة إعطاء الأولويّة للحفاظ على وحدة الدولة التركيّة، بمعنى مواجهة صعود العامل الكردي المهدّد لتوازناتها. وتحتفظ روسيا بعلاقات قويّة مع الكرد في سوريا والعراق، من دون الوصول إلى تأييد إقامة دولة كردية مستقلة، ما يبعدها قليلاً عن تركيا، لكنه يقرّبها من… أميركا! واستطراداً، لا تؤيّد أميركا أيضاً دولة كرديّة مستقلة (خصوصاً أن تكون في كردستان التاريخيّة)، لكنها تلقي بثقلها مع الكرد في سوريا والعراق ضمن مسار الخريطة المتغيّرة للمنطقة. ويدل التعامل الأميركي مع تناقضات كرد العراق على حدود تأييدها لهم، كما أنّ عدم مسارعتها إلى إنشاء دولة للكرد في العراق يؤكد ذلك، خصوصاً أن كردستان العراق فيها مقوّمات دولة أكثر من “كوسوفو”. ونشأت الأخيرة في زمن الأحادية الأميركيّة، ما يشير مجدداً إلى التداخل المرّ بين الصراعات التاريخيّة الإقليميّة والأقواميّة من جهة، ومتغيّرات التاريخ التي لا تتوقف من الجهة الثانية.
واستطراداً، تُظهر معركة الموصل المنتظرة، التشابكَ الإقليمي بجلاء، وفي مواجهة داعش. هناك الجيش العراقي لنظام قريب من إيران مع مسافة ما منها. وهناك “الحشد الشعبي” فائق القرب من إيران، ويثير خوفاً أصيلاً من مجازر مذهبيّة في الموصل، ربما مهدّت لظهور “داعش-2” مجدداً. وهناك البيشمركة الكرديّة السنيّة، التي تثير حساسيّة عرب سنّة في الموصل، خصوصاً أنها انزلقت إلى ممارسات انتقاميّة بعد سقوط نظام الديكتاتور صدام حسين، لكنها تريثت كثيراً قبل قتال “داعش”. وهناك “الحشد الوطني” من عشائر سنيّة عربيّة، ربما لا ينفر كثيراً القوات التركيّة في العراق، خصوصاً إذا تفجرت مقتلات مذهبيّة. وتحاول الولايات المتحدة قيادة ذلك التنافر المتشابك، من دون أن تسمح لإيران بالتغوّل في معركة الموصل، كما تحاول إيجاد حل للمشاركة المقلقة لـ”الحشد الشعبي”. وبوضوح، نجحت أميركا في منع روسيا من الدخول مباشرة على خط معركة الموصل، لأن حسابات العراق ونظامه تختلف عن حسابات طغمة بشار الأسد.
ولنتذكر أيضاً أن سوريا هي المرتكز الذي انسالت منه حدود الدول العربيّة، منذ “سايكس- بيكو” إلى تفتت دولة الوحدة مع مصر، إلى التفتت الحاضر في حدود دول المشرق العربي. فهل إيران هي فعليّاً قوة اقليمياً قادرة على التدخل العسكري المباشر في المدى الاقليمي الذي يتحرك فيه نفوذها؟ سيكون ذلك تفسيراً واسعاً لحدود اتفاقها النووي، بالأحرى، سيكون تورّطاً مذهلاً في سوء قراءة ذلك الاتفاق.
إذاً، لا حلف لتركيا مع روسيا، ولا تحالف ثلاثياً مع روسيا وإيران. لا يعود ذلك إلى عوامل إيديولوجيّة مع روسيا العلمانية، أو عوامل مذهبية مع تركيا “السنيّة” (الوصف ليس دقيقاً، لكنه يصح تقريبيّاً في وصف السياسة التركية في المنطقة العربيّة). لنتذكر أن علاقات اقتصادية مذهلة تربط تركيا وإيران، خصوصاً النفط والغاز. قبل “الربيع العربي”، كررت قيادتا البلدين أنهما، سويّة، المركز الفعلي للشرق الأوسط. لا تحالف، لكن تركيا وإيران تلتقيان في عدم تأييد دولة كردية، رغم علاقة وطيدة بين إيران والكرد في العراق، بل وعلاقة غير منقطعة تركياً، كما دلّت زيارة مسعود بارزاني لأنقرة مؤخراً.
المدن
أردوغان وبوتين والعجز العربي/ الياس حرفوش
رجب طيب أردوغان وفلاديمير بوتين هما الآن الزعيمان اللذان يستفيدان من الفراغ الذي خلّفه تخاذل إدارة باراك أوباما عن لعب دور القوة العظمى في الأزمة السورية، كما خلّفه العجز العربي عن مواجهة الدعم الروسي والإيراني لنظام بشار الأسد، والهيمنة الإيرانية الكاملة على مقدرات العراق.
في زمن العجز هذا، صار متاحاً للرئيس التركي أن يوجه الإهانات إلى رئيس حكومة العراق، داعياً إياه إلى معرفة «حجمه» والتزام «حدوده». كما صار في إمكان أردوغان أن يقرر متى يتدخل عسكرياً في المدينة الثانية في العراق، وبأي حجم وبأية شروط، وحجته أن أمن تركيا من أمن الموصل، وأن العراق غير قادر على ضمان هذا الأمن لا للموصل ولا لتركيا. وإذا لم يفعل أردوغان ذاك في الموصل، لحمايتها في الوقت ذاته من تنظيم «داعش»، كما من الهجمة المذهبية عليها بحجة تحريرها على يد قوات يفترض أنها تابعة للجيش الوطني العراقي، فيما لا تتردد في رفع الرايات المذهبية فوق عرباتها المدرعة… إذا لم يفعل أردوغان ذلك فمن تراه يفعل؟
أما بوتين فقد جاءه إخلاء باراك أوباما الساحة السورية على طبق من ذهب. وعلى عكس رفض أوباما نجدة المعارضة بالسلاح، أو حتى السماح لحلفائها الإقليميين بذلك، هبّ بوتين إلى تلبية طلب بشار الأسد بالدعم العسكري، فكان التدخل الروسي منذ آخر أيلول (سبتمبر) من العام الماضي، بخمسة آلاف جندي على الأقل، وقوة جوية هائلة، مدعومة بأنظمة صواريخ مضادة للطائرات (أس – 300 وأس – 400)، وقلب هذا التدخل المعادلة العسكرية وأتاح للأسد أن يتطلع إلى البقاء في السلطة، ولو فوق أنهار الدماء السورية وخراب المدن المدمرة، مثلما أتاح لموسكو أن تفرض نفسها كلاعب لا يمكن تجاهل دوره في أي عملية سياسية للتوصل إلى حل للأزمة السورية. لقد بات السعي الأميركي وراء هذا الدور الروسي أشبه بالاستجداء، كما حصل مع الاستعدادات لاجتماع لوزان أمس، إذ حرص جون كيري على دعوة سيرغي لافروف إليه، مستبعداً في الوقت ذاته أطراف المعارضة السورية، فيما جاء الوزير الروسي متردداً ومتذمراً، مع الإعلان المسبق أنه لا يتوقع شيئاً من الاجتماع، فيما القذائف الروسية تمطر مدينة حلب بالنيران.
في سورية نجح حلف المصالح بين الرئيسين التركي والروسي في تكريس معادلة تخدمهما في المنطقة الحدودية بين سورية وتركيا، على رغم الخلاف الذي ما زال قائماً بينهما (كما يبدو) في شأن مصير بشار الأسد. وفي ظل السيطرة الروسية الكاملة الآن على القرار العسكري في سورية، نجح الأتراك في اقتطاع مساحة تقارب ألف كيلومتر مربع من الأراضي السورية على الحدود، ويأمل أردوغان بتوسيعها إلى 4 آلاف كلم، ليحقق بذلك مطلب «المنطقة الآمنة» التي أرادها منذ زمن، ولم يتجاوب الأميركيون معه في تنفيذها، فكان غض النظر الروسي، الذي منع الإيرانيين والسوريين من تنفيذ عمليات في تلك المنطقة تعيق السيطرة التركية، وفي المقابل أتاح لبشار الأسد العثور على منطقة يستطيع أن يرسل إليها المقاتلين المعارضين الذي يتم «تنظيفهم» في حربه على المدن السورية.
في الوقت ذاته، فرض أردوغان نفسه كالقوة الوحيدة القادرة على مواجهة تنظيم «داعش»، أو دعم القوى السنّية المحلية المستعدة لذلك، كما كانت الحال في مدينة جرابلس، واستطاع بذلك أن يستبعد أي دور كردي عن هذه المواجهة، خصوصاً أن هذا الدور يأتي على رأس المشاغل التركية، ويكاد يسبق «داعش» أو يتساوى معه في مستوى القلق الذي يشكله لصانع القرار في أنقرة.
في حلف المصالح بين أردوغان وبوتين، يستخدم كل منهما الآخر. أردوغان «ينتقم» بغزله مع موسكو من التقارب الأميركي مع الأكراد، كما من توفير الملاذ لفتح الله غولن، الغريم الأول لأردوغان. أما الروس فيجدون في تقاربهم الحديث العهد مع أردوغان فرصة للرد على الاتهامات بأنهم يعادون السنّة في المنطقة ويتدخلون ضد مصالحهم في سورية. كما أن هذا التقارب يشكل فرصة كذلك لتركيا لتعزيز علاقاتها مع الدول العربية، الناقمة على الانكفاء الأميركي، والعاجزة عن لعب أي دور أو القيام بأي مبادرة، فيما تتطلع إلى قوة أخرى لتوازن هذا الغياب.
الحياة