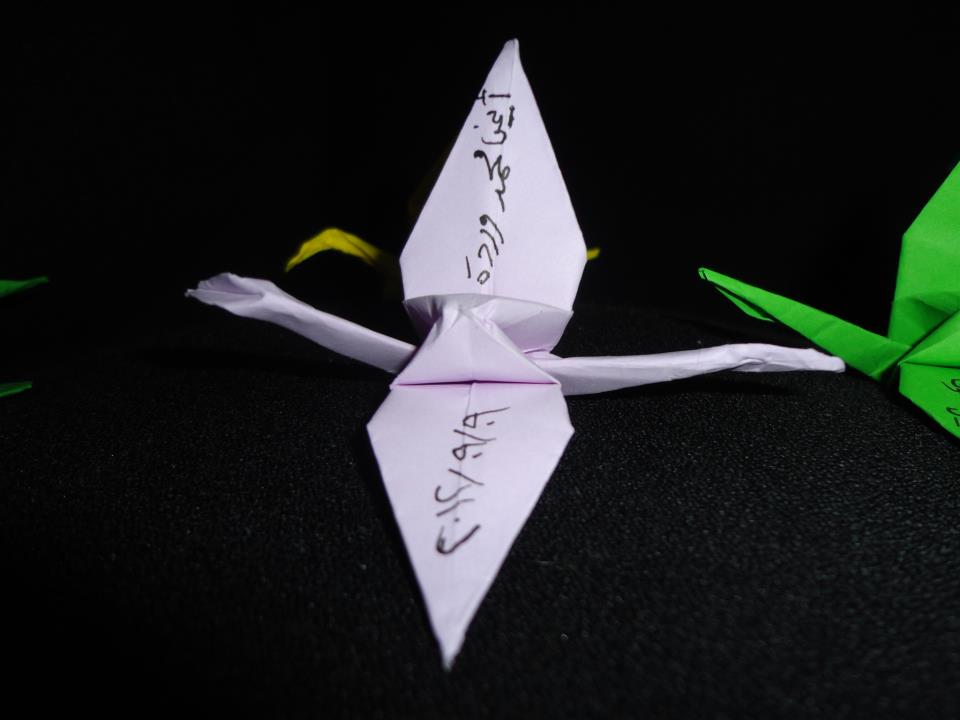التدخل الروسي في سورية، التوتر بين روسيا وتركيا –مجموعة مقالات وتحليلات-

من يمنع القرار السوري؟/ ميشيل كيلو
يؤكد وزير خارجية روسيا، المعروف بحدبه الشديد على الشعب السوري، أن “القرار يجب أن يكون للسوريين وحدهم في كل ما يتصل بمستقبل وطنهم ومصير بشار الأسد”. بهذا التوجه الحريص على سيادة الشعب السوري، واستقلال قراره، يقاوم سيرغي لافروف، بشراسة، التدخلات الأجنبية في شؤونه، وانطلاقاً من موقفه هذا لا يرى في احتلال جيش بلاده سورية تدخلاً أجنبياً، ويعتبره عملاً شريفاً يعزز حقوقها واستقلال إرادتها. وإذا تخلله قصف جوي مكثف للمعمور من أرجائها، المدنية منها بصورة خاصة، يقتل خلاله عدد كبير من بناتها وأبنائها، وتدمر مدنها وقراها، فهل هكذا يحمى حق السوريين في تقرير مستقبلهم، ومصير بشار الأسد، وينالون حريتهم؟.
في تصريح لا يحتمل تفسيرات متناقضة، يدعو لافروف إلى ترك السوريين يقرّرون وحدهم مستقبلهم، ومصير بشار الأسد ونظامه. ولا يتساءل سعادته عن مدى توافق تصريحه مع سياسات دولته السورية، وما إذا كان تدمير الجيش الحر يتفق واحترام حق السوريين “وحدهم” في تقرير مصيرهم، أو يفرض عليهم الأسد، على الرغم من تعارضه مع رغباتهم وحريتهم. إذا كان لافروف لا يرى تعارضاً بين سياسات بلاده وحق السوريين في تقرير مصيرهم وحدهم، فذلك لأسبابٍ، منها اعتقاده أن الجيش الروسي ليس أجنبيا بل سوري، وأن ما يقوم به جزء من حقهم في تقرير أمورهم، لا يتعارض مع إرادتهم الوطنية، وكيف له أن يتعارض إذا كان هدفه القضاء على الإرهاب، عدوهم اللدود الذي نجح في التسلل إلى صفوفهم، وتوطن في نفوسهم، ولو لم تساعدهم طائرات روسيا على إخراجه من قلوبهم وعقولهم، لكان فتك بهم أفظع الفتك.
بمنطقه هذا، يمون لافروف على سورية، ويعتبر نفسه سورياً، له حق النطق نيابة عن بني قومه، ولا ضير عليه إن منح عسكر بلاده الجنسية السورية، واعتبر سورية جزءاً من روسيا، وجيشها فصيلاً من الجيش الروسي. لا يغير من هذه الحقيقة أنه يساعد الأسد على التخلص منهم، ويمكنه من قتلهم جماعات وفرادى، ويزوده بكل ما هو ضروري لهدم بيوتهم على رؤوس أطفالهم ونسائهم. طبيعي أن الروس فعلوا ذلك لأن “أسدهم” رئيس شرعي، انتخبه الشعب السوري، في تعبير صريح عن حقه في تقرير مصيره، فإذا كان هناك من يشك بذلك، أو من يفهمه بصورة خاطىة، فما ذلك إلا لأنه عميل سعودي/ قطري/ تركي وإرهابي.
يستحيل فهم هذا المنطق الذي يبدو أنه يوجه خطى الكرملين بمعايير عقلانية وشرعية. لذلك، فعل المستحيل لإبقاء الأسد بالقوة في السلطة، من دون أن يتخلى عن أكذوبة “عدم التدخل في شوون السوريين”، أو يتوقف عن تذكير العالم بحتمية تولي السوريين حل مشكلاتهم بأيديهم، من دون تدخل طرف خارجي. يصدر هذا الموقف الغريب عن دولة عظمى، تخوض حرباً ضد شعبٍ، تريد له ممارسة حقه في تقرير مصيره، على أن تكون نتيجة قراره رضوخه من جديد لحكم الأسد ونظامه الاستبدادي والفاسد، وإلا رفضت موسكو قراره وقصفه طيرانها وأسطولها البحري، إلى أن يقبل ما قررته هي له: الأسد رئيساً أبدياً، ونظامه خياراً وحيداً.
ما ذنب لافروف، إذا كنا، طرفاً معارضاً، نرفض السخاء الروسي، وما تمليه عليه القوة العسكرية؟ وفي المقابل، ما ذنب السوريين إذا كان لافروف لا يحترم كلامه حول حقهم في أن يقرّروا وحدهم مصير بشار الأسد؟. وفي النهاية، هل كان الشعب السوري مخطئاً، لأنه يرفض أن يرى في جيشها الذي يحتل بلاده بالقوة غير احتلال أجنبي واجب المقاومة، ليس من حقه أن يقرّر نيابة عنه مصير بلاده، وأن يقصفه ليبدل موازين القوى بينه وبين النظام، ويرغمه على قبول من ضحّى بمئات الآلاف من بناته وأبنائه كي يتخلص منه: بشار الأسد ونظامه من جهة، بينما يبيعه كلاماً فارغاً عن حقه في تقرير مصيره بحرية من جهة أخرى.
يرفض الروس القرار السوري المستقل، بحجة الحفاظ عليه، ومنع غيرهم من التدخل فيه. صدق من قال: اللي استحوا ماتوا.
العربي الجديد
قدرة الاحتمال الروسي/ باسل العودات
مر سبعون يوماً على بدء روسيا حربها في سورية، وهي مازالت حتى الآن متمسكة بموقفها العسكري المساند للنظام السوري، وصامدة في موقفها السياسي تجاه الأزمة السورية، لا يزحزح قرارها شيء، لا الرأي العام السوري الذي بات معادياً لها بشكل غير مسبوق، ولا توتر علاقاتها مع تركيا، أو سوء علاقتها ببعض الدول العربية معها، ولم يردعها صراعها البارد مع الولايات المتحدة، ولا العقوبات الغربية المستمرة والمتجددة.
مرّ سبعون يوماً ادّعت خلالها وسائل الإعلام الروسية قيام الجيش الروسي بعشرات الغارات الجوية يومياً تُمطر بها السوريين بمئات الصواريخ والقذائف، وأطلقت آلاف الصواريخ والقذائف في حملتها العسكرية المستمرة، ورغم أنه رقم غير بسيط بالعرف العسكري، إلا أن تأثيره على تنظيم الدولة الإسلامية غير ملموس إلا بالتصريحات الروسية العنترية، كما أن تأثيره على القوى الثورية كان معكوساً حيث زاد إصرارها على المضي بالحرب وصار هدفها إسقاط النظامين السوري والروسي.
لم تستطع قوات النظام السوري خلال هذه الفترة تحقيق أي إنجاز أو نصر استراتيجي ذي شأن، رغم كل الدعم الروسي العسكري، ولم يستطع تغيير ميزان القوى إلا بشكل جزئي ومؤقت ومحدود، كما لم تستطع أو بالأدق لم تهتم بشل قدرات تنظيم الدولة الإسلامية، بل توجهت لتلقين المعارضة السورية درساً في طريقة احترام الزعيم وضرورة عدم المطالبة بإسقاطه، لا هو ولا نظامه.
دخلت روسيا إلى سورية بعد مرحلة من المناورة و(الاحتيال السياسي)، خلعت قناعها وضربت بعرض الحائط بكلامها (المعسول) الذي أسمعته لبعض المعارضين السوريين بأنها حيادية، ودخلت مدججة بأسلحتها وقوتها الكاملة، تضرب وتقصف وتقتل، وتتوعد كل من يحمل السلاح ضد النظام بمصير أسود.
مع دخول سلاح الطيران الروسي الهائج لسورية، كان التحالف الدولي مشغولاً بدراسة وسائل صد تنظيم الدولة في سورية والعراق وبحشد المشاركة الدولية للتعاون معه، وكانت أوربا منشغلة بموجات اللاجئين الفارين من الحرب السورية وغيرها، وكان العالم كلّه منشغلاً بمراقبة إرهابيين عرب وأوربيين عائدين من سورية ويخططون للأسوأ في بلادهم، فيما كانت تركيا منشغلة بانتخاباتها وبالمشاكسات التي يقوم بها الأكراد السوريون على حدودها الجنوبية، أما بعض العرب فقد كانوا في حيرة من أمرهم كيف يواجهوا نتائج الاتفاق النووي الإيراني.
التدخل الروسي العسكري في سورية فاجأ السوريين كما فاجأ دول الجوار وأربك المجتمع الدولي، جاء صاعقا ًوسريعاً، بدون مقدمات ولا مبررات مقنعة أو مكتملة الأركان، إلا أن السوريين والدول الداعمة والمؤثرة بالأزمة السورية سرعان ما استطاعوا امتصاص الصدمة الأولى، وسرعان ما مُنيت قوات النظام بخسائر كبيرة غير مسبوقة في الدبابات والقوات في معركة مشتركة بين قوات النظام والطيران الروسي، كما قُتل ضباط من الحرس الثوري الإيراني ومن عناصر حزب الله أكثر من أي فترة سابقة، وبدأت المعارضة المسلحة والدول الداعمة لها كل يخطط للمرحلة المقبلة وكيف يمكن تلقين المتدخل الجديد درساً.
تنحت الولايات المتحدة جانباً، وتركت المجال لروسيا لتفعل ما تريد، وتراقب بخبث ما يقوم به (الدب) الروسي الذي يضرب دون تفكير، فهي تُدرك أكثر منه أنه وضع أرجله في الرمال المتحركة، تلك الرمال التي تفادتها الولايات المتحدة في العراق سابقاً وفي سورية الآن، وهي تعرف تماماً كم تحتاج لوقت حتى يغرق فيها حتى أذنيه أو كم سيتحمل قبل أن يهرب منه.
بعد أسبوع من التدخل الروسي، بات لدى المعارضة السورية المسلحة قدرات أكبر، فانهالت عليها بسخاء الصواريخ المضادة للدبابات، وأعلنت الكتائب الثورية النفير العام، وبدأت تتوحد بخطوات متسارعة ضد عدو جديد ستخوض معه صراعاً مريراً من أجل البقاء، ووفق المصادر الغربية سيزيد السلاح كمّاً ونوعاً مادامت روسيا مستمرة في خططها.
ليست الأزمة السورية هي الأزمة الوحيدة التي تتعامل معها روسيا، فهناك مروحة واسعة من الأزمات، الداخلية والخارجية، ليس أولها المشكلة الأوكرانية ولا مقاتلوا القاعدة الشيشانيين، وليس آخرها الأزمة الاقتصادية، ولا تلك الأزمة المستحدثة مع تركيا، ولا التكلفة الباهظة لحربها في سورية، بل هي كل هذه الأزمات وغيرها الكثير مجتمعة.
تحاول روسيا بكل ما تملك من وسائل سياسية ودبلوماسية وإعلامية أن توحي بأنها تقفز بسهولة وخفّة من انتصار إلى آخر، وتستعرض قواها العسكرية (الخارقة)، وتُطلق صواريخاً من بحر قزوين وما وراء وراء قزوين، وتتباهى بإطلاق صاروخ من غواصة في المتوسط على تخوم الشاطئ السوري، وتُلوّح باستخدام النووي في سورية وهي تعرف أنه تهديد سريالي أرعن سخيف لا معنى له، وكل ذلك لتوحي للسوريين والعالم بأنها الأقوى وأنه يجب الرضوخ لشروطها في سورية.
كل هذه المعمعة الروسية لن تفيد، فالساسة الأمريكيون يعتقدون على نطاق واسع أن روسيا يمكن أن تحتمل وجودها في سورية بهذه الطريقة شهراً آخر، وإن صمدت وعضّت على أصابعها ستحتمل عدة أشهر قليلة، ومن ثم ستبدأ حُكماً مرحلة التراجع والخسائر والأسف من الورطة التي تورطت بها، خاصة وأن بديهيات الحالة السورية تؤكد على أنه لا يمكن لأي قوة أن تغيّر أو تكسر المسار، وأنه لا عودة للوراء، ولا رجوع لزمن الحكم الشمولي الطاغي، ولا للدولة الأمنية الطائفية، ولا للأحلام الأبدية بالحكم أو توريثه، ولا عودة لزمن الخوف والرعب والاستكانة والذل، وهذا ما سيُقاوم من أجله السوريون وسيتمرون به حتى تتعب روسيا أو تقبل مضطرّة بشروط منطقية معقولة تُرضي الضحية لا الجلاد.
المدن
ماذا قرّر بوتين؟/ ميشيل كيلو
بمتابعة التطورات التي أعقبت إسقاط طائرة السوخوي الروسية، يمكننا وضع يدنا على نوع قرار الكرملين ضد تركيا الذي أعلن فلاديمير بوتين بعض ملامحه التنفيذية، وقال إنه سيتخطى المجال التجاري والسياحي، وسيكون متدرجاً ومؤلماً، وسيجعل الأتراك يندمون كثيراً، لأنهم أسقطوا الطائرة، في حين كان قد اتخذ جملة تدابير عسكرية ميدانية رادعة إقليمياً ودولياً، تستهدف تقييد حركة القوات التركية المسلحة وفاعليتها، وفرض سياسة حافة الهاوية على حلفائها، مثل تعزيز الانتشار البحري الروسي شرقي المتوسط، قرب السواحل التركية، بطراد صاروخي فريد القدرات والتقنيات، وإرسال عدد كبير من الطائرات الحربية المتقدمة جداً إلى سورية، ونشر صواريخ s400 ذات القدرات الاختراقية والتعبوية الخارقة، القادرة على تقييد حركة الطيران التركي والأطلسي مئات الكيلومترات داخل الأراضي التركية، بما يعطل مجموعة مهمة من مطاراتها العسكرية، بما فيها التي يستخدمها “الناتو” وأميركا، ويمنعها من تحريك طائراتها، وتغيير أسلوب الطيران الروسي في مهاجمة الجيش الحر، وإدخال طائرات استراتيجية المهام وغواصات نووية إلى المعارك، واستخدام صواريخ طوّافة بعيدة المدى، دقيقة التصويب وذات قدرات تدميرية كبيرة، وأخيراً التوسع في استخدام الطائرات بلا طيار، لرصد “العدو” وتدميره، على الطريقة الأميركية في باكستان وأفغانستان واليمن.
بعد تصعيد التعبئة والقدرات الميدانية، وإعادة النظر في استخدامها، بدأ تطبيق الخيار السياسي/ العسكري الروسي الجديد، القائم من جهة على منع تركيا من إقامة منطقة آمنة، لأن قيامها
“لا يبدو أن منطقتنا في طريقها إلى السلام أو الحل السياسي، ذلك أن روسيا منهمكة في تصعيدٍ عاصفٍ يستهدف شطب الجيش الحر من معادلات الصراع السوري الداخلي، وتركيا من معادلات الصراع الإقليمي” يعني تعظيم قدرتها على التدخل في سورية، وتعظيم دورها في تحديد نمط الحل السياسي فيها، ورسم خطوط حمراء لتدخل روسيا، خصوصاً إن أيدت واشنطن قيام المنطقة الآمنة، ومن جهة أخرى، على رسم خطوط حمراء روسية، لتدخل ودور أنقرة السوري، تشمل إرغامها على الامتناع عن التصدي للطيران الروسي، وإن اخترق مجالها الجوي، وشن هجوم شامل على من تدعمهم من الجيش الحر في جبلي التركمان والأكراد وطردهم منهما، قبل الانتقال إلى جسر الشغور وإدلب، وفي النهاية إلى حلب، وخصوصاً مناطقها القريبة من الحدود التركية، وصولاً إلى تطبيق تام لقرار روسي بإخراجها من الصراع السوري، وتدفيعها ثمن الخسارة الاستراتيجية الشاملة التي ستحل بها وبالجيش الحر الذي سيواجه الهزيمة بدوره، ولن يبقى له غير بقع أرضية في أواسط سورية، مفككة ومنفصلة بعضها عن بعض، ومقطوعة عن مصادر تسليحها وتذخيرها.
هذه التحولات العسكرية الروسية، وما يترتب عليها من هجمات، تبدّل اليوم الأوضاع الميدانية، وخصوصاً في جبلي الأكراد والتركمان، فرضت على تركيا التخلي عن المنطقة الآمنة، وقيدت بالفعل قدرتها على زيادة دورها المباشر في الصراع، وتركت لها خيارين: أولهما، صد الهجوم الروسي، بتوسيع عونها العسكري واللوجستي للقوى السورية المقاتلة وتنويعه، بحيث يمكّنها الردع الذي ستمارسه بالواسطة ضد الجيش الروسي من استعادة بعض حريتها في التحرك المباشر، علماً أن خطط الروس نقلت جزءاً كبيراً من ثقل المعركة السورية إلى منطقة الساحل السوري، ووضع تركيا أمام تصعيد يهدّد بالتحرش المباشر بها في أي وقت، داخل سورية وخارجها. وثانيهما: تفعيل التزامات “الأطلسي” تجاهها وتحاشي الانخراط المنفرد في الخيار الأول، بمخاطره التي ستتحدّى قدرتها على مواجهته، في حال صعد بوتين ضدها إلى حدٍّ لا قبل لها بمواجهته بمفردها. ثمة طبعاً إمكانية للجمع بين هذين الخيارين، لكن الغرب ليس مستعداً للقدر الذي تتطلبه من مجازفة.
والخلاصة: لا يبدو أن منطقتنا في طريقها إلى السلام أو الحل السياسي، ذلك أن روسيا منهمكة في تصعيدٍ عاصفٍ يطاول قدراتها الميدانية وأهدافها السياسية/ العسكرية، يستهدف شطب الجيش الحر من معادلات الصراع السوري الداخلي، وتركيا من معادلات الصراع الإقليمي، ويستبعد أن يوافق الكرملين على حلٍّ لا يعبر عن النتائج التي يريد لها أن تترتب على هذين التطورين، أي أنه لن يوافق على عملية سلامٍ قبل تحقيق قدر كبير من هدفيه السابقين، أو قبل تحقيقهما كاملين.
في الختام، أعتقد أن على مؤتمر الرياض مناقشة هذه التطورات الخطيرة، واتخاذ خطوات عملية من شأنها إفشال الخطط والخطوات الروسية ضد الجيش الحر، وتطوير علاقات المعارضة مع بيئتها القومية والإقليمية، وخصوصاً منها بلدان الخليج وتركيا، من أجل إرساء حماية متبادلة في الاتجاهين وضمانها، وفتح طريق الحل من خلال إفشال السياسات الروسية التي يعني نجاحها في دحر الجيش الحر، وإخراج تركيا والسعودية من الصراع السوري، تعظيم قدرتها على فرض حلٍّ، لا علاقة له بجنيف أو حتى بفيينا، جوهره احتواء المعارضة، أو بعض فصائلها من النظام، وإجراء بعض الإصلاح الشكلي فيه، وبقاء الأسد متربعاً على صدرنا، والبعث الطائفي سيد المواقف.
العربي الجديد
روسيا وتركيا وبينهما “داعش”/ هوشنك أوسي
روسيا لا تنطبق عليها نظريّة «تصفير المشاكل» مع الجيران التي أطلقها رئيس الوزراء التركي أحمد داوود أوغلو، حين كان يرأس الدبلوماسيّة التركيّة. ذلك أن العلاقات الروسيّة – التركيّة، منذ انتهاء الحرب الباردة وانهيار الاتحاد السوفياتي السابق، كانت جيّدة، وتشهد نموّاً وتطوراً متسارعاً، ولم تتأثّر بـ «انقلاب» أردوغان على نظام الأسد، ودعمه المعارضة العسكريّة والسياسيّة السوريّة المطالبة باسقاط الأسد، حليف موسكو. بالتالي، لم تستيقظ موسكو يوم أمس حتى تكتشف دعم أنقرة للتنظيمات التكفيريّة والإرهابيّة النشطة في سورية. فهذا الأمر كان معلوماً لدى الروس. بل يمكن القول إن هذا الدعم، صبّ في طاحونة المصالح الروسيّة، لجهة جذب واستقطاب أنقرة كل العناصر المتطرّفة في روسيا الاتحاديّة ومنطقة القفقاس وجمهوريّات آسيا الوسطى، والزجّ بهم في «المحرقة السوريّة». وهذا بذاته مصلحة روسيّة كبرى، وخدمة عظيمة قدّمتها أنقرة لموسكو، ربما من حيث لم تحتسب الأخيرة.
وبعد إسقاط الطائرة الروسيّة، «فجأة» اكتشفت روسيا الضلوع والتورّط التركيين في دعم «داعش» وشراء أنقرة نفط هذا التنظيم الإرهابي، إلى آخر الاتهامات التي ساقها المسؤولون الروس. وبصرف النظر عن قوّة وصدقيّة الدلائل والقرائن التي قدّمها الروس، فنفي أردوغان المطلق لأيّة علاقة مع «داعش» يشبه، إلى حدّ بعيد، نفي حافظ الأسد أية علاقة لنظامه مع «العمال الكردستاني»، في الثمانينات والتسعينات. ويشبه أيضاً نفي بشار الأسد أية علاقة مع التنظيمات التكفيريّة التي قاتلت الجيش الأميركي في العراق بعد سقوط نظام صدّام! كذلك يشبه نفي أردوغان نفي حزب بي واي دي الأوجلاني السوري، أيّة علاقة له بنظام الأسد! وهنا، لا أقارن بين «الكردستاني» و «داعش»، ولا أضع التنظيمين في منزلة واحدة، كما يحلو لأنصار الأول تفسير ذلك. بل أقارن بين طريقة النفي المطلق والمبرم الذي تمارسه هذه الأطراف ووجود كمّ من الدلائل والقرائن التي لم تعد تخطئها عين!
غالب الظنّ أن إسقاط الطائرة الروسيّة كان متفقاً عليه بين واشنطن وأنقرة. والهدف الأميركي منه توريط أنقرة في الاشتباك السياسي أو العسكري مع موسكو وجرّ الأخيرة إلى التصادم العسكري مع أنقرة، الذي هو في الوقت عينه، جرٌّ للتصادم مع الناتو. وعلى رغم أن الغطرسة والعناد اللذين يتمتّع بهما الرئيس الروسي بوتين، لا يختلفان عما هو لدى أردوغان، فالروس أرادوا الردّ على تركيا اقتصاديّاً وإعلاميّاً، ولم يصل الأمر بعد إلى الردّ الديبلوماسي الذي ربما يصل إلى خفض التمثيل، ولن يصل إلى قطع العلاقات، فذلك ينذر باحتمال نشوب حرب بين البلدين. وأعتقد أن الأتراك لن يكرروا ما فعلوه إبان الحرب العالميّة الأولى، حين انزلقوا نحو الحرب ضدّ روسيا القصريّة، وما ترتّب على ذلك من استنزاف السلطنة العثمانيّة وإنهاكها، أكثر مما كانت عليه من استنزاف وإنهاك، ومن ثم تقسيم تركة «الرجل المريض» عبر «سايكس-بيكو». وبالتالي، فأي دخول للأتراك، في شكل مباشر، في حرب مع دولة عظمى كروسيا، قد يشعل تركيا بأكلمها، ويفضي إلى «سايكس-بيكو 2» بعد مرور مئة عام على الأول.
وربما قال قائل: «تركيا العثمانيّة، وقتذاك، ليست تركيا الحاليّة على الصعد الاقتصاديّة والعسكريّة والسياسيّة. ثم إن الدول التي اقتسمت أراضي السلطنة هي حلفاء تركيا الحاليون. وستقف هذه الدول مع تركيا ضد أي حرب تشنها روسيا عليها». لكن الحرب كفيلة بتدمير أكبر الصروح الاقتصاديّة وإتلاف أكثر النسج الاجتماعيّة تماسكاً، فما بالكم بحال النسيج الاجتماعي التركي المضعضع، والملغوم بقنابل القضايا القوميّة والعرقيّة الموقوتة، كالقضايا الكرديّة والعلويّة والأرمنيّة! وعليه، ربما يتريّث الناتو قبيل الانخراط في أيّة حرب محتملة ضد روسيا.
وهذا مع الأخذ في الحسبان أنه لو كانت تركيا كانت جادّة في غضبها من الاحتلال الروسي لسورية، ودعم موسكو نظام الأسد، ولو أن أنقرة مع ثورة الشعب السوري وإسقاط النظام، لبادرت هي إلى الضغط على موسكو، وقطعت العلاقات الاقتصاديّة والعسكريّة معها، وأغلقت المجال الجوي التركي أمام الطيران العسكري الروسي. لكن أنقرة لم تُقدِم على ذلك، كونها تدرك خطورة ما يمكن أن يترتّب على هكذا خطوة.
وفي المحصّلة، هذا الكلام هو في إطار مناقشة فرضيّات احتمال تصاعد الأزمة بين البلدين إلى الحدود القصوى. وفي هذه الحال ستكون لكل جانب أوراقه القويّة التي يستخدمها. فتركيا بإمكانها، إلى جانب الإجراءات المذكورة آنفاً، تحريك الحركات الإسلامية في روسيا ومنطقة القفقاس مجدداً، وإعادة وجهة الجماعات التكفيريّة الشيشانيّة والقفقاسيّة نحو روسيا. بينما يبدو أن موسكو حسمت أمرها في المواجهة غير المباشرة عبر التلويح بدعم «العمال الكردستاني» داخل تركيا وخارجها، وتحديداً في سورية، بتقديم السلاح والدعم اللوجستي لفرعه السوري. وهذا ما يقلق تركيا، لتقاطعه مع الدعم الأميركي لهذه الجهة الكرديّة في سورية. ثم هناك احتمال انفجار الوضع الكردي في تركيا، بأمر ودعم روسي-إيراني.
لذا، تناقل الإعلام التركي، مؤخّراً، اخباراً عن احتمال عودة المفاوضات بين أوجلان و «الكردستاني» والحكومة التركيّة مجدداً، بهدف تحييد «الكردستاني» عن أي نزاع محتمل بين روسيا وتركيا.
ويبقى السؤال: هل ستكون الأزمة المحتدمة بين موسكو وانقرة زوبعة في فنجان، كما حصل سابقاً بين أنقرة وتل أبيب؟، أم أنها فعلاً أزمة حقيقة، ليست في طريقها إلى التذليل على المدى المنظور، تسير على إيقاع وتيرة التراشق بالتصريحات والاتهامات، وما قد يترتّب على ذلك من أخطار وأهوال محدقة بالروس والأتراك؟ وهذا من دون إغفال أن حرباً كهذه قد تغيّر وجهة كل التنظيمات التكفيريّة والإرهابيّة وحركة الجهاد العالمي من استهداف أميركا وأوروبا إلى استهداف روسيا. وهذه أيضاً هي مصلحة أوروبيّة-أميركيّة.
* كاتب كردي سوري
الحياة
ماذا حقق بوتين من مغامرة التدخل في سوريا حتى الآن؟/ د. بشير موسى نافع
بدأت عملية التدخل الروسية في سوريا منذ 30 ايلول/سبتمبر، أي أن أكثر من شهرين مضيا عليها حتى الآن . قالت موسكو في مطلع العملية أنها موجهة ضد تنظيم الدولة والمجموعات الإرهابية الأخرى، ثم اتضح أنها تستهدف كل قوى المعارضة السورية، وتعمل على ترجيح ميزان القوى لصالح نظام الأسد. وقالت موسكو في البداية أن العملية ستستمر حوالي الشهور الثلاثة؛ ثم تراجعت عن التحديد، مؤكدة أنها عملية مفتوحة. اكثر من ذلك، أن العملية التي بدأت بحشد أحدث الطائرات والقذائف الروسية في قاعدة جوية عسكرية سورية واحدة بالقرب من اللاذقية، يبدو أنها ستتسع نحو قاعدة جوية ثانية بالقرب من حمص. المهم، وبغض النظر عن الأسباب خلف ذلك الاضطراب المبكر في أفق العملية، فربما بات من الجدير الآن التساؤل عن ما حققته بالفعل.
كان إسقاط الطائرة المدنية الروسية في شبه جزيرة سيناء إحدى أبرز النتائج المبكرة للتدخل في سوريا. ليست روسيا غريبة عن الإرهاب، بالطبع، وقد تعرضت أهداف روسية عديدة في التسعينات والعقد الأول من هذا القرن لعمليات إرهابية دموية. ولكن تلك الموجة من الإرهاب كانت وثيقة الصلة بصراع موسكو مع شعوب شمال القوقاز، واقتصرت على أهداف داخل الاتحاد الروسي. الآن، كما يبدو، توضع روسيا على رادار الإرهاب الدولي، مما قد يهدد مصالح روسية داخل الاتحاد الروسي وخارجه. نظام حكم الرئيس بوتين هو نظام تحكمي إلى حد كبير، ولكنه مهما كان تحكمياً، لم يزل يعبأ بالرأي العام الروسي. وعلى خلفية من سلسلة إخفاقات على صعيد الجوار والعلاقات مع الغرب، إضافة إلى الانحدار الملموس في الوضع الاقتصادي للبلاد، لم يكن خافياً أن بوتين سعى إلى تقديم التدخل في سوريا باعتباره عملية نظيفة. سوريا، أرادت إدارة بوتين أن تقول للشعوب الروسية، لن تكون أفغانستان، وأنها ستحقق الأهداف الاستراتيجية للعملية بدون خسائر ملموسة. العملية الإرهابية في سماء سيناء، شكلت الخدش الأول للخطاب الذي حاولت موسكو به تسويغ العملية وكسب دعم وتأييد الرأي العام الروسي لها.
ولكن الأمور لم تقتصر على إسقاط طائرة شبه جزيرة سيناء. ففي حادثة تصعيد لم تكن بعيدة عن التوقعات، قامت طائرة تركية بإسقاط طائرة روسية، بعد أن أخفقت الأخيرة في الاستجابة لرسائل التحذير وانتهكت المجال الجوي التركي في منطقة هاتاي الحدودية. ما يقوله الأتراك أن انتهاك الطيران الروسي للأجواء التركية تكرر في الشهور القليلة الماضية، وأن المسؤولين الأتراك أثاروا الأمر مع نظرائهم الروس وأكدوا لهم أن الجيش التركي سيطبق قواعد الاشتباك بصرامة ضد أي طائرة تنتهك أجواء البلاد. ويؤكد المسؤولون الأتراك أيضاً أن قواتهم لم تكن تترصد الطائرة الروسية بأي حال من الأحوال، لأنهم لم يتعرفوا على هوية الطائرة قبل إسقاطها. الروس، من جهتهم، نظروا إلى إسقاط المقاتلة من طراز سوخوي س يو 24، ومقتل أحد ملاحيها، باعتبارها طعنة في الظهر من قبل تركيا. مهما كان الأمر، فقد أدى إسقاط الطائرة إلى تسميم العلاقات بين البلدين، سيما بعد أن واكبت موسكو تهديداتها لتركيا بفرض عقوبات على الواردات التركية الزراعية لروسيا وعلى شركات الإنشاءات التركية العاملة في روسيا.
ستترك هذه العقوبات أثراً سلبياً على الاقتصاد التركي، بلا شك، وإن كان محدوداً. ولكن هذا التأزم المفاجىء في علاقات البلدين، سيترك أثراً لا يقل سلبية على روسيا. تطورت هذه العلاقات بصورة كبيرة في السنوات العشر الاخيرة، تاركة خلفها عقوداً طويلة من المخاوف والشكوك المتبادلة لحقبة الحرب الباردة، سيما بعد أن نجح الطرفان في فصل العلاقات الثنائية عن مواضع الخلاف الأخرى. وقد نجم عن هذا التطور تحسن ملموس في البيئة الاستراتيجية لروسيا وفي وضعها الاقتصادي. أصبحت تركيا إحدى الأسواق الرئيسية والدائمة لموارد الطاقة الروسية، واتخذت أنقرة موقفاً متميزاً عن شركائها في الناتو من الأزمتين الجورجية والأوكرانية، ولم تتردد في تعويض الواردات الروسية من المنتجات الزراعية، التي اعتادت روسيا الحصول عليها من أوروبا، بعد أن فرضت الدول الأوروبية عقوبات ثقيلة على روسيا. اليوم، إن استمرت موسكو في سياسة التصعيد ضد تركيا، ستتبخر المكاسب الاقتصادية والجيوسياسية للتقدم الكبير في العلاقات بين البلدين، الواحدة بعد الأخرى.
المسألة الأهم في كل هذا تتعلق بما أنجزه التدخل العسكري الروسي المباشر على الأرض في سوريا ذاتها. الإجابة، في الحقيقة، ليس كثيراً. قامت الطائرات الروسية حتى الآن بآلاف الطلعات ضد مواقع المعارضة السورية في أرياف إدلب وحلب واللاذقية، كما في ريف دمشق ودرعا. داعش، وحتى جبهة النصرة، لم تتأثرا بهذا التدخل بأي صورة من الصور؛ لأن الطيران الروسي لم يستهدفها إلا بصورة هامشية. أما على صعيد القتال بين قوى المعارضة الأخرى، سواء كتائب الجيش الحر أو الجماعات المسلحة الأخرى، وقوات النظام، فالواضح أن خطوط الجبهات لم تتغير بصورة ملموسة حتى الآن، وأن ميزان القوى بين الطرفين لم يزل على ما هو عليه. هذا، بالرغم من أن الدعم الذي يقدمه الطيران الروسي جاء مصحوباً بزيادة ملموسة في تعداد القوات الإيرانية وقوات حزب الله والميليشيات الشيعية، التي تقاتل إلى جانب نظام الأسد. ثمة من يقول، مثل الرئيس السوري نفسه، أن إخفاق قوات النظام في إحداث تغيير ملموس في جبهات القتال يرجع إلى تزايد معدلات الدعم الذي تقدمه دول مثل تركيا والسعودية وقطر لقوات المعارضة. قد يكون هذا صحيحاً، بالطبع؛ ولكن صحة هذا الرأي لا يجب أن تحجب النتيجة الأكبر: أن أكثر من شهرين من القصف الروسي الكثيف لقوى المعارضة لم يغير الكثير على صعيد الصراع على سوريا.
ما يجب تذكره دائماً هو حقيقة الأهداف الروسية من التدخل في سوريا. ثمة مصالح هامة لروسيا في سوريا، بالطبع، مثل القاعدة البحرية على الساحل السوري ومراكز التصنت في جبال اللاذقية. ولكن هذه المصالح، ومهما بلغت من أهمية، لا ترقى لطبيعة الموقف الروسي من سوريا، منذ بداية الأزمة السورية، ولا لحجم التدخل العسكري الأخير. الأرجح، إذن، أن بوتين رأى في سوريا فرصة، فرصة لإعادة توكيد دور روسيا على المسرح الدولي، وللرد على زحف الناتو المستمر نحو شرق ووسط أوروبا، وعلى ما يراه بوتين تبنياً غربياً للفكرة الديمقراطية من أجل إطاحة أنظمة صديقة لروسيا، بل وزعزعة نظام الحكم الروسي ذاته. المهم، أنه مهما كانت أي من وجهتي النظر هي الصحيحة، أولوية الأهداف السورية أو الأهداف الجيوسياسية الأوسع، لا يبدو أن بوتين حقق أياً من أهدافه. لا الكثير في سوريا تغير حتى الآن، ولا يبدو أن الغرب على استعداد للحديث مع الرئيس الروسي حول أوكرانيا أو جورجيا أو أي دور روسي أكبر على الصعيد الدولي. وربما كانت دعوة الناتو المبكرة لمنتينغرو للانضمام للحلف مؤشراً آخر على طبيعة الرؤية الغربية لروسيا بوتين.
٭ كاتب وباحث عربي في التاريخ الحديث
القدس العربي
العقوبات الروسية على تركيا: الكلام عنها أسهل من تطبيقها/ عامر ذياب التميمي
منذ أسقطت تركيا مقاتلة روسية قرب الحدود السورية توالت الإجراءات الروسية للانتقام من تركيا اقتصادياً. قرر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقف الاستيراد من تركيا وطلب من السياح الروس في تركيا العودة إلى بلادهم وأمر المؤسسات السياحية بوقف الرحلات إلى تركيا. وقررت تركيا وقف استيراد الغاز المسال من روسيا. وتسارعت الإجراءات والأوامر السياسية لتعطيل علاقات اقتصادية مهمة بين البلدين شبه المتجاورين اللذين لا يفصل بينهما سوى جورجيا والبحر الأسود.
تنامت التجارة والعلاقات الاستثمارية بين تركيا وروسيا خلال العقدين الماضيين إلى درجة مهمة، كما أن تركيا استمرت بعلاقاتها الاقتصادية مع روسيا، على رغم عضويتها في حلف شمال الأطلسي الذي قررت معظم دوله، الأوروبية والأميركية الشمالية، فرض عقوبات اقتصادية على روسيا بعد ضم الأخيرة شبه جزيرة القرم الأوكرانية ودعم المتمردين الانفصاليين في أوكرانيا. ونمت علاقات تجارية واقتصادية بين البلدين خلال السنوات الماضية، خصوصاً منذ سقوط الاتحاد السوفياتي، يمكن أن يؤدي تعطيلها أو خفض مستواها إلى الإضرار بمصالح كلا الدولتين.
في 2014 بلغت قيمة الصادرات الروسية إلى تركيا 25.3 بليون دولار في حين كانت واردات روسيا من تركيا 5.3 بليون دولار. ومثلت الهيدروكربونات 16.8 بليون دولار، أي 66 في المئة من قيمة الصادرات الروسية إلى تركيا. أما الصادرات التركية فشملت الفواكه والخضار والمنسوجات والمعدات. فهل يمكن روسيا أن تقاطع استيراد الخضروات والفواكه من تركيا في وقت تعاني فيه مقاطعة الاتحاد الأوروبي؟ وهل يمكن أن تتحمل تركيا مقاطعة الغاز الروسي والمواد البترولية؟
ويزور تركيا حوالى 4.4 مليون سائح روسي سنوياً يمثلون 10 في المئة من إجمالي عدد السياح. ويقدر إنفاق هؤلاء السياح الروس في تركيا بأربعة بلايين دولار سنوياً. وثمة تساؤلات حول مدى تراجع عدد السياح الروس خلال العام المقبل، إذا التزم الروس بالمقاطعة، وكيف ستتأثر المداخيل السياحية التركية نتيجة لذلك. لكن الجانب الروسي سيتأثر أيضاً، فهناك العشرات من الوكالات السياحية التي تنظم الرحلات إلى تركيا، التي أصبحت مقصداً مهماً للروس.
ولا شك في أن العديد من مؤسسات القطاع الخاص في روسيا ستتضرر من المقاطعة بعد الجهود التي بذلت على مدى تجاوز العقدين من الزمن لتطوير هذه العلاقات الاقتصادية. ولا بد من أن يبذل رجال الأعمال في البلدين جهوداً سياسية لوقف تدهور هذه العلاقات الاقتصادية والتي لا يمكن أياً من البلدين تحمله في ظل الظروف السياسية والاقتصادية التي يمران بها.
وهناك مشاريع مهمة جرى الاتفاق عليها بين البلدين بعد التوقيع عام 2013 على عقود بناء أربعة مفاعلات لتوليد الطاقة بكلفة مقدارها 20 بليون دولار، ووفق هذا الاتفاق تقوم شركة «روساتوم» الروسية، المملوكة من الدولة، بتنفيذ هذا المشروع في تركيا. وجرى الاتفاق على تمديد أنبوب غاز يمر عبر تركيا إلى أوروبا بديلاً عن الأنبوب الذي يعبر أوكرانيا. وعندما ذكر رئيس الوزراء الروسي ديمتري مدفيديف أن هناك إمكانات لوقف العمل بالمشاريع المشتركة فإن ذلك يعني تدهوراً حقيقياً في العلاقات الاقتصادية.
في مجال الطاقة تحديداً، تستورد تركيا من روسيا 55 في المئة من احتياجاتها من الغاز و30 في المئة من احتياجاتها من النفط من روسيا. وأي تغيير في العلاقات في مجال النفط والغاز سيفرض على تركيا البحث عن بدائل قد لا تكون موثوقة أو ملائمة. لكن هل يمكن روسيا أن تجد بديلاً للصادرات من النفط والغاز عندما تتوقف هذه الصادرات إلى تركيا؟ يبدو أن هذا الجانب من العلاقات التجارية سيفرض ضغوطاً مهمة على السياسيين في البلدين لمراجعة المواقف الداعية إلى المقاطعة. صحيح أن تركيا قد تتضرر إلى حد ما من المقاطعة نظراً إلى تطور علاقاتها التجارية والاستثمارية مع روسيا، لكن روسيا ستعاني عندما تقرر وقف علاقاتها مع شريك مهم مثل تركيا.
قد يصر بوتين على فرض عقوبات اقتصادية على تركيا لكنه في ظل الأوضاع الاقتصادية وتدهور علاقاته مع الغرب ليس في موقع مريح يجعله يتمتع بقدرات واسعة للإضرار بالاقتصاد التركي. ثمة أضرار ستلحق بالعديد من المؤسسات الاقتصادية التركية في قطاعات مهمة، مثل الزراعة والصناعات التحويلية والسياحة، كما أن الأضرار التي قد تنجم عن توقف الصادرات الروسية من النفط والغاز ستكون موجعة، لكن هذه المقاطعة ستؤدي إلى أضرار ماحقة بالاقتصاد الروسي الذي لن يستطيع أن يتحمل المقاطعة مع تركيا في وقت يواجه فيه مقاطعة واسعة النطاق مع أوروبا خصوصاً والغرب عموماً.
الحياة
مقامرة بوتين الكبرى/ سامح المحاريق
أنجبت روسيا مجموعة من لاعبي الشطرنج الأسطوريين، ولكنهم كانوا كلاسيكيين للغاية، يلعبون بطريقة منظمة، ذلك ما لاحظه الأمريكي بوبي فيشر، وبكثير من الفوضى أربك خصمه السوفييتي بوريس سباسكي ليدفعه إلى حافة الجنون، وهو يهزمه المرة بعد الأخرى، من خلال مجموعة من الحركات التي لا يمكن وضعها في نسق منظم، وكانت خطة فيشر تقوم على نقل وتيرة اللعب بعد حركة غير متوقعة، ويمكن وصفها بالغباء من قبله، ولكن الغباء المصطنع أزعج سباسكي لأنه كان يخرجه من تراتبية الاستراتيجيات التي يصوغها في رأسه.
الأمريكيون استطاعوا أن يطبقوا هذه المناورات طويلاً مع السوفييت، وأوقعوهم كثيراً في أحابيل التخمين المفرط لتحركات الأمريكيين التي لم تكن أكثر من (أكشن وشغل سيما)، حرب النجوم كانت خيالاً أمريكياً جامحاً صدقه السوفييت وطاردوه متعبين لدرجة الاستنزاف، ولكن الروسي الساذج لم يعد إلا جزءاً من ذكريات الحرب الباردة، فالمتقاعدون من الأجهزة الأمنية تحولوا إلى زعامات مافياوية، والعقول العلمية في أكاديميات موسكو تخصصت في غسيل الأموال، وتحليل مزاج الأسهم والسندات، وبوتين ليس مجرد قائد سياسي، ولكنه تمثيل للروسي الجديد المختلف في عصر يراه الروس مناسباً للخروج من معاطفهم الثقيلة والتمرد على خطواتهم الحذرة.
الكاوبوي الروسي خلطة جديدة أمام الأمريكيين، فبوتين الذي أخرج قمة المناخ الأخيرة في باريس عن كل مسارها، وحولها إلى استعراض سياسي استولى على نجوميته، تلاعب بجميع الحقائق بدون أن يبدو أدنى أثر للارتباك أو التوتر الانفعالي على ملامحه، فهو يجعل سقوط الطائرة الروسية مقدمة لمرحلة جديدة من الصراع في سوريا، بحيث تصبح السنوات السابقة المثقلة بمئات آلاف الضحايا مجرد مقدمة موسيقية للسيمفونية الوحشية الجديدة، ومنحها بوتين مسحة الملحمة قبل أن يغادر إلى باريس، وهو يخلع على جثمان الطيار الذي أسقطته النيران التركية صفة بطل الحرب.
لقد تحولت الحرب في سوريا من تدخل عسكري روسي يمكن أن يجلب على بوتين الكثير من الانتقادات الداخلية، إلى حرب مقدسة يجب على الروس أن يستغلوها من أجل تأكيد هيبتهم في العالم، والخصومة مع أردوغان، وهو الشخصية الصاخبة والكاريزمية يعطيه فرصة أن يجعل الكبرياء الروسي دائماً معرضاً للخشونة التركية وأن يجعله يمسك بالمبادرة التي بدأها مع إطلاق مجموعة من العقوبات الاقتصادية الموجعة على تركيا، بالإضافة إلى تجاهله لدعوة أردوغان للقائه في باريس، وتجنبه أن يجتمعا حتى في الصورة التذكارية للقمة المناخية، ذلك كان كافياً ليستحث الإعلام الفرنسي والعالمي لمطاردة الأفكار التي تجول في خاطره ومحاولة استقراء نواياه، ولكنهم للأسف وقعوا في فخاخه التي ستجعل العالم يترقب مزيداً من المفاجآت في الأسابيع المقبلة.
يدين بوتين تركيا ويعرض لمعلوماته حول تهريب نفط «داعش» عبر أراضيها ليتم شحنه بحراً، ويجعل غاية الأتراك من إسقاط الطائرة التركية التستر على هذه الفضيحة، ومع ذلك، فهو يرى أن القرار اتخذ بمعزل عن أردوغان الذي يحتاجه بوتين من أجل استفزاز المتحمسين في الكرملين وغيره، وبحيث يعطي لنفسه صورة عقلانية كان يحرص عليها أثناء مؤتمره الصحافي، ففي النهاية يريد أن يتبع بوتين سياسة تقوم على الغموض مقابل استثارة خصومه ليجعلهم مرة أخرى في موقع الفعل، بينما يتخذ فرصته للحصول على الموقع المناسب له في تحديد نوعية ومدى وتأثير الرد الذي يحتفظ به.
يتلاعب بوتين بترتيب الأحداث، ويرقص بمهارة في المساحات الرمادية، وفوق ذلك يحاول دغدغة العواطف، مع أنه لا يمتلك عينين مؤثرتين مثل كينيدي أو كلينتون فإنه لا يتردد في مشاغلة الفرنسيين، مؤكداً أن طياريه كانوا يكتبون هذا من أجل ضحايا باريس على صواريخهم بمحاذاة ما يكتبونه عن الانتقام للطائرة الروسية التي تعرضت لإرهاب «داعش» في سيناء، وبصورة توحي بأن روسيا حسمت أمرها في موضوع الحلول مكان إيران وتركيا معاً في المسألة السورية. أما دخول روسيا مكان إيران فنقلة يمكن تفهمها على أساس التزاحم بين مصالح الطرفين، فهما يتسابقان في الاتجاه ذاته، ولكن أحداً لا يرغب في أن يعطي للآخر فرصة الوصول لخط النهاية أولاً، أما إزاحة تركيا من موقعها بدعوى عدم صلاحيتها أو أمانتها في حماية مصالح حلفائها، فذلك يعني أنه يعلن نفسه الشهبندر للبازار السياسي الذي شهدته باريس، وأن على من يريد تحقيق مصالحه أو حمايتها أو ضمانها أن يخاطبه أولاً، وأن يؤدي له الثمن الذي يرتضيه، فهو ليس معنياً بالمستقبل الشخصي للأسد، ولا حتى بالبقاء على مقربة من مياه المتوسط، فروسيا تمتلك قوات بحرية يمكن أن تحمل مدناً بأكملها، والإبقاء على قاعدة عسكرية على الساحل السوري لا يستدعي كل هذه التضحيات والتكاليف في مرحلة هبوط أسعار النفط والمتاعب الاقتصادية الروسية المتعددة.
يتطلع بوتين للاستحواذ على صفقة ثمينة بعد أن أرهقت جميع الدول التي تتجاذبها، يقتنصها لنفسه ويعيد إنتاجها وفق شروطه الخاصة، ولذلك، فإنه لم يغلق الباب في وجه السعوديين الذين تحصلوا على صفقات عسكرية ليسوا في حاجتها على المستويين الميداني والاستراتيجي، وفوق ذلك، وجدوا الفرصة في ظل علاقات مشتعلة نظرياً بين لافروف والجبير، لأن يعقدوا واحدة من أكبر الصفقات الاستثمارية مع الروس، وبالمناسبة، فالسعوديون لن يذهبوا إلى موسكو بأموالهم هذه المرة، ولكنهم سيستقبلون إسهاماً روسياً في الاستثمارات النوعية في السعودية، وبما يعني اقتحاماً غير مسبوق لما اعتبر دائماً امتيازاً أمريكياً خالصاً، مع بعض العطايا الأمريكية للحلفاء في أوروبا الغربية.
تركيا اليوم مضطرة لترتيب أوراقها من جديد، فالطائرة التي أسقطتها ستكون الذريعة لروسيا لمزيد من التدابير للسيطرة على الشريط الحدودي مع تركيا، وكان ذلك ليلاقي معارضة شرسة بدون حادثة الطائرة، واليوم، فإن روسيا ستمتلك القدرة على إعادة ترسيم الوقائع في المنطقة، وربما التلويح بورقة كردية في مواجهة تركيا وزيادة معاناة تركيا التي ستجد نفسها مضطرة للتعامل مع تركة «داعش» بصورة منفردة، فبعد أن بدا «داعش، ولو لوهلة، أمراً واقعاً يمكن أن يعتبر بصورة أو بأخرى طرفاً في تفاوض حول مستقبل سوريا، أصبح مؤخراً إصبع إتهام يوجهه الجميع إلى الجميع.
موسكو تمكنت من اختطاف الأضواء في الأسابيع الأخيرة، بحيث فقدت واشنطن موقعها محجاً سياسياً للعالم، والرئيس الأمريكي يرتحل اليوم ليعقد لقاءات مع بوتين وغيره، فالواقع أن أوباما ليس لديه ما يقدمه ولياقته السياسية والفكرية أيضاً في أدنى مستوياتها، ومن يدخل البيت الأبيض ولديه مجموعة من الأسئلة، فإنه يخرج بدون إجابات وبأسئلة جديدة تزيده حيرة واضطراباً، ومع أن موسكو لا تملك هي الأخرى أي إجابات، وتطرح أسئلتها الخاصة، إلا أنها في النهاية تستطيع أن تحرك الواقع بما يعطيها صورة صاحب الخطة على الأقل، والمستبقي بين يديه على قليل من الحيلة وبصيص من الرؤية.
تختلف عصبية رقعة الشطرنج عن عبثية طاولة الروليت، ولكن الحظ له أهمية قصوى في اللعبتين، وبوتين رجل لا ينقصه الحظ، فصواريخه التي تحمل رسائل الانتقام لضحايا باريس وتضع هيبة فرنسا على أجنحة السوخروي، تتعزز سياسياً بتردد بريطاني عن تقديم الدعم الملموس والميداني للفرنسيين، وكأن باريس هي الأخرى ستجد نفسها في حلف يتشكل من المشتتين والتائهين حول رجل يعطي مظهره قدراً من الثقة والإصرار، وهذه أيضاً سمات تعطي أثرها بين مربعات الشطرنج وخانات الروليت على السواء.
٭ كاتب أردني
القدس العربي
لماذا يعد بوتين حليفا سيئا؟/ بول رودريك جريجوري
رحب البعض بتدخل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في النزاع السوري باعتباره فرصة للكرملين “للخروج من العزلة”، ويقال إن نزاع روسيا مع تنظيم الدولة الإسلامية قد وحد مصالحها مع مصالح الغرب.
وبالفعل، حث الرئيس الأميركي باراك أوباما مؤخرا في مؤتمر صحفي بوتين مرة ثانية على الانضمام إلى تحالف مناهض لتنظيم الدولة، ووصف الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند زيارته الأخيرة لموسكو بالجهد الرامي لبناء تحالف دولي واسع ضد هذه الجماعة الإرهابية.
للوهلة الأولى، تبدو فكرة أن روسيا حليف طبيعي ضد الإرهابيين الإسلاميين منطقية، فقد عانت البلاد من هجمات إرهابية مروعة على يد المتطرفين الإسلاميين، بما في ذلك تفجير طائرتها في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي فوق شبه جزيرة سيناء والذي راح ضحيته 224 من المسافرين وطاقم الطائرة، وجميعهم تقريبا من الروس.
ويعيش في الاتحاد الروسي قرابة عشرين مليون مسلم، معظمهم من السنة، وأفاد مسؤولو الأمن في البلاد بأن حوالي سبعة آلاف مقاتل من الجمهوريات السوفياتية السابقة وروسيا قد التحقوا بتنظيم الدولة.
ومع ذلك -وباستقراء أعمق للأمور- يبدو واضحا أن تحالفا ضد الإرهاب مع روسيا ليس إلا تفكيرا مثاليا قائما على التمني، إذ إن بوتين لم يذهب إلى سوريا لهزيمة تنظيم الدولة، وإنما تدخل لإنقاذ نظام الرئيس السوري بشار الأسد العميل لروسيا، وقد يتصرف بوتين أحيانا على نحو يعطي انطباعا بأنه مستعد للتخلي عن الأسد، ولكنه في نهاية المطاف سيدافع عنه، فترك الأسد يواجه مصيره قد يبدو علامة ضعف، وبالتالي يعد في نظر بوتين أمر بغيضا.
وقد يكون الروس العاديون في مرمى خطر هجمات المتطرفين الإسلاميين، ولكنهم لا يمثلون خطرا يذكر بالنسبة لبوتين أو حلفائه.
لقد عانت روسيا بالفعل من عدد من الهجمات الإرهابية، بما في ذلك مجزرة بيسلان عام 2004 التي راح ضحيتها 334 شخصا، معظمهم من تلاميذ المدارس.
وفي كل حالة من هذه الحالات كان رد الفعل على الهجمات وحشيا يتسم بالقوة المفرطة وباهظ التكلفة في ما يتعلق بالخسائر في أرواح المدنيين، وعلى الرغم من ذلك كان نظام بوتين يخرج سالما في كل مرة.
صحيح أن الهجمات الإرهابية في مطلع القرن قد أفضت إلى توحيد الرأي العام ضد المتمردين الشيشان وأمدت بوتين بالدعم العام الذي كان بحاجة إليه لتدمير غروزني عاصمة الشيشان عن بكرة أبيها.
وتعكس الثقة التي يبديها بوتين في تعامله مع الإرهاب طبيعة جهاز أمن الدولة الروسي، إذ تنفق روسيا على الأمن الداخلي أكثر مما تنفق على الدفاع الوطني، فلديها قوات وزارة الداخلية ولديها القوات الخاصة بوكالة الأمن الاتحادية والقوات الخاصة للخدمة المتنقلة وقوات الاستخبارات العسكرية، فضلا عن شبكة واسعة من الجواسيس والمخبرين المحليين.
وليس مسموحا في روسيا لمعارضي النظام الترشح لمنصب الرئيس، فضلا عن تقييد حقهم في التظاهر وتعرضهم للتعسف القانوني في المحاكم، ولا يتمتع المواطنون عمليا بحق حمايتهم من التصنت على مكالماتهم الهاتفية أو اعتراض اتصالاتهم الإلكترونية.
ينبغي لكل مجتمع أن يعمل على إيجاد التوازن اللازم بين الحقوق المدنية والأمن القومي، وبينما انزلقت روسيا التي يحكمها بوتين إلى طرف واحد من أطراف الطيف اختارت الولايات المتحدة وأوروبا -على الرغم من احتجاجات المدافعين عن الحقوق المدنية- أن تحتل الطرف الآخر. حقا، إن روسيا نموذج لأقصى الحدود لما يمكن لقوة الدولة القيام به للسيطرة على النشاط الإرهابي.
ومن النادر وجود جماعة إرهابية غير مخترقة من جانب مخبر يقدم تقارير عنها إلى موسكو، بل إن هناك دليلا على اختراق المخابرات الروسية المجموعة التي نفذت مذبحة بيسلان، فضلا عن أن أي مجموعة إرهابية تعلم أن عملياتها ستواجه بأقصى درجة من درجات استخدام القوة، ففي بيسلان -على سبيل المثال- استخدمت القوات الخاصة الروسية أسلحة الباريوم الحرارية.
وكما تشير ردود الفعل على هجمات باريس كان للقتل الذي يبدو عشوائيا لـ130 مدنيا صدى هائل في الغرب، خاصة مع صعوبة فهم الدوافع الدينية والأيديولوجية لذلك، بيد أن الكرملين لا يعبأ كثيرا بقيمة حياة الإنسان مثلما تفعل المجتمعات الغربية.
ووفقا لتفكير بوتين، تعد الخسائر في الأرواح أثناء هجمات المتطرفين أمرا غير مرغوب فيه، ولكنه في نهاية المطاف مقبول طالما لا يهدد النظام.
وقد يكون الشعب الروسي مروعا ومذعورا إلا أن النظام الروسي مهموم في المقام الأول ببقائه هو وبالكيفية التي يمكن بها استغلال رعب الناس لصالحه، والعمل مع الغرب لمحاربة تنظيم الدولة لا يخدم أيا من هذين الغرضين.
الجزيرة نت
بوتين وطهران والأزمة السورية/ د. يوسف مكي
في المقال السابق، الذي حمل عنوان «حول أسباب التدخل الروسي في سوريا»، ناقشنا عدة أمور، تناولت موقع روسيا حالياً في الخريطة الدولية، وأهمية استمرار سوريا، ضمن مناطق مصالحها الحيوية. أشرنا إلى أن روسيا بوتين، دعمت بقاء الدولة السورية، وحالت دون انهيارها، من خلال دعمها المستمر للقوات السورية. لكنها حين راقبت تغير موازين القوة على الساحة السورية، لغير صالح الجيش السوري، تدخلت بشكل مباشر، لدعم صموده.
واقع الحال، أن الأسابيع الماضية، شهدت انتقالاً جذرياً في السياسة الروسية، ليس فقط بالتدخل العسكري المباشر، داخل سوريا ولكن أيضاً بمحاولة فرض رؤيتها السياسية للحل، على المستويين الإقليمي والدولي، وقد حمل هذا الأسبوع، إشارات مهمة لتبدل جذري في الموقفين، الأمريكي والفرنسي، لصالح القبول بالرؤية الروسية للحل.
فوزير الخارجية الأمريكي، جون كيري، أعلن صراحة، أن بلاده لا تشترط تنحي الرئيس السوري، في التسوية السياسية، وأنها لا تمانع من استمراره في سدة الرئاسة، خلال المرحلة الانتقالية. وبالمثل صرح الرئيس الفرنسي، بما يقترب من هذه الصياغة.
لذا، فإن تمدد إرهاب «داعش»، على المستوى الدولي، قد أقنع صنّاع القرار الأممي الكبار، بأن الأهمية الآن، هي للقضاء على «داعش». سادت قناعة لدى معظم الدول أن الحرب على «داعش» لن تكون ممكنة من غير مشاركة الجيش السوري. وهكذا وجد الغرماء الكبار أنفسهم، يقفون في خندق واحد، ويتنازلون لصالح الموقف الروسي.
بالنسبة لنا، لا يمكن أن نختزل الموقف الروسي، بالرغبة في القضاء على الإرهاب فقط، وإن كان ذلك على رأس أجندات قيادة بوتين. فالأمر بالنسبة لهذه القيادة هو أعمق وأبعد بكثير من محاربة «داعش». فبالإضافة إلى ما أشرنا له في السابق، من أهمية سوريا بالنسبة للمصالح الجيوسياسية الروسية، فإن التدخل الروسي، مثل عودة الدب القطبي مجدداً للساحة الدولية، كلاعب رئيسي. ومن جهة أخرى، مثل نهاية لحقبة الأحادية القطبية.
لكن ذلك ليس نهاية المطاف بالنسبة لإدارة بوتين. فقد رصدت اتفاق الأمريكيين مع طهران حول الملف النووي. وطبيعي أن يكون لذلك امتدادات سياسية واقتصادية. فمنذ الآن أمست طهران محجاً للشركات الأوروبية والأمريكية، التي تهافتت بقوة، للحصول على حصتها في عملية بناء إيران، ما بعد رفع العقوبات، على كل الصعد.
وبالنسبة لروسيا، فإن ذلك يعني عودة هيمنة أمريكا على القوس الممتد من باكستان وأفغانستان، والذي لا يستبعد الروس، إذ ستلتحق به طهران مستقبلاً. وسيضم العراق، الحليف لطهران وواشنطن، وإذا ما فرضت إيران، بحكم الأمر الواقع سيطرتها على سوريا، فإن هذا القوس سيمتد من أفغانستان إلى حوض البحر الأبيض المتوسط وذلك ما لن تقبل به روسيا.
إن تدخل روسيا في سوريا، يقطع اتصال هذا القوس بحوض البحر الأبيض من جهة، ويتيح لها من جهة أخرى، فرصاً جديدة للتدخل في العراق، تحت شعار مكافحة «داعش» والمنظمات الإرهابية الأخرى الذي كان لعدة عقود، ومنذ عام 1958، إثر الثورة التي نقلت العراق إلى النظام الجمهوري، ضمن المناطق الحيوية للاتحاد السوفييتي السابق. وهو ما أعلنت روسيا رسمياً سعيها لتحقيقه.
وربما يجادل البعض، في أن علاقة موسكو بطهران الآن هي علاقة تحالف. وذلك أمر لا جدال فيه، لكن هذا القول يغفل جملة من الحقائق، أهمها أن موسكو تميز بين إيران كحليف لها، في حدود سيادتها على أراضيها، وإيران كقوة إقليمية، تسعى للتوسع على حساب، ما تعتبره مناطق نفوذها التاريخي.
من جهة أخرى، فإنها لا تملك ضمانة من التحول في سياسات إيران، لصالح توسيع علاقاتها بغرماء روسيا في الغرب، خاصة مع انتهاء أزمة الملف النووي الإيراني، ورفع العقوبات الاقتصادية الدولية عن طهران.
هناك توقعات من قبل كثير من الخبراء الاقتصاديين، بأن الأيام القادمة ستشهد انتعاشاً، لأسواق البازار في إيران، وانتقالاً لشرائح كبيرة، من المحسوبين على قم لهذه الأسواق. وسوف يؤدي ذلك من دون شك، لتوسع دائرة التيار الإصلاحي في طهران، وتراجع قوة المرشد الأعلى، في صنع القرارات المتعلقة بمستقبل إيران.
ولعل الوعي بهذه الحقائق، هو الذي يفسر موقف قيادة بوتين، من الأزمة اليمنية، بخلاف توقعات كثير من المحللين. فقد أعطت روسيا بامتناعها عن اتخاذ النقض في مجلس الأمن الدولي، بحق القرار الأممي الذي طالب بنزع أسلحة الحوثيين ضوءاً أخضر لتأييد التحالف العربي، ضدهم. ومن الصعوبة فهم الموقف الروسي، إلا حين نضعه في إطار خشية موسكو، من التوسع الإيراني في المنطقة.
وهناك ملاحظة أخرى، هي أنه رغم التحالف المعلن بين موسكو وطهران في الموقف من الأزمة السورية، لكن موسكو، على نقيض الموقف الإيراني، لا ترغب في تهميش المعارضة السورية، المعبر عنها بالمعتدلة. في حين ترى طهران، أن غياب المصالحة الوطنية، سيتيح لها إبقاء سوريا ضمن نفوذها. أما موسكو فتعمل على توسيع دائرة تحالفاتها مع القيادة السورية والمعارضة، على السواء. وترى في الانتقال السياسي في سوريا، نحو نظام ديمقراطي، فسحة أكبر لها لمحاصرة طهران.
ومن الواضح، أن روسيا جادة في التعاون مع الائتلاف السوري، ومنحه دوراً كبيراً في صناعة مستقبل سوريا. لكنها من جهة أخرى، تعمل على إبقاء الرئيس الأسد في واجهة الحكم. إن ذلك سيمنحها دور الوسيط والحكم، حتى فيما بعد تحقيق المصالحة. فروسيا ما بعد المصالحة، وفقاً لتصورات بوتين ستحظى بثقة الجميع.
بل إن روسيا تسعى بجد، إلى أن تكون جسورها مفتوحة وقوية مع الجيش الحر، الذي ستعمل على إدماجه مستقبلاً بالجيش السوري، بما ينسجم مع الأهداف التي أشرنا لها. وقد قطعت الدبلوماسية الروسية شوطاً كبيراً، في هذا السياق، ينتظر أن تجري ترجمته إلى خطوات في الأيام القادمة.
الخليج
المياه الدافئة وراء الصراع بين موسكو وأنقرة/ فهمى هويدى
بعض التاريخ يمكّننا من الإحاطة بخلفيات وسيناريوهات الصراع بين موسكو وأنقرة، وقد يساعدنا على أن نحدد رؤيتنا الاستراتيجية بناء على ذلك.
(1)
قصة جمهورية «مهاباد» تشكل مفتاحاً مهماً لفهم ما جرى وما يمكن أن يشهده الصراع بين موسكو وأنقرة، إذا قُدّر له أن يستمر ويتصاعد. و «مهاباد» هي مدينة واسم منطقة في شمال إيران، تسكنها غالبية كردية، وقد أصبحت جمهورية قصيرة العمر تشكلت في أعقاب الحرب العالمية الثانية، بعدما دخل الحلفاء إلى إيران وسيطر السوفيات على أجزاء من شمال البلاد. وفي ظل وجود القوات السوفياتية قامت كيانات مستقلة موالية لهم فيها، كانت أذربيجان واحدة منها، وكانت الثانية هي جمهورية «مهاباد الديموقراطية الشعبية» التي تأسست العام 1946 وترأسها قاضي محمد، مؤيداً من قبل «الحزب الديموقراطي الكردستاني». إلا أن الضغوط الغربية القوية على الاتحاد السوفياتي والشكوى التي قدمتها طهران أمام الأمم المتحدة واتهمت فيها السوفيات بعدم الانسحاب من أراضيها، اضطُرت موسكو إلى التخلي عن «مهاباد» بعد 11 شهرا من تأسيس جمهوريتها. وبانسحاب السوفيات وجهت إيران حملة عسكرية لاستعادة السيطرة على المناطق الكردية، وحين وصلت تلك الحملة إلى العاصمة «مهاباد»، فإنها ألقت القبض على رئيسها قاضي محمد وشقيقه ونفذت فيهما حكم الإعدام. إلا أن فريقاً من الأكراد ظل يقاتل القوات الإيرانية تحت قيادة رئيس الأركان في حكومة «مهاباد» مصطفى البرزاني (والد رئيس إقليم كردستان العراقي الحالي مسعود برزاني) إلا أنه هزم في المقاومة فلجأ إلى الأراضي السوفياتية، حيث بقي هناك حتى العام 1958، عاد بعدها إلى العراق.
هذه الخلفية تسلط الضوء على ثلاثة معالم في سياسة موسكو الخارجية. الأول والأهم يتمثل في التوجه نحو الجنوب في محاولة التوسع والتمدد. الأمر الثاني يتعلق باستثمار ظروف المناطق الرخوة التي لا تواجه فيها تحديات تكبح جماحها. الأمر الثالث يتمثل في العلاقة الخاصة والتاريخية التي أقاموها مع الأكراد واستثمرتها موسكو في تنفيذ مخططاتها.
(2)
اتجاه موسكو إلى الجنوب سابق على إقامة الاتحاد السوفياتي وظروف ما بعد الحرب العالمية الثانية. ذلك ان لهذه الاستراتيجية جذورا تمتد إلى القرنين الثامن عشر والتاسع عشر، أي في مرحلة روسيا القيصرية التي تمددت في آسيا الوسطى ومنطقة القوقاز، التي اعتبرتها حديقتها الخلفية المؤدية إلى الجنوب. ذلك أن أبصارها ظلت معلّقة طول الوقت بالمياه الدافئة في الجنوب التي كان البحر الأبيض المتوسط رمزا لها. في تلك المرحلة المبكرة، لم يكن السبيل إلى عالم المياه الدافئة سهلا بسبب وجود دولتين كبيرتين تعترضان ذلك الطريق، هما الامبراطورية الفارسية والامبراطورية العثمانية. ولذلك تعددت الحروب بين روسيا القيصرية وهاتين الامبراطوريتين خلال القرن التاسع عشر بوجه أخص. فقد اشتبكت مع الدولة الفارسية خلال السنوات 1804 و1813 و1826، ودخلت في حرب ضد العثمانيين في الأعوام 1828 و1829 و1853.
وإذ ظل التمدد والتوسع باتجاه المياه الدافئة عنصراً حاكماً في السياسة الروسية طوال الوقت، إلا أن الكنيسة الأرثوذكسية كان لها دورها المساند لتلك السياسة خصوصا في عهد الامبراطور نقولا الأول (العام 1853). إذ استخدم نفوذ الكنيسة في التحرش بالدولة العثمانية، فطلب من السلطان العثماني عبدالمجيد تنحية الكاثوليك وإحلال الأرثوذكس محلهم في القرارات المتعلقة بالأماكن المقدسة، بحيث يكون للأخيرين دون غيرهم حرية التصرف في مفتاح كنيسة المهد ببيت لحم. وفي طور لاحق طلب القيصر الروسي وضع جميع الرعايا الأرثوذكس في الدولة العثمانية (نحو عشرة ملايين شخص) تحت حماية روسيا وكنيستها الأرثوذكسية. وحين رفض السلطان العثماني الطلب، كان ذلك من بين الأسباب التي دفعت الروس إلى اجتياح البلقان في منتصف القرن التاسع عشر.
يُذكر في هذا الصدد أن القيصر نيقولا الأول الذي حكم روسيا بين عامي 1825 و1855م كان له النصيب الأوفر من بين القياصرة الذين أعلنوا الحرب على الدولة العثمانية. ومشهودة حروبه التي شنها بين عامي 1828 و1826 إضافة إلى حرب القرم بين عامي 1853 و1856. وفي الحالتين تدخلت الدول الغربية إلى جانب الأتراك لمنع روسيا من إنزال الهزيمة بالدولة العثمانية وعدم السماح لها بالوصول إلى البحر المتوسط. وفي الوقت ذاته، فإن روسيا ظلت آنذاك تساند حركات التمرد ودعوات الاستقلال الوطني في البلقان لإضعاف نفوذ الدولة العثمانية.
(3)
في الوقت الراهن، صار حلم القياصرة في الوصول إلى المياه الدافئة أقرب إلى التحقيق. إذ شاءت المقادير أن يتولى القيادة في موسكو زعيم أراد أن يعيد إلى روسيا هيبتها التي فقدتها بعد الذي أصابها جراء انهيار الاتحاد السوفياتي في بداية تسعينيات القرن الماضي. وتزامن ذلك مع اجتماع عوامل أخرى أعطت انطباعاً بأن الطريق إلى المياه الدافئة بات مفتوحا وممهداً. فإيران الجارة الكبرى تم تحييدها وعلى تفاهم وتوافق مع موسكو. والعالم العربي شُوِّه وعيه وانفرط عقده بحيث تحولت الأمة إلى شراذم متفرقة لم تعد تستهجن التدخل الأجنبي بقواعده وجيوشه وإنما صارت تشتهيه. ثم إن روسيا مطلوبة ومرغوبة من جانب النظام السوري، وثمة تفاهم ومصالح مشتركة بين القاهرة وموسكو. ليس ذلك فحسب، وإنما صارت مصر مشتبكة وعلى خصام مع تركيا، وهي التي وقفت إلى جانب السلطنة العثمانية ضد الروس أثناء حرب القرم في منتصف القرن التاسع عشر. ولا يقل أهمية عن كل ما سبق أن الولايات المتحدة لم تعد مشغولة كثيرا بما يحدث في المنطقة، بعدما حصرت اهتمامها وركزته على مواجهة تطلعات الصين. أما أوروبا التي كانت تقف بالمرصاد لتطلعات القياصرة الروس، فإنها أصبحت مشغولة بحسابات القارة واستقرارها، لدرجة أنها لم تفعل شيئا يُذكر لاحتلال روسيا لشبه جزيرة القرم في جنوب أوكرانيا.
روسيا الآن لم تعد فقط تتطلع إلى المياه الدافئة، وإنما أصبحت تتمدد على شواطئها في سوريا، ولم تكتفِ بتكثيف وجودها العسكري على الأرض والجو، وإنما عمدت إلى إقامة القواعد في طرطوس واللاذقية، وثمة حديث عن تجهيزها لقاعدة ثالثة قرب حمص. ليس ذلك فحسب، وإنما لم تجد القيادة الروسية غضاضة في أن تتعامل مع الشعب السوري بمثل ما تعامل به يلتسين مع الشيشانيين العام 1994، حين استخدم جيشه وطائراته لتدمير العاصمة غروزني وتسوية مبانيها بالأرض بعد إخلائها من السكان، وكان ذلك متماهيا تماما مع أداء النظام السوري.
في هذه الأجواء أسقطت تركيا الطائرة الروسية من طراز «سوخوي» التي اخترقت أجواءها، واعتبر الرئيس الروسي ذلك «خيانة» و «طعنة في الظهر» جرحت كبرياءه وبسببها أعلن أن بلاده مستعدة للرد والردع، ولن تمرر الإهانة بغير حساب عسير، وهو ما استدعى أسئلة عديدة حول طبيعة الرد وحدوده وما تملكه موسكو من أوراق وأرصدة تعينها على تلك المواجهة.
(4)
حتى الآن ثمة توافق على أمرين في الصراع الحاصل بين موسكو وأنقرة، الأول أن المواجهة العسكرية مستبعدة، خصوصا أن تركيا عضو في حلف «الناتو» الذي تشترك فيه الولايات المتحدة مع الدول الأوروبية، الأمر الذي يحول المواجهة العسكرية إلى مغامرة كبرى وحرب عالمية تحرص كل الأطراف على تجنبها. والأمر الثاني أن الرد الروسي سيكون في حدود العلاقات والإجراءات الاقتصادية التي يمكن أن تضر بالاقتصاد التركي سواء في إمدادات الغاز أو السياحة أو التبادل التجاري والمشروعات المشتركة، التي قد يكون لها تأثيرها أيضا على الاقتصاد الروسي. وليست معلومة حدود التصعيد الحاصل بين البلدين، لأن بيد روسيا ورقتَين خطيرتين يمكن استخدامهما في إزعاج تركيا إلى حد كبير. أتحدث عن ورقتَي الأكراد والعلويين الذين يمثلون ما بين 30 و35 في المئة من الشعب التركي. وبرغم أنه ليس هناك إحصاء دقيق للاثنين، فإن عددهم لا يقل عن 25 مليون نسمة، وهو رقم قابل للزيادة. ذلك أن علاقة الأكراد بالسوفيات والروس قديمة ووثيقة كما سبقت الإشارة. وتجربة جمهورية «مهاباد» التي أقاموها في إيران حاضرة لا تزال في الذاكرة. وإذا وضعنا في الاعتبار تدهور العلاقة في الوقت الراهن بين الحكومة التركية و «حزب العمال الكردستاني»، فإن ذلك قد يغري الروس بمحاولة توظيف الورقة الكردية في الضغط على أنقرة، برغم أن مسعود البرزاني رئيس كردستان العراقي يحتفظ بعلاقات إيجابية طيبة مع الأتراك، الأمر الذي قد يشكل عقبة في طريق ذلك المسعى إذا أرادت روسيا اللجوء إليه. ولا ينسى في هذا الصدد أن ثمة أكرادا في إيران المهادنة أو الحليفة، وحساسيتها إزاء الملف تشكل عقبة أخرى. علما بأني لا أعرف إلى أي مدى يثق الأكراد في موسكو التي ساعدتهم كثيرا في السابق، لكنها تخلت عنهم بسرعة حين أدركت أن لها مصلحة في ذلك. وهو ما حدث في تخلى الروس عن حكومة «مهاباد» في إيران، وحين تحالفت موسكو مع مصطفى كمال أتاتورك في عشرينيات القرن الماضي، فانفرد الرجل بهم حتى كان حكمه من أشد المراحل دموية في تاريخهم.
ورقة العلويين، وتحريضهم على التمرد في تركيا يمكن أن يتكفل بها النظام السوري الذي لم يقصر في محاولة استمالتهم وتحريضهم طول الوقت في صراعه مع النظام التركي. وفى ظل التحالف القائم بين دمشق وموسكو فليس مستبعدا أن يتوافق الطرفان على استثمار الورقة العلوية في إثارة القلاقل والاضطرابات في داخل تركيا.
هذا الخيار لا يخلو من مغامرة، لأن استخدام الروس لورقة الأقليات في الضغوط على تركيا قد يدفع أنقرة إلى الرد بتشجيع المسلمين السنة داخل الاتحاد الروسي بدورهم على التمرد وإزعاج حكومة موسكو، وقد ذكرت من قبل أن هؤلاء عددهم نحو 20 مليونا، كما أن بعضهم مستنفر وجاهز للتمرد على الحكم الروسي، خصوصا في الشيشان وأنغوشيا وداغستان، كما أشرت إلى تقديرات أعداد شبابهم الذين التحقوا بجماعة «داعش» في سوريا والعراق، التي تراوحت بين 4 و7 آلاف مقاتل.
إننا مقبلون على مرحلة مفتوحة على احتمالات وخيارات عدة، تتراوح بين السيئ والأسوأ (الأفضل ليس واردا)، ويهمنا في المشهد أمران، أولهما أن نتعرف على خلفياته وأبعاده، وثانيهما أن نحدد رؤيتنا الاستراتيجية بناء على ذلك. هذا إذا أردنا أن نحكم العقل والمصالح العليا، وليس الانفعالات والحسابات المرحلية والطارئة.
السفير
لكن كيف «تندم» تركيا على فعلتها؟/ محمد مشموشي
لا يعادل ما وصف بـ «الجنون الروسي» عقب إسقاط طائرة «سوخوي 24» من قبل المقاتلات التركية، سوى قول رئيس النظام السوري بشار الأسد لمستشار المرشد الإيراني علي أكبر ولايتي قبل أيام أن «الإنجازات» التي حققتها قواته على الأرض خلال الفترة الماضية دفعت «الدول المعادية» إلى تزويد المعارضة بأسلحة نوعية لم تكن تملكها من قبل. فكلاهما، أي «الجنون الروسي» وشكوى الأسد من «الأعداء»، دليل أكثر من كاف على أن ما تم في سورية منذ بدء الغارات الروسية قبل شهرين لم يحدث أي تغيير في ميزان القوى، ولا في استعادة أي من الأراضي التي فقدها النظام من جهة، وعلى أن ما يفكر فيه الطرفان للفترة المقبلة هو المزيد من التصعيد في الجو وعلى الأرض من جهة ثانية.
للتذكير فقط: اتخذ قرار التدخل الجوي الروسي (ومعه البري الإيراني) بعد كلام مماثل للأسد في آب (أغسطس) الماضي، تحدث فيه عن نقص في عديد قواته المقاتلة بسبب التهرب من الجندية، وعن انسحابها من بعض المناطق وإعادة تموضعها في ما سماه يومها «سورية المفيدة».
ولم يعد سراً أنه بعد ذلك قام قائد «فيلق القدس» الجنرال قاسم سليماني بزيارتين لموسكو تم فيهما التنسيق بين البلدين حول طريقة إنقاذ الأسد: قصف روسي من الجو، وتقدم بري إيراني على الأرض بالتعاون مع ميليشيات «حزب الله» اللبناني و «عصائب أهل الحق» العراقية والبقية الباقية من قوات النظام.
ولعله من هنا بالذات استهدفت الغارات الروسية، كما الهجمات البرية الإيرانية/ الميليشياوية/ السورية، قوات «الجيش السوري الحر» أكثر من أية قوات معارضة أخرى للنظام، بما فيها تنظيم «داعش» الذي يقال أنه الهدف الأول للتدخل الروسي. لكن المحصلة مع ذلك، وبعد نيف وشهرين من القصف من الجو ومحاولات التقدم في البر، لم تكن إلا ما بات معلوماً لدى الجميع أن في الداخل السوري أو في الخارج الدولي والإقليمي… وهو بقاء النظام السوري المهتزّ على حاله.
وحاله هذه لا تعني أن النظام سيسقط غداً، لكنها لا تعني في الوقت ذاته أن الحملة الروسية/ الإيرانية المشتركة نجحت في ضمان عدم سقوطه بعد غد على سبيل المثال.
في كلام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، غداة العملية، أنه وضع لها سقفاً زمنياً ينتهي مطلع العام المقبل، لكنه يبدو مؤكداً الآن، أقله من لهجته التصعيدية وإجراءاته الانتقامية تجاه تركيا (وقبلها تجاه مصر بعد تفجير الطائرة المدنية الروسية في سيناء) أن هذا السقف اختلف في صورة جذرية. وليس مبالغاً به القول إن بوتين يتجه إلى المزيد من التورط في المستنقع السوري.
ذلك أن بوتين لم يخف للحظة واحدة، لا بالقول ولا بالتدابـير التي اتخذها ضد مصر أولاً والآن ضد تركيا، أن كبرياءه الشخصي والقومي هو الذي أصيب في الحادثين. ولأن حركته باتجاه سورية، بعد عمليتيه في أوكرانيا وشبه جزيرة القرم، تمت تحت شعارات أقلها استعادة دور الاتحاد السوفياتي كقوة عظمى في العالم، وفي المنطقة تحديداً، يصبح مفهوماً إحساسه بالإصابة وبعمق الجرح الذي سببته.
وإذا كان من غير المفهوم معنى قوله المتكرر أن «تركيا ستندم على فعلتها»، وأن رده عليها لن يقف عند الإجراءات الاقتصادية، فمن المستبعد بدوره توقع أن يخاطر باللعب على شفير حرب فعلية مع تركيا، وتالياً مع الحلف الأطلسي، بنتيجة قراره التدخل في سورية.
ولا يتعلق الأمر بموازين القوى في العالم فقط، وبكون روسيا لم تخرج بعد من فترة النقاهة عقب سقوط الاتحاد السوفياتي وحلف وارسو، إنما أيضاً وقبل ذلك لأن بوتين يعرف أكثر من غيره أن لا اعتراض غربياً، ولا أميركياً تحديداً، على أن يكون لموسكو نفوذ ودور ما في سورية حيث قاعدتها البحرية القديمة في طرطوس، ولو أنها على الحدود المباشرة مع الحلف الأطلسي في تركيا.
إذاً، ماذا يمكن أن يكون فحوى التهديدات الروسية المتكررة لتركيا؟
غالب الظن، أن بوتين سيزيد تورطه العسكري (الجوي والصاروخي) في سورية، لا لشيء إلا للحيلولة في شكل كامل ونهائي دون تحقيق حلم تركيا بإقامة منطقة آمنة على حدودها مع سورية، بخاصة أنها أعطت وعداً للاتحاد الأوروبي بوقف نزوح السوريين إلى دوله، ونالت في المقابل موافقة أوروبية على إنشاء هذه المنطقة مضافاً إليه ثلاثة بلايين يورو لمساعدة هؤلاء النازحين. وفي موازاة ذلك، إذا لم يكن من شأن زيادة التورط هذه أن تعيد توازن القوى بين الأسد والمعارضة، كما بدا جلياً حتى الآن، فإنها تمنع سقوطه السريع من ناحية وتنفع في المفاوضات من أجل التسوية السياسية (في فيينا أو نيويورك كما قيل أخيراً) من ناحية ثانية.
لكن الأهم من ذلك، كما يعتقد البعض، أن تمد موسكو يدها بالعون العسكري (سلاحاً وتدريباً وذخيرة) إلى الأكراد المتحصنين في منطقتهم في سورية، والذين تحاربهم تركيا بدعوى أنهم ينتمون إلى «حزب العمال الكردستاني» التركي وأنهم يسعون لإقامة دولة لهم على حدودها.
بل أكثر، كما يقال، بمد اليد حتى إلى داخل تركيا نفسها، حيث من جهةٍ الطائفة العلوية وما لها من علاقــات سرية قديمة مع النظام العلوي في سورية، وحيــث من جهة أخـرى عـدد من الأحزاب اليسارية التي خاضت ولا تزال صراعاً سياسياً مريراً مع «حزب العدالة والتنمية»، كما بعض الأحزاب القومية والعلمانية فضلاً عن الأتاتوركيين الذين يخوضون معه حرب وجود.
لكن السؤال هنا لا يعود روسياً، إنما تركي أولاً وأخيراً وهو: ماذا يكون رد أنقرة في هذه الحال؟ وهل يبقى الرد في حدوده التركية، أم يصبح أطلسياً في ضوء الكلام الذي تردد أخيراً أكثر من مرة حول الأمن في تركيا والأمن في دول الحلف كلها؟
* كاتب وصحافي لبناني
الحياة
جبل المشكلات/ امين قمورية
يتباهى داود اوغلو بلقب “كيسينجر الشرق الاوسط” بعد نجاح انقرة في تطبيق نظريته “صفر مشاكل مع دول الجوار”، وخصوصاً عام 2003 عندما سعت تركيا إلى منع الغزو الاميركي للعراق، وأقامت أفضل العلاقات مع الجيران من سوريا ومصر والاردن والسعودية الى ايران وروسيا. هذه السياسة توجت مرشده الروحي أردوغان بطلاً في شوارع المدن العربية بعد الاستعراض الذي قدمه في دافوس أمام شمعون بيريس وتحديه الاسرائيليين بالسفينة “مرمرة” التي حاولت كسر حصار غزة.
ولكن يبدو ان “موجة الربيع العربي” عجلت في كشف النيات المبيتة لاردوغان كزعيم يطمح الى زعامة السنة في المنطقة واستعادة حدود السلطنة. في زمن قياسي، تحولت “صفر مشاكل” الى “أطنان من المشاكل” مع كل الجيران. انهارت الروابط التاريخية بين تركيا ومصر وارتفعت المتاريس بينهما. وبسبب القاهرة و”الاخوان” ارتفعت الحواجز مع السعودية والامارات. صداقة السلطان الجديد مع الرئيس السوري صارت جحيماً، خسره… ولم يكسب في المقابل سوى النزر المتطرف من معارضيه. الود الذي كان يربطه بايران تصدع على الارض السورية. والعلاقة الاستراتيجية مع صديقه الأخير في روسيا تحطمت أيضاً في السماء السورية. آخر المشاكل كانت مع بغداد التي استباح اراضيها بجنوده ومدرعاته. ولم يبق له من اصدقاء في المنطقة سوى امارة قطر التي لا يزيد عدد اصدقائها الفعليين عن اصدقائه، ورئيس اقليم كردستان العراق الذي يسايره علناً ويرتاب في كرهه للاكراد ضمناً… وطبعاً “أمراء اللحى غير المشذبة” الذين يسهل مرورهم الى أرض الجهاد في الشام والعراق في مقابل خدمات سياسية وامدادات نفطية مسروقة ورخيصة.
التدخل المرفوض من ايران في الشأنين العراقي والسوري، ولو كان بطلب من الحكومتين الرسميتين في بغداد ودمشق، لا يبرر بالضرورة التدخل التركي في العراق بطلب من محافظ سابق أو في سوريا بطلب من ائتلاف حزبي مفترض لا وجود له على الأرض أو بفتوى من أمير جماعة. إلا اذا كانت انقرة تعتبر نفسها وصية على السنة العرب وترى في الموصل وكركوك وحلب اقطاعات عثمانية مسلوبة ينبغي اعادتها الى حضن السلطنة بالقوة وباستغلال الفوضى.
كل دهاء داود أوغلو وبلاغة اردوغان لم يكونا كافيين لتغطية التدخل المباشر. كان يمكن أنقرة ان تكون اكثر مهارة في التمويه. واذا كانت موسكو موهت تدخلها بالقانون الدولي ومعاهداتها مع دمشق، فان تركيا التي لا يتوافر لها هذا الغطاء كان عليها ان تتعلم من ايران كيف تدخلت بالواسطة في اليمن وقلبت المعادلات فيها من غير ان تترك أثراً عينياً واحداً، لا جنود لا افواج عسكرية ولا دبابات، بل فقط عقيدة وعصب وانصار وتحكم من بعد.
العجرفة لا تبني دولاً عظمى، بل تُراكم جبل المشكلات.
النهار
تركيا وروسيا: راية أطلسية حمراء/ أحمد جابر
لأن الجغرافيا السورية صارت حصصاً، فإن المتدخل الروسي وجّه عنايته القتالية إلى البقعة التي يظنها حصته، أي إلى مناطق سيطرة النظام السوري، الذي كان محمياً سابقاً بحق النقض الروسي في مجلس الأمن، وبات محروساً بقوة نار الطرف الروسي ذاته في «محميته» الرسمية. في هذا السياق، يمكن فهم منطق الضربات الجوية التي استهدفت كل المعارضين الموجودين على تخوم منطقة «الحصة الروسية»، والتي نالت من أولئك الذين يمكن أن يشكلوا بتقربهم القتالي منها تهديداً مباشراً لها، ولذلك لم يأبه الروسي كثيراً لكل الأصوات التي نددت باستهدافه قوى المعارضة «المعتدلة»، ولم يستجب لكل الدعوات التي طالبته بتوجيه جهده الناري صوب القوة الإرهابية التي جعل ضربها ذريعة لدخوله إلى مسرح المواجهة.
بقي الطرف الروسي رؤوفاً بـ «داعش»، شديداً على سواها، وهذا مما اقتضته الخطة الأصلية، وأصلها بل جوهرها، الإمساك بمساحة سورية واسعة تمكن من يسيطر عليها من الجلوس براحة وثقة، إلى طاولة المتحاصصين.
الاشتباك التركي الروسي جاء في سياق التنازع التحاصصي إياه، فلقد بدا للطرف التركي أن الاندفاعة الروسية في الشمال السوري، من شأنها أن تنال من حصته، وأن التمدد المشترك للطرفين السوري والروسي، سيقلص مساحة نفوذ أنقرة، وسيجعل صوتها خفيضاً في مراحل لاحقة من المفاوضات على مآل الوضع السوري، وفي ما هو مرتقب من تفاهمات، عاجلة أو آجلة، حول التوازنات الدقيقة التي ستسيج هذه التفاهمات، والتي ستتكفل بحمايتها حتى أمد بعيد. اتصالاً بموضوع الحرص على عدم تهديد نفوذ اللاعبين الآخرين تهديداً جدياً، أظهرت موسكو تسرعاً عملانياً، أو لنقل أنه تكشف عن استخفاف بقدرات القوى المتدخلة الأخرى بعد أسابيع من بدء الضربات الجوية، وكان ذلك مخالفاً للبداية السياسية التي واكبت الغارات الأولى، تلك البداية التي حرص خلالها الرئيس الروسي على طمأنة تركيا والسعودية مثلاً، بكلام ديبلوماسي وباقتراح تعاون وتآزر في مجال التصدي للإرهاب.
لعل روسيا احتفظت بتوجسها في البداية، ولعلها التزمت جانب الحذر من مكيدة التورط في الرمال السورية، فكثفت اتصالاتها بجميع الفرقاء، وحددت لعمليتها العسكرية سقفاً زمنياً، وتمسكت بضرورة الحل السياسي في سورية، من خلال تسوية شاملة لا تستثني أياً من أطراف الصراع. هذه الرسائل المرنة كانت مظلة واقية للتدخل الروسي، وفي فيئها استمر في تحركه. إلى أن فاجأته شمس إسقاط مقاتلته من قبل القوات التركية.
لم تكن النيران تركية حصراً، بل هي كانت رسالة أطلسية أيضاً. كان على الطرف الروسي أن يقرأ سطوراً من الرسالة، منها: إن الدخول الفعال إلى الميدان السوري سيظل مقيداً بشروط من غض الطرف عنه، وإن تثميره في صيغة نفوذ لاحق لروسيا سيظل رهناً بإرادة الذين صاغوا الحدود المقبولة لهذا النفوذ، والذين يراقبون مدى الالتزام الروسي باحترام هذه الحدود. هذه المعادلة الدقيقة لا تحتمل تلاعباً بمكوناتها، وهي تكشف، من ضمن أمور عدة، أن مقولة الدولة العظمى لا تنطبق على روسيا الحالية، والأقرب إلى الوصف أنها دولة تمتلك قوة عسكرية فعالة، لكنها قوة لا ترسم مسار حركتها بذاتها، بل إن خطوط حركتها ما زالت ترسم بأقلام غيرها، وأن هناك من يوظفها عالمياً، فيفرد لها حيزاً ضمن خطته العالمية العامة.
لا يحتاج الأمر لتدقيق كثير، بل إن ما هو واضح للعيان أن جني استعمال فائض القوة الروسية في الميدان السوري، لن يكون ممكناً إلا إذا أبدى «المجتمع العالمي» الآخر استعداده لدفع «بدل أتعاب» للتوظيف الجديد، ودائماً بالعملة الدولية المتداولة، تلك التي ما زال لواء التفوق معقوداً لقدرتها «الشرائية» العالية، والتي ما زالت بمثابة الملاذ الآمن، سياسياً واقتصادياً وعلى كل صعيد.
بناء على ذلك، لن تستطيع روسيا أن ترد على رفع الشارة الحمراء في وجه مقاتلاتها بطريقة تتجاوز على ما لها من موقع على الخارطة الدولية، أي أن السياسة الروسية ستكون مضطرة لتعاود سيرة البداية التي حرصت على طمأنة الجميع، والطمأنينة ليست أقل من احترام مصالح الآخرين، وعدم تجاوزها. ومما يحتم ذلك على روسيا، خشيتها من أن تستفرد في الميدان السوري إذا ما أبدت تعنتاً، هذا التعنت له معنى واحد هو الإيغال في التدخل الميداني، وهذا إن حصل فإنه يعني زج القدرة الروسية في معركة مسدودة الآفاق ميدانياً، ومغلقة المنافذ سياسياً، هذا إذا ظل الحل في سورية معرفاً بصفته حلاً دولياً وإقليمياً شاملاً.
التعريف الشامل للحل، هو في الوقت ذاته الكابح الشامل للاندفاعة الروسية، ولأن الأمر كذلك، فإن تركيا ستظل محمية بـ «الشمولية الدولية»، وستظل متمتعة بحق رفع راية الأطلسي الحمراء، كلما ارتكب اللاعب الروسي خطأ، داخل الملعب وعلى حدود التماس. سيكون على الطرف الروسي أن يهدأ، وعليه ألا يطيل اللعب في المنطقة الخطرة… الخاسرة.
* كاتب لبناني
الحياة
تركيا تجبه حرباً ضروساً مجنونة و”خلاصية”/ إبراهيم قره غول
لن تقتصر على سورية، فهي حرب ستمتدّ من شرق المتوسط إلى خليج البصرة ودوله. إنها حرب طائفية تتستّر بقناع حرب الهويات العرقية، ومع الوقت لن تنجو منها أي دولة في المنطقة. فهي حرب رسم الخرائط من جديد. وأدعو إلى أن تتحرك الدبابات قبل أن تصل النيران الى الأماكن المقدسة. وإثر وضع طهران يدها على العراق، تسعى الى الهيمنة على سورية، ومشروعها التوسعي بلغ اليمن. وفي عام أو اثنين، لن تكون أي دولة خليجية في مأمن من المدّ الإيراني. وما مساعي إيران الحثيثة للسيطرة على سورية، إلا من أجل تطويق السعودية. فثمة خطة فارسية مجنونة. حرب إيران التوسعية في سورية هي حرب إقليمية، وإن لم توقف إيران في سورية، فإنها ستواصل التوسع.
وترمي حرب روسيا وإيران والأكراد على شمال سورية الى إحكام القبضة عليه، والتذرّع بـ «داعش» لشنّ حرب على المعارضة السورية المسلّحة وتصفيتها. وهذه حرب تستهدف تركيا في المرتبة الأولى. فموسكو وطهران تسعيان الى السيطرة على شمال سورية، وقطع التواصل الجغرافي بين تركيا والعالم العربي. فهل هي حرب نفطية لمد خطوط الطاقة، أو حرب إنشاء دولة كردية؟ هي حرب استباقية للتمهيد لما سيحصل بعد عامين عندما تبدأ إيران بالاستفراد بدول الخليج. فتكون تركيا معزولة جغرافياً عن العالم العربي ولا تستطيع أن تهب لنجدته.
جنون فلاديمير بوتين وجنون إيران من طينة واحدة، فالرئيس الروسي فرض هيمنته على القوقاز الجنوبي، ولم يتحرك أحد. وتدخل في أوكرانيا وقسّمها، ولم يوقفه أحد، فذهب واحتلّ القرم، ولم يتصدَ له أحد. واليوم، يسعى مع إيران الى احتلال سورية. لذا، ليس إسقاط الطائرة الروسية مسألة تركية وروسية فحسب. فهو حادث يقرع ناقوس الخطر من تبعات التدخل الروسي في سورية والهيمنة الروسية والإيرانية عليها. وتركيا ردّت على محاولات عزلها وحصارها. ولم تثنها عن الرد القوي العلاقات التركية – الروسية الممتازة.
ولا شك في أن تركيا دولة قوية ولن تستسلم أمام محاولات فرض أمر واقع عليها، ولن تردعها مساعي هذه الدول الإقليمية الى شغلها بمشكلاتها الداخلية (الحرب مع حزب «العمال الكردستاني» ووحدات الحماية الكردية) عن قضايا المنطقة. وحوادث مثل خرق روسيا الأجواء التركية، وتهديد السفن التركية في شرق البحر المتوسط، هي من بنات سياسة إيرانية أكثر مما هي تكتيكات روسية. وصار شرق المتوسط مزدحماً بالسفن الحربية، وكأن العدة تعدّ لحرب إقليمية مقبلة. وشأن تركيا، تنظر أميركا وأوروبا بعين الانزعاج الى التوغّل الإيراني – الروسي.
ويرمي الموقف التركي الى الحؤول دون اندلاع مثل هذه الحرب الإقليمية وحرب طائفية دينية في المنطقة، ومنع الدبابات الإيرانية من التقدّم نحو مكة المكرمة. وقد يوحي حشد الجيوش في شرق المتوسط بحرب مقبلة كبيرة على سورية يســميها المحافظون الجدد في أميركا حرب نهاية العالم. وسكوت تركيا عما يحصل في سورية يؤذن بنهايتها: اندلاع حرب داخلية وتقــسيم الدولة. لذا، تبادر أنقرة الى خطوات جريئة وقوية. فالتاريخ لا يكتب إلا بالجرأة والقوة.
* رئيس تحرير، عن «يني شفق» التركية، 5/12/2015، إعداد يوسف الشريف
الحياة
الحرب والسلم بين أنقرة وموسكو/ فلاديمير باستوخوف
غادر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان باريس من دون أن تتسنى له مصافحة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وأنذرت تصريحات بوتين بأن الأمر لن يتوقّّف على منع البندورة التركية من دخول روسيا. ومآل الصراع الروسي – التركي غامض، فهل يتحوّل إلى نزاع عسكري محلّي يشبه نزاعات القرن التاسع عشر، أو الى حرب تموضعية مصغّرة باردة تحاكي حروب القرن العشرين. وثمة سبيلان أمام روسيا للخروج من هذه الأزمة: السلام الصعب أو الحرب الضروس. وفي الخيار الأول، قد تفقد روسيا ماء الوجه، لكنها ستحتفظ بأجزاء أخرى من جسدها مثل «مشروع نوفوروسيا» (إنشاء جمهوريتين انفصاليتين مواليتين لروسيا على الأراضي الأوكرانية). أما في الخيار الثاني، فلا تخسر ماء الوجه، لكنها تنخرط في حرب واسعة بعيداً من حدودها. ويؤيد خيار الحرب عدد لا بأس به من النخب العسكرية والسياسية الروسية.
ويرجح أن تبالغ تركيا في الرد على الخطوات الروسية. والمشكلة أن النزاع بين هذين البلدين يحمل طابعاً مبدئياً. وليس مدار النزاع على طموحات أردوغان وبوتين فحسب، لكن على مصالح خاصة. والطموحات يمكن لجمها، لكن المصالح تترك على غاربها، وتُسقط المنطق السياسي، وتشوّه الخطط والنوايا.
ومكانة سورية في تركيا هي أشبه بمكانة أوكرانيا في روسيا. واللاذقية هي نظير مشروع «نوفوروسيا» الروسي في أوكرانيا. ويرى الأتراك أن الأسد هو نظير كابوس بيترو بوروشينكو (الرئيس الأوكراني) البوتيني. لذا، لا يسع أنقرة أن تقف موقف المتفرج من تدخل روسيا في سورية. ولا يسع موسكو ألا تتدخل هناك، فهي تريد أن تحقق عدالة اهتزت عقب انهيار حائط برلين. ويدرك كل منهما ما هو فاعل: القصف الروسي لمناطق التركمان لضمان سلامة نظام الأسد، وإسقاط الأتراك الطائرة الروسية من أجل رسم حدود التدخل الروسي في الصراع. لكن لا بد من التذكير بأن قوة تركيا في النطاق الإقليمي تفوق القوة الروسية، والضربة الأولى الموجّهة الى روسيا قد تكون موجعة.
* حامل دكتوراه في علم السياسة، عن «نوفايا غازيتا» الروسية، 6/12/2015، إعداد علي شرف الدين
الحياة
على هامش الأزمة الترك روسية/ د. مدى الفاتح
■ منذ أسبوعين تقريباً وخبر إسقاط تركيا للطائرة الروسية يتصدر عناوين الأخبار. أفرد الإعلام الإقليمي والدولي مساحة لمناقشة تداعيات الحادثة وتأثيراتها على المنطقة، كما تمت استضافة العشـــرات من المحللين والمراقبين والمتابعين الذين قدموا تصوراتهم وفتاواهم حول القضية.
بعد كل ذلك السيل من المعلومات والتحليلات أصبح من الصعب الإتيان بما هو جديد على المتابع، حيث تمت مناقشة الموضوع بجوانبه الفنية وتأثيراته الاقتصادية بشكل مكثف، لكن متفاوت الموضوعية. هذا التفاوت نبع في الواقع من حقيقة امتلاك أولئك «المحققين» في غالبهم لمواقف مسبقة مع أو ضد تركيا أو روسيا، وهو ما يحجب النظر بشكل مفيد وعقلاني للقصة التي تبدو معقدة بالنسبة لما يمكن تسميته بـ»العقليات التابعة»، لارتباطها بمفهوم «السيادة»، التي هي منتقصة عند معظم دول المنطقة، التي ربما لم تكن لترى في عبور طائرة أجنبية لأجواء البلاد بلا إذن انتقاصاً حقيقياً لسيادتها، لاسيما لو كانت تلك الطائرة تابعة لدولة كبرى.
لكن تركيا لا تتعامل كدولة صغيرة، ولا تنظر لنفسها كدولة من غمار دول الإقليم، وهي لذلك تتعامل بحساسية مع جميع من يعاملونها كجزء من المنظومة المستباحة المسماة بالشرق الأوسط. روسيا التي لم تقرأ الحساسية التركية بشكل صحيح بدت مصدومة من الجرأة على إسقاط طائرتها. ربما كان سبب تلك الصدمة هو العلاقات التجارية القوية التي تربط بين البلدين والتي جعلتهما، رغم الاختلاف في وجهات النظر السياسية، يبدوان كحليفين، أو ربما كان سبب الصدمة هو حالة «الانتفاخ الروسي» التي جعلت أنصارها يصورونها كقطب جديد مقابل القطب الامريكي. تصوير اعتمد بقدر كبير على حالة «التمرير» التي يمارسها الأمريكيون تجاه الاجراءات والتدخلات الروسية في القوقاز والقرم وأخيراً سوريا.
(هذا الانتفاخ مثّله فلاديمير جيرونيفسكي رئيس الحزب الليبرالي الذي دعا إلى إلقاء قنبلة ذرية على اسطنبول بغرض تأديبها!) اللافت في التحليلات التي استمعنا إليها والتي تحاول الموازنة بين قوة الطرفين تكرار المتحدثين لحقيقة أن تركيا عضو في حلف الناتو، ما يعني أن روسيا إذا دخلت في مواجهة فإنها ستدخل مواجهة كبرى لن تستطيع تحمل نتائجها وكلفتها الاقتصادية والعسكرية. من الناحية النظرية، تركيا عضو أصيل في ذلك الحلف، الذي تأسس كمنظومة دفاع غربية مشتركة، لكن إلى أي حد يمكن الاعتماد الاستراتيجي على ذلك مقابل تهديد جاد؟
بالنسبة إليّ أعتقد أن تراجع روسيا عن التصعيد، لو حدث، لن يرجع لخوفها من انتقام الناتو، بقدر تحسبها للآثار الاقتصادية والأمنية التي يمكن أن تترتب على حالة عداء صريح للجمهورية التركية. حتى الآن اكتفت روسيا بتوسيع نطاق عملياتها في سوريا، ومحاولة توجيه نوع من الحرب الاقتصادية عن طريق مقاطعة المنتجات وتعطيل التصدير والأعمال المشتركة، لكن الاحتمالات تبقى دائماً مفتوحة على ما هو أكبر. الطريف في تلك القضية ذات الأبعاد الخطيرة والتأثيرات اللانهائية على استقرار المنطقة في حال تصاعدها أكثر هو انقسام الرأي العام العربي بين مؤيد ومعارض لهذا الطرف أو ذاك، فبالإضافة للتصريحات السياسية الرسمية سوف تظهر «هاشتاغات» تطالب بدعم الاقتصاد التركي لتعويض خسائره من أي مقاطعة روسية، في حين يدشّن أنصار روسيا «هاشتاغاً» آخر بعنوان: إغضب يا بوتين!
بدا الأمر أشبه بتشجيع فريقين يلعبان الكرة. أشبه بمشهد أطفال بائسين بملابس بالية في مدينة فقيرة وهم يشجعون فريقاً أو لاعباً أوروبياً لا يعلم أساساً بوجودهم. لحسن الحظ لم يساير كلا القائدين، حتى الآن على الأقل، تلك الرغبة الطفولية لدى بعض أنصارهما في الدخول في مواجهة مفتوحة غير مدروسة العواقب.
النقطة التي لم يولها من استمعت إليهم الاهتمام الكافي هي تلك المتعلقة بموقف الولايات المتحدة من الأزمة. كان موقفاً غريباً وشديد البرود، ففي حين بدأت التصريحات تشتعل بين الطرفين، وبدأ الإعلام يتحدث عن مواجهة القيصر مع السلطان، كانت الولايات المتحدة تتحدث بهدوء عن ضرورة الانحياز للدبلوماسية والتمسك بالقانون الدولي، وهو موقف لا يتماشى مع ما اعتدناه من الدولة الأكبر التي قد تذهب للتدخل في أي مكان في العالم بدون انتظار إجماع دولي.
الموقف الأمريكي الذي كان متماشياً مع سياستها السورية وسياساتها الجديدة في المنطقة، يدل بوضوح على عدم عزمها الدخول في مواجهة مع روسيا بسبب تركيا، وهو ما يعني بالضرورة أن الاعتماد على الناتو، الذي تسيطر عليه الولايات المتحدة، لن يكون منطقياً، خاصة أنها رغم مساندتها لوجهة النظر التركية، لم تلبث أن لامت حليفتها، بشكل غير مباشر، باعتبار أنها لم تستشر قبل القيام بعملية الإسقاط، وهو ما يجعلنا نشكك في الرؤية التي كانت تقول إن عملية الاسقاط تم افتعالها بضوء أخضر غربي، من أجل جر روسيا إلى مواجهة، حيث أن الواضح هو عدم نية الحلف ولا دوله التورط في سوريا، لا من أجل عيون تركيا، ولا من أجل أي سبب سياسي أو إنساني آخر.
هذا يقودنا من ناحية أخرى لتفكيك النظرة السائدة التي تتحدث عن الارتباك الأمريكي أو عن ضعف شخصية أوباما. بالنسبة إلي فأنا لا أرى الرئيس الذي استطاع بنجاح الخروج من المستنقع العراقي، والتحضير للخروج من الآخر الأفغاني، عبر سياسة انسحاب متأنية، مرتبكاً. كما أنني لا أرى في سياسته التي تتوجه للاهتمام بالدول الآسيوية النامية على حساب الدول العربية، أي إشارة تنم عن ضعف وتراجع، بقدر ما أراها سياسة لإعادة الترتيب الواقعي للأوليات، خاصة أن المنطقة العربية لم يعد لديها فعلاً الجديد ولا المزيد لتقدمه للاقتصاد الأمريكي، الذي بات هو الآخر يبحث عن مصادر جديدة للدعم وللشراكة الموضوعية.
علينا ألا ننسى أن جزءاً مهماً من حملة أوباما كان قد تعلق بوعود التخفيف من التدخلات العسكرية التي كانت، وما تزال، من أهم المطالب الشعبية للأمريكيين، وهو ما يجعلنا نفهم إصرار الولايات المتحدة على الحل السياسي في سوريا، ورفضها أي دعوات للتدخل المباشر حتى ولو كان دعوة لإقامة منطقة عازلة أو آمنة. من هنا يأتي التناقض بين وجهتي النظر التركية والأمريكية، فبينما تكون سوريا بالنسبة للأوائل منطقة استراتيجية ذات أولوية، تبقى بالنسبة للأمريكيين مجرد أرض بعيدة بلا أهمية يمكن مقايضتها مع الروس أو الانتظار ببرود نتيجة ما ستسفر عنها الفوضى هناك.
ختاماً أقول إنه سواء كانت الدول الكبرى في حالة من التنسيق وتبادل الأدوار تجعلها تخسر هنا وتربح هناك، كما يزعم البعض، أو كان هناك تراجع حقيقي للامبراطورية الأمريكية لصالح مراكز قوى جديدة كروسيا، فإنه لن يكون للمجموعية العربية، بحسب المعطيات الحالية، أي دور مهم في قيادة الأحداث خلال المستقبل القريب، وإن أقصى حدود لدور أغلبهم لن يتعدى أن يكون مجرد حجر على طاولة لعب الكبار.
٭ كاتب سوداني
القدس العربي
مشروع إلغاء تركيا من المعادلة/ عبد الرحمن الراشد
الذي يظن أن الهبة الحكومية العراقية، الأولى من نوعها منذ إسقاط نظام صدام حسين، كلها ضد وجود القوات التركية على التراب العراقي فهو مخطئ. كل القوة التركية مائة وخمسون عسكريا فقط، يوجدون في محيط مدينة الموصل التي يحتلها تنظيم داعش منذ عام ونصف. وكذلك التهديدات الروسية المتصاعدة للأتراك ضد قواتهم على الحدود مع شمال سوريا، رغم أنها تعتبر منطقة تتزاحم فيها جيوش وميليشيات من أنحاء العالم.
التأزيم المتصاعد، من قبل المثلث الإيراني العراقي الروسي ضد تركيا، تتضح معالمه كمشروع لتحجيم تركيا، وإلغاء دورها الإقليمي، وبالتالي تحرير المشروع الإيراني من أي مواجهات في المنطقة، لتصبح طهران صاحبة القرار في العراق وسوريا. وهذا يتم في ظل التراجع الأميركي المتكرر خلال سنوات الأزمة الخمس، والذي لم يفعل شيئا باستثناء بيانات التضامن الكلامية.
السرية التركية الموجودة خارج مدينة الموصل جاءت بدعوة من محافظ الموصل سابقا من أجل تدريب أبناء المدينة المتطوعين للدفاع عن مدينتهم، بعد أن هربت قوات الحكومة العراقية، وتوغل الإرهابيون في أرياف تلك المحافظة. وقد تركت الموصل فريسة لـ«داعش» ولم يقرر الحشد الشعبي تحريرها، لأن جله من ميليشيات طائفية شيعية تم تكوينه من قبل إيران كبديل للجيش العراقي، وتتولى تدريبه وتجهيزه وتوجيهه.
والحقيقة لا تلام إيران وروسيا على تقدمهما الواضح في مشروع إبعاد وتقزيم تركيا إقليميا، لأننا في مواجهة إقليمية كبرى، ولأن الحكومة في أنقرة نفسها لم تفعل شيئا مهما للدفاع عن مصالحها خلال السنوات المضطربة. وهي ما لم تع الخطر، وإن كانت، بكل تأكيد، تراه بأم عينيها، حيث تتم محاصرتها تدريجيا من قبل هاتين الدولتين، فإن معالم المنطقة تتغير ضدها، وستكون تركيا الهدف التالي، لأنه لا يمكن لإيران وروسيا الاطمئنان لقدرتهما على الهيمنة وإدارة العراق وسوريا دون شغل تركيا داخليا.
سياسة تركيا تائهة في قضايا لا قيمة لها في ميزان الصراع الإقليمي. أشغلت نفسها بخلافات هامشية وإعلامية مثل معركتها مع مصر، أو دعم قوى معارضة مثل «الإخوان المسلمين»، ولا تعني شيئا مهما للأمن القومي التركي. قيمة الإخوان صفر في معادلة المنطقة، وخطر مصر على تركيا أيضا صفر، ولا يوجد ما يبرر إصرار أنقرة على الاستمرار فيه!
مشروع إيران في الهيمنة على المنطقة أصبحت معالمه واضحة. فقد قررت تحييد الولايات المتحدة والناتو من خلال منحهم مطلبهم الرئيسي، التخلي عن مشروعها النووي لأغراض عسكرية. وبالفعل نجحت في ذلك. ثم شرعت في الهيمنة على العراق، ورغم إسقاط رجلها الأول نوري المالكي، فإنها أطبقت على القوى السياسية، واليوم تملك القرار هناك في ظل عجز رئيس الوزراء حيدر العبادي. وفي نفس الوقت شكلت أول قوة عسكرية من ميليشيات إيرانية وعراقية ولبنانية وأفغانية يصل عدد أفرادها إلى مائة ألف في سوريا. وزادت من نفوذها بتفعيل حلفها مع روسيا التي أرسلت إلى هناك قوة عسكرية جوية وبحرية تفوق ما أرسله الاتحاد السوفياتي إلى المنطقة إبان الحرب الباردة.
ولأن تركيا هي القوة الإقليمية الموازية لإيران فإنها أصبحت مستهدفة، بشل يدها في سوريا، وإلغاء وجودها في العراق. ولا يمكن تحميل الأتراك وحدهم مسؤولية مواجهة الحلف الروسي الإيراني المندفع في الشرق العربي، لكنهم هم الرقم الأهم. ودون أن تعيد تركيا قراءة خريطة الصراع وإعادة التموضع فإنها ستجد نفسها في مأزق أكبر غدًا. تركيا أكثر من يحتاج إلى إحياء محور إقليمي يواجه الاكتساح الإيراني، ولا يمكنها فعل ذلك وهي تضع من أولوياتها قضية مثل «الإخوان»، الذين أمضوا ثلاثين سنة حلفاء أصليين لنظام إيران، الذي سبق أن جرب وفشل في دعمهم للوصول لحكم القاهرة في زمني الرئيسين السابقين أنور السادات وحسني مبارك.
الشرق الأوسط
الروس وحلم العودة إلى الشرق الأوسط/ عادل سليمان
يوم 27 سبتمبر/أيلول عام 1955، فاجأ جمال عبد الناصر العالم، عندما أعلن أن مصر وقعت صفقة أسلحة مع تشيكوسلوفاكيا (السابقة)، ما أثار ضجة كبرى إقليمياً ودولياً، فقد كانت تلك الصفقة الباب السحري الذي دخل منه الروس إلى الشرق الأوسط أول مرة، بينما كان العالم مقبلاً على عصر الحرب الباردة.
وبالعودة إلى الظروف التى تمت فيها تلك الصفقة، وفتحت الأبواب أمام الروس للدخول إلى الشرق الأوسط، نجد أنه مع بداية عام 1955، كان عبد الناصر قد حسم الصراعات على السلطة في مصر لصالحه تماماً، سواء داخل الجيش، أو في صراعه مع جماعة الإخوان المسلمين. هذا على المستوى الداخلي، أما على المستوى الخارجي، فقد تعرّضت مصر لهزة عنيفة، عندما قام العدو الإسرائيلى مساء يوم 28 فبراير/شباط 1955 بإغارة مفاجئة على موقع عسكري مصري في قطاع غزة، أطلق عليها عملية السهم الأسود، وراح ضحيتها 39 جندياً مصرياً.
تواكبت تلك الأحداث مع عقد مؤتمر باندونج في إندونيسيا في 18 إبريل/نيسان من العام نفسه، بدعوة من الرئيس أحمد سوكارنو، ومشاركة زعماء من الدول الأفروآسيوية الواعدة. من أبرزهم شواين لاي وتيتو ونهرو وعبد الناصر، ليتم تأسيس حركة عدم الانحياز، لتجنب الصراع المحتمل بين القطبين الجديدين، الغربي بقيادة أميركا والشرقي بقيادة روسيا، وجدها عبد الناصر فرصة لطرق أبواب مصادر جديدة للتسليح، فطلب من الزعيم الصيني، شواين لاي، في لقائهما مساعدته في ذلك، فتلقى وعداً شفوياً بالتوسط لدى الروس.
جاء الرد بعد ذلك بشهر، عندما أبلغ السفير الروسي في القاهرة عبد الناصر الموافقة على مده بالسلاح، على أن تتم الصفقة مع التشيك، لرغبة الروس فى عدم الدخول في مواجهة مباشرة مع الغرب في ذلك الوقت. وبالفعل، تم توقيع الصفقة مع التشيك، يوم أعلن عنها عبد الناصر. وقابل الغرب الإعلان عن صفقة السلاح بالغضب، وخرجت تصريحات تحذّر الروس من الدخول إلى الشرق الأوسط، وأبدت أميركا استعدادها للتجاوز عن الصفقة في مقابل رضوخ مصر لشروطها، لكن الأمور تطورت بشكل متسارع، وأمم عبد الناصر قناة السويس، ووقع العدوان الثلاثي في 29 أكتوبر/تشرين الأول 1956، ولعب الاتحاد السوفييتي دوراً، في ذلك الوقت، في مساندة الموقف المصري، ثم في توقيع اتفاق تمويل السد العالي وإقامته، وأصبح الوجود الروسي في مصر أمراً واقعاً، لم يقتصر على المجال العسكري، ولكنه تطور في اتجاهات متعددة، أهمها مجالات التصنيع والمشروعات الكبرى.
لم يقتصر الأمر على مصر، فمع سريان موجة الانقلابات العسكرية الثورية في المنطقة، العراق 1958، اليمن 1962، بالإضافة إلى الوحدة المصرية السورية (1958-1961)، ولجوء تلك النظم إلى الروس، لبناء الجيوش القومية، ثم جاء التطور الإقليمي الأكثر دراماتيكية، في حرب يونيو/حزيران 1967، والهزيمة العربية، ثم لحاق ليبيا بركب الدول القومية في انقلاب معمر القذافي 1968، ودخولها تحت عباءة التسليح الروسي.
تلك كانت سنوات الصعود والتمدد الروسي في منطقة الشرق الأوسط، بدأت في 1955، ووصلت إلى ذروتها في 68 و69. ومع بداية السبعينيات، بدأ المد يتوقف، ولم يتجاوز الدول الخمس في المشرق العربي، مصر والعراق وسورية واليمن وليبيا، إضافة إلى الجزائر في المغرب العربي. ومع تعقد الصراع العربي الإسرائيلي، وإدراك العرب أن الروس غير قادرين على الحل أو غير راغبين، وأنهم لن يتجاوزوا حدوداً معينة في مجالات التسليح، بدأ الاتجاه التدريجي نحو الغرب، والذي بدأه عبد الناصر نفسه، عندما قبل مبادرة روچرز الأميركية في أغسطس/آب 1970، لوضع حد لحرب الاستنزاف. ثم جاء أنور السادات، ليقوم بما أطلق عليه ثورة التصحيح في مايو/أيار 1971، وتخلص من كل رجال نظام عبد الناصر، ثم تخلص، بشكل مفاجئ، من كل الخبراء الروس في القوات المسلحة في 1972، في إشارة لها مغزاها لمستقبل العلاقات مع الروس، وتسارعت التطورات في حرب أكتوبر/تشرين الأول 1973، ثم الدخول في عملية السلام برعاية أميركية، ثم جاءت معاهدة السلام المصرية – الإسرائيلية عام 1979، وما أعقبها من دخول مصر تحت مظلة المعونة العسكرية الأميركية، ليتغير تسليح الجيش وتدريبه جوهرياً، بالإضافة إلى التحولات السياسية والاقتصادية التي انتهجها السادات نحو الانفتاح الاقتصادي. وهكذا بدأ غلق ذلك الباب السحري الذي دخل منه الروس في الخمسينيات والستينيات إلى مصر، ومنها إلى الشرق الأوسط كله.
شهدت حقبة التسعينيات مشهد الخروج الكبير للروس من الشرق الأوسط، مع انهيار الاتحاد
“شهدت حقبة التسعينيات مشهد الخروج الكبير للروس من الشرق الأوسط، مع انهيار الاتحاد السوفييتى السابق، وبداية تآكل الألة العسكرية الروسية في الدول التي تعتمد عليها” السوفييتى السابق، وبداية تآكل الألة العسكرية الروسية في الدول التي تعتمد عليها، والتي بدأت في العراق مع مغامرات صدام حسين العسكرية في حربه الطويلة مع إيران، ثم غزو الكويت، وتعرضه لحرب الخليج الثانية، وما أعقبها من عقوبات، انتهاء بالغزو الأميركي 2003، والذي قضى على الجيش العراقي وتسليحه الروسي تماماً. ثم توالت الأحداث، لتنهي ما بقي من جيوش تعتمد على السلاح الروسي، فى ليبيا واليمن وسورية، ولينتهي النفوذ الروسي في المنطقة، باعتبار الروس المصدر الرئيسي لتسليح المؤسسات العسكرية التي هي عَصّب النظم السياسية اليى كانت قائمة، وتدريبها. ولكن، في ظل كل تلك الظروف، تمكن الروس من الحفاظ على موطئ قدم في سورية. في ظل نظام الأسد الأب والابن، وهو ما يفسر تمسك الروس بدعم نظام الأسد حتى النهاية، لأن سقوطه يعني القضاء على أي أمل فى استعادة الوجود الروسي في المنطقة.
استيقظ لدى الروس، أخيراً، حلم العودة إلى الشرق الأوسط، وراحوا يطرقون الأبواب السحرية التي سبق أن دخلوا منها في خمسينيات القرن الماضي، ولأن العالم قد تغير كثيراً، كان على الروس أن يأتوا، هذه المرة، بقواتهم المقاتلة، لا مجرد خبراء ومستشارين ومدربين، بل سلاحاً وعتاداً ومقاتلين، وآخر ما أنتجته ترسانتهم العسكرية من أسلحة الجو والبحر والبر، وقد تم ذلك كله، في البداية، تحت مظلة “الحرب على الإرهاب”، ومرتكزاً على موطئ القدم الروسي فى سورية.
وانغمس الروس، على الفور، فى خضم المعارك الدائرة على الساحة السورية. ولكن، سرعان ما واجه الروس ردود الفعل غير المتوقعة، بدءاً من عملية تفجير طائرة الركاب المدنية الروسية فوق سيناء ومقتل 244 راكباً مدنياً، إلى إسقاط المقاتلات التركية قاذفة حديثة من طراز سوخوي 24. وفي اليوم نفسه، سقطت هليكوبتر مقاتلة روسية في الأراضي السورية، ودمرتها عناصر المعارضة المسلحة. بعد مرور أكثر من شهرين على الدخول العسكري الروسي المكثف إلى المنطقة، عبر بوابة النظام السوري، لم تتحقق أي نتائج ملموسة على أرض الواقع، فلا نظام الأسد تمكّن من استعادة أي من المناطق التي فقدها، ولا موازين القوى تغيرت، ولا توجد نتائج ملموسة للضربات الصاروخية والجوية الروسية المكثفة، اللهم إلا النيران الصديقة التي تسقط على بعض مواقع نظام الأسد.
هل يدرك الروس وقيصرهم الجديد أن الشرق الأوسط الذي يحلمون بالعودة إليه ليس هو شرق أوسط منتصف خمسينيات القرن الماضي؟ وأن بشار الأسد المحاصر في دمشق وأجزاء من الساحل السوري ليس هو عبد الناصر، بكل ما كان يحيط به من زخم محلي وإقليمي ودولي، والأهم، هل سيتحمل الروس التكلفة الباهظة لحلمٍ يبدو بكل المقاييس حلماً مستحيلاً؟
العربي الجديد
بوتين النووي/ حسام عيتاني
يأمل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ألا يضطر إلى تزويد الصواريخ «الحديثة والدقيقة» التي تطلقها قواته على مناطق سيطرة «داعش» في سورية رؤوساً نووية في سياق الحرب على الإرهاب.
منذ نهاية الحرب الباردة، نادراً ما صدر كلام جديّ عن استخدام الأسلحة النووية عن سياسي يتسم بحد أدنى من المصداقية. وباستثناء شطحات بعض غلاة المحافظين الجدد في إدارة الرئيس الأميركي السابق جورج دبليو بوش أو المحيطين بها من الذين اعتادوا توجيه تهديدات أكبر من أحجامهم، أثناء غزو أفغانستان والعراق وفي ذروة الأزمة حول برنامج إيران النووي، لم تعد معتادة الإشارة إلى السلاح الذري، سواء على المستوى التكتيكي الذي لوح به بوتين أو على مستوى الخيار الاستراتيجي الذي كان سائداً بين الخمسينات والثمانينات من القرن الماضي.
أرست الحرب الباردة ما يصح وصفه «بالأدبيات» في تناول الأسلحة النووية، خصوصاً بعد مواجهات كادت تدمر العالم، مثل أزمة الصواريخ الكوبية واقتراحات بعض الجنرالات الأميركيين بقصف كوريا وفيتنام نووياً أثناء الحربين هناك، وتشبّع القيادتين السوفياتية والأميركية بهاجس الإفناء الناجز المتبادل. حملت تلك الخبرة جانبي الصراع، السوفياتي والأميركي، على إبداء درجة أعلى من «الحكمة» في التعامل مع المسألة النووية.
تعريفاً، السلاح النووي يوجه لتدمير المراكز المدنية والاقتصادية والسياسية عند العدو. أما الأسلحة النووية الصغيرة من النوع الذي تحدث عنه بوتين مع وزير دفاعه سيرغي شويغو، فتُستخدم –نظرياً– ضد الأهداف العسكرية الضخمة: القواعد الكبرى والمطارات وحاملات الطائرات، ويكون استخدامها في سياق حرب نووية مفتوحة.
بديهي أن الحقائق هذه حاضرة في ذهن الرئيس الروسي، الذي يعرف حكماً أن استهداف أي منطقة يحتلها «داعش» بذخيرة نووية مهما صغر عيارها، يعني الموت الفوري لعشرات الآلاف من المدنيين، إلى جانب بضع مئات من مسلحي التنظيم الإرهابي.
تُفصح معادلة قتل آلاف الأبرياء مقابل القليل من المجرمين، من جهة، عن فشل أخلاقي فظيع يعاني منه بوتين الذي يحاول إخفاء هذه النقيصة بإبداء «الأمل» في ألا يضطر إلى الخطوة النووية، ويتشارك في فشله هذا مع المواقف القديمة لمحافظي أميركا الجدد. وتعلن، من جهة ثانية، بؤس السياسي الذي لا يملك سوى التهديد باللجوء إلى ما يفتقر اللجوء إليه إلى المعنى والجدوى باستثناء الدمار والقتل المجانيين، فالتلويح بقتل الذبابة بمدفع لا يكشف مهارة الرامي بقدر ما يُظهر خرقه وانعدام الوسائل الناجعة لديه في مكافحة آفة الإرهاب.
وإذا استفاد بوتين من فراغ القيادة في الغرب والانكفاء الأميركي ومن إدراكه أن لا التهديد ولا التنفيذ في حال حصوله، سيقابلهما أي رد فعل عملي، فإن ذلك لا يضعه في موقف متقدم على نظرائه من قادة العالم في حربه على الإرهاب، بل يجعله شريكاً لهم في عدم القدرة على استنباط أساليب تتجاوز اللجوء إلى القوة والحلول العسكرية الأمنية لكبح مشكلة تتخذ أبعاداً عالمية ويمتد نسيجها من جبال أفغانستان إلى أفريقيا.
وإلى جانب التبلد الأخلاقي والسياسي الذي تشير إليه فكرة قصف المناطق السورية بأسلحة نووية، فهي تقول إن ما من جهة عربية أو دولية ارتقت بعد إلى مستوى علاج ظاهرة الإرهاب من جذورها المتشابكة وصولاً إلى قمتها، وإن الحرب على الإرهاب أهم بأشواط من أن تُترك للضابط بوتين.
الحياة
عن رفض موسكو النفوذ الخارجي في سورية/ وليد شقير
عاملان رئيسيان يتحكمان بالسياسة الروسية حيال سورية والمنطقة، يعكسان تفضيلها تحقيق الأهداف المرحلية، مع تأجيلها البحث بأهدافها الاستراتيجية الكامنة وراء تحركاتها العسكرية والسياسية والديبلوماسية في الشرق الأوسط، والمتعلقة بمقاومتها تمدد النفوذ الغربي والأطلسي في دول أوروبا الشرقية، حديقتها الخلفية.
العامل الأول هو المواجهة المستجدة بين الجانبين الروسي والتركي التي حولها حادث إسقاط أنقرة طائرة «سوخوي» الى صراع مفتوح، مع ضوابط لا تقود إلى الحرب بين الدولتين.
أما العامل الثاني فهو أن لا حديث في نظر موسكو عن أي أمر في ما يتعلق بسورية والحل السياسي فيها وفي مستقبل المنطقة، إلا مواجهة الإرهاب، الذي التقطت حاجة الغرب الى إعطائه الأولوية بعد جرائم «داعش» في باريس والعديد من أنحاء العالم. بل إن الديبلوماسية الروسية باتت تربط المواجهة التي انطلقت مع أنقرة بعنوان الإرهاب، فتتهمها بتأييد الإرهابيين، وتهيئ لمزيد من الإجراءات ضدها.
بناء على هذين العاملين تسلك موسكو في دعايتها الإعلامية طريقاً يرفض منطق «النفوذ التركي المشروع» في الأراضي السورية، بحكم وجود أقلية التركمان والعلاقات التاريخية مع الشمال السوري. بل إن موسكو تقفز فوق تواجدها العسكري على الأرض السورية وزيادة عتادها وعديدها العسكري، قبل إسقاط طائرة «سوخوي» وبعده، لتدحض الاتهامات الموجهة إليها بأنها تسعى الى تثبيت نفوذها في بلاد الشام، وتبرر بذلك اعتراضها على الطموحات التركية بالنفوذ في سورية، فهي ليست في وارد القبول بتنافس الدول على من يفوز في الميدان السوري.
تبعد موسكو عنها تهمة تجاهل مصالح تركيا ودورها واستبعاد السلطان الجديد من المشاركة بالحلول في سورية بإعطاء بعد سياسي آخر لاختيار أنقرة المواجهة معها، هو السعي الى إجهاض عملية التفاوض في فيينا وإفشالها، والتي كان في أولوياتها التعاون لمكافحة الإرهاب، بالتوازي مع السعي الى إنجاح العملية السياسية بين النظام والمعارضة في سورية.
وفيما ينظر كثر إلى الصراع المفتوح بين موسكو وأنقرة على أنه أجهض الهدف التركي بإقامة منطقة آمنة في شمال سورية، بالتوازي مع الحل السياسي الذي يجب أن يقود الى إبعاد بشار الأسد من السلطة، فإن الجانب الروسي يستهزئ بتكرار رجب طيب أردوغان الدعوة الى رحيل الرئيس السوري.
«لقد سئمنا الكلام عن إزاحة الأسد لأنه يعرقل العملية السياسية، ولا نريد التحدث بعد الآن في هذا الموضوع، حتى مع الأميركيين، الذين نتفق معهم على خطوات يمكن تحقيقها، بدءاً بالحوار بين الفرقاء السوريين وفقاً لبيان جنيف1 وتوجيه الأمور نحو إجراء انتخابات هي التي تحدد من يبقى أو لا يبقى في السلطة». وإن لم يحصل تقدم يدفع واشنطن الى وقف المطالبة برحيل الأسد، فإن موسكو تراهن على أن يقود تزايد التفهم الأوروبي، وآخره التفهم الفرنسي، لوجوب محاربة الإرهاب من السوريين، معارضين وموالين للنظام، في ظل وجود الأسد، الى تعديل في الموقف الأميركي. وترمي موسكو الى أن تقابلها دول الغرب الموقف وفق المعادلة التالية: «إذا افترضنا أننا نريد بقاء الأسد في السلطة، فنحن لا نمارس ضغوطاً حتى يبقى، فيما الدول الغربية تريد رحيله وتضغط لأجل ذلك، ونحن نريدها أن تكف عن هذا الضغط وتترك الأمر للعملية السياسية السورية…».
لكن الأهداف الروسية المرحلية في سورية والتي تشمل مواجهة النفوذ التركي، تتناقض مع التعايش الروسي مع النفوذ الإيراني في سورية، بل إن الرئيس فلاديمير بوتين أكد التطابق مع طهران أثناء زيارته إياها قبل أسبوعين.
لا تفسير لاستعداد موسكو لتصعيد المواجهة مع أنقرة سوى أنها تستخدم النفوذ الإيراني في مواجهة الطموح التركي إلى النفوذ، على رغم تأكيدها أن التعاون مع طهران لأجل الحل السياسي في سورية لا يعني «أننا في محور الممانعة»، وأنها لا تنسق مع قوات «الباسيج» والميليشيات المدعومة من طهران، وتترك الأمر للسلطات السورية أن تنسق معها، لأن هذا شأنها «السيادي».
خطورة التحالف الروسي – الإيراني/ رندة حيدر
برزت في الآونة الأخيرة نقاشات داخل أوساط عسكرية رفيعة المستوى في إسرائيل عكست بداية تحول في السياسة الإسرائيلية إزاء التدخل الروسي في سوريا، وبصورة خاصة التحالف مع الإيرانيين لمحاربة تنظيم “داعش” هناك.
النقطة المهمة الأولى التي تجذب الانتباه التحذيرات التي وجهها كلُ من وزير الدفاع موشيه يعلون من خلال مداخلته في مركز صبّان الأسبوع الماضي، ورئيس أركان الجيش غادي إيزنكوت في ندوة مغلقة عُقدت في إسرائيل، من تخلي الولايات المتحدة عن القيام بدور أكثر فاعلية في الحرب ضد “داعش” في سوريا وافساحها في المجال لتعاظم الدور الروسي و”المحور الشيعي” بقيادة إيران والذي يشكل خطراً ملموساً على إسرائيل أكبر من خطر “داعش”.
تعكس هذه التحذيرات مخاوف إسرائيل من نتائج التدخل العسكري الروسي في سوريا على رغم التفاهم بين الطرفين المتعلق بنشاط سلاح الجو الروسي بالقرب من الحدود الإسرائيلية. وثمة اقتناع بدأ يتبلور داخل إسرائيل بأن الانجازات العسكرية التي حققها التحالف في سوريا ستؤدي حتماً الى تقوية محور إيران – “حزب الله” الأمر الذي يهدد إسرائيل مباشرة. الى جانب تخوف الإسرائيليين من امكان أن يغلّب الروس على الأمد البعيد مصالحهم وتحالفهم مع الإيرانيين على تفاهماتهم مع إسرائيل. صحيح أن خطر البرنامج النووي الإيراني لم يعد في طليعة المخاطر التي تتهدد إسرائيل، لكن تعزيز إيران مواقعها في سوريا عبر وجودها العسكري البري على الأرض المدعوم من الطيران الروسي بدأ يتحول الى مصدر قلق حقيقي. ويبدو ان الهدف الذي تسعى اليه إسرائيل الآن هو الحؤول دون أن تؤدي الحرب على تنظيم “داعش” الى تعزيز قوة ما يسميه الإسرائيليون “المحور الشيعي الراديكالي”، والسعي الى اقناع الأميركيين بأن محاربة الراديكالية السنية المتمثلة بـ”داعش” يجب ألا توقف الحرب على الراديكالية الشيعية.
النقطة الثانية في مواقف المسؤولين الإسرائيليين تشديدهم على انه من دون عملية برية واسعة النطاق ضد “داعش” لا مجال للانتصار في الحرب عليه. وهذا في رأيهم لا يمكن أن يحصل بالاستعانة بقوات الحرس الثوري الإيراني التي دخلت سوريا في أيلول الماضي، ولا بقوات “حزب الله”، كما من الصعب ان ترسل روسيا قواتها البرية، لذا فالمطلوب دور أميركي فاعل لتسليح قوات كبيرة محلية سنّية وقيادتها في الحرب على “داعش”.
دعوة إسرائيل الولايات المتحدة الى دور فاعل أكبر في الحرب على “داعش” مؤشر لعدم ثقتها بالدور الذي تلعبه روسيا حالياً وعلى تخوفها من انعكاسات التحالف الروسي – الإيراني عليها مستقبلاً.
ذرائع الحل العلماني الروسي للأزمة السورية/ محمد زاهد جول
شهد العالم في الأيام القليلة الماضية أحداثاً كبيرة، قد تكون بينها روابط مقصودة أو غير مقصودة، وما يقرر ذلك هي المعلومات الصحيحة عن الأحداث.
وهي غالبا ما تكون نادرة، ولذلك قد يكون المصدر الثاني التصريحات السياسية للرؤساء والوزراء والبيانات الرسمية التي تصدر بعد المؤتمرات والاجتماعات الرسمية، وما يصدر عن المؤتمرات الصحافية عن كبار المسؤولين، واخيرا ما يصدر عن بعض الصحافيين والمحللين في الصحف العالمية الكبرى، التي في الغالب تستند إلى معلومات قريبة من دوائر القرار أو أجهزة الاستخبارات المعنية بهذه الأحداث، وتعمل للاستفادة منها، من خلال تمرير معلومات تصب في استثمار هذه الأحداث. أما الأحداث التي وقعت في التطورات الأخيرة فهي كثيرة، ومنها الأعمال الإرهابية التي وقعت في تركيا ومصر ولبنان وفرنسا وسوريا وغيرها، والتي اتهم بها تنظيم «الدولة الإسلامية ـ داعش»، أو التي تبناها هذا التنظيم بنفسه، وقد بدأت هذه الأعمال في تركيا باستهداف محطة قطارات في العاصمة التركية انقرة، وإسقاط الطائرة الروسية بتفجير قنبلة فوق سيناء المصرية، وتفجيرات الضاحية الجنوبية في العاصمة اللبنانية بيروت، وتفجيرات باريس.
وقد أعقب هذه التفجيرات العالمية والمؤتمرات الدولية، العدوان الروسي بانتهاك الطائرات الروسية الحربية للاجواء الجوية التركية، ما اضطر تركيا إلى إسقاط إحداها وهي لا تعرف هويتها، ما وتر العلاقات السياسية بين روسيا وتركيا، والرد على كل التهم الروسية بأن تركيا تدعم تنظيم «داعش» بإثبات أن العكس هو الصحيح، حيث أكد الرئيس التركي أردوغان يوم 2015 /11 / 27 أن الشركات الروسية هي التي تشتري النفط من «داعش» وتبيعه إلى نظام الأسد، وقال أردوغان إن هذا مثبت بالوثائق في الخزانة الأمريكية. أما المؤتمرات المهمة فمنها، انعقاد مؤتمر فيينا الثاني لحل الأزمة السورية بحضور 17 دولة، ويدعي القائمون عليه بأنه تم الاتفاق على خريطة طريق، لإقامة حكومة انتقالية خلال ستة أشهر، وإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية خلال ثمانية عشر شهراً، ومؤتمر قمة العشرين بعده بيوم واحد في مدينة انطاليا التركية يومي 15 و16 نوفمبر 2015.
ولعل الحدث الأبرز في هذه الأحداث، التي تجمع بينها جميعا الأزمة السورية، فكل التفجيرات السابقة قام بها تنظيم «داعش»، وداعش منظمة إرهابية عمل الديكتاتور السوري بشار الأسد على إيجادها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، لتشويه صورة الثورة السورية، وكان سلوك «داعـــــش» قبل الغــــزو الروسي لسوريا وبعده لا يظهر عداء ولا صراعاً مع قوات بشار الأسد، ولا يستهدفون الوجود الروسي في سوريا، بل ذكرت مصادر للجيش السوري الحر أن قوات التنظيم كانت تهاجمهم بغطاء جوي روسي، وهذا يكذب الدعوى الروسية بأن روسيا تدخلت عسكريا في سوريا لمحاربة «داعش».
المشكلة الحقيقية في المنطقة التي تربط كل هذه الأحداث مع بعضها هي أن بشار الأسد استدعى كل دول العالم لتقاتل في سوريا، حتى تدخل سوريا هذا التيه الدولي ولا تتخذ قرارا صائبا في إنهاء وجوده في السلطة، فكلما اتفق العالم على ضرورة تنحيه عن السلطة، وقعت تفجيرات كبيرة في إحدى العواصم الأوروبية أو العالمية، لإثبات أن الجهود يجب ان تنصب لمقاتلة «داعش» التي تتبنى هذه التفجيرات، وليس محاربة الأسد ولا إسقاطه من السلطة، بحسب زعمه، بل وصل به الحال ادعاء أنه في خط الدفاع الأول ضد الارهاب وضد داعش، كما تقوم بهذه الدعاية المفضوحة من وسائل الإعلام التابعة لإيران ومحورها الطائفي في العراق ولبنان وقنواتها الفضائية. هذا التيه شتت الجهود الدولية في مؤتمرات جنيف منذ نهاية عام 2011 ، سواء لتشكيل مجالس باسم المجلس الوطني أو الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، أو مؤتمرات لجامعة الدول العربية، أو لدول أصدقاء سوريا، أو مؤتمرات جنيف، أو الأمم المتحدة ومجلس الأمن، وصولاً إلى مؤتمر فيينا الذي تتزعمه القيادة الروسية، وهي الدولة الغازية لسوريا بطائراتها وجيشها، وتحاول أن تهيمن على سوريا عسكريا أولاً، وأن تهدد دول الجوار بقوتها العسكرية ثانياً، والانفراد بالحل السياسي ثالثاً، ظانة أن قوتها العسكرية سوف تمنحها القضاء على فصائل الثورة السورية والجيش السوري الحر، وبالتالي تجعل كل أطراف الصراع داخل سوريا وخارجها لا تستطيع الاعتراض على الحل الذي ترسمه روسيا لسوريا المستقبل، حتى جاء إسقاط الطائرة الروسية من قبل الطائرات التركية، ردا على انتهاكها للمجال الجوي التركي، ولم يتوقف الرد التركي على اسقاط الطائرة، بل طالبت تركيا من روسيا الاعتذار عن هذا الانتهاك، فبدا الموقف التركي متحديا للغطرسة الروسية في المنطقة، وهذا الرد لن يتوقف في مستواه العسكري وهو الأعلى، بل سيمتد إلى مستواه السياسي، بحيث لن تستطيع روسيا تحقيق أحلامها، ولا فرض الحل السياسي في سوريا وفق هواها.
المشكلة في سوريا لم تعد مشكلة ثورة شعبية مع نظام استبدادي فقط، وإنما مشكلة دولية، تسعى الدول الكبرى لحسمها لصالحها، وبطريقتها العسكرية الخاصة، وبمؤتمراتها السياسية الخاصة أيضاً، فأمريكا منذ السنة الثانية للثورة منعت فصائل الثورة السورية من حسم معركتها العسكرية مع نظام بشار الأسد، بعد أن اضطرت الثورة السورية إلى استعمال السلاح وهي تدافع عن نفسها، فقد انتصر الشعب السوري في ثورته على نظام بشار الأسد منذ منتصف عام 2012، ولكن الدول الكبرى، وفي مقدمتها أمريكا خدعت الشعب السوري بمنع الأسلحة النوعية عن الثورة السورية أولاً، وتآمرت عليه في مؤتمر جنيف ثانياً، فلم تعمل ولم تضغط لتنفيذ قرارات «مؤتمر جنيف1»، الذي نص على حكومة انتقالية بكامل الصلاحيات، وتراخت امريكا أمام رفض روسي مزعوم، لأن أمريكا كانت لا تريد ان تنهي الحرب في سوريا، بل سمحت لإيران منذ منتصف 2012 ولحرسها الثوري والميليشيات التابعة لحزب الله اللبناني بالتدخل في سوريا والعمل على تغيير موازين القوى العسكرية فيها، واحتلال المواقع التي تسيطر عليها فصائل الثورة السورية، التي حررتها من نظام الأسد في الانتصارات السابقة، فبقي الحرس الثوري الإيراني يعيث في سوريا الفساد ويقتل الشعب السوري ويهلك الحرث والنسل، لأربع سنوات بدون أن يتمكن من الانتصار.
وبعد فشل مؤتمر واتفاق جنيف الأول والثاني، بفعل الاحتلال الإيراني لسوريا، جاء الحديث عن مؤتمر فيينا، وقبل أن يتوصل مؤتمر فيينا إلى اتفاق، بل قبل انعقاد مؤتمره الأول كان الاحتلال الروسي قد دخل سوريا، فمؤتمر جنيف الذي قادته في مراحله الأولى وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون وكوفي عنان، وصل إلى طريق مسدود بعد الاحتلال الإيراني لسوريا، وبسبب عدم وجود قوة دولية ضاغطة على حكومة بشار الأسد بقبول حكومة انتقالية بكامل الصلاحيات، بينما روسيا قالت على لسان وزير خارجيتها لافروف، قبل مؤتمر فيينا، بأن مستقبل بشار الأسد غير مطروح للنقاش، وهكذا أصبحت المؤتمرات الدولية مجرد أداة لزيادة التيه في سوريا.
أما تقارب وقوع التفجيرات الارهابية والمؤتمرات السياسية فيمكن الربط بينهما على أساس التحليل السابق، معتمدين على المعلومات الصحيحة أو التصريحات السياسية أو الكتابات الصحافية المهمة، فلا شك أن بعض الأطراف المشاركة في المؤتمرات قد تكون مشاركة في التفجيرات بطرق مباشرة أو غير مباشرة، ولا شك أن بعض الأطراف التي حضرت تلك المؤتمرات كانت مستهدفة بتلك التفجيرات، وقبل المؤتمرات بالذات، وقد تكون بعضها مستفيدة منها أيضا، فإيران التي حضرت مؤتمر فيينا الثاني ولم تحضر مؤتمر قمة العشرين، كانت المستفيد الأكبر من كل التفجيرات التي وقعت في تركيا وفي سيناء وفي فرنسا وفي لبنان وفي سوريا، بل ومن إسقاط الطائرة الروسية وهي تنتهك الأجواء التركية أيضاً، لأنها تجد فرصة لادعاء مصداقية رؤيتها، بأن هناك إرهاباً يضرب النظام السوري والدول الأوروبية، وبالتالي فعلى الدول الأوروبية والعالم مساندة النظام السوري ومقاتلة الارهاب، بحسب زعمها.
إن فشل ميليشيات الحرس الثوري الايراني والعراقي واللبناني في القضاء على الثورة السورية، وفشل الأحزاب الكردية المتحالفة معها في القضاء على «داعش»، شجع الظنون الروسية بأن فرصتها التاريخية لاحتلال سوريا والهيمنة على الشرق الأوسط توفرت، بعد انتظار طويل، وقد جاء الجيش الروسي لمحاولة القيام بهذه المهمة، ولكن امريكا واوروبا وهي تدرك مسبقاً فشل روسيا في قدرتها على تحقيق هذه الأهداف، فإنها لا تنفك عن دعوة الأطراف العربية والتركية للمشاركة في المعارك البرية، والتصريحات الأمريكية في هذا الاتجاه كثيرة، وهو ما أكد عليه وزير الخارجية الفرنسية فابيوس: «بأن فرنسا لن ترسل جنودا لمقاتلة تنظيم الدولة على الارض في سوريا، وأن هذا مناط بقوات سورية ومن الدول العربية السنية»، أي المطلوب أن تشارك القوات البرية التركية والعربية الرسمية بالحرب المشتعلة في سوريا.
الدور الروسي في سوريا، وبتعبير أصح الاحتلال الروسي، لن يزيد الحرب فيها إلا دمارا وقتلا وخسارة، ولن تكون مساعيه السياسية في مؤتمر فيينا إلا خيبة، لأن الروس لم يأتوا لمحاربة «داعش» ولا لإقامة الحل السياسي في سوريا، وإنما لاسترداد سوريا للامبراطورية البيزنطية الأرثذوكسية، ولذلك فإنها سوف تحاول تدمير كل معلم إسلامي بحجة الحل العلماني للصراع السوري، الذي لا تعارضه أمريكا في الاجراءات، ولكنها سوف تعمل لإفشال أهدافه في الهيمنة على الشرق الأوسط، وقد بدأت الدول الأوروبية الكبرى تتحسب له وتزيد من تدخلها في سوريا لمنعه، لأن فرنسا وبريطانيا وألمانيا ستعمل ضد النفوذ الروسي في سوريا، ولكن قدر الشعب السوري أن يواصل قتاله ضد الاستعمار القديم والجديد، وأن يكون الانتصار حليفه، وانتصار الامة التي ينتمي إليها بإذن الله.
كاتب تركي
القدس العربي
بوتين على المسرح التركي/ منى عبد الفتاح
على الرغم من حروب عديدة خاضتها روسيا وتركيا، منذ القرن السابع عشر (1676)، إلّا أنّ ما آلف بين البلدين، عقب فترة الحرب الباردة، كان الوقوف في وجه الهيمنة الأميركية المتصاعدة آنذاك. ولهذا السبب، تغاضت تركيا عن ممارسات الدب الروسي التاريخية، ومنها دعمه العسكري، واعترافه الشرعي بتأسيس إسرائيل، والذي كان سابقاً لدعم الولايات المتحدة لها.
لم يضع هذا الموقف التاريخي الاتحاد السوفييتي في موقف العدو بالنسبة للعالم الإسلامي، بأكثر مما كان عليه، نسبة لتوجهه الإيديولوجي المناقض، لكنه ساهم في لفت الانتباه إلى أنّ الاتحاد السوفييتي يقف عند الطرف المناقض تماماً لدول المنطقة الإسلامية العربية.
من هذه الدول، شذّت سورية، ومن بعدها مصر، باستعانتهما بالاتحاد السوفييتي في نهاية خمسينيات وبداية ستينيات القرن الماضي، طلباً للسلاح. ولم يمنع تأييد الاتحاد السوفييتي قيام دولة الكيان الصهيوني، أيّاً من مصر وسورية من إقامة روابط التعاون والتضامن معه، حتى في ردهات الأمم المتحدة. ولم يكن ذلك لخلو العالم من قوة أخرى، قد تخلق توازناً لهذه الدول الباحثة عن حليف قوي، فقد كانت الولايات المتحدة خياراً بديلاً، خصوصاً بتدخلها في 1956، وعملها على تأمين انسحاب القوات الإسرائيلية والبريطانية والفرنسية من مصر.
التقارب المؤقت بين تركيا وروسيا حكمته الظروف الدولية، فعلى الرغم من عضوية تركيا في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، فإنّ مجافاة الاتحاد الاوروبي لها جعلها تبحث عن حليف إقليمي، متضرر أيضاً من المجافاة نفسها، ويمكن أن يصنعا معاً قوة إقليمية، لكن روسيا انغرست بعيداً باتجاه إيران، على الرغم من الاختلاف الإيديولوجي بينهما، وبعد مقاطعةٍ دامت بين الدولتين زهاء أربعين عاماً. وهو موقف يقوم على التقليدية في صناعة التحالفات، خصوصاً بعدم تأثّر روسيا بالخلاف المذهبي العام بين أغلب الدول العربية السنيّة وإيران الشيعية من جهة، والخاص بين إيران وتركيا من جهة أخرى. كما أنّه لا يخفى عليها ما بين تركيا وإيران من طموح غير مسبوق في إيجاد قوة إقليمية إسلامية، وتنافس حاد واستخدام غير مسبوق لآلية الاستقطاب بالقوة الناعمة. ذلك ما يمكن ترجمته بأنّه يتأسس على خلفية “عدو عدويّ … صديقي”، لا سيما أنّ هذا العدو أصبح شريكاً اقتصادياً لروسيا وعسكرياً في مجال الطاقة النووية.
ذهب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى أكثر من هذه الشراكة، باندفاعه إلى نقد العقوبات
“بعد أن تهدأ عاصفة المقاطعة الاقتصادية، قد تستثمر روسيا الورقتين الكردية والأرمنية في الضغط على تركيا” المفروضة على إيران، والمتمثلة في الحظر التجاري الأميركي منذ 1979، بعد احتجازها رهائن أميركيين. ثمّ تفاقمها، بعد قرارات الأمم المتحدة، لزيادة الضغط عليها إبّان برنامجها النووي، فقد وقف بوتين في العاشر من يوليو/تموز الماضي في مؤتمر صحافي، عقده في ختام أعمال قمة منظمة شنغهاي، مطالباً برفع كل العقوبات عن إيران، ومؤكداً أنّ العقوبات ليست أسلوباً لحلّ المشكلات الدولية، ويجب إلغاؤها من الأساليب الاقتصادية العالمية، لأنّ هذا يقلب النظام الاقتصادي العالمي رأساً على عقب.
وليست تركيا الأولى التي تتعرض لفرض قيودٍ على صادراتها الزراعية إلى روسيا، وإنّما تأتي هذه الإجراءات في سياق التوتر السائد بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة من جهة، وبينه وروسيا من جهة أخرى، بفرض قيود على الواردات الزراعية من الدول، بعد فرض عقوبات على روسيا بشأن الأزمة في أوكرانيا.
ومنذ تشديد العقوبات الغربية على موسكو، على خلفية الأزمة الأوكرانية، تفرض السلطات الروسية، بشكل شبه يومي، حظراً جديداً على منتجات مستوردة من الاتحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة. وغالباً ما تُتهم روسيا باستخدام السلاح التجاري، باتخاذها الأسباب الصحية وحماية المستهلك ذريعة، ووسيلة ضغط دبلوماسية على جيرانها.
يكمن رأي دول حلف شمال الأطلسي (الناتو)، والتي لم يُعِرْها بوتين اهتماماً، حتى وصلت إلى درجة ورودها في تقرير الدفاع البريطاني لعام 2015، في أنّ روسيا تشكّل أكبر تهديد للسلام العالمي، بعد تنظيم داعش. ولا تزال القوى الغربية وتركيا في اختلاف كبير مع روسيا، بشأن مصير نظام بشار الأسد، بينما تصنّف روسيا كل معارضي نظام الأسد بالإرهابيين.
لا تستطيع روسيا التمادي في فرض عقوباتٍ على تركيا، خوفاً من ردة الفعل التركية، والمتماسكة إلى الآن، لأنّه في وسعها مبادلة المقاطعة بمقاطعة مماثلة، ومبدئياً هي قطع علاقات الطاقة مع روسيا، ومنع دخول الشاحنات والحاويات القادمة من روسيا باتجاه البوابات الحدودية والموانئ التركية، كما سيشمل ذلك جميع الواردات الروسية، بما فيها الواردات القادمة من دول أخرى عبر روسيا.
لا شكّ في أنّ وقف عدد كبير من الاتفاقيات، وانقطاع العلاقة بين البلدين ستحيق بروسيا خسارة اقتصادية كبيرة، قد تتحول، على المدى الطويل، إلى أحادية الجانب، في ضوء البدائل الخليجية المتوفرة لتركيا. والذي يجعل هذه البدائل تتيح حلّاً متكاملاً في الوقت الراهن، هو توحّد الرؤية المشتركة بين تركيا وقطر والسعودية في الموقف من الحرب السورية.
وما يضاعف الخسارة على روسيا أنّ بوتين بدأ، بالفعل، في ذرّ الرماد في العيون، باختلاق قصص وشائعات، أقرب إلى قصص جلسات الندامى، وهي نشر صورة لأردوغان مع رجلين ملتحيين، هما عاملا مطعم من عموم الشعب التركي. تبدو محاولة الإعلام المقرّب من بوتين بائسة جداً، في استخدام هذا النوع من الإثارة، وحبك قصة حول صورة في بلد غالبية أهله من المسلمين، فإشارة النظام الروسي، هنا، ليست إلى علاقة مزعومة فقط مع داعش، وإنّما محاولة للاستفادة من حالة الاحتقان الغربي، بعد حادثة باريس، ضد كل ما ينتمي إلى الإسلام، خصوصاً في شكله المظهري، سواء أكان باللحى أو الحجاب.
على الجهة الأخرى من هذه الأزمة، وبعد أن تهدأ عاصفة المقاطعة الاقتصادية، قد تستثمر روسيا الورقتين الكردية والأرمنية في الضغط على تركيا. فبينما تصنّف تركيا حزب العمال الكردستاني تنظيماً إرهابياً محظوراً، نجد أنّ موسكو تدعم هذه المليشيات الكردية. أما الورقة الأرمنية، فهي مواصلة لدعم أنقرة للأذريين في مواجهة الأرمن الذين تدعمهم موسكو، كما حدث في أزمة (ناغورني كارباغ).
على الرغم من تهوّر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، فإنّه يُستبعد تصعيد الأمور إلى أكثر من هذا الحد الذي قد تأخذ تداعياته أبعاداً أخرى، نظراً لاعتماد البلدين على بعضهما بعضاً. أما التعاطي مع الأزمة خارج نطاق الدولتين، فقد كان مبنياً على أسلوب بوتين المعروف بإيجاد مناطق توتر جديدة، عندما يتم التضييق عليه، وهنا إيجاده مسرحاً جديداً بعيداً عن الأراضي السورية.
عندما يخرج البلدان من هذه الأزمة، سيكون بوتين قد تعلّم درساً، هو أنّ مواجهة تركيا تعني دخول “الناتو” في المواجهة، وسيكون مهدّداً باشتعال حرب أخرى بين دول الحلف، بما فيها تركيا وبين بلده. ولكن، ما أحوج بوتين إلى قواته التي يتبختر بها مناصراً الأسد.
العربي الجديد
الحوار مع بوتين لا بشار/ محمد عبدالله العوين
انتهى مؤتمر المعارضة السورية في الرياض إلى نتائج ممتازة بعد أن تداول أبرز رموز المعارضة السياسية التي مثلها مائة مشارك وأبرز الفصائل المقاتلة التي مثلها خمسة عشر فصيلاً، وغاب أو اعتذر عدد ممن دعوا؛ لأسباب شتى، ولكن ذلك لم يغير من إيقاع هذا اللقاء الممتاز الذي لم يحدث أن تفوق الحوار فيه إلى هذه الدرجة من الاتفاق على الخطوط الرئيسة التي يطالب بها أغلب المعارضين؛ ولكنهم يختلفون في الكيفية التي يمكن بها تحقيق هذه المطالب.
لم يُدع بطبيعة الحال من تلوث بالفكر الإرهابي ومارسه على الأرض وراح ضحية ضلالاته آلاف الأبرياء من السوريين وغيرهم؛ كتنظيم داعش الذي لم تعد ولاءاته الاستخباراتية خافية على المتابع الفطن، وكجبهة النصرة التي تعد امتدادًا لفكر القاعدة وأطروحاتها وممارساتها الإرهابية على مستويات عربية ودولية.
ويجدر بنا أن ندون عددًا من النقاط المهمة بعد إعلان وثيقة الرياض؛ باعتبار أنها ستكون الآن المرجعية الرئيسة التي ستنطلق منها الخطوات السياسية القادمة بدءًا من مؤتمر نيويورك الذي سيعقد في الثامن عشر من ديسمبر، ومؤتمر فيينا الذي سيعقبه بعد فترة لن تطول.
1 – اتفق المؤتمرون في بيانهم على أنه لا مكان لبشار الأسد في المرحلة القادمة، وعلى تنسيق الجهود وتوحيدها في المرحلتين الانتقالية والسياسية، ويعنى بالأولى تشكيل حكومة مؤقتة تدير الأمور قبل تخلي بشار عن السلطة بصورة نهائية، وتعني الثانية إجراء انتخابات لاختيار رئيس جديد للبلاد.
2 – تم الاتفاق أيضًا على تشكيل وفد يمثل أطياف المعارضة للتباحث مع نظام بشار في مقررات مؤتمر الرياض.
3 – الدعوة إلى إخراج المقاتلين من الحرس الثوري الإيراني وحزب الله والأحزاب العراقية الطائفية المتطرفة المدعومة من إيران والمرتزقة الذين تستجلبهم طهران من أفغانستان وغيرها.
4 – وقف القصف الروسي على المدن والقرى والجماعات الثورية السورية التي تناضل من أجل إسقاط نظام بشار وإعادة بناء سوريا الحديثة، حيث ثبت أن القصف الروسي لا يستهدف داعش قدر استهدافه كل الجماعات والتكتلات القتالية الثائرة ضد النظام.
ربما كانت تلك أهم ما دارت حوله جلسات المؤتمر وتمت الإشارة إليها في مجمل فقرات الوثيقة المهمة التي خرج بها البيان.
لكنني سأسبق الأحداث والتطورات المنتظرة التي ستواجه تطبيق مقررات الوثيقة، وأطرح تساؤلات عدة لا أشك أبدًا أن كل قارئ قد وقف حائرًا قلقًا مندهشًا من بعض التطلعات المثالية التي تضمنتها المطالب السياسية والقتالية.
في البدء ربما كانت رؤية المقاتلين في الميدان أقرب إلى الواقع من آراء السياسيين المعارضين المنظرين خلف طاولات الحوار؛ فالمقاتل يحسب الانتصارات والهزائم وقوة وضعف الخصم بمقدار ما يحققه أو يخسره على الأرض، والسياسي يحسب نجاحاته وإخفاقاته بما يتفق أو يختلف مع آرائه على طاولات المفاوضات.
في كثير من الأحيان يحقق القتال أكثر مما يحققه الحوار، أو لنقل أن النجاح العسكري يفرض التنازلات السياسية، ولذلك فإن أية مطالبات سياسية مثالية دون تحقيق ضغوط عسكرية جلية على أرض الميدان لن تقود الخصم إلى الإذعان، وستظل المطالب حبرًا على ورق وكلمات مجلجلة على منابر الخطابة أو شاشات الفضائيات.
إنني ما زلت مندهشًا من مثالية أن يذهب وفد مفاوض إلى بشار ليطلب منه التنازل عن السلطة والخروج من سوريا بعد المرحلة الانتقالية أو قبلها! وكأن المنتظر أن يستقبل بشار أو من ينيبه وفد المعارضة بالورود والزغاريد!
وإن العجب ليبلغ مبلغه من نفس أي متابع أو قارئ صياغة الوثيقة وكأنها لا ترى الحضور العسكري المهول لروسيا؛ بل كأن روسيا قد قدمت إلى سوريا بقضها وقضيضها لتقضي نزهة أو رحلة سياحية ماتعة ثم تعود أدراجها إلى موسكو!
إن الحل الوحيد لإخراج بشار من سوريا وإعادة بنائها من جديد ليس في الحوار مع بشار؛ بل في الحوار مع «بوتين».
يجب أن نعترف بأن بوتين يدير المعركة الآن ويحكم سوريا وبإشارة سريعة منه يستطيع أن يقول لبشار: ارحل!
لولا القيصر لسقط بشار.
الجزيرة السعودية