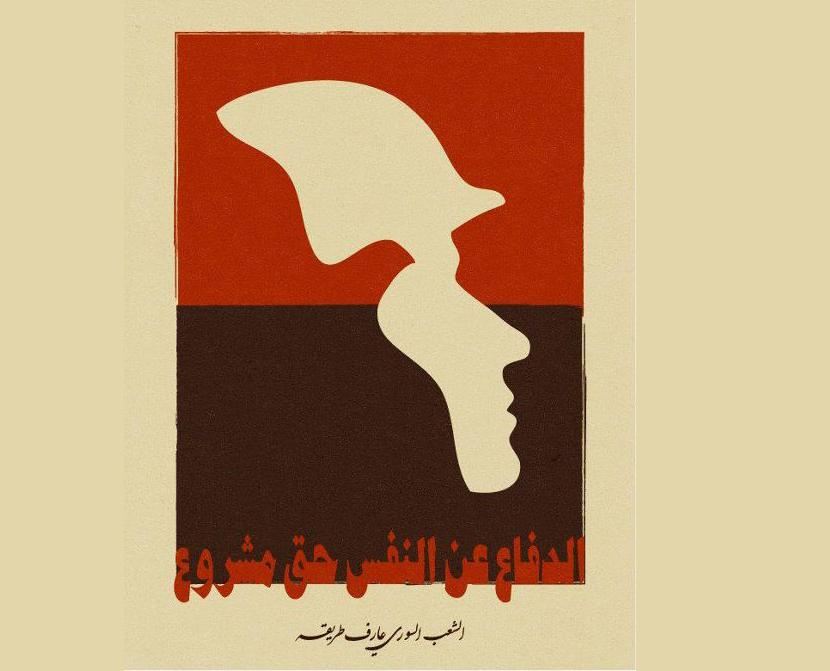التصعيد بين واشنطن وطهران –الاثار والنتائج- مقالات مختارة

عن أفق التصعيد بين واشنطن وطهران!/ أكرم البني
لم يهدأ الرئيس الأميركي دونالد ترامب من إطلاق التصريحات المعادية لإيران، إن في برنامجه الانتخابي أو بعد وصوله إلى البيت الأبيض. وأشدها وقعاً تهديده في شباط (فبراير) الماضي، بضربها عسكرياً، رداً على تجربتها المستفزة لصاروخ باليستي بعيد المدى، وأبرزها سخريته من الاتفاق النووي معها ورفض التصديق عليه ورده للكونغرس، ثم اتهامها كدولة راعية للإرهاب وإدانة دورها التخريبي في المشرق والخليج العربيين، متوسلاً عقوبات بحق منظمات وأفراد يدورون في فلكها، كاقتراحه إنزال عقوبات مفصّلة ضد الحرس الثوري الإيراني، وقبله فرض عقوبات واسعة على «حزب الله»، خلصت أخيراً إلى وضع مكافأة مالية للقبض على اثنين من قياداته، مسؤولين عن العمليات الخارجية.
فما أسباب هذا التصعيد؟ ومن أين يستمد قوته واستمراره؟ وهل يبقى في إطار المعركة الكلامية والتهديدات اللفظية، أم يصل إلى خيارات عملية مجدية تردع طهران وتمنعها من العبث على هواها في المنطقة؟!
إنه تنامي قلق واشنطن على استقرار مصالحها في الشرق الأوسط مع ازدياد رقعة نفوذ طهران وتنوع تدخلها في شؤون بلدان الجوار، ثم شعور البيت الأبيض بالحاجة إلى إرضاء وطمأنة الدول الخليجية الحليفة التي باتت تعاني الأمرّين من السياسة الإيرانية، في رهان ربما نضج بعد زيارة العاهل السعودي موسكو، على تخفيف اندفاعها صوب روسيا كخيار يعوضها من استمرار السلبية الأميركية. يُضاف إلى ذلك خيبة أمل أهم الشركات الأميركية من جني ثمار مجزية من الاتفاق النووي، حيث بدا أن الحكومة الإيرانية والحرس الثوري فضلا مثيلاتها الأوروبية ومنحاها على حساب الأولى الشروط الأفضل للتوظيف والاستثمار، ما يفسر وقوف تلك الشركات ضمناً وراء سياسة الرئيس الأميركي، بينما مال الموقف الأوروبي إلى محاباة طهران وتهويل قلقه من أن يفضي تنصل واشنطن من الاتفاق النووي وتصنيف الحرس الثوري كمنظمة إرهابية إلى تفاقم الاضطراب الأمني وزيادة التوتر في الشرق الأوسط! وإذا أضفنا أيضاً ضغط اللوبي الإسرائيلي مع تزايد إلحاح تل أبيب لردع ومحاصرة الخطر الإيراني الذي اتسع حضوره على مشارف حدودها، يمكن أن نقف عند أهم الأسباب التي تمد بالقوة والاستمرار التصعيدَ الأميركي الأخير ضد إيران.
ثمة من يعطي قيمة كبيرة لهذا التصعيد، ويتوقع أن يخلف نتائج وخيمة، إن استمر، على مستقبل الجمهورية الإسلامية، مرجحاً تفاقمه واحتدامه ربطاً بتأثير الحصار السياسي والعداء الإعلامي والعقوبات الاقتصادية الأميركية على بلد بات يتدخل على نحو انفلاشي في العديد من الأماكن، والقصد أن تضييق منافذ الحياة التجارية والإنتاجية، في ظل تراجع أسعار النفط، يشكل مقتلاً لدور طهران الإقليمي، ويعمق أزماتها الداخلية، فبدون المال الوفير واستجرار السلاح سيتعرض للتفكك والتراجع حلمها الإمبراطوري ومحاولات تصدير مشروعها الإسلاموي، كما قدرتها في الالتفاف على معاناة شعبها، الأمر الذي يفسر إسفافها الرسمي في نعت الرئيس الأميركي بألقاب مذلة ومسيئة، وعبارات التهديد والوعيد غير المتوازنة التي أطلقها بعض المسؤولين الإيرانيين ضد إدارة البيت الأبيض الجديدة ومطالبتهم بتأديبها وتلقينها درساً لا تنساه، ويفسر تالياً، سرعة لملمة الخلافات بين قوى الاعتدال والتشدد، وإشهار عبارات التوافق والدعم المتبادل بين الرئيس روحاني وقادة الحرس الثوري بعد مرحلة من التنابذ وتبادل الاتهامات. هذا يعني أن حكومة طهران، والحرس الثوري بوصفه المؤسسة الأقوى والقابضة على جُل الاقتصاد الإيراني، يقدران جيداً خطر الجديد الأميركي على المصلحة الجمعية، وهما يتحدان علناً لمواجهته أياً تكن النتائج، وربما يندفعان لتحريك بعض أدواتهما في عمليات انتقامية، مغلفة بعباءة الجهادية الإسلاموية، تطال مدناً أوروبية وأميركية، ثم تفعيل حروب بالوكالة لطالما اعتمداها، وتشجيع «حزب الله» كي يسخّن الأجواء مع إسرائيل، والأمل من كل ذلك حرف بوصلة الرأي العام وإعادة بناء الاصطفافات والمواقف.
بينما يعتقد آخرون واستناداً إلى محطات مشابهة، بأن ذلك التصعيد المتبادل لن يندفع نحو صراع واسع ومباشر، فنظام طهران يتحسب ويخشى اتباع هذ الخيار، ولا يرجو من تهديداته الصاخبة سوى التخفيف من حدة التصعيد الأميركي، بينما تعي واشنطن جيداً جدوى الاكتفاء بتشديد العقوبات في ظل ما تعانيه طهران اقتصادياً، وربما، هي وليس إيران، من يمتلك من الأدوات والفرص لإشغال خصمها واستنزافه، وثمة ساحات عدة يمكن أن تكون أماكن للمعارك بالوكالة بينهما، كالعراق وضمناً الساحة الكردية واليمن وسورية، وربما تبادر إن استدعت التطورات، إلى الاستعانة، عبر لبنان، بالعصا الإسرائيلية كسلاح ناجع اليوم لتبديل المشهد، ربطاً بحالة العزلة التي يعانيها «حزب الله» والخسائر الكبيرة التي مُني بها في سورية، وما تراكم في المجتمع اللبناني من متغيرات تضيق موضوعياً هامش مناورته، والأهم فقدانه ورقة المظالم الفلسطينية بعد المصالحة التي جرت بين حماس والسلطة الفلسطينية.
ويسأل أصحاب هذا الرأي: ألم يختبر «الشيطانان» الأكبر والأصغر أحدهما الآخر بما فيه الكفاية؟ أولا يصح القول أن أحداً منهما لم ولن يفعل ما يضر جذرياً بمصالح الآخر في المنطقة، وإن تنازعا على بعض الحصص والنفوذ؟ وأيضاً ألا يصح الاستنتاج بأن مناخ التوتر والتصعيد بينهما لن يفتح على المجهول بل سيبقى تصعيداً كلامياً تحدوه عقوبات اقتصادية في محاولة أميركية لانتزاع بعض النقاط؟ ثم ألم تتمرس طهران جيداً في طريقة معالجة أزماتها مع واشنطن وفق نهج مزدوج يجمع بين التهديدات اللفظية وتقديم جرعات غامضة من التنازلات، ويجمع تالياً بين خطاب شعبوي ينادي بالموت لأميركا موجّه إلى الشارع الغارق في أزماته، وبين الإنصات باهتمام إلى مطالب الولايات المتحدة؟ والأهم أليس من صلب مصلحة طهران اليوم عدم توسيع معاركها قبل هضم ما حققته من نفوذ، بل تسخير القنوات الأوروبية والحليف الروسي لتمرير رسائل ومواقف تخفف حدة التوتر وتفتح الباب على فرص بناء تفاهمات خفية مع إدارة البيت الأبيض الجديدة؟!
الحياة
لكنْ ما الذي تريده إيران حقاً؟/ مصطفى كركوتي
ثبت بعد أربعة عقود تقريباً على ثورة آية الله الخميني في 1979 أن إيران- الدولة وإيران- الثيولوجيا غير قادرة على تحقيق اختراق سياسي وفكري ملموس قابل للاستمرار، لا في محيطها الإقليمي المباشر ولا في الفضاء العالمي الأوسع.
ربما حققت طهران «نجاحاً» في العراق، ولكن هذا النفوذ لم يعد على بلاد الرافدين التي تدميها حروب طاحنة منذ مطلع الثمانينات إلا بمزيد من فقرٍ مدقع وبلاءٍ لا قعْر له. هذا النفوذ، في كل حال، ما كان له أن يحدث لولا وجود فراغ نَجمَ عن انسحاب واشنطن من العراق بقرار إدارة باراك أوباما.
ولا شك أيضاً في أن وجود حاضنة سياسية للنخبة الحاكمة في بغداد ساهم كثيرا في نجاح النفوذ الإيراني في العراق حتى الآن، ولكن هذا النفوذ لم يجد حظاً له في مناطق أخرى في الإقليم على رغم إصرار طهران على التدخل المباشر فيها. عملياً لم تقدم القيادة الإيرانية على تنوع شخصياتها وعلى مدى العقود الأربعة، أي مساهمة إيجابية في عملية التنمية البشرية أو الاقتصادية أو السياسية في أي من المناطق التي تتدخل فيها.
بعيداً من موقف الرئيس الأميركي ترامب الأخير من اتفاقية الملف النووي، وهو موقف يتعارض مع الأطراف الأخرى الموقعة عليه، غالبية المخططين لسياسة أميركا الخارجية لا تزال تشعر بعدم قابلية إيران للانفتاح -ولا نقول التصالح مع- الغرب بشكل عام. فالاعتقاد السائد بوجود تنافس سياسي داخلي بين «متشددين» و»معتدلين» داخل منظومة الحكم في إيران ليس دقيقاً.
فالمرشح للانتخابات يجب أن يحظى بمباركة مجلس تشخيص مصلحة النظام، وهو مجلس فقهاء دين غير منتخب، وأن يكون مؤيداً لأسس ثورة الجمهورية الإسلامية. وهذا يعني أن جميع المرشحين «متشددون» في إطار نظام حكم متجانس. وينسحب هذا على مرشحي الرئاسة، إذ إن فوز هذا المرشح أو ذاك لا يعتمد بالضرورة على شعبيته بمقدار اعتماده على رضاء القائد الأعلى علي خامنئي. فعلى رغم تغير الرئيس يبقى خامنئي صاحب القرار الأخير دائماً. وهناك أيضاً هيئة أعلى هي «مجلس صيانة الدستور» الذي ينحصر دوره بتصديق ما يراه مناسباً من قرارات مجلس الشورى (البرلمان) قبل أن تتحول إلى تشريعات.
الرئيس حسن روحاني معتدل إذا ما قورن بسلفه أحمدي نجاد وقد، فاز في أيار (مايو) الفائت بدورة رئاسية ثانية. لكن الرجل لم يفعل أي شيء يستحق الذكر على صعيد تحسين حقوق الانسان كما أنه فشل في سحب «اعتداله» على سياسة بلاده الخارجية.
ففي عهد ولايته الأولى دفعت بلاده بوحدات مختلفة من وحداتها الخاصة، لا سيما قوات «الحرس الثوري»، وبأعداد كبيرة، نحو سورية لحماية وإنقاذ نظام الرئيس بشار الأسد، واستخدمت في هذا المجال، وبوحشية موثقة، ميليشيات حزب الله اللبناني للمساهمة في هذا المسعى المعادي لرغبات أغلبية السوريين. كما قامت إيران في عهد روحاني بتقديم مــساعداتها المباشرة لميليشيات الحوثي في اليمن وتحشيد ميليشيات مذهبية في العراق. وتفيد معلومات نشرت في الغرب بأن «الحرس الثوري» يواصل تطوير تكنولوجيا تصنيع صواريخ باليستية متوسطة المدى في تهديد مباشر لدول الإقليم.
طهران تقول إن تطوير هذه الأسلحة هو لحماية إيران، ولكن هذا يتناقض مع توسع سياستها في الإقليم ووضع طاقاتها لتمويل تلك السياسة. صحيح أننا نسمع أصواتاً تقول إن هكذا صواريخ تستهدف إسرائيل، ولكن هذه الأخيرة ليست في اشتباك مباشر مع إيران (ولا حتى مع حزب الله بالمناسبة) منذ 2006، إذ باتت لطهران سياسة إقليمية تغطي مساحة كبرى تمتد من مرتفعات أرارات في الأناضول حتى الخليج والبحر الأحمر، وهي مساحة يتحدث عنها المسؤولون الإيرانيون في تصريحاتهم بين حينٍ وآخر. لقد تم التأكد أخيراً، جراء سياسة إيران الراهنة في الإقليم، من أن شعاري «الشيطان الأكبر» و «الشيطان الأصغر» ليسا إلا للتضليل والاستهلاك المحلي.
هذه الوقائع توضح قطعاً أن إيران ليست مستعدة- أو أنها ترفض- اتباع نهجٍ سوي في علاقاتها الإقليمية أو الدولية. ويخطئ من يفسر تنسيقها أخيراً مع تركيا وروسيا في المنطقة كإعادة نظر في سياستها الخارجية، إذ هو ليس إلا مجرد تحالف الضرورات الذي لا يلبث أن يضمحل بنفس السرعة الذي تشكل من أجلها.
هذا يحدث في وقت يدخل فيه الإقليم في خضم دورة دموية يخشى كثيرون أنه بات من المستعصي السيطرة عليها، فضلاً عن أنها ترهق بسرعة كبيرة اقتصاديات وثروات بلاده جميعاً، كما تهدد بتجفيف موارد الدول الكبرى المتورطة في الإقليم.
الحروب في المنطقة وغياب فرص التنمية الاقتصادية المستدامة (العدالة والمساواة وفرص العمل والتعليم إلخ)، حوّلت المنطقة إلى أرض خصبة للإرهاب والتطرف. والاستقرار المنشود لن يتحقق فيها ما لم يسد نظام إقليمي تتوازن فيه قواه الرئيسية، وما دامت طهران تواصل سياستها الراهنة ومغامراتها في أكثر من بلد عربي فإن المنطقة ستبقى معرضة للاضطراب وخطر التفتت.
إيران، وهي ركن أساسي في المنطقة، في مسعاها لدرء الأخطار عن أمنها كما يقول مسؤولوها، لا يمكن أن يسمح لها بتجنيد ميليشيات مختلفة من شيعة العراق ولبنان وأفغانستان وباكستان وأذربيجان، فضلاً عن «الحرس الثوري»، لخوض حروبها في المنطقة وضد شعوبها. صحيح قد لا يكون اقتصاد إيران قد دخل في مرحلة حرجة بعد بسبب مواردها الغنية، لكن كلفة تحشيد هذه القوى تأتي على حساب رخائها الاقتصادي بالتدريج.
هذه السياسة لن تصل بإيران إلى بر الأمان ولن تحقق لها بالضرورة الاستقرار الذي تتحجج نخبها السياسية بأنه يتعرض للتهديد. وعلى هذه النخب أن تنظر حولها كيف أن دولة عظمى مثل الاتحاد السوفياتي، انهارت بسرعة نتيجة سياستها التوسعية، لا سيما إثر تدخلها العسكري في أفغانستان.
ما تحتاجه إيران وما يتطلع نحوه الإيراني العادي، مثلما هو حال شعوب المنطقة الأخرى، هو الاستقرار والأمان كشرط حيوي نحو تحقيق النمو الاقتصادي. وهذا لن يحدث من دون الانفتاح على دول العالم الأخرى صاحبة الثروة والمال، والتعاون مع دول الإقليم على أساس احترام حقوق كل أطياف شعوبها.
الحياة
أخطار إطاحة الاتفاق النووي مع إيران/ جيفري لويس
تصدّر وصف دونالد ترامب في مجلس الأمن كيم يونغ أون بـ «رجل الصواريخ» وتلويحه بتدمير كوريا الشمالية اذا استفزت أميركا، العناوين. ولكن، والحق يقال، ان تلويح ترامب بالانسحاب من الاتفاق الإيراني النووي، هو أكثر ما يبعث على القلق. ورد الرئيس الإيراني، حسن روحاني على التهديد بالقول إن بلاده إذا أخلّت أميركا بالاتفاق وانسحبت، تكون مطلقة اليد في الإقدام على ما يخدم مصالحها. وهذه الأجواء تعيد الى الأذهان لحظة ابتعاد واشنطن عن الاتفاق النووي مع كوريا الشمالية في 2002، وإطاحتها أمثل فرصة لإحباط البرنامج النووي الكوري الشمالي. وأوجه الشبه بين الاتفاق المبرم مع ايران في 2015 وبين نظيره المفاوض عليه مع كوريا الشمالية في 1994، كبيرة.
وبدأت المشكلتان أو القصتان مع طموحات بيونغيانغ وطهران النووية. وفي الحالتين، يعود الفضل في كشف البرنامجين الى القدرات الأميركية الاستخباراتية وعمليات تفتيش وكالة الطاقة الذرية الدولية. فتقنيات الوكالة هذه، مثل فحص عينات بيئية، ضبطت كلاً من الحكومتين على حين غرة، وأماطت اللثام عن برنامج كل منهما النووي في وقت أبكر مما توقعت بيونغيانغ وطهران. وجمّدت كل من بيونغيانغ وطهران برنامجهما النووي نزولاً على ضغوط دولية. واليوم، يدرك المرء دواعي امتثالهما هذا. فالبرنامج الكوري الشمالي، شأن الإيراني، ضُبط قبل اشتداد عوده، ولم يكن يومها النجاح التقني مضموناً ولا كان ثابتاً ان واشنطن لن تلجأ الى قوتها التقليدية الكاسحة لوقف هذين البرنامجين. وإلى أوجه الشبه، تبرز اوجه بتاين واختلاف. فكوريا الشمالية كانت تسعى الى برنامج نووي ركنه البلوتونيوم، في وقت ان برنامج ايران ركنه تخصيب اليورانيوم بواسطة أجهزة طرد مركزية. وأبرمت واشنطن وبيونغيانغ اتفاق اطار نووي في جنيف في 1994، بعد عامين فحسب على اندلاع الأزمة. والأزمة مع ايران دامت سنوات، وأُبرم الاتفاق الشامل في 2015- اي بعد 13 عاماً على الكشف عن منشآت سرية لتخصيب اليورانيوم. ولكن الاتفاقين أجمعا على تسوية متشابهة: رفع طوق العزلة الدولية مقابل وقف دوران البرنامج العسكري (النووي). وارتضت بيونغيانغ وطهران تفتيشاً دولياً، وخوّل الاتفاق كل منهما مواصلة السعي الى قوة نووية سلمية، ولو تحت إشراف مُحكم. وأطلق الاتفاقان سلسلة ردود داخلية في الولايات المتحدة، تحديداً في وسط أولئك الراغبين في مواصلة الضغط على بيونغيانغ وطهران جزاء أسباب اخرى، مثل انتهاك حقوق الإنسان أو تهديد دول الجوار. ووصف السناتور جون ماكين الاتفاق مع كوريا الشمالية والمفاوضات مع ايران بـ «التهدئة». وواجه كل من الاتفاقين محاولات ترمي الى إطاحتهما. فالجمهوريون في الكونغرس ناضلوا من أجل ان تخلّ بلادهم بالتزاماتها مع كوريا الشمالية، فتأخّر تسليمها الوقود الثقيل. وسعى جمهوريون كذلك الى اعادة فرض عقوبات على ايران وإلى عرقلة استئناف الأعمال معها. وزعم معارضو الاتفاقين ان كوريا الشمالية وإيران لم تلتزما بنودهما، وروّجا لأخبار ثبت انها ضعيفة الصلة بالواقع، ومنها انشاء منشآت نووية تحت الأرض في البلدين هذين.
ولا شك في أن الاتفاق (المجهض) مع كوريا الشمالية والاتفاق مع إيران لم يساهما في تذليل المشاكل كلها. فالاتفاقان لم يحظّرا تطوير صواريخ ولا إجراء تجارب صاروخية، على رغم أن خطر الصواريخ تعاظم على أميركا وحلفائها. وفي كوريا الشمالية، برزت مؤشرات إلى شراء باكستان برنامج تخصيب سرّي لليورانيوم. وسعت إدارة كلينتون إلى جبه هذه المشكلات في عملية عرفت بـ «بيري بروسيس» (دعم الاتفاق بإجراءات ديبلوماسية تقف على إنهاء كوريا الشمالية برنامجها الصاروخي). وأوشك بيل كلينتون على إبرام اتفاق صواريخ قبل أن تطيح الاتفاق فوضى انتخابات عام 2000. وما حصل يومها يشبه ما ينصح به بعض الجمهوريين في مواجهة الاتفاق الإيراني.
وأرادت إدارة جورج دبليو بوش استئناف المفاوضات مع بيونغيانغ حيثما انتهت مع إدارة كلينتون. ولكن معلومات استخباراتية جديدة أشارت إلى أن أعمال بيونغيانغ في التخصيب فاقت الحسبان، فانتهز معارضو الاتفاق في الإدارة الجديدة الفرصة للإطاحة به. «هذه المطرقة التي كنت أبحث عنها… لتهشيم اتفاق الإطار (مع كوريا الشمالية)»، كتب جون بولتون، مساعد وزير الخارجية الأميركية حينها، في مذكراته.
ولا يخفى أحد ما جرى. في تشرين الأول (أكتوبر) 2006، استأنفت كوريا الشمالية تجاربها الصاروخية الطويلة المدى بعد أن علّقتها أثناء عملية «بيري»، وأجرت أول تجربة نووية. وأدركت إدارة بوش أنها اخطأت، فاقترحت نسخة معدلة «ومقلصة» من اتفاق الإطار الذي تخلّت عنه، يشمل ما سبق لبوش أن أصلاه نقداً شديداً: تجميد برنامج كوريا الشمالية النووي عوض تفكيكه فوراً وقبول تزويد بيونغيانغ بمفاعل نووي لإنتاج الطاقة. وربما كانت كوريا الشمالية راغبة في مقايضة مشروع سلاح نووي (لم ينجز بعد) مقابل تحسين العلاقات مع اميركا والعالم. ولكن بعد تجربتها النووية الأولى، بدأت فرصة نزع النووي الكوري الشمالي تضيق وتتبدّد. ثم سعى بوش ومن بعده باراك اوباما الى اتفاق مع بيونغيانغ، ولكن جهودهما انهارت ولم تكلل بالنجاح.
والحق يقال إن إقناع بلد بالتخلي عن سلاح نووي لا يملكه بعد أيسر من إقناعه بعد حيازته. لذا، رمت إدارة أوباما بثقلها وراء اتفاق مع ايران التي لم تحز بعد سلاحاً نووياً. وحين كانت تسأل الإدارة هذه عن تفاقم مشكلة السلاح النووي في كوريا الشمالية، لم يسعها القول سوى انها تسعى الى الحؤول دون احتذاء طهران عليها. واليوم، ترامب امام خيارات سبق ان واجهها بوش، فيما خلا تباين واحد: على خلاف كوريا الشمالية وبرنامجها السرّي لتخصيب اليورانيوم، تلتزم ايران الاتفاق المبرم في فيينا، وهذا ما اعلنته وكالة الطاقة الذرية. ولكن مثلما فعل بولتون، ثمة من يبحث اليوم عن «مطرقة». وإذا تخلى ترامب عن الاتفاق النووي مع إيران، ينتظرنا، على الأغلب، مآل سبق لنا اختباره: بروز دولة معادية لأميركا تلوّح بصواريخ مزوّدة برؤوس نووية. ألا يكفينا رجل صواريخ واحد؟
* باحث، عن «واشنطن بوست» الأميركية، 22/9/2017، إعداد منال نحاس
الحياة
سيناريوات حربية بموازاة «إستراتيجية ترامب» ضد إيران/ عبدالوهاب بدرخان
هناك حرب أو حروب صغيرة تتجمّع خيوطها وأسبابها في أجواء المنطقة العربية، ولعلّها الترجمة الفعلية لـ «العاصفة» التي أشار اليها الرئيس الأميركي قبل كشف إستراتيجيته الجديدة للتعامل مع إيران. قد لا تتلازم دوافع دونالد ترامب – «أميركا أولاً» – مع حاجات المنطقة، لكنها تتلاقى في شكل أو آخر، وإذا كانت الأخطار والتهديدات على درجات فلا شكّ في أن إيران هي اليوم أعلاها وأشدّها. وعندما تفجّرت الأزمة النووية كانت طهران وضعت قنبلة ميليشياتها المذهبية في الخدمة، فيما كانت تعمل على إنجاز قنبلتها النووية. واقع الأمر أنه كان ينبغي التعامل مع هاتين القنبلتين كأولويتين وكتهديدين متساويين ينبغي التعامل معهما في آن، لكن باراك اوباما اختار التصدّي للخطر النووي الآجل بالتفاوض على «تأجيل» القنبلة وترك الخطر العاجل، القائم والمتفاعل، بل ساهم في تغطيته، ليحصل على «أسوأ اتفاق» أميركياً، أما إيران فأشهرته كـ «أفضل اتفاق» يبطّن قبولاً لجرائم بقنبلتها المذهبية، بدليل رفع العقوبات عنها، ولا يحرمها نهائياً من قنبلتها النووية.
كان ذلك الاتفاق ترجمة لإرادة سياسية مصممة لدى اوباما بمقدار ما كان ثمرة دهاء المفاوض الإيراني وحنكته. فكل ما كان معلناً خلال عامَي التفاوض اقتصر على مسائل تقنية (نسبة التخصيب، أعداد أجهزة الدفع المركزي، تفكيك المنشآت، المراقبة، الحدّ الزمني…)، لكن اوباما وإدارته استنتجا غداة التوقيع أن الاتفاق سيؤدّي الى تغيير إيران سلوكها الإقليمي، فعلامَ استندت؟ وعندما يقول ترامب وإدارته أن إيران انتهكت «روح» الاتفاق فعلامَ تستند؟ لا يمكن هذه «الروح» سوى أن تكون سياسية، لكن النصوص التقنية لا تعبّر عنها، فأين تلك «الروح» إذاً؟ لا بدّ أنها في محاضر الحوارات الطويلة على هامش المفاوضات، وما يُحتمل أن الطرفين الأميركي والإيراني تبادلاه من تعهّدات لتسهيل التوصّل الى اتفاق تقني بلا أي «روح». في تلك الأثناء، وعلى خلفية المفاوضات، كانت إيران تجني المكاسب: أرواح الآلاف في سورية تُزهق، معاناة ملايين العراقيين تتفاقم، انقلاب الحوثيين في اليمن يتوسّع، تعطيل الدولة للاستحواذ عليها في لبنان يتأكّد، والقلق في عموم الخليج يتصاعد.
لم يتغيّر سلوك إيران في الداخل، أما في الخارج فأطلقت العنان لنهج التخريب وتمزيق المجتمعات، إذ كان هدفها التالي انتزاع الاعتراف بنفوذها السياسي، وقد حصلت على أداتَين جديدتَين: تنظيم «داعش» والحرب الأميركية عليه. ومع أن ادارة أوباما بكل أجهزتها كانت على علم بالعلاقة العميقة بين إيران والنظام السوري مع جماعات الإرهاب، إلا أنها ظلّت رافضة حتميّة مواجهة الاثنين معاً. في «إستراتيجية ترامب» افتراق واضح عن «إستراتيجية أوباما» في كونها تضع دور إيران في دعم الإرهاب وزعزعة استقرار المنطقة بموازاة إشكالية الاتفاق النووي، وتنتقل في تحديد الأخطار من الإشارات الأوبامية السطحية والخجولة الى ابراز السجل الأسود لإيران – الجمهورية الإسلامية من مساهمتها في قتل المئات من الجنود الأميركيين طوال عقود ثلاثة ماضية الى إيقادها العنف الطائفي في العراق وإزكائها الحرب الأهلية في سورية واليمن فضلاً عن تهديدها جيرانها والتجارة الدولية وحرية الملاحة… بمعنى أن «روح» الاتفاق (النووي) كانت تقتضي التعامل مع كل هذه المسائل، ومنها الحدّ من تطوير الصواريخ البالستية الذي كان مثار نقاش وخلاف خلال مفاوضات فيينا.
كل ذلك يبني «قضية» موجودة أصلاً وتتطلّب معالجة جدّية إذا كان استقرار المنطقة العربية ومكافحة الإرهاب هدفَين حقيقيين للقوى الدولية، وبالأخص للولايات المتحدة. و «القضية» كما أصبحت واقعياً، وكما أوضحتها «إستراتيجية ترامب»، لا تنطوي حالياً على مقوّمات تفاوض تريده الولايات المتحدة لتحجيم النفوذ الإيراني وتريده إيران للاعتراف بنفوذها. وثمة معطيات اخرى، كالأزمة الكورية الشمالية والصراع البارد بين أميركا وكلٍّ من روسيا والصين، وكذلك التردّد الأوروبي، تستبعد الضغط (أو التوافق) من أجل حلٍّ تفاوضي. فهذه الأطراف خرجت مستفيدة من الاتفاق النووي أو تنتظر مكاسب جمّدتها القيود الأميركية، وحتى الأوروبيون الذين يمقتون النظام الإيراني ويدركون النتائج الكارثية لتوسّعاته الإقليمية لا يبدون تأييداً لإلغاء ذلك الاتفاق أو لإخضاعه لمعايير واشنطن. لكن»إستراتيجية ترامب» قد تضطرّهم عاجلاً أو آجلاً لتوضيح مواقفهم بالاصطفاف «مع» أو «ضد»، وليست مصادفة أن يذكّر اثنان من المعنيين آنذاك (هانز بليكس رئيس المفتشين الدوليين ومحمد البرادعي مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرّية) بأن الأجواء الحالية مشابهة لما شهداه قبيل غزو العراق واحتلاله. قد يصحّ ذلك، لكن لن يكون غزو أو احتلال هذه المرّة، أما المسرح المرشّح فحدّدته إسرائيل بسورية ولبنان، بتغاضٍ أميركي (وروسي؟)، مع تداعيات قد تمتدّ الى العراق.
المهم في تلك الإستراتيجية أنها الأولى الواضحة في عهد ترامب، وكونها نتيجة توافق بين أجنحة الإدارة، وموضع ترحيب البارزين في الكونغرس (جون ماكين وبول راين). وربّما جاء الأهم في شروح الأطراف التي ساهمت في صوغها، وعلى الأخص وزير الخارجية ريكس تيلرسون الذي قال إن «هذه نهاية اللعبة (مع إيران) لكنها لعبة طويلة الأمد»، مؤكّداً التعامل مع كل التهديدات الإيرانية وليس الاتفاق النووي فحسب، ليخلص الى أن واشنطن تسعى الى «تغيير» النظام الإيراني عبر دعم قوى المعارضة. وفيما أعلن البنتاغون أنه يجري مراجعة شاملة للنشاطات والخطط دعماً للإستراتيجية الجديدة، أكمل مستشار الأمن القومي هربرت ماكماستر بأن ترامب « لن يسمح بأن يكون الاتفاق غطاءً لحكومة مروّعة كي تطوّر سلاحاً نووياً… ونحن نعرف من سلوك الإيرانيين في المنطقة وتجاه الاتفاق بأنهم تجاوزوا الخطوط المرسومة مرات عدّة». أما المندوبة الأميركية في الأمم المتحدة نيكي هايلي فأشارت مجدّداً الى «عدم السماح بأن تكون إيران كوريا الشمالية المقبلة»، على رغم أن ناقدي توجّه الإدارة الترامبية يحاججون بأن زعزعة الاتفاق مع إيران تقوّض احتمالات الحل السلمي للأزمة مع كوريا الشمالية.
من الواضح أن المواجهة مع إيران هي جوهر «إستراتيجية ترامب»، وأنها قد تستدرج حرباً تكاثر الحديث عنها أخيراً. فالأجهزة الإسرائيلية كثّفت أخيراً اتصالاتها مع واشنطن وموسكو، وطرحت أفكاراً في شأن الوجود الإيراني في سورية وحدّدت الخطوط الحمر التي ترفض تجاوزها. إذ لم يعد الاتفاق النووي الأولوية الحالية لإسرائيل بل الحدّ من النفوذ الإيراني. ثمة مؤشّر آخر في سلسلة اجتماعات عقدت أخيراً في واشنطن، بمشاركة سياسيين وعسكريين أميركيين وإسرائيليين، وأخرى حضرها مسؤولون من المؤسسات المالية الكبرى، وكانت الخيارات المطروحة إزاء التوسّع الإيراني محوراً للنقاش. وعلى رغم أن تصنيف الحرس الثوري كجماعة ارهابية بدا ضرورياً إلا أن تبنيه رسمياً من جانب الرئيس الأميركي يُلزمه بإعلان الحرب عليه إسوةً بالتنظيمات الإرهابية الأخرى، ما يعني حرباً واسعة لا تريدها أميركا لأسباب داخلية وخارجية. أما الحرب على «حزب الله» وغيره من الميليشيات الإيرانية في لبنان وسورية، باعتبارها أدوات لـ «الحرس»، فيمكن أن تأخذ فيها إسرائيل زمام المبادرة بموافقة أميركية ضمنية. واللافت أن تقدير المواقف ذهب إلى حد ترجيح عدم اعتراض روسيا على «فرصة» متاحة أمامها لتحجيم الوجود الإيراني في سورية، لكن سيكون لها لاحقاً دورٌ في إدارة وقف إطلاق النار.
في أي حال، إذا صحّت هذه التوقّعات، لن تكون الحرب وشيكة فهي تتعلّق أولاً بمرحلة «ما بعد داعش» في العراق وسورية، ثم بتثبيت «مناطق خفض التصعيد» في سورية، وأيضاً بجلاء الصراع حول المسألة الكردية. وكلّها محطات تسعى إيران إلى استغلالها في تعزيز نفوذها. ولا شك في أن الضربات الإسرائيلية المتواصلة للمواقع الإيرانية في سورية تشكّل جزءاً من السيناريو الذي يدور تحت أنظار الروس. ولعل ما يدعم احتمالات المواجهة العسكرية أن إيران تريدها طالما أنها أولاً خارج أراضيها، وثانياً تؤمّن لها إدامةً للصراعات إذا لم تحصل على اعتراف بنفوذها، وهو ما لا ينفكّ يبتعد. لذلك فإن مناخ المواجهة قد يجعلها أكثر عدوانيةً في عموم المنطقة العربية.
* كاتب وصحافي لبناني.
الحياة
كلمتان تكشفان عنصرية إيران/ حسان حيدر
كان الإيرانيون يتوقعون بالطبع مواقف ترامب المتشددة إزاء سياساتهم، بعدما دأب على التصريح بها طوال حملته الانتخابية، ثم بعد وصوله إلى البيت الابيض، لكنهم ظلوا يراهنون على إمكان تراجعه بسبب ضغوط داخلية وخارجية، إلى أن أعلن استراتيجيته رافضاً التصديق على التزام طهران الاتفاق النووي، وملوّحاً بالانسحاب منه ما لم يتم تعديله.
وعلى رغم أنهم شعروا بقلق كبير من تصنيفه «الحرس الثوري» ضمن قائمة الكيانات الداعمة للإرهاب، وما يعنيه ذلك من فرض عقوبات عليه لاحقاً، إلا أن ما أثار استياءهم الفوري كان استخدام الرئيس الأميركي مصطلح «الخليج العربي».
تقول مجلة «تايم» الأميركية أن «الكلمتين اللتين استخدمهما ترامب أثارتا غضب الإيرانيين على اختلاف انتماءاتهم، متديّنين كانوا أو ليبراليين، موالين للنظام أو معارضين له، قوميين أو ثوريين، لأن أيّا منهم لا يمكنه هضم تسمية اللسان المائي الذي يفصل إيران عن جيرانها العرب بأي اسم آخر غير الخليج الفارسي». وتضيف أنه «بعد دقائق فقط من الخطاب، بث التلفزيون الإيراني الرسمي شريط أخبار يشير إلى تسمية الخليج العربي التي أطلقها ترامب وإلى وصفه الإيرانيين بالأمة الإرهابية. وركزت وكالات الأنباء الحكومية وشبه الحكومية والمواقع الإلكترونية والصحف جميعها على هذه الإهانة المزدوجة».
ولم يتأخر الرئيس الإيراني روحاني في كلمة متلفزة في السخرية من «ضعف معلومات ترامب الجغرافية»، فيما زار ملايين الإيرانيين حسابه الرسمي على «إنستغرام» للتعبير عن غضبهم.
بالطبع، لا يتعلق الأمر بخلاف على التسمية، بل بمحاولة إيران إكساب الاسم القديم للخليج جسداً لم يعد له، عندما يتحدث مسؤولوها عن استعادة مجد «فارس» وكيف تتوسع «الإمبراطورية» لتشمل العراق وسورية ولبنان.
وأذكر أنه في عام 1987، تلقت صحيفة عربية مرموقة في بيروت رسالة وقحة من السفارة الإيرانية تجرأت فيها على دعوتها إلى استخدام مصطلح «الخليج الفارسي» بدلاً من الخليج العربي، وأرفقت طلبها بخرائط قديمة يونانية وفارسية، تعود إلى حقب تاريخية كان العرب خلالها أحد الشعوب المستباحة. وكان لبنان في تلك الفترة يتحول تدريجاً مرتعاً وساحة للاستخبارات الإيرانية وجهازها الجديد «حزب الله»، بموافقة نظام حافظ الأسد، وكانت عمليات خطف الأجانب التي يقوم بها العملاء الإيرانيون تحت مسميات مختلفة، في أوجها. وجاء رد فعل السفارة على عدم استجابة الصحيفة طلبها الغريب والمستهجن، زيارات قام بها شبان ملتحون يتحدثون بعربية ركيكة إلى مبنى الصحيفة وسؤالهم عن بعض العاملين فيها.
مشكلة إيران تكمن في عنصريتها التي تلبس اليوم قناع «الثورة الإسلامية»، وتظهر جلية في سعيها إلى تعميم نموذج الحكم فيها على دول المنطقة، وفي رفضها الإقرار بأن التاريخ الذي انقضى لن يعود، وأن الإمبراطوريات تظهر وتزدهر ثم تزول، وأن الوقائع أقوى من الخرافات، والحاضر أقوى من الماضي. وكثيرون يعرفون مدى صفاقة الإيرانيين وصلفهم منذ قيام جمهوريتهم الإسلامية، عندما يتعلق الأمر بالسيادة على الخليج العربي، وهم لم يتورّعوا عن احتلال جزر إماراتية ثلاث بحجة التاريخ نفسه.
والذين ينبرون اليوم لتحذير الولايات المتحدة من توتير العلاقة مع ايران، إنما يتجاهلون قصداً الحقائق الراسخة عن سلوكها، ولا يفعلون سوى الدفاع عن صفقات وعقود محتملة مع طهران.
ونسأل بدورنا: لماذا لا يشمل «التوتر» الذي يتحدثون عنه ما يحصل في المنطقة العربية، وكيف يشذ عنه التدخل الإيراني في العراق وسيطرة طهران الواسعة على القرار السياسي والعسكري في بغداد، وكذلك التدخل العسكري الإيراني في سورية وإرسال ميليشيات طهران المذهبية للدفاع عن نظام الأسد المتهاوي، وأيضاً إمساك ربيبها «حزب الله» بالوضع في لبنان وتشكيله دولة داخل الدولة أقوى منها وتديرها؟ وماذا يُسمى ما تفعله إيران في اليمن، من تسليح وتدريب لأطراف مذهبية بهدف تفكيك وحدته وتهديد جيرانه؟ أليس هذا توتراً وحرباً واعتداءً وانتهاكاً للحدود والكيانات، يستحق رداً؟
الحياة
الاتفاق النووي مجدداً… يحرّك القنابل الموقوتة/ جورج سمعان
غسل الرئيس دونالد ترامب يديه من الاتفاق النووي. لم يعلن انسحاب بلاده من هذا العقد الدولي. ولم يضع «الحرس الثوري» على لائحة الإرهاب. اكتفى بالدعوة إلى فرض عقوبات عليه. رمى بالمسؤولية على كاهل الكونغرس، وعلى الحلفاء أيضاً المعنيين بالاتفاق. نجح رجال إدارته في الخارجية والدفاع في كبح جموحه. والواقع أن العالم لم يكن يحتاج إلى كل هذا الضجيج والتحذير من حرب ضروس. فلا الرئيس الأميركي كان سيمسح توقيع الإدارة السابقة، ولا إيران جندت أجنادها للرد وضرب القواعد الأميركية في المنطقة. الخيار العسكري لم يكن مطروحاً. أفضل ما يمكن أن تلجأ الجمهورية الإسلامية اليه هو نهج كوريا الشمالية. في ذروة التصعيد بينها وبين واشنطن قبل سنوات لم تجرؤ حتى على إقفال مضيق هرمز كما كانت تتوعد أيام محمود أحمدي نجاد. وحتى تلويحها بالخروج على الاتفاق إذا نقضته أميركا لم يكن جدياً. تبدل المشهد الاستراتيجي في العالم والإقليم في السنوات الأخيرة، وخير دليل أن لا إجماع اليوم على فرض العقوبات مجدداً على إيران. حتى حلفاء الولايات المتحدة من الأوروبيين أعلنوا تمسكهم بتواقيعهم على الاتفاق باعتباره يخدم مصالحها. وستتمسك القيادة الإيرانية بهذا الإنجاز وما جر عليها من منافع لم تكن تتوقعها. يكفي أنه أبعد خيار الحرب الذي كانت تردد إدارة جورج بوش الابن أنه على الطاولة. وأفادها بإعادة ترميم اقتصادها المتهالك. واطمأنت إلى أن الولايات المتحدة لن تعمل على تغيير النظام. أصلاً كانت إدارة الرئيس باراك أوباما من زمن نأت بنفسها عن التظاهرات التي اندلعت في العام 2009 احتجاجاً على إعادة انتخاب الرئيس نجاد لولاية ثانية.
كان متوقعاً منذ أسابيع أن البيت الأبيض سيوجه ضربة إلى الاتفاق لكنها لن تكون… قاضية. وأوضح الرئيس ترامب ما كان وزير خارجيته صرح به قبل أسابيع: المشكلة ليست في عدم احترام طهران التزاماتها، بل في خرقها روح الاتفاق. بالطبع لا شيء في النص عن هذه «الروح». كان الرئيس أوباما يتوقع أن إبرام اتفاق تاريخي سيعيد إيران إلى العمل الدولي، وسيفرض عليها تغييرات في الداخل والخارج تقوي عزيمة تيار المعتدلين الذين سيتسلحون بما حققت سياستهم من مكاسب اقتصادية نتيجة رفع العقوبات دولياً وتعليقها أميركياً خصوصاً، بعد تجميد البرنامج النووي. وكان من ثمرة ذلك فوز الرئيس حسن روحاني بولاية ثانية على رغم كل الحملات من مناوئيه المتشددين، خصوصاً «الحرس الثوري». لكن توقعات الإدارة الأميركية السابقة لم تتحقق. وكان واضحاً أن الجمهورية الإسلامية أصرت أثناء المحادثات بينها وبين الدول الخمس الكبرى إضافة إلى ألمانيا، على حصر النقاش في البرنامج النووي من دون غيره من القضايا الأخرى المهمة التي تتعلق بسياساتها للسيطرة ومد النفوذ والهيمنة، فضلاً عن البرنامج الصاروخي. وهو ما لم يعترض عليه أوباما.
لذلك استغلت القيادة الإيرانية الاتفاق لتعزيز نهج التمدد في الشرق الأوسط، ومواصلة بناء برنامجها الصارويخ الباليستي. أفادت من ميل الرئيس أوباما إلى الطلاق مع سياسة القطب الواحد. فقد قرر التوجه نحو إشراك القوى الدولية الأخرى في إدارة شؤون العالم. وأبدى حماسة إلى خيار الحوار من أجل تسوية البرنامج النووي الإيراني. وكانت قمة الأمن النووي في واشنطن، في نيسان (ابريل) 2010 منطلقاً لهذا التوجه. لكن طهران لم تكن وحدها تترقب انكفاء الاستراتيجية الأميركية الجديدة نحو بحر الصين والمحيط الهادئ. كانت قوى أخرى على رأسها موسكو تستعد لملء الفراغ في الإقليم. وهذا ما حصل في كل من العراق وسورية واليمن أيضاً، وقبل ذلك في أوكرانيا وشبه جزيرة القرم. استغل خصوم الولايات المتحدة إصرار الإدارة السابقة على طيّ صفحة الحروب التي أطلقتها إدارة بوش الابن. أُطلقت يد «الحرس الثوري» في كل مكان في المنطقة. بل رأى المتشددون في طهران إلى إصرار أوباما على إبرام تسوية نوعاً من التراجع، فصار طموحهم المزيد. هم يدركون مثلما تدرك واشنطن أن الشرق الأوسط ركن أساسي في النظام الدولي وتالياً في السلم العالمي. ويريدون حجز موقع متقدم عندما يحين موعد البحث في النظام الإقليمي في «الشرق الأوسط الكبير» وفي النظام الأمني الخليجي خصوصاً. وفي حين ألح الرئيس الأميركي السابق على إبرام تسوية للبرنامج النووي تبرد أجواء التوتر في الإقليم وتبدد غيوم الحرب. استغلت الجمهورية الإسلامية هذا البرنامج لتميكن يدها في المنطقة. فما هو أخطر من القنبلة الذرية التي يخشاها جيرانها والغرب عموماً، تلك الميليشيات التي أنشأتها لمنافسة الجيوش الرسمية في أربع عواصم عربية وللإمساك بسلطة القرار في هذه العواصم. فهي مثل غيرها تعرف أن السلاح النووي الذي لا يمكن استخدامه أو هو محرم بموجب قانون الحرب والنزاعات المسلحة لا قيمة لامتلاكه، حتى في مفهوم الردع. هذه النظرية التي يرى كثير من الباحثين أنه لم تعد لها قيمة، مع تطور أدوات الحروب الحديثة والأسلحة التقليدية.
بالطبع شكل وصول ترامب إلى البيت الأبيض انقلاباً على سياسات سلفه في الداخل والخارج. بدأ بزعزعة برنامج الرعاية الصحية (أوباما كير). ثم التخلي عن اتفاق باريس العالمي للمناخ، واعادة النظر في اتفاق التجارة الحرة مع جيرانه وفي التبادل التجاري مع الصين. لذلك تخوف كثيرون، منذ وصوله ورفعه شعار «أميركا أولاً» وحتى عشية إعلان سياسته الجديدة حيال إيران، أن يدفع بالولايات المتحدة إلى العزلة. بينما تستند الجمهورية الإسلامية إلى تمسك الدول الخمس الأخرى بالاتفاق. وتتمتع بعلاقات تحالف مع روسيا والصين أيضاً. حدد الرئيس الأميركي ما يريد بوضوح: تعديل مدة العقد حتى لا تكون متاحة لطهران مواصلة برنامجها بعد انتهاء هذه المدة، والتفاوض على برنامجها الصاروخي وتكبيل أذرعها وميليشياتها في المنطقة. سبيله إلى ذلك هو إعادة فرض عقوبات شديدة عليها وعلى «الحرس الثوري» الرافعة الأساسية لاقتصادها في الداخل ويدها العسكرية في الخارج. وتعمد في كلمته التمييز بين القيادة «الديكتاتورية» والشعب. وهو ما يبعث مخاوف هذه القيادة من عودة العمل على تغيير النظام. وهو ما دفع ويدفع التيار المعتدل برئاسة روحاني إلى الاصطفاف مجدداً إلى جانب المتشددين خلف هذه القيادة.
كان واضحاً منذ بداية هذه الحملة على إيران أن الرئيس الأميركي يريد ترجمة موقفه النابذ للاتفاق النووي. لكنه كان إلى حد ما يقلد سلفه الذي توخى تخفيف أعبائه الداخلية وصراعاته مع الكونغرس بالانصراف إلى قضايا خارجية. فهو لم يستطع حتى الآن التفاهم مع المشرعين في أي قضية فلجأ إلى الميدان الخارجي. لا يعني ذلك أنه ألقى عبء المواجهة على الكونغرس، فهو أعلن صراحة سياسته حيال إيران وما يريد من ورائها. والسؤال هو كيف سيترجم هذه السياسة وهل ينجح؟ لا شك في أن الشرق الأوسط هو الميدان الرئيسي للمواجهة المفتوحة بين الطرفين. وبالتحديد البلدان الأربعة التي تنشط فيها الآلة الإيرانية مباشرة أو عبر أذرعها المحلية. يمكن القول بداية أن قطاع غزة الذي وفرت له الجمهورية الإسلامية في السنوات العشر الماضية كل أنواع الدعم انتقل كلياً إلى أحضان مصر. وكانت هذه طويلاً ترى إلى حدودها معه حدوداً إيرانية. ولا شك في أن المصالحة بين «حماس» والسلطة الفلسطينية أعادت هذه الورقة إلى القاهرة. وبدأت وزراة الخزانة الأميركية فرض عقوبات على «حزب الله» الذي تصنفه من سنوات «تنظيماً إرهابياً».
في ظل هذه التحولات، يرتفع الحديث عن استعدادات إسرائيل لحرب على الحزب ولبنان كله، مستفيدة من الموقف الأميركي الجديد حيال الجمهورية الإسلامية ومواقف خصومها العرب الذين رحبوا بخطاب ترامب قبل يومين. فهل تقع هذه الحرب فيما طهران منشغلة وحليفها الروسي لوقف الحرب في سورية وتعزيز مواقعها فيه؟ موسكو وطهران تتهمان واشنطن بأن قواتها تتعاون مع «داعش» وتعرقل القضاء على مواقعه شرق سورية وعلى الحدود المشتركة مع العراق. وهمّ القوات الأميركية وحلفائها في المنطقة هو منع قوات النظام و «ميليشيات الحرس الثوري» من ملء الفراغ الذي سيخلفه دحر «تنظيم الدولة» نهائياً. فهل سيخوض البنتاغون معركة كبيرة لإقفال الحدود وحرمان الجمهورية الإسلامية من ممر آمن من أراضيها إلى سورية ولبنان، عبر العراق؟ إنها مواجهة لن تبقى روسيا أيضاً بعيدة منها. هي إذاً منطقة أخرى مرشحة للمواجهة. المنطقة أيضاً المرشحة للانفجار هي كردستان العراق انطلاقاً من عزم بغداد بجيشها و «حشدها الشعبي» على استعادة كركوك ومنشآتها النفطية والمعابر الحدودية من يد إربيل. فهل تسمح واشنطن لإيران المهيمنة في بغداد بأن تخوض حرباً واسعة على حليفها الكردي الذي أعلنت استعدادها للتوسط بينه وبين حكومة حيدر العبادي، وكانت ولا تزال تشجع رئيس الحكومة وبعض الرموز الشيعية على الابتعاد من طهران؟ وأخيراً هل تلقي الإدارة بثقلها خلف «عاصفة الحزم» لإنهاء الانقلاب في صنعاء، فيما بات الحوثيون وحدهم في الواجهة عسكرياً وسياسياً بعدما قيدوا قدرات حليفهم الرئيس السابق علي عبدالله صالح وقضوا على التحالف معه؟
لم يعد هناك مجال للديبلوماسية بين واشنطن وطهران. والمشهد الاستراتيجي الجيد يتبلور خلال الأيام الستين التي سيعمل الكونغرس خلالها على ترجمة سياسة ترامب ستنقضي سريعاً. بالتأكيد، لا أحد من الطرفين يرغب في مواجهة عسكرية مباشرة بينهما، سيعولان على حروبهما بالوكالة. بعضها مشتعل وبعضها الآخر قنابل موقوتة تنتظر شرارة. ووكلاء الطرفين على سلاحهم. فهل يستمع ترامب الذي قد لا يدرك ان الوقت ربما فات لاعادة تغيير الوقائع على الأرض، إلى رجاله العسكريين والديبلوماسيين المجربين وكيف سيرغم إيران على وقف سياسة التوسع؟
الحياة
ترحيل المفاوضات النووية مع إيران/ فرانسوا نيكولو
الاتفاق النووي هو ثمرة تقاطع أو اتفاق عدد من العوامل، أبرزها إرادة إبرامه وظروفه وأحواله. وهذه العوامل هي من بنات المصادفات. والمثابرة تعظّم فرص التوصل إلى الصيغة المناسبة. فعلى سبيل المثل، لم يبق دومينيك دو فيلبان وقتاً طويلاً في منصبه في وزارة الخارجية الفرنسية (2002-2004) ليتسنى له إبرام اتفاق، على رغم أن الأحوال كانت مواتية. فالمُحاور، يومذاك، كان محمد خاتمي، وهو رئيس إيراني يرغب في استئناف العلاقات مع الغرب، وتولى عمليات التفـــاوض الدؤوبة حسن روحاني. واضطر هذا الأخير إلى انتــظار 8 أعوام قبل أن يُنتخب إلى رئاسة الجمهورية الإيرانية ويحقق مشروعه. ومنذ حملته الرئاسية الأولى، أعلن أوباما أنه يرغب في استئناف العلاقات مع إيران. ولكنه انتظر أربع سنوات وولايته الرئاسية الثانية قبل أن يسعه المضـــي قدماً في هذا المشروع. ويلاحظ أن ثمة مدة لاختمار الملفات ويتعذر تجاوزها، وكأن الأطراف المتحاورة تستسيغ استنفاد كل صيغ الحلول غير الناجعة وغير الصالحة قبل بلوغ الحلول المجــدية. ومنذ 2004، لم يخفَ المطلعون على الشؤون الإيـــرانية ومسائل حد الانتشار النــووي، وأنا منهم، أن وجهة تذليل الأزمة واحـــدة: القبـــول بالمشروع النووي الإيراني- وأي من عناصره لم يخالف مخالفة بائنة اتفاق الحـــد من الانتشار النووي، وحدّ حجمه أو نطاقه وإحاطته بطــــوق من قيود الرقابة والضبط الوثيقة لرصد أدنى خطوة نحــو حيازة القنبلة والاقتصاص منها. لكن الكلام علــى وجهة الحل هذه كان يستقبل بالصمم، وكان ينظر إلى أصحابه على أنهم انهزاميون يجب استبعادهم ومحاربتهم.
ولا شك في أن النظام الإيراني يغذي القلق الغربي، وينفخ في المخاوف على أنواعها. ومنذ مطلع التسعينات، برزت في الصحافة الدولية توقعات أوروبية وأميركية وإسرائيلية تدور على أن إيران تسعى إلى حيازة سلاح نووي وأنها ستبلغ مأربها بعد سنتين أو ثلاثة أعوام. وسرعان ما انقلبت إدانة إيران إلى محاكمة نواياها. وشطر كبير من الضالعين في الأزمة لم يكن في منأى من أطياف الماضي (طيف المحرقة في أوساط الإسرائيليين، وطيف أزمة الرهائن والهجمات المدمرة في أوساط الأميركيين والأوروبيين، وطيف مساندة الغرب صدام حسين في أوساط الإيرانيين). وساهمت أطياف الماضي في حرف التحليلات عن الواقع والصواب. فبرزت سياسة ابتزاز مقابل الثقة: مطالبة الغرب إيران بمد جسور الثقة معها قبل استئناف المفاوضات، وهذا مسعى لحملها على النزول على سلسلة من الشروط المسبقة قبل أن يتسنى لها التفاوض. وكانت فرص نجاح هذه الاستراتيجية، التي رأى الإيرانيون أنها علامة التكبر الغربي، معدمة (صفر). فالثقة هي وليدة اتفاق جيد يلتزم التزاماً أميناً. ولكن هذه الاستراتيجية التزمت طوال ست أو سبع سنوات، ووطدت القيود أكثر فأكثر على إيران. وهذا ما عرف في وقت من الأوقات بـ «المعايير المزدوجة» و «الحزم» (العقوبات القاسية) و «الانفتاح» (عرض الحوار)، أي سياسة العصا والجزرة. ولكن التكتيك هذا يغفل بديهيات العالم الحيواني: الحمار لا يقترب ممن يلوح في آن بعصا وجزرة. وإذا كانت الحال على هذا المنوال في العالم الحيواني، فما بال الإيرانيين؟
وكانت هذه الرؤية ترمي إلى هدفين، مكافحة الانتشار النووي وزعزعة النظام. ولكنها لم تصب في تشخيص تماسك الجمهورية الإسلامية. فضعف شعبيتها في أوساط الأكثر تعليماً ليس مرآة هشاشة كيانها. وحسِب العالم أن إيران، وهي بلد الريع النفطي، تنهار لا محالة حين يحظر عليها بيع النفط الخام وشراء الوقود المكرر. وحين أضرمت النيران في عدد من محطات الوقود إثر إعلان أحمدي نجاد رفع أسعار الوقود، سرى الأمل بوشك انهيار النظام في أوساط المراقبين. ولكن الخيبة كانت في انتظارهم. فاليوم المنتظر لم يهل يومذاك ولا في 2015. ولم تهل بشائره في 2009 حين نزل ملايين الإيرانيين إلى الشارع للاحتجاج على الانتخابات المزورة. ورد النظام رداً عنيفاً. وهزّ الخوف أوصاله، ولكنه التقط أنفاسه واستعاد شيئاً من مشروعيته حين أدار انتخابات 2013 إدارة نزيهة انتهت إلى فوز روحاني.
وكانت الأهواء تجتاح عالم المفاوضات. فلفت الضبابية رؤى الخبراء الذين يفترض بهم تنوير عالم السياسة. وأذكر أن موظفاً كبيراً في وزارة الخارجية الفرنسية يتولى الملف الإيراني، كان يؤكد لي بين 2004 و2005، أن إيران تملك ألف جهاز طرد ويسعها إنتاج اليورانيوم وتخصيبه وحيازة قنبلة في ستة أشهر. واليوم نعرف أن حيازة القنبلة تقتضي دوران عشرة آلاف جهاز طرد على الأقل. والتزم خبراء من مفوضية الطاقة النووية الصمت حين كان هذا المسؤول يتكلم، فهم كانوا يخشون اتهامهم بأنهم من أهل السوء. وكان من يخالف رأي الخبراء يقصى، والمترددون يلتزمون الصمت، والطعون البناءة تستبعد. فصارت الديبلوماسية الفرنسية أسيرة الأفكار السائرة واضطرت إلى التزام الموقف الأميركي، على رغم أنها كانت مخولة أداء دور الوسيط بين طهران وواشنطن.
ودرج الإيرانيون على سوء تقدير دعم الآخرين لهم. وكانت قرارات مجلس وكالة الطاقة الذرية الدولية تقع وقع المفاجأة عليهم، في وقت كانوا يعولون على التضامن الإسلامي ودعم العالم الثالث. ولكن حلفاءهم كانوا يتنصلون من دعمهم نزولاً على الضغط الأميركي. ولطالما حسِب الإيرانيون أن في وسعهم النجاة من مقصلة قرارات مجلس الأمن، في وقت كانت مواقفهم الاستفزازية (في عهد أحمدي نجاد) تدفعهم وهم غافلون إلى الهاوية. ودرج الإيرانيون في المفاوضات على طلب ثلاثة طلبات للحصول على طلب واحد. وقوض هذا التكتيك صدقيتهم. ومالوا إلى إصابة محاوريهم بالتعب، والاستفاضة في الكلام عن فضائل الجمهورية الإسلامية ونواياها الطاهرة. وتوهم الإيرانيون في عهد نجاد أن الاتفاق مع الصين وروسيا هو السبيل إلى الخروج من الأزمة. ولكن حسبانهم لم يكن في محله، وتعلموا من أخطائهم. فالتزم فريقهم المفاوض، على رأسه محمد جواد ظريف، مستوى عالياً من المهنية.
التناسب بين الهدف والوسائل
حين قرر الأميركيون إخراج المفاوضات إلى العلن في 2013، جندوا أفضل الخبراء لبلوغ أهداف محددة. وانصرف عشرات الديبلوماسيين والموظفين والخبراء، وعددهم يبلغ حوالى المئة، إلى عمل دؤوب: تناول الملف الإيراني طوال أكثر من 18 شهراً. ونموذج عملهم مختلف عما كانت عليه الحال في الماضي القريب حين كان بضعة موظفين رفيعي المستوى يتولون الملف تناولاً متقطعاً ودورياً في العواصم الأوروبية الثلاث منذ بداية الألفية الثانية. وكان المضي قدماً في حل الأزمة الإيرانية يقتضي تعيين عشرات الديبلوماسيين والخبراء والعمل من غير انقطاع في كل عاصمة أوروبية. ولكن هذه العواصم لم ترغب في شد الحبال مع إدارة جورج دبليو بوش.
عالم أحادي
واليوم، تبدو معالم العالم «المتعدد الأقطاب» أو «من غير قطب» ملتبسة. وكان القرار الإيراني التعامل مباشرة مع الولايات المتحدة- موجهة دفة هذا العالم الملتبس- في محله. وأخفقت أوروبا في ترجيح كفتها ودورها. والمفاوضات النهائية كانت مفاوضات ثنائية، أميركية وإيرانية. واللاعبون الآخرون أدوا دور المتذمر والمعترض. ولم يطعن الروس والصينيون في غلبة كفة أميركا في المفاوضات ولحقوا بركاب واشنطن، على رغم أن بعض نقاط الاتفاق تخالف مصالح بكين وموسكو، ومنها عدم رفع الحظر عن بيع طهران السلاح التقليدي. وجلا العالم من غير لبس على صورة عالم أحادي القطب في تناول الملف الإيراني.
العقوبات ضرورة؟
يذهب «صقور» السياسة الأميركية إلى أن الفضل في حمل إيران على قبول مفاوضات جدية والصدوع بقيود كبيرة على الانتشار النووي، يعود إلى العقوبات «الكاسحة» التي أصابتها بالشلل. ويزعم هؤلاء أن هذه العقوبات ستؤدي كذلك دوراً يضمن التزام اتفاق 14 تموز (يوليو) الأخير. فسيف العقوبات، ولو رفع، سيبقى مسلطاً على طهران ويحول دون التنصل من الاتفاق أو انتهاكه.
ولكن «الحمائم» تعيد إلى الأذهان ما يغفله الصقور: في 2005، قبل اللجوء إلى سلاح العقوبات، عرضت إيران تنازلات استعاد اتفاق 2015 عناصرها الأساسية: حد عدد أجهزة الطرد وتخفيضه إلى عدد أقل من العدد الذي أجمع عليه بعد عشرة أعوام، وتخفيض اليورانيوم المخصب إلى 5 في المئة، ونقل مخزون اليورانيوم المخصب إلى خارج إيران، والتزام البروتوكول الإضافي في انتظار المصادقة عليه في مجلس الشورى الإيراني. وإذ أترك نفسي إلى عالم الأحلام، أتخيل: لو أبرم اتفاق في أيام خاتمي وروحاني، لرجحت كفة المحافظين والمعتدلين، وربما لم يكن أحمدي نجاد ليبلغ السلطة. فهو أضاع على إيران والعالم ثمانية أعوام. ولكن في عالم الواقع يبرز سؤال: هل كانت أوروبا ستنجح في حمل أميركا جورج دبليو بوش على قبول مثل هذا الاتفاق؟ هذا أقرب إلى عالم سياسة الخيال أو الخيال السياسي على نحو ما يقال خيال علمي.
* ديبلوماسي فرنسي سابق، عن مدونة «آ كونتر كوران» الفرنسية، 26/7/2015، إعداد منال نحاس.
الحياة
نحن على حافة الهاوية/ خالد غزال
دفع خطاب الرئيس الأميركي ترامب التوتر في المنطقة الى درجة عالية من التصعيد. إذا كانت إيران شكلت الحلقة المركزية في الخطاب، إلا أن مفاعيله وآثاره تطاول مجمل المنطقة، وينال لبنان منها حصة غير قليلة. يطرح الخطاب ومعه الخطة الأميركية بمجملها أسئلة مقلقة عن مصير المنطقة والاستهدافات التي يرمي اليها، والحروب التي تبدو مفتوحة الى ما لا نهاية.
بداية، كيف تقرأ الولايات المتحدة علاقتها بإيران وكيف ترى الأخيرة هذه العلاقة. صحيح أن الرئيس الأميركي هدد قبل خطابه بإلغاء الاتفاق النووي وتصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية، لكن الخطاب لم يذهب الى هذا الحد، بل أشار الى تعديلات تطاول الاتفاق، أحالها الى الكونغرس للموافقة عليها. في المقابل، لم يصل الى تصنيف الحرس منظمة إرهابية، بل طرح إمكان فرض عقوبات اقتصادية، وهو أمر مختلف عن التصنيف الإرهابي. يشار في هذا المجال الى أن الدول الأوروبية المشاركة في الاتفاق النووي، تتوافق مع الموقف الأميركي في إدخال التعديلات وليس في إلغائه.
في الموقف الإيراني، يتحسس الإيرانيون حجم الأضرار التي تصيبهم نتيجة السياسة الأميركية الجديدة. فإذا كانوا ممتهنين إطلاق التصريحات المدوية بالحرب وتدفيع الأميركيين «دروساً جديدة»، بما فيها ضرب القواعد العسكرية الأميركية، فيجب التعاطي مع هذه التصريحات بصفتها «جعجعات من دون طحين». يعرف الإيرانيون أن الحرب، سواء من جانب أميركا أو من جانب إيران، لن تقع. فهذا التصعيد الذي يصل الى «حافة الهاوية» له وظيفة عودة الأطراف الى الطاولة ونسج اتفاقات جديدة.
إذا كان التحفظ واجباً في شأن اندلاع حرب أميركية – إيرانية، إلا أن الحرب الدائرة في المنطقة، خصوصاً في سورية والعراق، والتي تنخرط فيها إيران بقوة، إضافة الى تمددها الإقليمي في اليمن وتهديداتها لدول الخليج، هي الميدان الذي سيدور فيه الصراع الإيراني الأميركي. لا تخفي الولايات المتحدة توجهاتها في شأن انكفاء إيران الى حدودها الداخلية والكف عن الهيمنة على هذه الدول، فيما ترى إيران أن هذا الانكفاء سيكون بمثابة انتحار لأنه سيقطع الشرايين التي تتغذى منها، على مختلف المستويات السياسية والاقتصادية والأمنية. فالمنطقة العربية باتت بالنسبة لإيران المدى الحيوي، والحزام الذي يمنع اندلاع «الحروب الصغيرة» الى داخلها، والمجال الذي يحمي وحدتها المهددة من تفجر عناصر التقسيم المتمثلة في مجموعة من القوميات والإثنيات التي تعاني حرماناً من الحقوق واضطهاداً على جميع المستويات.
يترافق التصعيد الأميركي الإيراني مع تواصل عناصر التفجر في العراق مع المشكلة الكردية الناجمة عن قرار الانفصال، واستعصاء التوصل الى حل في المدى القريب بما ينذر بقيام حرب داخلية. كما أن المشكلة السورية لا تزال الحلول السياسية تتخبط فيها وسط تنازع روسيا وأميركا على تقاسم مناطق النفوذ. زادها توتراً الدخول التركي الى مناطق سورية، وسط تلويح صريح بإمكان اقتطاع أراضٍ، بما يذكر بمصير لواء الإسكندرون سابقاً.
لكن جديداً في السياسة الأميركية تناول هذه المرة الساحة اللبنانية من خلال التصعيد ضد «حزب الله» عبر تعيين اثنين من قيادييه كمتهمين بممارسات إرهابية ضد المصالح الأميركية، والتشديد على الموقف التصعيدي ضد الحزب. تزامن هذا الموقف مع تهديدات إسرائيلية بشن حرب على الحزب ستطاول مجمل لبنان وصولاً الى سورية. لا يجب التقليل من أهمية هذه التهديدات، فإذا كانت إيران سترغب في الرد على السياسة الأميركية، فقد تكون الساحة اللبنانية هي أحد المواقع التي يمكن للحرب أن تدور فيها.
إن مجمل الأحداث الدائرة، ومعها الخطة الأميركية تجاه المنطقة، وتواصلها مع الخطة الاسرائيلية الثابتة في التدخل في الدول العربية ونزاعاتها بهدف تفكيك هذه الدول، إضافة الى اللاعبين الآخرين خصوصاً تركيا، كلها تطرح أسئلة مقلقة حول مستقبل المنطقة. فهل دخلنا في مرحلة قوامها الإمعان في تفكيك الكيانات القائمة، أولاً على مستواها الداخلي، بما يعنيه من إعادة عناصر ما قبل قيام الدولة لتحل مكان الدولة المركزية القائمة حتى الآن؟ وهل دخلت المنطقة في مرحلة إعادة النظر بالكيانات على مستوى الجغرافيا السياسية، بما فيها رسم حدود جديدة تعدل ما سبق لاتفاقات سايكس بيكو أن رسمته؟ إذا كانت الأسئلة تعبّر عن هواجس مع بعض الوقائع، إلا أن المسار الذي تسير فيه المنطقة، وتدفع اليه القوى الاستعمارية الموجوجة والفاعلة على أرضه، من أميركية وإسرائيلية وروسية وإيرانية وتركية، لا توحي بالاطمئنان. مما يعني أن المنطقة سائرة بقوة الى الإقامة في الفوضى، وهي المقيمة فيها أصلاً، انما الى المزيد. فهل تعي الدول المقررة أن الفوضى ستكون أخطر عليها مستقبلاً من الدولة المركزية، وأن كلفة الوحدة تبقى أقل بكثير من كلفة التقسيم، سواء على المستوى الداخلي لدول المنطقة، أم على الدول الاستعمارية المقيمة؟ فالفوضى بحر سيغرف الإرهاب منه ويزدهر الى أقصى الحدود.
* كاتب لبناني
الحياة