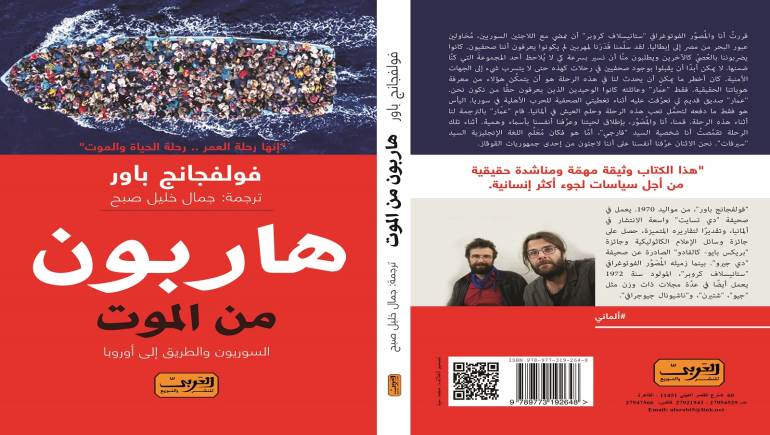الحكايات المتداخلة في رواية “المشّاءة” لسمر يزبك/ جمال شحيّد

بعد كتابي “تقاطع نيران” و”بوابات أرض العدم” اللذين صدرا في السنوات الأولى من الانتفاضة السورية، تطلّ علينا، سمر يزبك، في رواية “المشّاءة” (دار الآداب، 2017، 206 صفحات) التي تنقلنا إلى فضاءات سوريالية تتقاطع مع فضاءات الانتفاضة السورية.
الأنا الساردة
الرواية كلها عبارة عن سرد مكتوب بضمير المتكلم، يُنقل بصيغة حديث موجّه لشخص يبقى خافياً علينا حتى النهاية. تقول بطلة الرواية – وهي فتاة خرساء في التاسعة من عمرها، ويعتبرها الناس مجنونة، وتقيّد دائماً بحبل في معصمها – إنني “وُلدت وأنا لا أستطيع التوقف عن المشي. أقف وأنطلق بالمشي. أمشي وأمشي. أرى الطريق بلا نهاية. تقودني قدماي وأمشي. أنا ألحق بهما فقط”. فلا علاقة لها إذن بالمدرسة المشائية الأرسطية ولا بالمشائين في الفلسفة. أبو الفتاة هجر زوجته وابنه سعد وبنته (التي لا نعرف اسمها) وهما صغيران، لأسباب تبقى مجهولة. وتروي الفتاة أن أمها كانت تصطحبها معها إلى المدرسة التي تعمل فيها كعاملة تنظيف. وكانت تقيّدها في مكتبة المدرسة كي لا تمشي حيث تسوقها قدماها. فحنّت عليها الست سعاد أمينة مكتبة المدرسة وعلمتها القراءة والرسم. وذات مرة دعت الست سعاد أمَ الفتاة وابنتَها لزيارتها في “ساحة النجمة” في دمشق. وكان على الأم، التي تسكن غرفة واحدة في مخيم جرمانا أن تأخذ باصين للوصول إلى قلب المدينة، وكان عليها أن تتوقف عند حاجز للمخابرات وجيش الدفاع الوطني. وعند تدقيق الهويات ينقضّ الأمن على شاب ويقول له: “انزل يا حيوان. من جوبر يا ابن الكلب”. رُكل الشاب بشراسة، وأنزل باقي الركاب بعنف من الميكروباص. وأثناء فوضى التنزيل، انقطع قيد الفتاة، فوجدت نفسها حرّة. فراحت تمشي: “كنت أمشي، فعلاً كنت أمشي! ولا ألتفت! أسمع صراخاً وأمشي. أنا أمشي. أنا أمشي”. فأمرها العناصر بأن تتوقف، ولكنها تابعت سيرها، فركضت أمها وراءها لتوقفها، ولكن أحد العناصر أطلق عليهما النار، فماتت الأم وجرحت البنت في كتِفها: “لم أفهم لماذا انهال ثقل أمّي فوق جسدي، ولماذا رمت نفسها عليّ، ووقعتُ أرضاً على الإسفلت الحار، ولم أحرك جسدي. وشعرت بأنفاس أمي وهي تضمّني […] ورأيت أبواط العساكر المغبّرة، والمحيطة بي”. وفي فرع فلسطين حيث تم توقيفها أتى عنصر وأخبر الممرضة أن الأم قُتلت خطأ، وأنهم ينتظرون “أخي لاستلامي”. وسمعت الممرضة تقول لإحدى الفتيات اللواتي جُرح أخوها: “هذا جزاء الخونة ومن يهاجم ويتظاهر ضد سيادة الرئيس”. وفي الفرع تتعرف على بعض المعتقلات اللواتي تمّ التنكيل بهنّ. وأفرج عنها بسبب بكمها، فاستلمها أخوها سعد وهربا على ظهر “طرطيرة” إلى الغوطة الشرقية، وتحديداً إلى “زملكا”.
“أخي ورث مهمّة أمي في عملية الفك والربط. لكنه لم يقيدني إلى يده. صار يحمل على ظهره سلاحاً ثقيلاً”. وأودعت الفتاة في كنف عائلة طيّبة، وراحت تعلّم أطفال الحي أن يلوّنوا ويرسموا. وكانت ترسم لهم صوراً مستوحاة من روايتي “الأمير الصغير” و”آليس في بلاد العجائب”، وهما الروايتان اللتان تشكلان خلفية لافتة لرواية “المشاءة”. وكطفلة، تقدم لنا الرواية، مشاهداتها عن الأجواء العسكرية والاجتماعية التي كانت سائدة في الغوطة الشرقية: قصف الطيران، المسلحون المعارضون، عائلاتهم وأطفالهم الذين كانت الراوية البكماء ذات التسع سنوات تعلمهم الرسم وترتل لهم القرآن [المحيّر في الرواية كيف تستطيع البكماء ترتيل القرآن وهي بكماء؟ ولكن للخيال دوراً لا يمكن إنكاره]. ورغم تقييدها كانت تمشي: “كنت أمشي في الحلم ولا أتوقف. أمشي ولا… أتوقف، وأسمع صوت أمي. وجهها لا يبدو أمامي، أرى شعرها فقط”. وبسبب القصف الشديد وإلقاء السلاح الكيماوي على الغوطة، اضطر سعد إلى مغادرة المكان ليقاتل في مكان آخر، ولكنه أودع أخته لرفيقه في السلاح: حسن. وشاء القدر أن تبقى على قيد الحياة بعد سقوط الكيماوي على المنطقة. وتصف لنا الراوية الفظائع التي شاهدتها في مشفى عربين، وحالة المصابين بالكيماوي: “أمسك حسن برأسي ووضعه في حضنه وهمس: لا تموتي”. وقال لي حسن لاحقاً: “إن الطائرات بعد أن ألقت الغاز، عاودت القصف من جديد، وأصابت سيارات الإسعاف التي جاءت لإنقاذ المصابين، والناس الذين هربوا من القذائف السامة، وصعدوا إلى الطبقات العليا، لأن الغاز يستقر في الطبقات السفلى، قد ماتوا في القصف”. كانت الجثث تتكوّم حولها، وظن المسعفون أنها ميتة. وسمعت أحدهم يصرخ بطفله المدنف: “بابا لا تنام”. أما حسن فصفعها قائلاً: “فيقي… لا تنامي”. وتقول الراوية: “كان هذا تمريني الرابع على الموت. اكتشفت في الأيام الماضية أن الحياة هي تمارين على شعور الدخول في الموت. كل ما يحصل هو تمرين، مثل التمرين على الرسم والخطوط والألوان”. وفكّرْت في رسم صورة الموت، ورأت أنه ورقة بيضاء تتحول إلى الأسود ثم تعود بيضاء خلال ثوان. “حتى فتحتُ عينيّ على سقف الغرفة التي بدت لوهلة تمطر بقشور الدهان، وهطل المطر من جديد، كانت هي اللحظة التي عدت فيها إلى الحياة”.
وينقلها حسن أو الشاطر حسن كما تقول، إلى أحد الأقبية “الآمنة” ويوثق ربطها كي لا يعاودها وسواس المشي، وترك لها كيساً من التفاح ووعدها بأنه سيعود قريباً. وأثناء غيابه كانت تهجس بالرسم والألوان واستذكرت – وهذا طبعاً من سمر يزبك – فصلاً من كتاب الثعالبي عنوانه “في ضروب الألوان والآثار” شرح فيه معاني الألوان: الأبيض “هجان، خالص، ناصع، يقق، بهق، واضح…”؛ الأسود “أدلم، ظل، أربد، آوى، أحوى…”. وتقضم ما تبقّى من التفاحة الأخيرة التي تركها لها حسن. وتسبح في عالم الحروف والألوان؛ فتتصور الأبجدية كالتالي “الألف تنتهي بطير له جناح واحد. الباء تنتهي بجناحين. التاء تنتهي بعود ثقاب. الثاء فوق نقاطها الثلاث تضع مظلة. السين تنتهي بسرير بقوائم عالية. الجيم والحاء والخاء، تنتهي بأصابع كف…”، الخ. وخلقت أبجديتها السوريالية، كما خلقت ألوانها. ولكن “هل توجد جمل تستطيع وصف اللون الذي كانت تتركه القذائف الكيماوية؟ هل كان أزرق؟ رمادياً مائلاً إلى الزرقة؟ هل كان شفافاً وأزرق؟ أنا وصفت اللون بالبنفسجي. ولكن، هل هو تماماً هكذا؟”.
وتنتهي الرواية بتعداد الحكايات المتناسلة التي قَصّتها الراوية: “حكاياتي لم تنتهِ، وحكاية حسن لا تزال في البداية. حكاية أمي التي اختفت. حكاية الفتاة الصلعاء التي اختفت. حكاية أخي الذي اختفى. حكاية أم سعيد التي اختفت. حكاية حسن الذي اختفى… وأنا حكاية سأختفي […]. لم أعد أركز في الحروف. وعليّ أن أصرخ”.
حكايات دائرية متداخلة
ثمة لازمة لافتة في رواية “المشّاءة” ترجئ القصّ إلى زمن لاحق: “هذه قصة أخرى سوف أرويها لك لاحقاً”، “هذا غير وارد الآن”، “هذا ما سأحكيه لك لاحقاً”، “أفضل الاستمرار في حكايتي كما هي”… وهذا يخلق نصاً مليئاً بالتداعيات التي ينبغي على القارئ ربط تفاصيلها. وعندما تؤجل الكاتبة قصة من السرد، تستدركها لاحقاً، ولو بصورة ضمنية. إنها تقفز فوق حدث ما، وتنبّه القارئ إلى ذلك كي تحرّض عنده عنصر التّشويق. وهذا أشبه بالدمى الخشبية الروسية المتداخلة التي توقّف عندها طويلاً فلاديمير بروب في تحليله بنية الحكاية، ونجد نواتها في حكايات ألف ليلة وليلة.
أجواء سوريالية
“استيقظتُ في أحد الأيام ورأيت أنني ضوء معلق في السقف”؛ “أرى عيني أخي تكبران وتكبران وتتحولان إلى بالونين”. ومن خلال الكواكب السرية المقتبسة فكرتها من رواية «الأمير الصغير» لأنطوان دي سانت اكزوبيري، تسبح الراوية في عالم فانتازي. فعندما كانت أمها تبقيها عند الست سعاد في مكتبة المدرسة كانت مخيلتها “تزدحم بحيتان بيض طائرة، وبنجوم ذات لون برتقالي تتحرك بين الصفوف، وشخصيات تختفي من وقت لآخر”، وكانت تظهر لها كائنات غريبة وتسمع أصواتها في رأسها: “حيتان بأقدام نعامة، وقرد برأس زرافة، وأرنب بريش نعام، أما الجمل فنبت له جناحان صغيران، مثل جناحي وطواط عند رقبته”. وفي المكتبة، “كانت الدروب تحملني، لم أكن أمشي، كنت أبقى واقفة في مكاني، تمسكني بعض النباتات المتدلية من أغصان الأشجار، وتطوف بي العالم كله”. وتصرّح قائلة: “صرنا أصدقاء، أنا والأمير الصغير. تعلمت منه، كيف أبني كواكبي، كما فعل هو، وكان عليّ بناء الكواكب”. وتتصور أيضاً أنها استيقظت ذات يوم ورأت أنها “ضوء معلق في السقف، وكنت أتأرجح داخل ورق مقوى لونه أبيض، بياضه ناصع”، هذا ما رأته بعد أن أصيبت بالسلاح الكيماوي في الغوطة الشرقية.
وتعود إلى حكاية “آليس في بلاد العجائب”، وتريد أن تضيف إليها بعض المخلوقات: “لو كنت أعيش في ذلك الزمن الذي كُتبت فيه الحكاية، لاقترحت على كاتبها أن يضيف مجموعة أسماك تطير في دروب الغابة التي تجتازها آليس. أسماك تظهر فجأة وتختفي، تدور حول رأس آليس مثل الجنيات، وتطلق فقاعات في سماء الغابة، وهذه الفقاعات يجب أن تكون ملونة، وكل سمكة لها فقاعاتها الخاصة بلونها، وهذه هي أنوار، أنوار الغابة التي كانت تنقص الحكاية…”. كذلك تود لو أن أنطوان دي سانت إكزوبيري “أضاف مجموعة أخرى من الكواكب، مختلفة الحجوم، كواكب هي ساعات عملاقة تحيط بكواكب الأمير الصغير”.
* * *
هذا الجو الاستيهامي الذي خلقته، سمر يزبك، في رواية “المشّاءة” هو الجو الذي عاشته وتعيشه سورية خلال السنوات الخمس الأخيرة، إذ هو جو عبثي مثقل بالأحداث اللامعقولة وغير المتوقعة، التي لا تستشف حقيقتها إلا مخيّلة جبّارة كمخيلة الراوية “المشّاءة” المكبلة التي مشى بها الخيال بعيداً بعيداً. ألا تمثّل هذه الراويةُ المقيدةُ سورية في واقعها وتوقها الى الانطلاق من جديد؟
ضفة ثالثة