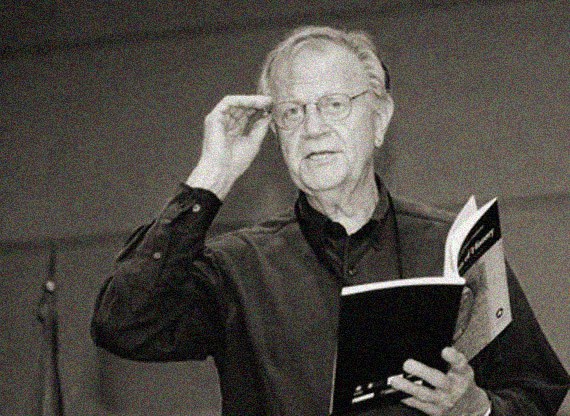الدين وداعش.. هل الأصولية نتاج “طبيعي” في مجتمعاتنا؟/ سلامة كيلة

كلما جرى تضخيم تنظيم أصولي، تميل النخب إلى تعميم المشكلة، فتجري الإعادة إلى الدين، وإلى التخلّف المجتمعي. وينصبّ النقاش حول جوهر الدين ليجري التأكيد أن داعش، وأمثالها، هي نتاج طبيعي للإسلام. فتطرح المسألة كمسألة تخلّف طويل، هو نتاج الدين في مقابل الحداثة، ويُعاد إلى الإسلام الأول والنص القرآني، وسيرة الصحابة، وصراعات الدولة الأموية والعباسية، في سرديةٍ لا تاريخية، ولا علمية، ولا واقعية كذلك، تُظهر وكأن هناك “جوهراً ثابتاً” بعيداً عن مجريات الواقع، وليس نتاج الواقع.
ولينحرف الصراع إلى صراعٍ مع الدين، وهو ما أنشأ الميل الإلحادي المتصاعد في كل المنطقة، لكنه أبعد الصراع عن جوهره الحقيقي.
ولا شك في أن التعميم يوصل إلى ذلك، لأنه يُدخل في “المجردات” و”الهلوسات”، والهواجس، ولا يمسّ الواقع الذي أنتج هذه الظاهرة، وظواهر كثيرة غيرها.
وأيضاً، كل تعميم لن يقود إلى الوصول إلى فهمٍ، ولا إلى حل. لهذا، تظل الهواجس هي الحاكمة، وتفضي إلى عكس ما يُراد، أي بدل مواجهة هذه الأصولية، وتفكيكها، تجري تقويتها وتدعيمها، باستنفار فئات اجتماعيةٍ تتحسّس من مسّ الدين، بعدما باتت متّهمة بدينها.
وإلى إعطاء مبررات للقوى الأصولية، لكي تكسب شعبياً. فالصراع ليس صراع إيمان/ إلحاد، هذا صراع وهمي، وُجد في مرحلة من مراحل التطور في التاريخ العربي، وأفضى إلى العقلنة التي طرحها ابن رشد. ووجد في أوروبا وأفضى إلى العقلنة والعلمنة تأسيساً على ما بدأه ابن رشد.
الفهم التاريخي هنا مهم، وهو ضروري ضرورةً حاسمة لفهم التاريخ الإسلامي، بما في ذلك الدين، وأيضاً لعدم الخلط بين التاريخ والراهن.
فعلى الرغم من أنه يمكن أن يجري الاستناد إلى نصٍّ قرآنيٍّ، يدعم ما تقوم به داعش، أو الإخوان المسلمون أو غيرهما، يمكن الاستناد إلى نصٍّ آخر يقول “لا إكراه في الدين”، وبالتالي، يمكن الدخول في مناظراتٍ لا أفق لها، فـ”القرآن حمّال أوجه”.
فقط الفهم التاريخي هو الذي يسمح بوضع الإسلام في سياقه التاريخي، ومن ثم، فهم الأسس الموضوعية التي فرضت نشوء التيارات السلفية و”الجهادية” والإخوانية.
تأويل ديني
كل هذه الحالات هي ليست نتاج الدين، بل إن “التأويل الديني” الذي يطرح لتبرير نشوئها، هو نتاج الراهن. ولهذا، يجب البحث في “البيئة الاجتماعية” التي تنتج هذا النمط من المجموعات.
الإخوان المسلمون هم نتاج موضوعي، حيث إنهم نتاج إحساس فئات اجتماعية بأن التطور يتجاوزها، ويتشكل، في الواقع، وضع جديد، لا مكان لهذه الفئات فيه، وأن الأفكار التي تعيشها، والبيئة التي تعيشها، باتت مهددة بصيرورة حداثية، تتجاوزها. لهذا، تمسكت بالبنى التقليدية والوعي التقليدي، والنظام السياسي التقليدي. تمسكت بالمنظور الفقهي ضداً للمنظورات التي أتت بها الحداثة.
لقد دافعت عن واقعها الذي هو استمرار لقرون ماضية في مواجهة واقع جديدٍ يزحف، ويدمّر قيمها وبيئتها الاقتصادية (الحرف والبازار والبيئة الفلاحية الإقطاعية). لهذا، دافعت عن البيئة المدينية المغلقة، وعن النظام الإقطاعي والمَلَكية.
ولا شك في أنها استندت إلى النص القرآني، ودعت إلى الإسلام الأول، وهي تفعل ذلك كله، وأصرّت على تطبيق الشريعة، لكي تكرّس سلطتها وسطوتها. ولا شك في أن “الإسلام” الذي وصلت إلينا بتفسيراته هو نتاج تلك البيئة التي نشأت، إثر انهيار الدولة والمجتمع، نهاية الدولة العباسية.
هي، هنا، تستخدم الدين للدفاع عن واقع قائم في مواجهة واقع جديد، يهدم القائم، ويفتح لمسار حداثي جديد، ليس لها فيه موقع. وهذا ما جعلها تتمسك بالمنظور الفقهي، الذي يبقي الفكر محبوساً في بنيةٍ عتيقةٍ، لا تستطيع فهم الراهن.
ما دفعها إلى شن الحرب على الفكر الحديث عموماً، وعلى النظم القومية التي عمّمت “حداثة منقوصة”، وفتح على اعتبار أن كل ما تحقق هو التعبير عن “الجاهلية الجديدة”، كما قال سيد قطب. هذا المنظور الذي فرض تأسيس التنظيمات “الجهادية” التي تريد تدمير القائم والعودة إلى الأصول.
ولقد تشكلت هذه التنظيمات من فئاتٍ مهمشةٍ ومفقرةٍ، أو من بيئاتٍ كانت ولا تزال تعيش ما قبل التاريخ، في مناطق لم يشملها التطور في بنيةٍ عامةٍ، باتت تنتقل إلى مرحلة جديدة. في ذلك كله، كان النص الديني يُخضع لتبرير هذا المنظور الانكفائي المعادي للبيئة الجديدة، والذي يسعى إلى تدمير كل التطور المتحقق.
وعلى الرغم من التطور الذي تحقق في كل المنطقة، فإن هناك مناطق ظلت “خارج التاريخ”، تعيش وضعية “القرون الوسطى”، التي تبعت انهيار الدولة العربية الإسلامية، وحيث أدت الغزوات والحروب إلى دمارٍ شاملٍ، أعاد المجتمعات إلى مرحلة أقرب إلى البداوة، وإلى تحوّل المدن إلى مدن مغلقة، محافظة وتمتهن التجارة بالأساس.
هذا التهميش “الحضاري” هو البيئة التي تقطنها، أو تؤثر فيها تلك الأفكار الأصولية، وهي منبع “الجهاديين”. بالتالي، فإن تفاوت التطور هو الذي يسمح لأن توجد بيئة يمكن أن ترفد الأصولية. هنا، تصبح المسألة محدَّدة، وليست “فالتة”، أو معمّمة، لأنها محصورة في بيئة محدودة، ومناطق معينة. بيئة ظلت خارج التاريخ، بالتالي، يمكن أن يتلبّسها التاريخ، فتعتقد أنها قادرة على إعادته كما هو، أو كما تتخيّله هي أنه هو.
هذا هو منبع فكرة الخلافة و”الجهاد”، ومنبع كل التطبيقات التي تمسّ المرأة والعلاقات الاجتماعية، والتعامل اليومي، وحتى اللباس، سواء تعلّق الأمر بالرجل أو بالمرأة. وهذه بيئات “مفوّتة”، كما كان يقول ياسين الحافظ عن مجمل المجتمعات العربية، لكننا، هنا، نلمس بيئات معينة ظلت “مفوّتة” بالمعنى التاريخي، وظلت تريد إعادة إنتاج التاريخ، لكن التاريخ “المفوّت”، وليس “التاريخ الناصع” الذي عاشته المنطقة قروناً.
بعيداً عن التعميم
ما لا بد من لمسه بدل التعميم هو لماذا هذه الفئات التي تمثّل جزءاً ضئيلاً في المجتمع، هي التي باتت تنشط، وتتسلّح، وباتت تحمل “مشروعاً” تجهد من أجل تحقيقه؟ بمعنى: أين الفئات الوسطى، وأين الطبقات المفقرة التي تعيش الحاضر بكل “تخلّفه” وأزماته؟ بالتالي، يطرح السؤال: ما هي الوضعية التي مكّنت هؤلاء، وهل كانت بفعل ذاتيٍّ، أو كانت نتيجة “عناصر مساعدة”، تمتلك كل القدرة على إنتاج ما نشاهده، في القوة العسكرية وفي النشر الإعلامي، كما في التمويل؟
ربما يفرض هذا الأمر ليس الميل لوصم الإسلام بما نلمس اليوم، بل بتحليل الأساس الموضوعي لهذه الظاهرة التي باتت تعمّم القروسطية، والتشدّد الأصولي، وبالتالي، الدمار في مجتمعاتٍ تجاوزت إمكانية تقبّل هذه التكوينات العتيقة، والبالية معاً.
إذن، ليس البحث في الدين هو ما يوصل إلى نتيجة، ولا الحكم المسبق بأن ما نشهده هو “جوهر الدين”، لهذا، إن كل الميل لتعميم النقاش حول ظاهرة محددة (كانت تنظيم القاعدة وباتت تنظيم داعش) بالحديث عن الإسلام لا معنى لها، ولا قيمة علمية لها، لأنها تكرّس نظرة مثالية، تقوم على “الجوهر المطلق”، “الجوهر الثابت”، من دون لمس الواقع، والصيرورة الواقعية. ومن دون فهم الأسباب الموضوعية التي أنتجت الدين في الماضي، وأنتجت هذه الظواهر الآن.
داعش هي نتاج واقع راهن. هي نتاج بيئات “مفوّتة” تعيش الماضي في أدنى مراحل انهياره، وهي بهذه الصفات لا تستطيع فعل ما تفعل، أو ما يقال إنها تفعل. وهذا الأمر يفرض أن يناقش من زوايا أخرى متعددة، في تكوين “مركّب”، تشكّل من عناصر متعددة، لا يفيد فيها التركيز على “الخلاف الفقهي”، أو “التفسير الفقهي”، ولا تعميم “أصلها” برميها على الدين، والتاريخ والتخلّف. بالتالي، لا بد من لمس المستوى السياسي الذي يجعلها تظهر فقط في المناطق التي تكون قد دخلت ضمن استراتيجيات الدول (المحلية أو العالمية).
وكذلك المستوى المتعلق بـ”الصورة” التي تبدو أنها من إخراج هوليوودي، وليس من قدرة فئات نقول إنها نتاج بيئات “مفوّتة”. وعلى ضوء ذلك كله، نستطيع أن نفسّر الخلافات الفقهية التي ظهرت في إطار المجموعات “الجهادية”، منذ عبد الله عزام إلى أبو بكر البغدادي وأبو محمد الجولاني.
العربي الجديد