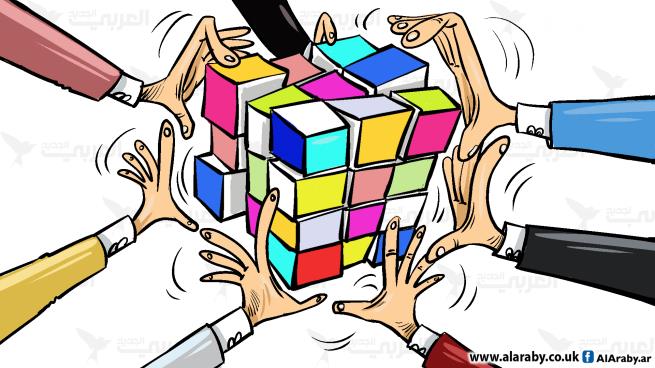السوريون المستميتون يهربون من مملكة الأوهام الأسدية إلى واقع الحرب الجارح
وضاح شرارة
“أُسِّست المملكة على صهوات الخيل
ولكنها لا تُحكم على ظهورها”
(أغوداي خان ابن جنكيز خان)
بينما كان الفتيان الماويون، في الصين الحمراء، وفي أقاليم ثورة أو حركة 1968 الأوروبية والعالمية، يشمرون عن سواعدهم المتحفزة، وينبرون للثورة الثقافية البروليتارية الكبرى الأولى على علاقات الإنتاج الرأسمالية وأبنيتها السياسية الأمرية والمرتبية الصلبة، ويقصفون “مقر الأركان” اليميني والمنيع، ويعدون بثورات ثقافية بروليتارية كبرى لا تقل من غير مبالغة عن الألف- كان فتيان ماويون آخرون، وربما هم أنفسهم، ينشدون، وقبضاتهم مشدودة ومرفوعة، “السلطة تخرج (أو تؤسس، على قول ابن الفاتح المغولي “الكبير”) من فوهة البندقية”. وفي المناقشات الدائرة على ثبات الحكم السلالي الأسدي، ودوامه منذ نحو نصف قرن او نيف وأربعين سنة، وبلائه وتماسكه في العاصفة التي تهب على سوريا منذ 14 شهراً وتنذر بالدوام نظيرها أو أكثر، يميل معظم المراقبين والمنخرطين الى تعليل الثبات والدوام والبلاء بالهتاف الماوي: السلطة مصدرها وركنها فوهة البندقية، وولاء حاملها الماشي في صف مرصوص وأعمى، وقيامه على مقر الأركان المنكفئ، في حال، أو على “الشعب” الأعزل والثائر، في حال أخرى.
مرض السلطة المميت
فيذهب المراقبون والمنخرطون أو معظمهم الغالب إلى أن العامل الأول في ثبات حكم الخان الثاني، بعد الخان الأول، الوقت الطويل المنصرم هو إرساؤه حكمه أو تسلطه ونظامه على احتكار السلاح وأجهزة القوة وأصولها وفروعها الاستخبارية والإدارية والرقابية والإعلامية والقضائية. فعلى رغم الخدمة العسكرية العامة، وشمولها فئة الشبان من غير تمييز من جملة سكان نحو 80 في المئة منهم من السنة غير العلويين ومن غير أنصار “السلالة” العصبيين، وسع حلف العشيرة الحاكم تمليك 70 في المئة من المناصب والأعمال النافذة والضاربة في أجهزة القوة لأهل العصبية والولاء الأقربين. واستيلاء طائفة تعد، اليوم، 9 في المئة من السكان (وخسرت نحو 2 في المئة من حصتها من السكان هما قربان ارتقاء شطر من نخبها)، على 70 في المئة من المناصب وعديد الأجسام والأسلاك القاهرة، هذا الاستيلاء يسد المنافذ على محاولات إضعاف القبضة المسلحة، ويحكم في هذه المحاولات بالإخفاق والتعثر. فإذا بلغ عديد القوات المسلحة والأجهزة المساندة نحو 400- 450 ألف “مجند”، وسع القيادة الآمرة خسارة 120 ألفاً الى 150 ألفاً من غير لحاق الشلل بها. وإلى اليوم، إذا صح أن المنضوين في صفوف الجيش السوري الحر بلغ عددهم حوالى 40 الى 60 ألفاً، لم تبلغ الخسارة إلا ثلث هذا العدد. والأغلب على الظن أن ثلثي الـ40 إلى 60 ألفاً “الأحرار” ليس في مستطاعهم القتال وربما لا يرغبون فيه، إما لنقص العتاد، وإما لعسر الانخراط في وحدات طرية العود وضعيفة التنسيق والانضباط، وإما لهول اختبار القتال الأهلي وفظاعته…
وتماسك العصبية المستولية من طريق العشير الجامع والواحد، واحتكار القوة والتصميم على القتل، علاج قديم ومشهور لتآكل السلطة و “مرضها” المميت خبرته المجتمعات العربية المشرقية والمغربية، وأعمل حكامها في سوس جماعاتها و “مجتمعات” هذه الجماعات أزماناً طويلة. ومن هذا الوجه، يشبه حكم العصبية الأسدية العلوية المستولية “ممالك” سابقة كثيرة ملأت قرون ضعف الدول الإسلامية الطويلة والمتمادية. ولم تغب ملاحظة هذا الأمر عن الخان الأول، ولا عن حلف الخانات الثلاثي، جديد- الأسد- عمران، الذي انفرط عقده إقصاءً وقتلاً. فتصدي ضباط أقلية ومذهبية وطرفية وريفية للاضطلاع بالدور الأول على رأس الدولة السورية خالف تقاليد عريقة وراسخة. فهذه قصرت الأقليات (المسيحية القومية على الأغلب) على المنافسة على المحل الثاني، أو الوزارة دون الإمارة، على قول فرنسوا زبَّال في تحليله “كليلة ودمنة” لابن المقفع. ويقتضي التربع في المحل الأول، وهو تقليدياً محل الكثرة السنية، عربية أو إسلامية سلطانية (سلجوقية عسكرية أو مملوكية غير قومية أو عثمانية)، يقتضي قوة معنوية وسياسية على الجمع والشبك تضوي إلى صاحب المحل الأول “عصبية الدولة”، وتقوم من الجماعات الفرعية الموالية مقام اللحمة و “النسب الوهمي”.
وفصَّل حافظ الأسد جهازَ الحكم السوري على مقاس استيلاء ضابط الاستخبارات العلوي الريفي والجبلي على الدولة الوطنية، عاصمة ومحافظات. وشرطُ التفصيل والإلباس الأول هو اجتثاث أضعف مسوغ ولو شكلي لاقتسام مقاليد السلطة الفعلية، كان المسوغ طائفياً طبعاً (حقوق الطوائف في التمثيل) أم محلياً (حقوق المناطق أو المحافظات) أم تقنياً (حقوق الخبرة) أم طبقياً (حقوق أصحاب رأس المال أو المستثمرين أو ملاك الأرض). فالحكم كله للـ “واحد” وحده. وحمل الديكتاتور الجديد نفسه وسلطته ونظامه على ضدٍ للأبواب التي أراد اجتثاثها: فهو قومي على خلاف الطائفية والقطرية، وهو شعبي على خلاف الطبقات… وتفترض هذه الحال ألا يبقى اثر لنفوذ المكانات والطبقات القديمة في اي مرفق من مرافق الدولة، وهذا أمر يسير نسبياً على الديكتاتوريات الثورية والحزبية، أو من مرافق المجتمع، وهذا أصعب وأشد عسراً حتى على الأحزاب الكليانية الشيوعية. وإطفاء أثر المكانات والطبقات القديمة، وتوهين عصبياتها ولحماتها، ونخر مقومات نفوذها، يُبلغ (أو تُبلغ) من طريق واحدة هي نصب الولاء الشخصي والمباشر للقائد الأوحد والأعلى معياراً للأهلية الوطنية، السياسية والاجتماعية. وتوحيد معيار الولاء يتيح أمرين مختلفين وربما متضاربين: تقريب أفراد ينتسبون الى جماعات مذهبية ومحلية واجتماعية “غير صديقة” ورذل جماعاتهم، من غير غمط الجماعة العصبية المستولية والنواتية “حقها” في الاستيلاء والسطو، تدريجاً، على المحل الأول ومقاليد الأمر وموارده. فالمعيار محايد وغير عصبي شكلاً وظاهراً، وهو الولاء للدولة، وللدولة العتيدة و”الجديدة”، على خلاف الدولة التقليدية المائعة والرخوة، جسد شاخص، من لحم ودم ولغة (أو خطابة)، يملأ الدولة المجردة والبعيدة بقوة عينية، ويمتلئ بها.
أحمال الدولة
ويسَّر اجتثاث النظام القديم، العثماني والفرنسي والسوري المختلط، عقدٌ أول من الانقلابات العسكرية (1949- 1958)، أعقبته 8 أعوام من ناصرية أصيلة وناصريات مقلِّدة، ثم 4- 5 اعوام من اختبار استيلاء متعثر على المحل الأول، فاقمت عثرته خسارة الجولان في أثنائها. وفي أثناء ربع القرن هذا (1946- 1970) تصدعت أركان حكم “الجماعات” القديمة. فغرقت هذه في انقساماتها ومنازعاتها وعداواتها، الناجمة عن مصالحها المباشرة وعصبياتها الأهلية و “الجهوية” وأحلافها الوطنية والإقليمية. ولا ريب في أن أحمال إنشاء الدولة الوطنية وسوسها، وخلافة الانتدابات، وإواليات حكمها المعقدة، وقيام إسرائيل، وتبعات الصراعات الدولية والإقليمية، هذه الأحمال فاق ثقلها قدرة الطبقات الحاكمة والطبقات المحكومة على الاحتمال، فهي خرجت، ومجتمعاتها، لتوها من قرون طويلة من التبعية والانقياد. ولم تتول السلطة الفعلية والمستقلة طوال الزمن المديد هذا ولم تصدر عن نفسها في أثنائه. وورثت بين ليلة وضحاها، في ميزان التاريخ السياسي والاجتماعي، سلطة ومجتمعاً كانت هذه الطبقات والجماعات عالة عليهما حين كانت سياستهما. وتدبيرهما بيد قوة خارجية. فقصارى جهد الطبقات والجماعات، في أثناء العهود التي توالت على مجتمعها “الوطني” الموروث، هو محاكاة أساليب الحكم الخارجي ومناهجه، وتقليدها. وطوال العهود المتفرقة هذه كانت الطبقات والجماعات المحلية أو الوطنية في موقع ضعف واستضعاف. فجاءت ابنية الدولة الوطنية المركزية، بمواردها وإداراتها وقواتها المسلحة، فوق طاقة الجماعات الحاكمة على التدبير والتصرف بكثير. فاقتصر الحكم غالباً، على المكانة والمنافع الريعية المتأتية من المكانة والاحتكار والحماية، وعلى المنافسة بين أصحابها على اقتسامها.
ولم يكن النهج الناصري، وهو وارث دولة راسخة ومستأسدة على جماعات مجتمعها، لا قبل الوحدة العابرة ولا في أثنائها، مدرسة تؤهل الجماعات والطبقات المحلية، على جهتي السلطة، للحكم والتدبير والتحكيم في المنازعات والخلافات. ولا وسع الديكتاتوريات العسكرية الرثة، قبل الوحدة ثم بعدها مباشرة، تولي مثل هذا التأجيل أو تمهيد الطريق إليه. فلم يصعب والحال هذه على لواء “المخابرات” الجوية تحميل “النظام القديم” كله، الوطني (القطري) والطائفي المذهبي (السني) والطبقي (“البورجوازي”) والحزبي العصبي والإيديولوجي، أوزار الركود والانقسام والهزائم والهشاشة “السورية”. وبدا استيلاؤه على الحكم منقذاً من الترجح والتطرف اللذين أوقع سوريا فيهما استيلاء صلاح جديد وزميلته اللدودين والأخوة الجندي وسليم حاطوم على الدولة قبل سنين قليلة. وأورثت الناصرية الأنظمةَ والدول والبلدان العربية المشرقية، فيما أورثتها، معايير رأي سياسية، جماهيرية عامية وقومية إقليمية ودولية عالمثالثية، لا فكاك منها تقريباً، وزادتها “الثورة” الفلسطينية صرامة. فإذا حاول نظامٌ الانفكاك منها سلط على نفسه إدانةً قاطعةً بالمحافظة والعزلة والتأخر.
فملأ حافظ خان (الأسد)، حين نصب نفسه قائداً قومياً، “عربياً سورياً”، فراغاً عميماً وعظيماً بفراغ عميم وعظيم يفوق سابقه وطأة وإيهاماً وتشبيهاً. فالفراغ السابق كان أبقى على حطام مجتمع وجماعات، وفتات إدارات وكفاءات وأفراد، وعلى بواعث سعي وعمل. فأسرع النظام الجديد الى التضييق عليها، قبل عزلها وخنقها وتصبيرها مومياءات في متاحف الصمت والخواء مثل الجبهة الوطنية ومجلس الشعب واتحادات العمال والفلاحين والكتّاب والصحافيين. ولكن الطاغية العربي ليس من مخلفات عصر مضى وأفل، على خلاف رأي أدبي و “تنويري” فيه. فهو شديد المعاصرة، ومتنبه الى مقتضيات هذه فوق تنبه التنويريين المحترفين. فسعى في “الامتلاء”، على ما تقدم القول، بروافد وموارد دولة تتصاغر الدولية التقليدية، المدعوة “دولة العصر الليبرالي”… العربي، بإزائها وتتضاءل. وزعم، غير هيَّاب ولا متردد، القدرة على الاضطلاع، معاً وفي آن، بالمهمات العظيمة والساحقة التي ناءت بها الجماعات والطبقات الحاكمة والمحكومة طوال ربع القرن الذي انقضى على رفع الانتداب وجلاء القوات المحتلة الأجنبية، وهي (المهمات) إنشاء الدولة الوطنية من صفر، والتصدي لتركة الانتدابات، وجبه إسرائيل، وتحمل تبعات الصراعات الدولية والإقليمية وإداراتها من دمشق وقصر الرئاسة فيها.
وماشى تفصيل حافظ الأسد جهاز حكمه على مقاس استيلائه وسعيه في اجتثاث مسوغات اقتسام السلطة أهواءً وبواعث سورية وعربية قائمة وفاعلة، على نحو ما ماشى زعمه مكافأة “دولته” المهمات العظيمة والساحقة المتخلفة من تصفية ذيول السلطنة العثمانية والاستعمار الغربي المباشر والمرحلة الوطنية والاستقلالية المتعثرة والمرحلة الناصرية المتلعثمة أهواءً شعبية، سورية وعربية، محمومة. وعلى رغم تحفظ عربي عريض، شعبي ورسمي، عن المثال القيادي الفظ والسري والباهت الذي جسده حافظ الأسد، وعن استيلائه على سوريا في أعقاب هزيمة 1967 وأيلول 1970 “الأسود” وشراكته فيهما على هذا القدر أو ذاك، على رغم التحفظ المزدوج طابقت أخيلة الخان الجبلي والعلوي السياسية والقومية أخيلة جماهيرية معاصرة. ولولا هذه المطابقة لما تمكن ضابط الاستخبارات المستولي من ممارسة الوصاية العدائية والثأرية على المنظمات الفلسطينية المسلحة منذ طردها من الأردن الى حين استقرارها و”تخزينها” (صلاح خلف) في لبنان، قبل نفيها الى اليمن وتونس وعودتها الى فلسطين مشرذمة ومتحاربة. ولما وسعه الإسهام الراجح في ابتكار اللبننة، ومزاولتها وتطويرها وإثرائها، طوال عقد ونصف العقد، وإغراق الفلسطينيين والإسرائيليين وغير هؤلاء وأولئك في “وحولها”، ثم توريثها نمطاً سياسياً ناجزاً ومدمراً يصلح لميادين ومسارح وطنية وأهلية متفرقة الى اليوم. وحالت الأخيلة المتطابقة، دون الانتباه الى انقلاب القائد العروبي والقومي الأول والمفترض الى قائد “إسلامي” ثانوي يعتال ويتعيش على نفوذ إيران الخمينية في أوساط الحركات الإسلامية الناشئة والقديمة، ويحتمي به من غائلة قمعه الدامي والفاجع لتمرد إسلاميين محليين عليه. ويتوسل بالمسألة الفلسطينية شأن إيران إلى تحصين نظامه من التحفظ العربي وعداوة الغرب.
الأخيلة المتضاربة
فقبل التماسك النسبي والجزئي والمترنح بعض الوقت في قلب العاصفة السورية، أرسى الخان الجبلي والأقلوي صروح “دولة” شامخة وطاغية ومقلقة على أسس غير قائمة إلا في الوهم. فـ “الدولة المفتاحية” (فاروق الشرع) في الملعب الشرق أوسطي وفيلته السكانية والاقتصادية والوسيطة والعسكرية تفترض كل ما لم يتوافر لحافظ الاسد: الموارد والعدد والتوزيع المقسط والقوات المقاتلة والمجهزة والديبلوماسية الخانقة. فالدولة التي أوجبها واحدة ومتشابكة في الوهم والتخييل والحسابات الاستراتيجية، لا تنتمي جماعاتها الى حيز سياسي أو تاريخي مشترك او متضافر: فبعض جنوبها ينظر الى الأردن بعض آخر الى فلسطين أو إلى شطر طائفي منها. وبعض شمالها ينظر الى العراق (أو الى شطر منه) وإلى شطر من تركيا. وبعض آخر هواه في كردستان على جبهتي الفرات أو وراء تركيا. والسهل السوري الفسيح بعضه يتصل بالساحل وامتداده اللبناني التجاري والمصرفي، وبعض آخر جزء لا يتجزأ من “الداخلية” العربية والبدوية النفطية وأسواقها وتجاراتها وأهوائها السياسية والمذهبية. وأما أقليات الجبال والمدن الكبيرة فيحلم بعضها بـ “حلف أقليات” خائفة ومنكفئة، حين يحلم بعضها الآخر بالهجرة واستيطان مهاجر بعيدة وغريبة. و”الأرياف” دوائر سكن وعمل واستنقاع ضيقة. ويحيط فقراؤها ومهاجروها الداخليون بالمدن أو بقاياها، إحاطة حبل المشنقة برقبة المشنوق (لينين). وهذا كله بقي على حاله طوال نصف قرن.
وهذا الإرث، وهذا المركب الأهلي والبلداني والسياسي والاجتماعي، رفعهما الخان المستولي إلى مرتبة القدوة والعلاج والأداة الاستراتيجية والتاريخية. وصدق الدعوى معظم السوريين والعرب معظم الوقت. وأرسى على هذا التصديق سياسة إقليمية فاعلة ومخربة. فلم يدر أحد من ضحاياها أو من الرابحين منها من أي طريق خَسِر أو من أي طريق ربح. ويعد هذا، أي النظام، قرينة على المهارة والإبداع والإعراب عن “روح الأمة”. ووسعه شق السوريين والعرب، والمجتمع الدولي، شقين وشطرين، وحال الى اليوم بين هذه الدوائر وبين الإجماع على رأي فيه، على رغم “هجنته” وغرابته الفاضحتين، وعلى رغم فصامه المروع، قولاً وعملاً.
ونظير “صمود” الخان الابن، وهو يبدو معقولاً أو قابلاً للاعتقال في شباك الفهم فوق قابلية ضده، ينهض مراس حركة السوريين وعنادها ودوامها على طرف نقيض. فيعصى النقيض أو الضد الفهم السببي، ذاك الذي يزاوله نشطاء هيئة التنسيق الوطنية على وجه التخصيص وبعض “مخضرمي” معارضة “الداخل”، والفهمَ الحدسي الذي يزاوله بعض محترفي التحليل التاريخي والأدبي. وما يُتناقل واستقر رواية جامعة لواقعتي تظاهرة 14 آذار 2011 بدمشق (“الشعب السوري ما بينذل”) وتظاهرة 18 من الشهر نفسه بدرعا (والعَلَم عليها جواب ضابط الأمن قريب الخان الأهل: “انسوا أولادكم” ثم “هاتوا نساءكم إذا كنتم عاجزين عن استنتاجهن أولاداً محل أولادكم”)، يدعو الى العجب. فإلى 14- 18 آذار 2011 لم ينتبه سواد السوريين الى انهم، ومن ولدوهم قبل جيل من اليوم وبلغوا 50 الى 60 سنة، إنما عاشوا في ذل عميم ومقيم ليس بعده ذل. ولم يدركوا، على هذا، أن “المجد” الذي أعطيه الخان والفاتح الجبلي والمذهبي إنما ارتفع سراباً خلاباً في صحراء خالية إلا من الكذب وأشراكه التي لا تحصى، ومن عظام عشرات آلاف القتلى عنوة وملايين الموتى كمداً وخيبة وخسراناً ممضاً.
ولكن السوريين الذين يقومون على طاغيتهم، “الواحد”، ويرمون بأنفسهم في مرامي نيرانه، ولم يبالوا بثمن هائل يسددونه لم يتستر الطاغية يوماً على هول فاتورته ولوح به منذ أيامه الأولى عِدْلاً وكفواً لأضعف اعتراض أو تحفظ وصدَّق التلويح في شتاء 1982 بحماة، هؤلاء السوريون يفزعون الى مقاتلهم اليوم من انهيار صروح الكذب والتشبيه العالية التي رفعها الطاغية. فكأن (على سبيل الاستقراء) الاستماتة، الباهظة الثمن والموقَّعة والمتمايلة والمنتشية، هي جواب تصدع “سوريا الأسد” وثمرة هذا التصدع. فيصدق في السوريين ما قاله بوريس باسترناك، صاحب “دكتور جيفاغو”، في “ترحيب” الروس بدخول بلادهم الحرب العالمية الثانية، وإقبالهم عليها على رغم أثمانها العظيمة. فهو قال في تعليل الترحيب والإقبال هذين ان الحرب والموت والقتل فيها كانت واسطة الروس “السوفياتيين” و”الستالينيين” إلى الواقع، وطريقهم أو جسرهم إليه، بعد 23 سنة من التخييل الاشتراكي والأممي الشامخ. فالموت في حرب حقيقية ومادية، هي عزاء “مواطني” ممالك الوهم التي يبنيها طغاة عقيمون
المستقبل