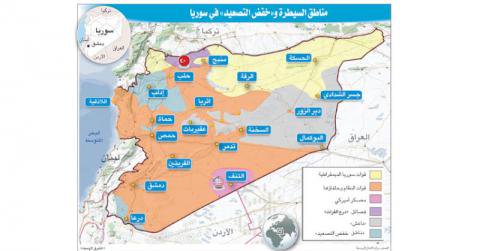المثقفون السوريون والثورة
أكرم البني
تنحسر مع تفاقم المأساة الانسانية فرص الحياد والنأي بالنفس في الأوساط الثقافية السورية، وتحرم صور الخراب المعمم وأعداد ما فتئت تزداد من الضحايا والمعتقلين والمشردين هذه النخبة من “عادتها” في التهرب من المسؤولية وتحديد موقف واضح مما يجري في البلاد.
والمعنى أن الثورة السورية وضعت المثقفين والمبدعين ولأول مرة أمام امتحان نوعي لاختبار مدى عمق خيارهم الإنساني وعمق التزامهم بمعاناة أهلهم، وأعادت فرزهم بصورة أكثر حدة وحسماً، بين من أعلن انحيازه التام إلى صفوف الحراك الثوري ودعم مطالبه المشروعة في الحرية والكرامة وبناء الدولة الديمقراطية، وبين من لا يزال يبحث عن ذريعة يستند إليها لتبرير انهزاميته واستمرار سلبيته وتردده في اتخاذ موقف واضح، وبين من زاد التصاقه بالسلطة ووقف مع أهل الحكم وعمل على تسويغ ارتكاباتهم ونشر ذرائعهم عن المؤامرة والعصابات المسلحة وجماعات أصولية أو سلفية تتحين الفرصة للانقضاض على السلطة والمجتمع!
الاصطفاف الأخير هو الاصطفاف الشائع في بلادنا، وقد نجحت النخبة الحاكمة وطيلة عقود في استنبات أنواع شتى من المثقفين الموالين لها وتسخير إنتاجاهم وإبداعاتهم الفكرية لتثبيت ركائزها وسياساتها ولتعضيد النظام الذي تقوده وضمان تأييد الناس له وقبولهم به، منهم من آثروا الصمت والتزموا الحياد تجاه مآسي المجتمع ومعاناته المريرة وساهموا في نشر روح الخوف والخنوع طلباً للسلامة، ومنهم من قدم، طوعاً أو كرهاً، بعض أشكال الدعم والمساندة للحكام واكتفى من الغنيمة بالإياب.
وكان أكثرهم سوءاً، من اندمج في عالم السلطة ومغانمها وصارت مهمته الرئيسة تبرير سياسات الحاكم وتسويغ ممارساته الاستبدادية والدفاع عن بطشه وظلمه، ليضمحل أو يغيب دور المثقف النقدي ولتتصدر اللوحة وجوه أتقنت الترويج للوضع القائم وأسسه السيادية وثلة من المحازبين للسلطة أو الأتباع أو لنقل ما يشبه الأبواق تدافع عن سياساتها ومواقفها.
لكن انهيار “الستاتيكو” القديم، وتبدل المشهد السوري بفعل استخدام العنف المفرط وتصميم أهل السلطة على المعالجة الأمنية وأسلوب القمع الواسع والعشوائي لمواجهة تصاعد المظاهرات الاحتجاجية، ساعد في نشوء وعي “محايث” للحراك الشعبي العفوي في أوساط المثقفين يلح على إعادتهم إلى موقعهم الحقيقي وتسخير المجال الثقافي ليكون مدخلاً مناسباً للتفاعل مع الناس وتمكينهم وتعزيز وحدتهم وصمودهم، لنشهد حالة من إعادة الاصطفاف لشريحة من المفكرين والكتاب والفنانين جاؤوا من شتى المنابت والمشارب واختاروا دعم حراك شعبهم ومطالبه، بعضهم كرد فعل أخلاقي ووجداني على ما يرونه من عنف مفرط لا يحتمل، وبعضهم لأنهم استشعروا أنهم أكثر المعنيين بمطالب الحرية والمساواة وقيم المواطنة وحقوق الإنسان التي ينادي المتظاهرون بها، وبعضهم من باب الحرص على تجاوز الأوضاع المتفاقمة بأقل تكلفة ممكنة ربطاً بإدراكهم لحجم المخاطر المحتملة على الدولة ومصير المجتمع ووحدته الوطنية بسبب توغل أصحاب الخيار الأمني والعسكري في خيارهم!
إن رفض القمع والإقصاء وإدانة استخدام القوة العسكرية ضد المتظاهرين العزل وسقوط العديد من القتلى والجرحى كان فاتحة لتحرك بعض المثقفين السوريين، وشهدنا مع تطور الأحداث عدداً من اللقاءات والاجتماعات دعا اليها مثقفون لبناء تصور مشترك لتغليب لغة العقل والحوار ونبذ العنف وتعزيز روح التضامن والوحدة الوطنية، تزامنت مع إصدار بعض الرسائل والبيانات والعهود الوطنية، حملت أسماء أدباء وشعراء وفنانين من مختلف المدن السورية، كان أشهرها ما عرف “ببيان الحليب” الذي طالب بإيصال الحليب والغذاء لأطفال وأهالي مدينة درعا المحاصرة، وأفضى إلى حصار بعض الشخصيات الأدبية والفنية والتشهير بها، ونضيف هنا ما أعلنه بعض المثقفين من مواقف مؤيدة للثورة خلال لقاءات إعلامية وما عرض من لوحات ورسوم داعمة للاحتجاجات تدين العنف السلطوي، دون أن ننسى المشاركات المتنوعة والجريئة لعدد من الكتاب والفنانين في بعض المظاهرات والاعتصامات ومبادراتهم لإلقاء كلمات تضامنية مع الثورة والشهداء في مجالس العزاء التي أقيمت في بعض المناطق والأحياء.
ما سبق إذ يشير إلى حيوية الحقل الثقافي السوري بعد خموله الطويل، وإذ يكشف تنامي شجاعة المثقفين ورغبتهم في المشاركة وجهوزيتهم لتحمل المسؤولية في هذه اللحظة الحساسة، لكنه في المقابل وبعيداً عن لغة المصالح وتفاوت درجات الاستعداد للمواجهة والتضحية يكشف عن كتلة من المثقفين لا يزالون لأسباب معرفية ينأون بأنفسهم عن الأحداث وتجمعهم تحفظات متنوعة على الثورة ومروحة واسعة من الحجج والذرائع لتسويغ ذلك.
بعضهم لعجزه إلى الآن عن إحداث قطيعة فكرية مع العقلية والطرائق القديمة ولا يزال أسيراً لشعارات مواجهة الصهيونية وتحرير الأرض، ومحاربة المؤامرات والأخطار التي تحيكها الدوائر الاستعمارية، ويعتبر الحفاظ على ما يسمى “حالة الممانعة القائمة” مكتسبا وطنيا وقوميا، وكأن هزائمنا المتعددة وحالنا التي تثير الشفقة لم تقل كلمتها بحق هذه العقلية! وبعضهم لأنه يجد فيما يجري تنفيذاً لرؤية أميركية قديمة عن “الفوضى الخلاقة” مستنداً إلى ما صارت اليه أحوال البلاد وإلى الإرباكات والتوترات التي تعاني منها الثورات العربية الأخرى، كي يطعن بمشروعية الثورة وبأنها جالبة للاضطرابات والفوضى والتذرر.
وبعضهم لخشيته من ازدياد دور القوى الإسلامية بتنويعاتها في الثورة، وتخوفه من خطورة المشروع السلفي على الديمقراطية وبنية الدولة والمجتمع، مبالغاً في انتقاداته لبعض الهتافات والرايات الدينية التي ترفع، أو لاعتماد المساجد مراكز لانطلاق المظاهرات، وأيضاً للقيمة التي تعطى لأيام الجمعة في وضع الشعارات وتوجيه المحتجين، ولما يشاع عن قدوم مئات المجاهدين إلى سوريا لمناصرة الثورة تحت شعار “نصرة الإسلام في بلاد الشام”.
وبعضهم لأنه يعيب على الثورة شعبيتها وهذا الاختلاط الطبقي العجيب بين المحتجين، فلا تقنعه مظاهرات تضم الغني والفقير وتلتحق بها فئات اجتماعية تتباين مصالحها الاقتصادية، ولا يعجبه تقدم شعارات الحرية والديمقراطية والكرامة على شعارات مناهضة الفقر والعوز والبحث عن فرص العمل! وبعضهم لأنه يلتقط تجاوزات بعض الجماعات المحسوبة على المعارضة، ويبالغ في عرضها للطعن بأخلاق الثورة، أو يتكئ على خلافات قوى المعارضة وما تظهره من أمراض ومن تشتت وعجز عن تنسيق نشاطاتها، ليظهر استياءه من النزعات الأنانية والانفعالية لمتحدثين باسمها، وما يشاع عن فساد وسرقة لأموال المهجرين واللاجئين، وعن صراعات على المواقع والمناصب.
صحيح أن المثقفين السوريين لا يشكلون كتلة متجانسة موحدة الأهداف والاهتمامات، بل هم فئات متنوعة تخترقها المصالح والحسابات الذاتية، وصحيح أن بعضهم لا تزال تأسره طرائق التفكير القديمة ولم يتحرر بعد من دور التعبئة الأيديولوجية في دراسة الظواهر وتحليل الأحداث، وأن غالبيتهم لم تعتد ولنقل أحجمت لفترات طويلة ولأسباب متنوعة عن ممارسة نقد ضد التسلط وانتهاكات حقوق الإنسان، ولم تظهر قدراً كافياً من التضحية والشجاعة للاعتزاز بالحياة الإنسانية وحرية التفكير والإبداع، لكن الصحيح أيضاً أن ثمة مشتركا يجمعهم بصفتهم عموماً أشد الناس التصاقاً بالمعرفة وأقربهم إلى تحكيم العقل والنقد وأكثرهم استعداداً للتعبير الإبداعي والإنساني عن هموم البشر وتطلعاتهم، والأهم أكثرهم تأثراً بما يحصل من مشاهد ومجازر مروعة يندى لها جبين الإنسانية، ما يضع على عاتقهم مهمة نوعية تتعاظم موضوعياً اليوم للرد على ما وصلت إليه أحوالنا، وعلى الأقل للتضامن مع تضحيات الجماعة التي يعيشون بين ظهرانيها، وما تكابده من قهر وتنكيل.
في الماضي عندما كان الشعب السوري ينوء تحت وطأة التخلف والجهل واستبداد السلطنة العثمانية، كان المفكرون والمثقفون هم أول من بادر للرد على هذه الوقائع، فتقدموا بجرأة للعب دورهم في إيقاظ الناس من سباتهم الطويل وقدموا لقاء ذلك التضحيات الجسام، واليوم مع الحضور المتنامي لدور البشر في تقرير مصائرهم وإصرارهم، أياً يكن الثمن، على نيل حريتهم وكرامتهم، ينهض تحد جديد أمام المثقفين السوريين وتغدو الحاجة ماسة لدورهم في نقد هذا الواقع المريض ومشاركة الجماهير معاناتها وهمومها، كما مطالبها وتطلعاتها!
هو أمر حيوي أن يعقد الأمل على دور المثقفين السوريين في مسيرة الخلاص، ربما للتعويض عن قصور المعارضة السياسية وقد شتتها أمراضها وأضعفها القمع والإقصاء وشروط نضال قاسية، وربما لصدقيتهم والثقة بضمائرهم المنحازة بداهة لحقوق البشر وحرياتهم، وربما كرهان على روح المسؤولية العالية لديهم الرافضة لتخريب المجتمع وتفكيكه وتجنيب البلاد النتائج السلبية والمدمرة التي يرجح أن تنجم عن الإصرار على التوغل في الخيار الأمني!
هي عقود من القمع والفساد ردت الثورة عليها، وأزاحت الستار عن مجتمع حي بكل ما يحويه من علل وأمراض، فاتحة صيرورة وعهداً جديداً عنوانه الشعب يريد، ومستدعية في الحقل الثقافي ضرورة تصحيح علاقة المثقفين مع محيطهم ولنقل إعادة الاعتبار لموقعهم المتميز في المجتمع.
وإذا كانت المسؤولية الأساسية في خلق هوة بين المثقف والجمهور تقع على عاتق الاستبداد الذي عطل فعالية الثقافة وأخضعها لمصالحه وحاجاته وقطع تيار المعرفة من الوصول إلى المجتمع تحت طائلة التخوين والنفي والسجن، فثمة جزء من المسؤولية يتحمله المثقفون أنفسهم باستسلامهم لنتائج ما يحصل والتردد في المجاهدة الذاتية لردم هذه الهوة، ولنقل استسهال التعايش مع حالة الحياد والسلبية، وخلق المبررات للتهرب من واجبهم في التعبير عن معاناة المجتمع وآلامه وحاجاته والمساهمة في تغييره.
ليس من مثقف حقيقي من يتنكر لحقوق الناس وحرياتهم، من يخون الموقف الصائب من الاستبداد بوصفه المسؤول الرئيس عما نعيشه الآن، من لا يستند إلى الثورة لإجراء مراجعة نقدية لموقعه ودوره في المجتمع، وليس من مثقف قادر أن يبدع نقدياً إذا ما استمر في الارتهان لرؤية أيديولوجية بما فيها من ثوابت معرفية وتحصينات فكرية والتزامات مسبقة بصور وحلول جاهزة، ولم يتسلح أولاً وقبل كل شيء بطرائق التفكير العلمي المفتوح على مختلف التجارب التاريخية، ومن لا يعمل على نشر ثقافة ديمقراطية تتفهم الاختلافات القائمة بين الناس وما يترتب عليها من اجتهادات وتغذي روح التعايش معها دون أن تسعى إلى تهمشيها أو إلغائها.
وليس من مثقف حقيقي من لا يساهم بدوره في بناء رؤية جديدة ذات بعد نهضوي لمستقبل البلاد كنقطة انطلاق لتجاوز ما تشهده الثقافة بصورة عامة من خسوف الاتجاهات العقلانية وتراجع المشروع التنويري ودوره في استيعاب مقومات الحضارة الحديثة، وأيضاً للرد على الأصوات اللاعقلانية التي تدعو إلى العيش في الماضي والموروث دون نقد أو اجتهاد وبنفس القدر مواجهة الروح الدوغمائية بوجهيها الوطني والقومي، ملاك الحقيقة المطلقة غير القابلة للاختبار أو النقاش والذين درجوا على تغليب الصور والعبارات المحفوظة على كل دليل عقلي أو تجريبي.
ثورة الحرية والكرامة في سوريا هي ثورة تطاول الحقل الثقافي أيضاً، ثورة تخلق الفرص لتأكيد التزام المثقفين بمعاناة شعبهم وحقوقه، وأيضاً لتحريرهم من حالة “النوسان” الأيديولوجي بين ثقافة الاستبداد السلطوية وبين النزعة الظلامية والعقائدية الدوغمائية، ثورة تفتح الآفاق واسعة لإعادة صياغة دور المعرفة في الحياة، وبناء التصورات المرتبطة بالتاريخ الحي، وقراءة المسارات المحتملة في سياق تحولات الأحداث وتطورها كما تجري على أرض الواقع لا كما ترسمها العقول والأفكار.
الجزيرة نت