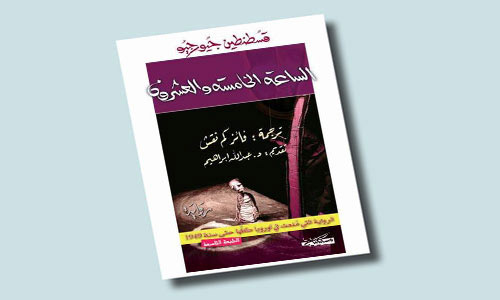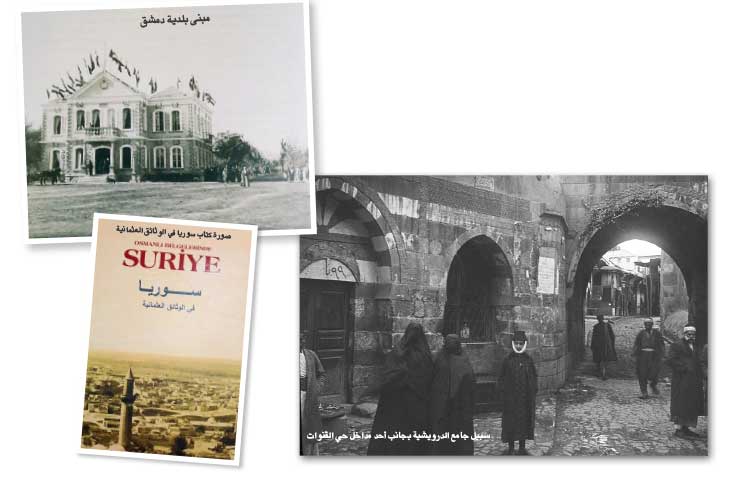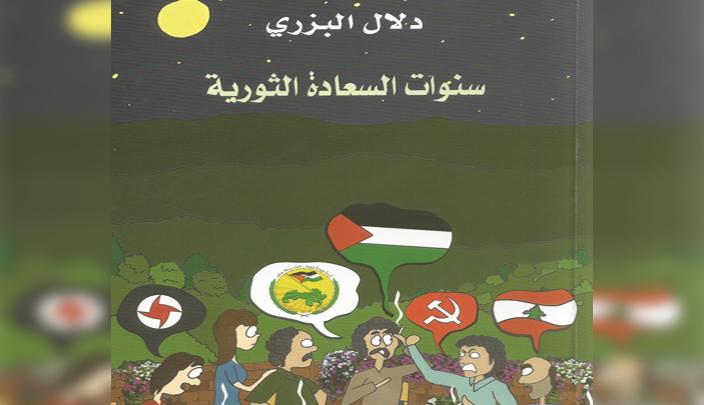المقاهي والثورات والسياسة: من إسطنبول العثمانية إلى باريس الستينيات/ محمد تركي الربيعو
يعتقد المؤرخ العثماني إبراهيم باشوي 1574ـ 1650 أن عادة شرب القهوة والأماكن التي تقدمها قد دخلت إلى القسطنطينية العثمانية بفضل تاجرين سوريين، هما حكيم وشمس، وذلك في غضون عام 1555.
ووفقاً لما يؤكده جيوليو فيراري في مؤلفه «التقاليد القديمة والحديثة» الذي نُشِر في عام 1832، فإن هذين التاجرين فتحا هناك منزلين لشرب القهوة في حي طوب كابي، وهذا ما أثار إعجاباً لا مثيل له، وجذب إليه الحشود العديدة من البكوات والأسياد والضباط من كل مقام والقضاة، وأشخاصاً آخرين من كل طبقة ومهنة، فأضحت هذه المقاهي مكاناً يجتمع فيه سكان المدن ليقضوا فيه الساعات بأكملها، كي يلعبوا الدامة والشطرنج أو ليتحدثوا عن الفن والعلوم والآداب. وخلال سنوات وصل عدد المقاهي في ظل حكم سليمان الثاني 1565 ـ 1574 إلى حوالي ستمئة مقهى تنتشر في المدينة القديمة. لذلك ومنذ اليوم الذي فكر فيه التاجران حكيم وشمس بفتح المقهيين بالقرب من البازار المصري، ورغم كل اللعنات التي صبها رجال الدين القلقون مما اعتبروه آثاراً ضارة لهذا المشروب، فقد أخذت القهوة تشهد انتشاراً واسعاً داخل المدن العثمانية، لتنشر لاحقاً على الجانب الآخر من المتوسط في عدد من المدن الأوروبية.
ولعل رحلة هذه المقاهي بين المدن المتوسطية هو ما شغل بال المؤرخ الفرنسي جيرار جورج لوميرعلى امتداد كتابه «القهوة والأدب: المقاهي الأدبية من القاهرة إلى باريس»، والمُترجم حديثاً للعربية عن دار ألكا، ترجمة مي محمود.
فبدءاً من إسطنبول، مروراً بالقاهرة وبعض المدن في المغرب العربي، وانتهاءً بمقاهي باريس ومثقفيها، هي الرحلة التي قضتها قهوة السوريين حكيم وشمس خلال ما يقارب الأربعة قرون. من هنا يحاول جيرار البحث في قصة هذه القهوة، وما حملته من أفكار وتطورات وتغيرات في عادات المجتمع، ليس على مستوى الشراب وحسب، بل أيضاً على مستوى الاجتماع، وتبادل الأفكار، وحتى على مستوى بناء مجال عام جديد، كما هو الشأن في أوروبا. كما يكشف لنا الكتاب أن روح القهوة والمقاهي، لا يفوح منها تاريخ تحول اجتماعي وحسب، أو روح الصوفيين حكيم وشمس اللذين جلباها إلى المدينة، بل تفوح منها أيضاً رائحة تمردات وثورات؛ ورائحة تاريخ آخر من العلاقة بين السلطة والمديـــــنة، مغاير لبعض الرسوم الكاريكاتيرية التي ترددها بعض الكتب المدرسية.
ففي القرن السابع عشر عُدّت المقاهي في ظل مراد الرابع مقرات للفساد؛ إذ وجد الأخير أن المقاهي أصبحت مكاناً للقاء المتآمرين والجنود العصاة، وهذا ما عزّز من كلام بعض المحافظين، الذين كانوا يستاؤون من طريقة احتفال المتصوفة بالقهوة، عبر تقديمها بطريقة ظنوها انحلالاً أخلاقياً، في حين يمكن تأويل طريقة التقديم هذه باعتبارها جزءاً من مقدس أو طقوس الانتهاك (إذا اعتمدنا على مقولات الأنثروبولوجي المغربي عبد الله حمودي) التي عادة ما تترافق مع طقوس المتصوفة، التي هي التعبير الأكثر وفاء ـ بعكس السلفية مثلاً ـ عن معنى المقدس الإسلامي (ينقسم وفقاً لروجيه كايوا وحمودي ونور الدين الزاهي إلى مقدس احترام ومقدس انتهاك).
وقد أراد السلطان في الواقع، من خلال دعمه لحجج المحافظين والمعترضين على القهوة، أن يضرب ـ وفقاً للوميرـ أماكن النقاشات الحرة إن لم نقل التحريضية. إذ وفّرت المقاهي مجالاً يتيح للعامة، وبعض الجماعات التعبير عن آرائها بشكل علني حول دور السلطات المحلية؛ وبالتالي كان إغلاقها بالاساس يأتي من باب الدوافع السياسية. لكن فترة الإغلاق هذه لم تطل، وسرعان ما لبثت المقاهي أن عادت في الربع الأخير من القرن السابع عشر، لتكتسب شعبية لم تشهدها في أي وقت مضى.
ومع فترة التنظيمات العثمانية عند نهاية القرن التاسع عشر؛ تنوّعت المقاهي وصُنِفت إلى فئات معينة، كما ظهرت – وفقاً للومير- عبارة جديدة تُستخدم للإشارة إلى عدد منها وهي «خيرتان»، التي استُخدِمت للإشارة إلى الأماكن التي توفّر للزبون مطالعة الصحف والمجلات، وأحدث ما ظهر في المكتبات، فقد تحول أحد المقاهي وهو «سرافيم» الواقع في حي بيازيد بالقرب من البازار القديم، إلى صالون حقيقي خلال ليالي رمضان، فغالباً ما تجمّع فيها المثقفون من أمثال نامق كمال ليتحدثوا عن القضايا السياسية، وليعلّقوا على الأخبار، ويتناقشوا في الآداب والفنون خاصة، كما غدت المقاهي مكاناً متميزاً ورصيناً، حيث يتجنب الجميع التحدث بصوت عال، ولا يأتي أحدهم إلى المقهى إلا بما يليق من الملابس. بيد أن قدوم أتاتورك دق جرس النهاية لهذه الساعات الثرية، التي كان يقضيها الناس في المقاهي بعيداً عن الهموم. ولتدخل تركيا مع هذا الأفول زمناً آخر؛ إلا أن القهوة سرعان ما ستعثر على أماكن جديدة/قديمة لها، لإكمال دورها في نشر الأفكار وتبادلها خلال النصف الأول من القرن العشرين.
فمدينة القاهرة، التي عرفت القهوة في زمن العثمانيين، وقبله ربما، سرعان ما ستكون أمام فصل جديد من علاقة هذا المشروب وأماكنه بالنهضة الفكرية والأدبية التي كانت تعيشها في تلك الفترة. وكأن لومير بانتقاله من مقاهي إسطنبول إلى مقاهي القاهرة، يشير إلى دور لروح القهوة ربما خلف بعض الدعوات والمشاريع التي كانت تنادي بأن تكون مدينة القاهرة بديلا عن إسطنبول الخلافة؛ لما لا، وتاريخها مليء بالتمردات والثورات ضد السلاطين. ومن عساه – وفقاً للمؤلف – أن يكون أفضل من نجيب محفوظ، مرشداً يقودنا إلى دروب وعوالم مقاهي القاهرة، مدينة الخلافة الضائعة. ففي فترة الشباب، اكتشف محفوظ مقهى زقاق المدق، الواقع بالقرب من جامع الأزهر، وفي هذا المقهى بالذات، رسم في خياله مشاهد رواية «زقاق المدق».
وعندما جرى تحديث الصالون الأدبي لمقهى ريش، قرر صاحب المقهى أن يغلقها أيام الجمع، عند ذلك انتقل محفوظ ورفاقه إلى أحد مقاهي الأرصفة الصيفية المحاذية للنيل، وحدث له أن انتقل أخيراً إلى مقاهي الحسين. بيد أن جماعة الكُتّاب الجدد لم تكن لهم صلة بزمرة عرابي، أي رفاق العباسية القدامى، ولهذا السبب آثروا ارتياد كازينو الأوبرا، فكان يأتي إليها كتّاب مهمون مثل لويس عوض وسلامة موسى وفتحي غانم.
وفي نهاية المطاف، عمدت الجماعة إلى تنظيم قرارات عامة. استمرت حتى لاحظها رجال ناصر في بداية الستينيات. ففي بادئ الأمر شاركهم الحضور ضابط بوليس، كان يصغي إلى النقاشات الأدبية وينتفض عند سماعه أسماء مثل: كافكا أو بروست، أو مصطلحات الواقعية والحداثة، أو غيرها من لغة الأدب الاصطلاحية، ولذلك طلب من نجيب محفوظ أن يكتب له التقرير الذي سيرفعه إلى البوليس، فطُرِد من الاجتماعات. ومع قدوم السبعينيات والثمانينيات، يبدو أن المناخ الفكري والثقافي الذي كانت تعيشه هذه المقاهي، أخذ يتلاشى شيئاً فشيئاً في ظل إغلاق المجال العام الذي كانت تعيشه المدينة، لتشهد في التسعينيات وبداية الألفية الجديدة (كما تنبهت إلى ذلك الأنثروبولوجية الهولندية انوك دي كوننغ في كتابها «أحلام عولمية» غزواً من مقاهي الستاربكس، التي بات ارتيادها شرطاً للانضمام إلى عالم النخب الجديدة، في حين غدت مقاهي المتصوفة أماكن للمهمشين والخطرين على المجتمع.
انقلاب الأدوار:
ولكن كيف كان حال رحلة قهوة شمس وحكيم على الطرف الآخر من المتوسط؟ داخل المدن الفرنسية بالأخص. هنا يلاحظ لومير تشابهاً بين الجدال حول القهوة في المدن العثمانية، والجدال الذي شهدته مدن فرنسية في القرن السابع عشر، فكثيرون كانوا يعتبرونه مشروبًا غير مضر أو خاصاً بالمسلمين.
أما عن تبدُّل القناعات لاحقاً، فيعزو لومير هذا الفضل لشخصية السفير العثماني مصطفى آغا، التي ألهمت موليير لكتابة مسرحيته «البورجوازي النبيل»، إذ سحر هذا السفير القصر الفرنسي بتهذيبه، فما لبث أن عمل الفرنسيون على تقليد عاداته في المأكل والمشرب، وسرعان ما اعتمدوا شرب القهوة مذللين مرارتها بالعسل والسكر.
مع ذلك لم تستطع القهوة دخول نطاق العادات، ولذلك فقد بقيت المدن الأوروبية في غياب المقاهي فقيرة على مستوى الحياة العامة إلا ما كان منها من حانات، والتي غالباً ما كانت موصومة بسوء السمعة، وكذلك الكابريهات التي لم تكن مكاناً يرتاده ابناء العوائل الفاضلة. وفي عام 1672 افتتح باسكال، وهو من أصل أرمني، محلاً لبيع القهوة في معرض سان جيرمان الذي أُقيم في شهر سبتمبر/أيلول، بيد أن هذه المقاهي الأولى كانت بيوت مظلمة وقليلة الجاذبية، وبالخلاصة كانت شبيهة بالكابريهات، فقد كان روادها يدخنون ويشربون القهوة المغشوشة والبيرة السيئة، وكما كان الحال مع الحانات فقد كان من العار على شخص محترم أن يظهر في هذه المقاهي. لاحقاً، تضاعفت أعداد المقاهي، ولا سيما بعد أن أنشأ تويوفراست رونودو صحيف الكازيت عام 1631 وابتداء من هذا العام شهدت الدوريات الإخبارية نجاحاً متزايداً، كما أخذ يُنظر إلى المقهى بأنها أكثر قدرة على إعمال الفكر على نحو أفضل مما هو في الكباريه، وهذا ما يفسر مقدار تعلق رجال الأدب في القرن الثامن عشر بالمقهى.
وقد بقي تأثير المقاهي على الطبقة الفرنسية يزداد تعاظماً في القرن الثامن عشر، لكن شكلها وطرازها تغيّر جذرياً، وعلى نحو تناسب مع الشهرة التي حظيت بها وحجم الآمال التي عُقِدت عليها، ومنها على الأخص الأمل في البقاء ضمن الاهتياج والاضطراب الذي طال المجتمع برمته، كما شكّلت غالبية المقاهي مراكز للمعارضة السياسية، حيث تُوجّه أشدُّ الانتقادات إلى تصرفات الحكومة. ولم تغيّر الحرب العالمية الأولى والثانية من الأمور شيئاً، وجعل الشعراء من المقهى مملكتهم. وفي شتاء عام 1942 كان معظم أدباء المقهى يكتبون متقوقعين على أنفسهم، منكمشين داخل أرديتهم يغطّون وجوههم باللفافات، والباقون يتحدثون بصوت خافت أو يتنقلون بخطوات محسوبة، لكي لا يزعجوا العاملين فيه. وكانت سيمون دو بوفوار أول من لاحظت محاسنه وأفادت منها، كما يشير جان بول سارتر «لم نلبث أن استقررنا فيها تماماً، فكنا نصل فيها من التاسعة صباحاً حتى منتصف النهار ثم نذهب للغداء وعند الثانية بعد الظهر نعود إليها».
لقد اخترح سارتر الفلسفة الوجودية التي حققت انتصاراً عقب الثورة بإدخالها الفكر الألماني إلى فرنسا داخل مقهى فلور، الذي كانت له طقوسه الخاصة، وكان زبائنه يعيشون فيه كما لو كانوا يعيشون في إناء مغلق؛ ويحرص سارتر على أن يبيّن لنا ذلك ويقول: «لم يكن الغريب مقبولاً ولا محبوباً على الإطلاق». ولم يكن سارتر يعود إليه إلا بصحبة ميرلو بونتي وزوجته. كما كان البير كامو يحب المجيء إليه، وأصبح بيكاسو من رواده المواظبين، إضافة للمحلل النفساني جاك لاكا؛ وكان الجميع يحضر كل يوم، ما ساهم بإطالة تقليد الزيارة إلى مقهى فلور، خلال سنوات الستينيات، ثم استولى على المكان عالم السينما مثل جون وش وجيرار فيليب وجسد جميعهم مرحلة أفول المقهى المشرف.
٭ كاتب سوري
القدس العربي