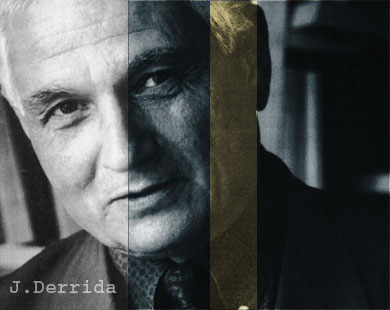تشيسواف مِيووش: لم أقلْ ما كنتُ أفكّرُ فيه حقاً

ترجمة وتقديم : هاتف جنابي
لا خلاف اليومَ بين المختصين في حقل الأدب وبخاصة الشعر البولندي، حول أهمية ومكانة ميووش الشعرية والأدبية. يعتبره البعضُ أهم شعراء بولندا، لكنّ غالبيتهم تميلُ إلى اعتباره أحدَ كبار شعرائها في القرن العشرين، واضعينه جنب كلٍّ من الراحل زبيغنيف هربرت (1924-1998) وتادئوش روزيفيتش (1921-2014) وفيسوافا شيمبورسكا (1923-2012). ويلاحظ القارئ تقارباً في العمر بينهم، وعليه فهم من جيل واحد، رغم كون ميووش أكبرَهم سناً. وميووش بحسب تعبير الشاعرة البولندية المعروفة يوليا هارتفيغ (1921) قادرٌ على «تحويل المواضيع التي تبدو غيرَ شعرية إلى شعر حقيقي.
إنّ شعره مفتوحٌ على المواضيع كافة التي تُثيره كإنسانٍ، وهذا بحدّ ذاتهِ أمرٌ نادرُ الحدوث لدى الشعراء الآخرين. ربما هذه صفة الشعراء الكبار». وميووش، وفقاً لرأي الناقد البولندي البروفسور يان بْوونْسكي: «يستطيعُ التكلم بكلّ اللغات الشعرية».
تشيسواف ميووش (هكذا يُلفظُ بالبولندية) ولدَ في 30 حزيران 1911 في ليتوانيا، في عائلة بولندية ذات تقاليد. كان يتكلم البولندية في البيت، والروسية في الشارع وأحيانا الليتوانية والبيلوروسية.
تعلم اللاتينية أثناء دراسة الحقوق، وفي ما بعد العبرية، والانكليزية والفرنسية. في عام 1937 انتقل نهائياً إلى وارسو. ساهم أثناء الاحتلال النازي لبولندا، في الحركة الثقافية السرية المناهضة للاحتلال. انتقل في 1945 إلى مدينة كراكوف التي هجرها إلى منفاه في الولايات المتحدة الأميركية ثم عاد إليها في 1993 ليقضي فيها بقية حياته.
كانت سنوات الخمسينات والستينات (أقام في باريس لاجئاً سياسياً منذ 1951، وفي 1960عُيّنَ أستاذاً في جامعة بركلي في أميركا)، فترة تثبيت اسمه كشاعر وناقد ومترجم وروائي، لكنه في بادئ الأمر، حظي بشهرة خارج بولندا بفضل نقده الجريء، العميق واللامع، للوضع السياسي والثقافي لبلاده ومنطقة وسط وشرق أوروبا، في كتابه الشهير «العقل الأسير» الذي أنجزه أواخر 1951 وصدر في 1953 بثلاث لغات: البولندية والفرنسية والإنكليزية. تبعه برواية الأولى «الاستيلاء على السلطة» التي أصدرتها «دار غاليمار» في 1953. والأمرُ الذي يلفت انتباهنا في هذا المقام، هو رأيه في الرواية بشكل عام، كتب حينئذ: «اشتركتُ في مسابقة للرواية التي أعلنها… أحد نوادي الكتاب السويسرية، «رغم اتفاقي مع رأي ستانيسواف إغناتسي فيتكيفيتش، بأن الرواية ليستْ عملاً فنياً، إذْ لا يعدو كونها «كيساً» يمكن للمؤلف أن يُعَبّئ فيه كلّ ما في كبده»، مع ذلك فقد عبّأ تشيسواف بعد تلك الرواية «كيسين اثنين»!
لم يترك الفائز بجائزة «نوبل» (1980) موضوعاً إلا وكتب فيه شعراً، محافظاً قدر المستطاع على انضباط شعري، رغم تنوع الأشكال التي مارسها. من الناحية الشكلية استفاد من «المرونة» التي امتاز بها الشعر الفرنسي، لكنه حافظ على إيقاعه الشعري، وانضباط قصيدته بنيوياً وفكرياً، وهو بذلك يذكرنا إلى حد ما بما امتاز به الشعرُ الأنغلو – ساسكي. هكذا هو شعر ميووش، لمن يقرأه للوهلة الأولى، مزيج من الروح السلافية والإرث الفكري – الثقافي – الحضاري الغربي، بيد أنه ظل قلقاً، يبحث عن ذاته وتطوير أدواته الشعرية شكلاً ومضموناً حتى وفاته في 14 آب (أغسطس) 2004. عرفته شخصياً، وكانت لي معه قبل ذلك مراسلات أثناء منفاه الأميركي. منحني ثقته بالموافقة على ترجمة شعره، وكنت أول من ترجمه من البولندية إلى العربية مطلع الثمانينات.
كتبَ في قصيدته «آرس بوئتيكا» (بيركلي 1968):
«كنتُ دائما أتطلّعُ لشكلٍ أكثرَ رحابةً،
خلْوَاً من إفراط الشعر والنثر…».
وعن فائدة الشعر يجيب في القصيدة نفسها:
«فائدةُ الشعر أنْ يُذَكّرَنَا
كيف من الصعبِ عليكَ أنْ تكونَ ذاتك».
حاول ميووش أن يلتحم بالواقع وبنفس القدر أنْ يبتعدَ عنه. كتب: «أحدُ مواضيع كتاباتي هو البحث عن الواقع، الواقعُ هو معضلةٌ حقيقيةٌ اليومَ». ولكي ينجو من دنس الواقع، حاول أن يخلق لنفسه «بحبوحة»، أي تلك التي ينشدها الشاعر والفنان، وكأنه يُطبّقُ فكرة سيمون وايل القائلة: «المسافة روحُ الجمال». المسافة التي يعمل على كسبها الشاعر والفنان بكدّه وعرق مسعاه. في اعتقاده هناك مستويان للواقع: المستوى الواقعي الفعلي- المكاني، والمستوى المتخيّل. والشعرُ يجدُ نفسه في الفضاء الثاني. كان ميووش يعتقد في أعماقه، بهذا القدر أو ذاك، بأن الشاعرَ خاضعٌ لقوةٍ خفية، لشيطان الشعر. رغم المسافة التي أوجدها ميووش بينه وبين اللاهوتية إلا أنه لم يبتعدْ كثيراً عن فكرة أن المخيلة ببعدها الفضائي – المكاني قد ارتبطتْ وتشكلتْ من خلال الدين والمعتقدات.
القصائد التالية غير منشورة سابقاً بالعربية، اخترناها (باستثاء أغنية حول نهاية العالم) من أشعار تشيسواف ميووش في فترة ما بين الحربين العالميتين الأولى والثانية، التي كان يركز فيها الشاعرُ على ثنائية الفكرة والشكل عبر إيقاعية متميزة وموهبة واضحة وسَمتْ أشعاره الأولى، وقادتْ في ما بعد لولادة ديوانه «الخلاص» (1945) الذي يعتبره النقادُ البولنديون أحد أهم الأعمال الشعرية البولندية التي صدرت بعد الحرب العالمية الثانية.
أنتِ الليلةُ القوية
أنتِ الليلةُ القوية. لا لهيبُ الشفاهْ
يُدرككِ، ولا ظلُّ الغيومِ الصافيةْ
أسمعُ صوتَك في دوائرِ الحلم الدامسِةْ.
وتُشرقينَ هكذا كما لو أنّ النهارَ جاء.
أنتِ ليلةٌ. أنا وإيّاكِ في الحبِّ على استرخاء
خَمّنْتُ مصيرَ وسوءَ الحروب الآتية.
يَمُرّ الرّعاعُ والشهرةُ من حولنا تَجُوزُ
وتنطلق الموسيقى كما لو أنّ زجاجاً داسه حذاء.
أقوياءُ هم الأعداءُ والأرضُ ضيقة
وأنتِ لها أيتها الحبيبةُ مخلصةْ.
عند مياه الأرض غصنُ لَيْلَكٍ حَنَتْهُ
الريحُ أسْوَدُ من غابةٍ مجهولة.
حكمةٌ عظيمةٌ، أيتها الفانية
طِيبةٌ غيرُ أنثويةٍ في يديك الواهنتين
ولمعُ معرفة يُشرقُ فوق الجبين:
قمرٌ مستكينٌ وبدرٌ دون اكتمال.
مع ذلك
مع ذلك كنا هكذا متشابهين
بكلِّ ابتذالِ أعْضَائِنا وفُرُوجِناً
بقلبنا النابضِ بقوةٍ في النشوةِ والخوف،
بالأمل، الأمل، الأمل.
مع ذلك كنا هكذا متشابهين
بحيث إن التنانين الكسولةَ وهي تتمطى في الهواء
كانت تحسبنا إخوةً وأخوات،
يلعبون في وئام في حديقة مشمسة،
فقط نحن لم نكنْ نعرف ذلك،
منغلقين كلُّ واحد في جلده، على انفراد،
لسنا في حديقة، لكن في أرض مريرة.
مع ذلك كنا متشابهين هكذا،
رغم أن كل ورقة عشب كان لها مصيرها،
كل عصفور في الفِناء، كلُّ فأرةِ حقل.
والرضيع الذي يحصل على اسم «يان» وربّما «تريسا»،
وُلِدَ إما في سعادةٍ طويلة أو مُعاناةٍ وعار
مرةً واحدةً حتى نهاية العالم.
هذا العالم
من الواضحِ أن ذلك كان سوءَ فهمٍ
وما كانَ مجردَ محاولةٍ حَرْفياً أخذوه.
ستعود الأنهارُ بعدَ قليلٍ إلى بداياتها،
تتوقف الريحُ عن دورانها.
الأشجارُ بدلاً من التبرعم ستسعى إلى جذورها.
الكبارُ يركضون وراء الكرة،
يتطلعون في المرآة ومرة أخرى يكونون أطفالاً.
سيستيقظ الموتى دون أن يُدْرِكوا.
حتى يصيرَ ما حدث وكأنه لم يحدثْ.
يا له من انشراح! تنفسوا الصعداءَ يا منْ عانيتم كثيراً.
إنْسَ
إنسَ المعاناةَ
التي ألْحَقْتَها بالآخرين
إنسَ المعاناةَ
التي بكَ أُلْحِقَتْ
المياهُ تجري وتجري
الرِّبَاعُ تتلألأ ثم تتلاشى
تسيرُ في أرض تتذكرها بالكاد
أحياناً تسمع أغنيةً عن بعد
ماذا تعني، تسأل؟
مَنْ هناك يُغنّي؟
الشمسُ الطفليةُ تُشْرقُ
حفيدك والحفيدُ الأكبرُ يولدُ
مرةً أخرى تُقادُ الآنَ من يدك
ما برحتْ أسماءُ الأنهار معك
كيف تعرف الأنهارُ أن تدومَ طويلاً
حقولكَ هاجعةٌ مُرَاحة،
قلاعُ المدنِ ليستْ مثلما كانتْ
وأنتَ تقف أبكمَ عند العتبةْ.
هذا واضح
واضحٌ أنني لم أقلْ ما كنتُ أفكّرُ فيه حقاً،
لأنّ مَنْ يَسْتحقُّ الاحترامَ هم الفانونَ،
ولأنه من غير المسموح الكشف شفهياً ولا خطياً
عن أسرار ابتذالنا الجسدي المشترك.
ثمة عمل مخصص للمترددِ الضعيفِ الحائر:
في أنْ يرتفع سنتمترين أعلى رأسه
كي يُمْكنَهُ القول لليائس:
«أنا مثلك أيضا ندبتُ على نفسي».
أغنيةٌ حول نهاية العالم
في يوم نهاية العالم
النحلةُ تحلّقُ فوق زهرةِ الكبوسين
الصيادُ يُصْلِحُ الشبكة اللامعة
الدلافينُ المرحةُ تتقافزُ في البحرِ،
العصافيرُ الفتيةُ تنقرُ الميزابَ،
والأفعى لها جلدٌ أصفرُ، كما ينبغي أنْ يكون.
في يوم نهاية العالم
النساءُ يَمْشِيْنَ في الحقل تحت المظلات،
السكّيرُ ينامُ على حافةِ العشبِ،
باعةُ الخضرواتِ يُنادونَ في الشارعِ
والزورقُ ذو الشراعِ الأصفرِ يُبْحِرُ للجزيرة
صوتُ الكمان يتواصلُ في الفضاء
ويكشفُ الليلةَ النجمية.
والذين انتظروا البروقَ والرعودَ
هم خائبون
والذين انتظروا الإشاراتِ والطبولَ الملائكية،
لا يُصدقون أنها تحدثُ الآن.
طالما أنّ الشمسَ والقمرَ في الأعالي،
طالما أنّ النحلةَ الطنّانةَ تزورُ الوردة،
طالما أن الأطفالَ المتوردينَ يولدون،
لا أحدَ يُصدّق أنها تحدثُ الآن.
وحدَهُ العجوزُ الأشيبُ الذي كادَ أنْ يكونَ نبياً،
لكنه ليس بنبيّ، لأن لديه شغلاً آخر،
يقولُ وهو يربطُ الطماطمَ:
لنْ تكونَ نهايةٌ أخرى للعالم،
لنْ تكونَ نهايةٌ أخرى للعالمِ.