تكعيب ياسوناري كاواباتا/ صبحي حديدي
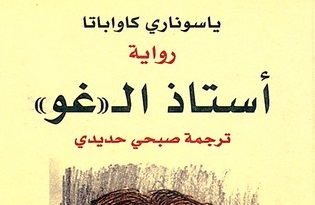
نشرت صحيفة «جابان تايمز» سلسلة مقالات بعنوان «كيف شكّلت الفنون البصرية أدب اليابان»، وقعها داميان فلاناغان، الناقد البريطاني المختصّ بالأدب الياباني. الحلقة الأخيرة، التي نُشرت قبل أيام، كان عنوانها «نافذة ياسوناري كاواباتا السيريالية على العالم»؛ وفيها يساجل فلاناغان بأنّ «بلد الثلوج»، رواية كاواباتا الشهيرة (نقلها إلى العربية الشاعر اللبناني الراحل بسام حجار)، «محاولة راديكالية» تسعى إلى «تطبيق تقنيات الرسم الغربي الحداثي وما بعد التكعيبي على قماش الأدب الياباني». وهذه قراءة تذهب عكس ما هو شائع في تفسير الرواية، في أنها أقرب إلى مرثية حزينة ــ كعادة غالبية أعمال كاواباتا ــ ترصد محاق التراث الياباني في مختلف ميادينه.
ويتوقف فلاناغان عند الجملة الأولى في الرواية، التي تسير هكذا (في الترجمة الإنكليزية): «عند انبثاقهم من نفق الحدود الطويل، دخلوا بلد الثلوج» (في ترجمة حجار: «نفق طويل بين منطقتين وها قد حللنا في بلد الثلوج»)؛ فيعتبرها الأشهر في نماذج السرد الياباني على امتداد القرن العشرين، لكنه يقرأها من زاوية مغايرة، وجديدة حقا: أنها «تمهيد لما سيكشفه القطار بعد خروجه من العتمة إلى الضياء: أنّ نوافذه ليست ألواح زجاج تشفّ عن عناصر الطبيعة في بلد الثلوج الذي يعبره القطار، بل هي مرايا تكعيبية وسيريالية تزيغ عندها الرؤية، ويضطرب الإدراك، وتتشوّه المعطيات؛ على نحو كثيف سوف يتابعه القارئ في سلسلة من التداعيات المتعاقبة التي تنتاب شيمامورا، بطل الرواية.
والحال أنّ هذا التأويل هو الأحدث عهدا، في نطاق مخزون هائل، زاخر ومتواصل، من شغف (ولعلي أقول: هوس!) إعادة قراءة أعمال كاواباتا، ليس على سبيل إعادة تثمينها عبر تحليلات متنوعة المناهج والمدارس والأدوات، فحسب؛ بل، كذلك، لاسكتشاف واكتشاف أيّ جديد طارئ، ومفاجئ، يمكن أن يخرق، أو حتى يُبطل، المأثور والمألوف والمستقرّ والشائع عن أدب أحد كبار أساتذة الرواية في القرن العشرين. وضمن هذه الروحية وجدتني، شخصيا، أعيد قراءة «بلد الثلوج»، في الترجمتين الإنكليزية والعربية، بحثا عن المعطيات التي قادت فلاناغان إلى استنتاجاته بصدد السيريالية وما بعد التكعيبية في الرواية. خذوا، مثلا، هذه الفقرة (بترجمة حجار): «في الخلفية البعيدة جدا كان منظر المساء يرتسم متواليا كأنه أصبح، على نحو ما، طبقة قصدير متماوجة لهذه المرآة. وكانت الوجوه البشرية التي تعكسها أكثر وضوحا إذ تتداخل كصور مضاعفة في شريط. لم يكن هناك بالتأكيد أي رابط بين الصور المتوالية في الخلفية المعتمة وتلك، الأكثر وضوحا، للشخصين الجالسين. ومع ذلك كان الكلّ متناغما في وحدة رائعة، فكم كانت الشفافية الأثيرية للوجوه تبدو ملائمة وممتزجة بالتشوّش المعتم للمنظر الذي يكتنفه الليل، ليشكلا معا كونا واحدا وحيدا، ضربا من العوالم التي تفوق الطبيعة، العوالم الرمزية التي لا تنتمي إلى هذه الأرض…».
كذلك توجّب أن أستذكر بعض الحقائق التي تحكي سيرة الرواية، والتي تكتسب دلالة خاصة هنا: أنها نُشرت أولا في صيغة حلقات، بين 1935 و1937، ثمّ عاد كاواباتا واشتغل عليها مجددا، وأضاف إليها أجزاء جديدة، ثمّ صنع منها نسخة نهائية؛ نُشرت سنة 1948، واتخذت هذه الهيئة التي يعتبر فلاناغان أنها «تركيب تكعيبي». كذلك فإنّ مشهد الفصل الأخير يدور في صالة سينما، الأمر الذي يحيل إلى طور في تاريخ الرواية اليابانية الحديثة شهد تأثر أمثال كاواباتا وجونيشيرو تانيزاكي بتقنيات الفنّ السابع. وأخيرا، أنّ ابن كاواباتا كان رساما، متمرد المزاج، منحازا إلى التيارات التشكيلية الحداثية الأكثر جذرية في عصره، مثل التكعيبية والسيريالية والمستقبلية والتعبيرية والدادائية؛ وبالتالي لم يكن الأب بعيدا عن أهواء الابن، كما يذكّرنا فلاناغان أيضا.
ولعلّ قراءة الناقد البريطاني في «جابان تايمز» تذكّر بقراءة أخرى للأرجنتيني ألبرتو مانغويل، عقد فيها مقارنة حاسمة بين رواية كاواباتا «منزل الجميلات النائمات»، ورواية غابرييل غارسيا ماركيز «ذكريات عن عاهراتي الكئيبات»؛ حيث اعتبر العمل الثاني سطحيا، وباهتا، وفاقدا لكثير من المهارات الفنّية الفريدة التي ميّزت تراثه الروائي الفذ؛ على نقيض العمل الأوّل، الذي أغدق عليه مانويل آيات المديح، محقا بالطبع. والإنصاف يقتضي التذكير، هنا، بإقرار ماركيز علانية ـبأنه إنما كتب روايته تحقيقا لحلم قديم في مجاراة رواية كاواباتا تلك، من جانب أوّل؛ وأنه، من جانب ثانٍ، جسّد حلمه ذاك بعد توقف عن الكتابة الروائية دام قرابة عقد كامل، تفرّغ فيه لإنهاء سيرته الذاتية المعروفة.
ومن جانبي، وإذْ شرّفني أن أنقل اثنتين من روايات كاواباتا إلى العربية، هما «ضجيج الجبل» و«أستاذ الـ غو»؛ أرى أنّ استمرار «النبش» المعمّق في منجز كاواباتا، وإعادة استدراك ما غفل عنه النقد الأدبي من خصائص عبقرية فريدة، هو بعض ردّ الجميل إلى معلّم كبير قدّم للإنسانية اختراقات كبرى في أغوار النفس البشرية، وفي برازخ العشق والاغتراب والشيخوخة والموت. ولم يكن غريبا أن يصبح أوّل أديب ياباني ينال جائزة نوبل للأدب، سنة 1968؛ وأن يُفضي به وعيه المأساوي الحادّ بواقع اليابان الحديث، ومعضلة البطل الملحمي الكسير، إلى الانتحار. فلا ضرر، إذن، في تكعيب روايته، بل ثمة كلّ المغنم والمثوبة.
القدس العربي

