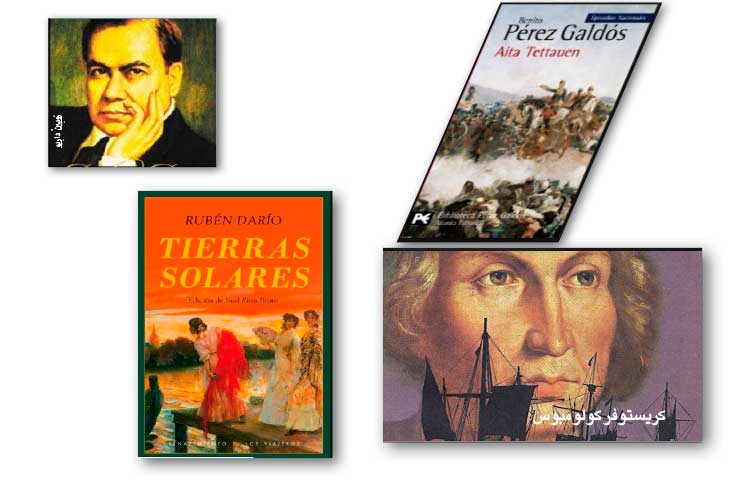دمشق “داخلَ” بيروت: شكراً لبيت الصداقة/ علي جازو
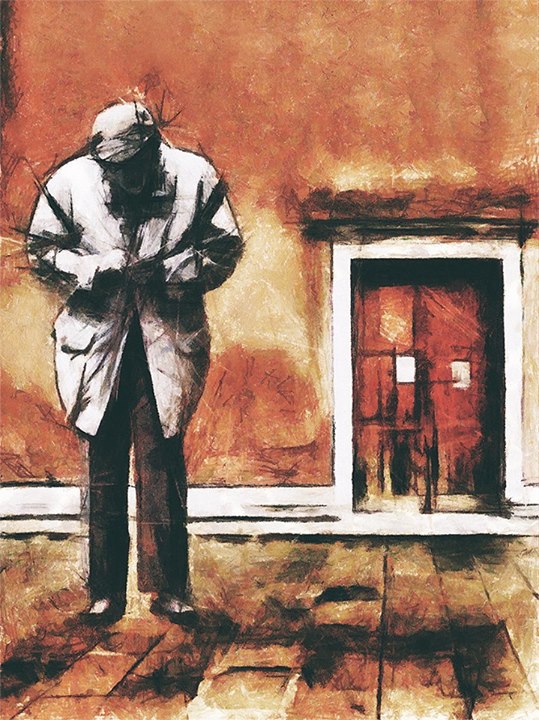
بيروت متاهة صغيرة، جيبٌ توضع فيه اليدان معاً: يد النعيم السكرانة منكمشة ومحاصرة ومتعرقة داخل قبضة كاتمة من يد الجحيم. بيروت بابل معاصرة متداخلة، مغرية ومتغيرة، عسيرة، ومتوترة. خيالها أضعف من مادة حياتها حيث القسوة أشمل من أن تُحصى وأثقل من أن تُزال. حركة النقل فيها سريعة وأخبارها محزنة. لا تقف عند شيء حتى تضع آخر مكانه، لكنها محل تتلاقى فيه العيون مع أرقها والخطوات مع عثراتها والوجوه مع أحلامها، لتعود وتلتمّ تعبة كروح مرهقة حزينة. قتلٌ هنا، وقتلٌ هناك، كأنما آلة جهنمية تنسخ الأحداث وكأن ضحاياها صور، لاغير. ليسوا بشراً، قدر ما هم قربان خسارات فاقت المعقول، ولم تعد تجد مكاناً داخل القلب ليبكي، ولا بيتاً لتأمن وترتاح. بيت كأي بيت!
كأنك داخل بيروت تحنّ إلى ما لن تكونه، لكنها تسعى إليه وتطلبه. بيروت ممر إلى غد لا يشبهها الآن. هي التي بقيت، رغم هشاشتها، من بين عواصم كثيرة، بلا أخبار كأخبار القاهرة، وبلا مكانة كمكانة دمشق – الثورة. لم تدخل الثورة بيروت، ذلك أنها عاشتها بأكثر من طريقة، وطلبتها ودفعت أثماناً باهظة لثوارات مختلطة وحكم احتلال شمولي قذر مديد خانق.
أنا بطيء وأشرد كثيراً. بيروت سريعة، وعليّ أن ألحق بها. لولا أصدقاء مدهشون في محبتهم وحرصهم وتعاونهم لما استطعت البقاء في بيروت. الآن لي أكثر من بيت، أكثر من بلد. لي قلوب أصدقائي من أهل بيروت، وهي أوسع من حجارة البيوت وألطف من لمسة خدّ الصباح على وجهي، وجهي الهارب. ذاكرتي ذاكرة مدينة رحبة. أتنقّلُ في بيروت، من شارع إلى شارع، عارفاً ومتأكداً أنني سأضيع الطريق؛ إذْ تحملني عيناي صوب أمكنةٍ لا تنتهي إليها قدماي! آمل أن أتعرّف على المدينة في أقلّ وقت ممكن، لكنني أفشل أن أحفظ الأسماء والمعابر “من” و”إلى”. علي أن أنظر فوق دائماً، بنايات ترتفع، وعمال يعرقون ويواصلون العمل في عز دين القلق والتوتر. ماذا تعني “سوديكو” مثلاً، ومن أين يا ترى أتى إسمُ “ساسين” إلى ساحة ضيقة لا تشبه تصورّي عن الساحات التي يفترض بها أن تكون واسعة كبيرة؟ هناك مشروع لترميم المكتبة الوطنية. متى يحل اليوم الذي نتلاقى فيه داخل المكاتب الرحبة، لا فوق جمر الخوف والكراهية واستحالة العيش. سائقو السرافيس مستعجلون، متذمرون، تنتقل عدوى استعجالهم إليك حالما تركب جنبهم. فردان، مونو، كولا. أسماء راقصة، ملمومة على بعضها، إذا ما فكرتَ بها كألفاظ فحسب. إذْ تلفظها على نحوٍ صوتيّ كمن يتعلم النطق أول مرة، تحسّها ضئيلة هشّة خفيفة، كما لو كانت مكوَّنة من ذرات منفصلة، من ذاكرة بعيدة تهترئ حالها كحال أي مكان، وما يدعمها الآن لا يشبه السببَ الذي أتى بها أسماءً على أمكنةٍ! تبدو الأسماء، لوهلة، منفصلة عمّا تشير إليه.
لمَ المكاتب أقرب إلى غرف ضيقة مغلقة، وشاغلوها يفكرون بما يحدث خارجها، لكنهم حينما يغادرونها يشعرون أنهم لم يغادروا؟ هناك بنوك كثيرة، كثيرة جداً. دعايات، دعايات تضرب العين في كلّ الطرق. أقول إن المشي أفضل، لكن المسافة بعيدة، والطرق مختلطة، وثمة مرتفعات سرعان ما ترهقني فيسيل العرق من صدغيّ وتثقل الرطوبة مشيي. ما أصعب التنقل هنا، وفيما أبحث عن طريق يمكنني السير فيه مشياً على قدميّ، ينصحني الشخص الذي أسأله أن آخذ سيارة أجرة. أحسُّ جسدي يحاصرني، وخطواتي تتثاقل كأنما هي تتحرك في مكان مغلق. ألهذا تراني أتعثر وأتوه؟ قدماي تتحركان في ماضي ذاكرتي، وجسدي يستصعب الاندماج في جسد المدينة – الحاضر الذي ليس لي سواه. ثمة مدينتان، واحدة تتحرك داخلي، وأخرى أتحرك داخلها. هذا جسر، ألا يشبه الجسر الفاصل بين ساحة المرجة والبحصة، وهذا الباص الأبيض الصغير السريع، أليس هو ذاته الذي جلست داخله أكثر من مرة نازلاً من أكراد إلى المهاجرين، ماراً بالجسر الأبيض؟ داخل نفسي تحضر دمشق. ما تراه عيني الآن من أمكنة ومقاه في بيروت تدخله أماكن ومقاه من دمشق، تخالطه وتتمزج به: مقهى الكمال الصيفي بدل مقهى ليلى في الجميزة، ومقهى الروضة عوض التاء المربوطة في الحمرا، ومكتبة إيتانا مكان دار المصوّر. إنها عين ذاكرتي التي تنظر وتستحضر وترى. يحمل المرء المكان في داخله، وإذ ينظر حوله يتمنى أن يجد شبهاً ما بين ذاكرته ومكان إقامته الحالية. إنه الحنين الذي يحسبه المفسّرون جرحاً. آخرون يجدونه مرضاً، لكنني لا أفكر بالتفاسير الآن ولم تعد هي ما يشغلني. يحدثني أحدهم عن “حرش بيروت”. سرعان ما أزوره عصر اليوم التالي. يستفسر شرطي البلدية، واقفاً أمام مدخل الحديقة، عن هويتي، وعن بطاقة اشتراك للدخول! لكنّه، بعد أن يراني سعيداً برغبتي الدخول والتجوال أول مرة كمن يكشتف كنزاً، يتنازل عن الترخيص، لمرة واحدة فقط. ترتفع نسمات خضراء مضيئة داخل الحرش الذي أعيدت إليه الأشجار على نحو ربما يشفي ذاكرة أحرقتها الحرب الأهلية اللبنانية.
أخيراً وجدت حديقة في بيروت، حديقة حقيقية. أشجار صنوبر غضة، ممشى مفروش برمل ناعم. كنت أجلس في حديقة السبكي، وأتذكر أن الشاعرة دعد حداد كانت تجلس هناك أيضاً، مطرودة وحائرة وممتلئة بحيوات وحيوات لا تكفي شاعرة “تبكي من شدّة الشّعر”! كانت دمشق رحبة، وبيوتها غير عالية ولا أبراج بها كحال بيروت التي لا ترى منها سوى بناياتها، ترتفع وتعلو بواجهات زجاجية سوداء. هناك كانت دمشق القديمة، باب توما، باب شرقي. كان يمكنني السير هناك في زواريب ظليلة. والسماء كانت أقرب من سماء بيروت. لكن دمشق كانت متيبسة كصمت باب قديم مغلق، كانت مزدحمة بنسيان أليف حوّل الرعب إلى عادة والنسيان إلى كلمات. كانت دمشق خائفة، خائفة، خائفة، وكانت الثورة، لم تزل، ثمن تجاوز الخوف.
يبدو أن التذكر يزيل الخوف عن الأماكن، إذ تغدو أقرب إلى موجة زمنية منها إلى كتل مكانية حاصرة وثقيلة. المكان ثابت والزمن ممحاة، لكن الإثنين يلتقيان ويستردان ما لهما دون تناقض، إذ لا تفاضل هنا، بل مزج واندغام وصهر. هذا أقرب إلى الإصغاء، إلى الموسيقى، منها إلى رؤية مكان عبر العين وحدها. أتخيل مكاناً مؤلفاً من أنغام وإيقاعات. تلك رغبة، لكنها حين تغدو جزءاً من العصب وجزءاً من اللهفة تصنع لهما مكاناً على مقاسها واشتعالها. ربما الذاكرة، مشفوعة بموجات حنين مرير، وحدها القادرة على أن تقوم بهذا العمل الغريب. لكأنّ داخل الذاكرة حجراتٍ آمنة، لكأنها بذلك مكانٌ محميٌّ، ضدّ الخوف، ضدّ النسيان. بيروت تذكرنا بدمشق، دمشق التي تصغر وتتضاءل وتحترق، فيما بيروت تحتوي ما هرب من الرماد، ونجا من ليل دمشق الطويل، لكي تعود إليه ثانية، بعد أن يستعيد أهل دمشق مدينتهم من نظامٍ يحتلّها ويدمّرها. مدينتان تختلطان الآن، لتكونا أوسع من جغرافيا العنف والكراهية وتبادل الثأر بثأر والخسارة بخسارة. مدينتان تتعارفان من جديد، لتكونا أقرب إلى شغف الصداقة الجديدة والتعارف الجميل، حيث يودع الواحد منا ذاكرته قلبَ الآخر، منهما إلى قرابة الدم اللعينة تلك التي تتناسل حقداً وعماء وبشاعة.
النهار