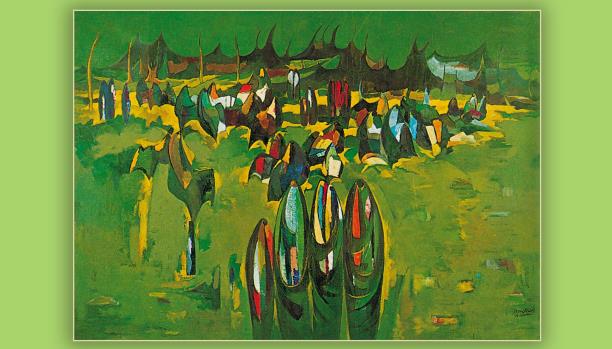سحر الأدب/ منتصر عبد الموجود

في معرض حديثه عن احتراف الأدب، ذكر ماركيز أنه كان في الثالثة عشر حين طالع ترجمة لألف ليلة وليلة، قصة صياد فقير ذهب إلى بيت صديقه ليستعير شبكة الصيد، كان الزوج خارج البيت، فعرضت عليه الزوجة اتفاقا قَبَلَه، ستعطيه الشبكة بشرط أن يعيدها مبكرا قبل عودة الزوج، وأن يعطيها سمكة من حصيلة صيده، التزم الصياد الشاب بالاتفاق، أعاد الشبكة مبكرا ومعها سمكة، حين شرعت الزوجة في تنظيفها، وجدت داخلها ماسة كبيرة بحجم جوزة الهند! يقول ماركيز إنه بعد قراءة هذه القصة، أدرك انه سيصبح كاتبا، فقد وقع أسيرا لسحرها وتحديدا لسحر تفصيلة صغيرة، أن امرأة هي من منحت الصياد الفقير الشبكة، يرى ماركيز أنه لو أخذ الشبكة من صديقه الرجل؛ لفقدت القصة سحرها، لماذا؟ لا يدري، فهذا سر من أسرار الإبداع.
طالما حمل الأدب ذلك السحر الذي نسعى خلفه متجاوزين التفكير في الجدوى من عدمها، وجميع الأعمال الأدبية على اختلاف قيمتها احتوت – بدرجات متفاوتة – على قبس من ذلك السحر، وحده الوعي الفني للكاتب قد يسعفه فيمزج ذلك القبس بعناصرأخرى – بعضها نفيس والآخر خسيس! – وفق معايير أشبه ما تكون باطنية، تسعى في ضوئها الأجزاء إلى التماهي في عمل مركب؛ يتمدد السحر عبر أوصاله كتمدد الدماء في الجسد الحي.
ما من وصفة للنجاح، وما من خطوات معدة سلفا، بل كل شيء خاضع للفوضى التي هي – من منظور أعلى – نظام يحتاج إلى كشف(1). فقوة هذا السحر قد تنعدم أو تتلاشى بين يدي كاتب توسل للنجاح كل سبيل، بينما يتجلى واضحا في عملٍ فشلَ كاتبه في الإخلاص لطموحٍ ما قبل شروعه في الكتابة، مَنْ مِن القراء لم يغض الطرف عن فشل توماس مان في مبحثه الجمالي حول الزمن عبر صفحات روايته (الجبل السحري)، ليس لأنه أفحم الجميع بسلسلة من الحوارات العميقة بين يهودي أجبره الفقر على التخلي عن عقيدته استجابة لما قدمته التنظيمات اليسوعية ثم الماسونية من فرصة للترقي الأكاديمي والمجتمعي، وبين ليبرالي إيطالي صارت الطبيعة بالنسبة له أخر المعاقل الإيمانية الجديرة بمنحها ثقته! بل لأنه – توماس مان – أصاب هدفا أبعد وأعمق من هذا الذي وضعه نصب عينيه حين شرع في الكتابة، فقدم استعارة عميقة لقلب أوروبا المترنحة على شفير هاوية الحرب العالمية الأولى، فاتحا للأجيال اللاحقة نهجا معرفيا وجماليا مفاده أن الكتابة ينبع جمالُها مما لدى صاحبها من جلد وبصيرة لازمين للكشف عن طبيعة العصر والإحاطة بروحه العميقة. والحال هكذا لا يتوقف القارئ عند مسائل من نوع، هل أخلص الكاتب لطموحه؟ كما لا يتوقف عند مواطن الملل المتعمد بين صفحات العمل، فقد تسلل – القارئ – عبر السطور إلى مجاهل ما كان ليصل إليها، تضعه موضع المساءلة حيال الشأن العام والشأن الشخصي، حاثة إياه على تبصر روح عصره، فالدرس الأسمى في الجبل السحري أن الأديب ليس كاتب نصوص جميلة بل صاحب الرؤية الأعمق لعصره، تلك التي تتكشف عبر ممارسة الكتابة كخيار وجودي؛ فيتجلى عبر كلماته سحر الأدب خالدا تتوالى عليه العصور وأجيال القراء.
تضافرت عناصر عدة لتخلق حسا بالقصور تجاه إبداع الياباني هاروكي موراكامي، عناصر لها نصيب من غرابة عالمه وأساطيره، منها عدم إخلاصه لتقاليد الكتابة الأدبية اليابانية، وتعامُل النقد معه على أنه يقدم رواية مشحونة بغرائبية ذات طابع خاص، لكنه في الحساب الختامي ليس أكثر من عارض لهذا العالم، صاحب صياغة لغوية جميلة، ومنسق فذ لأجزاء رواية تنتمي لعالم البيست سيلرز بكل ما له من قوة وضعف، بيد أن القارئ المنصف لا يستطيع أن يبخس موراكامي حقه راضخا للشائع والسهل، الأزمة مع موراكامي أنك تحب أن تقرأه مُسْلِما نفسك لتيار السرد، لا تريده أن ينقطع، تستبد بك نشوة لا تبالي معها بما إذا كان هناك ما هو أعمق.. أو ماذا يريد أن يقول… في ظل هذا الخيال الطاغي والعالم المنفلت – شكليا – لا يعدم الكاتب حيلة لتقديم معالجة فنية لما يعانيه لفرد الرازح تحت ثقل ضغوط الحياة المعاصرة إلى المعالجة الأسطورية لتاريخ هزيمة الدولة اليابانية، ولا ينسى أزمته مع الكتابة، كما في أمثولة مبتدعة بروايته (سبوتنيك الحبيبة)، للراوي صديقة دراسة، تعرف ماذا تريد… تريد الكتابة، بعد التحرر من القيود الجامعية استقلت عن أسرتها، كان هذا ضروريا لتتمكن من التفرغ لعملها، وبسبب من خياراتها تقاسي حياة متقشفة، تخبر الراوي أن مشكلتها مع الكتابة تقف على النقيض من المشكلة السائدة.. مشكلة الندرة! فهي تكتب وتكتب صفحات كثيرة جميلة، جمالها يلوح أبديا بلا بداية ولا نهاية، هي غير قادرة على صب هذا الجمال في شكل له بداية ونهاية، إبداع سرمدي لا أول له ولا أخر! عبر حوارهما يلوحان كوجهين لموراكامي، الصديقة وجهه المعذب والمبدد تحت وطأة الرغبة في الكتابة، والرواي وجهه الناقد العالم بأبعاد مأساته كمبدع حانق في صمت على إدعاءات الكثيرين حول منجزه، فيرد على الصديقة التي جاءته تبثه ألمها، بحكاية الميادين والبوابات.. فإذا كان المعمار الحضاري للغرب يبرز قوته بتصميم الميادين، فإن المعمار الحضاري للشرق (الصين تحديدا) يبرز قوته ببناء البوابات، ويسألها:: هل تعرفين كيف بنوا البوابات في الصين قديما؟ يحفرون عميقا في المكان المخصص، ويضعون في الحفرة عظام الأسلاف ، ولكي يضمنوا للبناء استمرارية الحياة؛ فلابد من دماء تُروى بها العظامُ، يشرع العمال في صيد الكلاب الضالة، يذبحونها ويصفونها حتى أخر قطرة دم فوق العظام، يشرعون بعدها في وضع الأساسات فوق عظام الأسلاف المروية بالدماء، كتابة الرواية مثل ذلك العمل يا عزيزتي، عليك أن تعرفي كيف تصطادين الكلب، واللحظة المناسبة لذبحه، وفوق أي من عظام الأسلاف تُصَفِّين دمه!
أمثولة جميلة تعيدنا إلى سحر الأدب الذي يبدو موراكامي مهووسا به حتى ليظن القارئ أنه همه الوحيد أثناء الكتابة، بيد أنه يأبى ذلك كما يأبى الرد المباشر بما فيه من فجاجة وتقريرية طالما تجنبها، وكأنه يصرخ في النقاد، ابحثوا في عملي عن عظام الأسلاف، ولا تُلْهِكم مهارتي في صيد الكلاب الضالة وذبحها عن كم خفايا تُثْقِلُ وجودها المغدور! من يدري؟ ربما بعد انقضاء أجيال من القراء يأتي سحر الأدب بجيل يستمتع بلذة اكتشاف عارمة لمنجز موراكامي – بكل ما له وما عليه – كتأصيل لطبيعة عصره و سيولته المائعة!
السحر الذي حفظ لتوماس مان حقه في تقديم عمل أصيل، رغم فشله في معالجة مسألة الزمن، هو ذاته الذي لم يحرم بودلير من تقديم عمل تأسيسي (سأم باريس) رغم فشله في الوفاء لطموح إبداع كتاب يضم لوحات عن الحياة المدينية على غرار لوحات جاسبار الليلي المُخْلصة لجوها ومزاجها القروسطي.. يالسحر الأدب حين يقود المبدع إلى فشل أكبر من أي نجاح!
إنه سحر الأدب ليس فقط الذي يربطنا إلى صفحات كتاب ساعات وساعات نقاسي متعة لا تنفد.. متعة من الخطورة حتى تقودنا إلى الضحك والبكاء والتمرد … وربما إلى القتل أيضا، كما في رائعة فيليب كلوديل (تقرير بروديك)2 حيث يُقْدِمُ أهلُ القرية على قتل الفنان الذي جسد حقارتهم الجمعية في عمل جميل، لم يملكوا حياله أي تسامح، فيليب كلوديل الذي لا يعدم الحيلة ليمنح بطله – بالأحرى لا بطله – السلبي.. الهش.. الخانع.. نصرا موجعا حد السقوط في البكاء، ساردا ذكرياته نزيلا في معسكرات النازي، وقد اختار بلا تردد أن يعيش مثل الكلب، ينام في المكان المخصص للكلاب، ويأكل طعامه على أربع منكسا رأسه في إناء مخصص لإطعامها، حتى صار كلبا شخصيا لأحد الضباط، ذلك الضابط الذي كان يعمل محاسبا في الحياة المدنية وله زوجة وأولاد، اعتاد على القيام بالتمشية الصباحية ممسكا طرف السلسلة المربوط بطلنا في طرفها الآخر.. يتبعه في أرجاء المعسكر على أربع وسط الثلوج التي لا تكف عن التساقط.. حين يعلم الضابط بنهاية الحرب وهزيمة بلاده، يجمع أمتعته ويهرب ذات صباح، وبينما يحث الخطا عند بوابة المعسكر، يتذكر كلبه.. يضع حقائبه على الأرض، بمفتاح معه يحرر بطلنا من قيد في رقبته، يلقي بالمفتاح بعيد كمن يرمي جمرة، قبل ان يسأل بصوت مسموع: من سيتحمل تبعات كل ما حدث؟ سؤال مصحوب بنظرة طويلة يسددها الجلاد لعيني الضحية، محاولة يائسة لطلب الغفران، ويأتي الرد موجعا مبكيا، إذ يركز البطل كل جسده وعقله ووعيه في نباح طويل، كذلك النباح الذي أمره به الضابط لسنوات؛ ليُدْخِلَ على نفسه ونفوس رفاقه البهجة! بيد أنه هذه المرة لا يضحك بل يسقط على الأرض، وقد ألمت به رعدة قوية، احتاج معها وقتا قبل أن يتمكن من النهوض والْعَدْو بعيدا… كم ممتع ومؤلم سحر الأدب!
ايلاف