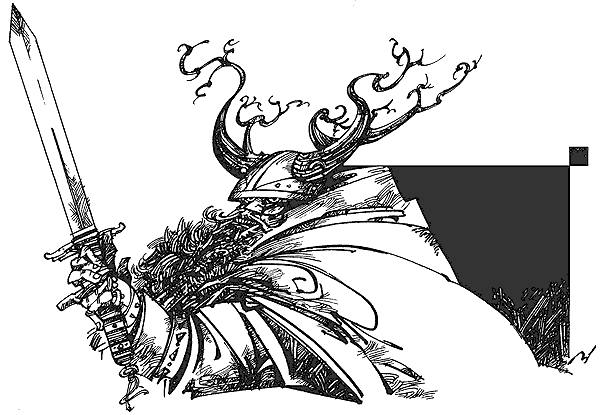سقوط جنرالات الثقافة
روجيه عوطة
لا تصدر مواقف بعض الشعراء والكتّاب عن ذاتيّتهم الثقافية فحسب، بل تنشأ عن النظام الثقافي الذي ينتمون إليه، قادة وزعماء وحاشية. فعندما اندلعت الثورات في بلدان اللغة العربية، الثورة السورية على وجه التحديد، اتضحت معالم هذا النظام، وظهر مرتبكاً، لا قدرة له على الإمساك بأحداث الشارع، بهدف تجميدها والقضاء عليها خطابياً. على ضوء الانهيارات في النظم السياسية، بانت العلاقة بين القمع، الذي تمارسه السلطة في الفضاء الإجتماعي، والإرهاب الذي يتبعه المثقفون السلطويون في الفضاء النصي، بحيث يشتركان في لجم المختلف، وتسويغ إقصائه، منعاً لأي خرق فردي أو بنيوي.
يتبادل الطرفان فضاءات معاركهما، ويلتبس عليهما الخلق، بما أنهما يمران بمرحلة من السقوط التاريخي، فيحاول كل منهما بأدواته أن يساعد الآخر على الإحتفاظ ببقاياه، والإستعانة بها من أجل مواصلة حضوره، نتيجة التنسيق بين الديكتاتوريتيّن السياسية والثقافية. لا يعود القتل فعلاً سلطوياً، ولا تظل الكتابة نشاطاً ثقافيا. يختلط الفعلان، ويصبح القاتل مبدعاً دموياً، والكاتب قاتلاً خطابياً.
في النتيجة، وبعد تحديد جنرالات آلاته العسكرية والأمنية، يعيّن الإستبداد جنرالاته الثقافية، مزوداً إياهم الأدوات والمقولات الإيديولوجية، وبأسلحة كلامية ونصيّة، تجمع بين الخرافة الشعرية والمواربة السردية، فضلاً عن الأدوات التي كان يستخدمها هؤلاء الجنرالات نصياً قبل معركة سقوطهم.
لا تقع حيلة “الخوف”، على سبيل المثال، عند بعض الشعراء، الذين صُوّروا كـ”متمردين ومعارضين” ثقافيين، من مثل أنسي الحاج وسعدي يوسف وأدونيس ونزيه أبو عفش، سوى في هذا السياق الأدواتي. هي خدعة إيديولوجية، تسوّغ التأرجح الآرائي، الذي تنم عنه المواقف والأحكام المؤيدة للأنظمة الدكتاتورية.
والحال، أن سقوط النظام الثقافي الذي يحوي هؤلاء الجنرالات، وكثيرين غيرهم، ينبئ بتصدع واسع يصيب البنى المعرفية والإبداعية التي أدت إلى تكريس الإستبداد في الإجتماع والثقافة، عدا توليدها الضبط الديكتاتوري في الفضاء السياسي.
إنحدار “لن” إلى “نعم، لا، بالطبع”
في مواقفه حيال الثورة ضد الديكتاتورية الأسدية، ينطلق أنسي الحاج من خطاب متأرجح بين تأييد النظام والإعتراض على بعض ممارساته، التي ينظر إليها الشاعر كأن طرفاً مجهولاً يرتكبها. لا يشكل القمع البنية الأولى للسلطة البعثية، وخصوصاً أن رئيسها بشار الأسد “شاب منفتح علماني حديث”، وأنها “ذات وجهين: واحد دموي وآخر ناعم”.
لجأ النظام إلى العنف بسبب إحدى النصائح التي وجهت إليه، “أن لا يضعف أمام المتمردين بل أن يبطش”، بعيداً من تاريخه القمعي، وولادته عبر حدث تاريخي إصطدامي، أي الإنقلاب، وتوابعه من تصفيات وإعدامات. في الجهة نفسها، كان على بشار “أن يكون قوياً لا أن يستعمل القوة”، محافظةً على “علمانيّته”. كأن القوة العنفية قد فُرضت على الديكتاتور “الشاب” ليستخدمها ضد السوريين. مع اندلاع الثورة، وقف الشارع في وجه “القصر”، وبدأت الحرب الدموية بينهما منذ اليوم الأول. بالتوازي، كانت “المؤامرة” تصيب أهدافها في سوريا و”سائر الأمة”: “نعم سوريا، والعرب جميعاً فريسة مؤامرة”.
في المقابل، انطلقت الثورات، ومنها السورية، كتحركات شعبية “عفوية” و”طاهرة”، لكن هذه البراءة قد سُرقت، وأبعدت عن مسارها الغائي الأولي. كالعادة، تُترجم هذه القراءة الإيديولوجية في لغة ذكورية، يستعملها الشاعر في تصوير الشعب أنثوياً كما لو أنه كائن ناقص، مخدر ودائم الضعف، فهذا “زمن زمنُ الضحك على الشعوب بواسطة مخدّراتها اللفظيّة. والبداية دوماً صادقة، محقّة، من موضع القهر والظلم. وفوراً تعقب البداية فصول التحكّم في الأزرار”. أما الوسائل التي يتبعها “الغرب”، وحلفاؤه “الماسونيون واليهود الصهاينة”، لحقن المجتمعات فعسكرية، وإعلامية وغيرها، لاسيما الأفلام والفضائيات، التي تبث صور الثورات، ويشاهدها الشاعر كأنها أفلام سينمائية، “لا يتردّد فيه الممثّلون، أي المقاتلون، في تأدية أدوار يطلبها منهم المراسل أو المصوّر خدمةً لحيويّة المشهد”.
بين نظام “علماني”، فرض على “رئيسه الشاب” استخدام القوة، وثورة شعبية، كانت “طاهرة” قبل أن تُغتصب وترتكب المعصية، يقف شاعر “الرأس المقطوع” محاولاً التوليف بينهما، بخطاب سياسي ينطوي من ناحية، على لغة متدرجة من اللغة المدرسية الدينية إلى اللغة الضحوية الأقلوية. من ناحية أخرى، ينزع إلى القراءة الإيديولوجية الخرافية. يكتب عن “مؤامرة”، تقودها إسرائيل والولايات المتحدة الأميركية، وتنظمها “الماسونية اليهودية”، وقد وقع في فخها النظام والشعب السوريان. بعد أن يثبت الشاعر هذه الخرافة من خلال وضع الأحداث السورية في معادلة سياسية عالمية، يؤلف موقفه من عروبة ماضوية وعجزٍ حاضر، يشتركان بالنظر إلى الآخر “الغربي” كعدوّ غير معلن، فرض على الأسد أن يستخدم العنف، وخدع المواطنين وصادر تحركهم البريء. لذا يتدخل الشاعر كأنه الأعلم، محاولاً التوليف بين الطرفين، وتصويب العنف والمخادعة في مسارٍ إيديولوجي، يُبسّط نتائج القمع ويسطّح قيمة الثورة.
بلغة مدرسية، وبعيداً من القتل النظامي، يدعو صاحب “لن” سوريا إلى الإستيقاظ، “إستيقظي يا سوريا”، و”تَعلّمي ممّا اختبرتِ، عندنا وعندكِ”، ويندب الشاعر عجزه الإيديولوجي، قارئاً الحدث السوري كاستمرار للضربات الموجهة ضد العالم العربي، منذ النكبة الفلسطينية. بصورة خرافية، يحيل التغيرات السورية على “رمية عين”، “رَمَتكِ العينُ وقد رمتنا قبلكِ، وعندك الخبر اليقين”.
ضمن هذا الفضاء اللغوي الخرافي، يوازن أنسي الحاج بين ضحيتي العين “الماسونية” المرمية عليهما، ويباشر التمهيد لتسوية لفظية بين النظام القاتل والشعب القتيل، محولاً “المؤامرة” إلى “حرب أهلية” بين “فريقي المأساة”. فيختصر مأزق الأسد بالبيروقراطية، والبطء الإداري في تنفيذ مواد الدستور الجديد، الذي يتألف من “إصلاحات جدّية”، على رغم أنه أتى متأخراً “نتاجاً لماكينة بطيئة صدئة ما زالت تتحرك وفق الأسلوب السوفياتي السلحفاتي”، وليس نتيجة تركيبة النظام الإستبدادية الفاسدة. أما التحرك الشعبي، فبعدما سرقه “المتآمرون” وصادروا “طهارته”، بدأ يثير، مثل كل الإنتفاضات العربية، الكثير من المخاوف حول أسلمته وتطرفه وعنفه.
في السياق التوليفي بين النظام البيروقراطي والمنتفض المسروق، يطلب أنسي الحاج من الأسد أن “يُقدم. إذا فعل فسيحبط المؤامرة على سوريا وعلى سائر الأمة”، مبيّناً قيمة وجهه “الناعم”، الذي اهتم بـ”أعلى ما في سوريا وهو الفن”، ما دفع الممثلة سلاف فواخرجي إلى تأييده، لذا حاول الثوار، بحسب الشاعر، اختطافها عقاباً لها على دفاعها عن النظام الذي حضنها كـ”فنانة”، بغض النظر عن أزمة الإنتاج الفني، الدرامي على وجه التحديد، من ناحية، وعن حملات الإعتقال والقتل التي مارسها النظام ضد الفنانين والممثلين والمخرجين إلخ. الشاعر نفسه، الذي يدافع عن النظام الحاضن لـ”فن” القمع والقتل، يتحدث عن حكيم الثورة السورية، الكاتب ياسين الحاج صالح: “ها هوذا رجل شبع سجناً ويعيش تحت الخطر ولا يزال يسدّد اللكمات”. يضع الحاج “ممثلة” النظام ومثقف الثورة في صورة توفيقية واحدة، على رغم الخطر اليومي الذي يتهدد المثقف على يد الديكتاتور “الحاضن” للفن.
يصل الخطاب التوليفي بين “نعم ولا” إلى أوج خرافته في علاقته مع “المتآمرين”، من خلال الرجوع إلى لغة أقلوية، تنم عن ذات مذعورة ومقفلة. فبمعادلة سياسية ضحوية، ناتجة من العجز الثقافي التاريخي أمام الغير “الغربي”، يكتشف الشاعر أن الوسيلة الوحيدة لوقف التطورات الثورية التي يمر فيها الشرق الأوسط العربي، هي “نشوب حرب عربيّة – إسرائيليّة. تَوَحّدَ العرب على إسرائيل في الماضي، فلِمَ لا يتوحّدون في الحاضر؟”.
غير أن معادلة “نعم، لا”، التي احتمى بها شاعر “لن” من حقيقة انهيار النظام، لا تنجح دائماً في إخفاء موقفه الموارب على الطريقة البعثية، والمنحاز إلى دم “الضحايا”، الواقعين في فخ “المؤامرة الماسونية واليهودية”، وليس المقتولين بأسلحة النظام، مثل أطفال الحولة، الذي لا يعرف الشاعر من قتلهم، “لا نعرف مَن ذبح أطفال الحولة وتلّ دُو، وقد لا يُعرف…. ولا ثورة تستحقّ قتل طفل. ولا سلطة ولا ثورة تستحقّان قتل أحد”. عبارة “السلطة” هنا مواربة، جردها الشاعر من “النظام”، كي تميل في دلالتها إلى “سلطة” الشعب الناقص بحسبه.
يفشل الشاعر في توليفه، ويعترف بتأرجحه الخائف بين النظام القاتل والشعب القتيل. يتوجه الحاج إلى النظام كأنه مستشاره، “لو تقتنع السلطة في سوريا أن الفقراء والمساكين الذين يموتون قتلاً هم بَشَر لا مؤامرة”، وإلى الثورة كأنه “أستاذ كبير”، “وتقتنع المعارضة أن الاستشهاد إذا لم يثمر في وقته – وقته ليس إلى الأبد – يتحوّل إلى موتٍ مجاني، وخاصة أن قيادته آمنة في المهاجر”. كأن المواطن السوري انتفض ضد الديكتاتورية للمطالبة بقتله الخالص، وكأن الشاعر يعلمه كيف يُقتل في الشارع.
تالياً، يصب كلام الشاعر عن “الحرية” في خدمة السلطة الأسدية، فيزيح موقف “نحن مع الحريّة للسوريّين ولو ذهبوا بها إلى الجحيم” عن دلالته الأولى في سياق من التوليف الموارب، بحيث تتحقق هذه الحرية الجحيمية في ظل “عطف الأب” و”رحمة الإحتضان”، حتى لو أخذ “الأب” والإبن الأبوي كل السوريين إلى الجحيم.
كما تصب تحية ممثلة النظام “الفنان” في إقصاء مثقف الثورة “الفدائي”، ولاسيما أن الممثلة “من نُور لا تُمَسّ بغير الحبّ”، على عكس المثقف الذي “يسدد اللكمات”. فالنظام، حاضن الحب، أما الثورة، فتحضن الملاكمين، الذين تحوّلوا، بحسب صاحب “لن”، من كائنات ناقصة إلى مخدرين ومتطرفين وقتلة.
في خطاب أنسي الحاج، تحول القاتل إلى قتيل، والقتيل إلى قاتل، أما “الحرية”، فمكفولة من الأول ضد الثاني.
في العيادة الإيديولوجية
يشترك الشاعران سعدي يوسف ونزيه أبو عفش في خطابهما الإيديولوجي، الذي لا ينطوي، كخطاب أنسي الحاج، على مواربة أو تأرجح بين النظام والثورات، بل على تعيين موقفي ثابت، إستناداً إلى عدد من الشعارات والخرافات والأحكام العدائية المسبقة. فبالنسبة إليهما، لا تتحرك المجتمعات الشرق أوسطية ضد الديكتاتورية من تلقاء إرادتها، بل تتحكم بها الولايات المتحدة الأميركية وإسرائيل.
فـ”أي ربيع عربي؟”، يسأل الشاعر سعدي يوسف، ليجيب: “نعرف تماماً أن أمراً صدر من دائرة أميركيّة معيّنة”، والدليل على وقوع هذه “المؤامرة” الأميركية أن الفقراء لا يعرفون كيفية استخدام الإنترنت ومواقع التواصل الإجتماعي، التي لعبت دوراً إعلامياً في التنشيط والتشبيك المجتمعي الثوري. لذا لا يمكن أن تكون التحركات الشعبية قد حصلت، بل كانت مجرد صور مفبركة وفيديوات مزورة، أي أنها مصنوعة من “المتآمرين”، الذين رموا بـ”قنابلهم” على الأراضي الليبية، وهذا دليل آخر على أن الثورة الليبية كان عبارة عن إحتلال.
يؤلف الشاعر خطابه الإيديولوجي من العداء للآخر “الغربي”، وتسحير إنتاجاته التقنية، والنظر إليها على أساس أنها وسيلة إحتلالية. يستقيم هذا الخطاب في لغة مازوشية، تجد في ذاتها انعكاساً لإرث تاريخي من العجز والإزدراء أمام الغير. فـ”الشعوب العربية” لا يمكن أن تثور، وإذا طالبت بحقوقها، فهذا يعني أنها وقعت في “الفخ” الخارجي، فـ”من هؤلاء القادة الفتيان؟ عيب والله”. تتماثل هذه القراءة الخرافية مع الخطاب الدعائي لكل سلطة ديكتاتورية في البلدان العربية، فكل فعل إختلافي تنتجه الذات هو من صناعة الخارج المتآمر، وكل فكرة يعلنها الغير أمام هذه الذات هي أداة غزو واحتلال ومجزرة مقبلة.
من هنا، يتقاطع موقفا سعدي يوسف وأبو عفش الخطابيان، وخصوصاً أن كلاً منهما يعرّف نفسه بحسب هويته الإيديولوجية، فالأول هو “الشيوعي الأخير”، والثاني هو “رجل ماركسي شيوعي علماني”، أما عدوّهما الوحيد فهو الولايات المتحدة الأميركية وملحقاتها الإسرائيلية. طالب أبو عفش بتكريم سعدي يوسف من خلال إطلاق إسمه على أحد شوارع دمشق، فهو المثقف الشجاع الذي “يصرّ حتى الآن أن يقول عن نفسه أنه شاعر ماركسيّ يكره أميركا”. أضاف أبو عفش إلى خطاب صديقه “الستاليني الأخير” لغة نرجسية، تنم عن استبطان إستبدادي من ناحية، وعن ذعر أقلوي من ناحية أخرى. فهو عندما يسأل عن احتمال تأسيس دولة ديموقراطية في سوريا، يجيب: “المشكلة أنني مضطر إلى شرح المشروح وتفسير المفسر”. وحين يتحدث عن المواطنين المنتفضين في ليبيا أو في سوريا، يصفهم بالـ”عبيد”، وإذا أسقطوا الطاغية، استبدلوه بطاغية آخر. من هذه الناحية، لجأ الليبيون إلى حلف “الناتو” ضد القذافي، ويلجأ السوريون إلى “المتآمرين” و”الأعداء” من أجل إسقاط النظام الأسدي. يعلن صاحب “عن الخوف والتماثيل” أن البعث الأسدي لم يخفه، على رغم المضايقات والإعتقالات التي تعرض لها، على عكس “المعارضة” التي يخاف منها، والتي تحضر مع هيلاري كلينتون للحرب الأهلية في سوريا.
تتمثل النرجسية المرضية في اللغة الشمولية التي يستخدمها أبو عفش لاختزال “الشعب” بذاته، “أنا الشعب”. يطلب الدخول في الحوار بين النظام والمعارضة المرعبة، التي كانت رفضت “الحوار”. ما يعني، بحسب الشاعر، أنها ارتكبت خطيئة غير مغفورة البتة: “لقد قالوا لا للحوار، هل هناك كائن عاقل في الدنيا يقول لا للحوار تحت أي ظرف وفي أية مناسبة؟”، بغض النظر عن الجرائم الأسدية، التي لم يسمع أبو عفش بها. فهو لا يساوي بين القاتل والقتيل، بل بين القتيل والقتيل. بالنسبة إليه النظام أحق بصفة “قتيل” من المواطنين السوريين، لأنه يتعرض لـ”مؤامرة” الديموقراطية الأميركية. أما القتيل الشعبي، فعبارة عن صورة مصنوعة من “الأعداء”، ولاسيما أن الثورة التي قُتل خلالها ليست “الثورة البلشفية”، كما أنه لم يمت في لينينغراد، بل من أجل مشروع أميركي. لتوضيح رأيه، يعرّف الشاعر الديموقراطية الأميركية بمثال إنتخابي مكرر، ويقارن ضمنياً بين فترة ولاية الرئيس الأميركي و”أبد” البعث، ويجد طبعاً أن الفترة الثانية أكثر ديموقراطية!
يعود سبب الخلل في الإدراك الزمني إلى الذعر التأييدي، فـ”إذا انهار النظام في سوريا الذي عارضتُه أربعين عاماً فإلى أين سأذهب؟”، لذا لا مفر من الدفاع عن الإستبداد الأسدي، والترويج لإصلاحاته، التي يرى الشاعر أنها في حاجة إلى وقت طويل كي تتحقق. خلال هذه الفترة يتذرع أبو عفش بعزلته ومأساته الشعرية، ليقنع الآخرين بنرجسيّته الأقلوية المرضية، حتى يخال المرء أن موقفه نوع من التعويض اللفظي عن خسارة، هي على الأرجح عدم حصوله على “مركز” في صفوف “المعارضة”، كما لو أنه يطلب من الشارع رفع صوره وإعلانه شاعره الديكتاتوري كي يرضى عن “ديموقراطيّته الأميركية”. في هذا المعنى، يجاهر أبو عفش، على رغم سلميّته الشعرية المعلنة، في اعتباره أن المواجهة مع المثقفين، عليها أن تجري بكل أنواع السلاح، “وإذا ما واجهتهم أوح لهم دوماً أن معك سلاحاً، أياً كان هذا السلاح، سلاح السلاح، أو سلاح وقاحتك وفجورك واحتقارك”، قبل أن يؤكد “أنا أكره الديموقراطية”.
نهاية التحايل الهرم
إلا أن التشكيك الخرافي، الذي يتبعه نزير أبو عفش وسعدي يوسف وأنسي الحاج، كان أدونيس قد استند إليه منذ اليوم الأول لاندلاع الثورات العربية، وخصوصاً الثورة السورية. فموقف “الشاعر والمفكر الكبير”، كان الإشارة الأولى إلى ظهور النظام الثقافي كانعكاس خطابي، لفظي ونصي، للنظام الإستبدادي. فمن كان يصوّر نفسه كـ”منفي” من بلاده، و”مضطهد” من جماعته، بسبب ثوريته الثقافية، باشر التشكيك في التحركات وغاياتها، وتسويغ قمعها، بحجج وأحكام، تنسف مستقبل الثورات وتتمسك بماضيها النظامي.
فكي ينضم إليهم مثلاً، اشترط أدونيس على المواطنين السوريين أن لا يخرجوا من الجوامع، وأن لا يخلطوا بين المفاهيم السياسية والدينية، وأن يبدأوا بثورة مفهومية، “ثقافية”، قبل أن يطالبوا بـ”إسقاط نظام الرئيس المنتخب”. بمعنى آخر، طالبهم الشاعر بأن ينسوا ثورتهم كي يتذكرهم.
لكن، بعيداً من موقفه التبسيطي المكرر والمفضوح، يمثل أدونيس “مثقف” النظام الذي اهترأت أدواته، ولم تعد قادرة على إقناعه، قبل أن تحاول التوجه إلى الآخرين. لتعاسة ظرفه، اندلعت الثورات العربية، بينما كانت إيديولوجيته قد بلغت شيخوختها، وعجزت لغته عن الإحتيال والمداهنة. لذا انكشفت مخادعته في لحظة توفيقه بين الدم في الشوارع ومطالبة “سيادة رئيسه” بالإصلاح.
يجمع “مثقف النظام”، أو بالأحرى جنراله، في موقفه من كل حدث مجتمعي، الأدوات الخطابية واللغوية المضادة للتغيير الإختلافي، ويسوّغ التعطيل باللجوء إلى الأحكام الإيديولوجية والخرافية. إذ “يتخوف” من مستقبل الأحداث، ويشكك في ولادتها، كما يشوّه أطرافها وجوانبها، ولاسيما الإيجابية منها، التي يتنبأ بظلاميتها وعنفها المقبل. غالباً ما يبني هذا المثقف أحكامه انطلاقاً من نظرة إيديولوجية ثنائية، بحيث يجد في الطرف الشعبي كائناً قاصراً، وفي الطرف السلطوي “أباً” حاضناً على رغم قسوته، فيوبخ الشعب وينصح النظام ضحوياً. من ناحية أخرى، يشيد المثقف “نجوميّته” من استثمار النكبات، قبل أن يتخلى عن ذواتها الفردية، إذا انتفضت على شمولية مواضيعها.
والحال، أن التخلي عن الفرد يستوي في خطاب المثقف النظامي، بالرجوع إلى الجماعات وعصبياتها، فيتجاوز الجنرال الثقافي الهوية المقفلة لفظياً، لكنه يكرسها واقعياً من خلال التشدد في رقابة الأحداث، وتصنيفها بحسب توقيت ظلاميّتها المرتقبة. بمعنى آخر، يشرع المثقف السلطوي في تعيين وجهة كل حدث نحو السلبية التاريخية، بالإرتكاز على عنصر الوقت. فأدونيس، على سبيل المثال، تخوّف من ظلامية الثورات المستقبلية، وأبو عفش متخوّف من ظلاميّتها المضارعة، أما أنسي الحاج فينظر إلى التحركات الثورية كأنها وُلدت بين الماضي والمستقبل الظلاميين، وهي أسيرة الظلامية الحاضرة.
المشترك بين مثقفي الديكتاتوريات أنهم يلجأون إلى التكثيف الشعاراتي وتضخيم الخرافات من أجل نسف الوقائع. في هذه الحال، لا يحضر التأويل كوسيلة تحليلية بين الوسائل التي يستخدمونها، بل يحل مكانه التسحير والتبسيط الخرافيان، كما لا يحضر الشعر كفعل تعبيري، بل كأداة من أدوات المخادعة والنفاق. في الوقت نفسه، يشترك مثقفو الإستبداد في تحملهم مسؤولية وصول المجتمعات إلى سحق الهاوية، وحين قرر الأفراد الإنتقال من الديكتاتورية إلى الحرية، وقف هؤلاء ضدهم.
لم تكن مواقفهم وآراؤهم نقدية، مثلما تعامل الكثير من المثقفين الإختلافيين مع الثورات بتأييدها نقدياً، بل نظروا إليها كأنها تحركات قاصرة، إما مصنوعة تآمرياً في الخارج، وإما في الداخل على أيدي أطراف بسطاء التفكير والإدراك. من الضروري أن يعلن كل فرد رأيه حيال أحداث الفضاء العام، لكن رأي “مثقف النظام” خدعة سلطوية لإرباك المختلف، ثم قصفه.
يتفسخ النظام الثقافي بالتوازي مع انفراط النظام السياسي المستبد. تطال التفسخات مفهوم المثقف الشائخ، المدافع عن النظام باحتقار الأفراد، والمؤيد للقاتل بالتشكيك في موت القتيل. فضلاً عن رفضه الشعبوية وتغذيتها، والإحتجاج على الظلامية وتكريسها، ومعارضة العصبية واللجوء إليها. كل هذه السبل المواربة، بأدواتها الإيديولوجية واللغوية، بدأت بالسقوط خطابياً ونصياً، مؤكدةً أننا، كأفراد ومجتمعات، “هرمنا” في الثقافة أيضاً.