عن الخوف والبهجة والأمل ومشاعر ثورية أخرى
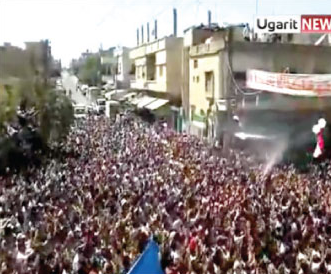
زياد حداد
نشر أحدهم على الـ”يوتيوب” مقاطع بالغة القصر لحضور رزان زيتونة وياسين الحاج صالح في إحدى مسائيات الثورة السورية في ريف دمشق. غني عن القول إن الناشطة والكاتب كلاهما لاجئان إلى حياة سرية تتيح لهما هامشاً من حرية القول والتفكير في سبل دعم ثورة شعبهما على النظام الغاشم.
يلوح الاثنان باسمين، يصفّقان على وقع أهازيج تحيط بهما ويرددها جمع يستره الليل فيبدو على كثرة لا يحدّها العدد. غير أن ما يتبدّى أيضاً من خلال هذه المقاطع وأخرى مشابهة، هو حضور فرح عميق، ربما يكون ما سمّاه رينه شار “كنزنا السري” حين كان في صفوف المقاومة ضد النازيين. في الحضور الجمعي السوري دوماً دورٌ للموسيقى في التظاهرات، كما هنالك قدرة على منافسة المصريين في ابتكار النكات، لا سيما متى تعلق الأمر بعاصمة المقاومة اليوم، حمص. إلا أن نكات السوريين يظل فيها ألم غامض وابتسام لا يخفي المرارة. كما يبدي الشعب السوري اليوم أيضاً مقدرة هائلة على التمسك بمطلبه الأساسي، أي إسقاط النظام الأمني الحاكم بأمر القوة المفرطة المحضة، ولكن مع التنويع والابتكار المتواصل للشعارات، ومنها ما يقفّى على قافية الأبد والأسد الشهيرة، فيطالب بالحرية لكل أولاد البلد، أو يشدد على ان المطلوب “دولة مدنية، عدل وكرامة وحرية”، مذكّراً بالشعار الأول الذي أطلقته الثورة المصرية “كرامة، حرية، عدالة اجتماعية”!
يطلق الشعب السوري (وتلك أيضاً حال المصريين وربما كل الشعوب الأخرى الثائرة بدءاً بتونس مروراً باليمن والبحرين) في كل هتافٍ ردوداً على مقولات كثيرة وقائلين كثر. فلا هي “إسلامية” ولا دولة خلافة ما يطالب به، ولا ثورته هي في طبيعة الحال دعوة لإنقلاب عسكري يستبدل طغمة بأخرى. كما أنه يشدد على أن البلد ملك لكل أبنائه ولا يسعه أن يضاف إلى عائلة بعينها أو شخص بمفرده. فوق ذلك، يضع الشعب السوري تحديداً دقيقاً لمفهوم الكرامة: الكرامة هي ما يتوسط الحرية والعدالة، وما يطير بجناحيهما. لا تعود الكرامة كرامة الأمة، على ما يحسب خطباء “حزب الله” في لبنان، ولا تظل الحرية حرية الأمة، على ما كان عفلق يقول. ما بين العدل، الاجتماعي والقانوني والاقتصادي، والعدل في الفرص والحظوظ، والعدل في المناطق وتوزيع المشاريع الإنمائية، وما بين الحرية، حرية كل فرد في القول والعمل والتعبير والرأي والمعتقد والخطأ والإصابة، تنمو نبتة الكرامة حين لا يعود من شبّيحة ولا مخابرات ولا أزلام نظام ولا أنصاف رجال يلعقون حذاء السلطة ويبصقون في وجه الفقير!
إذاً، في تظاهرات الشعب دوماً مزيج من الخوف – إذ لا يؤمن جانب القوة الظالمة – ومن الاحتفاء بكنز حريته واجتماعه. تتوّج الموسيقى ذلك الفرح، دونما تعقيد. ربما أنتجت مصر كمّاً أكبر من أغاني ثورة ميدان التحرير، إذ كان للثورة ميدان ثابت وتغطية إعلامية، كما سبقتها أعوام من انتاج فني لم يهدأ. أما سوريا فقد ألغى حكم العائلة الأسدية فيها مواهب شعبها حتى ما عاد في الإمكان العثور على أغنية أو مغنٍّ سوري ذي وزن يكون قد وُلِد بعد “الحركة التصحيحية”! غير أن سوريا، ما إن عمّتها التظاهرات، حتى عادت إلى انتاج الأغاني الهادرة، البسيطة والمباشرة، الذاهبة إلى لبّ المسألة: هنالك قاتل، عليه أن يرحل، وشعب يصحبه الأمل. وحتى بعدما قتل شبّيحة النظام إبرهيم القاشوش واقتلعوا حنجرته، وحتى بعدما كسروا أصابع علي فرزات، إلا أن سوريا أيضاً ولاّدة وأضافت آخرين كثراً إلى القاشوش واحتفت كثيراً بفرزات.
في مقابل ذلك الفرح الممزوج بالخوف، وذلك السخط الملطّف بالأمل وروح النكتة، تبدو تظاهرات أخرى، تلك التي يحرّكها النظام أو يدعو إليها في لبنان “حزب الله” وفلول حلفائه، خاويةً من بهجة الحرية، غاضبةً من دون أن يشوب غضبها أمل أو يعبره ظل ابتسامة. لكن أشد ما يبرز فيها، غياب أيّ خوف وأيّ فرح. أصحاب هذه التظاهرات، المتشابهة في طولها وعرضها كأنما خرجت من معمل واحد، معتدّون بقوتهم منتشون بذواتهم واثقون بانتصاراتهم متعطشون إلى عنف أكبر يُنزله قادتهم الملهمون بالأعداء.
يحسب البعض أن الغضب شعور ثوري، كما يحسبون الاعتداد بالقوة ثقة بالنفس. غير أن بعض التدقيق كافٍ للتثبت من أن الغضب لا يسعه أن يكون إلا شعوراً رجعياً، يطالب باستعادة ما مضى أو ما فُقد، ولا يسعه إلا أن يكون شعور أقلية تسعى إلى طمأنة نفسها بالمزايدة في مظاهر الغضب وانتفاخ الأوداج. حين تكون الثورة أو التظاهرة شعبية، فإن ما يحدوها هو الأمل بالتغيير وباحتمالات المستقبل. الغضب ايضاً شعور مسلّح. لا يسع الأعزل أن يغضب. يسعه أن يسخط، أن يثور، أن يرفض المهانة. لكنه في مواجهة السلاح، عاجز عن الغضب وقادر على تطويق عنق الدبّابة بعقد ياسمين، كما فعل شباب سوريون كثر، لم يتوان النظام الذي عجز عن قتلهم مواجهة، عن قتلهم في الاعتقال غير الشرعي.
يسع بشار الأسد، الراغب في العودة إلى ممارسة طب العيون (هل نقترح عليه أن يطبب ضحايا قنّاصة المجلس العسكري في مصر؟) أو حسن نصر الله، الآمل من دون أي شك أن يتم دراسته الدينية، أن يهددا ويغضبا ويبديا نيوب الليث متى شاءا، مستندين إلى اعتداد بالنفس تبيحه حساباتهما للقوة الصاروخية أو للمواقف الدولية. غير أن من يبني ثقته على مثل ذلك، ليس من تجلله الثورة بهالاتها الخطيرة الرائعة، بل من تلطّخه بقع الحسابات الخارجية (موالاة أو ممالأة) التي لا تحدد أهدافها وفق مصلحة الشعب بل وفق الإيديولوجيا، التي سبق لرولان بارت أن رأى في نعت “المعتدّة” أو “المغرورة” الوحيد اللائق بها، أو المصلحة الذاتية الرخيصة.
أما الشعب، الراغب في العودة إلى العمل والعائلة والعلاقات الغرامية والإجتماعية، وهو الذي تنازل عن ذلك كله، موقتاً، لحساب ثورته رفضاً للاستمرار في المهانة، فمن لا يستطيع أن يعتدّ بنصر لم يقم بعد ولا أن يثق بقوة صاروخية لا يملكها، ولا بعلاقات دولية تتخطى مصلحته. الشعب هو مَن لا يزال يكتنف مصيره الغموض، إلا أنه مَن يملك الأمل. ذاك أن الأمل قوة تقيم الحلم على مسافة، وتجعل من المسافة هذه حافزاً على اجتيازها بالعمل والإبداع والابتكار والخلق (فلننظر أين أوصل الولاء الأسدي شاعراً كسعدي يوسف؟ إلى خسيس البذاءة! ومثله كثيرون في لبنان للأسف). والشعب هو مَن يملك البهجة، لأنه كثير ومتشابك ومتعدد وملوّن ومن رحمه الدافقة يخرج أصحاب المفاجآت الحقة (لا الاستراتيجيا الدعائية)، أي مَن يملكون المستقبل الآتي وتغييره.
لا ننسى، نحن المتابعين من بيروت بأيد مرتجفة وعيون معلقة على الـ”يوتيوب” والـ”فايسبوك”، أننا كنا أيضاً كثيرين وملوّنين وأنيقين ومبتهجين، في ثورتنا ضد وجود الجيش السوري في لبنان وضد النظام الأمني التابع له. بين حريتنا وحرية السوريين حبل سرّة يمر تحت جبال لبنان بين بيروت ودمشق. بيننا اليوم مَن راح يعتذر عن ذلك، من خائب الأمل في سياسيينا إلى ذاك الطامع في مال إيراني أو في عزة صاروخية. لن يتردد هؤلاء في الإنقلاب مرة أخرى متى لاحت لهم بشائر سقوط بشار الأسد أو ضعف “حزب الله” أو انقطاع تمويله. ما كل ضلالة تستحق أكثر من تجاهل صاحبها ونسيان ضحالته الفكرية والإبداعية، تلك التي توازي فقر مخيلة الجامعة العربية.
بيننا اليوم، في لبنان وفي سوريا أيضاً، من يعتريهم خوف من نوع آخر: الخوف من القوة الغاشمة الظالمة، بل الخوف من آتي الأيام ومن الإخوة في الأوطان ومن ابتعاد عن مراكز القرار والثروة والجاه. يشبه هذا الخوف رعب النبالة أو البورجوازية من الانحطاط الاجتماعي، من خسارة المستوى الطبقي المزعوم. يتناسى هؤلاء أن مراكزهم صنعتها روح المبادرة والمغامرة والانفتاح والتعلم، وينشدون من القوة العسكرية حراسة قلعة باتت أساساتها منخورة. ليس خوف بعض المسيحيين من “إسلامية” الثورات العربية بأوفى نصيباً من الحق من خوف بعض “الإسلاميين” من كونها مؤامرة إٍسرائيلية أميركية! الإسلاميون مكوّن أساسي من المجتمع، وما محاولة وضعه في القمقم إلا وصفة لانفجار أكثر دموية! يحق للإسلاميين المشاركة في الثورة، إلا أن الشعب الذي يعطّر ثوراته بالموسيقى والبهجة والأمل والنكتة ليس من يسلّم نفسه لتنقيب النساء ولعتمة التكفير! وحده من يقبل المجازفة، مع الشعب، بالثورة ويشاطره التطلع إلى آتٍ أفضل ومستقبل أوسع أفقاً، يستحق أن تكون له ابتسامة رزان زيتونة وياسين الحاج صالح! ووحدها امرأة تسفر عن وجهها في النضال كل يوم، رزان مثلاً ورزان الأخرى ورفاه ناشد وعشرات الألوف من نساء سوريا، تكسب حريتها من دون منة وتكسب مساواتها من دون زائف العطف!
لقد أثبتنا في لبنان أن الثورات لا تنتصر دوماً، أو قد يكون لها نصف انتصار، وأنها قد تنتحر أحياناً بشفرة الطائفية. تعلّمنا ذلك بجهد شاق. السوريون اليوم أرقى وعياً منّا وأرحب صدراً بتنوعهم. أملهم، كبهجتهم وكالخوف عليهم، معدٍ. ومن يؤمنون بحقوق الشعوب في الحرية والكرامة والسيادة يعرفون أين هي ساحات العيد اليومي.
النهار


