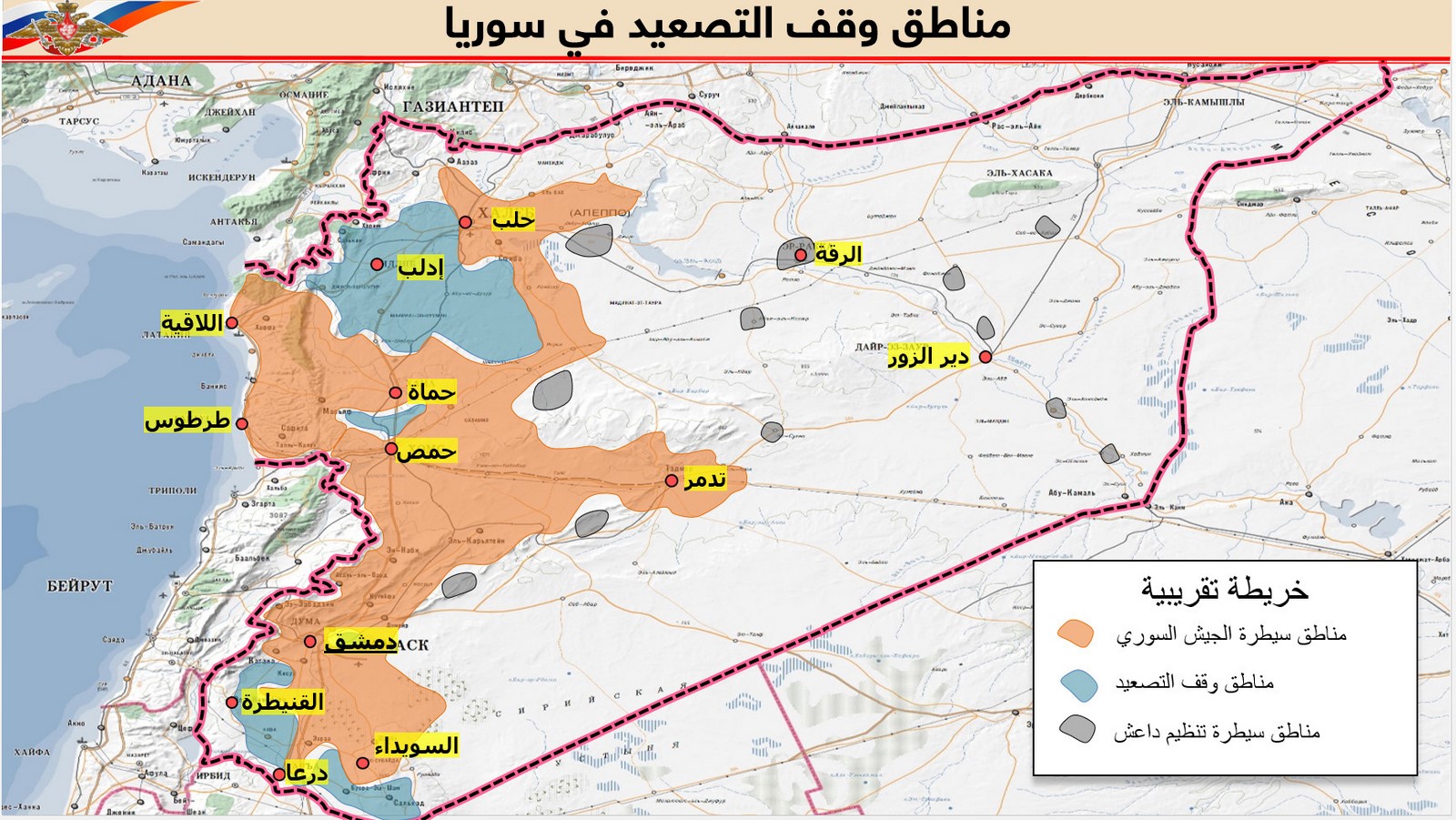فيما تتجه المنطقة وجهتها الكارثية تبقى الدولة المدنية هي المخرج/ عبدالباسط سيدا
إلى أين تتجه المنطقة؟ وما هو المصير الذي ينتظر أجيالها المقبلة؟ ماذا عن مستقبل التنوّع بكل أبعاده، والتمازج الحضاري على مختلف المستويات؟
أسئلة مصيرية، وجودية، تؤرّق كل متابع لم تغرقه التفاصيل بعد؛ ولم تسلّمه أهواء النزعة الانتمائية حتى الآن إلى هذا الاصطفاف أو ذاك من الاصطفافات التصادمية التي بدأت تتشكل، وتتبلور ملامحها بقدرة القادرين ممن تلاقت، وتفاعلت، خبايا خططهم الرامية إلى إعادة ترتيب أمور المنطقة بعيداً من إرادة شعوبها وحاجاتها الحقيقية.
ولكن السؤال المحوري، المفصلي، الذي يفرض ذاته عادة قبل الأسئلة السالفة هو: لماذا وصلنا إلى ما نحن فيه راهناً؟
بعد سقوط الاتحاد السوفياتي، طرأ تراجع حاد في شعبية الفلسفة الماركسية التي كانت قد غدت الإيديولوجية الأكثر شعبية، إن لن نقل شعبوية، في الستينات والسبعينات من القرن الماضي؛ وتمكّنت من استقطاب العديد من الشرائح والقوى الاجتماعية؛ وأصبحت الإيديولوجية الرسمية، أو الخلفية الإيديولوجية، لمعظم الأحزاب والمنظمات في المنطقة، وذلك على عكس التيارات الأخرى التي كانت قد برزت في العقود السالفة، ولم تتمكن من تجاوز حدود النخبة الثقافية التي كانت تبشّر بها. ويُشار هنا بصورة خاصة إلى التيارات: العلمانية، والليبرالية، والوجودية، والوضعية المنطقية، والجوانية والبنيوية…. الخ.
ومع انتفاء تأثير الماركسية بوصفها إيديولوجية تعبوية، إذا صح التعبير، أمست الأجواء شاغرة لصالح ايديولوجية الإسلام السياسي بتلاوينها المختلفة، وذلك بعد أن كانت الإيديولوجية القومية قد مُنيت بانكسارات وانحسارات سواء في تركيا أم في مصر، ومن ثم في سورية والعراق نتيجة تحوّل حزب البعث فيهما إلى يافطة للتستّر على الممارسات الإستبدادية بنزعاتها الطائفية والجهوية، بل العائلية والأسرية.
وفجأة سادت شعارات ضبابية في مختلف الساحات؛ شعارات عامة لا تقول شيئاً مع الإيحاء بأنها تقول كل شيء، وكان الأبرز من بينها: الإسلام هو الحل.
ولكن عن أي اسلام نتحدث؟ وما هي طبيعة الحلول المقترحة؟ وماذا عن آليات التطبيق؟
وغالباً ما كانت الإجابات مبهمة، هلامية، خاضعة لأمزجة المروجين واجتهاداتهم التي كانت، وما زالت، متباينة إلى حد التناقض.
وفي أجواء الخواء الإيديولوجي، وتراكم الإنكسارات على المستويين الموضوعي والذاتي، بالنسبة إلى الأفراد والجماعات، وهيمنة فكرة التماهي بين المؤامرة والعولمة؛ أصحبت ايديولوجية الإسلام السياسي بتوجهاتها المحافظة المعتدلة، والراديكالية الجهادية بمسمياتها المختلفة، من سلفية وعلمية ومقاتلة وتكفيرية وغيرها، هي المناخ العام الذي احتوى الأنظمة والحركات المعارضة لها في الوقت ذاته، وغدت مفاهيم الإيديولوجية المعنية بمثابة أدوات التفكير، وركائز الترويج بالنسبة إلى الجانبين.
فالأنظمة من ناحيتها وظفّت المفاهيم المعنية للتغطية على إخفاقاتها، وعجزها في ميادين التعليم، والعمل، والصحة، والسكن، والضمان الاجتماعي، والبحث العلمي، وتأمين مستقبل أفضل للأجيال القادمة. وكان الإستبداد بالنسبة لها ضرورة لا بد منها لإستمرارية سلطتها المفروضة.
أما الحركات الإسلامية المعارضة للأنظمة المعنية، فلاذت هي الأخرى بخطاب اسلاموي، ماضوي، لتسويغ جهودها المعاصرة، ورغبتها في الإستحواذ والسيطرة. يساعدها في ذلك التقدم التكنولوجي في ميادين السلاح والإعلام ووسائل الإتصال؛ والأهم من هذا وذلك هو تنامي الإمكانيات المادية بفعل الممولين القادرين، وتداخل كل ذلك مع حسابات القوى الإقليمية والدولية.
والأمر اللافت في اللوحة أكثر من غيره، هو ما يتمثّل في تلك العلاقة الطردية بين استبدادية الأنظمة وعجزها، وتنامي وتيرة التطرف الإسلاموي، الذي بلغ ذروته راهناً في المشروع الداعشي الذي تتعاظم قوته على المستويين الأفقي والعمودي. وهو يجسّد حصيلة تضافر وتفاعل جهود استخباراتية، وحركات دعوية، وتبعات حالة الضياع الوجداني التي يعيشها قسم لا يستهان به.
إن الخروج الآمن من الوضعية المعقدة السوداوية التي تعيشها منطقتنا لن يكون بالحلول الأمنية العسكرية وحدها التي تستهلك الطاقات، وتدمر الإمكانيات، وتساهم في تجديد دورة العنف والتطرف، وغالبا بمستويات أقسى وأشد.
لن تتمكن مجتمعاتنا من القطع مع نزعات التطرف والتشدد ما لم تطرح مشاريع حقيقية، تقدّم الحلول الجادة، غير الإنشائية التزيينية والتخديرية، لجملة من المشكلات المزمنة المتراكمة، خاصة ما يتصل منها بالشباب. كما أن مسألة إفساح المجال في المناهج الدراسية، والبرامج التعليمية، ومراكز البحث والدراسات والنشر، للتعريف بمختلف التيارات الفكرية والفلسفية، والأديان الأخرى، هي مسألة في غاية الأهمية، وذلك ضمن إطار استراتيجية بعيدة المدى.
ومن الواضح في هذا المجال أن الدولة الدينية، أو شبه الدينية، غير قادرة على أداء هذه المهمات الحيوية، لأنها لا توائم طبيعة التنوع الذي نعيشه واقعاً في مجتمعاتنا. فدولة من هذا النمط لا تنشد المستقبل، بل تعيش في الماضي بآلامه وعذاباته. وقد دفع غيرنا ضريبة باهظة نتيجة تمسكّه بدولة كهذه؛ ولكنه تخلّى عنها حينما أدرك أن الدولة لا بد أن تكون حيادية على مستوى الإنتماء والتعامل، حتى تكون دولة الجميع.
الدولة المدنية التي تفصل بكل وضوح، ومن دون أي حرج، بين السلطة السياسية والدين، هي المدخل الحقيقي لخروج مجتمعاتنا من حالة التيه الكبرى التي تعيشها وتعاني منها.
قد تبدوالمطالبة بهذه الدولة في وقتنا الراهن صيغة من الرومانسية المستقبلية. و نحن نعلم تماماً أن القوى المستفيدة من الأزمات والحروب ستكون لها بالمرصاد. ولكن التمعّن الهادئ المسؤول في كل ما جرى ويجري، بعيداً عن الهيجانات والشعارات والتشبث بسلطات متكلّسة، يؤكد أن المستقبل هو للدولة المعنية، هذا إذا كانت لدينا الرغبة في التوجه نحو المستقبل كما ينبغي.
* كاتب وسياسي سوري
الحياة