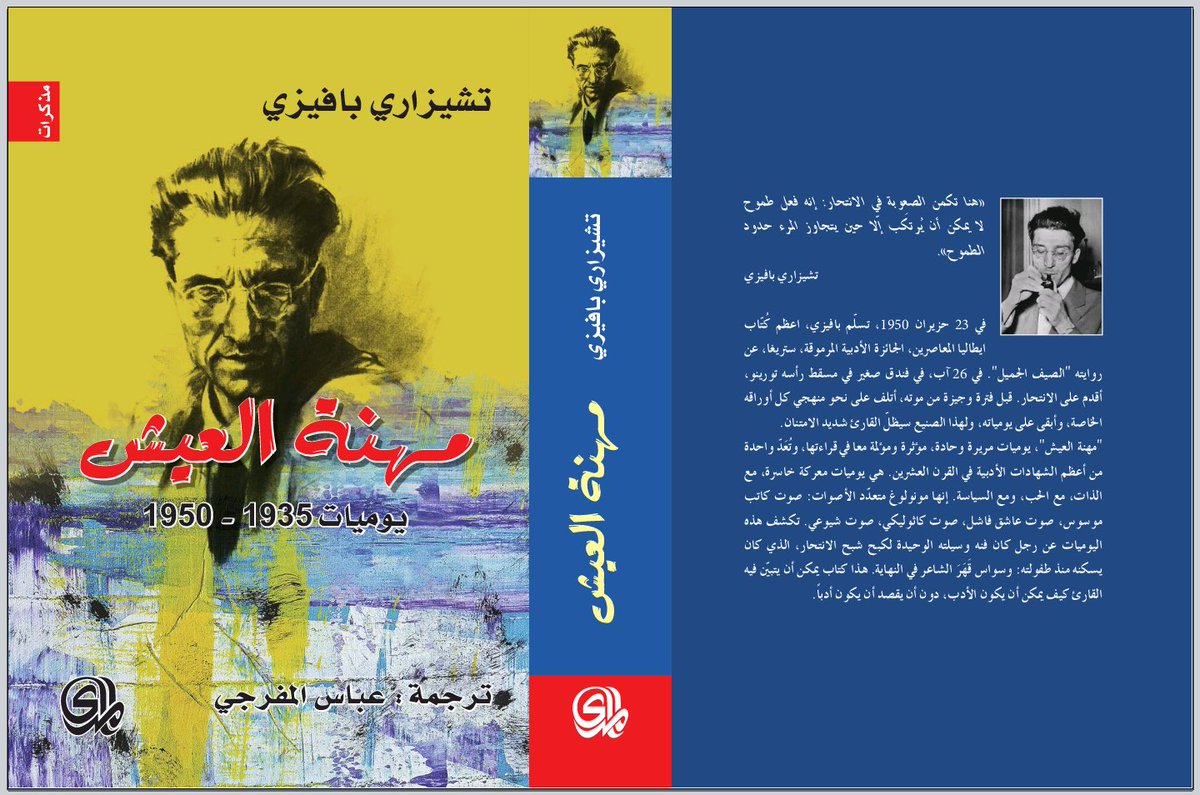كتابان لمحمد كامل الحطيب: “وردة أم قنبلة-إعادة تكوين سورية-” و “المأساة السورية: مائة عام من العذاب”

الكتاب الأول “وردة أم قنبلة-إعادة تكوين سورية-“
حمل هذا الكتاب من الرابط التالي:
وردة أم قنبلة-إعادة تكوين سورية-
مقدمة الكاتب
ـ قصة لم أكتبها، وأتمنى على التاريخ أن لا يكتبها ـ
هوايتي، وربما هويتي التي تخيلتها وارتضيتها لنفسي، هي: القصة القصيرة. أن أكون كاتب قصة قصيرة، هذا كان مشروعي وحلمي وانتمائي الأول والأخير في هذه الحياة منذ بدأت تحديد طريقي فيها. وقد عملت، منذ وعيت، على ممارسة هذه الهواية ـ الغواية، ورسم أو تخيل هذه الهوية وتوضيح وتدعيم هذا الانتماء، فكتبت عدة مجموعات قصصية أعتبرها، على ما هي عليه، نفسي. لكننا، على ما يبدو «لسنا نحن الذين نصنع سينمانا، ـ اقرأ: حياتنا ـ فالزمن الثوري ـ اقرأ: العاصف ـ هو الذي يصنعها ويصنعنا»، كما كان يقول المخرج السينمائي الروسي «سيرجي إيزنشتاين»، إذ إنني أحياناً أجد، أو أضبط نفسي ـ خفية عن نفسي ـ أكتب غير القصة القصيرة… أحياناً أجد نفسي خارج هذه القصة القصيرة كلها… لا أكتمكم أنني أحياناً أشك في جدوى هذه القصة القصيرة، وأشك في هوايتي وهويتي وحلمي ومشروعي، أشك في نفسي وفي بلدي وفي الناس.
شخصياً، وكهاوٍ لكتابة القصة القصيرة، تقوم طريقة كتابتي لهذا الفن على التفكير ملياً في موضوع القصة التي أريد كتابتها. أحياناً أفكر شهراً، وأحياناً أفكر شهرين، ولا يندر أن أفكر عامين وثلاثة في قصة قد أكتبها في صفحتين… أحياناً تعيش فيَّ القصة عشر سنوات، وأحياناً أكثر. وهناك قصة تعتمل فيَّ، وأعيش فيها منذ أواسط السبعينيات من القرن العشرين، عندما كنت أؤدي الخدمة العسكرية في مدينة حلب. إنها قصة أفكر فيها منذ ذاك الوقت، لكنني لم أجرؤ حتى الآن على كتابتها.
تحكي هذه القصة، واعذروني إذا لم أعرف كيف أصفها: هل هي قصة قصيرة، أم هي قصة طويلة، الصراع الوجداني ـ النفسي لمدرس جغرافيا يدرس للطلاب خارطة بلاده والعالم كما هي مرسومة على السبورة، لكن المشكلة أن هذا المدرس يعتقد أنه يدرس خارطة مزيفة ومزورة ومرسومة على عجل، أو أنه، في حالة أخرى، يدرس، وهو الأخلاقي، «أكاذيب في أكاذيب» لكنه لا يجرؤ على إعلان «هذه الحقيقة» أو على فضح هذه الأكاذيب.
مؤخراً، وربما بعد أحداث أيلول 2001، وبعد تطورات داخلية في سوريا، ازداد إلحاح قصة هذا المدرس وهذه الخارطة على مخيلتي وقلمي، لكنني مازلت، كما في البداية، وربما أكثر، خائفاً من أن أكتب هذه القصة، لكن خوفي من كتابتها، وربما رغبتي الدفينة في عدم كتابتها، كما قد يقول التحليل النفسي، يبدو اليوم أقوى من السابق، وأكثر إقلاقاً، فمشكلتي المستجدة مع هذه القصة القديمة أنني بدأت أخاف جدياً ـ هل خوف وساوس؟ ـ أن يكتبها أحد غيري، أخاف أن يكتبها دون إحساس، من لا يبالي بالبشر، أو بمخاوفي ومشاعري، وربما من لا يبالي بدلالة هذه القصة، أخاف أن يكتبها هذا البارد، الماكر، المراوغ… أخاف أن يفعلها ويكتبها: التاريخ.
قصة أرفض أن أكتبها، لكنني أتمنى على التاريخ ألا يكتبها. لكن يبدو أنها قصة قصيرة مثل غيرها من القصص، قصة لا تنتظر أو تستشير كاتبها.
إنها ـ على ما يبدو ـ قصة تكتب نفسها بنفسها0
محمد كامل الخطيب
2006
رأي ياسين الحاج صالح في الكتاب
ياسين الحاج صالح
قد ينفرد الأستاذ محمد كامل الخطيب عن غيره من المثقفين السوريين بشدة قلقه وتشاؤمه. وقد ينفرد كتابه “وردة أم قنبلة: إعادة تكوين سورية” ، الذي صدر مطلع العام الحالي بمستوى متقدم من التشاؤم قياسا إلى ما تبدى في كتب سابقة له. الرجل قلق في كتابه هذا من احتمال انسياق بلاده إلى الاحتراب الأهلي والتقسيم على أساس طائفي (ص 91)، ويرى أن هذين الاحتمالين يترتبان على “خيار الدولة الدينية أو مشروعها”، الخيار الذي يعتقد أنه واحد من خيارين تقف سوريا أمامهما.
يتراءى للكاتب “أن سوريا، ومعها مناطق وبلدان كثيرة على أبواب إعادة تكوين”، ويتساءل عما إذا كانت “إعادة التكوين هذه ستجري على أساس عقلاني، علماني، ديمقراطي، مدني، أي على أساس تعاقد وطني اجتماعي متساو للبشر، كبشر يستطيعون اختيار هوياتهم ودولهم، أو أن تتم إعادة التكوين على أساس إلهي، ديني– طائفي” (ص 91-92). ليسوا قلة من يشاركون الأستاذ الخطيب هذا الطرح المغلق والإيديولوجي والمضارب للخيارات على السوريين، لكن قد يكون هو أول وأصرح من يرتب على تقدم الخيار الثاني إعادة رسم خريطة سوريا: “ووقتها”، يقول، “لا مجال إلا لإعادة رسم الخرائط، على ما يبدو” (ص 92).
هل سوريا مهددة فعلا بأن يعاد تكوينها على “أساس إلهي، ديني– طائفي”؟ لا يطرح الكاتب هذا السؤال، ولا يقدم لقارئه تفسيرا لسبب بروز هذا الاحتمال. والواقع أن لكتابه كله بنية تقوم على التلميح لا التصريح، والاستدلال لا البحث، وتجنب النقاش لا طرح فرضيات يمكن لآخرين اختبارها. وتكتسب قضاياه وضوحها مما ينبث فيها من رموز وتلميحات ومواربات وتواطؤات.. لا يلتقطها غير المثقفين السوريين على اختلاف منابتهم ومشاربهم، لكنها غامضة جدا لغير السوريين، أو للسوريين أنفسهم إن رفضوا التواطؤ على تلك الرموز والاستعارات، ولم يحاولوا كشف محتواها “العقلاني العلماني”.
شيء آخر يتجنبه الكاتب بثبات لافت: مناقشة طبيعة وتكوين النظام السياسي في سوريا. هذا إغفال غريب في كتاب يطرح مستقبل البلاد للتأمل، وفي بلاد يحكمها منذ 36 عاما نظام واحد ذو سمات شمولية قوية، ما يعني أنه متحكم بجوانب الحياة كافة، السياسية والاجتماعية والثقافية والدينية والنفسية. لكن كيف استطاع الأستاذ الخطيب فعل ذلك؟ بتبني مقاربة تاريخانية تنزع، كما هو دأب المقاربات التاريخانية دوما، إلى إذابة الحدث التاريخي في مخطط حتمي متعال على وقائع والتجارب البشرية الحية، وإلى التقليل من شأن خيارات الفاعلين ومسؤوليتهم لمصلحة منطق تاريخي لا غالب له (في هذا تاريخانية الخطيب التخطيطية مناقضة لتاريخانية عبد الله العروي التي تفسح مجالا لدور فاعل للمثقف والسياسي. وقد يكون أصل فقر تاريخانية مؤلفنا كونها أداتية، لها غرض أيديولوجي محدد كما سنرى، وتاليا ليست واعية بذاتها).
يقرر الخطيب أن النهضة العربية تجلت في: (1) وعي التخلف عن الغرب، و(2) محاولة اللحاق به، أي “الانتقال من النمط الريفي- الزراعي للإنتاج والحياة إلى النمط المديني الصناعي الحديث”، و(3) “الانتقال من اللاحم الامبراطوري الديني للمجتمع، إلى اللاحم القومي الثقافي، أي الانتقال من الدولة الدينية إلى الدولة القومية- الوطنية”. ومحرك التاريخ الحديث هو ديناميكية التوسع الرأسمالي التي يحفزها التقدم التكنولوجي و”مبدأ الربح” وتركز السلطة والثروة والثقافة في المدن، “وهذا أمر جديد بدأ منذ القرن التاسع عشر” في رأيه. ولم يكن المجتمع العربي خارج هذه “العملية التاريخية العالمية” التي أقحمته في المسرح العالمي. وكانت نهضة العرب مثل غيرهم من شعوب الشرق تعني تكييف هذه العملية التاريخية لصالح هذه الشعوب. وهي “عملية نضال وبناء دولة وتحرر وطني ضد الاستعمار، مثلما هي عملية تحرر اجتماعي”. وجوهرها “إدراج المجتمعات العربية، كمجتمعات بدوية وفلاحية كلها – بريفها ومدنها- في النظام العالمي الرأسمالي – المديني المنتشر والمسيطر، بدءا من أوربا” (ص 14-18).
هذا هو الإطار النظري الذي يؤسس لجملة ما يورده الكاتب من أفكار ومواقف في كتابه. وكما هو ملاحظ، فإننا إزاء تاريخانية، مبسطة من الصنف الذي يستحيل التفكير في الشأن السياسي على أرضيته. الحاضر هنا بلا كثافة ولا قوام ذاتي. والدولة هنا وكالة تاريخية مطواعة، أو أقله محايدة، في خدمة التقدم أو اللحاق؛ فلا جدوى من النظر في بنيتها وآليات عملها وتكوين نخبة الحكم ونمط ممارسة السلطة وكيفية اتخاذ القرارات وما إلى ذلك. والعملية التاريخية هذه التي يصفها بأنها “آلية وغائية” (ص 23)، معقولة بالكامل بغض النظر عما قد يرافقها من مآسي إنسانية: فكل ما هو واقعي عقلاني وكل ما هو عقلاني واقعي (ص 23)، حسب هيغل الذي يستحسن الكاتب اقتباسه، ويخفق في الإحاطة بأصل فكرته .
قاموس مزدوج
يعتقد الأستاذ الخطيب أن هذا الإطار يمكنه من فهم “الحراك الاجتماعي السكاني” الذي شهدته البلاد العربية بعد استقلالها بوصفه «عملية تحضير وتمدين ورسملة وتحديث لهذا المجتمع الريفي ككل، وليست عملية “ترييف للمدينة العربية” كما يحلو حتى لبعض “الماركسيين” القول» (ص 19).
لكن ألا يمكن القول إن ترييف المدنية العربية هو أحد الوجوه التناقضية لعملية تمدين المجتمع العربي ككل؟ نتساءل على أرضية افتراضات الكاتب، ومن باب استغراب سخطه الشديد على أطروحة ترييف المدينة. غير أن الخطيب، وفي نقلة مباغتة تكشف مصدر سخطه، يقرر أن الكلام على ترييف المدينة العربية هو “قول يخفي في طياته بذور وعي، أو لا وعي، طبقي قديم، أو وعي ولا وعي طائفي مؤسف”. كيف ذلك؟ ما علاقة الكلام عن ترييف المدن بالوعي أو اللاوعي الطائفي المؤسف؟ هذا ما يمكن أن يتساءل بصدده قارئ غير سوري. أما القارئ السوري الذي اعتاد قاموسا مزدوجا للتعبير عن أفكاره السياسية والاجتماعية فسيدرك أن ثنائية ريف/ مدينة أبدلت خلسة بثنائية أخرى هي أقلية (أقليات)/ أكثرية دينية ومذهبية، أو بفظاظة أكبر: علويين/ سنة. لقد تحول الكاتب من قاموس إلى قاموس دون أن ينبه القارئ، وربما دون أن ينتبه هو أيضا.
والحال قد يكون ياسين الحافظ من أول من تحدثوا عن ترييف المدن في سوريا والبلاد العربية وهو شخص يصعب اتهامه، بالطائفية رغم أنه لم يكن يتهيب التحديق في عين الولاءات والمنازعات الطائفية مباشرة. على كل حال لا يضع الكاتب اسمه في قائمة من أربع كتاب عرب، بينهم سوريان، يتهمهم بـ”النظرة الطائفية إلى الفكر أو المجتمع والتاريخ”: محمد عابد الجابري وحازم صاغية وبرهان غليون وجمال باروت (ص 21). ويبدو أن أساس اتهامهم هو اعتقاد مؤلفنا أنهم يستخدمون مفهومي الأقلية والأكثرية “بالمعنى الديني والطائفي”. وهو معنى ينكر هو شرعيته، لأنهما من المفاهيم “المدنية والسياسية” “المتحركة”. ونرجح من جهتنا أن سبب رفضه لاستخدام المفهومين، حتى في سياق تحليلي، هو خشيته مما كان يسميه المنظرون الليبراليون الأوربيون في القرن التاسع عشر “طغيان الأكثرية” والخوف من هضم حقوق الأقليات. غير أن الطريق الأسلم، في تقديرنا، لضمان حقوق الأقليات هو الإقرار بوجودها، ذلك أن إنكارنا شرعية المفاهيم لا يغير من الواقع شيئا، بل قد يوفر غطاء نظريا لاستبداد لا يعترف بأي حقوق للجميع، إلا بقدر ما تقتضي ذلك دواعي استقراره وشروط استمراره ودوامه. وواقع الحال ناطق.
من ناحية أخرى فإن هذه الفكرة الشائعة رغم ضحالتها، فكرة أن الأقلية والأكثرية مفهومان متحركان وسياسيان وليسا مفهومين دينيين وثابتين، تحرمنا من مقاربة العلاقة بين الأقليات والأكثريات، الثابتة منها والمتحركة، ومن اقتراح مفاهيم نظرية وخطط سياسية وإجراءات قانونية للحد من احتمالات تطابقهما. فمن المحتمل جدا أن تكون أية أكثرية سياسية مدنية متحركة مكونة من الأكثرية الدينية في بلدنا في المراحل الباكرة من التحول الديمقراطي. والتقارب هذا سيكون أكبر كلما طالت الشروط الراهنة التي تغذي الوعي الذاتي الفئوي لدي جميع مكونات المجتمع السوري. فلا نظن الكاتب يجادل في أن المرحلة الراهنة هي مرحلة “تراكم ديمقراطي أولى”، تتحلل فيها الروابط الأهلية، الدينية والمذهبية والإثنية وغيرها، لمصلحة رابطة المواطنة. ما يجري في الواقع هو المزيد من انحلال الرابطة الوطنية، وليس العكس. وهو انحلال لم يهبط من السماء. إن أسبابه أرضية ويتعين تحليلها على الأرض. لكن كان من شأن مقاربتها بالتحليل أن يقتضي من الأستاذ الخطيب التخلي عن آلته التاريخانية، والنظر إلى السياسة ووقائعها وهياكلها بعين العطف.
إلى ذلك، لماذا لا يصح الكلام على أقليات وأكثريات دينية وإثنية ومذهبية؟ ثمة جماعات، دينية أو مذهبية أو إثنية، في مجتمع تتشكل أكثريته المطلقة (أكثر من 50% من سكانه) من جماعة دينية أو مذهبية أو إثنية مختلفة. هذا واقع يحتاج إلى اسم من أجل حدّه وضبطه. كلمتا أقلية وأكثرية تسميان هذا الواقع. ولتبديد التباسات محتملة يمكن أن نتحدث عن أقلية (أو اكثرية) مذهبية أو أقلية انتخابية أو أقلية قومية، وإن شئنا أقلية وأكثرية عمودية وأفقية…إلخ. في الماضي العربي الإسلامي كانت تستخدم كلمة نوعية لا كمية، إن جاز التعبير، هي كلمة الملة. لكن فيما عدا أن الملل كانت تقتصر على الأديان المعترف بها قرآنيا، وتقصي الجماعات المذهبية الإسلامية (السياسة العملية مختلفة نسبيا وأكثر براغماتية..)، فإن المضمر في هذه الكلمة أن السيادة العليا هي حتما وحصرا للمسلمين. وهو ما ينطبق على تعبير “أهل الذمة” أيضا بدرجة أكبر. أما كلمات أقلية وأكثرية فهي مرتبطة بعقلية العصر الكمية، ورغم أنها دخلت ثقافتنا مع الفتوحات الاستعمارية، إلا إنها متشربة بدلالات تتصل بالديمقراطية وحماية الأقليات أو ضمانة حقوقها المتساوية.
إلى ذلك فإن كاتبنا نفسه يتبين “وعيا ولا وعيا” طائفيا في سلوك ماركسيين وتقدميين وغيرهم. فإذا كان يقر بدور تفسيري للعامل الطائفي في توجيه أفكار بعضنا، فلماذا يرفض تناول هذا الدور بالتحليل؟ أليس الأنجع أن نتناول مفهومي الأقليات والأكثريات الطائفية بالبحث الاجتماعي والتاريخي بدلا من تحريمهما وشن حرب ضدهما؟ المفاهيم ليست أوثانا ولا مقدسات، إنها أدوات يمكن تطويرها وإرهافها لمقاربة الظواهر الاجتماعية. قد يخدش هذا حساسياتنا ويسبب حالات سوء تفاهم بيننا، لكن مع ضرورة بذل الجهد لتجنب الإثارة المجانية للحساسيات، ينبغي القول إن هدف المعرفة هو تحليل الظواهر المزعجة وليس إنقاذ المظاهر اللطيفة.
والواقع أن هذا هو التناقض الأكبر والمكون للكتاب كله: إن القضية المحركة لتفكير الكاتب هي القضية الطائفية التي يشدد عليها النكير إلى درجة تحريم ذكرها (إلا في صيغة اتهامية)، وهو تحريم ملفع بتحليل كونوي وتاريخاني مجرد لا يقدم أي فائض قيمة معرفي من جهة، ومسيج باتهامات بالطائفية ضد خصومه الفكريين من جهة أخرى.
ليس الكلام على أقليات وأكثريات دينية ومذهبية كلاما طائفيا بالضرورة، وليس تحريم استخدامها برهانا على التحرر من الطائفية. إنها أدوات للتحليل الاجتماعي والسياسي، لا غني عنها في أي مجتمع حديث. كان يمكن للكاتب، لو ترفع عن الاتهام، أن يطور أدوات لمقاربة الشأن الطائفي دون تهويل فيه ودون تعام عنه. وإذ لم يفعل فقد انفصمت مقاربته إلى رفض مجرد لأخذ العامل الطائفي بعين الاعتبار على الصعيد النظري، مع التلويح بما لا يقل عن خطر الحرب الأهلية وإعادة رسم خريطة البلد على الصعيد العملي. ولو ترفع عن الاتهام كذلك لما شن حربا ضد مفهوم ترييف المدنية، ولبدا له المفهوم هذا علائقيا، ينفتح من جهة على تزايد سكاني وضغط على الأرض في الأرياف، وعلى مدينة ضعيفة الطاقة الدمجية من جهة أخرى، مدينة تهاوت تحت الترييف لعجزها عن التمدين. أصل الترييف عجز البنية الإنتاجية للمدينة عن استيعاب الدفق البشري الذي تولد عن تنقيد اقتصاد الكفاف أو شبه الكفاف الريفي، والزيادة السكانية المرتبطة بالتقدم الصحي، وتحلل الروابط الأهلية أمام تقدم العلاقات الرأسمالية في الريف. الأمر الذي يدفع القادمين إلى أنشطة هامشية ( كان يشتغل في القطاع غير المنظم 43% من العاملين في سورية عام 1999، يعيشون عمليا خارج دورة الاقتصاد الوطني ) وتوسيع صفوف العاطلين عن العمل (22% من قوة العمل حسب بحث لمعهد كارنيغي الأميركي نشر مؤخرا ) فضلا عن البطالة الهيكلية في أجهزة الدولة. كانت هذه الأجهزة، الإدارية والأمنية والعسكرية والإنتاجية، قد استوعبت الدفق البشري الريفي في السبعينات، لكن طاقتها الاستيعابية تراجعت في الثمانينات والتسعينات، ثم غدت كتيمة حياله في السنوات العشرة الأخيرة. هذا الشرط تفاقم بسبب السياسات الاقتصادية في العهد البعثي التي اعتمدت محاسبة اجتماعية وسياسية عينها على الولاء والمحاسيب وليس على الاستثمار المنتج والربح والمردودات التنموية. وهي السياسات التي فاقمت قصور المدينة، وتبدو حريصة على ألا تطور مدننا شخصية قوية ذات تقاليد حية وقدرة على المبادرة والاحتجاج والتفاعل مع العالم. بعبارة أخرى القصور التمديني للمدينة علائقي على مستوى آخر: فهو ثمرة تقاطع ضعف مستوى الرسملة الاقتصادية والبرجزة الاجتماعية والثقافية في البلاد من جهة، وسياسة نخبة سلطة تضع في المقام الأول من اهتمامها إدامة سيطرتها والانفراد في تحديد الأولويات الوطنية وتحريك الموارد الوطنية من جهة أخرى.
ومن أهم مظاهر الترييف ضعف التشكل أو التبنين المديني، عمرانيا وبيئيا، كما مؤسسيا ووظيفيا. عمرانيا المدينة السورية، خصوصا العاصمة دمشق، مثال للكيتش، أي لسقم الذوق والوظيفية في أشد أشكالها تدنيا وبدائية. وخلوها من الساحات العامة أمر لافت للنظر. وهي تفتقر إلى مراكز ثقافية متفتحة ونشطة، وإلى مسارح وصحف وصالونات..، وقبل الجميع إلى حياة قانونية، وبيروقراطية عقلانية حديثة تتعامل مع السكان بصرف النظر عن حيثياتهم، فوق افتقارها إلى الصناعة الكبرى والنقابات الناشطة. يضاف إلى ذلك كله سيطرة العلاقات القرابية والمحسوبيات المميزة للريف لا للمدينة الحديثة. وكما ألمحنا، هذا يتصل بالطبع بمستوى التطور الرأسمالي الرث في بلادنا، لكن كذلك بتكوين وتفضيلات طواقم السلطة في البلاد، وهي طواقم من أصول ريفية، وجدت في السلطة وريع السلطة مصدر نفوذها وثروتها، في ظل ضعف التراكم الرأسمالي المحلي. وهي كذلك النخب التي أضحت اليوم طبقة ذوات أو وجهاء جدد، تفوق في انغلاقها، وفي ثرائها وسلطتها، طبقة “أعيان المدن” من التجار و”ملاك الأراضي الغائبين” (فيليب خوري) ، ممن كانوا نخبة السلطة في العهد الاستقلالي. هذا كله لا علاقة له بالطائفية. وجرى مثله في بلاد عربية وغير عربية لا تضج بأديانها وطوائفها.
ولو قاوم الكاتب إغراء الاتهام والقاموس المزدوج لتبين أن الريف السوري ككل، وهو متعدد الطوائف، هاجر إلى المدن السورية جميعا، الكبرى أكثر من غيرها، والعاصمة أكثر من الجميع؛ وأن أكثر المدن السورية جديدة بالفعل، وكانت قبل عقود فحسب قرى كبيرة بعض الشيء. وأن المدن السورية الكبيرة والقديمة، دمشق وحمص وحماة وحلب، كانت مدنا ما قبل رأسمالية أي محدودة الطاقة الدمجية وغير قادرة على تحويل الفلاحين إلى عمال صناعيين.
كثير من هذه الظاهرات التي تندرج ضمن مفهوم ترييف المدينة رآها الكاتب نفسه (ص 35 و36 مثلا)، فلماذا يحارب مفهوما لا منافس له في توحيد حزمة الظاهرات هذه؟ لأنه أعطاه معنى إيديولوجيا منفصلا عن معناه العلمي، أو لأنه يشعر أن المفهوم يستخدم لأغراض إيديولوجية تتصل بالتنازع الطائفي. هل هو محق؟ هل يحصل أن تستخدم مفاهيم الريف والمدينة والترييف … لأغراض إيديولوجية وسياسية تتصل بالتنابذ الطائفي؟ نعم للأسف . لكن هذا يقتضي من الكاتب، ومن أي مثقف عقلاني، تقصي أصول القاموس المزدوج عند السوريين وكشف المخاتلات والمواربات والإبدالات الشائعة في أوساطنا العامة والنخبوية . ولو فعل لتبين أن أصل تلك الحيل هو التطييف الخفي للحقل السياسي والإيديولوجي المحلي. ما يعني أن اعتماد لغة أكثر شفافية وأقل ازدواجية يقتضي بكل بساطة فصل المؤسسات السياسية الوطنية عن التكوينات الطائفية الجزئية.
لكن بدلا من إقامة موقع علمي وسياسي يمكنه من نقد المداورات الخطابية يقيم الأستاذ الخطيب على الدوران حول هواجس مرتبطة بالشأن الطائفي: “وربما كانت هذه النوستالجيا [إلى “شرب النراجيل” والقاهرة القديمة وحلب القديمة…]، أحيانا، شكلا من أشكال التعبير عن المعارضة والرفض الاجتماعي والسياسي والطبقي بل والطائفي لما يحدث، أو عدم القدرة على فهمه. مثلما هي، وبصريح عبارة، شكل سهل – “إعلان”- من أشكال “المعارضة السياسية”، تماما، كالظاهرة الدينية الإسلامية في المنطقة العربية” (ص 37). نلتقي مرة أخرى هنا التناقض الأكبر في كتاب الأستاذ الخطيب: لا يقارب الطائفية بتحليل موضوعي، ولا يستطيع تجاهلها؛ الاتهام هو الحل.
ضد الحدث
وفيا لمقاربته التاريخانية الآلية، يرى الكاتب أن ما حدث في “هذه الدولة العربية أو تلك” ليس “مجرد اغتصاب للسلطة، أو قطع للشرعية، أو إيقاف لمسار الديمقراطية، أو ترييف لمدينة لم تكن أصلا إلا مركزا ريفيا مضخما، أو إرهاب وجشع للسلطة والمال”. هذه “ظواهر” في رأيه، وهي لا تبدو اغتصابا وقطعا وإيقافا وترييفا وإرهابا وجشعا إلا “لمن لا يريد التعمق في المجريات التحتية، لكن غير الخفية، للحركة التاريخية، ويكتفي بالشيء كم يبدو، دون محاولة التعمق في الشيء كما هو، كما في التفرقة الكانتية المشهورة” (ص25). متعمقا في الشيء كما هو، يبدو التاريخ للكاتب عرضا للتاريخانية، لمخطط تاريخي متعال يلعب حيال التاريخ كحدث دور الشيء في ذاته الكانطي حيال الظاهرة. وبعد إفقاد الحدث استقلاليته وتبخيره في هذا المخطط العمومي والمجرد، كيف لا يكون الاستعمار والطغيان مبررين في أدق تفاصيلهما؟ من غورو إلى رفعت، ومن صدام إلى بريمر؟ ولن ينسى أن يقول إن هذا هو “مكر التاريخ”، وتلك هي “طريقة تبدي التاريخ”: “إنه التاريخ الذي يسير بالدم والدموع والآلام والعنف، عبر آلية تكوين المجتمعات والدول وانحلالها، يسير بالجرائم والنهب، مثلما يسير على إيقاع حفيف الشجر وتلاشي الأمواج على الرمل وحبو طفل على عشب يانع”. تتساوى الجرائم وحبو الطفل حين يغدو التاريخ مطلقا! ومن ثم ينقاد إلى القول: “ذلك هو التاريخ الذي يعلو على آلامنا وأفرحنا، على انتصاراتنا وهزائمنا”. كنا نظن أن ما يعلو على “أحكامنا البشرية[كذا]”، وعلى آلامنا وأفراحنا.. هو القدر وليس التاريخ. غير أن التاريخ، وقد ارتدى حلة تاريخانية تضفي النسبية على العناء البشري، والإطلاق والعلو على حركة “آلية وغائية”، ليس إلا صيغة معلمنة عن القدر الديني، قادرة على امتصاص كل ما هو حدث وتبرير كل ما هو مأساوي .
ضد الاتساق
على أن قدرية الكاتب التاريخانية تبقي وفية لذاتها طالما هو يتكلم عن “المجريات التحتية، لكن غير الخفية” لتشكل الوضع الراهن، فإن تلامحت احتمالات تغيره بارح الكاتب تاريخانيته، وبدا له التاريخ “أفق احتمالات أكثر مما هو ممرات إجبارية” (ص 90). بعبارة أخرى، لا ينساق الكاتب وراء المنطق التاريخاني إلا لأنه يقوده إلى تبرير أوضاع قائمة يتوجس من تغيرها، أما حين تبدو التطورات مقلقة من وجهة نظره فيضحي بتاريخانيته التخطيطية رأسا. فهو نقدي حيال ما قد يأتي، بقدر ما هو تسليمي حيال ما هو قائم. وينبغي ألا يكون هذا الافتقار إلى الاتساق مفاجئا. فللكاتب إيديولوجيته التي لا تتسق إلا إن لم يكن تفكيره متسقا.
بيد أن المؤلف يستبقي من تاريخانيته، حتى حين ينحاز إلى التاريخ كـ”أفق احتمالات”، تهميش السياسة وإقصاء الحدث السياسي. فلا نعثر على كلمة واحدة عن النظام السياسي وأصوله وبنيته وتكوين نخبة السلطة ونوعية “اللاحم” الذي يشد السوريين اليوم إلى بعضهم. من أين أتت الدعوة إلى “لاحم إلهي، ديني- طائفي” اليوم؟ لا يسعفنا “تحليل” المؤلف في الإجابة على هذا السؤال، رغم أن اللاحم هذا يقلقه كثيرا. والحال لم يتنزل اللاحم الإلهي أيضا من عند الله ولم يسقط من السماء. إنه نتاج شروط بشرية، سياسية واجتماعية واقتصادية وثقافية يتعين تحليلها.
لكن بلى، يتحدث الكاتب بالفعل عن النظام السياسي. يشير بطريقة مواربة إلى استبداد عسكري وحزبي قائم في تقابل مع استبداد ديني وطائفي مهدد، متكتما على أية إشارة إلى دور مفترض للعنصر الأهلي في الاستبداد الأول. ويمضي دونما حذر إلى المفاضلة بين الاستبدادين، كاشفا انحيازا للأول كان مخبئا وراء تاريخانيته الفخمة. الاستبداد الحزبي العسكري (إقرأ: الحالي) “لا يتدخل في شؤون الإنسان الحياتية اليومية”، وهو يكاد يكون “مؤقتا ومرهونا بطغمة عسكرية وسياسية قصيرة الأجل”. ويستذكر ديكتاتوريات حسني الزعيم وأديب الشيشكلي وأمين الحافظ (؟!)، قبل أن يدلي بملاحظة كاشفة جدا، أو “أعراضية”، بصددها: “لم ينبذ أحد تلك الدكتاتوريات أو يصمها بوصمة دينية أو طائفية أو قومية، أو جهوية” (ص 84). واضح على ماذا يرد الكاتب (على من يقولون ببعد طائفي للاستبداد الحالي)، لكن ليس من سياق كلامه، بل من الترجمة الفورية التي يجريها القارئ السوري بين قاموسين.
الاستبداد الديني الطائفي، بالمقابل، “يتدخل في ضمير المرء وفي حياته ومأكله ومشربه وطرق مخالطته الاجتماعية”. وبينما لا يخبرنا الكاتب إن كان الاستبداد هذا خالدا خلافا لاستبداد الطغمة العسكرية “المؤقت”، فإنه يشير إلى إمكانية “تغيير الولاء في ظل الاستبداد العسكري والسياسي، أما صاحب العقيدة، أو الدين، أو القومية [القومية أيضا؟] فيظل مقتنعا ومقيما على عقيدته غير عابئ، وغير مقتنع بمفهومي الأقلية والأكثرية”. هل ثمة شيء من الارتباك في هذا الكلام؟ لن يلبث معنى هذا السياق الظاهر أن يستضيء من السياق الكامن: «لن يستطيع أحد أن يقنع أحدا بترك عقيدة أو قومية أو انتماء، أو تاريخ ارتضاه لنفسه (…) وحافظ على وجوده خلال مئات السنوات لمجرد “نبذه” بأنه “أقلية” أو مدحه بأنه “أكثرية”». واضح جدا! والفضل في وضوحه للسياق الكامن الذي يركبه القارئ من نتف ونتوءات وارتباكات السياق الظاهر الذي يتحدث بلغة مجردة ومفهومية. والحق أن كتاب الأستاذ محمد كامل الخطيب هذا يصلح مادة ممتازة لدراسات أسلوبية ولتجريب أدوات تحليلية مثل ازدواج القاموس وازدواج السياق، وذلك بشرط وضع مقدمة اجتماعية وسياسية وتاريخية كافية لهذه الدراسة. سنلاحظ فقط أن السياق الكامن يظهر مباشرة على السطح حين تتعطل، بين وقت وآخر، الآلة التاريخانية للكاتب، وتكف عن طحن “الوقائع الصلدة” إلى مسحوق نظري متجانس، فتنزل هذه منها كتلا خاما من الواقع، كما هي.
ويبدو أن الكاتب يقصد أن الإقرار بوجود أقلية وأكثرية يشكل ضمانة لعدم فرض ولاءات خارجية على الأقلية. هذا معقول، لكن سبق أن رأينا أنه يحرم مفهوم الأقلية الدينية أو الطائفية. وكلامه لا يستقيم إن افترضنا أن مقصده الأقلية والأكثرية “كمفهومين سياسيين متحركين”. إذ أن “العقيدة” و”القومية” و”الانتماء” لا تضاف إلا إلى أقليات وأكثرية دينية ومذهبية وإثنية.
لنضرب صفحا عن “مدح الأكثرية” و”نبذ الأقلية”، لمتابعة مواطن قلق الكاتب: «لن يقبل أحد من أحد، وخاصة في العالم المعاصر أن يفرض عليه انتماء، أو نمط حياة وسلوك وعادات وحياة وتقاليد وتاريخ وعادات مأكل ومشرب ولباس ومخالطة اجتماعية وطريقة عبادة تحت لافتة أنتم أقلية كونوا مثل الأكثرية. وهذه أمور ليست تافهة، فالناس يعيشون في مثل هذه الأمور وعليها، ولا يعيشون دائما على “الأفكار الكبيرة” وبها». ملحوظتان من طرفنا: (1) الناس لا يعيشون أبدا على “الأفكار الكبيرة” أو بها؛ (2) ليس نمط الحياة والمأكل والمشرب والزي والمخالطة… أشياء غير تافهة فحسب، بل هي أسلوب الحياة، وجوهرها. ودون تهويل، لكن ضد أي تهوين، نشارك الكاتب الاعتقاد بأنه إذا فكر أي طرف سياسي أو إيديولوجي سوري فرضها على غيره فإن ذلك وصفة للحرب الأهلية بالفعل. من لا يدرك ذلك لا يفقه شيئا، ولا يحس كذلك. إن الحق في ارتداء بنطال جنز ضيق أو عدم وضع حجاب أو احتساء الخمر يفوق في أهميته حق التعبير عن الرأي بحرية وحق التجمع والاحتجاج العلني. ومن غير المتسق وغير الأخلاقي أن يستنكر أي كان إقدام ميليشيات المظليات المرتبطة بسرايا الدفاع على نزع الحجب عن رؤوس نسوة دمشقيات خريف 1981، ثم يقبل أو يدعو إلى فرض الحجاب على نساء سوريات أو منعهن من ارتداء ما يحلو لهن، أو منع سوريين من احتساء مشروبات كحولية في مطاعم ومحلات عامة. والواقع أن سوريين كثيرين، من الأقليات الدينية والمذهبية كما من المسلمين السنيين، يخشون أن يسعى الإسلاميون، “الإخوان” أو غيرهم، إلى فرض نمط حياة ديني على البلد أن تسنى لهم الوصول إلى الحكم. وهو أمر لا يمكن قبوله بأي حال. فما تحقق للسوريين من حرية على مستوى أنماط الحياة الخاصة يتعين أن يستكمل بحرياتهم المدنية والأساسية، لا أن يسحب بعد انطواء صفحة “الاستبداد الحزبي العسكري”.
بعد ذلك يعود الكاتب إلى رفض صلاحية مفهومي “الأقلية والأكثرية في المجال الديني والطائفي والأقوامي”. يعود كذلك إلى الاتهام بالطائفية: “ومع الأسف فكثير من متكلمي السياسة – هذه الأيام- وخاصة في ذوي “الماضي اليساري” يلعبون هذه اللعبة التنكرية غير النظيفة، وغير الواعية – على فرض حسن النية- ويمارسون السياسة عبر مكبوتاتهم الدينية والطائفية، أو عبر غريزة ثأرية على ما يبدو” (ص 86). الترجمة ضرورية هنا: إن معارضين للنظام، يساريين بعينهم (لن نترجم أكثر!)، يتحدثون عن أقلية وأكثرية، إما تغطية غير نظيفة وقد تكون غير واعية لنوازعهم الطائفية (السنية؟)، أو تحركهم دوافع انتقامية حيال النظام الحالي. لماذا؟ ولماذا يكبتون دوافعهم الدينية والطائفية؟ لا يسخو الكاتب بإجابات على أسئلة لم يطرحها.
تبقى بضعة نقاط تفصيلية لكنها تضيئ “براهين” الكاتب ومستوى حججه: “ينبغي التذكير بأن محاولة إعادة اللاحم أو العاقد أو المشروع الديني الإسلامي في الجزائر أدت منذ تسعينات القرن العشرين إلى شبه حرب أهلية” (ص 87). ملحوظة: هناك رواية أخرى تقول إن انقلاب المركب العسكري المافيوزي في الجزائر على انتخابات ديمقراطية جرت عام 1992 هو سبب الحرب الأهلية في الجزائر. هل الحركة الإسلامية مشاركة في المسؤولية؟ بلا ريب. لكن نقاشا جديا للحرب الأهلية الجزائرية يقتضي مقدمات مختلفة وأكثر تجردا. يضيف: “ومحاولة فرض اللاحم أو العاقد أو المشروع الديني في السودان أدت إلى مشروع تقسيم السودان”. ملحوظتان: (1) الحرب الأهلية في السودان بدأت قبل “المشروع الديني”؛ (2) توقفت الحرب في الجنوب بينما “المشروع الديني” مستمر. ثم أحلى الكلام: “أما العراق فيعيش أجواء حرب أهلية للأسباب المتقدمة إياها، سواء كان اللاحم المفروض هناك قوميا أو دينيا أو طائفيا”. أية “أسباب متقدمة”؟ ومتى تقدمت؟ وما معنى القول سواء كان اللاحم كذا أو كذا؟ أقل ما يقال أن هذا الكلام غير متسق، وأن نظرية اللاحم لا تفيد إطلاقا في تفسير الحرب الأهلية العراقية، إلا إذا ترجمت من لغة ميتافيزيقية إلى لغة سياسية مباشرة: دكتاتورية صدام حسين “الحزبية العسكرية”، الطائفية أيضا، حطمت الوطنية العراقية وفرقت العراقيين طوائف واثنيات..
وأخيرا، الطائر المحكي: “أما في سورية الثمانينات من القرن العشرين، فقد أدى تحويل المعارضة السياسية إلى معارضة دينية، إلى بداية نشوء أحاسيس ومخاوف وأفكار، ثم تشكيل جمعيات وتجمعات طائفية لدى مختلف الطوائف، كما هو معروف” (ص 87). أكثف ثلاثة أسطر ونصف في الكتاب! ثلاث ملحوظات: (1) تحويل المعارضة السياسية إلى دينية؟ كيف تحولت؟ ومن حولها؟ ولماذا تحولت؟ وهل لهذا الكلام المعنى ذاته لعبارة: قيام معارضة سياسية على أرضية دينية واعتمادها العنف في مواجهة نظام متهم بانحيازات أهلية؟ (2) “بداية نشوء أحاسيس”؟ بداية؟ أحاسيس؟ أية أحاسيس؟ عند من؟ هل نزلت “الأحاسيس” فجأة من السماء مثل “اللاحم الإلهي؟” (3) جمعيات وتجمعات لدى مختلف الطوائف؟ ليس مختلف تماما، وليس لدى الطوائف تماما، وليست جمعيات وتجمعات تماما!
أسهبنا في متابعة حجاج الأستاذ الخطيب وبراهينه السياسية لأننا نعتقد أننا بحاجة إلى تطوير مقاربة متسقة لأدبيات وفيرة، ومرشحة لمزيد من الوفرة، في سوريا، أدبيات تتكتم على موضوعها بدل أن تنيره: أدبيات المسألة الطائفية. لا نزعم أننا بلورنا هذه المقاربة، لكننا نأمل أن نكون تقدمنا خطوة في هذا السبيل. ويقيننا أن مقاربة علمية للمشكلات الطائفية لا بد لها بداية من الانكباب على استنطاق النصوص الملتبسة حولها ومحاولة كشف ما تقوله دون أن تصرح به.
سمات فكر مرتعد
على أن عرض إشكالية الكاتب النظرية وتفنيد قضايا كتابه وكشف موارباته والبرهنة على عدم اتساقه هو نصف العمل الضروري للتعليق على كتابه وكشف دلالاته. المقاربة الأنجع في تقديرنا هي النظر بالفعل في تكوين سوريا الحالي وتاريخها الحديث، والعمل على كشف الاختلالات المحتملة في تكون البلد، والأوجه القلق التي تبثها تطورات هذا التكوين. يتعدى جهد كهذا طاقة هذا المقال. حسبنا القول إن المشكلة الطائفية التي يتمحور حولها كتاب “وردة أم قنبلة” تحتاج تناولا أكثر تجردا وانكبابا على السجل التاريخي الفعلي بتفاصيله، والأهم ترفعا على منطق الاتهام والتبرؤ. الطائفية ليست هوية الآخر بل هي شرطنا العمومي. وهو شرط يتعين أن نجعل منه موضوعا للتفكير والمعرفة، لا ذاتا شيطانية تتقمص “الآخرين”، بينما “نحن” منزهون عنها. هذا ملح علميا ووطنيا.
الطائفية شرط عام يستغرقنا جميعا. يكفي قليل من الصدق مع النفس لنتبين كم هو حاضر ومنتشر الشعور الطائفي . وهو بالتأكيد ليس مشكلة فرد أو فردين، أو أربعة مثقفين عرب وسوريين، أو حفنة من “يساريين سابقين”. إنها مشكلة جميع الأفراد، بمن فيهم الأستاذ الخطيب وكاتب هذه السطور، ومشكلة جميع الأفراد ليست مشكلة فردية بل هي مشكلة اجتماعية ووطنية، يتعين وصفها وتحليلها ومعالجتها بصفتها كذلك.
ملح أيضا مقاربة مشكلاتنا الوطنية بتوازن واتزان. من غير المنصف أن تكون حفنة من “اليساريين السابقين” هي البطل الشرير في قصة “إعادة تكوين سوريا”. ومن غير المعقول أن يكون هؤلاء أهم وأخطر ممن كانوا ولا يزالون يحتلون الموقع الأفضل للتحكم في سير عملية التشكل السوري، والذين لا يمكن أن نفهم أسرار “اللاحم الإلهي” المتربص ببلدنا دون أن نحلل تكوينهم وهياكل سلطتهم وبنية مصالحهم. هذا بينما النظام نفسه الذي يغفل الكاتب عنه لا يزال الأقدر على قطع الطريق على الاحتمالات التي يخشاها.
ما الذي يفعله هؤلاء اليساريون السابقون؟ أو كي نتكلم “مِن الآخِر”: هل النقاش في المسألة الطائفية نقاش طائفي هو ذاته؟ بمعنى ما نعم. فالطائفية مشكلة سياسية تتصل بهياكل السلطة والثروة والنفوذ في البلاد، وبالنفاذ التفاضلي إليها. نحن لا نحتل مواقع متناظرة من الهياكل هذه. هذا يعني أن بعض المواقع لا يناسبها أن يطرح الشأن الطائفي للنقاش فيما تفضل مواقع أخرى أن تطرحه. المشكلة في تفاوت المواقع، وما قد يترتب عليها من فرص للنفاذ إلى الهياكل تلك والتأثير عليها. وتخميني الشخصي أن ما يفعله “يساريون سابقون” هو مساءلة هذا الواقع والتحرش به. المساواة بين الطرفين، القائمين على تلك الهياكل والمهتمين بإثارة النقاش حولها، انحياز للأقوى بينهما، وهو انحياز غير لائق بالمثقف النقدي والوطني، خصوصا إن كان يعتقد أن بلاده على أبواب إعادة تكوين خطرة.
وما نلمسه في الكتاب هو تراجع العناصر الديمقراطية والثورية والعقلانية في وعي الكاتب لمصلحة المحافظة والتشاؤم والانكفاء. وهو يدل في الواقع على حجم الإفساد الذي تسببت فيه علاقات سلطة امتيازية وغير منصفة في الوعي العام، وعي منحدرين من أقليات مذهبية ودينية بخاصة، مع ما هو معروف تاريخيا من أن الأقليات رصيد متجدد للمطالب الديمقراطية والتغييرية. وما الجمع بين نزعة محافظة سياسية ونزعة تغييرية إيديولوجية غير الحصيلة الإجمالية لهذا الإفساد الخطير. ولا نرى سبيلا للتغلب على هذا الفساد دون مقاومته، دون التحول من مضغ المخاوف وتغذيتها واحتضانها إلى النظر إلى تكوين بلدنا ووعينا بصورة اقل مواربة واكثر شجاعة. فلنترك التلويح بإعادة رسم خريطة البلد للطائفيين!
من جهة أخرى يبدو لنا أن تشاؤم الكاتب وثيق الصلة بنزعته التأملية المنعزلة عن العمليات الاجتماعية، والمتولدة هي ذاتها من العزلة المضروبة حول النشاط العام، السياسي والثقافي، المستقل في البلاد. هذا يفسر انتشار الاكتئاب والمزاج القائم في أوساط واسعة من المثقفين السوريين، الأبعد عن المشاركة في الشأن العام على وجه الخصوص. كان من شأن حياة عامة أكثر انفتاحا وحيوية أن تحد من نزعات التشاؤم والسودواية ليحل محلها مزاج أكثر عملية ونشاطا. والقصد أن نبرز الصلة بين مصادرة الحياة السياسية والعامة للسوريين وأجواء العزلة المحيطة بهم وبين المنظورات القاتمة لكاتب “وردة أم قنبلة”، وإن انعكست الصلة هذه في كتابه على شكل انحرافات إيديولوجية ليساريين سابقين أو نزعات دينية متأصلة.
يبقى أنه على مستوى التجريد والعمومية الذي يتحدث منه الكاتب يتعذر إضاءة أو حسم أي من القضايا التي يطرحها. ينبغي النزول إلى واقع مترب، أكثر اختلاطا ودنيوية، من أجل التفكير في تكوين سوريا وآفاق إعادة تكوينها. لا مناص كذلك من مقاربة الواقع بطريقة مباشرة تسمي الأشياء بأسمائها. إذ كيف نعالج المشكلات الطائفية بينما نحن نمتنع حتى عن تسميتها تطَيّرا؟ هذا تفكير سحري لا يساعد في اجتراح حلول “عقلانية وعلمانية وديمقراطية ومدنية” لمستقبل سوريا. وليس بمثل هذا الفكر المرتعد، المذعور، المنغلق على ذاته والمكتفي بتشاؤمه، تتكون سوريا جديدة.
أخيرا، كتاب “وردة أم قنبلة؟” برهان على أن التجريد والعمومية من جهة، والنزعة الشعورية من جهة ثانية غير متعارضتين. فالعموميات أصلح لاستيعاب دفقات شعورية غير مسيطر عليها ولا شكل لها. فيما يحتاج وعي منظم إلى صيغ تفكيرية أشد انضباطا وأكثر اعتناء بالتفاصيل. وإذا كان نص الكاتب لا يمنح مفاتيحه للقارئ غير السوري فلأن مفاتيحه شعورية، لا “يلقفها وهي طايرة” إلا الشركاء في التكوين الشعوري ذاته. كما أن سمة اللااتساق التي رصدناها في نقاش الأستاذ الخطيب تزول تماما حين ننتقل من مستوى الوعي والمفاهيم إلى مستوى الشعور والانفعال. ثمة ذعر واحد وتشاؤم واحد متجانس يتخلل صفحات الكتاب جميعا.
ضعف الوعي الوطني
في الختام، الكتاب نتاج ومؤشر على ضعف الوعي الوطني السوري. لا يتماهى السوريون في الدولة. والتماهي الثقافي متراجع، وهو ينعقد على أية حال على العروبة لا على السورية. هل نتماهي في القضية الوطنية؟ كان يمكن لذلك أن ينجح لو لم تكن الوطنية هذه متعارضة بالتمام والكمال مع تحقيق المواطنة الحرة للسوريين. ضعف الوعي الوطني يتسبب في قوة أشكال الوعي غير الوطنية، سواء كانت فوق وطنية كالعروبة (والكردية والقومية السورية) والإسلامية أو دون وطنية كالطائفية والعشائرية وتشابكاتهما المتعددة، و”معادلات التحويل” بينها وبين الإيديولوجيات العصرية. هذا يحث على التركيز على الثقافة الوطنية والقيم الجمهورية من مساواة وحرية وأخوة، في مواجهة الطائفية والنزعات دون الوطنية، كما في مواجهة مخاطر الهيمنة الخارجية، وذلك بدلا من التقوقع على الذات واجترار المخاوف والتشاؤم. ولا ريب أن التطلع إلى مجتمع لا يتفاوت فيه الناس بسبب حيثياتهم القرابية والدينية والمذهبية والإثنية هو مثال جدير بالمثقفين الديمقراطيين ويستحق الكفاح من أجله. غير أن الانطلاق منه دون الاعتناء بشروطه الموضوعية لا ينجب علما ولا نضالا وطنيا بصيرا. إنه وصفة للاستبداد.
إعادة رسم الخرائط العقلية والسياسية أكثر عقلانية وإنسانية ووطنية من أية بدائل تحاصر السوريين بثنائيات شالة لا تخدم إلا دوام الوضع الراهن. وهي بالتأكيد أولى بالاشتغال عليها من “إعادة رسم الخرائط” الجغرافية.
الكتاب الثاني: المأساة السورية: مائة عام من العذاب
حمل الكتاب الثاني من الرابط التالي
المأساة السورية: مائة عام من العذاب
مقدمة الكاتب للكتاب الثاني
هذه الفصول الآتية: المأساة السورية: مائة عام من العذاب. كتبت تحت ضغط الأحداث المضطربة واللاهبة الراهنة في البلدان العربية وسورية خصوصاً عام 2011، على الرغم من أن التفكير فيها يجري بالنسبة لي منذ زمن بعيد. وربما لهذا كان بالإمكان أن أكتبها على شكل دراسة أكاديمية مثل الفصل الأول عن انتهاء دولة الخلافة العثمانية وسوء الفهم المتبادل بين العرب والأتراك، وما تبعه من محاولات بناء الدولة الحديثة في كل من تركيا والبلدان العربية وسورية تحديداً، حيث نجحت أتاتوركية تركيا، وأخفقت البلاد العربية التي انفصلت عن الدولة العثمانية والتجربة التركية في بناء دولتها المدنية الجديدة. لكنني آثرت الطريقة قريبة المتناول في هذه الظروف؛ طريقة المقال المبسط الموجه لعموم القراء، فقد بدت لي هي الطريقة المناسبة للوصول إلى عموم الناس والمشاركة في هذه الأيام السورية اللاهبة، بل وفي تحديد موقف من تاريخ المأساة السورية، كما أراها، عبر أو بعد عرض تاريخها.
موقفي واضح:
مع المواطنين السوريين ضد كل أشكال القهر والحرمان والاستبداد السياسي والاجتماعي والإنساني، ومهما كان لونها واسمها، وصفتها: دينية أم قومية أم عسكرية أم سياسية، التي يعيشونها منذ خمسين عاماً، أو تلك التي يحوم شبحها في الأفق.
بقيت نقطة:
عام 2006 أصدرت كتاباً بعنوان “وردة أم قنبلة: إعادة تكوين سورية” وخلاصة هذا الكتاب أن سورية مقبلة على إعادة تكوين، فإما أن تكون دولة مدنية ديمقراطية علمانية لجميع مواطنيها، وإما أن تكون قنبلة موقوتة.
آمل أن يعتبر هذا الكتاب تتمة للكتاب السابق، مع ملاحظة أن القنبلة انفجرت، أو بدأت في الانفجار على ما يبدو، وهو ما كنت أخافه، وربما هو ما يخافه أكثرنا على ما آمل، إلا أولئك الذين يريدون تحويل الوردة إلى قنبلة حقاً، غير مبالين بانفجارها الوشيك إذا ما استمروا على لامبالاتهم وطريقتهم في السلوك ومعالجة هذه المسألة ـ المأساة السورية المعقدة.
ما العمل إذن لنزع فتيل القنبلة؟
لا أعرف ـ بالضبط ـ ما العمل، مع العلم أن الحل نظرياً سهل ومعروف، وإن كان الأمر يبدو لي أحياناً مثل تراجيديا إغريقية: نرى الكارثة تحدث أمام أعيننا، وربما نسعى إليها، دون أن يستطيع أحد لها إيقافاً. وربما لهذا لم يبق لي إلا أن أردد مع ألبير كامو:
“وعرفت ما كنت أعرفه مرة أخرى”
لكن، ومرة أخرى:
إما أن تكون سورية دولة مدنية، ديمقراطية، علمانية، لجميع مواطنيها وحاملي هويتها “السورية” الشخصية، كأفراد أحرار، هم حقاً مكونات الشعوب والدول الحقيقية الحديثة وليس كقوميات وطوائف وأديان، دولة تلتزم في بنائها وقوانينها وسلوكها ودستورها الشرعة العامة لحقوق الإنسان، فتكون بذلك وردة المنطقة الحقيقية، وإما أن تكون قنبلة فتنفجر مثل أي قنبلة. وعندها ستسبح الوردة في دمها ودموعها، وقد تمسي حطاماً وحلماً، أو قد تذبل على أفضل تقدير.
كلنا مسؤول عما سيحدث، ويظل التاريخ أفق احتمالات، وطرقاً يحددها من يسير فيها، فلا عتب ولا مسؤولية على أحد أو على “مجاهيل” أو “مؤامرات” إذن.
لا عتب ولا مسؤولية إلا على السوريين أنفسهم.
محمد كامل الخطيب
دمشق ـ أيلول ـ 2011
صفحات سورية ليست مسؤولة عن هذا الملف، وليست الجهة التي قامت برفعه، اننا فقط نوفر معلومات لمتصفحي موقعنا حول أفضل الكتب الموجودة على الأنترنت
كتب عربية، روايات عربية، تنزيل كتب، تحميل كتب، تحميل كتب عربية،