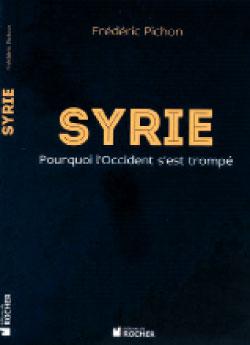كمال صليبي في ستّ مرايا/ نجم الدين خلف الله
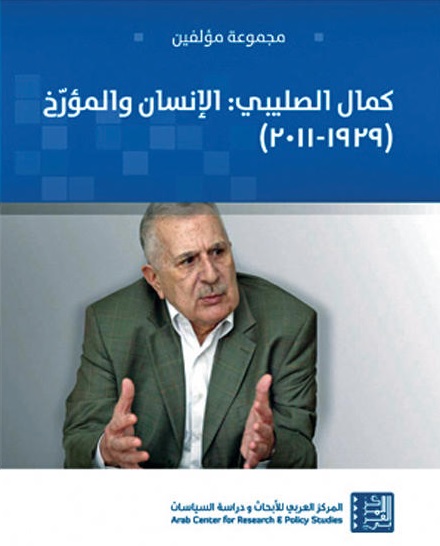
تشكِّل الكتابة التاريخية عقدة العُقد في قراءة التراث العربي – الإسلامي. فهي أداة المعرفة الموضوعية بهذا التراث، والمرحلة الضرورية لعقلنة الصلة به، فتجاوزه. وفي الآن ذاته، تشكل هذه الكتابة – إن أنجزت بشكل مغلوط وغير نقدي – عائقاً يحول دون تحقيق هذه المعرفة، إن هيمنت الأيديولوجيات الدينية والقومية على مضامين هذه الكتابة ومناهجها.
ومن المعلوم أنَّ تأويل التاريخ “الرسمي” هو من صلاحيات الدولة وحدها، صلاحية توارثتها عن رجال الدين الذين كانوا يؤسطرون التاريخ لتقديس الماضي أو لتبرير الحاضر والآتي. ولم تكسر هذا السياج المضاعف، الخاضع لسلطتَيْ السياسة والدين، إلا قلةٌ قليلةٌ جهدت لكتابة توخَّت فيها “الموضوعية” ما استطاعت، واعتمدت الشواهد والوثائق في برودها، سعياً لمساءلة الماضي وزحزحة اليقينيات.
ومن أشهر من اشتغل على هذا الحقل المعرفي الملغوم، المؤرخ اللبناني كمال صليبي (1921-2011). وقد خصّص له “المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات”، مؤخراً، كتاباً جديداً، بعنوان “كمال صليبي: الإنسان والمؤرخ”، اشترك في إعداده عدد من الأساتذة، من بين زملائه ومتابعيه، وهم: عبد الرحيم أبو حسن، وإلياس القطار، ووجيه كوثراني، وناديا الشيخ، ومايكل بروفنس وعبد الرحمن شمس الدين.
تناولت الدراسة الأولى سيرة الإنسان وجوانب من شخصيته وفضائله (العلم والتواضع)، وخُصّصت الثانية لبيان أسلوبه في التأريخ لِلُبنان الحديث. وتعرّض المقال التالي إلى علاقة صليبي بمؤرخي الشرق. وأما البحث الموالي فركز على ريادته في النظر الوضعي لتاريخ لبنان الوسيط، في حين تناول المقال الخامس تأريخه لعصور الإسلام الوسطى، واستعاد المبحث الأخير نظريّتَه المثيرة عن جغرافية التوراة وأسماء المواطن المذكورة فيها.
وهكذا، لا يهدف هذا الكتاب بفصوله الستة إلى التعريف بكمال صليبي، وبأعماله الغزيرة، وإنما هو إضاءة نقدية لجوانب من مسيرته العلمية والإنسانية. ولعل الخصال الإنسانية التي اكتشفها القارئ هي الأكثر إفادة وتشويقاً، لأنها تضعه أمام بعدٍ وثيق الصلة بمنهجية التأريخ وفلسفته، بما هي صبرٌ على مقارعة الوثائق بعضها ببعضٍ، واستنطاق للشواهد بتؤدة وتثبتٍ، وتوسيعٌ لدائرة المدوّنات بغرض المقارنة بينها. وتظل الفضيلة الأبرز للمؤرخ اللبناني – بإجماع هذه الدراسات – هي التحرّر من سلطة الأيديولوجيات لاستعادة الماضي ومعرفته بموضوعية.
وحتى ندرك أهمية هذه الفضيلة، علينا أن نستذكر أنَّ الحقول التاريخية التي اشتغل عليها صليبي ظلّت وثيقة الصلة إما بالرؤى اليهودية التي بنت شرعيتها الاستيطانية على تضخيم سرديات التوراة وتحويرها، فاستغلالها لتبرير الممارسات الراهنة، وإما بالسلطة الكنسية التي أوَّلت تاريخ الشام حسب مقولاتها، مع وضع السيد المسيح في صميمها.
وقد استوعبت مدارس الاستشراق الغربي رؤى هاتيْن السلطتين لتقصر “الحقيقة” على ما يقوله هو عن الماضي، مخطِّئاً كل نظرية أخرى. ويبدو من شهادة كمال صليبي ذاته أنَّ من بين المستشرقين الألمان مَن دعاه، بفظاظة، إلى التخلّي عن أطروحاته حول تاريخ اليهودية والبحث في أماكنها التوارتية، لا لشيءٍ إلا لأنه مسيحي، ولا يحق له الخوض في قضايا كهذه.
ومن جهة ثانية، وفي ظل تصارع الطوائف الدينية المشرقية وتنافس أنظمتها المرجعية والرمزية، تمت العودة إلى تاريخ الشرق الوسيط من أجل تضخيمه وجعله عماد كل طائفة، على حساب النظر الوضعي، وأريد لذلك التأريخ أن ينجح حيث فشلت الإرادة السياسية في تحقيق تفوّق الطائفة. ولذلك سعى صليبي إلى نقد هذا التأريخ المرتبط بالإرادات السياسية والطائفية وتحريره من سلطة الأحزاب ومشاريعها.
ويقوم منهجه – كما أوضحه هذا الكتاب الجماعي – على تأكيد أهمية إتقان معجم العربية القديمة، وأصولها السامية، لتفسير أحداث التاريخ، إلى جانب الجغرافيا الأنثروبولوجية. فقد اعتبر صليبي أنَّ من بين المبادئ القادرة على تجاوز تناقضات الكتابات الرسمية هو تحقيق أسماء الأماكن وتحرّي أصولها، وتعقب التحويرات التي طرأت عليها حين تنتقل من مجال ثقافي – ألسني إلى آخر.
ومن أمثلته المشهورة كلمة “مصر”، التي كانت، حسب التوراة، مسرحاً لعديد الأحداث المقدسة، ولكنها لا تحيل، في رأيه، إلى “مصر” المعروفة حالياً، بل إلى منطقة واقعة غربيَّ الجزيرة العربية، من حدود اليمن صعوداً إلى الحجاز. علماً أن معنى “مِصر”، حسب لسان العرب القديم، هو: الحاجز والقلعة والمنطقة الآهلة، ومنه اشتقَّ فعل مصَّرَ الأمصار أي جعلها حَضريَّة. واستند في هذه الفرضية إلى القصص التي تذكر رحلات إلى “مصرايم”، وتشير إلى مُددٍ ومسافاتٍ وعدد أيام مسير تنطبق جغرافياً على مناطق “مصر” الجزيرة العربية، لا على أرض الأهرامات.
هذا الكتاب أبعد من معارف تاريخية منثورة. فهو يقطع مع ما تعوَّد عليه الجمهور العربي في الاحتفاء بالشخصيات الثقافية، بعد رحيلها. إذ غالباً ما يكون هذا الاحتفاء في شكل مهرجانات خطابية، يغلب عليها التمجيد وتطغى فيها الشهادات الشخصية الوجدانية. فمع صدور مثل هذه الأبحاث الرصينة، تُسجل ظاهرة مهمة تتمثل في الاحتفاء بالمفكرين عبر تعريف إسهامهم الفكري بأسلوبٍ أكاديمي، سهل التناول، أنيق العبارة.
وليس إنجاز مثل هذه الدراسات، وحتى تنظيم الندوات، من قبيل الترف الفكري، بل هو من صميم الفعل الثقافي الذي يعين على إشاعة المعارف التاريخية وتبسيطها، وفتح آفاق القارئ على قضايا وتساؤلات ظلّت لعقود طويلة من اختصاص المستشرقين وحدهم، يصوغون عنها ما يحلو لهم من النظريات، وقد يفرضونها مسلماتٍ ويستغلونها لوضع العالم بأسره أمام واقع سياسي (بغيض). وأياً ما كانت وجاهة فرضيات صليبي وصحتها، فإنها توجِّه القارئ إلى الماضي بوصفه مشكلةً، لا بوصفه يقيناً، وذلك أولى مراحل نقد الأفكار الراكدة.
العربي الجديد