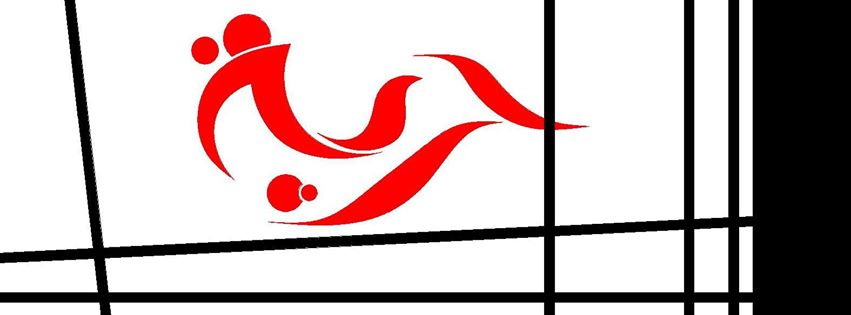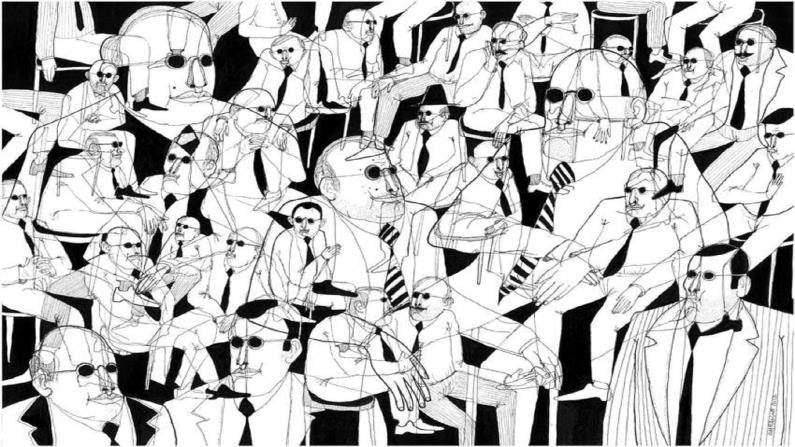كيف اغتربنا؟
سليمان تقي الدين
ليس في تجربتي ما أخجل منه، لكن هناك الكثير الذي ندمت عليه. فإذا كان المرء صادقاً في خياراته ومعطاء في نشاطه إلى حد بذل الغالي والرخيص وسنوات العمر الثمينة، فيجد نفسه معاقباً على ما قام به، فليس هناك من مرارة توازي هذه المرارة. هذه الخيبة مزدوجة لأنها تتصل أولاً بطبيعة التغيير الذي شاركنا فيه، وثانياً بتحولنا إلى ضحايا من ضحاياه. والعبرة هنا أننا لم ننجح في تغيير مفهوم الممارسة السياسية إلى الأفضل، بل إلى الأسوأ، وقد ساهمنا في إنتاج سلطة، ورموز لها، هي الأسوأ بكل المقاييس والمعايير. لقد كانت أفكارنا سُلَّماً للانتهازية الشخصية الذي تسلقه الآخرون، وبصورة أو أخرى أفسدنا الحياة اللبنانية، حين دفعنا إلى واجهة الحياة السياسية، نماذج من الوجوه التي تلاعبت بمصالح الناس، وأخذتها مجدداً إلى أشكال من التبعية والخضوع.
انتزعتنا هزيمة 5 حزيران 1967 من دائرة السياسة اللبنانية التقليدية ورتابتها، وألقت بنا في خضم الجدل الصاخب عن أسباب الهزيمة وكيفية الخروج منها. كانت هزيمة 5 حزيران زلزالاً في الوجدان والتفكير خضت الشوارع العربية. تهاوت أفكار ومفاهيم ورموز وطروحات وانبعثت أخرى تتجه إلى نقض الماضي والبحث عن أجوبة. وكان لبنان منتدى العالم العربي ومرآته ورئة الحرية الجاذب لكل الثقافات والأفكار. اندلعت حركة فكرية سياسية غير مسبوقة في المدينة الكوسموبوليتية وفي معظمها حلَّقت فوق المسرح اللبناني ويممت شطر العالم العربي كله بغليانه وتناقضاته. وفي نهاية 1968 حصل العدوان الإسرائيلي على مطار بيروت ليطرح مهمات لبنانية أكبر من المساهمات الثقافية والتضامنية. خسر لبنان الحرب في ضربة واحدة ذات دلالة رمزية على الفشل والعجز. وفي 23 و24 نيسان كان صدام المتظاهرين طلباً لسياسة دفاع وطني ودعم العمل الفدائي الفلسطيني لحظة القطيعة بين الجمهور والنظام القائم.
كانت صورة لبنان القديم شاحبة جداً بنظامه ورموزه وأحزابه وقياداته السياسية. تلقف الشباب اللبناني الوافد إلى المدينة المفتوحة موجات من الأفكار كان يضج بها العالم، واستوحى المثال من حركات تحرر وطني كانت تحقق انجازات باهرة. أطلق الشباب اللبناني «سلطة الخيال» وأخذ ينتسب إلى مشروع التغيير الذي طرق أبواب المؤسسات السياسية التقليدية بما في ذلك الكنيسة اللبنانية. ومن معركة الكرامة ربيع 1968 بين الفدائيين و«إسرائيل» في الأردن بدأت تتجسد فكرة المقاومة الشعبية حتى حمّلناها مهمة البديل عن حرب الجيوش والدول. انخرط عدد كبير من الشباب اللبناني والعربي في المنظمات الفلسطينية وصارت قضية فلسطين «قضية العرب المركزية» المدخل لتغيير الأوضاع العربية، حتى أننا أطلقنا عليها صفة «الرافعة التاريخية».
لكنَّ النهضة الفكرية والسياسية التي اجتاحت العالم العربي بحثاً في أسباب الهزيمة بدأت محاصرتها في الردة اليمينية داخل النظام «القومي العربي». فسرت موجة من العداء لليسار والدور السوفياتي وحصلت انقلابات عزّزت الاتجاه اليميني في الأنظمة الوطنية وشكلت حرب تشرين 1973 حركة التفاف على النهوض الوطني انتهت إلى إخراج مصر من دائرة الصراع ووضعت الجبهة الشرقية مكشوفة يتنازعها البعثان العراقي والسوري ويتلاعبان مع دول عربية أخرى بمصير القضية الفلسطينية ومحاولات احتوائها.
بعد أيلول الأسود في الأردن 1970 راح اليسار اللبناني يبحث عن شرعية شعبية في الحركة المطلبية والاجتماعية ويبالغ في قراءة أوضاع الطبقات وصراعاتها وفاعلية انخراطها في المعركة الوطنية ضد العدو «الامبريالي والصهيوني والرجعي». وقبل ان يتجذر في هذه البيئة كانت البلاد تتجه إلى انقسام وطني عميق حول موجبات لبنان والتزاماته الوطنية والقومية، وتتصاعد المطالب الطائفية ومعركة أجنحة السلطة، ويحصل فرز سياسي طائفي كان أقوى من الفرز السياسي الاجتماعي فتجاوزه واحتواه.
لم يكن اليسار التقليدي منتجاً لوعي حقيقي بالمسألة الطائفية، فرأى فيها أيديولوجية لنظام متخلف وظيفتها تحوير الصراع الاجتماعي والسياسي وتعطيله. ورأى ان الصراع السياسي الوطني والاجتماعي ونشر الوعي السياسي: كلاهما كفيل بمواجهتها ومحاصرتها. إلا ان اليسار الجديد ساهم بفهم أفضل لهذه الظاهرة التاريخية الاجتماعية الشاملة التي حولت الجماعات الطائفية إلى مؤسسات سياسية، وقنوات لتوزيع الدخل الأهلي تغتذي من نظام التمييز في الحقوق وتتقوى من خلال رأسمالية مالية تتعايش وتتآلف مع أشد العلاقات الاجتماعية تخلفاً.
كما وجد اليسار الجديد صلة عضوية بين النظام الطائفي والكيانية اللبنانية كحلقة من حلقات منظومة إقليمية تخدم مصالح الغرب والرأسمالية العالمية وتوفر البيئة السياسية الملائمة لهما. وفي هذا السياق بدأت شخصياً في وقت مبكر دراسة المسألة الطائفية وقدمت فيها مساهمات لا زالت تحتفظ بجديتها وجدّتها.
لكن الفكر النظري يبقى نظرياً ما لم يتحول إلى فعل سياسي وقوة مادية من خلال حركة سياسية قادرة على إدارة الصراع والتأثير فيه. فلم يتأخر اليسار عن التماهي مع الجسم السياسي العروبي التقليدي وينخرط في مواجهات أهلية أفقدته إمكانية بناء «الكتلة الوطنية التاريخية» التي تشكل المشروع البديل عن النظام القائم. انزلق اليسار تحت ذريعة الدفاع عن المقاومة الفلسطينية إلى التموضع في بيئة شعبية ذات هوية محددة سلفاً فلا هو تمكن من قيادتها ولا هو استطاع ان يخاطب البيئة الشعبية المختلفة.
بدأت أدرك هذه الحقيقة مع مطلع حرب السنتين (1975 ـ 1976) لكن من ينخرط في العمل السياسي يخضع لعملية تكيّف أو لالتزام يصعب التحرر من أحكامه. فبعد ان سقط بيننا رفاق شهداء صار الانسحاب من متابعة المواجهة عملاً من أعمال الجبانة أو الخيانة. هذا الشعور تملكني مراراً وتكراراً حين كنت أرى ان الطريق ليس كما اشتهي وأريد. بل إن الانتساب إلى جماعة أو حزب هو فعل تسليم بحصيلة خيارات الجماعة وقبول بالتنازل الطوعي الواعي عن جزء كبير من الذات بما في ذلك بعض القناعات. ويكون الأمر سهلاً في الحياة السياسية السلمية الديموقراطية المنفتحة العلنية المكشوفة الخاضعة لاستفتاء الناس وآرائها، ويكون الأمر صعباً في المؤسسات التي تنشأ في ظروف الصراع المسلح والحرب الأهلية.
لم يكن حالنا في المسألة القومية أفضل من حالنا في المسألة اللبنانية. جنحت منظمة التحرير الفلسطينية إلى مشروع تسوية كانت تفترضها ممكنة بعد حرب تشرين 1973 ويعززها الواقع العربي والدولي. ذهبت منظمة التحرير إلى قيادة معركة التسوية وانخرطت في الصراعات العربية العربية وفقدت الكثير من مقوماتها بدلاً من ان تعزز مشروعها للتحرير. وصارت تتصرف بالساحة اللبنانية على أنها رهينة وورقة من أوراق التفاوض لا بيئة حاضنة للثورة. ولطالما ساهمنا في هذه الخطة رغم النقاش الذي أطلقناه ضد ما كنا نرى فيه مشروعاً جديداً لتصفية القضية خاصة من خلال مشروع المملكة المتحدة الأردنية. وفي الواقع، كنا نقاتل طواحين هواء حين لم نكن نسعى بجدية إلى إيجاد برنامج وطني حقيقي ونساهم في خلق برنامج عربي للتحرير. وحين اجتاحت إسرائيل لبنان العام 1982 كنا قد أدركنا ان القضية الفلسطينية لم تعد قضية العرب المركزية وان مواجهة إسرائيل ليست في جدول أعمال أحد وان لبنان ترك لوحده يواجه نتائج هذا الانحدار العربي.
أطلقنا «المقاومة الوطنية» لكن هذه المرة لم نكن نشعر بأن الأفق مفتوح على الأمل. فما شاهدناه من تناقضات لبنانية فلسطينية وسورية لبنانية فلسطينية كان فجيعة كبرى على المستويين السياسي والإنساني. وبالفعل دخلنا في مرحلة الحروب العربية العربية، ولم نكن نثق في الموقع الذي نحن فيه. ثم كانت الحرب الأهلية اللبنانية هذه المرة عارية من أي التباس، فلم نكن آنذاك إلا أسرى صراعات إقليمية ودولية، وكان على الواحد منا ان «يحمل في داخله ضدّه» وان يكون مشاركاً من غير ان يختار نوع السلاح ونوع المواجهة. كان من السهل على أي إنسان ان يختار خياراً فردياً للانسحاب أو الانكفاء، لكن هذا الاختيار ليس علامة إيجابية حين يكون قادراً على تحسين أداء وخدمة أناس والتأثير في بعض القرارات والتوجهات. كانت هزيمة الحركة الوطنية عام 1976 المفصل الأساسي في كل التداعيات اللاحقة. لكننا لم نستدرك هذه الهزيمة بمراجعة سياسية شاملة. أما الثمانينيات فكان علينا ان نعيد قراءة المتغيّرات من حولنا وقد ساهمت في ذلك. لكن موجة الإحباط والتراجع لم تسمح بتحول هذه المراجعة إلى مشروع. أغرقتنا الأحداث المتتالية في دوامة الصراعات اليومية وعطّلت إمكانية المراجعة. لم نساهم في قراءة الأوضاع العربية الجديدة. لم نمارس نقداً لتجربة الثورة الفلسطينية، وكيف انتهت إلى معطيات جديدة. خلال ثلاثة عقود لم تنشأ حركة فكرية سياسية تتعامل بصورة واضحة مع السيطرة السورية على لبنان ونتائجها. وحين تغيّر العالم مع سقوط جدار برلين ثم انهيار الاتحاد السوفياتي لم نفهم الجديد في العالم. قبلنا ضمناً نهاية فكرة اليسار بل فكرة التغيير.
تعريب المسألة اللبنانية وتدويلها كانا قيداً خطيراً على فاعلية القوى المحلية. نشأت تشوهات كبرى في جميع المؤسسات السياسية فرضت معايير ومقاييس وأساليب للعمل مناقضة لأي مشروع مستقل. وجاءت التسعينيات بعد الطائف لتضع البلاد تحت وصاية سورية سعودية مزجت مفاسد المصالح النفطية إلى مفاسد الاستبداد السياسي. أعيد بناء النظام اللبناني وقد استقطب نخباً واسعة إلى مؤسساته وقواه وتم تعطيل الحريات بسلاحي القمع والمال وبتفعيل المؤسسات الطائفية وتطويعها.
والحق يقال كانت هذه المرحلة أقسى مراحل التهميش لكل فكر أو عمل من أجل التغيير. ولا أبرر نفسي إذا ما قلت انني بقيت خارج هذه القوى والتيارات والأجواء وما زلت أتعرض مثل كثيرين غيري إلى سياسة النبذ والمطاردة والتضييق حتى في سبل العيش. وها نحن الآن، من بقي منا شاهداً على زمن التشوهات: ضحايا الماضي والحاضر، تطارد قوى النظام ذاكرتنا وتحاصر وجودنا، فلا نملك ان ننتسب إلى الماضي ولا نملك ان نعيش في المستقبل. ولعلنا نؤشر للقضايا التي تتحول إلى مشاريع استثمار فتسرق أو تصادر أو تحوّر على يد بشر لم تتوافر لنا مصادر القوة على إخضاعهم للمساءلة والمحاسبة، وربما لم نكن نحن أيضاً كذلك، كل في حدود سلطته واستخدامه لهذه السلطة التي تنبعث من كل نشاط اجتماعي. جئنا في زمن التضخّم الأيديولوجي والأحلام الكبيرة وتعثّرنا أمام شؤون الحياة العادية التي كان يجب ان تجعل أقدامنا على الأرض. تساهلنا كثيراً في مسألة الوسائل تجاه مسألة الأهداف، كما تسامحنا مع الأشخاص لحساب القضايا. لكننا لم نخسر المعركة الكبرى فقط، بل خسرنا «التأسيس» لخميرة أي عمل مستقبلي.
يشفع لنا اليوم ان العالم تغيّر من حولنا ولم نعد نستطيع التعامل معه بفكر الماضي ووسائله وأهدافه. وإذا كان لأحد من جيلنا أن يرضى عن نفسه قليلاً، فهو إذا كان يمشي مع الزمن، ولا يحمل على كتفيه جثته وماضيه، ويتندر بتاريخه، بل يعرف كيف يطرح أسئلة هي في أساس القلق المعرفي والوجودي. وإذا كان لي ما أملك من ذخيرة بعد، فهو أنني قلق غير مطمئن لمجريات هذا الزمن وان بي شهوة لتغيير «العالم».
السفير