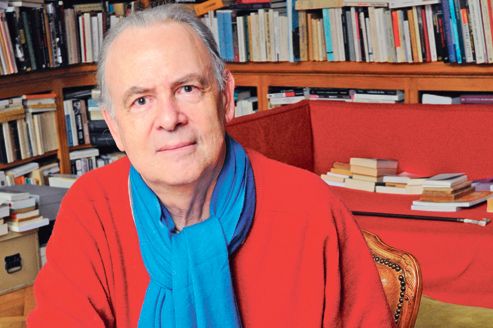مجنون نخلة!/ سلام عبود

طوال ربع قرن من مكوثي في أسوج، لم أوفـّق في الحصول على نخلة طبيعيّة. أطول النخيل عمراً لم تمكث عندي حيّة سوى عامين متتاليين. لم أيأس. موت نخيلي صار دافعًا إضافيّا لمعاندة الخيبة، ولمقاومة ضغط الكمّاشة القاتلة، التي أرّقت صقر قريش: الإقصاء والمنتأى. لكنّ عسر الولادة الطبيعيّة أرغمني على اللجوء الى ما هو غير طبيعيّ، الى التبنـّي. شرعتُ في كلّ مكان أذهب اليه أبحث عن أولاد النخل، فسائلها، وأحملها معي بحنوّ الأب، وخوف الأمّ، وحيطة المهرّب.
من مصر وتونس والمغرب حملتُ الفسائل العربيّة الأصيلة، لكنـّها لم تنبت، سواء في حديقة البيت أو في داخله. كانت تورق مثل طفلة، ثمّ تضمر مثل وليد عليل، وتذوي رويداً رويداً، ثمّ تموت. واحزناه! في كلّ مشاتل النباتات ومتاجرها في أسوج بحثتُ، وتفحصّتُ، واشتريتُ، وجرّبتُ حظـّي في استنبات نخلة. عبث في عبث. عبث محض. كما لو أنّ نخلة الله العصيّة لا تريد مقاسمتي مزن التغرّب والنوى. صديق لي أنبت نخلة في أسوج ورعاها، فتجاوز رأسها سقف البيت. حسدتُه من كلّ قلبي، وقرّرت نكايةً فيه، وفي نفسي، أن أشتري نخلة اصطناعيّة، من مادة البلاستيك والألياف الطبيعيّة. غرستُها في غرفة الإستقبال منذ سنوات، ووضعت نوراً متحرّكاً يشرق على رأسها ووجهها الاصطناعيّ الجامد، يتوّجها مثل هالات القديسين الموتى. أردتُ أن أخدع عقلي ومشاعري، وأن أناكد الفشل، وأخفي أنّي أضحيتُ ناكياً في نفسي أيضاً، موغل فيها. ولم أتردد، بضمير مبطـّن، في أن أجيب جلّ زوّاري إجابات مبهمة لتضليلهم، ومنعهم من إدراك حقيقة نخلتي وبريقها الخلّـب.
نخلتي الاصطناعية، توأم الغربة، غدت سرّي الكاذب في مقاومة الهلاك.
دهمني جنون النخل. تحوّل ولعي بالنخلة الى ما يشبه الغرام، ثمّ الهيام، ثمّ الخبل. رحت أبحث عن النخلة في كلّ مكان. قرّرتُ تقصّي آثارها على طول الشريط الساحليّ، الممتدّ من تركيا حتّى حدود البحر الأخضر. بحثتُ عنها في السواحل الشماليّة للبحر الأبيض المتوسط كافة، من قبرص، مروراً بصقلية وشواطئ مالطا الصخريّة، ووديان أشبيليّة وقرطبة وغرناطة، مارّاً عبر الساحل كلـّه، من ملقة الى تورامولينوس، وابن المدينة، وفونخيرولا، وماربيا، حتّى جبل طارق ومدخل بحر الظلمات. نخلة عبد الرحمن! خيمة الله، ومظلة الشجن المهيب، تتراءى لي في الوديان والهضاب والقلاع والحصون والمتنزهات، تبدو لي مرةً منصّةً للنحر، ومرةً أخرى متكأً لولادة الفجر. لم أر نخلة حزينة من دون أن أتوقف قربها مواسياً، ولم أر نخلة مترفة ونضيرة لم أقف تحتها مبتهجاً لبهجتها. هوس النخيل، أو جنونه، جعلني أوثـّق مرئياتي النخليّة كلـّها، لكي لا تضيع ملامحها مني، أو تشحب صورها في ذاكرتي، حتّى استوت عندي غابة عظيمة من النخيل، تمتد على طول الساحل الأوروبي للبحر الأبيض المتوسط وجزره. أردت احتكار حقوق تخليد النبتة الغريبة، نخلة الله الضائعة خلف البحار البعيدة، سيدة الفراق والعناق الجليلة. غابات من النخل تملأ ملفات الحاسوب، وتملأ جهاز عرض الصور، لكأنني مالك أقدار النخيل، وأميرها الافتراضيّ الأوحد.
مدوّناتي عن أصل النخلة وفصلها ملأت مئات الصفحات. تقصّيتُ تاريخها، منذ ولادتها، وحتّى قبل ولادتها في عصور ما قبل ولادة التاريخ. عرفتُ أمّها وأباها، وربّها وملائكتها وشياطينها. حتـّى أني ذهبتُ باحثاً عنها في الجنـّتين: الجنـّة الأولى، التي افتتحت فطريّة الكون، والجنـّة الأخيرة، التي تنهي لعنة الكون.
شيئاً فشيئاً، صار لديَّ عالمان نخليّان، عالم الخيال والوهم والذاكرة والكلمات، محبوساً في الصور الثابتة والمتحرّكة وفي الورق، وعالم الواقع مجسّداً في نخلتي البلاستيكيّة العجماء.
لم تتغيّر علاقتي بعالم النخيل إلا بعدما ولدت إيزابيلا. ابنة ابنتي الصغرى جمانة. لم تلد عند جذع نخلة، لكنها عند المخاض، حينما نقلت من البيت الى مستشفى الولادة، رافقتها في السماء طائرة إنقاذ مروحية، تابعة للطوارئ! جاءت الوليدة ناقصة. حضرت سبعة أسابيع قبل موعدها الطبيعيّ. كانت قطعة صغيرة من اللحم، مثل سنجاب وليد، بالكاد كنـّا نرى عينيها. وضعوها تحت المراقبة الخاصّة لأسبوعين، ثمّ أفرجوا عنها في اليوم الخامس عشر، بعد أن تأكـّدوا تماماً أنـّها صالحة للحياة. ربّما لهذا السبب – قوة الحياة – منحوها الاسم الأكثر إثارة للشجن والكدر والمرارة القوميّة في نفسي: إيزابيلا، الشريرة!
ظهور حفيدتي ايزابيلا المتعجل، أضحى وسيلة لتدمير العلاقة الفريدة، التي أقمتها مع نخيلي المتخيل، ومع نخلتي الخرساء.
من دون سبب معلل أضحت نخلتي طريدة أثيرة، وهدفا لغزوات إيزابيلا. وحتـّى قبل أن تتقن الحبو، تعلـّمت فنّ الوقوف، من طريق ليّ أطراف نخلتي، والتشبّث بها. ومنذئذ لم يعد يستهويها شيء في الدنيا أكثر من نتف سعفات نخلتي واحدة واحدة، بلذة ما بعدها لذة. كانت تعرف، بفراسة شرّيرة، تفوقت فيها على البالغين، أنّها في مواجهة خصم مغشوش، واهٍ، ومستعبد. كانت تدرك وهي تنتف السعفات أنّ غضبي مزوّر أيضاً. هي واثقة تماماً من أنّها النبتة الحيّة، النبتة النابضة، ابنة الله الشرعيّة، وليست ابنة المصانع. قِطعُ الألياف والبلاستيك المبعثرة، لا تعدو أن تكون، في نظرها، سوى قمامة من مخلّفات الصناعات البتروكيميائية. ترسل لي ضحكتها، وهي تصرخ بساديتها الملائكيّة، بمزيج من العربيّة والسويديّة: “ددو… دار!” (جدو! أنظر هناك!)، ثمّ تُريني أصابع النخلة المجتثـّة، وأظفارها الشوكيّة المقتلعة (سُلاّءها)، وشعرها الليفيّ المنتوف. أفكر في سرّي: لا الطبيعة رفقت بي فمنحتني نخلة حيّة، ولا إيزابيلا ارتضت بنخلتي الكاذبة.
بيد أنّ النخلة وإيزابيلا- أعظم المتخاصمين في حياتي- لبثتا تتنازعان في روحي بمثابرة وإصرار عدوانيّ. نخلتي الكاذبة تصارع بصمت وجلد، بسكون الموتى السرمديّ، من أجل تثبيت انتصاري على الهزيمة، ولو بنجاح مصطنع، وهميّ، عابر وخادع. وفي المقابل تقف إيزابيلا، التي تشتعل حياة، مثل مرجل ماء فائر. حينما أمسك جسمها النحيف، بين كفيّ، وهي تتلوى، مثل كتلة مطاط حيّة، أحسب أنّها ليست جسداً، بل قدر بخار مضغوط، تتدافع فورة غليانه من كلّ خليّة في جسدها. إيزابيلا، الغريمة الوجوديّة لنخلتي، تستلّ السعفات الطوال، التي تظلل غفوتي “الميسانيّة” العميقة، كما تستلّ روحي من بدني.
صراع علني بين الموت والحياة، يقول لي: من لا يملك المقدرة على الموت، لا يملك المقدرة على الحياة!
هذه الحكمة المتأخرة، لم أتعلـّمها من موت البشر، المفجع. فعلى الرغم من كثرة ما رأيت من أموات، تعلـّمت درس الموت والحياة من الكائن الذي ما صرخ عند الموت والولادة قط، تعلّـمته من النبتة الصمّاء. في حديقة بيتي صرت أعاشر المزروعات كلـها، وأواطنها على أنّها مثلي، تملك روحاً كروحي، حتّى خيّل اليَّ أنها تعرفني، كما أعرفها. بتّ أراني جزءاً من نشيد التناسخ، تناسخ الأقدار والأعمار. هي حيّة، إذاً هي روح! كم يحزنني انطفاءة روح وردة، أو ذبول شجيرة! لكنّني تعلـّمت، أو أرغمتني الفصول على تقبل موت الورود الجميلة، على أنّه جزء من ناموس حياتها. اكتشافات الشيخوخة هذه دفعتني منذ سنوات الى حبّ الخزامى. بدأتُ باستقدام أبصالها من غير مكان، من موطنها الأمّ تركيا، ومن المغرب، وألمانيا وهولندا، لأنّها تختلف عن كثير من الورود – الورود المنفردة، وليس الشجيرات- بأنّها تختفي ثمّ تعود في الموسم الجديد. تطلّ برأسها في الزمان عينه، والمكان عينه، مبتسمة، مبشّرة بحياة جديدة، وبألوان باهرة، تعيد الى الحديقة المتيبّسة، بفعل جليد الشتاء، طغيانها العاطفيّ، فتشعرني بأنّي مقبل على زمن آخر، زمن جديد جداً، في حياة قديمة جداً.
على الرغم من هوس الخزامى، إلاّ أنّ الورود من الفصيلة الزنبقيّة ظلـّت مجرد شيء جميل، بارد الأحاسيس، لا يملك مشاعر النخل المتأججة. النخلة لها عواطف مغايرة، حتّى لو كانت من البلاستيك. فهي ليست محض نبتة، وليست كائنا زرعيّاً خالصاً. إنّها أمّ وعمّة، ورمز أبديّ للحنين. أليست هي الظلّ، الذي حماني يوماً ما من لفح الشمس! من أكل جمّارها غيري! ومن شرب ماء بارداً مسكوباً من كافورها المضمّخ برائحة الأعماق السحيقة غيري! أليست هي المتكأ أيضاً، تضع عليه ظهرك وتغفو في سماء الحلم الغريب، الذي اسمه الحياة. على هذا المتكأ وضعت العذراء ظهرها، حينما جاءها المخاض. شدّت جسدها بجسد النخلة فسطعت أنوار “ذو النخلة”؛ ثمّ هزّت إليها بجذع النخلة، فأمطر عليها رطب الله الجنيّ، واخضرّت روح الله في الأرض.
إذا كانت ورود الخزامى تزّين لي معتكفي البعيد بانفجاراتها اللونيّة، فإنّ نخلتي الغريبة، أليفتي الوجوديّة، وكاتمة أسراري المعلنة، تحاورني بصمت مطلق، وتقاسمني أوجاع النأي عن سماوات عصيّة، وعن أزمان لا عودة لها. أتذكر رجل إديث سودرغران، الذي بحث عن زهرة، فوجد ما يُخذِل. لقد بحثتُ عن نخلة فوجدت وهماً من البلاستيك والألياف الجافة. ورغم رضاي، وتواضع آمالي، وعظم كنز قناعتي بهذه العطيّة الاصطناعيّة، إلاّ أنّ القدر الذي منحني نخلتي الكاذبة، منحني في الوقت نفسه، روحاً إضافيّاً، اسمه إيزابيلا. قدر مركـّب ومرتـّب من قبل قوى عابثة. قدر بدأت أرى فيه روحي المسروق منّي، كلـّما كبرت إيزابيلا، يوما بعد يوم، وكلـّما تناقصت فرصتي للبقاء معها في عالم واحد. أصبحتُ أقيس فنائي بمسطرة بقائها. مسطرة وجودها السحريّة تمدّني بعمر، وزمن، وشغف، وحياة إضافيّة، تعوّضني، من حيث لا أدري، عن كلّ دقيقة أفقدها في رحلة العمر، المتسارعة النهاية. أضحت تدسّ حياتها الفوّارة في تلافيف حياتي الآيلة الى الزوال، وتحشر روحها الثائر في بدني المندثر. لكأنها زمن استدراكيّ مستلف، يرمّم ما تساقط من أوراق شجرة العمر المتداعية. بدلا ًمن نخلة حقيقيّة حيّة منحني القدر الماكر لعبة صناعيّة تتلذذ بها حفيدتي، وتعذبني بفرحها الغامر وهي تقاتلها بإصرار وغيرة وحسد.
لكنّ النخلة لم تزل صامدة في صمتها وصبرها اللامتناهي. أرمّمها كلـّما عادت إيزابيلا الى بيت والديها. ليس لي إلاّ أن أحسد نفسي، فأنا أساكن نخلة، نخلة ما، حتّى لو كانت نخلة خائنة وجوديّا! نخلة تحاورني بصمتها الأبديّ، تشكو لي غدر حفيدتي، تذكـّرني بالحفيدة لو فرّ طيفها من خياليّ سهواً. عدوانيّة الحضور الأثيث، في كيان إيزابيلا، الذي ربما يهدف، في المقام الأوّل، الى إقناعي باستحالة إبدال الموت بالحياة، قاد الى ما يناقضه تماماً: استحالة إبدال الحياة بالموت. فكلـّما نتفت إيزابيلا سعفة أو خصلة من الليف، أجدني مرغماً على إعادة ترميمها، حتّى بات تبادل الموت والحياة طقساً واجباً، كما لو أنّه شعيرة مقدّسة، أو نظرة وعيد من إله غاضب الى عابد رعديد. أضحى لزاماً عليَّ أن أعيد إكساء النخلة أعضاءها المقتلعة، أعيد إحياءها، وأجعلها جاهزة لموت جديد، لمعركة جديدة تخلقها فورة الحياة الناهضة في كيان إيزابيلا.
لم يتوقف عبث إيزابيلا عند حدود إرغامي على اصطناع حياة خارجيّة لنخلتي، بترميم جسدها الهامد، عقب كلّ مغامرة. شيئاً فشيئاً شرعت معجزة عناد إيزابيلا تمنح نخلتي القتيلة بعضاً من روحها المتوقد؛ تمنحها، من دون أن تعلم، عاطفة وصوتاً وخيالاً. مباراة الموت والحياة، التي احتكرتها إيزابيلا منحت نخلتي قوّة إعجازيّة، خارقة ومموّهة، تشبه السحر، تشبه المحال، تشبه انبثاق الحياة من العدم. لم تأت إيزابيلا يوماً الى بيتي من دون أن تحمل معها ابتكاراً وجوديّاً فريداً ومثيراً: سنّ رابعة نبتت هذا الأسبوع، كلمة “مورفار” السويدية صارت “جدو” العربية، كلمة “فوفوفو” أصبحت “هوند” و”كلب”. نظرة واحدة، ساخرة، من عينيها الماكرتين تجعلني أعيد كلّ حساباتي الخاطئة عن خرافة ما يُعرف بالصفحة البيضاء، وملائكيّة الطفل الإلهيّ. ما انفكت إيزابيلا تتبارى بمكر شيطانيّ مع جمود نخلتي، التي لا يتحرك فيها سوى هالة الضوء الصادرة من قمر مُصانع.
لم تعد نخلتي كما كانت. هي الآن غير تلك التي كانت قبل ولادة إيزابيلا. لقد علـّمتها الحياة قرب إيزابيلا ما لم تعلـّمها المصانع كلـّها. ربّما الحسد! هل ينتقل الحسد من جسد الحيّ الى روح الميت؟ ها هي النخلة أمامي، تقول لي بلسان إيزابيلا: “ددو… دار!”. انظر الى الصمت، فلا أرى شيئاً سوى ضحكة إيزابيلا العابثة، المتحديّة، تتردّد معلـّقة على سعفات نخلتي البلاستيكيّة: “جدو… انظر هناك!”.
هكذا بدأت نخلتي ترغم نفسها، يوماً بعد يوم، على تعلـّم نطق الكلمات، وتتدرب على الخروج من صمتها البلاستيكيّ المطبق، حتّى أضحت تحاورني، وفي أحيان كثيرة أجدها مشاكسة، تجيد المشاغبة، بالضبط مثل أختها وعدوّتها إيزابيلا، تقول لي بعربيّة مخلوطة بالسويديّة لتخدعني: “ددو… دار!”.
ألتقط الصوت الخفيّ. استدير الى هناك، بكلّ شيخوختي، الى حيث تشير. ضوء دائري، مثل القمر، يهبط على سعفاتها الطوال. ضوء حارّ، مثل شمس بصريّة، تسّاقط على سعفات نخيل “أبي الخصيب” الداكنة الخضرة. أغفو وأفكر: البصرة أم ميسان! لا فرق، كلتاهما بعيدة، كلتاهما فقدت نخلها الناضر، ورطبها الجنيّ. كلتاهما أندلس خلّـب. كلتاهما تغشاهما أتربة الحروب، وأغبرة الويلات المهلكات. كلتاهما عطِشتان الى اللون، الى الارتواء، الى حريّة البشر الأحياء، بالضبط كما أنا عطش الى ما تبقى في كأس الحياة.
النهار