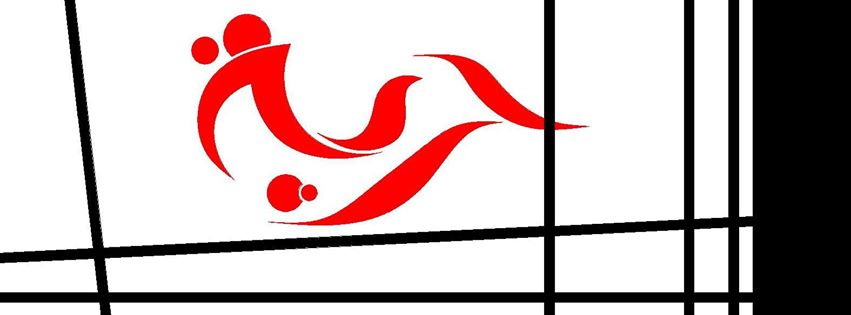محور جريدة النهار السنوي: الاستبداد الديني مضرَّجاً بأدواته؟

الاستبداد الديني مضرَّجاً بأدواته؟
عقل العويط
العالم العربي سيبصر النور لا محالة. لا لزوم للتشاؤم، على رغم كل ما يظهر على سطح المتغيرات العربية من ارتدادات ظلامية، قد تعيدنا إلى عهود الدولة الدينية ومآسيها، ولاسيما في تونس ومصر. بل يجب أن نكون متفائلين، وإن بيقظةٍ وتحفظٍ واقعيين. فهذه من اللحظات التاريخية النادرة التي تثور فيها مجتمعاتنا العربية، لا على أنظمتها الديكتاتورية الفاسدة فتطيحها فحسب، بل تثور فيها على ذاتها، وتنتصر عليها أيضاً، مُعيدةً النظر في مسلّماتها النقدية والثقافية والقيمية والسياسية.
لا. مصيرنا العربي ليس موقوفاً على الاستبداد. كأن تنتقل مجتمعاتنا وشعوبنا ودولنا من الرزوح تحت مطرقة الديكتاتورية القوموية والأمنية والعائلية الى الرزوح تحت سندان ديكتاتورية الإمارة الدينية، على ما يمكن أن تتمخض عنه بعض الثورات العربية القائمة. إذ لا بدّ أن يكون ثمة مصير نهضوي ثالث يتحضر في خضمّ العواصف والتغيرات التي تشهدها الحياة العربية من مغارب العالم العربي حتى مشارقه. ولا بدّ لهذا المصير من أن يختمر بصبرٍ جميل، وبطول أناة، ويتبلور، ليتخذ في ما بعد أشكالاً وبنىً لا تزال غير واضحة وغير مكتملة العناصر.
يعيش العالم العربي حالياً هواجس الخوف من أن تُسرَق منه ثوراته الشبابية والشعبية النقية، وتوظَّف في خدمة مشاريع إسلاموية استبدادية. كثرٌ يرون أن هذه الهواجس ليست مبنية على فرضيات، بل على وقائع قد تكون تنبئ بما هو أخطر وأدهى. من مثل ما تؤول إليه حالياً ثورتا تونس ومصر العظيمتان. وما قد تؤول إليه ثورة عزيزة أخرى، هي الثورة السورية، التي أطلقتها جموع شبابية وشعبية وتيارات ديموقراطية.
لا نريد تبسيط الأمور، وتظهير الصورة العربية الراهنة باعتبارها مشروخةً بين استبدادٍ كان قائماً واستبدادٍ يلوح عملانياً في الأفق. كما لا نريد أيضاً تعميم ثقافة اليأس، فنحكم على واقعنا العربي المتشعّب والمركّب والمعقّد حكماً إغلاقياً تبسيطياً، فحواه استحالة قيام تغيير ديموقراطي حقيقي، يجعل الحكم البديل في أيدي سلطات مدنية تدين بالحق والعدل والقانون. لكننا في الآن نفسه لا نريد “الاغتراب” عما يعتمل في الواقع، بإشاعة أحلام رومنطيقية تهويمية قد تكون بعيدة المنال في المدى المنظور.
فها هو زعيم “حركة النهضة الإسلامية” في تونس، راشد الغنوشي، يقول إن “الحركات الإسلامية ستخرج في نهاية الأمر منتصرة، وستسيطر على أنحاء العالم العربي، عقب فترة انتقالية صعبة، وأتوقع انتصار الثورة السورية، وأن تحدث إصلاحات في أكثر من بلد عربي، خصوصاً منطقة الخليج”، داعياً “الجماعات العلمانية للانضمام إلى الإسلاميين، لإدارة المرحلة الأولى بعد عزل الحكام الاستبداديين، وفي نهاية الأمر، الإسلام سيكون النقطة المرجعية”.
غير بعيد من فحوى هذا القول، ما يشهده من تحولاتٍ دراماتيكية الواقعُ السياسي في مصر التي أطاحت ثورتها النيّرة حكماً استبدادياً غاشماً استمر أربعة عقود. فما إن “فاز” محمد مرسي في انتخابات الرئاسة المصرية، حتى كشف “الإخوان المسلمون” والسلفيون هناك عن أنياب توجههم الفعلي العميق، وشبقهم للاستيلاء “الدستوري” على السلطة استيلاءً كاملاً ماحقاً، انطلاقاً من الشعار الذي رفعوه منذ عهود: “الإسلام هو الحل”.
وإذا كانت الثورتان “المضادتان” في كلٍّ من تونس ومصر، بما تنطويان عليه من عزائم خلاّقة وإشراقات ديموقراطية ونهضوية فذّة، تُظهران المشقة التي يواجهها الإسلام السياسي في إحكام سيطرته على هذين البلدين، فإن ذلك يجب أن يكون مدعاة عميقة للتفكر في البدائل التي لا يمكن في أيّ حالٍ من الأحوال أن تكون نكوصية أو استبدادية أو أحادية الجانب.
أما في سوريا، التي لا تزال ثورتها البهية في ذروة تأججها، فإننا نتوق إلى أن يكون لقواها الطليعية الحرّة والديموقراطية اليد الطولى في وضع حدّ سريع وحاسم لمأساة الشعب السوري، بأقلّ الخسائر الممكنة، من خلال الخروج نهائياً من الاستبداد الأسدي. آنذاك، فقط، تنفتح الأسئلة الملحّة على مصاريعها، وفي مقدمها كيفيات استتباب الحرية للشعب السوري، بمكوّناته المتنوعة، في نظام ديموقراطي تظلّله دولة محرّرة من براثن الاستبداد الشنيع الذي فعل بسوريا ما لم تفعله أيّ وحشية في التاريخ، كما فعل بلبنان وبالجوارَين العراقي والفلسطيني، ما لا نزال نلملم شظاياه المتناثرة فوق جثمان حياتنا.
نعرف أننا معنيون جداً بالحرية والديموقراطية في العالم العربي كله. خصوصاً في سوريا. كذا نقول عن “أمّ الدنيا”. والعراق. وتونس. وهلمّ.
لقد تكشفت الانتفاضات والثورات العربية عن تيارَين كبيرَين، ثقافيين وسياسيين، في كلٍّ من البلدان المعنية: التيار المدني بألوانه الليبيرالية والعلمانية واليسارية، والتيار الإسلاموي – الإخواني – السلفي، آخذين في الاعتبار أن مكوّنات المجتمعات العربية في البلدان الثائرة أكثر تعقيداً من الفرز البادي للعيان.
وعليه فإن “الملحق” يطرح الأسئلة الآتية:
أين نحن كمثقفين من المأزق المقلق الذي يواجه هذه الثورات؟ وكيف يمكن الشعوب المنتفضة والثائرة أن تتجنب الوقوع في فخاخ ديكتاتوريات بديلة، ترفع شعارات الدين وترتدي أقنعته الزائفة؟ وكيف يمكن هذه الشعوب أن تنجز مؤسساتها الديموقراطية، في دولة الحق والعدل والقانون والحرية، بعد سقوط الأنظمة الحالية؟
نحن في “الملحق” موقفنا واضح، وعملنا واضح: الاستبداد في كل أشكاله ومسمّياته، هو الهدف الذي نصوّب عليه، ماضياً وحاضراً ومستقبلاً، وأياً يكن: أمدنياً كان أم علمانياً أم عسكرياً أم سياسياً أم مجتمعياً أم ثقافياً أم دينياً. تشغلنا الأفكار والأسئلة التي تقضّ العقل النقدي الحرّ، لا السياسات الصغيرة. لذا نشرّع صفحاتنا للبحث عن مقوّمات الحرية والحداثة، ومساءلتهما ونقدهما، لترسيخ حضورهما في حياة الأفراد والمجتمعات. هكذا سنظلّ نقارع الصخور، إلى أن تتفجر الينابيع وتفوز بالحرية.
والآن، قد يجد الإسلاميون المتشددون أكثر من طريق عربية إلى الحكم، مشرقاً ومغرباً. لكن إلى متى؟! فالشعوب الثائرة أعلنت أنها لن تهادن أحداً، وأياً يكن. لقد قرّرت هذه الشعوب أنها تريد حرياتها وإقامة مؤسساتها الدستورية والديموقراطية، بدون إيعاز من أحد. وقالت قولتها التاريخية بعدم إمكان الرجوع إلى الوراء، بعد الآن. شأننا في هذا شأن هذه الشعوب. أما قضيتنا فهي قضية الحرية المفتوحة على الحلم. والحرية هذه، ستظلّ تقرع على صدر الحلم إلى أن يطلع الضوء.
بعد قليل، سيطلع الضوء على لبنان وسوريا ومصر وتونس والعراق، وسواها من بلدان عربية تائقة إلى الحرية. ومع طلوع هذا الضوء، فإن الاستبداد سيكون، ولا بدّ، مضرّجاً بأدواته الاستبدادية، التي سترتدّ عليه هذه المرة. أما الاستبداد الديني، فستقتله ادواته، شأنه شأن ما سبقه في المضمار.
يشارك في هذا العدد السنوي، كتّاب ومفكرون من لبنان وسوريا ومصر وتونس وليبيا: أحمد بيضون، سمير فرنجية، مسعود ضاهر، منى فيّاض، دلال البزري (من لبنان)، ياسين الحاج صالح، نائلة منصور، بكر صدقي (من سوريا)، يوسف رخّا (من مصر)، آدم فتحي (من تونس)، ومحمد الأصفر (من ليبيا). أما الغلاف فبريشة الزميل الفنان أميل منعم.
الثورة، الإسلام، وامتلاك السياسة: في نقد “التيار المدني” والاستقطاب المدني الإسلامي
ياسين الحاج صالح
هنا “الإشكالية” التي طرحها الملحق على الكتاب العدد السنوي
تكشفت الانتفاضات والثورات العربية عن تيارين كبيرين، ثقافيين وسياسيين، في كلٍّ من البلدان المعنية: التيار المدني بألوانه الليبيرالية والعلمانية واليسارية، والتيار الإسلاموي – الإخواني – السلفي.
في ضوء الواقع الراهن، بتعقيداته المحلية، والإقليمية، وتناقضات المصالح الدولية، أين نحن كمثقفين من المأزق المقلق الذي يواجه هذه الثورات، وكيف يمكن كلٌّ من الشعوب المنتفضة والثائرة أن لا يقع في فخاخ ديكتاتوريات جديدة بديلة، ترفع شعارات الدين وترتدي أقنعته الزائفة، وأن ينجز مؤسساته الديموقراطية، في دولة الحق والعدل والقانون والحرية؟
***************المقالة
لا أرى، بداية، أن الكلام على “تيار مدني” متعدد الألوان يتقابل مع تيار إسلامي متعدد التيارات الفرعية منتجٌ معرفيا أو سياسيا. من شأن ذلك أن يُغفِل تمايزات كبيرة ضمن كلا التيارين، يتواتر أن تتغلب على التمايز الكبير المفترض بين “مدنيين” و”إسلاميين”. محور الاستقطاب الرئيس في السياق العياني للثورة السورية اليوم هو الذي يفصل بين من هم مع الثورة إلى حين إسقاط النظام الأسدي، ومنهم مدنيون” و”إسلاميون”، وبين من هم مع النظام، ومنهم “مدنيون” يحصل أن يُعرِّف بعضهم نفسه بالليبرالية واليسارية، وبالعلمانية خاصة، ومنهم “إسلام” حكومي داجِن ومدجِّن.
ولعل الأمر لا يختلف جوهريا عن ذلك في مصر وتونس. فليس الاستقطاب المنتج هو ذاك الذي يفصل قطاعين من النخبة تميزهما اعتبارات عقدية، مؤمنين مقابل ملحدين مثلا، أو إسلاميين مقابل علمانيين، أو شرع الله محل القوانين البشرية، على ما قد يفضل طرح الأمر إسلاميون تسلطيون ومدنيون تسلطيون. معيار التمييز اليوم هو الثورة في سورية إلى حين إسقاط النظام، وهو الكفاح الديمقراطي في مصر وتونس، أي بين من يعملون من أجل مساحة اكبر للمبادرات والفاعلية الشعبية في حياتنا السياسية والعامة وبين تسلطيين إسلاميين ومدنيين تفكيرهم متمركز حول الدولة المربية، وحول فرض العقيدة الإسلامية أو “المدنية” عبر الدولة.
هل توفر “الإسلامية” أساسا متميزا للطغيان؟ و”المدنية” أساسا تفضيليا للديمقراطية؟ لا أقول إن العكس هو الصحيح، لكن أتشكك كثيرا في هذا التقدير.
1
ليس صحيحا بحال أن “التيار المدني” ديمقراطي لمجرد كونه غير إسلامي، أو مناضل من أجل الديمقراطية. الواقع أن تاريخ متن هذا التيار طول العشرين عاما الماضية على الأقل يضع طيفا واسعا منه في موقع أقرب إلى النظم الحاكمة، وإن بتحفظ متفاوت عليها. فإن كان من توجه سياسي يمكن نسبته للتيار المدني المزعوم فهو “الاستبداد المستنير”، أي نسخة من الاستبداد أقل انحطاطا مما عرفنا في العقود الماضية، لكنها محبة للثقافة والمثقفين، وتعمل على “تنوير الشعب”، ولا بأس في أن تتعامل معه بغلظة أبوية. لزوم “التربية”. والفاشية ليست نهجا تفضه أجنحة من “التيار المدني” في التعامل مع انتفاضات العامة، على نحو تظهره الثورة السورية أيضا.
أما الخصم النوعي لمختلف مكونات هذا التيار فهو “الإسلاميون”.
يمكن التكلم على تناقض بين الطابع المفتوح لتفكير هذا التيار والطابع المغلق لسياسته. لكن فكره خلال الجيل الأخير ليس منفتحا في الواقع، ولا يحوز مبدأ انفتاح أصلا على ما يصير ويتحول. لقد اغتال التيار المدني نفسه بنفسه حين وقف على أعتاب الدولة الاستبدادية المنحطة في مواجهة الإسلاميين وأي “مدنيين ديمقراطيين” (إثبات ذلك ميسور من أعمال مثقفين سوريين مكرسين).
بالمقابل يحمل التيار الإسلامي المعاصر تناقضا بين وجه شعبي مكتسب في مقاومة الطغيان، وبين منزع سلطوي متجه نحو الهيمنة والاستئثار. وضمن هذا التيار تيارات فرعية، تشغل مواقع متفاوتة بين طرفي التناقض، مع كونها أقرب جميعا إلى المنزع التسلطي بحكم تكوينها الفكري، المفتقر بدوره إلى مبدأ انفتاح. كلما عرف الإسلاميون أنفسهم بدلالة معتقدهم الديني حصرا كانوا أميل إلى التسلط (الجماعات السلفية والجهادية) والانعزال عن غيرهم، وكلما عرفوا أنفسهم بمناهضة الطغيان والمطالب الاجتماعية كانوا أقرب إلى سند لحياة سياسية منفتحة وإلى الشراكة مع غيرهم. وتنجذب قطاعات من الجمهور إلى الإسلاميين اليوم لأنها تجد عندهم طاقة احتجاج نشطة، وانضباطا أخلاقيا، ومغايرة جذرية للنظم النخبوية التي حكمت بلداننا خلال العقود الثلاثة أو الأربعة الأخيرة، فيما لم يشكل “مدنيون” غير الجناح المعتدل للنظم النخبوية نفسها، ودون طاقة احتجاج عامة، ودون أن تكون لهم دعوة اجتماعية وأخلاقية عامة من أي نوع.
2 وليس الانطلاق اليوم من استقطاب إيديولوجي مدني إسلامي بالأمر المحايد سياسيا. فهو في الواقع يضع هياكل الحكم النخبوي في موقع الحكم الأعلى بين “تيار مدني” فاقد للعزيمة السياسية ولا مشروع إيجابيا لديه، وبين إسلاميين صاروا تجسيدا للمعارضة السياسية الأكثر جذرية. وهذا يناسب تماما النظم الاستبدادية المنحطة التي اجتهدت في العقدين الأخيرين، وفي سنوات ما بعد أيلول 2001 بخاصة، على تصوير نفسها متراسا “متمدنا” ضد محكوميها المتوحشين، الإسلاميين بخاصة. وليس في الكلام على نظم منحطة انزلاقا نحو الهجاء، بل هو محاولة لإظهار افتقار هذه النظم إلى أي مبدأ أو فكرة عليا تسمو على البقاء المؤبد في الحكم وامتلاك كل الأشياء. إنها انحطاط منظم. ويناسب الطرح نفسه “مدنيين” عاجزين عن المبادرة الفكرية والسياسية، ومن شأن بقاء الأوضاع كما هي أن يحجب عجزهم عن تغيير أي شيء في أنفسهم أو في العالم حولهم. لكنه يناسب أيضا التيارات الأكثر تسلطية بين الإسلاميين حين يظهر أنهم المعارضون الحقيقيون والأكثر قربا من الشعب.
الطرف الذي يدفع ثمن هذا التركيب الإيديولوجي- السياسي هو “مدنيون ديمقراطيون”، إن جاز التعبير، مشاركون في مقاومة الطغيان، ومخاصمون للتيار المدني الداعي إلى الاستبداد المستنير، وللإسلاميين ومبادئهم الدينية السياسية التي لا تفيض عن نظام “الاستبداد العادل”: نظام “يطبق الشريعة” و”ينزل الناس منازلهم” و”يعطي كل ذي حق حقه”. ويخسر أيضا إسلاميون ديمقراطيون، مثقفون أفراد ومجموعات صغيرة، لا تشكل تيارا منظما، حالها في ذلك حال “المدنيين الديمقراطيين”.
3
لكن فلنعد إلى جذور المسألة.
لماذا شغل إسلاميون هذا الموقع الكبير في المجتمعات العربية الأكثر تحديثا؟ وكيف حصل أنهم أخفقوا في أية تمردات قادوها بأنفسهم (في سورية بين أواخر السبعينات ومطلع الثمانينات، وفي مصر أواسط السبعينات، ثم على نحو متقطع في الثمانينات والتسعينات…)، بينما تقودهم ثورات لم يفجروها والتحقوا بها متأخرين ومترددين إلى مواقع الصدارة السياسية؟ غير ما سبق ذكره من المغايرة السياسية والأخلاقية الجذرية للنظم المنحطة القائمة، وطاقة احتجاج كبيرة، من أهم سوابقها التمردات الفاشلة المشار إليها، شكّل “الإسلام” استراتيجية كبرى لا مثيل لها لامتلاك السياسة في مجتمعاتنا من قبل جمهور مستبعد ومفقر سياسيا وماديا. المقصود بامتلاك السياسة امتلاك التنظيم والرأي والقضية الواضحة، حيازة مبدأ عدالة أو تمرد ضد “الظلم”، وطاقة لتشكيل مجتمع مختلف عما هو قائم. قد نختلف قليلا أو كثيرا في الحكم على “التيار المدني” المتعدد الألوان، لكن هل هناك من يعتقد جديا بأنه يحوز مبدأ مغايرا لتنظيم المجتمع والدولة عما نعرف منذ عقود؟ أو أنه حائز على قدرات خاصة في مجال التنظيم والتعبئة المجتمعية الواسعة؟ أو أن قضايا الحرية والعدالة للجميع تشغل بال أعلامه وعموم المنتسبين إليه؟ وإذا كانت هذه النظم بلغت المدى الذي نعلمه من الانحطاط، مما لا يكاد يتشكك فيه حتى دعاة “الاستبداد المستنير”، وإن فسروه غالبا بطريقة تضع عبء الانحطاط على المحكومين لا على الحاكمين، إذا بلغت مدى الانحطاط المعلوم، ألا يقتضي الأمر إعادة نظر جذرية في فلسفتها التحديثية الدولانية (المماهاة بين الدولة والحداثة أو العقل)، وفي أولوية الهدف (التماثل مع النموذج الحداثي) على الممارسة العملية لملايين البشر وحياتهم وصراعاتهم؟ وعلى حساب القضايا الاجتماعية وقضايا القيم؟
لقد توافقت هذه الفلسفة التي يواليها “التيار المدني” وتطبقها النخب المنحطة مع إنتاج “عالم أول داخلي” صغير، لا يكاد يتعدى عشر السكان، يتمايز عن عالم ثالث داخلي يعتبر متوحشا ومهددا للمتحضرين في العالم الأول الداخلي الوكيل، الذي يتماهى مع العالم الأول الأصيل. وينبغي إخضاعه بعنف استعماري نموذجي، مما بلغ فيه النظام الأسدي مرتبة لم يضاهها الاستعمار الفرنسي، ولا إسرائيل. وبين العالمين هناك عالم ثان ليس شريكا في العالم الأول، لكنه يخاف كثيرا من العالم الثالث، ويغلب أن يكون عونا للعالم الأول عليه. امتلاك السياسة عنصر مقاومة وتحرر في مواجهة نظم تعتمد في دوامها على تجريد محكوميها من السياسة، من التنظيم والرأي والمغايرة. وفي سورية حيث أضحى امتلاك الحرب شرطا لامتلاك السياسة، توفر تنويعات من “الإسلام”، تتراوح بين الإسلام الشعبي إلى الإسلام السلفي والسلفي الجهادي، الأرضية النفسية والفكرية الأنسب لامتلاك الحرب عبر مفهومي الجهاد والاستشهاد.
4
قد يوافق “مدنيون” على ما سبق كتحليل لواقع مضى أو هو في سبيله إلى المضي، لكن على الأرجح ليسوا على استعداد للموافقة على ما يتضمنه من سياسة: إن السياسة الصحيحة هي التي تتيح للعالم الثالث الداخلي، للمتوحشين والبدائيين الداخليين، امتلاك السياسة والرأي والتنظيم، والحرب إن لزم الأمر، وإلا فليس من حق أحد أ يمتلك شيئا. وقبل ذلك تنطلق من أن بدائيتهم علائقية، هي الوجه الأخر للعمليات السياسية الفكرية الاقتصادية التي قادت إلى نشوء العالم الأول الداخلي، الطوابق العليا الأكثر تنظيما وانضباطا من مجتمعاتنا، والأكثر تحكما في حياتها وفي حياة غيرها. وتاليا لا سبيل إلى تجاوز البدائية والتوحش دون تجاوز هذا العالم الأول أو الغرب الداخلي في الوقت نفسه. أعني الغرب كمسيطر عالمي لا كثقافة. ليست هذه معركة عقدية أو “ثقافية” (بالمعنى “المدني” للثقافة: “الذهنيات” و”صناديق الرؤوس”، يا للغرابة!). إنها صراع اجتماعي وسياسي من أجل الحرية والتحكم بالحياة. فالغرب الداخلي، خلافا للغرب الغربي، ليس منتجا للقيم، ولا يشكل نموذجا رياديا يقبل التعميم، ولا هو قوة ديمقراطية ولا “تنويرية”. لكن هل من شأن الإسلاميين، الذين يحاولون احتكار تمثيل العالم الثالث الداخلي، أن يحملوا نموذجا للديمقراطية والحداثة؟ ألا يحتمل أننا، ونحن نواجه الغرب الداخلي، ننزلق إلى التفكير في الغرب كهوية غريبة نواجهها بهوية أصيلة، بدل أن نفكر فيها كسيطرة نواجهها بمقاومة تحررية؟ السؤال في مكانه تماما، وكانت اعتراضات على الهيمنة الغربية (إدوارد سعيد بخاصة) قادت بدروب متنوعة، إلى تبرير الأصالية، أو إلى تسهيل رد واقعنا إلى الإسلام والهوية الإسلامية، وليس إلى الصراع من أجل الحرية والكفاية والعدالة، الذي يسهم فيه مسلمون وغير مسلمين، مؤمنون وملحدون، إسلاميون وعلمانيون.
هذا طريق مسدود لا يفضي إلى التحرر، ويفترض أن لا نهدر وقتا على السير فيه اليوم. تحررنا لا يتمثل في استعادة طابع إسلامي ماهوي مزعوم لمجتمعاتنا، جرى استلابه من وراء ظهر مجتمعاتنا وفي غفلة عنها، بل في تحرر الأفراد والجماعات، وفي نهوض الشرائح الأشد حرمانا بالخصوص، وفي الحريات السياسية والاجتماعية، بما فيها حريات النساء والمخالفين وغير المؤمنين وأية أقليات محتملة. لا نُعرِّف مجتمعاتنا بـ”الإسلام”، على ما يفعل غربيون وإسلاميون و”مدنيون” ونخب منحطة، بل بصراع الناس من أجل امتلاك السياسة والحياة، والحرب، على نجو ما يفعل الناس في الغرب وغير الغرب، متوسلين ما في متناول اليد من متاع فكري وسياسي وأخلاقي. “الإسلام” استراتيجية محتملة في هذا الصراع، أهلته ظروف العقود الأخيرة لإشغال موقع متقدم في سياسة مجتمعاتنا ووعيها الذاتي، لكنه ليس موضوع الصراع، ولا هو الهوية الثابتة والنهائية للمنخرطين فيه.
5
هذا يعيد الموقف من الإسلاميين إلى الأرض الاجتماعية السياسية من قبة السماء التي تتنزل منها العقائد المطلقة، ومن قبب الرؤوس المكتفية بما فيها من نور؟ أليست القبتان قبة واحدة، على كل حال؟ ويعيد إلى النقاش تناقض الإسلاميين الذي سبقت الإشارة إليه: بين كون الإسلام الذي يستندون إليه خطة لامتلاك السياسة في مجتمعات مفقرة منها، وبين كونه عقيدة خاصة لمؤمنين؟ منهج مقاومة، ومنهجا محتملا للتحكم السياسي؟ في مصر وتونس نرى بوادر التحول من أحد الدورين إلى الآخر.
منطلقنا المبدئي في مواجهة احتمالات استبداد إسلامي جديد أن هذا لا يطرح تحديا خاصا مختلفا عن تحدي مواجهة الطغيان الذي خبرناه في العقود الماضية، خلافا لما يفضل أن يعتقد “التيار المدني”. الفرضية الأساسية لهذا التيار أن التقاء العقيدة الدينية بالاستبداد السياسي يجعل مستحيلا مقاومة وتجاوز هذا التركيب. لكن يبدو هذا افترضا تأمليا لا سند له من الواقع. لا يدوم النظام الإسلامي في إيران لأنه إسلامي، وليس بفضل عقيدة المطلق ومناورات الاستبداد وحدها، بل لأنه يلقى دعما شعبيا حقيقيا. وتدوم نظم الخليج، وهي غير منتخبة ولا تالية لثورات على كل حال، بفضل الريع النفطي والحماية الأميركية. ولا نرى سببا لافتراض أن يكون طغيان أي حاكمين إسلاميين أشد، لمجرد كونه إسلاميا، من طغيان النظام الأسدي أو نظام مبارك أو بن علي. بل إن عنصر المقاومة والمغايرة وامتلاك السياسة الديمقراطي في تكوين الإسلاميين المعاصرين يرجح أن التحول نحو الطغيان أعسر بالأحرى، لا أيسر. فيما نعلم من المثال السوري أن حكم هذه النخبة واجه أية اعتراضات اجتماعية منذ شهوره الأولى بالدبابات والإعدامات وقصف الجوامع، وهذا لأنه على الأرجح فاقد للعنصر الشعبي جوهريا، وبمثابة حكم استعماري غريب. هناك افتراض آخر يقول إن أكثرية سكان بلداننا، ولمجرد كونهم مسلمون، مضمونون للإسلاميين في كل حال. يشارك في هذا الافتراض الإسلاميون التسلطيون الذين يستخلصون وجوب خلوص الحكم لهم من الصفة الإسلامية الماهوية لمجتمعاتنا، ومدنيون يظنون أن شعبية الإسلاميين مستمدة من اعتبارات تتصل بالدين وبـ 15 قرنا…، لا بمقاومة نظم منحطة في أجيالنا الحاضرة، وكذلك هذه النظم المنحطة ذاتها التي ترى أن خصومة محكوميها لها نابعة من قبب رؤوسهم الفاسدة، وليس من انحطاطها هي. ليس هذا الافتراض صحيحا بحال. وضع الإسلاميين الراهن تاريخي، ولد في تاريخ، وثبت في تاريخ ثابت لم يتغير، وهو متغير حتما في تاريخ متغير. ولقد مرت أزمنة لم يكن الإسلاميون فيه التيار المتصدر في مجتمعاتنا “المسلمة”. والدلالة البسيطة لذلك أن اشتقاق موقع الإسلاميين السياسي الراهن من الصفة الإسلامية المفترضة لمجتمعاتنا أمر بالغ الزيغ والضلال أيا يكن قائله.
ونميل إلى أن الإسلاميين في الحكم سيواجهون مشكلات مع الجمهور الذي والاهم وانتخبهم، وليس أساسا من “التيار المدني”. ولا يبعد في هذه الحالة أن يتوسلوا الدين لنزع السياسة الثمينة من الجمهور، والاستئثار بالتنظيم والرأي، والسلطة، لأنفسهم.
ولا ينبغي أن يكون أمرا مستغربا تغير دور الدين بتغير موقعه: مقاوم في مواجهة الطغيان، لكنه نزاع إلى التسلط والطغيان حين يكون في الحكم. والسياسة الصحيحة للمدنيين الديمقراطيين فيما نفترض هي الانخراط في صراع الشعب ضد الطغيان الجديد، وليس الموقف الانعزالي المعادي للشعب والإسلاميين.
6
ماذا بخصوص موقف “المثقفين”؟ نتجاوز أنه ليس هناك حزب أو تيار أو طبقة اسمه “المثقفون”. الأسوأ في تقديري هو موالاة “الفلول” تحت لواء الخوف من الإسلاميين، كما يبدو أن “مدنيين” في مصر يفعلون، أو العمل على تغليب استقطاب مصطنع، مدني/ إسلامي، في سورية على الاستقطاب بين نظام منحط وإجرامي وثورة شعبية. ليس المثقفون سياسيين، لكن لا شيء يغفر للمثقفين افتقارهم للحس السياسي، في زمن الثورات بخاصة.
والواقع أننا نرجح أن هناك خللا جوهريا في المثال التنويري الذي يصدر عنه التيار المدني وكثير من المثقفين. هذا المثال لا يقود إلا إلى مواقع قريبة من “الغرب الداخلي” (وهذا “طبقة”، وليس نموذجا) أو الخارجي. ولا يقود بحال إلى تعميم فعلي للنموذج الغربي في بلداننا. وفيما يتجاوز الشراكة في الصراع ضد الطغيان الحالي، لا شيء يسوغ الانضمام الثقافي إلى الإسلاميين بذريعة أنهم الممثلون الطبيعيون للشعب. ليس هناك أي مبرر وجيه لهذا الافتراض الأخير، إلا إذا افترضنا، مرة أخرى، أن الناس ينحازون إلى الإسلاميين لأسباب غير عقلانية، تتصل بـ”طبيعة” مجتمعاتنا، لا باعتبارات سياسية واجتماعية تاريخية. وهذا باطل سواء قاله الإسلاميون أو “المدنيون” أو الغربيون، أو النظم المنحطة. الثقافة مهمة لأنها تشرح، أو يفترض أن تشرح، الأوضاع الصراعية في كل حين، وتكشف ما هي الرهانات الفعلية وراءها. وكذلك لأنها تقترح أشياء إيجابية، غايات وضوابط، تشكل جزءا من الصراع الحالي وتسهم في دفعه نحو الحصائل المرجوة. وأيضا لأن للثقافة بعد أخلاقي محرر وبانٍ للضمير، هو الذي أهدر خلال الجيل الأخير على يد المدنيين التنويريين (علامتهم الفارقة: الكلام الكثير على العقل والمعرفة…).
والمثقفون مهمون لأنهم يقومون بهذه الأشياء، ولأن الوضوح في شأن ما يجري يصنع فرقا. يقتضي الأمر ألا ينخرط المثقفون في عملية تزوير منهجية للواقع على ما يفعلون كثيرا.
وبينما لا ريب في الحاجة إلى عمل ثقافي أكثر انشغالا بحرية الأفراد بما فيها الحريات الاجتماعية، ومنها حرية الاعتقاد الديني (بما فيها اللااعتقاد وتغيير الدين واللاأدرية)، فإن هذا يمر عبر الصراع على الشعب مع الإسلاميين. وما يحصن أية قيم مكتسبة هو تحولها إلى ثقافة للشعب، وما يضعفها هو اقتصارها على كونها ثقافة نخبة. فشل التيار المدني لدينا فشلا مستمرا ومتكررا لأنه لم ينتج ثقافة، وتراجع عن فهم الثقافة كعملية تفاعل واكتساب، وتراجعت العناصر الديمقراطية والإنسانية في تفكير أعلامه وعمومه في ربع القرن الأخير، وتحول إلى التشاؤم والتبشير بالتشاؤم (انقراض، أصولية، ظلامية…). ليست أوضاعا ديمقراطية ناجزة هي ما يمكن أن تؤدي إليه ثوراتنا الديمقراطية الجارية التي لا تواجه نظما منحطة فقط، ولا تطلعات الإسلاميين المحتملة إلى الهيمنة فقط، وإنما أيضا أوضاعا إقليمية ودولية ليست مواتية لتطور ديمقراطي معافى. لكن الثورات أطلقت ديناميات تحررية، لا نتصور لها توقفا في وقت قريب. ومن الظاهر حتى الآن أن حجم القوى الاجتماعية الناشطة سياسيا في البلدان التي شهدت ثورات لا يقارن أبدا بحجمها قبل الثورات، وأن جزء كبيرا من الصراعات الجارية في هذه البلدان متولد عن فيضان هذه القوى الاجتماعية الحية على الأطر السياسية والفكرية المتاحة. ظاهر أيضا أن فرص الاعتراض وامتلاك السياسة أكبر اليوم من أي وقت سبق خلال نصف قرن على الأقل. هذا يكفي للكلام على ثورات ديمقراطية.
حدود للتسليم “الواقعي” بتحوّلات الثورة السورية
أحمد بيضون
لا بدّ من حدّ للتسليم الواقعي بما تصير إليه حركة تاريخية تبدأ متّخذة لنفسها صورةً بعينها ومتطلعة إلى أفق معلن ثم تجد نفسها، بعد حين، وقد اتّخذت صورةً مغايرة وأصبح إفضاؤها إلى الأفق الذي أرادت فتحه، في البدء، أمراً معلّق الاحتمال أو غير مرجّح الحصول في مدى منظور.
نفكّر في الثورة السورية: في ما آلت إليه موازينها العامّة وفي إلزامها المتدرّج لمثقفيها بالتقبّل المتتابع لأطوار وأحوالٍ آلت إليها وكان بعضهم قد عبّر عن أشدّ الخوف من التوجّه نحوها قبل أن تحصل فعلاً.
ثمّة حدّ للمنطق الذي يتذرّع بكون النظام الأسدي، بإيغاله في القمع الهمجي وبما تمكّن من استنهاضه من دعم حاسم في النطاقين الإقليمي والدولي، هو الذي فرض هذا أو ذاك من التحوّلات التي شهدتها الثورة وراحت تزيدها غربة عن صورتها الأولى: عن الإلهام الأصلي الذي استنهض، طوال شهور، إعجاب العالم وإن يكن لم يستنهض نخوة قوى كبرى كان معوّلاً على حزمها لترجيح كفّة الثورة. فلم يقيّض لهذه حسم المواجهة لمصلحتها في مهلة مشابهة لما احتاجت إليه، في العامين الأخيرين، أقطار عربية أخرى وبأكلاف قابلة للمقارنة بتلك التي تكبّدتها شعوب تلك الأقطار. النظام فرض “هذا”: هذا مؤكّد ولكن المعضلة الجديرة، هي أيضاً، بالنظر وبالعمل هي أن “هذا” قد حصل وأن نتائج بعينها ذات وقع غير هيّن على مستقبل سوريا تترتّب على حصوله.
ما نشير إليه من أطوار وأحوال له أسماء معلومة يسهل استذكارها، فلا نبقى في عالم المجرّدات. كانت الثورة في شهورها الأولى سلمية: اتّخذت التظاهر أسلوباً رئيساً لحركتها وتركّزت بؤرها الكبرى في مدن متوسّطة الأهمية إجمالاً، معوّلها الأوّل على الأرياف المحيطة بها وعلى فائض الزراعة في هذه الأخيرة. وهي – أي المدن – تستقبل، إلى ذلك، فيضاً من أهل الريف من غير تهيئة أو توفّر لما يسهّل لها استيعابه. عالجت السلطة الأسدية حركة التظاهر هذه بالبطش الشديد وتمكنت من الحيلولة طويلاً دون غلبة يعتدّ بها للحركة على ساحات العاصمتين، دمشق وحلب، وتركّزها فيهما، على غرار ما تمكنت من تحقيقه، ردحاً من الزمن، في حمص وفي حماه، مثلاً…
ولقد بدا، مع تعاقب المجازر، أن المنفذ المتاح من هذا النفق الدموي يتمثّل في تشقق آلة القمع على نحو يضعف ذراع النظام الضاربة مقلّصاً قدرته على البطش، من جهة، ويوفّر حماية للحركة، من جهة أخرى، وحاجزاً في وجه قمع بدا أنه لا يلوي في تصاعده على شيء. وقد حصل هذا التشقق وتوسّع. إلا أنه لم يبلغ حدّاً تشلّ معه آلة النظام القامعة وذلك لأسباب تتّصل بالتكوين التاريخي لهذه الآلة وبما أورثه هذا التكوين من تماسك طائفي لمعظم قياداتها ولأهمّ قطعاتها المقاتلة. وهذا في ظلّ الصفة الطائفية المعلومة للنظام والخشية الطائفية التي راح النظام يسعى إلى تعزيزها، في صفوف الأقليات عموماً، من مغبة سقوطه.
هكذا راحت سوية القمع ترتفع إلى ذرى دموية مهولة وراح المكوّن العسكري في الثورة يزداد، مع ارتفاعها، أهمية، ويتوسع مستدرجاً، فضلاً عن النظاميين “المنشقّين”، عناصر من خارج القوّات النظامية، بل أيضاً من خارج سوريا كلها. وكان أن قوّات الثورة هذه قد أفلحت، مع تمادي المثابرة العنيدة، على الرغم من سوء تجهيزها المؤكّد والتبعثر الظاهر لقياداتها وتوجهاتها، في السيطرة على مناطق ومرافق كثيرة وفي التظهير المتزايد لعلامات التضعضع والتراجع في جهة النظام.
على أن هذا التطوّر، في جانب الثورة، نحو مواجهة العنف بالعنف كان ينتهي، في الواقع، لا إلى حماية الحركة الشعبية بتنوّع قواها واتساع قواعدها الاجتماعية، بل إلى الدفع بها نحو الهوامش والحلول المتدرّج محلّها. كان ينتهي إلى ما سمّي “عسكرة الثورة” بما يعنيه ذلك من تغليب لأفق العسكر وأسلوبهم في الصراع السياسي ولمسلكيتهم الاجتماعية ولما يحتاجون إليه من أنواع الدعم التي يتعذّر المضيّ في المواجهة المسلّحة إن هي لم تكن متاحةً ولو على شحّ وندرة.
اليوم أصبح وقع العسكرة هذا على الثورة أمراً مقضياً. وكان بين أبرز وجوهه نقل هذه الأخيرة من السباحة في مياه إسلام شعبي، غائم الملامح الاجتماعية وضعيف الإلزام في السياسة، إلى إسلام آخر، ضيّق في حركيّته ومتزمّت في شعائريته ولو على نحوين مختلفين كثيراً أحدهما عن الآخر: فواحد تفرضه، على الخصوص، انتقائية تعتمدها مصادر الدعم، الخليجية أساساً، فيعزّز في السياسة تنظيم “الإخوان المسلمين” الذي انتقل من حال الذواء المتأتي عن عقود القمع إلى حال التصدّر والحظوة الواسعة في صفوف العسكر المنشقّ وفي صفوف التمثيل السياسي للثورة سواءً بسواء. وواحد آخر يعتمد السلفية الجهادية هوية وأسلوباً ويستدرج إلى الساحة السورية من أشرنا إليهم من “مجاهدين” مختلفي المنابت على النحو الذي بات مألوفاً منذ بزوغ نجم “القاعدة” في أفغانستان. هذا كله يسّرته سيادة العنف على الساحة كلها ولكن يسّره أيضاً تهالك المعارضة السياسية المتمادي وضعف أطرها وعجزها عن الارتقاء بالعلاقات بين أطرافها وبمسلكية هذه الأطراف، في مهلٍ مقبولة، إلى السوية المصيرية للمواجهة الدائرة على أرض سوريا والسوية الرفيعة لاستعداد السوريين للبذل.
يصحب هذه النقلة صراحة متفاقمة في رسمٍ ذي صفة طائفية لخطوط المواجهة السياسية الجارية في ميادين الداخل. والطائفية – وقد أشرنا إلى هذا أيضاً – أمر تسهل نسبته إلى النظام: تاريخاً وانتساباً. ولكن الطائفية شيء يتغير وينقله العنف خصوصاً من حال إلى حال. ولا يمكن القول إنه لا يزال حيث وصلت الثورة السورية اليوم في حاله التي كان عليها عند انبثاق الثورة.
ثمّة شرعية لاتّهام النظام بفرض هذه التحوّلات بسائر وجوهها على من يواجهونه. ثمة شرعية للقول إن هذا الذي حصل ويحصل لم يكن منه بدّ بسبب ما أظهره النظام من همجية وبسبب استبسال حلفائه الخارجيين في إسناده. وهذا استبسال لم يتهيّأ ما يوازنه للثائرين وللثورة. ثمة وجه للبحث عن أصل الطائفية المتفاقمة في تكوين النظام ولتحميل قدر جسيم جدّاً من المسؤولية عن تفاقمها لسلوك النظام. بل يمكن أيضاً نسبة حال الخواء والتهاوي التي ظهرت فيها تشكيلات المعارضة السياسية إلى عشرات من السنين جهد النظام خلالها في إخلاء البلاد من السياسة. يصحّ القول أيضاً، من غير شك، أن أسوأ ما يمكن حصوله لسوريا هو بقاء النظام الأسدي محكّماً برقاب شعبها وأن ما سيقدم عليه هذا النظام، إذا استوثق من بقائه وإطلاق يده، نوع من الاستئصال المختلف الوجوه يضيق عن قباحته الخيال.
ولكن العزاء الذي ينطوي عليه هذا التوجيه نحو النظام للاتهام، بمختلف شُعَبه، عزاءٌ محدود وإن تولّت تسديده بوصلة سليمة. فالحال أن هذه التحولات الفادحة حصلت وتحصل فعلاً وأنها تحمل على استذكار شعارات الحرّية والكرامة والوحدة الشعبية التي شارك السوريون في رفعها شعوباً عربية أخرى وتحمل على السؤال عن المصير المرجّح لهذه الشعارات في الآفاق التي باتت الثورة الجارية مشرفة عليها. ولا ريب أن الجواب (أو الأجوبة) عن هذا السؤال يفترض أن تترتّب عليه (أو عليها) وجهة (أو وجهات) تقترح، في الأفق الذي فتحته الثورة نفسها، على العمل السياسي.
كان وعدُ الربيع العربي كله، والثورة السورية ساحة عزيزة من ساحاته وذروة من ذراه، “فَتْحَ المستقبل”. فما العمل، اليوم وغداً، لمنع إغلاق المستقبل من جديد؟
محاولة الالتفاف على القوى الأكثر تطوراً
في الربيع العربي: لبنان ومصر نموذجاً
سمير فرنجية
تثبت أحداث مصر وتونس يوماً بعد يوم عجز الأحزاب العقائدية التي وصلت الى السلطة عن التعامل مع التحولات العميقة التي أحدثها الربيع العربي. ليس هذا العجز ناجماً فقط عن خيارات هذه القوى السياسية، بل تعود اسبابه الى ما هو أبعد من السياسة وصراعاتها، تعود الى تحول أساسي لم تأخذه هذه القوى في الاعتبار وهو استعادة الفرد العربي لدوره، الأمر الذي أسقط منطق الاختزال الذي كانت تعتمده كل القوى العقائدية، من كان منها حاكماً باسم الأمة او معارضاً باسم الدين، وهو منطق قائم على اختزال الانسان بالجماعة والجماعة بحزب والحزب بقائد. هذه معادلة تؤدّي عملياً الى القول: في البدء كان “القائد”، وليس الانسان، ولا حتى “الكلمة”.
الربيع العربي هو في أساسه فعل أفراد قبل أن يكون فعل جماعات سياسية. بو عزيزي في تونس ووائل غنيم في مصر وحمزة الخطيب في سوريا وغيرهم، أفراد لا علاقة لهم بجماعات. أثار الظلم الذي طاولهم موجة من التماهي العاطفي تخطت كل الحدود وأحدثت ما لم يكن أحد يتوقعه، مُطلقة عملية محاكاة على مستوى العالم العربي لم يكن أحد يتوقعها.
لقد شهدنا في لبنان مع اغتيال الرئيس رفيق الحريري ظاهرة شبيهة من التماهي العاطفي فاجأت الجميع وخصوصاً من كانوا وراء عملية الاغتيال. وقد نبعت قوة الحركة الاستقلالية من كون غالبية الناس الذين شاركوا في انتفاضة الإستقلال إنما تحركوا بقرار ذاتي. لم يأتوا استجابةً لنداء من خارجهم، بل اعتبر كلٌّ منهم نفسه، وعلى طريقته، شريكاً أصلياً في المعركة الدائرة. نعم كانت الأحزاب السياسية حاضرة وفاعلة بالتأكيد. غير أن وجودها كان أقلياً بلا جدال. ولئن كان استقلال 1943 من إنجاز نخبة لبنانية، هي “آباء الإستقلال الأول”، فإن استقلال 2005 هو من إنجاز كل لبناني شارك فيه بشكل أو بآخر. وهنا يكمن الفرق، كل الفرق، بين الإستقلالين.
التحوُّلُ الأساسي الذي أحدثه 14 آذار 2005 كان تحوّلاً من طبيعة ثقافية – أخلاقية. لقد أطلق استشهاد رفيق الحريري دينامية مصالحة مدهشة لدى كل لبناني مع نفسه ومع الآخر. إن جوهر تلك الظاهرة، التي لم يقدّر أحدٌ مداها في حينه، لا ينتمي إلى حقل السياسة، بل إلى نظام القيم ومرتبة الأخلاق. ذلك أن تلك الصحوة الوجدانية أعادت اللحمة إلى مجتمع عصفت بتضامنه وقطّعت أوصاله حربان متواليتان، ساخنة (1975 – 1990) ثم باردة (1990 – 2005)، فصيّرته مجرّد رُكام من أفراد مشتتين وغير قادرين على التضامن والفعل.
لقد شهد 14 آذار إذاً، وللمرة الأولى في تاريخ لبنان، انبعاثَ هوية وطنية لبنانية لا تُحدِّد مضمونها طائفةٌ بعينها؛ هوية جامعة تتجاوز الانتماءات الطائفية من دون أن تلغيها؛ هويةٌ من شأنها أن تُعيد إرساء العيش المشترك على شروط الدولة الحاضنة لجميع اللبنانيين لا على شروط قوى طائفية سياسية معينة.
انبعاث هذه الهوية الوطنية الجديدة عبَّر عن نفسه بولادة رأي عام مدني، وازن ومستنير، ربما أيضاً للمرة الاولى في تاريخ لبنان. وهو أمرٌ في غاية الأهمية لمستقبل الوطن، لأنه أدخل بُعداً جديداً كل الجدّة على الحياة السياسية التي كانت حتى ذاك محكومة بعمليات التحالف والخصومة والنزاع في ما بين زعماء الطوائف وأعيان المناطق.
هذا الرأي العام غير طائفي، لأنه غير قابل للإختزال في طائفة بعينها. لكنه أيضاً ليس علمانياً، لأنه لا يضع الهوية الوطنية في مواجهة الانتماءات الطائفية والمناطقية. إنه رأيٌ عام مدني، وهو بذلك أكثر حداثةً وانفتاحاً من الطبقة السياسية التي تحاول تمثيله وتواصل في الوقت نفسه إعطاء الأولوية المطلقة لـ”حقوق” الطوائف، أي عملياً لقيمومتها هي على تلك الحقوق.
هذا الرأي العام مستقلٌ بطبيعته، بمعنى أنه لا يشكل احتياطياً ثابتاً لحزب بعينه، بل يمنح تأييده لكل اداء سياسي منسجم مع تطلعاته، ويمنعه عن أي أداء مخالف. لذلك فإنه لا يخضع لمنطق توازن الرعب الذي يحكم العلاقة بين القوى السياسية. فسلاحه هو اللا عنف!
حاولت القوى العقائدية من دينية وطائفية تهميش هذا الرأي العام والعودة الى المنطق الذي كان سائداً قبل انتفاضة الاستقلال. كلفة هذا الأمر كانت باهظة؛ إذ باتت البلاد منقسمة انقساماً يصعب تخطيه، والدولة مشلولة شللاً كبيراً، وخطر الفتنة يزداد يوماً بعد يوم.
الطريق نفسها يسلكها “الأخوان” في مصر. فهم ارتكبوا خطأً جسيماً عندما تصرفوا كأنهم أصحاب حق مطلق، فحاولوا الحصول على صلاحيات وصفها أحد المعلقين بـ”السلطانية”، الأمر الذي تسبب بانقسام المجتمع نصفين متقابلين، وهو انقسام أكدته نتائج الاستفتاء حول الدستور الجديد الذي نظمته السلطة.
فاذا كان من حق “الأخوان المسلمين” في مصر الامساك بالسلطة نتيجة انتخابات نيابية و/ أو رئاسية شارك فيها المصريون بوصفهم مواطنين أفراداً، فليس من حقهم الإمساك بالدولة وتغيير طبيعتها استناداً الى مشروعهم الخاص من دون توافق المجتمع بكل مكوّناته الأساسية. إن أكثر ما يعبّر عن هذا التوافق المجتمعي، بصيغة قانونية تعاقدية، هو الدستور. لذا ينبغي ان يعكس الدستور هذا التوافق المجتمعي، وليس من شأنه التعبير عن ميزان قوى سياسي متغيّر بطبيعته، مثلما لا يحقّ له التعبير عن فئة واحدة في المجتمع، خصوصاً إذا كانت جماعة حزبية.
الى ذلك لم يدرك “الاخوان” أمرين اساسيين:
الأول أن معارضيهم اليوم “هم الذين أنهوا الحكم السابق بكل قوته وجبروته وواجهوا بطشه ورصاص جنوده”. لم يتراجعوا في الأمس ولن يتراجعوا اليوم.
الثاني أن من الصعب جداً الارتداد على هذا التحول التاريخي الذي أحدثه الربيع العربي والاستعاضة عن ديكتاتورية “علمانية” بأخرى “دينية”. للتذكير فقط، فقد جرى منذ سقوط حسني مبارك تأسيس ما بين 6 و10 آلاف جمعية غير حكومية.
إن التحدي الذي يواجه الحركة الاسلامية هو في الخروج من التقابل بين الاسلام والديموقراطية وابتكار “طريق اسلامية” نحو الديموقراطية شبيهة بـ”الطريق المسيحية” نحو الديموقراطية التي تجسدها اليوم الأحزاب الديموقراطية المسيحية في اوروبا. المهمة ملحة نظراً إلى التحديات التي تواجهها على أكثر من صعيد، ولاسيما الصعيد الاقتصادي- الاجتماعي، والتي تتطلب إعادة الوصل مع مكوّنات المجتمع الأكثر تطوراً وانفتاحاً.
آفاق الديناميكية الجديدة التي أطلقتها مصر بثورتها على الإسلاميين
دلال البزري
سواء رست الديناميكية المصرية الجديدة على “انتصار” ما للإسلاميين، أو “تفاهم” ما مع الجيش، أو “تسوية”، أو حتى أزمة مفتوحة، فإنها، أي الديناميكية، وبسبب طبيعتها الجذرية، قد استهلت عهداً لن يغلقه ولا واحد من هذه الاحتمالات: فتحت أبواب جهنم على دعاة الاسلام السياسي، الذين صاروا تحت النظر والحساب. وهذه آفة الآفات بالنسبة إلى أناس يتلخص قولهم بـ”هذا ليس كلامي… إنما كلام الله”. انكسر احتكارهم للدين، وباتوا، مثلهم مثل أي فصيل “دنيوي”، تؤخذ عليهم قلّة دينهم وقلّة أخلاقهم، الموثقَين، فضلا عن قلّة مهارتهم وتدبّرهم السياسي أو الاقتصادي؛ على الرغم من كل الأحابيل التي أدمنوا نسجها بمهارة تتناقض وإنعدام درايتهم هذه للشؤون الأخرى.
إنها إرهاصات الثورة المصرية الثانية. هذا هو مصيرها، أن تأتي بعد الثورة الأولى. هي كانت متوقعة، هذه الثورة الثانية، الدينية. ولكن مبكرة؟ هكذا؟ بهذه السرعة؟ فقط بعد ستة أشهر من تولي الاسلاميين السلطة؟ القدر، أو التاريخ، ساعد على ذلك، بحرب إسرائيل على غزة، وبالدور “القيادي” الذي لعبه الرئيس المصري “الإخواني” في بلوغ وقف النار، ثم إمعان الاميركيين بالتغزّل به، والباقي نعرفه. ركب مرسي عقله وأصدر “الدستور المكمّل” الذي فجّر ما شاهدنا.
أما عن دور الثورة الأولى في إذكاء الثانية، فأمره أعقد. ربما لا نلمّ الآن إلا بقدر منه: أوله، ان الثورة الأولى أشاعت فكرة “سلطة الشعب”، لا “سلطة الشريعة”. خصوصا تلك التي كشف الاسلاميون الآن انهم في صددها، وبعضهم بإلحاح شديد؛ والتي تعتمد على تفسير فقهاء غادروا هذه الدنيا منذ قرون. ببساطة، ما حاول الاسلاميون فرضه من قوانين ودساتير وإجرءات بإسم الله، صراحة أو مواربة، في وسع المواطن المصري أن يحتجّ عليها الآن باسم الثورة نفسها التي أتت بهؤلاء الى الحكم. سلطة الشعب، الديموقراطية، الثورة، رفض الاستبداد. هي كلها ثمرات الثورة الأولى.
ثمرتها الأخرى، هي إسقاط المنظومة الفكرية التي قامت في ظل مبارك، والتي اعتمدت على تعميم نوع من التقوى، أو بالأحرى نوع من النفاق الديني، كان كالحصن الإسمنتي ضد كل مكاشفة أو نقد حقيقي، ناهيك بتمرّد، أو ثورة. كانت مصر وقتها محكومة بمظلة حديدية، تحرمها من تنفس الهواء النظيف؛ صنعها النظام بالتواطؤ مع الاسلاميين. مكاسب هذه المظلة توزعت بينهما، ربما بالتساوي: للنظام المكسب الأمني، وللإسلاميين المكسب الايديولوجي، الذي تعمْلق قبل الثورة. أول ما فعلته هذه الأخيرة، أي الثورة الأولى، انها حفرت ثغرة في هذه المنظومية “الايمانية”. وهذه واحدة من المفارقات التي تضجّ بها الثورات العربية: الثورات العربية التي أوصلت الإسلاميين الى الحكم، أفقدتهم في الآن نفسه مقومات هيمنتهم الفكرية. أو، إذا تواضعنا قليلا، قلنا إن ما بعد الثورة وضع الأسس التي بموجبها سوف يفقد الاسلاميون هيمنتهم. في كلتا الحالتين، فان إرهاصات الثورة الثانية، مهما كانت خواتمها، سوف يكون لها لاحقاً آثار بيّنة.
قد تخبو قليلا ديناميكية هذه الثورة، أو قد تشتعل، أو تعتدل، أو تندفع، أو تفْتر، لكنها انطلقت… وسوف تولّد سجالات، وتستأنف نهضات، وتتفاعل مع دقة المعطيات، وتمتحن فيها واقعية الطاقات الجديدة، أو المتجددة. وكلها مقومات صراع فكري- سياسي طويل، يومي، معقّد، غير متساوي اللحظات، ولا متشابه الأواسط، وربما النهايات. لكنه سوف يكون مخترعاً نموذجه الخاص، ذا لغة مطابقة، بإرثه وتاريخيته ودينه. لا يحتاج وقتها الى نماذج، شرقي أو غربي، إلا على سبيل التثاقف.
على كل حال، لا نأمل أثناء هذه السنوات غير شيء واحد: أن لا يكون هذا الصراع غارقاً في دماء لاعبيه أو دمار أرزاقهم. مجرّد أمل.
أما على المدى المتوسط، فإن آثار إرهاصات هذه الثورة الثانية ذات إمتدادات متنوعة، نختار هنا أكثرها وضوحاً:
على تونس اولاً، حيث يسود ما يشبه الحالة المصرية، ولكن محوره القضايا الاجتماعية، الصراع بين حزب “النهضة” الاخواني والاتحاد التونسي للشغل. معطوف على سلفيين منفلتين، ترخي معهم “النهضة”، ثم تشتدّ. التباس مفجر لصراع شبيه، وخصوصا ان “المرشد الأعلى للدولة التونسية”، الشيخ راشد الغنوشي، بدأ طوقه يعمّ، فيما فشلت كل جهود الرئيس اليساري المنصف المرزوقي، شريكه الوهمي، الذي لم يتقدم فكريا أونصة واحدة في دأبه لإثبات “توافق الإسلام السياسي مع العلمانية”.
على سوريا ثانياً، حيث تصطدم ثورتها ضد الديكتاتور بسدّ هائل عماده “إخوان مسلمون” وسلفيون و”جهاديون”. هو نفسه السدّ الذي احتمى خلفه أصدقاء بشار الأسد وأقلامه، كذريعة لتهشيم الثورة معنويا وإفراغها من صدقيتها. الآن جاءت الهِبة من مصر: هناك مراحل تكاد تقول. الاولى، بإسلامييها، لن تدوم. لكنها مستمرة، لأنها شرط أساسي من شروط تعطيل الفعل السلطوي الاسلامي المقبل، المعنوي والمسلح. شرط من شروط ولوج الثورة الثانية.
على النساء العربيات ثالثاً: الكثيرات من بينهن رأين في الإسلام السياسي خطراً على القليل من مكتسباتهن السابقة على الثورة. يرصدن فتاويه ورواياته وأقواله وأفعاله، يلتقطن إشارة من هنا وأخرى من هناك. غير راضيات عن عدم رضاهن من الاسلاميين، يحاولن التمسّك بالأمل، حباً بالثورة وطلباً للسلامة وكرهاً للشك. لكن الإنفجار المصري ضد مشروع الدستور الإسلامي، الذي استشرس “الإخوان” والسلفيون للتصديق عليه، كشف كل الألاعيب التي تشعوذوا بها أمام الاعلام، خصوصا الغربي، “الموثوق به”، حول “وسطيتهم” و”اعتدالهم” و”دفاعهم عن المرأة”. كشف انقضاضهم، ليس على المرأة فحسب، إنما ايضا على الطفلة. مشروع الدستور الاسلامي وردود الفعل عليه، أعطى دفعة فكرية للنساء، بأن منحهن الحرية المطلقة من الآن فصاعدا في التفكير في الفكر الاسلامي. المعركة المصرية ضد الدستور الاسلامي كانت مثل ضوء فاصل، يشير الى أرض المعركة التي ينبغي للنساء استكمالها. هنّ بالذات، لأن الخطر الاسلامي عليهن أشدّ. مثلهن مثل الاقباط، رابع المستفيدين من الثورة الثانية، فان حكم الاسلام السياسي بالنسبة إليهن هو إلغاء لوجودهن. وحدة حال الاثنين، النساء والأقليات، يعود فضلها الى الأسس الثابتة لنظرية فصائل الاسلام السياسي، القائمة على تهميشهما.
نقطة اخيرة: اعتادت مختلف تنويعات هذا المزيج الحداثي على تفادي المسألة الدينية، أو على تناولها بحذر شديد، او اعتماد بعض ألفاظها، أو شعائرها، أو قراءتها بعبارات أقرب الى النفاق الديني. في عصر مبارك كان يُقصد بهذا السلوك الذهني حماية النفس من مضاعفات تكفير أو تشهير أو إساءة سمعة. أما الآن، وبعد كل الذي حصل، صار الإهتمام بالمسألة الدينية، بكل أوجهها، من صميم السجال المقبل.
مرةً أخرى، نحن نصِف هنا عملية مديدة، المطلوب منها ان تغيرنا بالقدر الذي سوف يتغير به الاسلاميون. حنيئذ، فقط حنيئذ، يمكننا التكلم عن اتجاه “ديموقراطي مسلم”، على غرار “الديموقراطي المسيحي”، التي حكمت أحزابه بعض دول أوروبا من دون ان يعيدها الى محاكم تفتيش الضمائر والتكلّم باسم الله. إسلامية سياسية تكون مرّت بمخاضنا نفسه، وأعطت التاريخ شأنه، فكانت قراءتها للشريعة اكثر توافقا مع نفسها، قبل ان تكون مع غيرها.
هل نحلم؟
هل يمكن حماية الثورات؟
منى فياض
بداية أود التعليق على تعبير “نحن كمثقفين”. من نحن هذه؟ في ظل التغيرات الجذرية الحاصلة هل يشكل المثقفون جسماً واحداً متجانساً ينفعل ويتخذ مبادرات او مواقف متماثلة تجاه حدث او قضية او ما شابه؟ للمثقفين اتجاهات ومواقف وآراء متباينة ومتناقضة ومتعارضة، فهم ليسوا كتلة متراصة على غرار الاحزاب الدينية الفاشية السائدة. لكن يظل للتساؤل مبرره، إذ إن سؤالاً فرض نفسه تجاه الاحداث الاخيرة في مصر: ما هو موقف الجسم القضائي من قرارات الرئيس المصري؟ هنا قد لا ننتظر اجابة واحدة من هذا الجسم بل متعددة وقراءتنا لها هي التي تسمح ببلورة موقف او بتوضيح الصورة. من هذا المنظار يحق طرح السؤال نفسه عن المثقفين. الطبيعي في الحالتين، وفي غيرهما، بروز التعدد في الاتجاهات أو حتى تناقضها.
غالباً ما كان المثقفون – ويكونون- مع السلطة. من هنا صفة “مثقفي السلطان”. المثقفون الذين كانوا مع الضعفاء في التاريخ قلة.
برهنت الثورات العربية أن المثقف العربي بشكل عام، ما عدا قلة قليلة، لم يكن في الطليعة؛ ونجوم الثقافة وابطالها لم يتوقعوها. على الأقل في ما يخص المثقف – النجم التقليدي. بيّن الحراك الحاصل منذ بدايات العام 2011 ان الفئات الشابة المتعلمة والمعولمة من الطبقة الوسطى هي الوسيط المحرك الذي ساعد على تفجير الثورات وليس المثقف التقليدي، الذي ربما أخّر أو حتى أعاق تطوير آليات مساعدة على التغيير. الكثير منهم كان قد التحق بالأنظمة البائدة واستفاد من فنادقها وجوائزها ودافع عنها. بلغ تزيين الاستبداد والدفاع عنه حد اختراع صفات للتخفيف من بؤس العيش تحت سلطانه الغاشم، من مثل القبول بالمستبد لعلمانيته هرباً من الاصوليات (المضحك المبكي أن من يدافع عن علمانية مثل هذه الأنظمة هو نفسه من يدافع عن حركات أصولية في سياق آخر مقاوم!). أو اللجوء الى الشعار المخاتل مثل الممانعة وما شابه.
المرحلة الراهنة لم تعد مرحلة “المثقف النجم” التي يمثلها بامتياز أدونيس وكلنا يعلم مواقفه ومهادنته الطويلة للنظام “العلماني”، “العلوي” للمناسبة، واستسهال انتقاد الله والدين لسهولة النجاة من القصاص (الدنيوي مثلا!) والامتناع عن توجيه أي نقد علني للنظام المستبد. إذاً هذه المرحلة ليست مرحلة “المثقفين النجوم” الذين فقدوا دورهم وبريقهم مع ذهاب الأنظمة الحاكمة. لا دور للمثقفين الآن إلا بمقدار انتمائهم الى التحرك الثوري الجاري في العالم العربي والمساعدة على التخلص من آثار المرحلة الماضية والنضال المتواصل ضد المستبدين الجدد المختبئين تحت عمامة الدين، وتحمل تبعات ذلك.
الانحياز الى الشعوب التي برهنت عن طفرة من الوعي غير المسبوق، يفرض نفسه هنا، بعدما اعتبرت طويلاً ميؤوساً منها وبعدما برزت تنظيرات سادت لبرهة من الزمن عن “العقل العربي” الجامد بتكوينه. والانحياز الى الجيل الشاب الذي استوعب معنى الحق في المطلق، الحق في الحرية والحق في الكرامة بمعناها الانساني الشامل، أي الحق في التمتع بالحقوق الانسانية الأساسية بحسب ما تنص عليها شرعة حقوق الانسان. والحق في الحرية بمعناها الرمزي والفعلي. الأرجح أن يبلور هذا الجيل الأمور بطريقة خلاقة تتخطى القيم التقليدية المعيقة في الثقافة العربية. الجديد المهم على الصعيد الثقافي أن حركات الاحتجاج الشعبية اثبتت الشرعية الاخلاقية والاستراتيجية للنضال غير العنفي.
الجماهير استفادت من تجارب الشعوب. ففي وقت نجد الكثير من “مثقفينا” يدافعون عن النظام الوحشي الدموي في سوريا ومن خلفه حليفته إيران لمصالح غالباً ما تكون مادية ضيقة، نجد أن الشعوب العربية استفادت من تجربتها مع حكامها الذين امتهنوا كرامتها ووجودها من خلال قوانين “طوارئ” دامت لعقود وعقود!
لذا نجد أن الشعب المصري العظيم الذي على أكتافه سوف يتحدد مصير الثورة المصرية ومستقبل الثورات العربية، لم تنطل عليه حيل الرئيس “الإخواني” في أنه يطلب السلطات شبه الإلهية لفترة آنية. سلطت قرارات الرئيس مرسي المفاجئة وإعلاناته الدستورية الضوء على مدى هيمنة جماعة “الإخوان” على آلية صنع القرار السياسي في البلاد، وتسبب إصرار الجماعة على إجراء الاستفتاء على مسوّدة دستور غير توافقية، موجة رفض عارمة خوفاً من أجندة الجماعة الضمنية وانعدام الثقة في مدى قبولها بدولة مدنية ديموقراطية تستوعب تنوع المجتمع المصري بكل مكوناته، ما يهدد بتغيير هوية مصر التعددية فتصبح دولة دينية تخفي تحكم “ولاية المرشد” على شكل “ولاية الفقيه” في النموذج الشيعي الإيراني.
يبدو إن هذا أكثر ما يخيف المصريين، أن يغمضوا أعينهم ويفتحوها ليجدوا أنفسهم تحت نظام إسلامي متطرف من النوع الذي شكله آية الله الخميني في إيران منذ 33 سنة. والذي لم ينتخبه الشعب الإيراني رئيسا أو مرشدا أعلى. كان قد وعد الناس أنه سيترك السلطة للشعب بعد نجاح الثورة وسيذهب إلى قم لمتابعة مهنته في التدريس هناك. لكن ما حدث أنه بقي في السلطة ومنح نفسه صفة “الولي الفقيه”. الثورة الإيرانية لم تنفذ وعودها. وعلى غرار ما يفعل “الاخوان” في مصر، تم إعداد الدستور في إيران بسرعة ولم يجد الناس المتحمسون فرصة كافية لقراءته بعناية، والذين قرأوه وأرادوا أن يعبّروا عن آرائهم المختلفة كانوا يعتبرون معادين للثورة. الدستور الإيراني بعد الثورة كتبه أنصار الخميني، وكان الخيار الوحيد المتاح للناس أن يصوتوا بـ”نعم” أو “لا” على الدستور. لم يكن هناك مجال لاقتراح أي تغييرات. وبعدما نجح الدستور في الاستفتاء بنسبة 99 في المئة أمر الخميني باعتقالات وإعدامات على نطاق واسع بهدف تصفية وتشتيت المعارضين للثورة الذين تجرأوا على النزول إلى الشارع للاحتجاج على زيادته لسلطاته.
كانت الثورة في إيران إنجازا حققته جماعات مختلفة اتحدت على هدف واحد، كما حدث في مصر، وهو إطاحة الاستبداد. لكن سرعان ما اختُطفت الثورة واستغل الخميني محبة الناس له للتخلص من معارضيه وتأسيس أول حكومة إسلامية متطرفة في المنطقة. وهذا ما يحاول تكراره الرئيس مرسي.
ثم ما قيمة دستور لا يؤمن استقرارا للبلاد؟ وما قيمة دستور يقسم المصريين؟ والأخطر ماذا سينتج من الاستفتاء من عدم استقرار وعنف؟
لكن المصريين تعلموا الدرس وهم واعون تماماً أن ثورتهم لم تنته بمجرد إجراء انتخابات رئاسية ديموقراطية. وهم يرفضون الادعاء بأن الصلاحيات المطلقة التي يطلبها “آنية” فقط، لأنهم صاروا يعرفون تماماً أنه لا يوجد ديكتاتور موقت. كل الحكام المستبدين زعموا أنهم مضطرون الى إجراءات استثنائية بشكل موقت ثم استبدوا بالسلطة الى الأبد.
من إيجابيات الانقضاض السريع والشراهة الاخوانية للهيمنة على مصر، أن هذه الممارسات تقدم نموذجاً لما يمكن أن تسفر عنه ممارسات القوى الإسلاموية في دول الربيع العربي في مرحلة التحول الديموقراطي وبناء مؤسسات الدولة، التي تعني لهم عملية بناء دولة تسلطية باسم الدين الاسلامي، تؤمن بالانتخابات وتحترم نتائج الصندوق من دون أن تحترم بقدر مماثل حقوق الأقليات، والفصل بين السلطات.
إنها ممارسة شكلية للديموقراطية جوهرها فرض الإذعان والقبول بدستور هو محل خلاف لكنه يؤسس لدولة إسلامية على غرار دولة “ولاية الفقيه”، من خلال استخدام براغماتي لأدوات ديموقراطية، ولغة مزدوجة، ووعود فارغة وفهم مغلوط لمفهوم الأغلبية نفسه بحيث يساء تفسيره. من حق الأغلبية إدارة الحكومة إذا فازت، لكن لا يحق لها أن تفرض أحكامها على الجميع. هناك فارق شاسع بين الحكم والحكومة. تستطيع الأغلبية إدارة الشؤون العامة المتغيرة وفق أنظمة ثابتة. وهنا الفارق بين الجماعات الفاشية والديموقراطية. الأغلبية في نظام ديموقراطي تدير شؤون الدولة في إطار نظام يقوم على توازن السلطات، ووفق الدستور الذي يفترض أنه توافقي ويمنح الجميع الحقوق نفسها ويحمي الأقليات وكل القوى التي يتشكل منها المجتمع.
أمام ممارسات “الاخوان” يصبح من الطبيعي ان ينقسم المجتمع المصري حول نزعة الانفراد والهيمنة للإسلامويين، وان تتضخم مخاوف القوى المدنية والمسيحيين من احتمال أن تكون الانتخابات التي أتت بالرئيس مرسي هي الأخيرة. لكن مناخ الربيع العربي وانطلاق سيرورة التغيير العميقة يمنعان تكرار تلك النماذج. إن الطبقة الوسطى العريضة والقوى الشبابية النشطة التي راكمت خبرات نضالية خلال معاركها خلال العامين المنصرمين، يضاف إليها إعلام قوي مستقل عن الدولة، ونظام قانوني وقضائي مستقر ونخبة قضائية ذات تكوين مهني عريق، قادرة على النضال الطويل من أجل حماية الثورة.
غلطة “الإخوان” تأتي من عدم إدراكهم أن مصر قد تغيرت وانتقلت خطوات بعد الثورة في اتجاه الحرية والكرامة الإنسانية على مستوى الإحساس الداخلي عند كل فرد. انها معركة مستقبل مصر بين “الإخوان” وبقية الوطن. ومن ينتصر في هذه المعركة سيرسم ملامح مصر المستقبل. وهذا ما سوف يؤثر في مختلف أنحاء العالم العربي.
على كل حال يبدو أن لممارسات “الاخوان” في مصر إيجابية الدفع نحو استيلاد الكتلة المدنية الليبيرالية في وجه ممارسات الاستبداد العائدة باسم الدين. وإظهار أن قوة هذه الكتلة لا تأتي من تنظيمها، بل من قوة تمثيلها الفعلي لأكثر من نصف الشعب الذي ما عاد يرضى لا بالديكتاتورية العسكرية ولا بالديكتاتورية الدينية. هذا النصف يتضمن أيضاً المتدينين الاسلاميين المنفتحين والمعتدلين الذين يريدون إسلاما ليبيراليا يعتمد الفكر المتسامح والمنفتح. وكلما تبلور وعي هذه الفئات بنفسها ككتلة تاريخية ذات وزن وحاولت تنظيم نفسها وبلورة برامجها السياسية الموحدة ورؤيتها المشتركة، نجحت في تغيير التاريخ والتعجيل في بلوغ أهداف الثورات التي اندفعت مثل طوفان في العالم العربي، والتي ستنتصر على المديين المتوسط والطويل مهما تكن الأكلاف. النموذج البطولي السوري النادر ماثل أمام أعيننا.
الانتفاضات العربية وأوهام الدولة الدينية
مسعود ضاهر
تثير إشكالية الدين والدولة في زمن الانتفاضات العربية نقاشاً حاداً بسبب الصراع بين القوى السياسية التي تحالفت لإسقاط بعض الأنظمة العربية ثم تباعدت إلى درجة احتلال الساحات العامة المتقابلة التي تضم مئات الألوف من المناصرين من الجانبين، وهم يرفعون شعارات متعارضة تماماً.
تشهد الحياة الثقافية العربية اليوم صراعا حادا بين تيارين ثقافيين كبيرين إنطلاقا من رؤية متناقضة حول طبيعة الدولة التي ستتمخض عنها الانتفاضات الشبابية، وتبيان مدى شرعيتها وقدرتها على التغيير، فانخرط عدد كبير من المثقفين العرب لتوضيح علاقة الدين بالدولة على المستوى العربي العام. وقد آن الأوان للخروج من دائرة مقولات استشراقية تصف المجتمعات العربية وفق منظار طائفي ومذهبي وقبلي.
على رغم الضجيج الكبير حول النزاعات الطائفية والقبلية الجارية في الدول المنتفضة، اثبتت تلك النزاعات عدم قدرتها على وقف الإرهاصات الثورية التي تتفاعل داخل الوطن العربي. ووقف مثقفو الطوائف مشدوهين أمام تطور الانتفاضات التي أسقطت أربعة أنظمة عربية خلال عام واحد.
هناك سجال ثقافي حاد حول إشكالية الدولة والدين في العالم العربي، بعيدا من الرؤية الثقافوية السائدة حول صراع السنّة والشيعة، والإسلام والمسيحيين، والعرب والأكراد والأمازيغ، وغيرها من مقولات توصيف الانتفاضات ونشر اليأس من قدرتها على الاستمرار والتغيير.
طُرحت إشكالية الدين والدولة في الدول المنتفضة من موقع إسلاموي يريد أنصاره تطبيق الشريعة الإسلامية، مقابل قوى ديموقراطية وعلمانية وليبيرالية ويسارية متنوعة ترفض أوهام الدولة الدينية وتتمسك بدستور عصري لدولة مدنية أو علمانية تتبنى الديموقراطية، والحريات العامة والفردية، ودولة المؤسسات وفصل السلطات، وإستقلال القضاء.
فالانتفاضات الشبابية غير مسبوقة في تاريخ العرب الحديث والمعاصر. وقد أحدثت هزة سياسية كبيرة من حيث النوعية والفاعلية والانتشار. ولا يجوز أن تُقرأ بمنهجية وفق مقولات استشراقية لم تنتج معرفة حقيقية حول ما يجري داخل الوطن العربي.
ليس من شك في أن الموروث الإسلامي عميق الجذور في التاريخ العربي، وقد تميز بنوع من التداخل بين مفهومي السلطة والدولة. فصاحب السلطة هو الملك أو الفرعون أو الإله في مصر، وبلاد ما بين النهرين، وبلاد الشام. الدولة في زمن الخلافة الإسلامية هي دولة الرسول ومَن خلفه في حماية الدين وسياسة الدنيا. ثم دخلت مفاهيم غير إسلامية على الخلافة متأثرة بالتيارات الشعوبية والجماعات الإسلامية غير العربية، فتحولت دولة سلطانية أو شاهنشاهية، وتم التنظير لها من خلال الأحكام السلطانية أو ولاية الفقيه.
على الجانب العربي، بقيت السلطة في الولايات العربية التي خضعت للمماليك ثم للعثمانيين تنبني على العصبية القبلية وفق الأطوار التي تميزت بها بحسب المفهوم الخلدوني. فهي دولة الأسرة الواحدة، أو المشيخة الوراثية، أو السلالة الواحدة. ولا تزال تعتمد على الوراثة، ومجلس الشورى داخل العائلة في معظم أقطار الخليج العربي. في حين بنيت دولة المخزن في المغرب العربي على سلالات دينية تخرج عن طاعتها أحيانا “دولة السيبة”، أي دولة المناطق السائبة والخارجة عن سيطرة الدولة المركزية. كانت أبرزها دولة الموحدين التي تبنّت الخلافة المستندة إلى عصبية دينية متوارثة بحيث تتداخل الخلافة بالدين الإسلامي وفق منظومة قيم ثقافية واقتصادية وسياسية إسلامية. وتبلورت حديثا دولة الشوراقراطية التي تعتمد العصبية الدينية المنفتحة، وتحاول المواءمة بين مفهومي الشورى الاسلامي والديموقراطية الغربية، بالإضافة إلى الدولة الطائفية على النمط اللبناني وأخيرا العراقي، التي تعزز ركائز الطائفية والمذهبية في الممارسة السياسية والإدارية والاجتماعية.
توصيفات الدولة العربية
في القرن العشرين
الدول العربية هي دول ريعية حافظت على كثير من تقاليد القمع الموروثة من مرحلتَي الحكم العثماني والسيطرة الأوروبية. واحتكرت القيادات السياسية فيها السيطرة على مؤسسات الدولة ورعاياها، وحافظت على استمرار الدولة الريعية كنظام سياسي يخدم مصالحها في الدرجة الأولى. ووظفت الطائفية والقبلية في الثقافة السائدة كإيديولوجيا مجرّبة لتشويه الوعي الوطني والاجتماعي لدى الجماهير العربية.
استمرت الدولة القبلية فاعلة بقوة في مجتمعات عربية انتقلت من البداوة إلى الدولة الحديثة. لكن الوعي الديني أو القبلي المؤدلج لم ينتج سوى نظام سياسي مفكك، ودولة قمعية تتخفى وراء حجاب قبلي أو ديني لم يعد قادرا على إخفاء الوجه البشع للطبقة السياسية المسيطرة. وتحولت القبلية السياسية إلى ديموقراطية قبلية، أو دولة ديكتاتورية بقيادة الحاكم العسكري أو القائد الواحد. وارتكزت دولة البدو، أو دولة البدوقراطية، على الذهنية القبلية حيث لا يستقيم دين إلا بجماعة قبلية، ولا تحكم جماعة إلا بالعصبية الدينية وفق المفهوم الخلدوني. فأقامت تحالفات المصلحة القبلية على العصبية القبلية، وزواج المصلحة، بالإضافة إلى استخدام العصبية الدينية لشد أزر الجماعة القبلية. فلم تعد العصبية القبلية مجرد ارتباط قائم على وحدة الدم بل باتت لها وجوه عدة، دينية، وقبلية، وسياسية، واقتصادية، وغيرها. وتعود صلابة الذهنية القبلية المتجددة إلى قوة الموروث القبلي التاريخي، إلى جانب منظومة القيم الأخلاقية المتقاربة بين أفراد القبلية والتنظيم السياسي القبلي المبني على زعامة سياسية متوارثة في القبيلة والعشيرة.
ولا تزال الذهنية القبلية تعوق التفاعل الإيجابي مع الثقافات العصرية وبشكل خاص الثقافة الديموقراطية على اختلاف تجلياتها. ففشلت دولة الديموقراطية الشعبوية على الطريقة الليبية، ودولة الديموقراطية التوافقية على الطريقة اللبنانية، ودولة الشوراقراطية في أنظمة عربية حاولت الجمع بين ذهنية البداوة ونظم الإسلام السياسي.
مشكلات بناء الدولة الديموقراطية في زمن الانتفاضات الشبابية
يحتكر الغرب صفة الديموقراطية السليمة لنفسه. لذلك يؤكد منظّروه أن الانتفاضات العربية فشلت في تبنّي الديموقراطية على الطريقة الغربية، وسخرت الإنتخابات الشعبية لإبقاء ركائز السلطة القديمة، وتبنّت ثقافة التبرير على حساب ثقافة التغيير الجذري والشامل، فاستمرت الدولة الريعية في العالم العربي تولد نزاعات طائفية ومذهبية وقبلية، وتقسم مغانم السلطة بين زعماء الطوائف والقبائل. لم تنبن علاقة المواطن العربي الحر بالدولة العصرية على أسس حقوقية، وهي تتطلب إقامة حكم القانون وبناء دولة المؤسسات. تعاملت الدولة العربية الحديثة ذات الخلفية القبلية أو الطائفية مع السكان كرعايا يتبعون زعماء الطوائف والقبائل وليس كمواطنين أحرار ينتمون إلى دولة ديموقراطية تعتمد المواطنة، والكفاءة الشخصية، والشفافية، والمساءلة، والمساواة أمام القانون في الحقوق والواجبات دون النظر إلى العرق، أو اللون، أو الانتماء السياسي، أو الديني، أو القبلي.
لا تزال الدولة التسلطية في الدول العربية تعيد إنتاج تلك الركائز، وتسمح للطبقة السياسية الحاكمة باستغلال السياسة والدين من دون أن تخضع للمساءلة والمحاسبة والعقاب. وتصنّف القيادات السياسية الحاكمة في دولها بأنها قوى سلطوية تعتبر نفسها فوق الدولة لأنها عاجزة عن محاكمتها، أو الحد من نفوذها، أو معاقبتها. تحولت التعددية الدينية وتنوع الجماعات العرقية والقبلية إلى معوقات بنيوية تحول دون توحيد المجتمع وتجانسه إلا في إطار دولة القانون والمؤسسات التي تشكل أداة فاعلة للتوحيد السياسي والوطني الشامل.
في ظل هيمنة الإيديولوجيا العصبوية المستندة إلى العرق أو الدين أو القبيلة، سيطرت ثقافة العصبيات السائدة على امتداد الوطن العربي. وهي تخدم، في الدرجة الأولى، طبقة سياسية فاسدة تقودها بورجوازية ريعية بشرائحها المتعددة، وتكرس الدولة القمعية نظاما استبداديا يتلاءم مع سيطرة الرأسمالية الريعية على العالم العربي. تشكل هيمنة الوعي الطائفي والقبلي على الوعي الوطني ركيزة صلبة لإستمرار النظام السياسي الاستبدادي، وتأبيد الوراثة السياسية في العالم العربي. بعد نجاح انتفاضات الربيع العربي باتت الحياة الثقافية العربية تتوقع بروز مقولات علمية لبناء دولة ديموقراطية طالما حلم بها شباب الانتفاضات. ورفع المتنورون منهم شعارات عقلانية تدعو إلى بناء دولة ديموقراطية سليمة تقوم على العدالة الاجتماعية، والرفاه الاقتصادي، واعتماد الكفاءة الشخصية في مجال تولي الوظائف وإدارة شؤون الدولة بحس عال من المسؤولية. ورفضوا بصورة قاطعة كل أشكال الحكم الديني الذي يبقي المواطنين العرب في موقع رعايا الطوائف والمذاهب وفق ما تخطط له تيارات إسلامية، أصولية وسلفية.
بدأت انتفاضات الربيع العربي بتحالفات سياسية مرحلية على أسس غير واضحة، فطغى النضال اليومي زمن الانتفاضات على صلابة المواقف الاستراتيجية الداعية إلى التغيير الشمولي. وحين تمسكت القوى الشبابية بالعمل على بناء دولة ديموقراطية مدنية، ردّت القوى الإسلامية بالدعوة إلى تطبيق الشريعة الإسلامية، ونشرت شعارات شعبوية مقرونة بوعود كبيرة من دون أن تقوم بأي تغيير إيجابي لحل المشكلات الاقتصادية والاجتماعية. ووعدت جماهيرها بقيام دولة حديثة تطبق مبادئ الشريعة الإسلامية على مختلف الصعد. وتمسكت بالثقافة السائدة التي ساعدتها على الوصول إلى السلطة لتستخدمها في تأبيد سيطرتها السياسية عبر إصلاحات شكلية لا تمس بنية النظام السياسي القائم. ولم تفصح عن برنامج عملي يتضمن مقولات علمية موثّقة حول كيفية حل المشكلات القائمة بأدوات معرفية علمية وليس برغبات ذاتية. وتجاهلت شعارات القوى الشبابية والشعبية التي أطلقتها إبان انتفاضات الربيع العربي، ولا تزال تناضل بصلابة من أجل تنفيذها وصولاً إلى التغيير الشامل. ولا يزال شباب الانتفاضة يطالبون بقيام دولة المواطنة التي تساوي بين جميع المواطنين في الحقوق والواجبات من دون أي تمييز ديني، أو عرقي، أو قبلي.
تحاول القوى الإسلامية التي شاركت في الانتفاضات الشعبية إحلال نظام سياسي إسلامي مكان النظام التسلطي السابق. أدركت النخب الثقافية العربية على الفور أن عهد التسلط السياسي لم ينته بعد، فانتفضت القوى الشبابية والشعبية مجددا ضد القهر، والاضطهاد، والقمع، وطالبت بوضع حد لسياسة تغييب المعارضة والرأي الآخر. فالنظام السياسي الإسلامي المقترح لا يزال صعب المنال منذ قرون طويلة. وهو مفهوم ضبابي لم يستطع الداعون إليه تحديد طبيعة المؤسسات السياسية المرتبطة به وقدرتها على مواجهة عصر العولمة والتبدلات السياسية المتسارعة. ودلت ردود الفعل الشاجبة لقرارات الرئيس المصري أنها تهدد الوحدة الوطنية، وتستدرج تدخلات خارجية بالغة الخطورة تؤثر سلبا في القرار المصري المستقل. وبلغ التفكك الداخلي في المجتمعات العربية المنتفضة درجة متقدمة من الخطورة تحت وطأة العصبيات الطائفية والمذهبية والقبلية وغيرها. وقد تناولتها قوى المعارضة بالنقد البناء من موقع البديل الديموقراطي، والتغيير الشمولي. وحذرت من اعتماد سياسة التجريب السياسي واختبار شعارات شعبوية حول حكم سياسي يطبق الشريعة الإسلامية في مجتمعات عربية متعددة الانتماءات الطائفية والسياسية.
إن إصرار القوى الإسلامية التي تسلمت مقاليد السلطة السياسية في مصر وتونس على تطبيق الشريعة الإسلامية يفضي إلى نزاعات كبيرة بين السلطة والمعارضة قد تؤدي إلى عصيان مدني أو حرب أهلية. فالتظاهرات وحركات الاحتجاج، الشبابية منها والشعبية، تملأ ساحات المدن وميادينها. وهي تحذر من أخطار تغييب الحلول العقلانية للمشكلات القائمة، والاستعاضة عنها بشعارات شعبوية لا علاقة لها بالنظم الاسلامية.
تجدر الملاحظة إلى أن نسبة عالية من الجماهير العربية في الدول المنتفضة قد سلّمت مصيرها موقتا إلى أحزاب وقيادات انتهازية توظف الدين الإسلامي في خدمة مصالح شخصية وحزبية. وهي قيادات تفتقر إلى الكاريزما الشخصية والرؤى الثقافية الواضحة، فتروّج لشعارات شعبوية قادت في الممارسة العملية إلى صدامات واسعة في بعض الدول المنتفضة. في حين بقيت المشكلات الاقتصادية والاجتماعية الموروثة تزداد حدة وتدمّر الكثير من الطاقات البشرية والمادية في المجتمعات المنتفضة التي تواجه قوى المعارضة فيها ممارسات قمعية لا تقل شراسة عما كانت عليه في السابق.
عادت القوى الشبابية في الدول المنتفضة تبحث عن دور لها بعيداً من هيمنة الإيديولوجيا الدينية وشعاراتها الدوغمائية. وتفاعل المثقفون المناصرون لنجاح الإنتفاضات مع مواقف الجماهير الشعبية التي عادت إلى ساحات المواجهة بإصرار أشد على التغيير الشامل. فتعززت فرص التغيير الذي يتلاءم مع طبيعة التبدلات العاصفة التي يشهدها العالم العربي بكل تناقضاته. وبدا واضحا أن في الإمكان بناء مستقبل أفضل للشباب العربي في زمن حرية الكلمة والفكر المقاوم، ومشاركة الشباب في معالجة المشكلات التي تعانيها المجتمعات العربية واقتراح حلول عقلانية لها.
غيّرت الانتفاضات الشبابية وجه العالم العربي الذي استكان طويلا لتعسف أنظمة تسلطية وإستبدادية مدعومة من الخارج. وهي ترفض اليوم السكوت مجددا على تعسف السلطة السياسية، دينية أكانت أم مدنية أو عسكرية. ودعا قادتها للتمسك بالدولة الديموقراطية دون سواها، ورأوا أن من واجبهم تقديم نموذج عربي متميز في بناء حداثة سليمة لا تقود إلى التبعية للخارج، وأدركوا أن الحداثة السليمة تنبني على الإنسان الحر الواعي والمزوّد العلوم العصرية، وعلى نشر التكنولوجيا المتطورة وتوطينها لزيادة الإنتاج الاقتصادي. وتلعب مقولات الثقافة العقلانية والتغيير الجذري والشامل دورا مهما في تعرية الثقافة السلطوية السائدة، وأوهام النظام السياسي الذي يقوم على استغلال الدين لأغراض سياسية.
في الوقت عينه تكشّفت أهداف الإيديولوجيا الدينية التي تشكل العمود الفقري للنظام السياسي السائد اليوم في كل من مصر وتونس، وبدا واضحا أن الدعوة إلى قيام نظام سياسي على خلفية دينية وفق توجهات أحزاب الإسلام السياسي تساهم في تزييف الوعي السياسي لدى الجماهير الشعبية المنتفضة. في حين أن بناء الدولة المدنية بعد قيام انتفاضات الربيع العربي يشكل جامعا مشتركا بين الانتفاضات الشعبية العربية. وتدرك بحسها الوطني السليم أن تغييب الديموقراطية في الدول المنتفضة يقود حتما إلى قمع المعارضين من جميع الاتجاهات الليبيرالية والعلمانية والقومية.
ملاحظات ختامية
مع استمرار الذهنية الدينية، لا بل المذهبية الفاعلة بقوة في المجتمعات العربية المنتفضة، تنتفي كل أشكال الديموقراطية السليمة، فيهيمن زعماء الأحزاب الطائفية على المجتمع بإسم الدين، وزعماء القبائل بإسم العصبية القبلية. وتدخل الدول العربية المنتفضة في صراع جماعي بين قوى سياسية توظف الاسلام في السياسة وتصر على قيام دولة دينية، وقوى معارضة لها توافقت على بناء دولة ديموقراطية مدنية.
لا تزال العصبيات الدينية والقبلية حاضرة بقوة في المجتمعات العربية، ولا تزال الدولة الديموقراطية مفهوما ضبابيا في عالم عربي محكوم بالذهنية الدينية والقبلية. ومع إصرار القوى السياسية الحاكمة في دول عربية منتفضة على تطبيق الشريعة الإسلامية تراجعت مفاهيم الحرية، والوطن والمواطنة، والسيادة، وحقوق الانسان العربي الفرد. وباتت مؤسسات الدولة العصرية مهددة بالزوال، وعاجزة عن ممارسة الديموقراطة دون مشاركة الديموقراطيين في معركة شرسة لحماية أنفسهم ووطنهم. فإنتشار الوعي الديموقراطي لم يخفف من الوعي الديني بل زاده صلابة في الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها الدول العربية المنتفضة. وهي قوى إسلاموية سلطوية لا تستطيع إقامة التعارض مع السلطة الدينية، وتحديدا مع سلطة المرشد الديني أو سلطة ولاية الفقيه. فالمؤسسة السياسية في الدول العربية المنتفضة اليوم هي امتداد للسلطة الدينية التي تتمتع بصلاحيات واسعة للرقابة على الناس والكتب والفنون والمطبوعات والمسرح والأغاني والنوادي الفكرية. فهناك اليوم تصادم حاد وجذري بين قوى إسلاموية استغلت الانتفاضات الشبابية لتحاول بناء دولة إسلامية تتعارض جذريا مع أهداف تلك الانتفاضات، وبين قوى ديموقراطية عريضة تواجه بصلابة المد الإسلاموي الذي يستخدم العنف السلطوي بإسم الاسلام السياسي. وهي معركة مصيرية تطال حاضر العرب ومستقبلهم.
رهانات المرحلة الانتقالية بعد الاستبداد: سوريا مثالاً
نائلة منصور – سوريا
“البناء بطيء والتهديم سريع”، هذه المقولة المستقاة من الحس العام (السليم) تكاد تكون هاجسي الحالي، أنا نائلة منصور، امرأة سورية منحدرة من الأقليات الدينية الموجودة في هذا البلد المشرقي المعقد. “السرعة” مفهوم يتضمن الكثير من العنف الرمزي والتنافسية والذكورية وسيطرة القوي على الضعيف. السلاح سريع، أسرع من العقل، والثأر سريع، أسرع من السلم الأهلي ومن بناء المواطنة وترسيخ المساواة والعدل والقانون وإطلاق الحريات العامة وترسيخها كتقليد تراكمي لا يمكن التفريط فيه كمكتسب، وقد يكون بناء المجتمع المدني الحق والاقتصاد المتحرر من هيمنة السلطة ومن المنظومة الريعية، كأحد عتبات الدولة الديموقراطية التشاركية، أبطأ من فرض فكر شمولي جديد. يرتبط الأمر في حالتنا السورية بشعور الاستلاب وعدم القدرة على تملك زمام الحياة، وبأن أقدار الملايين من البشر ومصائرهم صودرت من دون أن يشعروا، وكأن المصادرة تمت سريعاً.
الراصد للمجتمعات ومن بينها مجتمعاتنا في زمننا الحالي، يرى أن أزمة “صبر” كبيرة تسم الأجيال الشابة وانشراط كبير بالسرعة وخصوصاً في العصر الرقمي: صناعة الرأي العام تصل لحظياً إلى الشريحة المستهدفة، فبابا الفاتيكان أصبح يغرد على حسابه على “تويتر” وأضحت تغريدات السياسيين المصريين مثل البرادعي مادة تناقلتها وسائل الإعلام الرسمية عشية الاستفتاء على الدستور. في هذا السياق وفي ظل انفتاح الأجيال الشابة على التجارب الديموقراطية للشعوب الأخرى، يبدو الجميع كأنهم يتعلقون بغلال الدولة الحداثية ومخرجاتها حصراً، يريدون حرق “الخوارزمية” الديموقراطية ومراحلها الطويلة للوصول إلى “الحالة” الديموقراطية. يذكر المفكر المغربي عبد السلام شدادي في مقال له حول تقبل المجتمعات الإسلامية الحداثة والانفتاح جملة لافتة، في ما يأتي ترجمتي لها: “قلائل هم الذين فهموا، حتى أيامنا هذه، أن الحداثة كل لا يتجزأ، وأنه كي نحافظ على الجوهر لا يمكننا أن نتفادى فترة خسارة كلية وإعادة بناء”، ويحيل في هذا الموضوع على مثال اليابان التي تواضعت بعد خسارتها في الحرب العالمية الثانية وتعلمت عن قرب من المثال الأوروبي في الحداثة حتى تصل إلى ما وصلت إليه. إلا أن أي مراقب علمي وجدّي لا يمكنه أن يقسر هذا الاتجاه اللجوج بالقول “اصبروا، الثورة الفرنسية استمرت مئة عام!”. من المهم اعتبار هذا الانشراط بالسرعة سمة أساسية لعصور ما بعد الحداثة وأنه لا بد سيغير من طبيعة آليات الانتقال الديموقراطي، سلباً أو إيجاباً.
لذلك وبسبب المفارقات الآنفة الذكر لـ”السرعة” سيكون هذا المفهوم ناظماً ضمنياً لمناقشتي الأسئلة المطروحة في الملف: كيف يمكن الشعوب المنتفضة والثائرة أن تتجنب الوقوع في فخاخ ديكتاتوريات بديلة، بخطوات متينة وثابتة (حتى لا أقول سريعة)؟ وكيف يمكن فعل المثقفين أن يكون مؤثراً وناجعاً في مواجهة تسارع الأحداث؟ أما لماذا نتحدث عن المرحلة الانتقالية، فهل لا يزال هناك من يتساءل إن كان النظام الأسدي زائلاً؟ النظام ساقط ونحن في انتظار الإعلان الرسمي لهذا السقوط، وعلى كل إنسان سوري أن يفكر حالياً في ما بعد الأسد.
المساحة المتاحة لي في هذا المنبر وعدم معرفتي العميقة بـ”انطولوجيات” الحركات الإسلامية المعتدلة منها أو المتشددة، المرشحة الأكثر حظاً لإعادة إنتاج استبداد من نوع جديد، يدفعانني إلى تبني بعض الفرضيات، توافق حدسي وخبراتي كمواطنة تعيش في بلد مشرقي، الهوية الإسلامية بارزة فيه، وسأعتبر هذه الفرضيات مسلّمات (ظرفية) دعونا نقول إنها تفيد المحاججة هنا وحسب.
بدءاً، كلنا يعرف ولسنا في حاجة إلى مختصين حول هذه النقطة، أن الإسلام السياسي كان أحد ضحايا الاستبداد السياسي خلال النصف الثاني للقرن الماضي، ومشروعه السياسي بقي افتراضياً دون الدخول إلى حقل المشاركة السياسية الفعلية. والإسلام السياسي أقرب إلى عموم الشعب، ليس في الضرورة ببرنامجه السياسي ولكن على الأقل بمرجعيته الدينية وقربه الاجتماعي. من جهة أخرى المقولة الأساسية عند التيار الإسلامي: “السيادة والملك لله” هي طوق نحو كسر احتكار السلطة على طغمة قليلة من الأفراد. تالياً، فالمطالبة بالسيادة الإلهية لا تجد أساسها في الإسلام الكتاب ولكن في الظروف الاجتماعية السياسية التي عاشها محكومون أصبحوا يرفضون خصخصة الحكم، سيادة وشرع الله هما برنامج جامع لعموم الشعب، وعموم الشعب يريد مضامين جامعة بمعنى العدل وتوزيع الثروات والإنصاف. في ظل القحط السياسي المديد وفي ظل فشل أنظمة الحكم العلمانية التقدمية والاشتراكية في الطرح العملي والحقيقي لهذه المعاني، لا يعود من المستغرب والحال هذه أن يرجع الناس إلى ما يعرفونه مما يرضي هذه الآمال، أي الدين. تالياً، شعار “الملك لله” لا يشبه في دلالته الشعار الذي رفعته الكنيسة في أوروبا قبل قرون لتقصي السلطة الزمنية ولتظل السلطة الروحية محتكرة للسلطة. على العكس تماماً، الشاب السوري النمطي الذي ينادي بشرع الله هو شاب عانى من خصخصة السلطة ويريد تشاركية أوسع وفي منظوره ومرجعايته الحق الأعلى، المطلق هو الضامن الوحيد لتلك التشاركية لأن أقرانه ومواطنيه يتقاسمون معه تلك المرجعية.
انتهت مسلّماتي. الإسلام السياسي لم يشارك بعد بالسياسة في عصرنا المشرقي الحديث، والنزوع نحو المراجع الدينية هو تعبير عفوي وطبيعي عن الاضطهاد المديد واحتكار السلطة بيد قلة من الأفراد حيث لا يمكن المشاركة. وبعد، هل لا يزال هناك مكان للهلع والرهاب من مشاركة الإسلاميين في السياسة، تالياً احتمال وصولهم إلى السلطة؟ هذا واقع قبلناه أم لم نقبله.
ينبغي أن نوجه توجسنا حالياً إلى كيفية الحد (السريع نسبياً) من خطر مصادرة الأحزاب الإسلامية للحريات العامة ومن خطر تحول المشاركة السياسية إلى “تسلطية” جديدة حتى لا نقول شمولية. يبدو هنا أن المعركة الأولى والأساسية هي الدستور وهذا ما تعلمنا إياه الأحداث المصرية الجارية. الدستور كوثيقة اتفاق وطني عليا يتم شبه إجماع على مضمونها. الدستور الناظم لشكل الحكم لمدة طويلة والمؤسس لجمهورية جديدة هو فرصة لا تتكرر قبل تعاقب القرون ولا تطرح إلا بعد أحداث عظمى وعميقة كما هي حال الثورة السورية اليوم. فهل يمكن أن نفوّت هذه اللحظة التاريخية؟ لست قانونية في محكمة دستورية ولكن كمواطنة عادية أرى من المهم أن يتم إقرار الدستور قبل أن تُفرز القوى السياسية، عبر جمعية تأسيسية تحقق أكبر قدر من التمثيلية لمكوّنات الشعب السوري على تنوعها وللمرأة السورية. وأن يضمن الدستور حقوق جميع المواطنين بغض النظر عن جنسهم أو انتماءاتهم. الترقب والرصد المثابر لإنجاز هذه الوثيقة الوطنية بما يناسب الهوية السورية ومبادئها الجديدة، يقعان على عاتق القانونيين، ولكن من الملحّ كذلك أن تضطلع النخب المثقفة بمهمة النقد والرقابة ومناهضة البوادر الأولى لكل اختراق أو تعسف. السؤال المطروح هنا: هل يمكن أن يتضمن الدستور بشكل صريح وعلني فصل الدين عن الدولة وحصر الدين وممارسة المعتقدات في الفضاء الفردي؟ في الواقع، الاقتناع بأن “السيادة للإنسان” وأنه المنتهى الأسمى هو نتيجة سيرورة طويلة تتعلق بظروف كل بلد وليست قطعاً حدياً مع ما سبق الثورة. مع ذلك من المهم أن تتضمن معركة الدستور هذا الجهد الذاتي المسرّع لنضج الظروف الموضوعية، لتثبيت هذه النقطة. من المفيد للسوريين أن يتابعوا السيرورة الدستورية في مصر وأن يجتهد القانونيون لإمكان إقرار مواد الدستور بعيداً من تأثير التجاذبات السياسية، وأن يدرسوا إمكان أن يتم الاستفتاء على الدستور بعد انتخاب للجمعية التأسيسية وليس تكليف، ولم لا يتم الاستفتاء على كل مادة من مواد الدستور؟ في ما يتعلق بالنقد المجتهد غير المهاود، فالأمر لا يقتصر على الناقدين المثقفين ومادة النقد لا تقتصر على النصوص والمادة الإعلامية والسلوك السياسي للنخب السياسية المنتخبة. بعيد انتخاب “حزب النهضة” في تونس، لفتني أن أحد أشكال فعل المجتمع المدني، عدا الحراك النقابي والتظاهرات المدنية المناهضة لمصادرة الحريات وحرية المرأة، تمثل في إنشاء مراصد لمراقبة الحريات وأن واقعة بسيطة كقرار فصل الإناث عن الذكور في صالة رياضية في العاصمة تونس كانت محط نقاش طويل وإدانة وتفاعل عبر الشبكات الاجتماعية التونسية. المجتمع المدني السوري لم يكن موجوداً في ظل نظام البعث وهو الآن في طور الولادة وسيطول أمد اشتداد عوده ليشكل حصانة لدولة الديموقراطية، إلا أن هذا لا يمنع أن يستقي السوريون من تجارب الدول التي سبقتهم في مخاض الانتقال الديموقراطي، ليدعّموا قوتهم في مواجهة أخطار محتملة.
معركة أخرى ستكون شديدة الأهمية في رأيي، هي تمثيل المرأة ومشاركتها في صنع القرار وحضورها بين النخب السياسية. لا يمكن في الوقت الحالي أن يكون هناك بديل من نظام “الكوتا” النسائية للبدء بترسيخ هذه المشاركة، وكل كلام آخر (للأسف يأتي أحياناً من النساء أنفسهن) عن ضرورة تمتع المرأة بالكفاءات المطلوبة كمتطلب أولي للترشح ما هو إلا رومنطيقيات أو تكريس لظاهرة “السقف الزجاجي” في مجال السلطة، السقف الذي يسد طريق السلطة بشكل شبه حتمي أمام المرأة. كأن كل المرشحين الرجال متمتعون بكامل الخصائص المنصوص عليها في دفتر مواصفات الترشيح!
حاولت أن أورد بعضاً من التحديات اللحظية والطارئة التي تجب علينا مواجهتها إسعافياً حتى لا يغدر بنا الزمن مرة أخرى. سيكون للمثقفين أو على الأقل هذا ما نتمناه، دور كبير في شحذ الأدوات الفكرية للنقد واستخدام الأدوات المتاحة في العصر الرقمي من صحافة الكترونية وتقانات اتصال متطورة وشبكات اجتماعية لا ينبغي أن نستخف بها مطلقاً، يمكنها أن تصنع رأياً عاماً ويمكنها أن تعيد تشكيل ذكاء جمعي وأن تكون نواة لفضاء عام تُقام فيه السجالات السياسية والاجتماعية، إن أُحسن استخدامها وامتنعنا عن الوقوع في الحلقة المفرغة لرفض الآخر والبحث الحصري عن أشباهنا. خلال سنتين من رصدي للشبكات الاجتماعية السورية المعارضة، لاحظتُ إلى أيّ حد حررت هذه الأداة التعبير عند المرأة، على سبيل المثال. أقول التعبير ولا أقول اللغة، فلا تزال المرأة تتحفظ عن مناقشة الجيواستراتيجيا أو التاريخ السياسي أو الاقتصاد الصرف أو الحيثيات العسكرية، إلا أن التعبير أصبح أكثر حرية حيث المقيّدات الاجتماعية الجندرية والمقاطعة الحثيثة لكلامها في محادثة واقعية غير افتراضية تزول إلى حد ما في الشبكة العنكبوتية. نحن بعيدون عن أن تكون الانترنت أداة للديموقراطية المباشرة، لكنها أداة متاحة لمثقفينا في تفاعل مباشر مع عموم الناس، عليهم أمثلتها وعدم التقليل من شأنها.
هذا عن التعبئة في مواجهة رهان السرعة الذي سيرافق المرحلة الأولى، ولكن يبقى أن العمل الأساسي في ترسيخ الدولة الديموقراطية الحديثة هو العمل الطويل الدؤوب، تكريس المؤسسات الحكومية الضامنة لإرساء القانون، تمكين المجتمع المدني وتكريس الحريات العامة وضمانها وعدم المساس بها، ترقين القيم المجتمعية المرتبطة بالاستبداد وفرز قيم جديدة. هذا الشق الأخير يتم في جزء منه عبر إصلاح المضامين التعليمية، لكن العبء الأكبر فيه يقع على عاتق المثقفين. المجتمع ينتظر من المثقف، عدا النقد، تفكيك رموز الثقافة الاستبدادية وإشاراتها على المستويات كافة في المجتمع، وتدوينها في أدبيات تخص تاريخنا وهويتنا. من دون تفكيك هذه المعقدات التي دخلت في النفس الجمعية للسوريين لا يمكننا أن نخطو نحو تأسيس مرحلة جديدة منعتقين من مخلفات جحيم استمرت أربعة عقود.
كل ذلك ليس أحلاماً وردية تحمّل الديموقراطية ما لا تحتمله. كل ذلك يصبح ممكناً بعد زوال الاستبداد. حتى مواجهة الإسلام المتشدد يصبح ممكناً لأن الشرط السياسي اللازم لمواجهة كهذه تحقق، وهذا ما يثبته الحراك الحالي في كل من مصر وتونس. عدا الظرف السياسي الموضوعي، فإن الإنسان في شعوبنا المشرقية تمثل تصورات عن الاستبداد وتبعاته، نتيجة خبرته وخبرة الأقدمين الموروثة، لن ينساها وسيتيقظ لمواجهة إرهاصات استبداد جديد. نرى في المثال السوري أنه على الرغم من تعقيد الثورة السورية وعسكرتها المقلقة، فإن من انخرط فيها ودفع أثمانها الخيالية لن يتوانى عن مناهضة أي جهة أخرى تريد مصادرة حريته.
هل استطعتُ أن أتخفف من هاجس السرعة والتسارع؟ ربما عليّ أن أستبدل مقولة “البناء بطيء والتهديم سريع” بمقولة أكثر حداثة: “الشعب السوري عارف طريقه”. طريقه طويل وعسير. ولكن ما الجديد؟
الإسلام ديناً ودنيا وثورة
بكر صدقي – سوريا
اتفق كل من أحمد معاذ الخطيب وجورج صبرة، في تصريحين متزامنين، على رفض قرار الولايات المتحدة وضع “جبهة الجهاد والنصرة لأهل الشام” على قائمة المنظمات الإرهابية، ويشغل الرجلان موقعين قياديين في تجمعين رئيسيين من تجمعات المعارضة السورية. هذه واقعة ذات دلالات عميقة يمكنها أن تشكل مدخلاً ثرياً للكلام على العلاقة بين ثورات التحرر العربية الراهنة والصعود الذي يشهده الإسلام السياسي بمناسبتها. واضح من القرار الأميركي والرد السوري عليه أننا أمام عالمين متصلين ومنفصلين في الآن نفسه، يتكلمان لغتين مختلفتين، لهما هموم مختلفة وتطلعات مختلفة.
بدا للوهلة الأولى أن موجة الثورات العربية التي نادت فيها الشعوب الثائرة بالحرية والعدالة والكرامة، تستهدف الانتقال من أنظمة استبدادية إلى النظام الجمهوري الديموقراطي وفقاً للمعايير الغربية السائدة في العالم. سواء أكان النظام الاستبدادي على علاقة طيبة مع الغرب كما كان واقع الحال في كلٍّ من تونس ومصر واليمن، أو في حال من المشاكسة معه كنظامَي القذافي في ليبيا والأسد في سوريا، بدا الهدف البديهي للشعوب الثائرة تقويض الاستبداد وإقامة النظام الديموقراطي، بل و”اقتصاد السوق” على أنقاض أنظمة اقتصادية مافيوية سمتها المشتركة فساد بلغ مستويات غير مشهودة، وبات يهدد الاستقرار الاجتماعي والسياسي. عنيت أن ظاهر الأمور يشير إلى أن هدف ثورات الشعوب العربية يتسق مع التطلعات الغربية المعلنة في عولمة نموذجها الاقتصادي – السياسي – الثقافي. وكانت البرامج المعلنة للقوى السياسية الثورية في شقّها العلماني – الليبيرالي بمثابة التعبير الشفّاف عن هدف تلك الثورات.
بيد أن الحركات الإسلامية سرعان ما انخرطت في هذه الثورات، بعد شيء من التردد، وطغى على المشهد الإعلامي لون إسلامي صريح كاد أن يحجب في ظله التيارات الليبيرالية والعلمانية. وإذا كانت محطتا “الجزيرة” القطرية و”العربية” السعودية قادتا الجانب الإعلامي في الثورات العربية، فأبرزتا دور التيارات الإخوانية والسلفية فيها بدوافع مفهومة، فإن نتائج الانتخابات الحرة في كلٍّ من تونس ومصر كشفت القوة الحقيقية للإسلاميين. مقابل فوز الليبيراليين المفاجئ في الانتخابات العامة في ليبيا، كان الهجوم على السفارة الأميركية في بنغازي من مجموعة سلفية، بمثابة استدراك دموي لخسارة الإسلاميين في اللعبة الديموقراطية، وخروجاً منهم على قواعدها، فضلاً عن دلالته على العداء الصريح والعدمي للغرب. لكن المشهد السوري يبقى الأكثر غنى بالدلالات، والأكثر خصباً في انفتاحه على الاحتمالات المستقبلية. فلندقق في معطياتها بصورة مخصوصة:
يمكن الحديث عن بدايات عدة للثورة السورية، على رغم تكريس الخامس عشر من شهر آذار 2011 تاريخاً متفقاً عليه بين السوريين. ففي 18 شباط من العام نفسه تعرّض شاب للضرب على يد شرطي مرور في سوق الحريقة وسط دمشق القديمة، فهبّ تجار السوق والزبائن وعابرو السبيل للتظاهر تضامناً معه، فأطلقوا شعارات ستطبع الثورة السورية بطابعها: “الشعب السوري ما بينذلّ!” و”حرامية! حرامية!” في إشارة مغفلة منهم إلى المجموعة الحاكمة التي يشكل الفساد ملمحها الأبرز والأشد ضرراً بالمجتمع.
جاءت البداية الثانية بتخطيط مسبق، فقد استجاب عدد من الشبان يعد بالعشرات لنداء أطلقته صفحات على موقع الـ”فايسبوك”، فخرجوا، في 15 آذار، من الجامع الأموي وعبروا سوق الحميدية الأثري وهم يهتفون “الله، سوريا، حرية وبس!” مستبدلين الحرية باسم الرئيس السوري في هتاف معروف كان يعلو في المسيرات المؤيدة له.
أما البداية الثالثة فانطلقت، في 18 آذار، من مدينة درعا على الحدود الجنوبية مع الأردن، احتجاجاً على اعتقال 15 طفلاً من أبناء المدينة من جهاز الأمن السياسي بقيادة ابن خالة الرئيس حافظ مخلوف الذي رفض إطلاقهم وأهان أهاليهم في شرفهم حين قصدوه يطالبونه بأطفالهم.
كان القمع المنفلت المجنون هو الرد الوحيد للنظام على تلك التظاهرات السلمية المحدودة، وسال الدم غزيراً منذ البداية، ونمت التظاهرات ككرة الثلج وانتشرت على كامل المساحة الوطنية، بتناسب طردي مع حجم العنف الذي واجهها به النظام، وواظب السوريون على سلميتهم ووطنيتهم الجامعة على الضد من عنف السلطة ونزوعها الطائفي المكشوف.
كانت النتيجة الطبيعية لهذا المسار أن المكوّن المدني “العلماني” القائم على شذرات من الطبقات الوسطى المتعلمة، انحسر بتناسب طردي مع تفاقم حجم العنف المنفلت من جانب النظام، ولم يبق في ساحة الفعل الثوري إلا الطبقات الأكثر تهميشاً والأقل تعليماً في بيئات مسلمة سنية بصورة غالبة.
كذلك أدى العنف السلطوي من جهة والصمت العربي والدولي عليه من جهة ثانية، إلى تفاقم الشعور بالمرارة والغضب اللذين شكّلا تربة خصبة للتسليم بمشيئة الله واللجوء إلى حمايته ورحمته، فصعد ذاك الشعار المعبّر بشفافية بليغة عن هذه الحالة: “يا الله، مالنا غيرك يا الله!”
ثم بدأت الانشقاقات من الجيش كنتيجة طبيعية للزجّ به في الحرب ضد الشعب، الأمر الذي عرّى في المقابل اعتماد النظام أكثر وأكثر على عصبية طائفية شكلت قاعدته الاجتماعية الأكثر تماسكاً وربطت مصيرها بمصيره. وحمل ثوار المناطق الريفية السلاح دفاعاً عن أنفسهم وأهلهم، فتشكلت أولى مجموعات ما سيطلق عليه لاحقاً “الجيش السوري الحر” وهي مجموعات متناثرة تفتقر إلى التنسيق على المستوى الوطني، وإلى قيادة سياسية كفؤة.
باستثناء النموذج الليبي، لم يمد الغرب يد العون إلى ثورات “الربيع العربي” وخصوصاً الثورة السورية التي تركت لمصيرها أمام إجرام نظام فقد كل شرعيته المطعون بها أصلاً، وتحول عصابة مسلحة عدوّها الوحيد الشعب والوطن. مع تفاقم الحالة الإنسانية وبلوغ إجرام النظام مستويات فظيعة (قصف المدن بالمدفعية والطيران والبراميل المتفجرة، والإعدامات الميدانية والمجازر الطائفية التي ركّزت على ذبح الأطفال والنساء بطرق بشعة، واستهداف الطوابير أمام المخابز بالقصف الجوي، وقتل المعتقلين في سجون النظام وحرق أجسادهم، ونهب الممتلكات الخاصة) واستمرار التواطؤ الدولي شهراً بعد شهر، أصبح واضحاً لدى السوريين أن الولايات المتحدة وحلفاءها الغربيين يريدون لثورتهم أن تهزم، بخلاف ادعاءاتهم، ولا يقلّون عداءً لها عن حلفاء النظام المعلنين كإيران وروسيا والصين و”حزب الله” وحكومة المالكي ومجموعة دول البريكس.
حُبِّر الكثير من الورق لفهم الموقف الأميركي الذي حيَّرَ المراقبين والمحللين. يمكن القول اليوم بدون مجازفة كبيرة إن السياسة الأميركية من الثورة السورية استهدفت منذ البداية وأدها، وحين فشل النظام في تحقيق ذلك، أصبح الهدف احتواء نتائجها واحتمالات انتشارها خارج حدود سوريا، وهو هدف يشمل الثورات العربية ككل. لقد أحست الولايات المتحدة بالهلع أمام حجم التغييرات الكبيرة التي تنبئ بها هذه الثورات، والتي من شأن انتصارها تغيير معادلات القوة وموازينها على المستويين الاقليمي والعالمي. كان من شأن سقوط الأنظمة العربية المتتابع كأحجار الدومينو، وبروز لاعب جديد في المشهد السياسي هو الشعب صاحب الإرادة وممتلك زمام القوة، أن يفتح الطريق أمام نهوض هذه البلدان المنضوية بأشكال مختلفة في إطار الهيمنة العالمية للغرب بقيادة الولايات المتحدة.
لنتصور عالماً عربياً (وإسلاميا) تحرر من قيود الاستبداد والفساد ومن حكامه المعتوهين، وانطلق إلى الأمام لامتلاك أسباب القوة الاقتصادية والثقافية والسياسية، وانخرط في العصر والعالم. هذا في وقت يشهد الغرب أزمة مالية فتّاكة عبّرت عن أزمة النموذج الاقتصادي الغربي في حلقته الأحدث (الليبيرالية الجديدة المتحررة من قيود الدولة والحدود بين الدول معاً). وتضافرت أزمة النموذج الاقتصادي هذا مع أزمة أعمق وأشمل هي أزمة النموذج الحضاري الغربي الذي نطلق عليه اسم الحداثة. تتمثل أزمة الحداثة الغربية هذه في أنها خسرت رهانها الأصلي في التحول إلى نموذج عالمي، ولم تعد تعبّر سوى عن هيمنة الجزء على الكل. الحداثة الغربية نموذج خاص تفاقمت خصوصيته وعنصريته باطراد، فبات مثاله الأكثر تقدماً (الاتحاد الأوروبي) مجرد نادٍ للدول المسيحية لا يتحمل التعدد والاختلاف، ينغلق أكثر وأكثر على نفسه، ويتخذ من الإسلام خصماً ونداً يثير مخاوفه (رهاب الإسلام).
إن صح هذا التحليل، نصبح أمام السؤال الذي يخصّنا: ما هو ردّنا المجدي على هذا الوضع؟ يرتسم في الأفق جوابان، يقول الأول بـ”الإسلام هو الحل” ويقول الثاني بـ”الحداثة هي الحل”.
يرتسم المشهد الاجتماعي – السياسي لدينا، على ضوء “الربيع العربي”، كما يأتي: تيار إسلامي صاعد يتطابق مع الهوية الدينية للأكثرية، وتيار حداثي يُعلي من شأن قيم الحداثة الغربية تحت عناوين التنوير أو النهضة أو التقدم، ويُظهر تشدداً في تمسكه بالعلمانية المفهومة بوصفها على عداء مع الإسلام، ويخاطب قشرة نخبوية متغربة ومنفصلة عن المتن الاجتماعي العريض. الواقع أن هذا التيار كان منسجماً مع نفسه فاختار مبكراً الاصطفاف وراء الأنظمة التي استهدفتها ثورات الشعوب التي أثارت هلعها. قسم صغير فقط من التيار الحداثي العلماني انحاز بوضوح إلى جانب ثورة الشعب، لكنه فضّل الهرب بمعظمه من قمع النظام إلى الخارج، خارج الوطن وخارج الفعل. هكذا حدث تطابق شبه كامل بين الثورة والمتن الاجتماعي الأكثري، وتوزعت الأقليات الدينية والمذهبية والإثنية بين العداء الصريح للثورة والمساهمة المحدودة فيها والنأي بالنفس في انتظار نتيجة الصراع، بقدر ما يمكننا الحديث عن تلك الجماعات كـ”أحزاب سياسية” ترى وتتصرف ككتلة عصبوية واحدة.
إن دفاع العلماني المسيحي جورج صبرة ورجل الدين السني المعتدل معاذ الخطيب عن “جبهة النصرة” في مواجهة الاتهام الأميركي لها بالإرهاب، يعبِّر بشفافية عالية عن تماسك “الداخل الوطني” أمام غربٍ رائزه “صدام الحضارات” ورهاب الإسلام، وعن ثورةٍ تستعيد ملامح ثورات التحرر الوطني من الاستعمار الأوروبي. وقد أطلق كثيرون بحق على الثورة السورية اسم “ثورة الاستقلال الثاني”، كما شكّل اتخاذ علم الاستقلال رمزاً للثورة، بدلاً من العلم المعمول به، تعبيراً آخر عن عمق الاغتراب الوطني بين النظام والشعب.
ولكن ألا تشكل “جبهة النصرة” أو غيرها من المجموعات الجهادية خطراً جدياً على مستقبل بلداننا؟ ألا نرى اليوم بالعين المجردة النزعات الاستبدادية المكشوفة لجماعة “الإخوان المسلمين” في مصر وتونس؟
بلى، هي مظاهر من مرض الإسلاموية الطفولي على غرار الوصف اللينيني لليسارية الطفولية. وهي طفالةٌ خطرة قد تكلفنا الكثير من الدماء والآلام وتمزقات في النسيج الوطني.
يبدو أن بلداننا مقبلة على مرحلة إسلامية لا مفر منها، قد تكون فرصةً للتيارات الإسلامية الصاعدة لاكتساب النضج المطلوب الذي من شأنه أن يجد صيغة مبتكرة قوامها التمسك بالهوية الثقافية في مواجهة غرب خسر رهان التعميم، والانخراط في العصر والعالم بلا حدود.
أما التيار الحداثي العلماني ومعه الأنظمة المتهاوية، فقد تكشفا عن أنهما مجرد استطالتين سطحيتين للغرب المستعمر في الأمس والعنصري المنغلق على نفسه اليوم. كاتب سوري مقيم في دمشق، نشر مقالةً صحافية في وقت مبكر من الثورة، زلّ قلمه زلة معبّرة حين كتب عن دمشق باسم الإشارة “هناك”. فعقل كاتبنا ووجدانه مشدودان إلى حواضر أوروبا إلى درجة يرى فيها دمشق التي يقطنها “هناك”!
هذا ليس مما يسرّ. فالإسلاموية المصابة بمرضها الطفولي أحوج ما تكون إلى معارضة ديموقراطية علمانية توازنها وتضبط شططها وتدفعها إلى تطوير نفسها في اتجاه التكيف مع شروط العصر وقيمه الكونية. بكلمات أخرى: مجتمعاتنا الخارجة من ظلام الاستبداد بحاجة إلى تركيب يجمع التيارين الرئيسيين، الإسلامي الذي يمكنه أن يساعد العلماني على استعادة هويته الثقافية الوطنية، والعلماني الذي يمكنه دفع الإسلامي إلى التصالح مع قيم العصر.
لنسمِّ الأشياء بأسمائها
يوسف رخّا – مصر
هنا القاهرة؟ نعم. وهنا شخص بلغ به الضجر حد الشماتة. اليوم سأسمّي الأشياء بأسمائها. قد لا يعترف “التيار المدني” الذي أنتمي إليه للوهلة الأولى بأن هذا ما نحن في صدده، وقد لا تصوغه “الثورة” التي شاركتُ فيها بالألفاظ ذاتها. لكن، مذ استتب أمر “الإخوان المسلمين” في السلطة بمعاونة “ثوار” لا يزالون عمياناً عن كل ما سوى المناهضة المستبدة لـ”فلول” نظام يبقى أفضل بأي مقياس من الديكتاتورية الإسلاموية، باتت الحوارات/ الشجارات في فضاء الجدال السياسي داخل هذين المعسكرين تتمحور حول سؤالين: هل من “توافق وطني” محتمل في السياق الراهن؟ وهل قامت “ثورة يناير” من أجل معادل سنّي لولاية الفقيه؟ هنا “مصر الثورة”؛ ولأن الإجابة عن السؤالين هي بالضرورة لا، هذا ما أجدني أتحدث فيه مغالباً فجيعتي بعد عامين على بدء التحول.
تقول الشعارات الإسلامية: “ماذا رأيتم من الله حتى تكرهوا شريعته؟”. لنفرض أننا لم نكن قد رأينا. أمس، يوم ٥ ديسمبر في مصر الجديدة، رأينا “شريعة الله” على إسفلت مصر الجديدة. رأينا “الإخوان المسلمين” والسلفيين والجهادين – تحت أعين الشرطة – يقتلون المتظاهرين المناهضين للرئيس “الشرعي” محمد مرسي والمحسوبين على الثورة بدم بارد. رأيناهم يأسرون ويسبّون ثم يحتجزون ويعذّبون سباياهم وأسراهم ضرباً وخنقاً وطعناً وصعقاً بالكهرباء بل وتعليقاً على أسوار قصر الاتحادية حيث كان المحتجون قد كتبوا تنويعات مختلفة على رسالة القطاع الأوسع من المصريين المدينيين إلى مرسي: “ارحل يا ابن الجزمة”. وإذا أطلقوا سراحهم فليسلّموهم إلى الشرطة بتهمة البلطجة، حيث يصبح قرابة مئتي مجني عليه متهماً وماثلاً أمام نيابة باتت في خدمة الجماعة وتحت أمرها بعد الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس يوم ٢٢ تشرين الثاني وانطلقت في إثره الاحتجاجات، محصّناً قراراته ضد الطعن القضائي.
ليس هذا وحسب: إن قوّادي “الحرية والعدالة” (كما صرت، عن نفسي، أعرّف “قيادات الإخوان”) بلغ بهم التبجح حد التلاعب الإعلامي والطائفي بهوية القتلى لكي ينسبوا الضحايا إلى أنفسهم. هكذا رأينا شعب الريف الكادح يزحف على المدافعين عن أبسط حقوقه باسم الله ليمارس عليهم أقسى أنواع القمع الرسمي بصفة غير رسمية، ورأينا دعاة “شرع الله” من المتنطعين على الثورة، بلا خجل، يسبغون على سياسي حنث اليمين وثبت عليه الكذب على نحو قاطع عصمة الأنبياء إن لم يكن القداسة الإلهية. هذا ما رأيناه أيها “الفصيل السياسي” الشريك.
¶¶¶
قبل شهور كان واضحاً أن ثنائية الثوّار والفلول السائدة إذاك تحت “حكم العسكر”، ليست سوى إيماءة شعاراتية طارئة سرعان ما سوف تنهار أمام صراع أكثر جذرية بين الإسلام السياسي وما سواه من توجهات، لأن الإسلام السياسي من الشمولية والعنف والرياء بحيث لا يستوي وجوده متجاوراً مع “فصائل” أخرى.
اليوم، بينما يُحشد الرعاع والإرهابيون من الأقاليم المظلمة في “تظاهرات تأييد” قاهرية لا يميّزها عن تظاهرات بلطجية مبارك سوى وساختها الريفية وتبجحها الوقح بإرادة السماء، يتهم قوّادو الحرية والعدالة ميدان التحرير المحتشد تلقائياً ضد الأخونة والتخليج، ضد تقويض القضاء والتمهيد للسيطرة على الإعلام، بأنه صار قبلة الفلول (علماً بأن الحكومة الإخوانية، ووزارة الداخلية بالذات، قائمة في الأساس على من كانوا يتقلدون مناصب في “العهد البائد”؛ علماً بأن “الإخوان” كانوا أول من تفاوض مع نظام مبارك وفي تاريخهم السابق على الثورة أكثر من واقعة تحالف مع الحزب الوطني المنحل). لقد بلغ جهل الإسلاميين وغباؤهم في مصر حد التهديد بالعصيان المدني “تأييداً لقرارات الرئيس”؛ ومتى كان التأييد من وظائف الحراك الاحتجاجي؟ ومتى…
عشية الاعتصام عند الاتحادية، وإثر هرب الرئيس من باب خلفي للقصر المحاصر، ثم التناقص التدريجي لأعداد المعتصمين هناك، أرسل “الإخوان” مسلحيهم المنظمين لفض اعتصام الاتحادية ومعاقبة “الثوار”. وبعدما دفعوا لآخرين مقابل التحرش بالنساء وافتعال العنف سواء أفي التحرير دار الثورة أم في ماسبيرو مركز الحراك القبطي.
¶¶¶
ثم إننا رأينا “مؤيداً” على “يوتيوب” يسبّ المعتصمين أنفسهم بِغِلٍّ غير مفهوم بعد فض اعتصامهم، رأيناه يستدل بعلبة “جبنة نستو” وجدها في إحدى الخيام على أن “بتوع حمدين والبرادعي” اللذين يكرههما (لأسباب هي الأخرى غير مفهومة) ليسوا سوى خونة ممولين من الخارج (ومن ثم، أو إلى ثمة، “ضالين” ممن تذكرهم فاتحة القرآن).
إن ما يثبته مثل هذا المشهد أن الإسلامي المتحمس ليس في حاجة إلى حقائق/ معلومات مطابقة للواقع التجريبي، ولا إلى أي منطق نظري مهما كان بسيطاً، ولا حتى إلى الحد الأدنى من أدنى حد لإعمال القوى الذهنية العادية، لكي يقيم حجة تبرر له غضباً ينفث من خلاله كراهيته لذاته ويعبّر عنها من خلال التشبث بالغوغائية الشعبوية وسواها من أشكال التخلف من جهة، وعبر رفض كل ما يمكن أن يذكّره بدونيته من جهة أخرى (وهو العالم الواسع بما فيه احتمالات التقدم).
دعك إذاً من أن المتظاهر ضد مرسي هو في الضرورة، بالنسبة إلى ذلك الإسلامي، “بتاع” أحد سواه؛ إن الجبنة النستو التي يأكلها الجميع، إسلامياً أكان أم غير إسلامي، هي الدليل الدامغ على العمالة والخيانة ومناهضة “الشريعة” وكل ما من شأنه أن يهدد “الإسلام” في خطابه الساعي إلى يوتوبيا، هو يعلم قبل غيره أنها لا يمكن أن تكون.
¶¶¶
واليوم؟ اليوم يكبّر غلمان السلف داعين “أمير المؤمنين” الجديد أنْ “اضرب ونحن معك”، رافعين أعلام السعودية و”القاعدة”، محرّضين “خرفانهم” على قتل رموز المعارضة في القضاء والإعلام بوصفهم “فاسدين” و/أو “كفرة فجرة”. اليوم يتطوع هؤلاء الغلمان والمتعاطفون معهم – بأوامر من القوادين – لأداء أدوار جلاّدي “أمن الدولة” في إعادة هزلية لمسلسل القمع البوليسي المفترض أنه مورس على الإسلاميين من قبل، ولكن أمام عدسات الهواتف في الشوارع، وفي أكشاك الشرطة العسكرية، وفي غرف داخل أسوار القصر.
بينما يحدث ذلك، يقبع اليسار المدجّن في محبسه “الوسطي” وقد أخرسته التطورات وإن استمر في ترديد شعارات الثورة على الفساد والتوافق الوطني كالمنوّم مغنطيسياً، ملتمساً أعذار الجهل والكبت وحداثة العهد بالسلطة، محذراً من “حرب أهلية” لا سبيل إلى تجاوز هذه المرحلة المنحطة – وقد مسك الكلب عظمة – إلا بشيء مثلها. حرب قد بدأها الإسلاميون بالفعل رافعين شعار “قتلاهم في النار وقتلانا في الجنة”، وبإيعاز من “القيادات” الميليشيوية الفاسدة والفاشلة التي لا تزال تتغنى بديموقراطية الصناديق واحترام رغبة الشعب.
يحدث هذا، وفي اليوم التالي يلقي الرئيس خطاباً رسمياً يغربل فيه نظرية المؤامرة المخابراتية المعتمدة منذ منتصف القرن فيقول إن بلطجية النظام السابق اعتدوا على متظاهرين سلميين؛ إن البلطجية في خدمة سياسيين حان وقت محاكمتهم، وإنهم قد اعترفوا بجرمهم أمام الشرطة. لا يتعرض ولو بكلمة للفرق بين المحتجين و”المؤيدين”. لا يتعرض ولو بكلمة لجرائم الإسلاميين وتواطؤ الشرطة عليها. إن عدد البلطجية الذي يذكره مطابق لعدد المعتصمين الذين أوقفهم “الإخوان” وعذّبوهم ثم سلّموهم؛ ومع ذلك، رغم النفوذ الإخواني في النيابة، لا يستطيع أحد أن يثبت عليهم أي جرم حتى يطلق سراحهم بعد مماطلة في اليوم الثالث. ولا يعرف أحد عمن كان يتحدث الرئيس.
¶¶¶
“حماية الثورة”: قل ما تشاء يا رفيق. أنا فعلاً نادم على مشاركتي في الحماقة الكبرى التي تسمّونها الثورة، ولم أشعر مثل اليوم بضآلتي ولا جداوي أنا وكل ما يمكن أن أمثّله. كل ما في الأمر أنني تصورت خطأ أنني أعيش في مجتمع يمكن أن يدافع عن مصالحه، أو يعني مجتمع له طليعة تعرف تلك المصالح أو ترى أبعد قليلاً من بشاعة القمع اللحظي وأخلاقية الشعار. قاطعت الانتخابات البرلمانية وقاطعت انتخابات الرئاسة، وحاولت على مدى سنتين أن أستفز المعنيين لأذكّرهم إلى أين نحن ذاهبون. الآن أحس أننا قد وصلنا، ولم أعد متأكداً من أن مصر ليست سوريا، ولا أشعر أن عندي أي شيء أقدمه. ليسقط الإسلام السياسي وليسقط التدين الذي أنتجه؛ لتسقط أكذوبة القومية العربية ومزحة التحرر الوطني؛ لتسقط ترهات النهضة ودعارات المقاومة؛ ليسقط الفساد والاستبداد. ولكن ليسقط كل من ساهم ولو بنَفَس شارد في ركوب شعوب وأوطان بأسرها على هذه السفن الورقية ومن ثم وصولنا إلى هنا. نحن يا رفيق لا نستحق الحياة.
22 نوفمبر 2012 إثر صدور الإعلان الدستوري
¶¶¶
مع ذلك، ورغم ذلك: لدى التوافقيين والوسطيين وقطاع كبير من “الثوار” كما لدى الإسلاميين أنفسهم، يظل الإسلام السياسي مضطَهَداً حتى حين يكون في السلطة؛ يظل قومياً حين يعمل لصالح إسرائيل، وتوافقياً حين يستبد بالقرار، وديموقراطياً حين يكرس الشمولية؛ يظل “فصيلاً” ضمن الفصائل حين يحتكر لا القرار السياسي فحسب وإنما الدستور ذاته، كما يظل الممثل “الشرعي” للشعب حين يُقصي ثلاثة أرباع ذلك الشعب نوعاً، إن لم يكن كماً، ويغامر بالدولة بعدما غامر بالمجتمع والثقافة الوطنية بكل معانيها المحتملة على مدى عقود.
هكذا يأتي ناشط نجم ممن بادروا إلى انتخاب مرسي، وهي الخطوة التي أدت مباشرة إلى ما نحن فيه؛ وبدلاً من الاعتذار عن قصر النظر والمساهمة في صعود الاستبداد الظلامي وتسهيل مهمة التخلف الممنهج أو إعلان موقف واضح من الديكتاتورية الدينية التي تمثلها الرئاسة، إذا به يشير إلى جذر الخلاف في الجمعية التأسيسية الموالية ورئيسها فيغرّد قائلاً: “أنا مش نازل أسقط مرسي، أنا نازل أسقط الغرياني”.
لماذا إذاً لا نقول إن الإسلام السياسي يحقق أهداف الثورة بالفعل ونحن نراه يستعملها وإيانا للانقلاب على ما بقي من المؤسساتية واستبدالها بشمولية عشائرية أبشع ألف مرة من “نظام مبارك” الذي ثرنا عليه؟ طالما لا تسعى “الثورة” لحساب نفسها باستبعاد أمثال ذلك الناشط من الأصوات المعبّرة عن رواسب الوعي النضالي الأخرق ودعارات البطولية الاستعراضية بكل ما فيها من جهل وغباء ولامسؤولية إجرامية، لعل ما يفعله مرسي كمسؤول ملف الرئاسة في جماعة “الإخوان المسلمين” هو “ثورة مصر” بالفعل. ولعلنا جميعاً بمن فينا ذلك الناشط فلول.
¶¶¶
أمس في مصر الجديدة تأكد ما كنا نعرفه، أو انهار ما كانوا يكذبون به علينا – ولا يزالون – من أن هناك مساحة تقاطع حقيقية بين الإسلام السياسي والديموقراطية أو الوطنية أو الحرية أو العدالة الاجتماعية أو أي قيمة أخرى نادت بها “ثورة يناير”؛ أو أن ما يتهددنا في هذا المنعطف التاريخي هو الشمولية العسكرية أو استمرارها. ولا أهمية الآن لتوجيه السؤال إلى الرفاق ممن صوّتوا لمرسي: ماذا كنتم تتوقعون؟
إنها أدوار ورثها أصحابها – وإن طوّروها – من قوميي الانقلابات ودعاة مناهضة الاستعمار واليسار الذي بادر من ثم إلى موالاة “الشيوخ”. هنا القاهرة وهذا ما وصلنا إليه: ملتحون يقمعون الاحتجاج في حماية “الرئيس الثوري”، قاصمين ظهر أيّ منظومة مدنية محتملة، متاجرين ليس فقط بالعقيدة وإنما أيضاً بدماء مواطنيهم؛ مدن تعلن استقلالها عن حكم “الإخوان”؛ و”ثوار” لا يزالون يدافعون عن انتخاب مرسي بوصفه “النار” التي فضّلوها على “عار” شفيق حرصاً على “المصلحة الوطنية”! فهل كان شفيق ليجرؤ على إصدار إعلان دستوري مثل الذي أصدره مرسي ثم إرسال ميليشياته لقمع الاحتجاج عليه؟ أتمنى عليك أن تجيبني، أخي في الثورة.
ولو كان في البلاد مؤسسة عسكرية “وطنية” متماسكة، هل كانت لتسمح بتسليم الدولة لجماعة سرية إرهابية تمارس القمع المجتمعي والعنف السياسي ونشر التخلف بانتظام منذ عشرينات القرن الفائت؟ ولو كان للإسلام السياسي أي صلة بالديموقراطية، هل كان ليخرج في “تظاهرات تأييد”؟ ثم ماذا نحن الآن فاعلون؟ لا أهمية للإجابة عن هذه الأسئلة، أقول. الأهمية للاعتراف بأن الإسلامويين المتزمتين هم رعاع الأمة، ومنظّريهم نخّاسوها، وقادتهم أثرياء حربها من زعماء عصابات الملتحين. ولنسمِّ الأشياء بأسمائها معترفين بفشلنا الذريع مرة وإلى الأبد. ولنقل مثلما قال الرئيس مرسي في نهاية خطابه: والله من وراء القصد.
محنة الكرنفال
آدم فتحي – تونس
خفقةُ جناح الفراشة التونسيّة الملتهبة التي تداعت لها بقيّة أحجار الدومينو العربيّة لم تستشر أحداً ولم تنتظر قيادة. ترجمت ما تراكم من ثقافة وإبداع ونضال إلى طاقة حيويّة وقامت في اللحظة التي رأتها مناسبة وصنعت أسطورتها المؤسِّسة وأطاحت طُغاتها ثمّ تركت للسياسيّين أن يواصلوا المهمّة. وهذه هي المشكلة.
لم يكن هؤلاء السياسيون قد تغيّروا بما فيه الكفاية كي يقودوا المرحلة بما يكفي من رؤى وأساليب مغايرة. فجأةً تحوّل قسم من المثقّفين إلى عرّافين وقرّاء كفّ. وفجأةً تحوّل قسم من السياسيّين إلى مهاجرين وأنصار وثوّار و”ثوّار أضداد” يتناهشون الغنيمة ويحاولون احتكارها واحتكار القوامة عليها بدايةً من التسمية، من دون أن يتواضعوا بما يكفي للاعتراف بأننا أمام فرصة غير مسبوقة مفتوحة على ممكنات قد تؤول إلى ثورات غير نمطية وقد تتمخّض عن ثورات مغدورة وقد تؤول إلى شيء مختلف كلّ الاختلاف.
لكأننا أمام طائرة مستقبلية وثب فجأةً إلى قمرة قيادتها طيّارون لا كفاءة لهم في أفضل الأحوال إلاّ لقيادة هليكوبتر! لا فرق في ذلك بين إسلاميّين وعلمانيّين إلاّ من باب الاستثناء الذي يحفظ القاعدة. لسنا إذاً على الأرجح أمام مشروع دنيويّ تتهدّده أخطار الاستبداد التيوقراطيّ، فحسب، بل نحن أمام صرخة حريّةٍ تحاصرها الذهنيّة الاستبداديّة المعشّشة بشكل أو بآخر داخل معظم الفاعلين، من دون تعميم ومع احترام الاستثناءات.
نحن نعايش تاريخاً يتشكّل وليس من شكٍّ في أنّ كلّ تشخيص حاسم لما يحدث هو نوع من استطلاع الغيب. إلاّ أنّ ما تحقّق حتى الآن ليس بالهيّن. لعلّ من أهمّ ما تحقّق كشف المستور عن حقيقة مجتمعاتنا وإطلاق الكثير من المكبوت المغيَّب وإسقاط العديد من الأقنعة المركّبة التي كادت تتحوّل إلى قناعات والتي صنعت لنا على امتداد عقود صورةً زائفة عن أنفسنا شبيهة بالبطاقة البريديّة حلّت محلّ الوجه.
احتكار التاريخ
من بين ما كشفت عنه هذه الثورات وجود رغبة لدى الجميع، تقريباً، في إعادة كتابة التاريخ، كلٌّ على هواه وكلٌّ على قياسه. بدايةً من التسمية بوصفها حكراً على الأب وعلامة على عموديّة النسب. لم يفهم معظم النخبة أنّ في التسمية ما هو عبء على المسمّى، وأنّ الحدث الذي قام بنفسه يريد تسمية نفسه بنفسه، في نوع من القطع مع الشجرة السلاليّة. هكذا لم يكن فرقٌ بين من استحضر الفتوحات الإسلاميّة ومن استحضر نموذج الثورة الفرنسيّة لسنة 1789. كلاهما انطلق من كرّاس شروط لتشخيص الحدث وتسميته. كلاهما اتكأ على الذاكرة وأبطل الخيال. في قصّة “خليفة الأقرع” صوّر لنا الكبير الراحل البشير خريّف تراجيديا فتى يسمح له الرجال بدخول بيوتهم لأنّه في نظرهم أقرع، أي لا خوف منه على نسائهم. ثمّ نبت له شعر فأُوصدت أمامه الأبواب فإذا هو يطلب استعادة قرَعه أي استعادة رمزيّة الخصاء. تلك هي الرغبة الكامنة في خطاب الكثيرين اليوم على اليمين وعلى اليسار. ينبت للشعوب “شَعْرٌ”، أي ثورة، فيحرص الساسة على اقتلاعه. يريدونها شعوباً قرعاء أي مخصيّة كي لا يُخشى جانبها!
احتكار الحاضر
من بين ما كشفت عنه هذه المرحلة، الاستقطاب الحاصل بين التيّار المدنيّ بألوانه الليبيراليّة والعلمانيّة واليساريّة من جهة، والتيّار الإسلامويّ الإخوانيّ السلفيّ الدعويّ أو الجهاديّ من الجهة الأخرى. ممّا يعني وجود جزء من مجتمعاتنا العربيّة يتعامل مع الحاضر من خارجه. وإنّ من مزايا ما حدث أن يعيد إلى وعي النخبة والجماعة ضرورة الاعتراف بوجود هذا الجزء من المجتمع، وضرورة البحث عن أسلوب وخطاب جديدين للدخول معه في جدل عميق بعيداً عن غوايتَي الاستخفاف والشيطنة.
إلاّ أنّ الأمر لا يقتصر على مجرّد صراع سياسيّ بين معسكرين. نحن أمام اختلال بنيويّ عميق في نسيج مجتمعاتنا. وهو اختلال استفحل نتيجة الأسئلة الاستيهاميّة التي وقع في فخّها جانب كبير من مثقّفينا عن وعيٍ حينًا ومن دون وعيٍ حينًا آخر، ونتيجة الحلول الإيهاميّة التي برع في حبك خيوطها النظام العربيّ ككلّ، بعلمانيّته السطحيّة الزائفة والمدجّجة بالخوذات العسكريّة أحياناً وبفاشيّته الوراثيّة المتنكّرة في زيّ مدنيّ أحياناً أخرى.
لعلّ أخطر ما كشفت عنه هبّةُ الشعوب العربيّة لإطاحة طغاتها: صعوبة التمييز في الجوهر بين المعسكرين. كلاهما، مع حفظ المقامات واحترام الاستثناءات، لا يرى مستقبله إلاّ في ماضيه. كلاهما يعمل انطلاقا من الذاكرة معطّلاً الخيال والاستنباط. كلاهما يملك الحقيقة ويريد أن يكون عرّابها الوحيد. كلاهما يريد السلطة ويبحث عن طرقٍ للاستيلاء عليها. كلاهما لا يتحمّل التعدّد ولا يؤمن بالتداول. كلاهما سلفيٌّ بشكل أو بآخر، وكلاهما يريد احتكار الحاضر انطلاقاً من سلفيّته الخاصّة.
احتكار المستقبل
من المفارقات التي كشفت عنها هذه المرحلة المزلزِلة، أنّ السلفيّة لم تعد حكراً على الإسلاميّين. وأنّ العلمانيّة لم تعد حكراً على العلمانيّين. من أجل الحصول على أصوات الناخبين، “تَعَلْمَنَ” الإسلاميّون وتداعوا إلى صناديق الاقتراع، هم الذين يقولون بالبيعة ويعتبرون الانتخابات بدعة والديموقراطيّة ضلالة. ومن أجل الحصول على أصوات الناخبين “تَأَسْلَمَ” العلمانيّون وشرعوا في ترقيع ثوبهم الحداثويّ بخيوطٍ دينيّة في نوع من الماركيتينغ السياسواتيّ المفضوح وغير المقنع. هكذا أنجبت المرحلة خطاباً ترقيعيّاً سلفيّاً عن ميمنته وميسرته في اصطدام مباشر بخطاب الثورة نفسها التي قامت تحديداً ضدّ الرتق والترقيع ومن أجل ولادة جديدة في ثوب جديد. هكذا وجد المثقّف نفسه في محور التجاذب بين معسكرين يختلفان في طريقة سعيهما إلى السلطة ويتّفقان عليه وعلى معاداته. لأنّ كلاًّ منهما يطالبه بالعودة إلى نقطة ما قبل المثقّف وما قبل الانتلجنسيا. نقطة التماهي بين الفقيه وبوق البروباغندا.
محنة الكرنفال
ليس من اسم مشترك لمحاولة احتكار الماضي والحاضر والمستقبل غير الاستبداد. أعود هنا إلى استحضار “بلاد الكرنفال”، الرواية التي نشرها آمادو سنة 1931 وكتبها عن “برازيله” وهي في دوار البحث عن ذات تتجاذبها الأنياب. مرّة أخرى أقول إنّ “بلاد الكرنفال” تشبه بلادنا. تبحث عن وجهها فلا تراه إلاّ منعكساً على مرايا مهشّمة: ما العمل؟ كيف الخلاص من البؤس والتخلّف؟ أيّ نهج هو الأصلح في الاقتصاد والحكم؟ أيّ أخلاق؟ أيّ حداثة؟ كيف يعيش الإنسان سعيداً وأين مفتاح السعادة: في السياسة؟ في الفلسفة؟ في الدين؟ في اعتبار غاية الحياة الموت؟ في الكفّ عن نشدان السعادة والتخلّص من الأسئلة والأحلام؟ في التخلّي عن المقاومة والاستسلام للأقوى والرضا بحياة البهائم التي لا تسأل ولا تشقى؟
في روايته الجميلة يؤكّد آمادو على لسان إحدى الشخصيّات أنّ من المستحيل اليوم كتابة قصّة جديدة عن الكرنفال. “ما يُكتب هو دائما القصّة نفسها. أب يمنح ابنته كامل الحريّة، وفي الكرنفال يتنكّر في زيٍّ جذّاب ويقابل فتاة متنكّرة فيصطحبها إلى غرفة وهناك يكتشف انّها ابنته. من الممكن طبعاً استبدال الفتاة بالزوجة أو الأخت أو الجدّة ولكنّها دائماً القصّة نفسها”. في سياق الراهن العربيّ يمكن استبدال الفتاة بالثورة أو بالنخبة السياسيّة التي يظنّها المواطن حقّاً وحريّةً وعدالةً وكرامةً، فإذا هي ردّة ونكوص ومقايضة للخبز بالهويّة أو مساومة على الحريّة بالخبز.
هذه المقايضة وهذه المساومة علامتان على الاستبداد وذهنيّته السرطانيّة المترسّخة في معظم النخب السياسيّة الحاكمة والمتطلّعة إلى الحكم. وهذا الاستبداد وذهنيّته هما الخطر الحقيقيّ الذي يتهدّد مستقبل الشعوب العربيّة ويشدّها دائماً إلى الخلف أو إلى ديموقراطيّة كرنفاليّة بلا مضمون.
دور المثقّف؟
المثقّف عدوّ المعسكرين لأنّهما يشتركان في ذهنيّة السقيفة، سقيفة بني ساعدة، حيث الرمز مسجّى والورثاء يتقاسمون الغنيمة. هؤلاء مهاجرون وأولئك أنصار، ومنّا أمير ومنكم أمير ولا يريدون شاهداً على ذلك.
إلاّ أنّ الاكتفاء بالشهادة يجعل المثقّف شريكاً في ما يحصل. وليس عليه كي لا يتورّط في هذه الشراكة إلاّ أن ينصت إلى موسيقى العصر وهي تلتحم بسمفونيّة التاريخ مانحةً المثقّف دوراً جديداً وهويّة منفتحة على أفقٍ أبداً متحرّك. على المثقّف أن يعيد النظر في الكثير من مسلّماته، وفي مقدمها ما يتعلّق بتحديد انتمائه إلى شريحة النخبة التي لم تعد اليوم على ما كانت عليه في الأمس ولن تظلّ غداً على ما هي عليه اليوم.
على المثقّف أن يكون نفسَه. أي أن يُولد من جديد. وأن يمنح مضموناً جديداً لعبارة غيفارا: لنكن واقعيّين ولنطلب المستحيل. هكذا يمكن عبور محنة الكرنفال والتغلّب على صعوبة الخروج من ذهنيّة الاستبداد.
أستحضر هنا فرانز فانون في أكثر من حوار وفي أكثر من كتاب وهو يحذّر من حلم المقموع بأنّ يتحوّل إلى قامع! داعياً الشعوب المتحرّرة لتوّها من قبضة الاستعمار إلى الإسراع في تكوين نخب جديدة، مؤكّداً أنّ الاستعمار لا ينتهي بمجرّد الحصول على الاستقلال بل لا بدّ من تحرير الذهنيّة والوجدان والفرد ككيان إلى جانب تحرير الشعوب والجغرافيا، وأنّ الاستبداد لا يُطاح حقًّا ما لم تُطَحْ ذهنيّته داخل العقل والوجدان إلى جانب ما يمثّله من شخصيّات ومؤسّسات وجماعات.
النخب الجديدة التي يشير إليها فرانز فانون ويدعو إليها بإلحاح هي تلك التي تحمل ثقافة جديدة، وهي كناية عن الذهنيّة الجديدة التي لا بدّ للوعي السياسيّ من التعبير عنها كي يكون في خدمة المصلحة العامّة. إنّ من شأن غياب هذه النخب وهذه الذهنيّة في نظر فانون أن يؤدّي إلى اختطاف الاستقلال أو الثورات من طرف انتهازيّين ومحترفي صفقات، لن يمثّلوا في النهاية سوى صور كاريكاتوريّة عن المستعمر والطاغية، ولن يسمحوا إلاّ بأن تتمخّض حركات التحرّر أو الثورات عن الحزب الواحد والاستبداد.
هل ينقذ المثقف الليبي شعبه؟
محمد الأصفر – ليبيا
ليس من خيار أمام المثقف إلا الانتماء إلى أحد التيارين المتصارعين على السلطة، التيار المدني المفترض أنه لا يعتمد على ميليشيات عسكرية أو إيديولوجية بأطيافه المتعددة من ليبيرالية وعلمانية ويسارية وغيرها، والتيار الديني ومتفرعاته من “إخوان” إلى سلفيين وأنصار شريعة وغيرها، بميليشياته شبه العسكرية وثوار شاركوا في الثورة ورفضوا تسليم اسلحتهم والانضواء تحت راية الجيش أو الشرطة الوطنيين بعد سقوط النظام.
بقاء المثقف دون دخول حلبة أحد التيارين السابقين يضعه في خانة المثقف السلبي الذي تدور حوله علامات استفهام، كفرضية أنه من منتظري انتصار أحد التيارين كي يجد في المنتصر الحظوة.
بعد سقوط النظام واعلان تحرير البلاد من ديكتاتورية القذافي تشكلت أحزاب سياسية كثيرة تفتقر إلى التجربة فجاء أداؤها باهتا وبدائيا جدا مقارنة بالديموقراطيات العتيدة كلبنان وتركيا.
نرى هذه الأحزاب تنقسم اثنين: احزاب تنتمي إلى التيار الإسلامي ويشكل تيار “الإخوان” فيها القوة الكبرى من خلال حزب “البناء والعدالة” الذي حصل على الترتيب الثاني في انتخابات المؤتمر الوطني الأخيرة. وأحزاب أخرى ليبيرالية وعلمانية ويسارية بعضها قزمي جدا اجتمع أكثرها في كيان اسمه تحالف القوى الوطنية الذي حصل على الغالبية في المؤتمر الوطني. لكن لأسباب عدة لم ينجح في تشكيل الحكومة أو تكوين غالبية بسبب النواب المستقلين الذين يتبعون أحزابا أخرى. أتوقع أن تحدث أزمة وصراعات بسبب الدستور مثلما حدث في مصر منذ أيام. يريد كل تيار سياسي أن يدس أنفه في الدستور ويلوي رقبته ناحيته بغض النظر عن مصلحة الشعب الذي فجر ثورة وانتزع حريته.
الكثير من الأقوال نسمعها هنا وهناك حول الأحزاب السياسية التى تدير ليبيا الآن وحةل تبعيتها ومصادر تمويلها. يقال إن التيار الإسلامي تموله قطر، والتيار الليبيرالي تموّله الإمارات العربية. لكلٍّ من هاتين الدولتين، بحسب ناشطين سياسيين، أطماع في ليبيا نظير ما قدمتاه من دعم مادي وسياسي ولوجستي أثناء الثورة، حتى ان الشارع الآن منقسم بينهما.
أقاويل كثيرة في الـ”فايسبوك” حول شراء خليجيين من خلال وسطاء ليبيين أراضي زراعية خصبة في الجبل الأخضر الليبي وبأسعار مغرية، مستغلين الفوضى الإدارية حيث القضاء غير مفعّل، ولا تزال مؤسسات الحرس البلدي والشرطة والجيش في حالة سبات. التحذيرات كثيرة حول هذا الموضوع الذي سيتسبب بمشكلات تتعلق بسيادة الدولة مستقبلا، وتستدعى الحال الفلسطينية وبيع الأراضي لليهود، والحال الليبية قبيل تعرض البلاد للاحتلال الايطالي عام 1911. الفارق أن للريال القطري والدرهم الإماراتي وقعهما الذي لا يقاوم في ظل هذا الزمن الحرج الذي تعيشه ليبيا.
يمكن تسجيل ملاحظات تدعو إلى الاستغراب. فبالرغم من أن الشعب أعلن ثورة واجتث النظام الديكتاتوري إلا أنه لم يتبوأ مكانه المستحق بفضل ثورته. الدولة الآن يحكمها رجال سبق أن عملوا مع القذافي، ومعظم من يشكل الوزارات يحمل جنسية أوروبية أو أميركية يقدم إليها الولاء أولا قبل بلاده الأم. بل أن بعض هؤلاء الساسة يعتبر أن الشعب الليبي غبي ولا يمتلك كفاءات سياسية أو علمية تمكنه من إدارة البلاد. الغريب أن هؤلاء الساسة الذين كانوا يعارضون القذافي من مكان آمن وعن بعد ووسط دعم غربي ودولي لا محدود، عندما يشكلون حكومة أو يعينون سفراء أو مديرين، غالبا ما يختارون شخصيات من ليبيي الخارج معظمهم لا يفقه شيئاً في الشأن الليبي. بينهم من لا يعرف حتى الكتابة والتحدث بالعربية بصورة مقبولة مما يجعل ليبيي الداخل والثوار يعيشون في حال تذمر وضيق وعدم رضا ممَا آلت إليه ثورتهم التي سرقها زمرة من غسلة الأكواب والصحون ومن الخونة الذين خانوا ولي نعمتهم القذافي. هذا يجعل خيانتهم للشعب لصالح الغرب واردة جدا. فالخيانة في النهاية واحدة وهي أن تكون معي وأضع فيك ثقتي لكنك تنقلب عليَّ عندما أعيش ضيقا أو ضنكا.
هناك حسنة واحدة في الثورة الليبية ينبغي أن نذكرها وهى أنه كلما حدثت حركة لإحياء حكم القذافي أو التمرد على الثورة في مدينة أو قرية أو صحراء، فإن ذلك لا يمر مرور الكرام ولا يُترك حتى يستفحل. فكل الأطياف السياسية والثوار يقفون وقفة رجل واحد أمام الخطر المحدق والآذن بعودة الديكتاتورية.
منغصات كثيرة تهدد ثورة ليبيا. ومن هنا ينبغي للمثقف أن يقوم بواجبه ودوره بحيادية ومهنية. يمكنه أن ينحاز إلى أحد الطرفين، لكن ينبغي أن يؤدي دوره بموضوعية، وإقصاء أيٍّ من التيارين لن يكون لصالح الديموقراطية. بل الصحيح محاورته والوصول معه إلى نقاط اتفاق ومساعدته على قبول الطرف الآخر والانخراط في لعبة الديموقراطية بشفافية من خلال التداول الطبيعي للسلطة. فالمنافسة تنتهي بإعلان الفائز. وينبغي للمثقف أن يساعد في انتشار الوعى وتطوير التعليم وإطلاق البرامج الثقافية التي ترفع من المستوى الثقافي للفرد كي تكون له رؤية تبعده عن الحال التي يعيشها معظم الناخبين شبه الأميين.
دمّر القذافي التعليم طوال 42 عاماً، فلا تستغرب الآن البتة أن تجد مهندساً أو طبيباً ليبياً لا يجيد الكتابة ولا القراءة. كان التعليم في زمنه هشا جدا ومعظم شهادات الدكتوراة والماجستير وخصوصاً التي يتم الحصول عليها من خارج ليبيا مشتراة بالمال والهدايا والرشاوى وحتى بالدعارة أحيانا. وامتدت هذه الحال إلى أسرة الديكتاتور حيث اشترى ابنه سيف الإسلام شهادة دكتوراه من بريطانيا ويقال إن أحد ساسة الثورة الكبار الآن كان كتب له الأطروحة. نلاحظ جدا أن أكثر الحاصلين على شهادات من خارج ليبيا لا يمكنهم العمل بهذه الشهادات في دول أخرى ولا في الدولة المانحة.
لا يمكن ليبيا أن تنهض من دون الاهتمام بالبنية الثقافية العامة من تعليم وانفتاح على العالم الخارجي وابتعاد عن التطرف والتزمت وإطلاق الحريات إلى آخر مدى وتشجيع قيام مؤسسات المجتمع المدني وإشراكها في الحراك العام وإصدار دستور يلبي طموحات الشعب الليبي ونزع السلاح من الميليشيات وتأسيس الجيش الوطني على أسس سليمة عصرية من خلال تجديد دمائه واستبعاد الجنرالات الذين تجاوزهم الزمن الآن.
هذه الأمور ليست مستحيلة وهي في متناول الشعب، والصراع ينبغي أن يحدث الآن من أجل بناء ليبيا وليس تدميرها.
الغريب أن المتصارعين الآن كانوا في سبات ويفاوضون الطاغية من أجل الفتات والافادة الشخصية، وعندما قضى لهم الشعب على الطاغية قفزوا من العربة مستغلين الفراغ السياسي الذي يعيشه الشعب فشكلوا المجالس المحلية واللجان وغيرها وانقضوا على مفاصل الدولة أو بالأحرى على أموال الشعب السائلة والمجمدة والتي تحت الأرض في وقت ينبغي فيه أن يخجلوا ويكونوا في الصفوف الخلفية مفسحين الطريق للدماء الجديدة التى واجهت الديكتاتور وقارعته.
حتى الآن في ليبيا لا يوجد اتحاد للكتاب ولا نقابة فاعلة للصحافيين أو نواد أدبية تؤثر في مسار الحياة. في الآونة الأخيرة تم اقتراح قانون يسيطر على الصحافة هو نفسه الذي كان مستخدما أيام الديكتاتور وتم اقتراح إنشاء وزارة للإعلام للسيطرة عليه. الحال الإعلامية تعج بالفوضى. الفضائيات الليبية والإذاعات، مملوكة من رجال أعمال لهم أطماعهم وأهدافهم السياسية، أو مملوكة من دولة قطر. الأحزاب السياسية تابعة هي الأخرى. الثورة فعلا سُرقت لكن اللص لم يبتعد بالغنيمة.
في إمكان الشعب أن يصلح المسار. هو القوة على الأرض وليس على الورق. الدول الأجنبية والعربية الداعمة لن تقف مع حزب يسقطه الشعب، وستغير سياستها بدعم الشعب الذي أطاح الأحزاب السارقة كما أطاح الديكتاتور القاتل. ستقف مع الشعب المنتصر أو مع الطرف الأقوى دائما لأن الضعيف لن يحقق لها مصالحها في ليبيا. ولا بأس بالتعاطي مع الطرف القوي فهو سيمنحنا القليل لكن هذا القليل مضمون وفي مأمن وأفضل من الكثير الهش الذي تذروه رياح الثورة في كل لحظة.
المثقفون في ليبيا احتضنوا ثورة الشباب ومنحوها الزخم المعنوي وأوصلوا صوتها إلى العالم وتضامنوا معها وحاربوا في صفوفها واستشهدوا مع ثوارها، لكن عندما تحررت ليبيا وبدأ وقت الغنائم عاش معظمهم اللحظة كما يلخصها هذا البيت:
ينبئك من شهد الوقيعة أنني أغشى الوغى وأعفّ عند المغنم
لكن هل يترك المثقف شعبه فريسة لهؤلاء الطامعين؟ هل يترك المثقف شعبه الذي لا يعي معظمه اللعبة ويتم إسكاته وتحييده بمنحة؟ لا. المثقف سيعلم الشعب. سيفتح له مدرسة قلبه. سيفتح له ليبيا الحقيقية التي تقدم إليه الآن زائفة. سيحرضه كي لا يكون كسولا. كي يعمل ويتثقف ويعيش الحضارة والرقي.
هناك مثقفون وثوار مُنحوا مقاعد نيابية وحقائب وزارية فنسوا زملاءهم المثقفين الذين كان يفترض أن يتعاونوا معهم لإصلاح ما يمكن إصلاحه.
نقول لهؤلاء: لكم الكراسي والمراحيض ذات المناديل المعطرة ولنا الشعب. فهو في النهاية سيصافحنا في الشارع بينما سيصب لعناته على من جعل عجلة ليبيا تتوقف وتفقد هواءها تدريجيا.
النهار