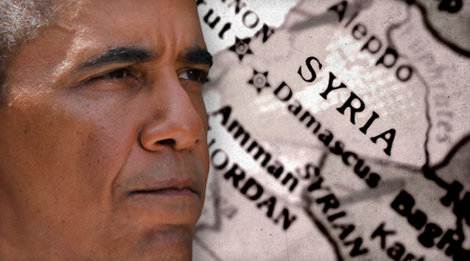مقالات مختارة تناولت “عقيدة أوباما”

بأيّ معنى «نعم، يستطيع» الانسحاب من الشرق الأوسط؟/ سامر فرنجيّة
وُوجِهت مقابلة مجلة «أتلانتيك» مع الرئيس الأميركي بكمّ هائل من الانتقادات، مفادها أن أوباما تخلى عن الدور التاريخي للولايات المتّحدة، مفسحاً المجال أمام قوى إقليمية كي تستفيد من الفراغ الذي تركه وراءه. بيد أنّ هذه القراءة لتصريحات أوباما الأخيرة، وإن كانت تصحّ في المدى القريب، تتجاهل القناعة الاستراتيجية التي عبّر عنها، والتي لا تختلف كثيراً عن مقابلة الصحافي توماس فريدمان له حول الاتفاق مع إيران قبل بضعة أشهر. ومفاد هذه القناعة، بخاصة بعد تجربة العراق، أنّ الشرق الأوسط أصبح منطقة «غير قابلة للحكم». لم ينف الرئيس الأميركي دور بلاده في أزمة المنطقة، ولكنه برر قناعته بالاستناد إلى بقايا خطابات «استشراقية» عن صراع أزلي بين «قبائل»، ليستنتج ضرورة عدم التدخّل في صراعات كهذه مقارنة بتدخلات «أنفع» في آسيا أو جنوب أميركا، قالباً رأساً على عقب المقولة المعتادة القائمة على ربط الاستشراق بالتدخّل الكولونيالي.
بهذا المعنى، يمكن اعتبار موقف أوباما أقرب بكثير إلى «روحية العصر» من مواقف نقّاده، أكانوا من الليبراليين الداعمين للتدخّل الخارجي أو محافظين جدداً. فمن جهة، بات هناك ميل «انعزالي» يخرق الحدود الأيديولوجية المعتادة في الغرب، ويرفض التدخّل المكلف لحل النزاعات «البعيدة». ومن جهة أخرى، هناك قناعة غربية بأن الشرق الأوسط بحدوده الحالية وأنظمته المتهاوية لن يُصلَح عبر تدخّل أو عدمه، وأنه بات أشبه بمشكلة يجب إدارتها بحماية الحدود من عدواها المحتملة، وتحويل دول الجوار، كتركيا، حاميةً لهذه الحدود. من هنا انتقاد أوباما للحلفاء الموكلين إدارة هذه المنطقة غير القابلة للحكم، والذين باتوا يعانون أزماتهم الخاصة. فمقابلة أوباما أقرب إلى تحدٍ رفعه في وجه الحلفاء في العالم، مفاده أنّ الشرق الأوسط يحتاج إلى عملية تدخل سياسي وعسكري ضخمة، وأنّ الولايات المتحدة، بوصفها أقل المتضررين تضرراً من هذه المنطقة، غير قابلة أو قادرة على قيادته.
وعلى رغم المذاق الكولونيالي لكثير من هذه المواقف أو النقاشات، بخاصة تلك التي تدور في الصحف حول ضرورة إعادة رسم حدود الشرق الأوسط، تبدو اليوم الخلاصة القائلة إنّ المنطقة في أزمة بنيوية لن تخرج منها إلاّ بعد عملية إعادة هندسة سياسية ضخمة منطلقاً لا مفر منه. فقد جاء الإعلان الأخير لأحزاب كردية بتبني «الفيديرالية» كمسوّدة للحل في سورية، وإن كانت قابلة للتفاوض، ليؤكد أنّ حدود المنطقة وطبيعة أنظمتها باتت على المحك. وربّما كان قرار الفيديرالية إعلاناً من أصحابه الأحزاب الكردية عن عدم انتمائهم إلى المنطقة غير القابلة للحكم، وطلب عضوية في دول الجوار التي تديرها. وليس التقاء المعارضة السورية والنظام البعثي على الرفض المبدئي لهذه الصيغة إلاّ تأكيداً بأنّ ثنائية الثورة باتت غير قادرة على حل المشاكل التي تواجه سورية، وبدأت تُستبدل بثلاثية أشبه بالوضع العراقي. ويتكرّر ترابط مسألة الحدود بأزمة طبيعة النظام في الدولتيّن المجاورتين لسورية. ففي العراق الذي يشهد فشل المحاولة الفيديرالية، تتفاقم المسألة الطائفية مصحوبة بأزمة معيشية، لتطرح معضلة الإجماع السياسي وطبيعة الحدود واستمراريتها. أما في لبنان، فأزمة النظام التوافقي أخذت شكل فشل المؤسسات المركزية في إدارة الإجماع السياسي والاقتصاد الوطني وصولاً إلى مسألة النفايات. ويشهد البلد محاولات متزايدة للانفكاك عن هذه الدولة، أكان «عسكرياً» أو «طائفياً» أو «خدماتياً».
فما يجمع الدول المنكوبة هو الترابط بين فشل النظام في إدارة عملية الإجماع السياسي والانهيار المحتمل للحدود الضابطة للحقل السياسي، وهو ما يخلق تداخلاً بين الأزمات. وبالعودة إلى مقابلة الرئيس الأميركي وتحديه، وفي مواجهة ترابط الأزمات الثلاث التي تشكّل هذه المنطقة «غير القابلة للحكم»، بات لكلام عن تدخّل أميركي لدعم المعارضة أو تدخل روسي لتعديل موازين القوى يتجاهل عمق الأزمات التي تواجه هذه المنطقة، والتي قرر أوباما التخلي عنها ببساطة لأنه يستطيع. وهنا لم يخطئ في تقديره أنّ أي تدخّل في سورية، مهما كان محدوداً، سيتطلب في ظل هذه الأزمات تدخلاً أوسع لإدارة ما سيخلفه هذا التدخّل، والذي بات يستحيل على الولايات المتّحدة، بكل عظمتها، القيام به. وفي وضع كهذا، أخذ أوباما على عاتقه الانسحاب من منطقة رأى أن لا جدوى من التدخّل فيها بحيث يورث الرئيس المقبل سياسة خارجية أقل أعباء.
غير أن تحدي أوباما ليس موجهاً حصرياً الى حلفائه السياسيين، فهو ينطوي ضمناً على سؤال موجه إلى سكان منطقة الموت هذه. فهو، من جهة، أقرّ بما قد يكون المقولة الأساسية لجميع منتقدي السياسات الأميركية، بخاصة منذ احتلال العراق، وهي أنّ التدخّل الخارجي أحد الأسباب الأساسية لأزمات هذه المنطقة، مفضلاً الانكفاء عن هذا الدور. لكنه أعلن، من جهة أخرى، انتهاء أهمية هذه المنطقة، ودخولها في حال من الفوضى والقتل، بحيث لم تعد تحتاج إلى أكثر من شرطة حدود تضبط تأثيراتها.
لقد رحل أوباما عن المنطقة، لكنّه أخذ معه كامل المقولات التي أكدّت على مدار القرن الفائت أهمية ومركزية الشرق الأوسط للعالم، من تلك الجيو-استراتيجية إلى المسألة الإسرائيلية، وصولاً إلى النفط ومن بعده الإرهاب. أما أيتام هذه القضايا، فلم يبق لهم إلاّ مواجهة حقيقة جديدة، وهي أن ميزتهم الأساسية باتت أنّهم سكان منطقة غير قابلة للحكم.
وقد تحتاج المرحلة الجديدة خطوات كالتي قام بها بعض الأحزاب الكردية في طرح مسألة الإجماع والنظام والحدود، على رغم كل الاعتراضات التي يمكن أن توجه إلى هذه الخطوة. بيد أنّ الالتفات إلى تلك المسائل يحتاج إلى إعادة بحث في المنظومة السياسية العربية، بعيداً من القضايا الكبرى باتجاه أهداف أكثر تواضعاً، لا تدعي تحقيق شيء أكثر من بناء مجتمعات أقل قسوة من التي نعيش فيها. وخطاب كهذا قد يغري العالم الخارجي بالعودة إلينا أكثر مما يفعل عرض مصادر أهميتنا المعتادة، من النفط إلى شريط لـ «داعش» أو تهديد باحتمال قنبلة نووية.
* كاتب لبناني
الحياة
أوباما والإحساس بالذنب كحاكم/ حازم صاغية
بإعلان باراك أوباما رغبته في زيارة هيروشيما يكتمل عقد التكفير الذاتيّ والاعتذار. فهيروشيما وناغازاكي اليابانيّتان، كما يعرف القاصي والداني، ضُربتا بالسلاح الذريّ الأميركيّ في خواتم الحرب العالميّة الثانية. أمّا كوبا التي زارها لتوّه، فهي الجزيرة المجاورة للبرّ الأميركيّ والتي حاصرتها واشنطن ردّاً على مصادرة الأملاك الأميركيّة بُعيد انتصار ثورة كاسترو في 1959. وإيران التي وقّعت معها الولايات المتّحدة وبقية الدول الكبرى الاتّفاق النوويّ، هي الدولة التي رعت واشنطن، عام 1953، انقلاباً عسكريّاً فيها نفّذه الجنرال زاهدي، وأطاح رئيس حكومتها المنتخب محمّد مصدّق إثر تأميمه الصناعة النفطيّة. وتردّد أيضاً أنّ أوباما ينوي زيارة فيتنام قبل انتهاء ولايته، ما يستدعي إلى الذاكرة فوراً الحرب الأميركيّة في فيتنام التي صارت من ملاحم القرن العشرين.
وفي هذا التوجّه شيء من الحسّ الأقلّيّ الذي صدر عنه أوباما كأفرو – أميركيّ ونجل لمسلم، وقد عُكس على الخارج الذي يُعدّ مقهوراً مثله مثل الأقلّيّات، فيما توصف أميركا بأنّها مصدر القهرين.
إلاّ أنّ الملاحظة الأولى التي تتبادر إلى الذهن أنّ العالم العربيّ لا يقع في مدار الشعور الأميركيّ بالذنب، على رغم العلاقة الشديدة التعقيد بين الولايات المتّحدة والعرب التي يردّها بعضهم إلى دعم واشنطن إسرائيل، أقلّه منذ 1967. ولربّما أحال أوباما موضوع العرب والذنب حيالهم إلى الأوروبيّين باعتبارهم هم، لا أميركا، الاستعمار التقليديّ للعالم العربيّ، بما فيه الاستيطان الفرنسيّ في الجزائر. لكنّ المرجّح أنّه، مثل بقية رؤساء أميركا، اعتبر الموضوع الإسرائيليّ – الفلسطينيّ أقرب إلى أن يكون داخلاً أميركيّاً من أن يُدرج في حسابات الخارج.
على أيّة حال، إذا كان الشعور بالذنب يحكم السلوك الأوباميّ حيال البلدان التي زارها وسيزورها، والتي عقد أو سيعقد اتّفاقات معها، بقي أنّ هذا الشعور ليس أصلح الحكّام دائماً. فهو، من غير شكّ، من علامات التمدّن ومن نتائجه، على ما تُبديه بصفة خاصّة زيارة هيروشيما المحتملة، فضلاً عن كونه دليلاً على منح القيميّ والثقافيّ والمجتمعيّ مواقع أكبر في صناعة القرار السياسيّ. لكنّه، إلى ذلك، يثير تحفّظين قد يجعلانه نقيض الغرض الأصليّ المتوخّى منه.
فممّا ينطوي عليه هذا السلوك ضمناً افتراض استمراريّة قوميّة عابرة للأطوار والتحوّلات السياسيّة. وهذا ما يتجلّى خصوصاً في حالة إيران وما يخمّنه بعضهم اعتذاراً منها. ذاك أنّه ما من صلة بتاتاً بين مصدّق والنظام الحاليّ سوى إقدام الأخير على تصفية بقايا المصدّقيّين سياسيّاً وأحياناً جسديّاً. ثمّ إنّ السلف الديموقراطيّ لأوباما، أي جيمي كارتر، سبق أن أضعف شاه إيران بسياسته في «حقوق الإنسان»، ربّما كاعتذار ضمنيّ من الشعب الإيرانيّ عمّا حصل في 1953. لكنّ التجاوب الذي حُرم الإيرانيّون من إبدائه، أبداه النظام الذي احتلّ السفارة الأميركيّة في طهران واحتجز موظّفيها 444 يوماً.
ويصحّ الأمر جزئيّاً على حقبة الحرب الباردة. فإذا جاز أنّ السياسة الأميركيّة حينذاك ليست ممّا يُدافَع عنه، إلاّ أنّه لا يجوز النظر إليها في معزل عن الصراع المحتدم مع الاتّحاد السوفياتيّ. وهذا الأخير لم يكن يمارس عزف البيانو في هنغاريا 1956 وتشيكوسلوفاكيا 1968، أو في الشرق الأوسط حين سلّح وعزّز أشرس الأنظمة العسكريّة والأمنيّة كالنظامين البعثيّين في سوريّة والعراق.
ومن جهة أخرى، فإنّ أوباما إذ يعتذر عن أميركا، يفترض في نفسه تمثيلاً قوميّاً لمسؤوليّة جماعيّة أميركيّة. وهذا الزعم التمثيليّ أكثريّ بطبيعته وليس أقلّيّاً، فضلاً عن انطوائه على تنقية للذات الأميركيّة بما يجعلها متعالية ومنزّهة عن ارتكاب الشرّ أو حتّى الخطأ. وفي هذا كلّه نكهة قوميّة مفادها بأنّنا انتصرنا كثيراً، وأنّه لا بدّ من تواضع مبالغ فيه قد يتجسّد على هيئة تسفيل للنفس هو وجه آخر لإعلائها.
الحياة
عقيدة أوباما وقواعد واشنطن/ بدر الإبراهيم
سياسة الرئيس الأميركي باراك أوباما مثيرة للجدل، وتُواجه بنقدٍ عنيف، ليس فقط من مناوئيه الجمهوريين، وإنما من بعض الديمقراطيين أيضاً، وبعض حلفاء الولايات المتحدة في العالم، ويتمحور النقد أساساً حول تقاعس أوباما عن اتخاذ قراراتٍ حاسمةٍ ضروريةٍ بخصوص استخدام القوة الأميركية، لا سيما في أزمات منطقتنا العربية.
كتب جيفري غولدبيرغ مقالاً مطولاً في مجلة ذي أتلانتك، شمل مجموعة أحاديث طويلة مع أوباما، أُجريت على مدى شهور، يتحدّث فيها عن رؤيته للسياسة الخارجية، أو ما سماها الكاتب في عنوان مقاله “عقيدة أوباما”، ويحاول أوباما الرد على منتقديه، موحياً أنه انفصل عن كتاب “قواعد واشنطن”، وهو يقصد أن هناك قواعد في التعامل مع الأحداث المختلفة، أرستها مؤسسة السياسة الخارجية، ويُفترض أن يلتزم بها الرؤساء المتعاقبون في واشنطن، تميل عادةً إلى الردود العسكرية في التعاطي مع الأزمات، فيما يرى أوباما أن اتباع كتاب القواعد هذا يمكن أن يكون فخاً مؤدياً إلى اتخاذ قراراتٍ سيئة، بينما هناك أسبابٌ وجيهةٌ في بعض الحالات لعدم الأخذ بهذه القواعد، كما في رفضه استخدام القوة بشكل مباشر في سورية.
هل يقرأ أوباما من كتابٍ آخر غير كتاب قواعد واشنطن؟ لا شيء يدل على ذلك، بل هو في الحقيقة يطبّق قواعد واشنطن القاضية باستخدام القوة العسكرية، بوصفها جزءاً رئيساً من الدور الأميركي في العالم، وتمظهر الهيمنة الأميركية، لكنه يتخفّف من كلفة استخدام القوة، ويحاول تقليلها قدر الإمكان، ويرفض خوض مغامراتٍ على طريقة سلفه جورج بوش الابن.
يرى أوباما أنه ليس انعزالياً في سياسته الخارجية، بل واقعي، والواقعية تقتضي اختيار المكان الذي يمكن للولايات المتحدة أن يكون لها فيه تأثير حقيقي. لكن واقعية أوباما عند التدقيق فيها، بعيداً عن اختياراته للكلمات المنمقة، ليست إلا سياسة تقشف، تمنع التوسّع في التدخلات العسكرية وتضبطها، وهي تقوم باختصار على: “التراجع، وخفض النفقات، والحد من المجازفة، ونقل الأعباء إلى الحلفاء”، كما يوضح ستيفن سيستانوفيتش، خبير السياسة الخارجية الرئاسية في مجلس العلاقات الخارجية، ويضيف أنه لو تم انتخاب جون ماكين عام 2008 لرأينا درجة من التقشف، لأن هذا ما أرادته الدولة، بعد حربٍ لم تسر بشكلٍ إيجابي في العراق. يشير هذا إلى أن أوباما لم يختلف سوى في درجة التقشف، وفي تقديراته لما يجب أن يتدخّل فيه وما لا يجب، وهو مثل بقية الرؤساء خاض حروباً وشغّل الآلة العسكرية الأميركية، لكنه اختلف عن جورج بوش الابن، في عدم خوضه مغامراتٍ كبيرة، والاعتماد على تقليل النفقات بسبب مغامرات الأخير، وترجم هذا بالاعتماد على سلاح الطيران دون القوات البرية، كما في ليبيا ثم ضد تنظيم داعش في العراق وسورية، وخوض حروب الطائرات من دون طيار، في اليمن وباكستان وأفغانستان.
“عقيدة أوباما في استمرار لوم الآخرين على بؤسهم، مع تجاهل دوره باعتباره واحداً من صنّاع هذا البؤس”
اعتمد أوباما أيضاً على إشراك الحلفاء في تحمل المسؤولية، وهو يرفض فكرة “الانتفاع بالمجان” التي يطبقها بعض حلفائه، ويضرب مثلاً بالتدخل في ليبيا، إذ يؤكد أن الفرنسيين والبريطانيين لم يتحملوا مسؤولياتهم بالشكل الكافي، وأنه حاول إعطاء دورٍ لفرنسا في قيادة التحالف وبنائه، لدفعها إلى العمل أكثر، على الرغم من أن أميركا هي التي أوجدت البنية التحتية للتدخل. توجه أوباما يشدد على العمل المشترك عبر أحلاف، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بقضيةٍ لا تشكل تهديداً مباشراً للأمن القومي الأميركي، وهو يعتمد على وجود قوةٍ تقاتل على الأرض، نيابة عن الجنود الأميركيين، وهكذا يدير حربه على “الإرهاب”، وتحديداً ضد تنظيم داعش، كما يشرح مسؤولون في إدارته: سلاحٌ جوي، وعمليات للقوات الخاصة، وعملٌ استخباراتي سري مع جيشٍ من آلاف المتمردين في سورية.
حجم التوقعات من أوباما، وتوقعاته من حلفائه أيضاً، أصابت الطرفين بخيبة أمل متبادلة، من دون إغفال نظرة أوباما قبل ذلك إلى بعض حلفاء أميركا التقليديين، وعدم قناعته بالتعامل معهم، وعلى الرغم من ذلك، كان واقعياً في التزامه بقواعد واشنطن في تعاطيه معهم، مع هامش اختلاف. التدقيق في سياسة أوباما تظهر التزاماً بالمؤسسة ورؤيتها، وامتلاكه، في الوقت نفسه، هامش مناورةٍ ما، مكنه من الظهور بمظهر المختلف عن رؤساءَ طبقوا قواعد واشنطن، لكنه في المجمل طبّق سياسة تقشف، يبدو أنها تترك بصمتها حتى على برامج مناوئيه من مرشحي الحزب الجمهوري.
لعل حديث أوباما غير مرة عن حاجة المسلمين إلى القيام بإصلاحاتٍ تُكيِّف الإسلام مع الحداثة، تشير إلى محاولته التهرّب من الأزمة التي تشكلها التدخلات الإمبريالية لأميركا في المنطقة العربية، فقد دعا المسلمين إلى التوقف عن التظاهر بأن سبب مشكلات المنطقة هي إسرائيل، التي تبرز نموذجاً واضحاً لأعمال الهيمنة الاستعمارية الغربية. تغدو المشكلة ثقافيةً، تتعلق بمواءمة الإسلام مع الحداثة، في حين لا يرى أوباما أن التدخلات الأميركية تُشكِّل قبله (ومعه في شكلها الأقل كلفة ومجازفة) رفضاً لكل تجربة للتحديث وبناء ذاتٍ مستقلة في المنطقة.
إنها عقيدة أوباما في استمرار لوم الآخرين على بؤسهم، مع تجاهل دوره باعتباره واحداً من صنّاع هذا البؤس، ودعوة هؤلاء إلى تعديل أوضاعهم، بما يتلاءم مع الانضواء تحت مظلة الهيمنة الأميركية.
العربي الجديد
أوروبا ليست عالة على النظام الدولي ولا راكباً خلسة/ سيمون دي غالبير
لا يحمل جديداً قول باراك أوباما أن الأوروبيين هم «ركاب مجاناً» يستفيدون من النظام العالمي الذي ترعاه الولايات المتحدة من غير مساهمة يعتد بها. فهو قول بالٍ أو متقادم في واشنطن. بالتالي، لم يخرج الرئيس الأميركي عن «قواعد اللعبة في واشنطن» حين شكا إلى جيفري غولدبيرغ تهرب الأوروبيين من تسديد «حصة عادلة» في الشؤون المعولمة. ودار كلام أوباما على مناوأته «الركاب المجانيين» أو من هم عالة على المجتمع الدولي، حين حمل حلفاءه الأوروبيين على قيادة حملة «الأطلسي» على ليبيا في 2011. وكان لانتقادات أوباما وقع المفاجأة على الأوروبيين في وقت تعاظمت الإنجازات المشتركة بين الحلفاء «الأطلسيين». فالرئيس الأميركي عوّل على الحلفاء في السياسة الخارجية أكثر من أسلافه. وسبق أن تذمر روبرت غيتس، وزير الدفاع الأميركي في ولاية أوباما الأولى و (تذمرت) إدارة سلفه جورج دبليو بوش، من شرخ بين دول الأطلسي، فمنها من يرغب في تحمل كلفة الالتزامات، وأخرى تستفيد من عضوية الحلف من غير رغبة في اقتسام عبء الأخطار والكلفة. وشأن غيتس، دعا ليون بانيتا (وزير الدفاع الأميركي بين 2011 و2013) الأوروبيين إلى زيادة الإنفاق الدفاعي في قارتهم. وهذه انتقادات كانت في محلها. فموازنات الدفاع الأوروبية، وهي تشمل مساهمة في موازنة «الناتو» الدفاعية، تقلصت منذ نهاية الحرب الباردة. لكن انتقادات أوباما اليوم لا تحتسب التغيرات الأخيرة. فللمرة الأولى منذ سنوات، عدلت الدول الأوروبية عن تقليص النفقات الدفاعية، باستثناء عدد قليل منها. فالأحوال الأمنية تغيرت في القارة على وقع تجدد التنافس بين القوى الكبرى، وتعاظم خطر روسيا إلى الشرق وفراغ القوة الذي يؤجج الاضطراب والإرهاب والهجرة من الجنوب. وعلى رغم أن الدول الأوروبية لن ترفع كلها الإنفاق العسكري إلى 2 في المئة من ناتجها القومي، على نحو ما يطلب «الناتو»، بلغت دول أوروبية بارزة مثل بريطانيا وبولندا هذه النسبة، وتوشك فرنسا على بلوغها، وألمانيا ترفع موارد الدفاع المالية.
ويعتبر أوباما أن الحلفاء الأميركيين درجوا في «العقود الماضية» على حمل الولايات المتحدة على الإقدام، ثم التقاعس عن المساهمة. لكن إلقاء نظرة على العمليات العسكرية الأميركية منذ نهاية الحرب الباردة، يظهر أن الأوروبيين نادراً ما «دفعوا» أميركا إلى عمليات عسكرية، وغالباً ما شاركوا فيها على رغم أن مصالحهم لم تكن مهددة. وحملة أوباما على «الركاب مجاناً» هي أولوية مستهجنة في وقت تجبه الحلفاء على ضفتي الأطلسي تحديات مشتركة. الأوروبيون لم «يدفعوا» أميركا إلى حرب الخليج الأولى في العراق في 1991، بل دعموا القوات الأميركية ومدوها بعشرات آلاف الجنود. وحين كانت مصالحهم المباشرة على المحك، غلب التردد على موقفهم من حملة «أطلسية» تقودها أميركا في البلقان بين 1995 و1999. لكنهم شاركوا في الحملة الأطلسية العسكرية بعد استنفاد الحلول الديبلوماسية، ولعبوا دوراً بارزاً في إرساء الاستقرار في يوغوسلافيا السابقة. وإثر هجمات الحادي عشر من أيلول (سبتمبر) 2001، أجمع القادة الأوروبيون على دعم التدخل الأميركي في أفغانستان، على رغم أن مصالحهم المباشرة في هذا البلد لا يعتد بها. وشارك آلاف من جنودهم في الائتلاف الدولي بقيادة أطلسية منذ 2001 من غير أن يؤيد قادتهم القرار الأميركي اجتياح أفغانستان. ولا يخفى أن الأوروبيين لم يكونوا وراء غزو أميركا العراق عام 2003، ولو شاركت بريطانيا وإسبانيا في الائتلاف الدولي، على خلاف دول مثل فرنسا وألمانيا.
والحال أن الأميركيين هم من دعا الأوروبيين إلى دعم حملات عسكرية، ولو انقلبت الآية رأساً على عقب في الأعوام الأخيرة حين دعت فرنسا وبريطانيا – ومسؤولون في إدارة أوباما – أميركا الى المشاركة في التدخل العسكري في ليبيا في 2011. خلافاً لما أكده أوباما، بادرت المقاتلات الفرنسية إلى حماية بنغازي قبل تدمير القوات الأميركية أسلحة الدفاع الجوي الليبية. وخلص تقرير استقصائي نشرته صحيفة «نيويورك تايمز» أخيراً إلى أن الإخفاق في إرساء الاستقرار في ليبيا إثر الحملة العسكرية كان وليد عدد من العوامل، أبرزها تردد الحكومة الليبية الجديدة في الترحيب بمساهمة قوى خارجية في إرساء الاستقرار في مرحلة ما بعد القذافي. وعلى رغم الإخفاقات في هذا البلد، ما نجم عن التدخل الرامي إلى تفادي كارثة إنسانية في ليبيا لا يزال أفضل من مآل الأمور نتيجة وقوف الغرب موقف المتفرج في سورية منذ 2011، أو مما نجم عن تدخله غير المسوّغ في العراق عام 2003. وقبل رفض البرلمان البريطاني المصادقة على عملية في سورية، دعت بريطانيا وفرنسا إلى رد عسكري على استخدام بشار الأسد الأسلحة الكيماوية ضد السوريين في آب (أغسطس) 2013. بدا يومذاك أن الضربات الجوية قد تغيّر مسار حرب قد تزعزع استقرار أوروبا. وأيدت لندن وباريس الضربات، إثر إعلان واشنطن أنها سترد على انتهاك سورية معايير حظر استخدام السلاح الكيماوي. والحملة المتواصلة على «داعش» لم يفرضها الأوروبيون على الولايات المتحدة. ولا شك في أن عدد الدول الأوروبية قليل في هذه الحملة، وحري بها زيادة مساهمتها. وفي العام الماضي، قادت حاملة الطائرات الفرنسية العمليات على «داعش»، في وقت كانت حاملة الطائرات الأميركية في الصيانة وخارج الخدمة في الشرق الأوسط للمرة الأولى منذ نحو عقد.
والأزمة السورية سلطت الضوء على نازع شائك في الحلف الأطلسي: ففي بعض الأحوال، تتردد الدول الأوروبية في شن عمليات عسكرية من غير مساهمة أميركية، ولو كانت كفة مصالح أوروبا ترجح على المصالح الأميركية. لكن التدخل الفرنسي في مالي عام 2013، لم يحتج إلى قيادة أميركية ولا دعم أميركي، شأن تدخل فرنسا في منطقة الساحل الأفريقي وفي جمهورية وسط اأفريقيا. ودور الأوروبيين الديبلوماسي يدحض وصفهم بـ «ركاب مجاناً». فالاتفاق النووي الإيراني المبرم في تموز (يوليو) 2015، هو ثمرة مساع ديبلوماسية أميركية وأوروبية. وعلى رغم أن واشنطن هي مَن دعا الأوروبيين إلى تشديد طوق العقوبات التجارية على إيران، لم يكن لها فضل في نجاعة العقوبات. فالعلاقات الأميركية – الإيرانية التجارية مقطوعة منذ 1979. ولو لم يدعم الأوروبيون العقوبات لما قيد لثمارها أن تنعقد. وهم من تكبد شطراً راجحاً من الخسائر الناجمة عنها. والعقوبات على روسيا والتي أدت إلى إبرام ألمانيا وفرنسا وقف نار هشاً في أوكرانيا في 2015، تحمّل آلامها الاقتصادية الأوروبيون وليس الشركات الأميركية. واعتمدت إدارة إوباما على هؤلاء الحلفاء في جبه الأزمة الناجمة عن ضم روسيا شبه جزيرة القرم وتدخلها في شرق أوكرانيا.
* ديبلوماسي فرنسي، باحث، عن «ذي أتلانتيك» الأميركية، 24/3/2016،
إعداد منال نحاس
الحياة
عقيدة أوباما: اللعنة على الشرق الأوسط!
رأي القدس
يزور الرئيس الأمريكي باراك أوباما في نيسان/ابريل المقبل كلاً من بريطانيا، حليفته الكبرى في أوروبا، والسعودية، حليفته الكبرى في المنطقة العربية، وذلك بعد دراسة تحليلية استندت إلى لقاءات معه في مجلة «ذي أتلانتيك» وجّه فيها انتقادات لطريقة تعامل رئيس الوزراء البريطاني الحالي مع قضية التدخل العسكريّ في ليبيا للإطاحة بالعقيد معمّر القذافي، كما وجّه فيها انتقادات لاذعة أخرى أثارت غضباً شديداً عليه في الرياض.
الزيارتان، ضمن هذا السياق، هما محاولة من أوباما لمداهنة حليفتيه التقليديتين وذلك قبل أن يتوارى من المشهد السياسي العالمي في بداية السنة المقبلة، كما يجمع بينهما موضوع ما يسمى «الشرق الأوسط» وأزماته المستعصية؛ ويبدو الرئيس الأمريكي، في الحالتين، منزعجاً من أن بصمته «الكربونية» (على حدّ وصفه للأثر السلبيّ لدخان طائرته الرئاسية على المناخ العالمي) على سياسات العالم لن تكون بالنصاعة التي كان يريدها الرئيس الحائز على جائزة نوبل للسلام.
البريطانيون تعاملوا بأسلوب التجاهل البارد مع «نكزات» الرئيس الأمريكي، غير أن السعودية، لا تستطيع أبداً تجاهل الكمّ الهائل من الانتقادات لأنها، في الحقيقة، لا تعبّر عن «فشّة خلق» نرجسية منطوقها، في الحالة البريطانية، هو «لماذا أحرجتموني فاضطررت للمشاركة في التدخل العسكري. لقد اعتمدت عليكم ولم تكملوا المهمة بشكل جيد»، بل هي رؤية متكاملة تهدم أسس العلاقة الاستراتيجية المفترضة بين واشنطن والرياض، وتعيد رسم استراتيجية شرق أوسطية جديدة خطيرة يبتعد فيها البيت الأبيض عن المملكة بقدر اقترابه من خصمها الإقليمي الرئيسي، إيران، وهو ما عبّر أوباما عنه بالقول: «على السعوديين أن يتشاركوا مع أعدائهم الإيرانيين في الشرق الأوسط».
تحليل المجلة الأمريكية لـ «عقيدة أوباما»، يقدّم في الحقيقة، رؤية سطحية عامّة حول القضايا العربية لا تلاحظ غير مساوئ العرب (والسعوديين على رأسهم طبعا) وتتغاضى تماماً عن الدور الأمريكي في المآل الذي وصلت إليه المنطقة، فتجمع، لتحقيق ذلك، الطروحات اليسارية العامّة، من قضايا المناخ واللاجئين والمرأة إلى انتقاد الاستبداد والفساد، بحيث ينصبّ جحيم هذه الانتقادات على السعودية فحسب، وتُخرج إيران (لسبب واضح) وإسرائيل (لسبب أكثر وضوحا)، من المعادلة.
إحدى النقاط الأكثر تداولاً في خطاب أوباما (وهو خطاب شعبويّ منتشر أيضاً في خطاب يتشارك على التحاجج به كل أعداء الرياض، من النخب القومية العلمانية إلى الميليشيات الشيعية) هو تحميل السعودية مسؤولية تحويل الإسلام من دين مسالم وجامع إلى دين متعصب وصارم وذلك بإغداق الأموال على المدارس الوهابية في العالم، وهو ما جعل الكثير من النساء محجبات وأدى، بحسب ما يقوله الرئيس للمجلة، إلى «غضب المسلمين الزائد» خلال السنوات القليلة الماضية!
والحقيقة أن لا شيء يمكن أن يكشف ركاكة هذا الخطاب الذائع لدى أوباما (والجوقة الكبرى التي تردده) كمثال إسرائيل.
في سؤال المجلة لأوباما عما كان يأمل من تحقيقه من خطابه الأول الموجه للعالم العربي والإسلامي في القاهرة قال: «كانت حجتي كالتالي: دعونا نتوقف جميعاً عن الادعاء بأن اسرائيل هي سبب مشاكل الشرق الأوسط».
بين فكرة أن «إسرائيل ليست سبب مشاكل الشرق الأوسط» فاصلة طويلة انتهت بطلب «التشارك مع إيران بالشرق الأوسط»، وبين النقلتين هناك نقد هائل ليس للسعودية فحسب بل لكل الدول الإسلامية، من إندونيسيا وباكستان حتى تركيا والأردن ومصر، وهناك إخلاء لمسؤولية الولايات المتحدة الأمريكية، التي هي، حسب أوباما، «قوة خيرة يمكن أن تتدخل إذا كانت التكلفة محدودة»!
لا يلاحظ نقد أوباما الاستشراقي أن تحجب النساء في العالم الإسلامي و«غضب الإسلاميين الزائد» موضوع معقّد تتداخل فيه معطيات الاجتماع والاقتصاد والسياسة والهويّة، وأنه، في حيّز منه، ردّ فعل هائل على فشل الدولة الوطنية العربيّة التي استلهمت المشروع الغربي، كما أنها ردّ على مثال الغرب الأكبر للتقدّم والحداثة: إسرائيل، وعلى شراكة الاستبداد العربي، الذي ينتقده أوباما مخليا مسؤوليته عنه، مع هذا الغرب نفسه.
الملخّص الذي يمكن أن يستفيده قارئ «عقيدة أوباما» هو: اللعنة على الشرق الأوسط!
القدس العربي
أمريكا ستخسر كثيرًا بابتعادها عن السعودية:«عقيدة سلمان» تسعي لإصلاح ما أفسدته «عقيدة أوباما
محمد خالد
قال تحليل نشره موقع «ناشيونال إنتريست» إن السعودية وحلفاءها يحاولون التقدم في المنطقة العربية لإصلاح ما أفسدته «عقيدة أوباما» القائمة على الانسحاب من المنطقة وعدم التدخل عسكريا لأسباب إنسانية (جرائم الأسد)، أو سياسية لمحاصرة النفوذ الإيراني والميليشاوي الشيعي الذي نتج عنه دول فاشلة، وتنظيم «الدولة الإسلامية».
وقال التحليل الذي كتبه المحلل السياسي السعودي «نواف عبيد» أن ما تفعله السعودية هو «عقيدة سلمان»، التي ترد بها المملكة على فشل عقيدة «أوباما» في المنطقة.
ويشير «عبيد» في التقرير الذي جاء بعنوان: «عقيدة سلمان.. الرد السعودي على ضعف أوباما» إلى أن «عقيدة أوباما» التي شرحها مقال «جيفري جولدبرغ» في مجلة «ذي أتلانتيك»، كشفت أن «أمريكا والسعودية في مسار تصادمي حول القرارات الاستراتيجية في الشرق الأوسط»، وأنها متعارضة تمامًا مع «عقيدة سلمان» التي تتبناها المملكة من أجل استعادة السلام والاستقرار في المنطقة.
ويحذر الكاتب السعودي أمريكا من أنها «ستخسر كثيرًا بابتعادها عن المملكة»، لأن «النفوذ الأمريكي في العالم العربي كان معتمدا منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، إلى حد كبير على العلاقة الخاصة مع المملكة».
وكان الرئيس «أوباما» عبر عن هذه العقيدة في حملته الانتخابية الأولى عندما قال إن «الولايات المتحدة لا تستطيع استخدام قوتها العسكرية لحل المشاكل الإنسانية»، ثم قال لمجلة «ذي أتلانتيك» أن أمريكا رفضت توريط السعودية لها في حروب طائفية، وستركز على آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية بدلا من المنطقة العربية.
وأوضحت مقالة جولدبرغ أنَّ «عقيدة أوباما» لا تظهر التردد الكبير للرئيس الأمريكي تجاه التدخل العسكري في المنطقة لقمع إيران أو الأسد أو داعش فقط، لكنها أظهرت أيضا تخليه عن العالم العربي، ودعمه المعلن لإيران القوية، حتي أنه دعا الرياض لاقتسام النفوذ معها في المنطقة.
و«هذا ما يفسر قراراته التي اتخذها بعدم مهاجمة بشار الأسد رُغم تجاوزه الخط الأحمر باستخدام الأسلحة الكيميائية، والإذعان لطموحات إيران الإقليمية وتوقيع الاتفاقية النووية، والسماح بنمو المليشيات الشيعية في العراق، وتجنب الضغط على إسرائيل بالقضية الفلسطينية، والتساهل مع تنظيم الدولة، لأنه ليس تهديدا وجوديا على الولايات المتحدة»، بحسب الكاتب.
البديل «عقيدة سلمان»
ويقول الكاتب أن الوسيلة الوحيدة لإصلاح ما أفسدته عقيدة «أوباما»، هي «عقيدة سلمان»؛ التي تري أن بشار الأسد يجب خلعه من السلطة، وأنه يجب التصدي لطموحات إيران الإقليمية والنووية، والتصدي للمليشيات الشيعية في العراق وسوريا ولبنان واليمن باعتبارها «منظمات إرهابية يجب تدميرها»، وأن العالم يجب أن يعترف بدولة فلسطين، إضافة إلى ضرورة محاربة تنظيمي «الدولة الإسلامية» و«القاعدة».
ويشير إلى أن أبرز خلاف في الرؤى بين العقيدتين، يكمن في تأكيد السعودية أن إيران هي سبب المشاكل الأمنية الكبرى في الشرق الأوسط، بينما يري «أوباما» أن السعودية «تشارك» أو «تتقاسم» النفوذ في المنطقة مع إيران، معتبرا هذا «محض هراء، بالنظر إلى أن طهران تدعم الإرهاب بشكل غير محدود»، بحسب قوله.
3 عناصر في عقيدة سلمان
ويشرح المحلل السعودي ما يقول إنها ثلاثة عناصر بارزة تميز «عقيدة سلمان» التي يشدد على أنها لم تظهر فجأة، لكن لها جذور تاريخية، وهي:
(أولًا): ظهور عقيدة سلمان جاء نتيجة «حاجة استراتيجية»، بعد الانسحاب المتزايد للقيادة الأمريكية من المنطقة، كنتيجة لعقيدة «أوباما».
(ثانيًا): أن عقيدة سلمان لها جذور في التاريخ العربي، تتعلق بمواجهة النفوذ الايراني على مدار التاريخ، ولذلك لن يسمح الملك «سلمان» لإيران، التي تسعى لإعطاء الأقلية الشيعية اليد العليا في العالم الإسلامي، بتجاوز 1400عام من وجود الأغلبية السُنية.
(ثالثا): عقيدة سلمان مدعومة بتطورات واسعة وتحوّلات كبيرة في السعودية، على المستويات العسكرية والسياسية والتحالفات العربية.
150 مليار دولار لتوسيع منظومة الدفاع
ويشرح ما قصده في الفقرة الثالثة قائلا أن: «التدخل العسكري السعودي الذي حدث خلال الخمس سنوات الماضية لم يسبق له مثيل، حيث أنفقت المملكة ما يقارب 150 مليار دولار لتوسيع منظومة الدفاع (شراء أسلحة حديثة) وسيزداد هذا المبلغ بقيمة 100 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة».
أيضا هناك تدخل سعودي عسكري متزايد في المنطقة بديل للتدخل الامريكي، حيث شارك الجيش السعودي والقوات الحليفة في عدة نقاط ساخنة، حيث تدخل في البحرين في عام 2011، وفي الحرب الحالية في اليمن لقتال الميليشيات الإيرانية، كما تشارك القوات الجوية السعودية في التحالفات المضادة لداعش في سوريا، ويتوقع أن تتوسع للعراق في المستقبل القريب.
أيضا ضمن هذه التطورات، أعلنت المملكة عن تحالف مكون من 34 دولة ضد الإرهاب (زاد فيما بعد إلى 40 دولة)، من بينهم باكستان ومصر وتركيا وماليزيا ونيجيريا، وأكمل هذا التحالف تدريبات كبيرة أُطلق عليها اسم «رعد الشمال»، حول مدينة حفر الباطن العسكرية مؤخرا، شارك به 150 ألف جندي من 20 دولة يتدربون على سيناريوهات المعركة المحتملة.
المملكة ستتدخل في العراق وسوريا
ويشدد المحلل السعودي علي أن هذا التحالف ورغم أنه يركز حاليا علي ضرب تنظيم «الدولة الإسلامية» وتنظيم «القاعدة»، إلّا أنه «يتدرب على تدخلات محتملة في العراق وسوريا ضد الميليشيات الشيعية المتنامية هناك، والمدعومة من إيران، والمكّونة مما يقارب 75 ألف مقاتل غير نظامي، مزودين بأسلحة قوية».
ويرجع هذا لتجاهل إدارة «أوباما» تلك الميليشيات، بالرغم من أنها تهديد إقليمي كبير، مؤكدا: «الأمر مسألة وقت فحسب قبل أن يضطر التحالف الجديد الذي تقوده السعودية على القيام بعمليات عسكرية داخل الأراضي السورية والعراقية».
ويختم تقريره بتأكيد أن «عقيدة أوباما» التي بشرت بحقبة جديدة من عزوف الجيش الأمريكي عن التدخل في المنطقة، «أدت إلى الفوضى ونزيف المزيد من الدماء، ولملء هذا الفراغ القاتل، كان على السعودية وحلفائها التقدم في محاولة لإعادة النظام لمنطقة تعاني من دول فاشلة، وتنظيم الدولة الإسلامية، والوكلاء الإيرانيين».
ولهذا ينصح الإدارة الامريكية الجديدة القادمة بعد «أوباما» -الذي أوشكت رئاسته على الانتهاء- أن «تكون أكثر واقعية وإيجابية تجاه دور أمريكي فعلي يستهدف جلب الاستقرار لأكثر المناطق أهمية استراتيجية في العالم (المنطقة العربية)».
الخليج الجديد