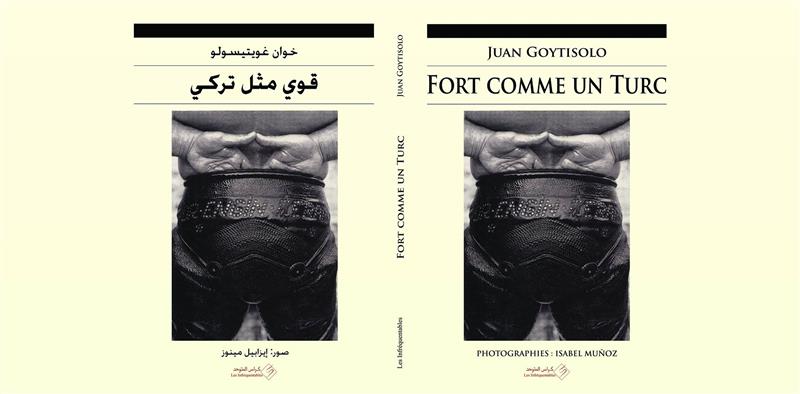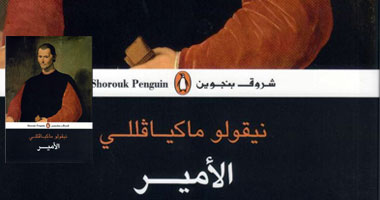مقدمة كتاب “الثقافة كسياسة” لياسين الحاج صالح
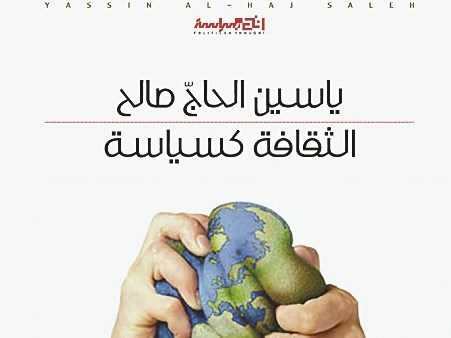
تعمل نصوص هذا الكتاب على إظهار ما هو سياسي في الثقافة، وكشف ممارسات سياسية في أعمال مثقفين، سوريين أساساً، تعطي انطباعاً بالتجرد عن السياسة والابتعاد عن الصراع السياسي. تَوجُّه الكتاب بذلك معاكس لتوجه كتابين سابقين للمؤلف هما «أساطير الآخِرين” (2011)، و”بالخلاص، يا شباب!” (2012)، وقد عملت فيهما على تحويل كلّ من الدين والسجن إلى موضوعين ثقافيين، وإدراجهما في جدول النقاش الثقافي العام.
ما يشرِط إمكان هاتين الوجهتين المتقابلتين هو أن الثقافة والسياسة ميدانان من العمل المشترك، يحوز المنخرطون فيهما على سلطات ورساميل رمزية متفاوتة، ويتعين أن يتحملوا بالمقابل مسؤوليات اجتماعية لا وجه عادلاً للتنصِّل منها. المثقف والسياسي فاعلان عامان، تترتب على ما يقومان به آثارٌ عامة، مُستوجِبة للمساءلة، وإن تكن أدوات الثقافة مغايرة لأدوات السياسة. تشتغل الثقافة بالكلمات وتراكيبها (تقتصر مواد الكتاب على «ثقافة الكلمة”)، فيما تشتغل السياسة بالقوة وموازينها. لكن لا الثقافة مُبرّأة من علاقات قوة وصراعات حول السلطة والاعتراف والمكانة، ولا السياسة منفصلة عن إنتاج معارف وخطابات، يتعهده السياسيون وأعوانهم. السياسي المحض الذي يعمل حصراً في حقل القوة غير موجود، ومثله المثقف المحض الذي يلهو في ملعب الكلمات البريئة. الكلمات البريئة غير موجودة على أيّ حال. صحيح أن الكلمات لا تقتل، لكنها قد تستخدم لتبرير القتل أو التحريض عليه أو السكوت عنه أو حجبه أو تبديل اسمه.
يعمل المثقفون في حقل اجتماعي سياسي مستقطَب، ويعرفون أن كلماتهم ونصوصهم تُوظَّف ضمن هذا الحقل لتسويغ خيارات وانحيازات ومواقف سياسية أو لها أثر سياسي مباشر. وفي سوريا، وموادُّ الكتاب لا تكاد تتكلم على غيرها، للمثقفين أيديولوجية فئوية ضمنية تقول إنهم، بالتعريف، في موقع اعتراض على النظام السياسي القائم، من حيث كونهم مثقفين فحسب. هذا غير صحيح، ليس فقط لأن من المثقفين موظفون في أجهزة السلطان، ولا تنعزل مواقعهم وآراؤهم عن علاقات القوة المشكلة للنظام السياسي، ولا كذلك لأن تفضيلات مثقفين اتجهت طوال عقود وعلى نحو نسقي إلى النيل من خصومه السياسيين والثقافيين، إن لم تجاهر بتبريره صراحة، ولكن كذلك لأن التفضيلات السياسية والمواقع الاجتماعية لمثقفين كثيرين، بخاصة من يجمعون بين كونهم «مثقفين فحسب” وبين إرادة نسبة صفة اعتراض سياسي وأخلاقي لأنفسهم، تضعهم في دائرة النخبة الاجتماعية التي تحظى بقدر من الحصانة والامتياز مقابل قدر من الولاء للنظام، أو التبرير المُداوِر، أو التجنّب والصمت.
كان نمط الكتابة الفكرية المواكبة للزمن البعثي-الأسدي هو الكتابة غير المسكونة، الخالية من البشر، في بلد أُخليت سياسته كلياً من سكانه. فمثلما قام النظام السياسي على تغييب العموم واغتيابهم، وعلى منعهم من إنتاج التمثيل، والتقرير في الشأن العام من فوق رؤوسهم، طرد النمط الكتابي المهيمن البشر من النص، وشارك منتجوه في اغتيابهم، وفي الكلام عليهم من فوق رؤوسهم. وكلما أمعن السلطان في تغييب الجمهور من السياسة، اشتد اغتياب أهل الفكر للجمهور المُغيِّب وإنكار جدارته الثقافية، والسياسية والأخلاقية، على ما تحاول مواد هذا الكتاب أن تظهر.
العقيدة التي انبنت على التغييب السياسي للجمهور، وتطوعت في خدمة الاغتياب العام، هي الثقافوية التي هيمنت في مراتب المثقفين في سوريا في ربع القرن السابق للثورة. وأعني بالثقافوية شرح المجتمع والسياسة بالثقافة مفهومة كـ”عقلية” أو «ذهنيات”، والتكتم بخاصة على الأوضاع السياسية العيانية، وعلى شروط حياة أكثرية السكان الاقتصادية والاجتماعية، والميل، بالعكس، إلى اعتبار هذه الشروط ذاتها نتاجاً لذهنية السكان أو عقلهم. ولذلك فإن نقد الثقافوية، وهو عنوان أساسي في هذا الكتاب، ليس مجرد اعتراض على منهج حتموي ضيق للتفسير، ولا هو محاولة لكشف انحيازات اجتماعية وسياسية للثقافويين، تُموِّه منابع المشكلات والصراعات الاجتماعية، وليس مدخلاً بالغ الأهمية إلى إضاءة العالم الاجتماعي والسياسي الذي تُشكِّل الثقافوية حجابه الأيديولوجي، ما أسمّيه العالم الأول الداخلي؛ وإنما هو، فوق ذلك كله، فعل اعتراضٍ سياسي مباشر على هذا العالم الأول، وعلى نخبة السلطة التي تتماهى في سياسة «عالمها الثالث الداخلي” بـ”العالم الأول”، الرأسمالي والمسيطر و”المتحضر”، في سياسة العالم الثالث العالمي في الأزمنة الاستعمارية. حداثية الأشياء والعناوين الأيديولوجية والواجهات التي يُحامي عنها الثقافويون العلمانيون تتوافق مع ظهور ثنائية اجتماعية، ثنائية أمّتين أو عالمين، العالم الأول والعالم الثالث، أمّة الصاعدين الممتازين الجديرة بالحماية والتي يتمتع أفرادها العاقلون الذكور (مع حاشية نسويّة «حديثة” المظهر)، وجموعها المنضبطة والمنقادة، بحقوق، ويشكل الثقافويون مثقفيها العضويين؛ ثم أمّة المعزولين المحرومين التي لا تستحق الحماية ولا حقوق لأفرادها، وجموعها الهائجة الجاهلة التي لا عقل لها. ليس فقط لا يتوحد السوريون ولا تتشكل منهم أمة على أسس مفهوم الحداثة الذي يروج له الثقافويون، بل إن هذا المفهوم يتوافق، بالأحرى، مع خوض أمّة العاقلين من أصحاب الحقوق حرباً مطلقة ضد أمّة الجاهلين المحرومين من الحقوق، بنسائها «المتخلفات” المحتقرات اللاتي يُغتصَبن في المقرات الأمنية، ورجالها المتخلّفين الذين يُعذّبون ويقتلون في مصانع الرعب تلك. ليس جذر ما نشهده منذ خمس سنوات من حرب استخدم فيها كل سلاح، من الطيران الحربي إلى السلاح الكيماوي إلى براميل المتفجرات إلى القتل تحت التعذيب إلى الحصار والقتل جوعاً ومرضاً، غير حرب العالم الأول، الأسدي، ضد العالم الثالث السوري.
طرد النمط الكتابي المهيمن البشر من النص، وشارك منتجوه في اغتيابهم، وفي الكلام عليهم من فوق رؤوسهم. وكلما أمعن السلطان في تغييب الجمهور من السياسة، اشتد اغتياب أهل الفكر للجمهور المُغيِّب وإنكار جدارته الثقافية، والسياسية والأخلاقية
في «سوريا الأسد”، عاش معظم المثقفين في العالم الأول أو على حواشيه، بينما دُحر العالم الثالث بعيداً إلى الهوامش غير المرئية، فلا يُسمَع له صوت. هذا وفّر بيئة مناسبة لصعود السلفية الجهادية بعد تفجّر الثورة وصراعاتها العنيفة منذ ربيع 2011. هنا، وبخصوص الإسلاميين عموماً، نحن حيال ثقافوية إسلامية، تُعرِّف الجمهور أيضاً بالمعتقد الديني، وتُفسِّر سوء الحال بابتعاد مزعوم عن «الإسلام”، وتستنتج وجوب أيلولة الحكم للإسلاميين استناداً إلى الماهية الإسلامية لـ”الأمّة”. ولا يعدو هذا المشروع كونه مشروع سيطرة نخبوية، مرشحٍ لطحن البشر بصورة لا تحسد المطحنة البعثية-الأسدية في شيء.
بعد الثورة السورية التي أكتب هذه المقدمة في أجواء ذكرى تفجرها الخامسة، تطور لديّ تشكك عميق بمفهوم المثقف ذاته، إذ يبدو أنه يحمل في سِجلِّه الوراثي غريزة الصعود الطبقي والانفصال عن العامة، وعن أيّ بيئات اجتماعية حيّة، والعيش بالمقابل في بيئة خاصة معقّمة، تشكل جيباً ضمن «أمّة العاقلين” أو «أمّة الدولة”. السجل الوراثي لمفهوم المثقف تشكل عبر الطفرة التاريخية التي أفضت إلى ظهور هذا الكائن الجديد في سياق ملتبس: الحداثة/الاستعمار في النصف الثاني من القرن التاسع عشر. هذا لا يوجب حتماً التخلي عن المفهوم والدور المنسوبين للمثقف، لكنّه يستوجب تشككاً قوياً فيهما معاً، وكذلك في «الرسالة” المُضمّنة فيهما: التنوير والقيادة الفكرية والتاريخية. تلزم جهود قوية لإحداث طفرة في السجل الوراثي لمفهوم المثقف، كي يتجه بكيانه ووجدانه نحو أمة الجاهلين، المقموعين من الدولة والمحرومين من السياسة والحقوق. في شروطنا الحالية، جملة مفهوم المثقف والدور والرسالة تتوافق مع أن يكون المثقف عنصراً من «الغرب الداخلي” أو العالم الأول الداخلي، وليس من «الشرق” أو العالم الثالث.
وهذه البنية تبيح لنا القول إن النتاج الفكري لمثقفي العالم الأول الداخلي هو بمثابة استشراق داخلي، موضوعه مثل نموذجه الأصلي هو «الشرق” مردوداً إلى الدين. وهو ما يُدرِج نقد هذا الضرب من الاستشراق في عملية التحرر السياسي والاجتماعي والثقافي، التي كان التحرر من الاستعمار جولة فحسب من جولاتها، وما يشكل استئنافاً لعمل إدوارد سعيد وتلاميذه.
***
تشكل الثقافوية ضرباً من استمرار منهجي للاقتصادوية ذات الأصول الماركسية التي هيمنت في تفكير جيل سابق من المثقفين السوريين، ومر بها معظم ثقافويي اليوم. ومن أبرز أوجه التماثل النزعة الحتمية، والتفسير الاختزالي بعامل واحد؛ ومنها أن الاثنتين منشغلتان بصورة ما بمفهوم «التخلف”، لكن مع فارق مهمّ بينهما في هذا الشأن. فالاقتصادوية تشرح التخلف بمفردات الاقتصاد السياسي (الفقر، البطالة، مستوى التأهيل، سياسات الدولة الاقتصادية والاجتماعية، نمط التراكم الرأسمالي القائم، ترابط أنماط الإنتاج على المستوى العالمي…)، وتطور موقفاً سياسياً نفسياً متعاطفاً مع «المُتخلّفين”، داعماً لهم في الكفاح من أجل تغيير أحوالهم، فيما تطور الثقافوية موقفاً سياسياً نفسياً كارهاً لـ”المتخلفين” المفترضين، متعالياً عليهم ومغتاباً لهم وعدائياً تجاههم. وهو ما يَسْهُل أن يتمفصل مع النزعات الطائفية في سياقنا السوري المعلوم، وما يقلل الحساسية العامة حيال ما يصيب أولئك «المتخلفين” التعساء. ليست الثقافوية، تالياً، خطأً في التحليل أو قصوراً في المعرفة، وليست بحال من أخطاء الفكر، إنها من خطايا السياسة والضمير العام بالأحرى. ولا يعدو المرء الإنصاف إن قال إن بعض رموز الثقافوية الذين جرى تناول أعمال لهم في هذا الكتاب يُكنّون أشد الضغينة للناس الذين يفترض أنهم يحاولون تنويرهم. الثقافوية بهذا المعنى أيديولوجيا خطرة، رجعية ويمكنها أن تكون فاشية، تُسهِّل إلحاق الأذى بعموم الناس، وترتبط دون اعتراض بأوضاع يَسهُل إيذاؤهم فيها.
وبعد هذا كله، ليست المشكلة في الثقافوية أنها نقد أحادي الجانب للثقافة، يتكتم على الشؤون السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وكذلك الأوضاع الدولية، مما لا يستقيم فهم شيء في عالم اليوم دون أخذه في الاعتبار (ومما ألحّت عليه فصول الكتاب)؛ مشكلة الثقافوية، بالأحرى، أنها لا تنتقد الثقافة ذاتها إلا بعد تقليصها إلى بُعدِها الموروث، إلى ما يفترض أنه الأصل الثابت المستمر. لن نجد عند أعلام الثقافوية السوريين نقداً لنمط إنتاج الأفكار والعلاقة بين المعارف والتجارب، وتكوين الحقل الثقافي المحلي، ومدى استقلالية المنتجين الثقافيين بأدواتهم وشروط عملهم، ولن نجد، من باب آخر، إشارات ناقدة لإدخال نخبة الدولة الأسدية مفاهيم مثل «البيْعة” و”تجديد البيعة”، ومثل «الإجماع»، ومثل «المَكْرُمة” و”العطاء”، ومثل «الأب القائد”، كمدركات أساسية تُسمّي العلاقة بين عموم السكان في سوريا والحاكم، وتُسمي أيضاً النكوص الاجتماعي والثقافي والسياسي الذي تمادى جيلين قبل تفجر ثورة 2011، وكانت السلطنة الأسدية مضخّته الكبرى.
وخلافاً لعقيدة ثقافوية غير مبرهن عليها، فإنه لا أساس لافتراض استمرارية تاريخية تلقائية، لا تنقطع بغير جهد قطيعة خاص، قد يقتضي حرباً طويلة أو دولة مركزية عنيفة، يحصل أن توصف بأنها «تنظيماتية” أو «يعقوبية” (عزيز العظمة)، وتعمل بكل تَجرُّد على المجانسة الاجتماعية والتوحيد السياسي والتحديث الثقافي. الأصح في ما نرى أن الحاضر هو زمن الحياة والأحياء والإحياء، وأن الماضي لا يتمادى إلى اليوم إلا بجهد خاص، جهد وصل وإحياء، أو بعثٍ واستحضار. ما يلزم تالياً هو النظر في بنية الحاضر، في القوى العاملة والمُعتمِلة فيه، وفي وكلاء الماضي من النخب السياسة والاجتماعية التي تحيي القديم وتبعثه في الحاضر. ولا وجه للتهرب من هذا الواجب بافتراض آخر، أسوأ من الاستمرارية التلقائية، افتراض أن لتاريخنا خصوصية تجعل الماضي قوياً ومجتاحاً للحاضر الضعيف. لا خصوصية لتاريخنا، وماضينا مثل أيّ ماضٍ غيره لا يفعل شيئاً؛ الحاضر هو الفاعل، وهو ما يستدعي ما مضى وانقضى. فلننظر في بنية الحاضر.
لوحة: سعاد مردم بيك
بيد أن أهم ما تخفق الثقافوية فيه هو قضيتها الأساسية: شرح التعثر السياسي وتعذر الديمقراطية بعامل كبير أساسي هو «الثقافة”. فبقدر ما أن الثقافوية تردّ الواقع الكثروي المركب والمتغير إلى هذا العامل الواحد الكبير، وبقدر ما أنها تدعو إلى قطيعة و”خلق” (أدونيس)، و”حرب مئة عام ضد الأصولية” (جورج طرابيشي)، فإنها تزكّي عملياً طلب السلطة المطلقة التي تقلب هذا الواقع الفاسد رأساً على عقب. ليس في بنية هذه النزعة الاختزالية، أي «ذهنيتها”، التي تردّ الكثير إلى واحدٍ، ما يحول دون انتصاب الواحد على رأس الكثرة، واستعبادها، إن باسم الحداثة أو الوطن أو الإسلام. الثقافوية، تالياً، لا تؤدي إلى غير تعذر الديمقراطية، وليست بحال شرحاً صادقاً لغيابهما. والواقع أن ما سيراه القارئ من تشكك الثقافويين في الديمقراطية وعدائهم للمجموعات المكافحة من أجلها، ووقوفهم في مواقع أقرب إلى نظم الطغيان القائمة، مؤشر كاف على ذلك.
***
يتألف الكتاب من 13 نصاً، موزعة على ثلاثة أقسام، كُتبت بين عامي 2006 و2015.
يعتني القسم الأول بتعريف الثقافوية ونقدها. خصص النص الأول، الثقافوية العربية المعاصرة، خصائص منهجية ومحددات أساسية، للتعريف بها وإبراز طابعها الاختزالي، ويميز بين ثقافوية علمانية وثقافوية إسلامية. ويُعرّف النص الثاني، نظرية الحتمية الثقافية في الثقافة السورية، بملابسات ولادة الثقافوية، ويعمل على إظهار طابعها التضليلي الأصيل، عبر اثنين من أبرز أعلامها السوريين، جورج طرابيشي وأدونيس، ويُظهِر أن هناك الكثير من السياسة في تغافل المثقفَيْن عن السياسة. النص الثالث، من الإسلام إلى المجتمع: مقاربة جمهورية علمانية، يستأنف نقد المثقفَيْن السوريين المذكورَين، وبخاصة تمركز تفكيرهما حول الدين على نحو مماثل لتفكير الإسلاميين، ويظهر الكوامن الفاشية في هذا التفكير العلماني-الإسلامي المشترك، ويقترح التحول من هذا التمركز إلى النظر في المجتمع وأحواله. ويقول النص الرابع، من نقد الثقافوية إلى نقد الثقافة والدين، إنّ لدينا فعلاً مشكلات ثقافية ودينية تسيء الثقافوية طرحها، لكنها مشكلات حقيقية يتعين التصدي لها بالتفكير والمعالجة، وبالتالي فليس لنقد الثقافوية أن يُعفي الثقافة والدين من النقد، أو يكون تبريراً لبنى وموارد ثقافية محلية تسوّغ الاستبداد والتمييز والعنصرية. ويختص النص الخامس، خطاب العقل وظهور تيار العقليين، بتقصي الجذور السياسية والفكرية لخطاب العقل الذي استعمر الثقافة العربية العالمة في ثمانينات القرن العشرين وتسعيناته.
وفي القسم الثاني أربعة نصوص تتناول جوانب من أعمال مثقفين سوريين وعرب: عبدالله العروي، وبرهان غليون، وجورج طرابيشي، وعزيز العظمة، ومحمد كامل الخطيب، وسليم بركات.
ينكبُّ النص السادس، في نقد عبد الله العروي «المثقف العربي” برنامجاً لتحقيق الحداثة، على نقد تاريخانية المفكر المغربي، أستاذ جيل أو أكثر من المثقفين في المغرب والمشرق، منهم كاتب هذه السطور، وعلى رهانها على المثقف كبرنامج للتحديث، ويظهر تناقضاتها، ويدعو إلى تصور مغاير للعمل الثقافي والسياسي. وينصب النص السابع، نظريات المثقفين السوريين في الدولة العربية، على تفحص نقدي لأفكار برهان غليون وجورج طرابيشي وعزيز العظمة حول الدولة والمشكلة السياسية العربية. غليون يراها نتاج عدوانية الدولة، بينما يرى طرابيشي أن الدولة تعبير عن المجتمع، فيما يرى العظمة أن الدولة متقدمة على المجتمع، ويُحامي عنها في كل حال. أما النص الثامن، الخرائط الجغرافية أم الخرائط العقلية هي التي ينبغي إعادة رسمها؟ فهو مراجعة نقدية لكتاب «وردة أم قنبلة؟! إعادة تكوين سورية” لمحمد كامل الخطيب، صدر عام 2006. يتكتّم الكتاب، وفق تقاليد التفكير الثقافوي عموماً، على الجذور السياسية لمشكلات مجتمعاتنا المعاصرة، فيحرم نفسه وقرّاءه من الإحاطة بجانب مهم، إن لم يكن الأهم، من جذورها، ومن اقتراح شيء مفيد لمعالجتها. النص التاسع، الماهية والكراهية: الأديب الفصيح ضد الرعاعة الأمة، هو رد على مقالة عنصرية غثّة لسليم بركات، الروائي والشاعر السوري المغترب، نشرت في أواخر 2010، غداة موسم الثورات العربية، يستعيد فيها معظم غثاء التفكير الثقافوي اليميني وأحكامه على «العربي” و”المسلم”، وبصورة كاريكاتيرية مُصفّحة بفصحى عربية ثقيلة.
وفي القسم الثالث أربعة نصوص أيضاً تهتم بجوانب من جذور المشكلة الثقافية في سورية والعالم العربي.
يرصد النص الحادي عشر، الغيلان الثلاثة: مقالة غير عقلانية، تًغوُّل كل من الدولة والدين والغرب في مجالنا، والمسعى المجنون وغير الإنساني لكل من هذه القوى الثلاث لجمع تناقضات لا تجتمع بغير الإمعان في القوة. ويعرض النص الثاني عشر، انفصال عن الجدار: مقالة في الثقافة والثورة الثقافية، تحكّم منطق توزيعي في تفكيرنا خلال ثلاثة أجيال ثقافية، جيل اشتراكي فكّر في توزيع الثروة أكثر من إنتاجها، وجيل ديمقراطي فكر في توزيع السلطة وليس في كيفية إنتاجها، وجيل علماني يفكر بدوره في توزيع المعنى ولا ينتجه، وينفتح هذا الطرح على التفكير بثورة في الثقافة، متوجهة نحو عالم إنتاج. من الأبوات إلى الأنوات، جيلان من الثقافة والسياسة، هو عنوان النص الثالث عشر، وهو يُظهِر التحول من جيل «الأبوات” القوميين واليساريين المنتمين إلى منظمات سياسية أو سياسية-عسكرية من أجل التغيير والتحرير بين ستينات القرن العشرين ومطلع ثمانيناته، قبل أن يَحِلَّ محلهم جيل الأنوات، وهم مثقفون وناشطون أفراد لا ينتسبون إلى هذا النوع من المنظمات، ولا يكفّون عن الانخراط في حروب المكانة. ويتساءل النص الرابع عشر والأخير، الأزمة الوطنية ونهاية المثقف النبي، عن جذور امتناع المثقفين السوريين عن النظر في تكوين بلدهم، ويجد ذلك في الخوف من حكم طغموي مخيف، وفي كونهم مثقفي مآلات نهائية (التقدم والحداثة بخاصة)، و/أو في كونهم مثقفي ماهيات قومية أو دينية، منعزلين عن صراعات اليوم الاجتماعية والسياسية.
لقد قمت بتنقيح النصوص كلها تنقيحاً محدوداً على العموم. لم أقل في الصيغ المنقحة هنا شيئاً ما كان يمكن لي قوله في الصيغ الأصلية، لكن أوضحت صيغاً ملتبسة، وأضفت في حالات قليلة شروحاً لازمة، وحذفت ما بدا لي استطراداً نافلاً. ولقد ثبتُّ تاريخ نشر كل من النصوص في ذيله لإعطاء فكرة عن تاريخيتها. وباستثناء نص واحد، الأزمة الوطنية ونهاية المثقف النبي، كتب في إسطنبول، فقد كتبت النصوص الأخرى كلها في دمشق، وإن أكن استأنفت العمل على اثنين منها هنا في تركيا: خطاب العقل وظهور تيار العقليين، وفي نقد عبد الله العروي.
***
الكتاب ككل مساهمة بأدوات الثقافة في الصراع الاجتماعي والسياسي السوري. وهو اعتراض على نصب سور فاصل بين الثقافة والسياسة، أو التذرع بتمايز الحقلين لتسويغ تخلي المشتغلين في مجال الثقافة عن مسؤولياتهم الاجتماعية والسياسية.
في الوقت نفسه تنحاز هذه النصوص إلى استقلال الثقافة، ضد استتباعها للسياسة المباشرة والظرفية، وكذلك ضد ميل مثقفين إلى أن يشتغلوا سياسيين. الثقافة قوة سياسية بما هي ثقافة، بما هي شكل من أشكال العمل العام له شخصيته الخاصة وكرامته الذاتية. من واجب المثقفين أن يتدخلوا في السياسة في كل وقت، في أوقاتنا الدموية اليوم بخاصة، وأن يقولوا كلاماً واضحاً عن السلطة وعن السجن والتعذيب والعنف والتمييز والقتل والمنفى والكراهية والتحقير والتعصب والعنصرية. لكن هناك شيء واحد أسوأ في رأيي من أن يعمل المثقفون كسياسيين عمليين، هو زعم المثقف بأن مجاله هو الفكر أو الفن، وأنه لن «يُلوّث” نفسه بالسياسة وشؤونها. في مثل شروطنا الراهنة، قبل الثورة السورية المقتولة، وليس أثناءها فقط، هذا المسلك استراتيجية تبرر الراهن دوماً، ولا تبرر غيره. حين يُقتل الناس بكل طريقة، حين يُذلّون ويهانون، حين يحاصرون ويُجوَّعون ويموتون جوعاً، وحين يكون ذلك سياسة عامة شعارها هو «الجوع أو الركوع!”، حين تُغتَصب النساء والأطفال في مقرات أجهزة الأمن، حين يُقتل المئات منهم بالغازات السامة خلال ساعة، حين يدفنون تحت أنقاض بيوتهم المقصوفة بالبراميل المتفجرة؛ من يتعالى حينها على السياسة فاقد للإحساس وللإنسانية ذاتها، ويغلب أن يكون هذا التعالي قناعاً للانحياز إلى الأوضاع القائمة. وهو يجرد نفسه من القدرة على إدانة قتلة آخرين إدانتهم واجبة، داعش وأخواته. وبالمناسبة، هذا أصل بعض صمت الصامتين؛ تصمتُ لزمن طويل على قاتل تواليه، فلا يبقى لك وجه للكلام على قاتل صاعد تعاديه.
وليس السبب الوحيد للتحفظ عن اشتغال المثقفين كسياسيين كرامة الثقافة واستقلالها، بل أولاً الحاجة إلى ثورة في مجالنا، في الكتابة والثقافة والحساسية. هذا هو الشيء الوحيد الذي من شأنه أن يُكرِّم من قُتلوا ومن عُذِّبوا ومن خُطفوا، يكرم ثورة الكرامة المقتولة في بلد هو اليوم استعارة عالمية. مساهمة المثقفين في الثورة هي الثورة في الثقافة.
*النص مقدمة كتاب بالعنوان نفسه يصدر عن المؤسسة العربية للدراسات والنشر هذا الشهر.
ياسين الحاج صالح
كاتب من سوريا مقيم في اسطنبول