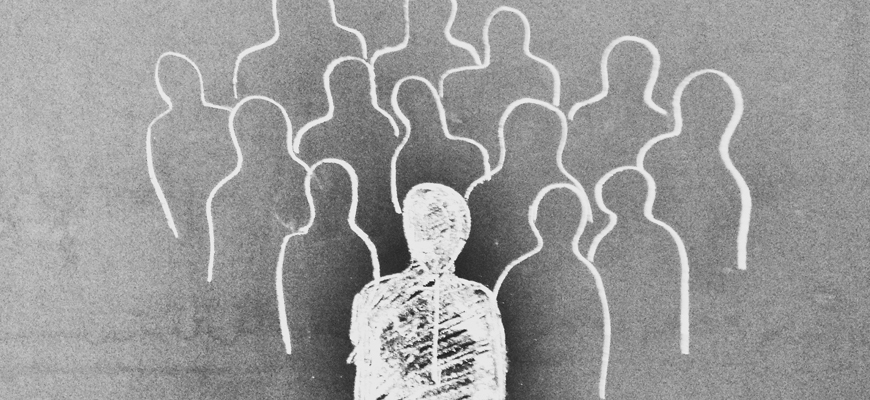ملف “الجديد” الشهرية الثقافية عن المرأة العربية

تأنيث الكتابة/ سعيدة تاقي
تأنيث الصوت وتأنيث الكتابة سيفضيان بالضرورة إلى تأنيث اللغة رغم إكراهات الأبنية والصيغ والاشتقاقات، لأن الحفر العميق في متون اللغة بمنظور الأنثى سيولِّد من رحم اللغة المؤنَّث حيزاً أرحب.
وَسْم العالَم بالمؤنَّث مطْلبٌ متجدِّد لكنه ليس بالجديد، فالعالم منذ بدء الخليقة فضاء مشترَك بين الجنسين. لكن قـضت السلطة الاجـتماعية والفكرية والديـنية والسـياسية بـروافدها الـمادية والرمزية أن تحاصِر “الأنثى” وأن تكيل لها على يد شريكها في الحياة والفعل والوجود والخلود “الذَّكر” كلَّ مواثيق التقييد والاستبداد والاستغلال. لقد رصفت شهرزاد (التي صنَعها المجتمع الذكوري) من قبل لياليها بوهم سطوة التأنيث لكنها ظلَّت رهينة الليل والغبش والعتمة تقتات الحياة حكايةً ممتدَّةً على حواشي سرير شهريار، تُحكِم عليه سطوة الحكي بما تعــلَمُه وتُنــتِجه من سحر السرد ليلاً ويُحكِمُ عليها سطوة الذكورة والفحولة والقوة بما يعلَمُه من المجتمع وبما تعلَّمَه منه وبما يشارك في إنتـاجه وإعـادة إنـتاجه من قـيم وأعـراف لـبـاقي اليوم. وبذَّت “تودُّد” (سليـلة حكايات شهـرزاد) الفـقـهاء والعلماء وأهل النظر والحكمة وجرَّدتهم أمام الخليفة هارون الرشيد من ثيابهم نكاية بفضلهم وعلمهم، لكنها ظلت “الجارية” في حُكْم التاريخ والرواية والسرد شخصيةً تخرج من المخدع لتعود إليه. ولم تكن الـكـتـابة أو اللغة أو الفـعــل في كل ذلك إبـداعا يُـسلِمُ مـقـاليدَه للأنـوثة بصدق ونزاهة، بل كانت الفحولة تلوِّن كلَّ اللوحات، وكانت اللغة في كل ذلك، ومازالت، تجأر بذكورة المجتمع وباستبداد الفحولة بكل موازين التساوي أو العدالة أو الأنسنة.
ولـقـد اسـتـوت بـين أرفـف الـتـاريـخ، قـبـل ذلـك وبعـده، وبين أرفـف الـفـن والـعـلـم والأدب و الشـعـر والـقـصة والـرواية والمـسرح والفكر والفلسـفة والنـقـد والإعلام والسياسة أفعال مقاومة عديدة أعادت تنضيد الرؤى الجامدة وبثَّت في الخوابي شعلة تجدُّد وبعث وإحياء. وسعت إلى أن يغدو فعل الكتابة/التفكير مخلِصا للذات الكاتبة التي أنتجته دون اتكال على استبداد مطلق، أو اختفاء خلف ظل ذلك الآخر. لكن اللغة وهي “مَسْكَـن الإنسان”، وفق هايدغر، سابقة في الوجود والحدود والتسميات على وجود الكائن الإنساني، ومن ثم فإن اللغة لا يتكلَّمُها الإنسان بل إنها تتكلَّمه إذ تحدِّدُه وتسِمُه وتسمِّيه. لأجل ذلك لا يمكن النظر إلى صوت المرأة المميَّز مثلا في الكتابة وننسى أن اللغة تضع مدخل صيغة “أَمرأ” في معجم “المعاني” كالآتي:
مَرَأ: (اسم)
مَرَأ : مصدر مَرِئَ
مَرَّأ: (فعل)
مَرَّأْتُ ، أُمَرِّئُ ، مَرِّئْ ، مصدر تَمْرِئَةٌ
مَرَّأَ الضَّيْفَ : قَالَ لَهُ : هَنِيئاً مَرِيئاً
مرَأ: (اسم)
مرَأ : فاعل من مَرُؤَ
مرَأَ: (فعل)
مرَأَ يمرَأ ، مَراءةً ، فهو مَرِيء
مرَأ الطّعامُ: كان سائغًا مقبولاً، سهُل في الحَلْق، وحُمِدت عاقبتُه
هنأني ومرأني الطّعامُ
مَرَأَ فلانٌ: طَعِمَ
ولنعتد بأنّ “امرأة” وهي الصيغة الوحيدة في اللغة للجنس المؤنث هي في مداخل معجم اللغة:
امرأة
أنثى المرء، جمع: نساء ونسوة (من غير لفظها)
في حين أن “امرؤ”
أمرؤ- و إمرؤ
– رجل ، مؤنث امرأة . وتحرك «الراء» بحركة آخره، فيقال: «امرؤ ، امرأ ، امرئ». ولا تدخل عليها «أل» التعريف.
وفي ضـوء ذلك نـرى أن اللـغـة لـيـسـت بــريـئــة مـنـذ زمـن الـوضـع والاصـطـلاح والمواضعة والاتـفـاق أوالتوفيق، ومـازالت كذلك، تحمل بين ثـنـايـاها فوق المعـنى معـانٍ ومـبانٍ وكـيـانات وفلسفات وتواريخ وأيديولوجيات. فكيف باللغة أن ترتدي زيّ “المؤنَّث” لأن من كتبتها ذات مؤنثة؟ وهل تستطيع اللغة أن يطالها “التمكين” المؤنِّث للعالَم لأن الذات التي صاغتها ذات كاتبة مؤنَّثة؟
إن اللغة ليست لغة الرجل. هو لم يمتلِكها لكي تكون له وحده دون أن تكون للمرأة، لكنه قد صاغـها منذ قـرون بأثر رجعي، يخـلِّد لحـظة سـابقة في الـزمـن اسـتـبد فيـها بالـتـاريـخ واللغة والفكر والمجتمع والدين والسياسة والفن، وتملَّك بسطوة ذلك الامتلاك تاريخيا كلَّ الامتيازات التي جعلتْ مفهوم “القِوامة” الفقهي يمتد خارج أصول الفقه لكي ينسحب على كل المجالات والمتون والهوامش. فغدا الفضاء العام فضاء للرجل بمفرده يخضع لمزاجيته وأهوائه واكتساحاته أو انسحاباته. وامتد الأمر ليلحق كل الفضاءات من فضاء حقيقي أو كتابي أو سردي أو تخييلي أو أدبي أو ثــقافي أو اجـتماعي أو ديـني أو سـياسي أو فكري أو وجودي. إن الأثر استبد حتى بامتلاك الجسد فالمجتمع ملَّك الـرجلَ جـسده الخاص وجسد المرأة كذلك، ووضعه رقيبا على وجودها المادي في هذا الكون عبر تسلُّطه على جسدها وحضوره وغيابه وخواصه وأزيائه و حركاته… والتبس زمن الليل برداء الفحولة، وما أمكَـنَه أن ينعطف ولو قليلا بعيدا عن تلابيب ما يقتضيه ذلك الرداء من خيالات وأوهام وأطياف.
وحين تمكّنت الكاتبة من تملُّك أدوات المقاومة والرفض والفعل المضاد ضد كل صيغ التقــييد والاستــبداد والاحــتكار والاستــغلال عبر التعبير بصوتها الخاص عن رؤيتها للعالَم وللحياة وللوجود وللإنسان وللموجودات وللآخر/الرجل، فإن الكــتابة منذ المنطلق الأول في الخلق والصياغة والتشكيل والتوليف فعلُ وجود مؤنَّث ومؤنِّــث يُنفي بدايةً قالبَ “المفعول به” أو “المفعول فيه” أو “الموضوع” ، ذلك القالب الذي ظل لقرون طويلة لصيقا بالفنون والآداب منذ الشعر الغنائي وأغراض الغزل والنســيب والتشــبيب إلى العــذريات أو المُــجُـونيات والنحت والتجسيم والتشكيل والرسم.
ويلغي فعل الكتابة المؤنَّثة والمؤنِّثة ثانياً منطق الغلبة للأقوى أو للذي يملك “القِـوامة” أو الامـتـياز الـتاريخي بوضع يده (الرجل/الذكر) على اللغة والكتابة والتفكير والإبـداع. ويروم فعل تأنيث الكتابة ثالثا أن يشيِّد من منظور “الذات الكاتبة” كل “الموضوعات” التي تراها أو تتحدَّد خارج وعيها بذاتها تلك الذات الوجودية المؤنَّثة (بفتح النون) والذات الكاتبة المؤنِّثة (بكسر النون) في العالم وفق منظورها ورؤيتها وإدراكها. ولنتأمل في هذا المنعـطف الـثـالث بقـليل من الـسذاجة وكثير من الحيطة السؤال المطروح مقاميا للنقاش في معرض هذا المقال وغيره من مقالات الملف، لماذا نتساءل: هل تحقَّق صوت المرأة المختلف في كتاباتها أم إنها تكتب بصوت المرأة ولغة الرجل؟
هل لأن صوت الرجل هو الأصل بالفطرة والتاريخ والطبيعة ومادام صوت المرأة يلــوح في الأفــق فعليه أن ينــافس صوت الــرجل ويــواجهه ويقاومه من منطلقات الندية والمبارزة والتفوق والفوز؟
أم لأن صوت الرجل مجرَّدٌ ومحايد وأبيض لا لون له ولا تميُّز له، بـريء من كل انـتماء إلى أحد الجنـسـيـن (الرجل ـ المرأة)، وعلى صوت المرأة أن يوسَم بصوت المرأة ولغتها وكتابتها لأن المرأة تبني موقفاً وقضيةً تلونُ صوتها وتجعله مختَلِفاً عن كل سائد أو غالب أو مستبد؟
أم لأن صوت الرجل صوت ذكوري يعـبِّـر عن الـذكر وعن اســتبداده بكل الامتيازات والحقوق من منطلقات الاحتكار والسيادة التاريخيين وعلى صوت المرأة أن يكون كفؤا في المقاومة والدفاع والنضال لصالح العدالة الاجتماعية والتمكين النسائي؟
قد تكــون الإجــابات مترددة أو غير مُبصِرة والأســئلة بمفــردها قادرة على النظر بعمق وبعـد بصيرة وتأمل. لكن يمكن القـول بإيـجاز إن تـأنيث الكـتابة والفـكر والإبـداع والتـشكيل والعـلم والدين والفـقه والشريعة والتفسير وكذلك الخطابات التي تُنتَج بالموازاة من خطابات اجتماعية وثقافية وحضارية وسياسية يمضي في اتجاه تمكين الصوت الذي سُلبت كل امتيازاته باسم كل السُّـلط لقرون عديدة، لكنه يعني كذلك أن العالَم يستطيع أن يسَع بعـدالة الصوتـين معاً بتـميُّـز كل منهما بحقِّه في إعــمال النـظـر والـقـول والخطاب والإبداع والكتابة، وبحق الكاتبة الأنثى كذلك في الكتابة المضادة المُقاومة لكل تحجـيم أو استـبداد واحـتكـار حَصَرها لزمن طويل في مساحة “الموضوع المتحدَّث عنه/المفعول به” وألغى إمكاناتها بوصـفها “ذاتــا فاعــلـة” قـادرة على المبادرة والإنـجاز والإنـتاج والفعل.
إن تأنيث الصوت وتأنيث الكتابة سيفضيان بالضرورة إلى تأنيث اللغة رغم إكراهات الأبنية والصيغ والاشتقاقات، لأن الحفر العميق في متون اللغة بمنظور الأنثى سيولِّد من رحم اللغة المؤنَّث حيزاً أرحب يسع الكائن البشري بكل إمكاناته واحتمالاته وافتراضاته مثلما يسَع جنسَه أو وسْمَه أو تسميَتَه.
كاتبة من المغرب
الاختلاف لا يعني الاستنقاص/ حياة الرايس
‘الأدب النسائي’ فمصطلح مغرض اخترعه النقاد الذكور للفصل بين أدب وأدب بين ما يكتبه الرجل وما تكتبه المرأة على أساس جنسي بحت.
أولا لا بد أن نفرق بين الأدب النسائي والأدب النسوي. فـ”الأدب النّسوي” هو الأدب المرتبط بطرح ومعالجة قضية المرأة وبحركات التحرير النسوية، وهو نوع من النضال في سبيل حرية المرأة ونصرتها والدفاع عن حقوقها، ومساندتها في صراعها الطويل والتاريخي ضد اللامساواة مع الرجل. وهذا الأدب يمكن أن يشترك في كتابته المرأة كما الرجل: بمعنى كل من يتبنّى قضية تحرير المرأة ويُسخّر قلمه وإبداعه للدفاع عنها، مثلما يدافع عن قضية العمال أو اللاجئين أو أي قضية من قضايا المستضعفين في الأرض. بمعنى هو مرتبط بقضية وليس بجنس معين.
كما أن هناك كتابات نسائية لا علاقة لها بقضية المرأة ولا تحمل بالضرورة همّا نسويا خاصا. ربما تكتب عن قضايا أخرى أو تكتب أدبا يعكس تطلعاتها ورؤيتها للحياة كإنسان متأثر بالمجتمع ومؤثر فيه فقط.
وشخصيا لا يحرجني وصف النقاد لكتاباتي “بالأدب النسوي” وأن أكون من المدافعات عن قضية المرأة ومن أشرس المدافعات أيضا. كما دافعت عن عدة قضايا أخرى في كتاباتي، لأن الكاتب الذي ليس له قضية، ليس بكاتب وإنما هو يلعب لعبة ترصيف الكلمات.
ولكني ألحُّ على أن قضية المرأة عندي تتنزل في صلب المجتمع. وهي قضية مجتمع بالأساس وقضية سياسية أيضا باعتبارها تمس الحريات وحقوق الإنسان والديمقراطية والمساواة بين البشر.. وليست قضية فرد صادف أن كان امرأة.
وأنا أصنّف ” ككاتبه نسويّة “. ربما لأن أغلب عناويني تحيل على المرأة مثل مجموعتي القصصية الأولى “ليت هندا….” وكتابي الثاني “جسد المرأة من سلطة الانس إلى سلطة الجن” والثالث “سيّدة الأسرار: عشتار” ثم المجموعة الشعرية “أنثى الريح” وسلسلة قصص الأطفال “حكايات فاطمه”.. إضافة إلى عملي كمديرة مركز ثقافي تابع للاتحاد الوطني للمرأة التونسية يحمل اسم “فضاء 13 أوت الثقافي” (و13 أغسطس هو تاريخ إصدار مجلة الاحوال الشخصية التونسية وهو العيد الرسمي للمرأة التونسية) لعل كل ذلك يجعل النقاد يصنفون كتاباتي في خانة الأدب النضالي.
وبالدخول إلى تفاصيل محتوى كتبي نجد أنها في “ليت هندا..” تتناول قضايا المجتمع ككل.. فأغلب أبطال قصص المجموعة وشخصياتها من الرجال وهي تعالج قضايا اجتماعية ومسائل فلسفية وتطرح أسئلة وجودية مثل قصة “عزرائيل والكاتب” وتعالج مشكل الطبقات الاجتماعية والتمييز العنصري ومشاكل العمال وسوء توزيع الثروات إلى غير ذلك. أما كتابي الثاني “جسد المرأة من سلطة الإنس إلى سلطة الجن” فهو يعالج بامتياز قضية المرأة وعلى وجه التحديد حالة النساء المسكونات بالجان، في مقاربة علمية سيكولوجية وفلسفية أنتروبولوجية. باعتبارها حالات باتولوجية تستدعي التحليل النفسي.
ثم تأتي “سيّدة الأسرار: عشتار” وهي رواية/مسرحية مستمدة من ميثولوجيا حضارات الشرق القديم وبالذات من حضارتي سومر وآشور حينما كانت الأنثى -آلهة- وقد قصدتها فعلا لأعيد الاعتبار إلى المرأة المهانة في ذاتها وفي جسدها في عصرنا الحاضر. وهي تروي قصة حب عظيم عاشته ربة الحب والخصب عشتار مع تموز، ولكنه في النهاية الحب العظيم الذي تحلم به كل امرأة وكل أنثى.
نص كتب بحب في مديح الحب والأنوثة كما جاءت في ألواح وملاحم العصر القديم مع فطرة البدايات، قبل أن يدخل الجسد والجنس بوتقة المدنس والمقدس والحلال والحرام والطمس والممنوعات التي حطت من شأنه وشوّهته. حين كان الجنس رمز الخصوبة والتكاثر وتعمير الكون. وحين كانت عشتار ربّة الخصب والحب والأرض والزرع.
وهي ملحمة شعرية في مديح الأنوثة كما وصفها النقاد الذين احتفوا بها كثيرا واعتبروها نوعا من الكتابة الإيروسية المتحررة وقد وصفها الناقد كمال الرياحي أجمل وصف حين قال “نص في مديح الجسد الحرّ، الجسد العاشق والجسد المنفلت من القيود والأسيجة. نص طليق في مديح الشبق المطلق يكتب أولى بنود دستور دولة الشهوة العظمى”. وأضيف نص في أنسنة الجنس والجسد أيضا. (وقد طبعت 10 طبعات ما بين تونس والإسكندرية والقاهرة وترجمت إلى الإنجليزية والفرنسية).
أمّا ديوان “أنثى الريح” الشعري فهو دعوة المرأة للتحرر مرة أخرى من كل ما يعرقلها من قيود المجتمعات البطريركية التي تشدها إلى الوراء في حركة ردة تعاكس كل تطور طبيعي وتعاكس اتجاه الطبيعة والريح الذي يدفع باتجاه العواصف والزوابع.. لتفجر طاقاتها الرهيبة التي طمسها مجتمع الذكور، على مدى القرون وهي الآن تندفع بكل قوة الحرمان والتحدي تبدع وتفتح عوالم جديدة كانت مغلقة دونها.
أما “الأدب النسائي” فمصطلح مغرض اخترعه النقاد الذكور للفصل بين أدب وأدب بين ما يكتبه الرجل وما تكتبه المرأة على أساس جنسي بحت وهذا نوع من الحيف والتمييز البغيض. لأن التمييز يجب أن يقوم على شروط إبداعية جمالية بحت، في التمكن من الأدوات التقنية وامتلاك اللغة وتطويعها وتخصيبها، ولا علاقة له بجنس الكاتب. ولا يجوز تجزئة الأدب بأيّ حال من الأحوال. وحيث أنه لا يوجد مصطلح يقابل ما يكتبه الرجل ولم نعرف تسمية تقول بأدب الرجل أو أدب الذكور فإنّ هذا المصطلح يفضح النوايا المبيّتة المتضمنة لتصغير وربما لتحقير ما تكتبه المرأة ونعته بمصطلح الأدب النسائي وربما أزاحته من المدونة الإبداعية أيضا والتي يريدونها أن تبقى مدونة ذكوريّة. إذ برأيهم أن الأدب الذي يكتبه الرجل هو الأدب الأصل. هو الجوهر وهو الأدب الإنساني الأساسي وما تكتبه المرأة مجرد ملحق لما يكتبه الرجل وتابع لهذا الأدب الأصلي الكبير عندهم.
وما التركيز على انتشار هذا المصطلح إلا تكريس لعقلية الوصاية في المجتمعات البطريركية والنظرة الدونية للمرأة على أساس كونها كائنا من درجه ثانيه. وهذا من رواسب عقلية مجتمع الذكور والثقافة العربية المعادية للمرأة التي تؤلّه الرجل وتحطّ من قيمة المرأة. فلا نستغرب أن يطلع علينا بعض ذكورها من الكتاب بهذا المصطلح، ليجعلوا من أدبها ملحقا من درجة ثانية. وبذلك لا تعدو المؤسسة الثقافية الأدبية أن تكون سوى نسخة مصغرة من عقلية القبيلة وترسيخ واستمرار لها.
ومن هنا أنا أرفض التسمية والمصطلح رفضا باتا احتراما لقلمي ولنصي الذي لا أقبل له أن يكون ملحقا أبدا. ما دمت أقدم مثلما يقدم الرجل مواضيع تمس قلب المجتمع والعمق الإنساني وهذا الشرط الأساسي للأدب، إضافة إلى الشرط الإبداعي الجمالي طبعا وربما أغوص في مواضيع لا يعرفها الرجل باعتباري أتميز عنه بتجربة الخلق والولادة.
لكنني أومن بمبدأ الاختلاف كامتداد طبيعي لثنائية الكون القديمة التي تضمن الاستمرار والتنوع: مؤنث/مذكر وأؤمن بالخصوصيات لكل من الرجل والمرأة دون أن يعني ذلك الاستصغار والاستنقاص أبدا وإنما التنوع والإثراء والتلاقح والإخصاب. فمن حق القارئ أن يرى العالم من وجهتي نظر مختلفتين لا من وجهة نظر أحادية. إذ لا فائدة أن نكون نسخ كربون من بعضنا البعض نساء ورجالا.
الطبيعة حبتنا بالاختلاف والتنوع فيجب أن نبرز هذا التنوع وأن نظهره في كتاباتنا دون خجل من ذواتنا. وإن خُلقت امرأة فتلك مصادفة طبيعية جميلة لا يجب أن أطمسها. فأنا أكره التشبه بالرجال أو أن أكتب مثل الرجل. وهو ليس دائما المثل بالنسبة إليّ لا في الحياة ولا في الكتابة.
عندما أكتب أحبّ أن ألامس العمق الإنساني بأناقة أناملي كأنثى. والنص عندي هو امتداد لجسدي فأنا أكتب بوهج أنفاسي المتصاعدة من مسام جلدي وأكتب بكل حواسي وعقلي وشراييني وقلبي وتلافيف الفكر ومنعطفات الذاكرة وعمق الوجدان، بكل تفاصيل تلك الذات التي لا يمكن أن تشبه ذاتا أخرى أبدا، ككل الكائنات في الطبيعة تماما. وكذلك الشأن بالنسبة إلى الرجل أيضا. على كل كاتب أن يحافظ على خصوصيته بالإضافة إلى مواقفه ورؤيته للحياة بطبيعة الحال، والنص هو ترجمان كل ذلك. والكتابة هي امتداد للفعل الطبيعي الأصيل أو هي صقل الفعل الطبيعي الخام.
وأنا أحب أن يجد القارئ تلك اللمسة الأنثوية في كتاباتي ويشمّ رائحة الأنثى في ثنايا سطوري فالكتابة هي عطرنا الداخلي في النهاية.
كاتبة من تونس
مفهوم التحرر النسوي على محك أصوليتين/ خلدون الشمعة
التمجيد الأعمى للعادات والتقاليد المحلية بلا تمييز هو بمثابة رد فعل يسعى إلى إيجاد علاقة تواصلية مع الأمر الواقع بمساوئه وحسناته، والمحافظة عليه بدلا من تغييره.
في الكلام السائد على مفهوم التحرر النسوي في المجتمع العربي التباسات أود بادئ ذي بدء أن أوجزها في أربعة:
الأول، هو أن مفهوم التحرر النسوي بعد مرور أكثر من قرن على دعوة قاسم أمين، مازال معياريا وليس وصفيا. والمفهوم المعياري كما نعلم يتصل بالقيم التي يعبّر عنها بأفعال يجب وينبغي ويتعين. فهي لا تبحث بوصفها مسألة اجتماعية بحتة، وإنما هي قيم ذات محمول ديني وعاطفي. وبعبارة أخرى فإنها سرعان ما تحيلنا، شئنا أم أبينا، إلى أصوليات مرجعية نصية لاهوتية ويقينية.
وبهذا المعنى فإنها تتسم بقداسة وممانعة، وتشير إلى حقائق ناجزة ومقطوعة بصحتها.
الثاني، هو أن مشروع التحرر النسوي السائد، بسبب من محموله القداسي في الأصولية الدينية، والعاطفي في الأصولية الأيديولوجية، غالبا ما ينظر إليه بعيدا عن المفاهيم الوصفية التي تحسن التمييز بين “الحقائق” و”القيم”. بل إن الخطاب الأصولي بشقيه الديني والقومي أو الماركسي، يخلق بذلك حالة من التماهي بين الحقائق التي يفترض أنها قابلة للنقض أو التفكيك أو البرهان وبين القيم العاطفية التي لا تحيل إلا إلى مرجعيتها النصيّة وبالتالي فإنها تظل ممتنعة على أيّ جدل أو جدال.
وتكمن خطورة هذا الخطاب في كونه أحاديا ينكر التعددية. فهو خطاب تحريك وتبشير بقدر ما هو خطاب سلطة لاهوتية مسبق الصنع. بل إنه سرعان ما يتحول إلى سلاح سياسي يستخدم لفرض أخطر أنواع الرقابة وأشدها توقا إلى ممارسة قمع الرأي الآخر.
الثالث، هو أن تكوين مفهوم عقلاني للتحرر النسوي، مازال على الرغم من مرور عقود على تجربة قاسم أمين، غائبا أو شبه غائب عن ميدان العلوم الإنسانية العربية. بل إن ربع القرن الأخير شهد بروز المرجعية النصية الدينية، بحدودها المرنة والمتشددة، باعتبارها مرجعية مشتركة في الخطاب الأصولي السائد حول المرأة، دينيا كان أم قوميا أم ماركسيا.
في هذه الالتباسات الثلاثة يكمن التحول الخطير الذي طرأ على مفهوم التحرر النسوي في المجتمع العربي، وهو تحول اعتُبر ضربا من “النوستالجيا الجماعية” (1) نحو إعادة صياغة العالم وفق وحدات أبسط وأقل تعقيدا.
ما أسباب هذا التحول؟ وهل يمكن إنجاز مشروع التحديث بدون البضاعة الفكرية الغربية التي لازمته والتي تنتمي إلى ما بعد عصر الأنوار؟ هل يمكن التحديث دون تغريب؟
هذا السؤال ظل مطروحا في جوهره منذ الأفغاني ومحمد عبده وقاسم أمين حتى الآن.
ثم ما طبيعة المرحلة التي وصل إليها مشروع التحرر النسوي؟ لعل من أبرز ملامح هذه المرحلة، انحسار الدور الذي سبق أن لعبته العلمانية بصيغها القصوى. بل إن مصطلح “المجتمع المدني” الذي تمليه ضرورات العولمة هو الذي حلّ الآن محلّ العلمانية على إيقاع ارتفاع وتيرة الخطاب الأصولي. وخير ما يعبر عن هذا التحول الذي أصبح فيه الخطاب النسوي يستمد مرجعيّته من نصية قد لا تمتّ إلى النصيّة الدينيّة بصلة مباشرة إلا أنها تحاول إيجاد المبررات لهيمنة الخطاب الأصولي الديني، المقدمة التي كتبتها باحثة جادة هي الدكتورة نوال السعداوي للطبعة الإنكليزية من كتابها: “The Hidden Face of Eve” فهي تقول فيها بالحرف:
“من الضروري أن نفهم أن أهم نضال تواجهه النساء في البلدان العربية الإسلامية لا يتعلق بالفكر الحر الذي يقف في مواجهة الإيمان الديني، أو بالحقوق النسوية كما تفهم في الغرب أحيانا في مواجهة الشوفينية الذكورية. بل إن هذا النضال لا يستهدف التصدّي لبعض المظاهر السطحية لخصائص التحديث في العالم النامي والغنيّ.. إن النضال الذي يُخاض هو في جوهره، محاولة لضمان قيام الشعب العربي بالتخلص مرة واحدة وإلى الأبد من جميع أشكال السيطرة التي تمارسها المصالح الرأسمالية” (2).
من الضروري أن نفهم أن أهم نضال تواجهه النساء في البلدان العربية الإسلامية لا يتعلق بالفكر الحر الذي يقف في مواجهة الإيمان الديني، أو بالحقوق النسوية كما تفهم في الغرب أحيانا في مواجهة الشوفينية الذكورية. بل إن هذا النضال لا يستهدف التصدي لبعض المظاهر السطحية لخصائص التحديث في العالم النامي والغني
دلالة هذا الكلام هي تأجيل القيام بمشروع التحرر النسوي حتى إشعار آخر.. وربطه تحديدا بإنجاز مشروع كبير غير قابل للإنجاز إلا بعد مرور عقود وعقود، وتعني الكتابة به حلم التخلص من سيطرة الرأسمالية.
ولهذا السبب بالذات فإنها تتجنب الاعتراف بوجود مجابهة بين الدين الذي يرفض مبدأ التعددية وبين الفكر المتحرر من قيود الواحدية النصية.
وعلى الرغم من أن نوال السعداوي تصف في الفصل الأول من الكتاب نفسه التعذيب الجسدي والنفسي الذي عانت منه عندما أجريت لها عملية ختان وهي في سن السادسة، وما تبع ذلك من عواقب لازمتها طيلة حياتها الجنسية فإنها تعلن في مقدمة الطبعة الإنكليزية أن النساء في أميركا وأوروبا يسارعن إلى إثارة الضجيج دفاعا عن ضحية الختان، وأنهن يكتبن المقالات الطوال ويلقين الخطب في المؤتمرات. تقول “من الطبيعي إدانة ختان البنات.. أنا ضد الختان والممارسات الرجعية القاسية الأخرى، ولكنني أختلف مع النساء في أميركا وأوروبا اللواتي يركزن على قضايا كختان الفتيات ويعتبرنها دليلا على القمع الهمجي الذي تتعرض له المرأة في البلاد الأفريقية والعربية فقط” (3).
هذا الخطاب الاعتذاري الذي يبرر تجاهل ظاهرة ختان المرأة واعتبار حلها جزءا من عملية التحرر النسوي ينطوي على تفسير واحد مفاده أن تجنب نشر الغسيل الوسخ أمام أعين الأجانب يبرر الدفاع عن ممارسات قبيحة فضلا عن الاعتراض على استخدام وصف المجتمع الهمجي.
وفي مكان آخر من مقدمة الكتاب تقول “الثورة في إيران هي في جوهرها سياسية واقتصادية. إنها انفجار شعبي يسعى لتحرير شعب إيران رجالا ونساء، وعدم إرسال النساء إلى سجن الحجاب والمطبخ وغرفة النوم”.
تعلق مراجعة الكتاب على هذا الرأي بقولها “إن بوسع المرء على أقل تقدير أن يلاحظ أن الحقائق لسوء الحظ تناقض تأويل سعداوي للإسلام” (4).
لا يعنينا في أمر هذه الطروحات أنها تكشف عن وجهات نظر مختلفة إزاء الثورة في إيران أو إزاء الدين عموما أو جواز أو عدم جواز نشر بضاعتنا التي تكشف عن قصور فيما حققته حركة التحرر النسوي، وإنما يعنينا دلالتها على وجود تحول خطير يتجلى في ارتفاع عقيرة الخطاب الاعتذاري الذي لم يعد همه تأجيل الدفع بحركة تحرر المرأة فحسب، وإنما تبرير ربطها بمشاريع التحرر الكبرى التي لا تجد سبيلها إلى التحقيق.
والحال أن هذا الخطاب الاعتذاري الذي يدشن ظهور أصولية قومية أو ماركسية تتقاطع مع الأصولية الدينية حينا لتتماهى معها في أحيان أخرى يمكن رصده وتفسيره من خلال ملاحظات ريتشارد بهرنت التي حاول فيها تحليل النزعة القومية في البلدان المستعمرة على أساس نظرية المثاقفة (5).
يرى بهرنت أن البلدان النامية تمر بفترة تحول ديناميكي ثقافي تتسم بعدم الاستمرار، وتعتمد على عمليات مثاقفة يمكن التمييز فيها بين نموذجين:
الأول يدعوه بـ”مثاقفة المحاكاة السلبية”، والثاني يدعوه بـ”المثاقفة التوفيقية الإيجابية”.
وهو يرى أن القومية في العالم الثالث هي حصيلة عملية تكيّف قائمة على المحاكاة يقوم بها من يدعوهم بـ”شعوب الهامش” مقابل “شعوب المركز” الأوروبية.
يسارع مثقفو الهامش إلى امتصاص فكرة القومية بما هي غربية المنشأ باعتبار أنهم يعاملونها على أساس أنها وسيلة للتغلب على مركبات النقص التي تسبب بها الحكم الاستعماري، والتعويض عنها. كما أن فقدان الهوية نتيجة لاهتزاز البنى الاجتماعية التقليدية يمكن أن يؤدي أيضا إلى إبراز القومية باعتبارها قومية بديلة. وأما الدولة القومية التي يتوقون إلى تحقيقها فإنها تعتبر من قبل شعوب الهامش بمثابة آلية “ميكانيزم” عالمية تكفل تحقق التطور الاجتماعي والاقتصادي، غير أن القومية التي يفرزها هذا الضرب من الدولة لا تنفع إلا باعتبارها “وسيلة جاهزة دائما لصرف انتباه الجماهير عن مشكلات حكوماتها غير المحلولة وإخفاقاتها ونكساتها”.
وأخيرا فإن هذه القومية “كثيرا ما تميل إلى تمجيد العادات والتقاليد المحلية بطريقة شوفينية”.
هذا التمجيد الأعمى للعادات والتقاليد المحلية بلا تمييز هو بمثابة رد فعل يسعى إلى إيجاد علاقة تواصلية مع الأمر الواقع بمساوئه وحسناته، والمحافظة عليه بدلا من تغييره. كما أن هذا الإفراط في التمجيد يقترن عادة بمحاولة استعادة الماضي أو إعادة عقارب الساعة إلى الوراء باسم استرداد العصر الذهبي. ويقابل ذلك في الخطاب الأصولي الديني طرح مسألة استعادة عصر السلف.
لنلق الآن نظره على هذا التماهي بين الأصوليّتين الدينية والقومية أو الماركسية، ونحاول وضع مفهوم التحرر النسوي على محكّ خطابهما المشترك وما ينطوي عليه من إشارات.
هناك حسب الدراسات النسوية نوعان من الاختلاف بين الذكورة والأنوثة: الاختلاف البيولوجي والنفسي يقوم على التمايز بين الجنسين (Sexes) ويعتبر الجسد فيه أساسا للمفاضلة بين الرجل والمرأة.
وأمّا التمايز الذي تحدده المحددات الثقافية والاجتماعية والسياسية فيقوم على اعتبار الجنوسة (Gendre) (6) أساسا للاختلاف بين الجنسين.
ويمكن القول إنه بموجب هذا الضرب من التصنيف أو ذاك، هناك نصية دينية أو عقائدية كمرجعية ثابتة تكمن وراء الخطاب الأصولي بفرعيه الديني والقومي أو الماركسي.
كما أن هذه النصية الثابتة تحيل الباحث عادة إلى “جوهرانية” تؤكد على أن الاختلاف بين الذكورة والأنوثة يسير إلى وجود جوهر بيولوجي وسيكولوجي مختلف للمرأة وبالتالي فإن ذاتيتها تقف خارج احتمالات التغيّر التاريخي أو الاجتماعي، أو تصبح بعبارة أخرى مسألة غير قابلة للحل.
وفضلا عن ذلك فإن هذه “الجوهرانية” تمضي في حالاتها القصوى إلى أبعد من مفهوم الاختلاف بين المرأة والرجل وتعتبره ضربا من المغايرة (Otherness) الكامنة في طبيعتهما الجوهرية التي تجعل المرأة هي الآخر أو الغير بالنسبة إلى الرجل، والرجل هو الآخر أو الغير بالنسبة إلى المرأة، ولهذا فعدم المساواة بين الجنسين لا يكون حصيلة لعملية تكييف اجتماعي فقط بل يتأسّس كذلك على مفهوم “القوامة” البيولوجية أو ميل الذكر الطبيعي إلى السيطرة على الأنثى واستغلالها واعتبار اختلافها مغايرة ثابتة لا زمن لها ولا تاريخ.
ومن جهة أخرى فإن المغايرة بمعنى اختراع الغير (Otherning حسب مصطلح غياتريسبيفاك) هي بمثابة عملية خلق الآخر في الخطاب الإمبريالي.
ترى سبيفاك أن المغايرة التي يمارسها الأب أو الأم أو الإمبراطورية هي جزء من خطاب السلطة والهيمنة. كما تعتبرها عملية إقصاء للآخر تقوم بإنتاج الآخر المستعمر على أساس أنه يمثل في الخطاب الكولونيالي رعية خاضعة لصانعها.
وهذا النمط من خطاب التبعية الذي يقوم على خلق الآخر وإقصائه يمكن أن نشبهه بالخطاب الأصولي الديني القائم على فكرة النص الثابت القومي، أو الماركسي القائم على فكرة الرسالة الأيديولوجية التي تمثل بدورها نصا ثابتا أو شبه ثابت. إنه في الحالتين خطاب مغايرة مستمرة تسلب المرأة الحق في أن تجعل الحيلولة دون اعتبار الاختلاف الاجتماعي والبيولوجي بينها وبين الرجل مسألة اختلاف وظيفي لا تترتب عليه مفاضلة في القيم تستحيل إلى فعل مغايرة يشير إلى علاقة بين تابع ومتبوع.
في ضوء ما تقدّم يمكن أن نطرح السؤال التالي: ما خصائص الخطاب الأصولي تجاه المرأة العربية الآن؟
من المعروف أن النص، والحدث التاريخي، والمؤسسة، كل ذلك يعتبر ضربا من ضروب الخطاب. وبعبارة أخرى فإن المرجعية النصيّة التي صاغت الخطاب الأصولي صارت في هذا الطور النكوصي من تجربة التحرر النسوي العربي تؤكد على علاقة التزامن بين التمثيل وبين الواقع، بين النص وبين آثاره المتمثلة في السلطة والتبعية والجنوسة.
وإذا أدركنا أن السمة الأساسية للتحرر النسوي في الغرب تكمن في النظام المعرفي السائد، وفي درجة تطوره الاجتماعي، أي في شعاره القائل “إن المرأة لا تولد امرأة بل تصبح امرأة”، (سيمون دو بوفوار)، وأدركنا أن المجتمع العربي لم ينجح في تغيير بنيته المعرفية التقليدية أو البطريركية (بلغة هشام شرابي)، فإن من البداهة الاستنتاج أن هذا المجتمع الذي يسيطر عليه الخطاب الأصولي والمرجعية النصية تجاه المرأة، مازال يصر على الفصل بين المبادئ العقلية وبين الحداثة. فهو ينظر إلى هذه الحداثة المؤسسة على العقلانية بوصفها سلعة ناجزة، يكتفي باستهلاكها. فحداثته إذن حداثة سلعة مبتورة عن مرجعيّتها العقلانية، حداثة النتيجة وحدها وليس السبب والنتيجة معا، فكأنها معجزة ليس غير.
يحسن هنا أن نستعرض بعض المحدّدات التي تتعلق بمفهوم التحرر النسوي في ضوء علاقته بالخطاب الأصولي السائد، والتي أوجزها فيما يلي:
◄أولا: بدأ التحرر النسوي مع عصر النهضة بداية مطلبية ذات مضمون اجتماعي، واعتبر أن الاختلاف الجنسي البيولوجي هو الذي يحدد التمايز الاجتماعي الجنوسي.
◄ ثانيا: تطور مفهوم التحرر النسوي في خطاب أيديولوجي متزامن مع العلمنة التي شهدتها الدولة العربية الحديثة بعد الاستقلال.
◄ ثالثا: شهد الخطاب الأصولي صعودا استثنائيا مع نجاح الثورة الإيرانية. وأعقب هذا الصعود تراجع مستمر في إنجازات التحرر النسوي التي أصبحت ترتبط ارتباطا وثيقا بفكرة التحرر السياسي الشامل.
◄رابعا: كان لعودة النصيّة الدينية وبروز الخطاب الأصولي تجاه المرأة أثرهما على هيمنة النص على الخطاب الأصولي: الرسالي الأيديولوجي، القومي والاشتراكي.
وقد تجلى هذا التأثير على القوى غير الدينية في اتجاهين:
أ- اتجاه آثر تأجيل طرح مفهوم التحرر النسوي خارج النص الديني.
ب- اتجاه آخر استبدل مرجعيته النصية القومية والاشتراكية، وأحل محلها مرجعية النص الديني محاولا التغيير بالتأويل حينا وبالتقويل حينا آخر.
◄ خامسا: لم يعد مفهوم التحرر النسوي تعدديا بل أصبح شموليا لا يتحرك بنصه الأيديولوجي إلا في داخل النص الديني نفسه.
◄ سادسا: طرح الخطاب الأصولي السائد تجاه المرأة رد فعله على الحداثة الغربية، ففصل الحداثة عن المبادئ العقلية التي أسستها في الغرب، وقام بتسليعها، أي الاكتفاء بالنظر إليها كسلعة أو بضاعة للاستهلاك.
وهكذا فإن الإنجازات الإصلاحية للأفغاني ومحمد عبده ومحمد إقبال التي حاولت جاهدة إيجاد طباق بين الفكرين الإسلامي والغربي، لم تلبث أن تسلمت الأصولية الإسلامية الصاعدة مفاتيحها، فاستعادت بذلك المرحلة النصية التي لا تقبل بهذا الطباق. وأحد الأمثلة البارزة على هذه المرحلة تصريح الإمام الخميني في إحدى مقابلاته التي أشار فيها إلى أن الإسلام لا يحتاج إلى صفة أو تعريف كعبارة ديمقراطية مثلا.
ومغزى هذه الإشارة هو الترويج لمرحلة من النقائية (Purism) التي تحيل إلى نص ولحظة تاريخية ينظر إليها باعتبارها ساكنة ثابتة غير قابلة للحركة وتمحو من ثم ما أعقبها من إنجازات مادية حققها الإسلام الحضاري.
◄ سابعا: المرحلة النقائية في الخطاب الأصولي أسفرت عن جملة من المشاريع التي وجدت أن اعتبار الإسلام نظاما شموليا يفتح الطريق أمام “أسلمة المعرفة”. فهناك تبعا لذلك أدب إسلامي وعلم اجتماع إسلامي واقتصاد إسلامي وسياسة إسلامية. وهكذا فالنتيجة اللافتة التي تُسفر عنها أسلمة المعرفة هذه هي أسلمة فكرة التحرر النسوي نفسها.
غير أنه لا يمكن على الصعيد الإجرائي، وأنا أتفق في ذلك مع طروحات برايان تيرنر (7) تطوير شيء اسمه علم اجتماع إسلامي للسبب نفسه الذي يحول دون وجود علم اجتماع مسيحي أو علم اجتماع يهودي أو أيّ نوع آخر من العلم الاجتماعي المرتبط بفئة عرقية إثنية معينة. فهناك منطق أساسي ونظرية في العلوم الاجتماعية يجعلها غير قابلة للانضواء تحت لافتة إثنية أو ثقافية أو تاريخية.
ثامنا: انضواء الخطاب الأصولي الرسالي، القومي والماركسي، تحت راية تستمد مرجعيتها من نصية دينية ثابتة يُدخل مفهوم التحرر النسوي في مرحلة يتعذر معها تحرير العقل من النص. وأنا لا أعمم هذا الحكم القيمي هنا وإنما أرى أن الاستثناء لم يعد قادرا على نفي ما أصبح أشبه بالقاعدة. ومن هذه الاستثناءات شديدة الأهمية طروحات نوال السعداوي وهي طروحات تختلف اختلافا بيّنا عن المثال الذي سبق أن سقته قبل قليل، في كتابها المرأة والجنس مثلا.
وكذلك تندرج في هذا التصنيف طروحات فاطمة المرنيسي الجريئة والصادرة من خارج النظام المعرفي النصي وبخاصة تلك التي ظهرت في كتابها “Beyondtheveil”.
وأخيرا فإنّ أخشى ما أخشاه هو أن تكون المرحلة التي بلغها مفهوم التحرر النسوي قد وصلت إلى ما يدعوه مؤرخو الفلسفة بمرحلة “الغلق” ()Closure أي مرحلة سيطرة نظرية أو مذهب لديه القدرة على تفسير الظواهر كلها دون أن يترك زيادة لمستزيد.
غير أن هذا “الغلق” يبدو في هذه النصيّة الدينية صادرا عن هيمنة فكرة الثبات وبالتالي فهو ربما كان يعادل إلغاء العقلانية نفسها.
ناقد من سوريا مقيم في لندن
إبداع المرأة بين الوضعية الأمازونية ومواجهة الاستلاب/ كاميليا عبدالفتاح
وضعية المرأة المُبدعةُ أكثرُ تعقيدًا وتأزُّمًا فهي -فضلاً عن طبيعتها الأنثوية الفيّاضة بالعاطفةِ والنشاط النفسي- تمتازُ بسماتِ الشخصية المبدعة.
الأمازونيات نساءٌ مقاتلاتٌ ذكرهن “هيرودوت” في تاريخه، وأشار إلى أنّهن عشن في شمال البحر الأسودِ، ورأى بعض المؤرخين أنهنّ عشنَ في أفريقيا. والمرأةُ الأمازونية امرأةٌ قوية يصطرعُ فيها الميلُ الفطري الأنثوي للرجل مع الميول القتالية الاستقلالية ؛ فهي تتزوج الرجل، وتنجبُ منه، لكنها تؤثرُ العيش مستقلة عنه، بل وتهيمنُ عليه -في كثيرٍ من الأقوال- وهي تعيشُ على القتال؛ ولذلك كانت المرأة الأمازونية تعمدُ إلى بتر أحد ثدييها حتى تتمكن من وضع الرمحِ والقوس أو السيف -عليه- بينما تحتفظُ بالثدي الآخر.
من هنا اتخذتُ هذه الوضعية الأمازونية عنوانًا لهذه القراءة النقدية؛ فهي وضعية تراجيدية يصطرعُ فيها التكوين الأنثوي مع نقيضه، وتعاني فيها الأنثى من ميلها إلى الرجل، واضطرارها إلى محاربته والاستقلال عنه، في الوقت ذاته -بما يُشبه في افتراضي- وضعية التأزّم النفسي والإنساني التي تعاني منها المرأةُ العربية عامة والمبدعة العربية خاصة، حيثُ تكابد هذا الصراع وهذه المفارقات بين ميلها إلى الرجل حبيبًا، زوجًا، صديقًا -إلى آخر ذلك- وتضطر إلى مواجهة القهر والاستبداد الذكوري المُهدِّد لكينونتها وتفرّدها.
لا تزالُ المرأةُ، في افتراضي، تعاني من التناقض والاضطراب خاصة في المجتمع ِالعربيِّ على صعيدِ وضعيتِها الاجتماعية والإنسانية والفكرية، لا تزال تُواجهُ من قطاعِ كبيرٍ في المجتمعِ العربيِّ باعتبارِها كيانًا إنسانيًّا ناقصًا لا يكتملُ إلَّا بالتبعيّةِ للرجلِ، و لاتزالُ، في افتراضي، في صراع من أجل الدفاع عن هويّتها.
ولعلّ الناقدة الأدبية والمعنيَّة بالنسوية جوليا كريستيفا قد لخّصت هذا الأمر في إشارتها إلى أنّ “المسألة النسوية قد شهدت تطورا في القرن العشرين عبر مراحل عدة، أولها: حول هوية النساء مع الرجال، والمرحلة الثانية كانت حول هوية النساء ضد الرجال، بينما شهدت المرحلة الثالثة شكّا حول مسألة الهوية برمّتها” (1).
وإنَّ وضعية المرأة المُبدعةُ أكثرُ تعقيدًا وتأزُّمًا؛ فهي -فضلاً عن طبيعتها الأنثوية الفيّاضة بالعاطفةِ والنشاط النفسي- تمتازُ بسماتِ الشخصية المبدعة، وما تقتضيه من حساسية ورهافةٍ، ونفاذِ روحٍ؛ فهي كيانٌ ثائرُ الفكر والشعور؛ ومن هنا تكابدُ أعمقَ مذاقات الاغتراب والتّصدع؛ النَّاتجِ من التناقض الصارخ بين ما تفرضهُ وضعيتُها الإبداعية من قيمةٍ وتقديرٍ وإكبارٍ، وما تلقاه على صعيد الواقعِ من إهمالٍ، أو إنكارٍ، أو قهرٍ، وإقلالٍ من الشأنِ.
لا تزال المرأة، في افتراضي، تعاني من التناقض والاضطراب خاصة في المجتمع العربي على صعيد وضعيتها الاجتماعية والإنسانية والفكرية
إنَّ هذه الوضعية المتأزِّمة للمرأةِ الكاتبةِ -فضلًا عن الوضعية المتأزِّمة للمرأة عامة- اقتضت كثيرًا من السماتِ الشخصانية في الكتابة النِّسائية، وهي شخصانيةٌ حتميةٌ، على صعيد المضمون والرؤى، وبعض سمات التشكيل الجمالي؛ ومن ثمَّ أتفقُ مع هيلين سيكسو في أنَّ الإبداع النسويّ “يحدثُ في مناطق غير تلك التابعة للهيمنة في النظرية الفلسفية. فهي لا تريدُ أن تدخل…، خارج المطلق النظري تتشكلُ الكتابةُ النسويةُ، وبالتحديد تتشكلُ في الثغرات التي لا تُسلط عليها الأضواءُ من قِبل البنية الفكرية الأبوية. بمعنى آخر هذه الثغرات موجودةٌ بالفعل وكائنةٌ ، لكنه غيرُ معترفٍ بها” (2).
بهذا المفهوم نذهبُ إلى أنَّ مصطلح “الإبداع النَّسْويّ” أدقُّ في التعبير من “الإبداعِ النِّسائيّ”؛ فالأوَّلُ “هو النصّ الذي يأخذ المرأة كفاعلٍ في اعتباره، وهو النصُّ القادرُ على تحويل الرؤية المعرفية والأنطولوجية للمرأة إلى علاقاتٍ نصيّة، وهو النصّ المهمومُ بالأنثويّ المسكوتِ عنهُ، الأنثوي الذي يُشكّلُ وجودُه خلخلةَ للثقافة المهيمنة، وهو الأنثوي الكامنُ في فجوات هذه الثقافة ، وأخيرا هو الأنثوي الذي يشغلُ الهامش”. [د. شيرين: كتاب نسائي أم نسوي] (3 ).
وقد ارتضيتُ في هذه الدراسة أنْ أطرح مقاربة نقديةً حولَ بعضِ نماذج من السيرةِ الذَّاتية النَّسويةِ؛ لأنَّ السيرة الذاتيةَ نصُّ مُعلن يضمرُ آخر غيرَ مرئيٍّ؛ فالمُعلن هو الوقائع التي عاشتها الذاتُ الساردة، أمَّا المُضمرُ فهو الوقائع الحُلمية أو الواقعُ المُرتجى الذي ظلَّ حلمًا غيرَ مُتحقّقٍ لهذه الذات. نحنُ في السيرة الذاتية بين نصٍ ظاهر، وآخر مراوغ إشاري، وأمامَ محاولةٌ إبداعيةٌ لإعادة بناء الذات كما ذهب شاري بنستوك في تعريف هذا النمط الإبداعي؛ فهي ترتكزُ على بروز الذاتية؛ بما يجعلها النمطَ الإبداعي الأكثر قدرةً في إبراز مواجهةِ الذات الأنثوية المبدعة للآخر، وإدانة الوقائع والأغيار المُستلِبة؛ وبذلك تتصدى السيرة الذاتية للخوف التاريخي المسكون في ذاكرة المرأة من التعبير عن الذات، تتصدى لذلك الركام من الاختباء والمواربة والتورية، والتقنّع والتَّبرؤ من نسبةِ كتابتها إليها كما تقولُ جين أتوميكينس (4).
تخيَّرتُ في هذه المقاربة النقدية نماذج من السيرة الذاتية النَّسوية لكلٍّ من الشاعرة الفلسطينية فدوى طُوقان، الكاتبة والمُفكّرة نوال السعداوي، الأديبة والمفكرة عائشة عبدالرحمن، فضلًا عن وقفةٍ قصيرة مع الأديبة اللبنانية مي زيادة.
تُوشكُ إشكاليةُ “تأزُّم وضعية الذات الأنثوية” أن تكونَ الإشكالية التي تتسيّدُ موضوعات هذه النماذج من السيرة الذاتية، وتُطرحُ باعتبارها مؤشرًا على تخلف المجتمع العربي وتأزمه الفكري والإنساني، ودليلا على تأخره في سلّم الإنسانية، وتعمدُ بعض الأديبات إلى إرجاع قهر المرأة إلى عهد سحيقٍ من عمر الزمان ؛ فتاريخ المرأة في رأي مي زيادة “تاريخُ استشهادٍ طويل؛ فهي عبر العصور المختلفة ليست إلَّا حيوانُ لذة ومتاع السيِّد، وطفلة لاهية للعبث” (5).
ورغم هذا فإنَّ خطابَ مي زيادة في سياق المُطالبةِ بالتحرر والكينونة النّسوية خطابٌ أُنثويٌ ناعمٌ يصف الرجل بالمُنعمِ والمُنصفِ والسيّدِ الكريمِ واهب الحريةِ والتحرر؛ ممَّا نعتقدُ أنَّهُ من مُوجباتِ المرحلة التاريخية التي عاشتها مي زيادة، على النَّقيضِ ممَّا نجدهُ في خطابِ كلٍّ من: نوال السعداوي وفدوى طوقان وعائشة عبدالرحمن، مع وجودِ فوارقٍ لاختلاف السمات الشخصية واختلافِ التّجربةِ الإنسانية حيثُ يوصفُ الرجلُ بأنّهُ نموذجٌ للسُّلطة القاهرة المُستلِبة.
ناقدة من مصر
صورة المرأة العربية/ ماهر عبدالمحسن
شعور قاسم أمين بحاجة الأمة عامة للإصلاح وحاجة المرأة بنحو خاص للإصلاح، إنما يأتي كنتيجة طبيعية لانخراطه في الحياة اليومية والاجتماعية لهذه الأمة.
يشهد التاريخ الإنساني بأنّ المرأة، في الكثير من مراحل هذا التاريخ، قد تعرّضت لظلم بيّن من قبل الرجل الذي دأب على حصرها في دائرة ضيقة لا تتجاوز تبعيتها ومن ثم خدمتها له.
كما يشهد أيضاً هذا التاريخ قيام بعض الرجال بالسباحة ضد هذا التيار الجارف، ومحاولتهم الدفاع عن المرأة وردّ، ولو جزء يسير من حقوقها المهدرة كي تتمكن من مواصلة دورها الحضاري الذي تم طمسه بفعل فاعل لا قلب له ولا رحمة.
في هذا الصدد يورد قاسم أمين عدداً من آراء المفكرين الغربيين الذين انتصروا للمرأة في كتابه “المرأة الجديدة” على النحو التالي: قال سيملس “للمرأة في تهذيب النوع الإنساني أكثر ممّا لأيّ أستاذ فيه، وعندي منزلة الرجل في النوع منزلة المخ من البدن ومنزلة المرأة منه منزلة القلب”، وقال شيلر “كلما وجد رجل وصل بعمله إلى غايات المجد وجدت بجانبه امرأة محبوبة”، وقال روسو “يكون الرجال كما تريد النساء، فإذا أرادت أن تجعل الرجل من ذوي الهمة والفضيلة فعلّم النساء الهمة والفضيلة”، وقال فنلون “إن الواجبات التي تطالب بها النساء هي أساس الحياة الإنسانية…”، وقال لامارتين “إذا قرأت المرأة كتاباً فكأنما قرأ زوجها وأولادها؟”. (قاسم أمين، المرأة الجديدة، القاهرة: مطبعة الشعب، 1911، ص ص123 -124).
وإذا كان جون ستيوارت ميل هو أول من قدم دراسة تنتصر لحرية المرأة وتتجاوز مجرد الآراء المتشذرة التي يوردها الفلاسفة هنا أو هناك، ربما لحفظ ماء الفكر في زمن لم يعد من اللائق به التفكير ضد الحريات عموماً وحرية المرأة بنحو خاص، فإن أبرز المحاولات العربية في هذا السياق إنما قد جاءت على يدي المفكر ورجل القانون قاسم أمين في بداية القرن الماضي من خلال كتابيه الشهيرين “تحرير المرأة” و”المرأة الجديدة”، واللذين يؤرخ بهما لبداية عصر جديد للمرأة يفصلها عن تاريخ طويل من العبودية سادت فيه النزعة الذكورية في كل مناحي الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والفكرية. كما جاءت المحاولة الأكثر معاصرة في بداية الألفية الثانية على يدي المفكر العربي إمام عبدالفتاح إمام من خلال مشروع فلسفي يضم أربعة كتب حتى الآن هي علي الترتيب: “أفلاطون والمرأة” و”أرسطو والمرأة” و”الفيلسوف المسيحي والمرأة” و”نساء فلاسفة”. (وقد وعد في نهاية كتابه “نساء فلاسفة” بتقديم كتاب يتضمن نساء فلاسفة من العصر الحديث). هذا بالإضافة إلى آرائه حول المرأة التي أوردها في عدد من المقالات ضمن مقالات أخرى تم جمعها في كتاب “أفكار ومواقف”.
والسؤال الذي يفرض نفسه، لماذا أقدم إمام عبدالفتاح على تقديم هذا المشروع بعد مرور قرن من الزمان على كتابي قاسم أمين؟
الإجابة لا تخرج عن أحد احتمالين: إما أن إمام عبدالفتاح قد رأى أن المرأة العربية لم تزل تعاني من إهدار لحقوقها وكبت لحرياتها رغم مرور هذه السنين الطويلة. وإما أنه وجد في محاولة قاسم أمين قصوراً ما، فعمل على استكمال هذا القصور حتى يكتمل بذلك المشروع الفكري العربي، الملقى على عاتقه مهمة تحرير المرأة العربية، خاصة في ظل المستجدات التي طرأت على الساحة ولم تكن موجودة في عصر قاسم أمين.
وعلى أيّ الأحوال لا يحاول هذا البحث القصير أن يجيب على هذا التساؤل، وإنما يحاول أن يبرز الكيفية التي عالج بها كل من قاسم أمين وإمام عبدالفتاح إشكاليات المرأة في المجتمع، فهو بحث فلسفي في المقام الأول يعنى بالمناهج والنظريات أكثر مما يعنى بالمضامين التي تحملها هذه المناهج وتلك النظريات. كما أنه يترك للقارئ مساحة للتفسير والتأويل، ومن ثم صياغة الإجابة التي يراها.
لماذا أقدم إمام عبدالفتاح على تقديم هذا المشروع بعد مرور قرن من الزمان على كتابي قاسم أمين؟ الإجابة لا تخرج عن أحد احتمالين: إما أن إمام عبدالفتاح قد رأى أن المرأة العربية لم تزل تعاني من إهدار لحقوقها وكبت لحرياتها رغم مرور هذه السنين الطويلة
قد تتقارب الغايات وتتشابه الوسائل، لكن النظرة المدققة تكشف لنا عن اختلافات جذرية بين ما قدمه قاسم أمين وإمام عبدالفتاح في مقاربتهما لموضوع المرأة.
وإذا عدنا إلى المقدمات التي وضعها المفكران لمؤلفاتهما لأمكننا أن نضع أيدينا على قدر معقول من هذه الاختلافات. فقاسم أمين يحدد هدفه من كتابه “تحرير المرأة” بأنه هدف إصلاح اجتماعي، فيقول “إني أدعو كل محب للحقيقة أن يبحث معي في حالة النساء المصريات، وأنا على يقين من أن يصل وحدة إلي النتيجة التي وصلت إليها، وهي ضرورة الإصلاح فيها” (قاسم أمين، تحرير المرأة، القاهرة: كلمات عربية للترجمة والنشر، 2012، ص9).
ويأتي هذا الإصلاح ضمن حاجة إلي إصلاح أشمل ينال الأمة بأسرها “لا أظن أنه يوجد واحد من المصريين المتعلمين يشك في أن أمته في احتياج شديد إلى إصلاح شأنها” (المرجع السابق، ص8).
ويحدثنا قاسم أمين في أكثر من موضع عن حاجة الأمة للإصلاح والوسائل المؤدية إليه، وكيف أنها شعور داخلي يدفع الإنسان إلى التعبير عن كل فكرة تطرأ على ذهنه لتخرج إلى النور وتسهم في تقدم الأمة.
والحقيقة أن شعور قاسم أمين بحاجة الأمة عامة للإصلاح وحاجة المرأة بنحو خاص للإصلاح، إنما يأتي كنتيجة طبيعية لانخراطه في الحياة اليومية والاجتماعية لهذه الأمة. فقاسم أمين- بهذه المثابة- يبدو كمصلح اجتماعي. يفكر من داخل المشكلة الاجتماعية وبوحي من أزماتها، لا كمجرد منظّر يتأمل الظاهرة ويعالجها من الخارج على نحو ما سنرى في مقاربة إمام عبدالفتاح. وليس أدل على ذلك من قول قاسم أمين نفسه “إني أكتب هذه السطور وذهني مفعم بالحوادث التي وردت على بالتجربة، وأخذت بمجامع خواطري” (المرجع السابق، ص22).
ولعل السبب في ذلك يرجع إلى الخلفية الفكرية لقاسم أمين، والتي أسهم في تشكيلها عمله بالقضاء وبالقانون، الأمر الذي جعله قريباً من المشكلات الاجتماعية التي كانت تعاني منها الأمة المصرية في ذلك الوقت، وهي نفس العوامل التي سوف تمكّنه من إيجاد الحلول القانونية لهذه المشاكل. وعلى ذلك فلا يستغرب أن نعثر لديه على مباحث من قبيل “الزواج” و”الطلاق” و”تعدد الزوجات” و”الحجاب”.
كاتب وباحث مصري
الأنثوية وسلطة الكتابة: القدرة على النفور من التاريخ/ علي حسن الفواز
مفهوم الاختلاف في الكتابة لا يعني البحث عن جنسٍ كتابي محدد، ولا عن توصيف يسبغ على الكتابة الأنثوية سمات، ويُعطي لها ملامح، بقدر ما أن الأمر ينحصر بالقدرة على النفور من التاريخ.
حين تم اكتشاف الكتابة، كانت السلطة قد احتازت أدواتها ووسائطها بيد الرجل، فكان هو المُدوّن والمؤرخ والعرّاف والملك ونصف الإله، واكتفت المرأة منذ المرحلة الزراعية/مرحلة التوطين بنوع من خصخصة الوظائف الجنسوية، وصار الرجل -تبعا للسلطة- محفوفا بالأساطير والأسفار والبطولات، وظلت المرأة هي كائن الانتظار والقربان/ بينلوب مثلا.
وحتى المراحل التي مارست فيها المرأة السلطة/الحاكمية لم تخرج من مهيمنة النسق المضمر، نسق الجماعة العسكرية، أو الجماعة الدينية، ونسق المؤسسة الزوجية، وحتى النسق العُصابي للقرابة والمقدس على طريقة الملكة زنوبيا والملكة المصرية كليوباترا، أو شجرة الدر والملكة بلقيس في الموروث الشرقي ظل استثنائيا، وفيه من المثيولوجيا أكثر مما فيه من الواقع، واللائي وقعن في النهاية تحت غزو أو قتل أو مهيمنة الرجل/الذكر/السلطة. ربما كانت كانت (طفرة شهرزاد) هي الشفرة الأكثر تمثلا لقوة الأنوثة المُفكرة/الحكواتية مقابل هشاشة النسق المهيمن للذكورة التي تمثلها السلطة العنفية لشهريار.
العلاقة ما بين سلطة الحكي وسلطة الجسد ومؤسسة الحاكمية أعطت لفاعلية الخطاب حضورا للكلام على حساب الإيروس، وللحضور على حساب الغياب، والحياة على حساب الموت، وتلك معادلة كان يفرض وجودها العقل المهيمن، عقل السلطة والذكورة الذي يعيش ثأرية عقدة الخيانة والرغبة، والتي تقود بالمقابل إلى تحفيز القراءة الثقافية للكشف عن أن العطب الجنسي للملك شهريار، هو مقابل رمزي وتعبيري للعطب السياسي.
حركات التجديد والتنوير والإصلاح لم تخرج تماما من نسق تاريخ تلك السلطة، بما فيها سلطة المجال/القصر/القلعة/الحريم/ التعليم والحاكمية، فكان الإصلاح يتموضع داخل المنظومة الدينية أكثر منه داخل المنظومة الحقوقية، وصولا إلى بداية القرن العشرين الذي يُعدّ العتبة النشوئية لموضوعات تحرير المرأة، والذي كان جزءا من تحولات اجتماعية وسياسية ونهضوية مهمة، حيث بدت تمثلاتها عبر حراك ثقافي وسياسي وحقوقي انخرطت فيها جماعات ثقافية وحقوقية مدنية ونقابات وأحزاب في أوروبا، لا سيما على مستوى قوانين العمل والأحوال المدنية، وليست الأحوال السياسية.
ولعل صدور كتاب قاسم أمين عن تحرير المرأة يُعدّ استشرافا شجاعا لأفق هذه التحولات، ولما حملته من مضامين إنسانية حول حرية المرأة لمواجهة قوى تقليدية لها سطوة رمزية لسلطة التابو والأب، ولها أيضا مرجعياتها النصوصية التي زخرت كثيرا بالأحكام والتآويل والفرضيات القامعة لأيّ شكل حقيقي وحرّ للمرأة على مستوى التنظيم والاستقلالية، وكذلك على مستوى الحصول على الحقوق المتساوية في العمل والأجور والضمان الاجتماعي والصحي والجنسي.
لقد ظلت ثنائيات العقل والحرية، والعقل والجسد، والعقل والأيديولوجيا، والعقل والنقل مجالات إشكالية، لم تتقعّد مفاهيمها ولا أطروحاتها، وأن تمثلاتها في الكتابة الأدبية ظلت أكثر إرهاصا بفكرة (النص المضطهد) النص المسكون بالإثم والخيانة -أنا كارنينا، مدام بوفاري- أو المسكون بالقوة الأخلاقية -الأم لمكسيم غوركي- أو بالرغبة المتعالية كما في رواية “المثقفون” لسيمون دي بوفوار.
مفهوم الاختلاف في الكتابة لا يعني البحث عن جنسٍ كتابي محدد، ولا عن توصيف يسبغ على الكتابة الأنثوية سمات، ويُعطي لها ملامح، بقدر ما أن الأمر ينحصر بالقدرة على النفور من التاريخ، التاريخ هنا بوصفه سلطة، أو عادات أو طقوس أو مركزيات أو علاقات، والذي اقترح للأدب النسوي بوصفه الجندري تموضعا داخل فضاء الأنوثة بوصفها الجنسوي المكتسب من السياق الاجتماعي، وربما هو هذا ما دفع البعض من كاتباتنا إلى استعارة صوت الرجل وسلطته وقناعه الفحولي -المُكتسب اجتماعيا أيضا- لممارسة التعويض الرمزي والتعبيري، وبما يجعل الصوت الفحولي في النص وفي اللاوعي نوعا من الاستمناء الإيهامي، والشفرة التي تدفع لتحليل العلاقة ما بين الذات والجنسي والمقدس، وللقبول بها داخل كتابة النص، إذ تكون الكتابة تعبيرا عن الذات، وللاعتراف بمتعتها، وبتكيفها مع الاجتماعي، فضلا عن وظيفتها الثقافية في استكناه الحمولات السيميولوجية والسيسيولوجية، وفي خرق الواقع، وإعطاء جرعات تعبيرية لخطاب الرغبة من خلال الصورة والإعلان والمشاركة والعمل وغيرها.
بعد مئة عام أو أكثر من صدور كتاب قاسم أمين عن خطاب تحرير المرأة يثار أكثر من سؤال حول هذا التحرر بوصفه وعيا بالحرية وبشروطها الاجتماعية والاقتصادية والنفسية، فما هي طبيعة العلاقة ما بين الحرية والجسد؟ وهل يمكن ممارسة الإفصاح عن الهوية (الأنثوية) خارج الجسد، وضمن مفهوم الذات الإنساني والرغبوي/التواصلي والإيمائي؟
هذه الحرية، وفي سياق هذه الأسئلة ستكون تعبيرا عن أيديولوجيا، وعن تمثلات تمنح الجسد قوته، وعن موضوع، وتُسكنه في اللغة بوصفه نصا أو جوهرا أو دافعا يُغني اللذة والتواصل والحرية بشحنات تجعله وجودا أو موضوعا.
الثورة الرقمية وصناعة المختلف
الثورة الرقمية كرست ما سمّاه د محسن بوعزيزي بمعالجات “السيميولوجيا الاجتماعية” إذ أسهمت في كسر النمط، وفي تغيير أطروحات التواصل والسيطرة والمراقبة، وصنعت للكتابة أنظمة سيميولوجية مغايرة، عبر العلاقات والروابط، وعبر استهداف النسق المهين الحاكم للعلاقة الواقعية والمفاهيمية، تلك التي أعطت مجالا للتسمية، وللاعتراف، ولاقتفاء أثر العلامة داخل الاجتماعي والرمزي، وصولا إلى فرضها في النظام التعليمي عند عدد من الجماعات التنويرية، ورغم أن الجماعات الأصولية، لا سيما بعد أحداث “الربيع العربي” حاولت إعادة فرض خطاب السلطة والمجال والحكم، إلّا أن ما أُنتهِك من أنظمة تعبيرية ظل يحمل معه حافزا، حتى وإن كان مُضمَرا، إلّا أنه سيظل باعثا على كتابة نص اجتماعي وحقوقي مغاير، يمكن أن تكون له سطوته في الشارع والتظاهر والاحتجاج في القانون وفي النضال المدني، وفي الكتابة المفتوحة أيضا عبر وسائل التواصل الاجتماعي بوصفها جزءا من معطيات الثورة الرقمية.
لقد أسهمت هذه الثورة في توسيع مديات الحديث عن تحرير المرأة، من خلال تحرير المجال والمحبس والقلعة عبر المكان الافتراضي والرجل الافتراضي، وعبر اصطناع المجال المضاد للاعتراف والإنتاج والتسويق والاستهلاك، لكنها أثارت بالمقابل جدلاً أعادنا إلى ثنائية الجندري والجنسي، إذ كرس النظام الرقمي خصوصيات غير نمطية، يتمثلها التخارج عن النظام الاجتماعي، وتساكنها رغبات مشحونة بطاقة التفجّر، تلك التي قال عنها روجي دادون “بالرغبة يتملص الجسد من تصرفاته الآلية ويجعلنا نتذكر بقوة، بالرغبة يتحين الجسد، يهتز، ويدرك نفسه باعتباره نبضا حيا، بها يجعل نفسه حاضرا ثقيلا رشيقا متوسلا أو آمرا”. (روجيه دادون : الرغبة والجسد، ترجمة محمد أسليم مجلة “علامات” العدد الرابع 1995).
فعل الرغبة يقود أيضا لاصطناع مملكة غير منضبطة للعلامات، تلك التي تستعير كثيرا من قاموس فرويد في اللاوعي ومن رولان بارت في السيميولوجيا لتكون ضد “الدوغما” و”المقدس” رغم أن الكثير من هذه الاشتغالات تظل متلبّسة به، وبعلاماته القامعة.. فهل استطاع الجندري الأنثوي في النظام الرقمي أن يتحول إلى سلطة؟ أم هل تحول هذا النظام إلى مجال تعبيري مقطوع عن النسق الاجتماعي والحقوقي؟ مقابل ما ظل الجنسي مكتفيا بطاقته البايولوجية التوليدية لتكريس الصورة المثالية لحواء الأسطورية وليست حواء الأرضية.
مثل هكذا أسئلة يمكن أن تكونّ عتبة نظرية وإجرائية لمقاربات معرفية حول مفهوم أنسوية الأنوثة، وحول طبيعة السلطة التي تظل رهانا معقدا على أدلجة هذه الأنسوي، وعلى أيّ معالجة إشكالية لاستيهامات التملّك والحرية، وعلى صياغة عقد اجتماعي آخر للعلاقة بين “الأنوثة والذكورة” وبعيدا عن رهابات الهجر.
من الصعب جدا وضع معيار لفحص هذه المعطيات، ومفارقاتها، فالكثير من الكتب تحدثت عن الخلط المفاهيمي للذكورة والرجولة والفحولة والأنوثة والنسوية، حدّ أن أطروحات ما بعد الحداثة واشتغالات النقد الثقافي وضعت مجالا نظريا لما يسمى بـ”النقد النسوي” والذي يرهن قراءاته للخطاب بجملة من العلامات والمؤشرات التي ينخرط فيها النص وسردياته وشعرياته وصولا إلى شرعنة وجود قاموس نقدي لهذا المعطى، لكن الطبيعة الإجرائية لذلك تظل محصورة في علاقة السياق الثقافي بالسلطة وبنظام علاماتها، وفي مجال علاقة التحليل النقدي بمرجعيات تكشف عن المقموع والمسكوت عنه في أنساقنا المضمرة، فضلا عن إبراز علاقة هذا النقد بالأدب والجسد بشكل خاص، لا سيما على مستوى السرديات، تلك التي اشتغلت عليها معالجات نقدية وثقافية كثيرة، لكن أبرزها ما يتعالق بالأطروحات المعاصرة لجوليا كرستيفا ولوس إيريغاري، وضمن مجال التعبير عن “النص المُضطْهَد” النص الذي ظل متذبذبا بين ثنائيتي الجسد والوعي.
شاعر وناقد من العراق