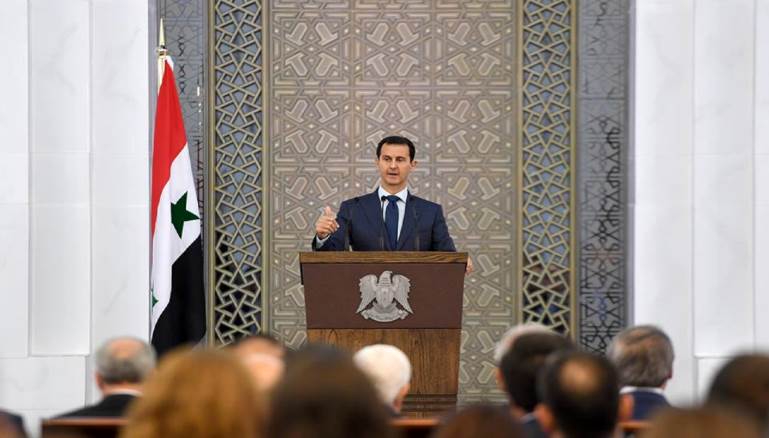من المناهج إلى المقابر/ سلام الكواكبي

في الماضي القريب، وإبّان مخاض بناء “الدولة” السورية بعد نهاية عهد الانتداب، تغنّى السوريون بانقلاباتهم العسكرية “البيضاء” قليلة الدماء، لتمييز مجتمعهم عن عنفية جيرانهم. وقد طوّروا في ذلك نظريات تتحدث عن طبيعة العلاقات الاجتماعية والتجانس الطائفي والتمازج المذهبي والتآخي المناطقي. وعندما اندلعت الحرب الأهلية في لبنان، وجدت بعض النصوص طريقها إلى التمييز والتمايز، معتبرةً أن ما أصاب الجار مرتبط بنوعية التركيبة “اللاوطنية” لدولة “اصطنعها” المستعمرون. وعندما انفجر العنف عراقياً، تناطحت أقلام “محللين” سوريين للبحث عن “أمراض” المجتمع العراقي التي تُخرج كل هذا العنف الغريب “حتماً” عن مجتمعنا السوري. وتطورت النظريات في تفسير غربة مجتمعنا عن هذه الأشكال العنفية، فمنها من أعاده إلى وعيٍ مُتخيّل، ومنها من تحدّث عن طبيعةٍ بشرية، وكاد أن يُقارب في تحليله التمييز الضيق، وبعضها تغنّى بانسجامٍ دينيٍ موهوم. واعتبرت تحليلاتٌ سلطوية، أو طالبة القرب منها، أن مناعة المجتمع السوري أمام العنف ناجمة عن “نظامٍ” سياسيٍ، أسّس لمجتمعٍ منسجم بالاعتماد على قواعد ناظمة، أجمع عليها “الخاضعون” له. وكان أكثر المخدوعين هم أبناء “الأقليات”، كما تُحب الدوائر الخارجية توصيفهم، وكما يحلو لجزءٍ من عامتهم التغني به، وكأنه عقد ألماسٍ، يقي من الشرّ القائم في بنية مخلخلة. وأخيراً، تدرّب المحللون الأجانب في هذا الحقل، محاولين تفسير “اللاعنف” في المجتمع السوري، مقارنة بأترابه القريبين والمشكلين من الخليط التكويني نفسه الذي طالما سمّاه الحالمون “الموزاييك” السوري، أو “الفسيفساء” السوري.
انهارت لوحة الموزاييك وتحطّم الفسيفساء، ليكشف عن مشهد طروادي عنفي مخيف. وتبين أن “اللاعنف” ليس هو إلا في أضغاث أحلام الكتبة. و”كشّر” المجتمع بتكويناته كافة عن “أنياب” عنفية، لا مثيل لها. فإن لم يكن قصفاً وتدميراً وتشريداً، فذبحاً واغتصاباً. وإن لم يكن في الكتابة فهو في الأغنية، وإن لم يكن في العلاقات المناطقية، فهو في العلاقات الأسرية الأكثر حميمية. وإن لم يكن في التشكيك، فقد أبدع في التخوين.
إن العنف الذي أبرزته السنوات الأخيرة في سورية، كما في غيرها من الجيران، ليس جينياً حتماً، ولا علاقة له بالمناخ، ولا بالتركيب الجيولوجي لمناطق السكن. هو نتاجٌ لتراكم حقبٍ من الجهل والتجهيل، يعود جزءٌ منها إلى مرحلة الاستعمار والانتداب والوصاية، المشبعة تجريماً، والجزء الأكبر إلى حقبة “الدولة الوطنية” ما بعد الاستقلال. وهي المدعومة بالنصوص، دينية حيناً وحزبية أحياناً، أو كلاهما معاً عندما يتزاوج السلطوي مع الديني ويصنعان “الظلامية التقدمية”. هذا العنف هو نتيجة لانعدام وجود، كما الرغبة في وجود، العقد الاجتماعي الأساسي في كل بناء. هو نتيجةٌ لصمت جزءٍ من النخبة عن الموت الذي جرى في جنباتنا، والبحث له عن مبررات إيديولوجية. إنه الذي أطربنا به جزء آخر من هذه النخبة “المضعضعة” فكرياً وأخلاقياً، بحديثه عن التمييز بين السلطة والدولة، وكأنه جاهل بألف باء السياسة وتعريفاتها حول الدولة المتمثّلة بالسلطة والسلطة المتغولنة على الدولة، وكأنه في هذا يُعالج الحالة السويسرية. إنه الاستماتة في الدفاع عن “مؤسساتٍ”، جرى بناؤها على أساس، وبهدف تهديم ما تبقّى من مؤسسات إن وجدت. إنه، أيضاً، الجهل بطبيعة المجتمع الذي نعيش فيه، وتقديرات نخبوية لتكوينه من خلال محيطٍ ضيقٍ.
إن العنف موجود في كل المجتمعات، وما يحدّ من انتشاره هو عقد اجتماعي واضح المعالم ودولة قانون ومناهج تربوية، تؤسّس للانسجام والتآخي، ولا تبني أسس الانفصام والحقد. فأول عنفٍ مورس بحق السوريين كان تربوياً. وبالنسبة لي، كانت “تباشيره” في اللحظة التي طُلب فيها منا، كتلاميذ، الانقسام بين مسيحي ومسلم، لحضور دروس الدين. هذا مؤشّرٌ لعنفٍ وقحٍ، في مجتمعٍ متعددٍ لمن أراد أن يبحث في جذور العنف، ولا يكتفي بمظاهره.
من جهتهم، هاهم الداعشيون قد تأكدوا أن التربية على العنف “أساس الملك”. فبعد يومين من جريمة قتل أسرى مطار الطبقة من الجنود، والتمثيل بجثثهم، أصدر مسؤول التعليم لديهم، أبو القرنين، وهو من البشر، عكس ما يبدو عليه من اللقب، تعليمات تتعلّق بالمنهاج المفترض تدريسه في حيّز “الدولة الإسلامية”. حيث ألغى عدة مواد، منها الدين والوطنية والتاريخ والفلسفة.
فهل كانت هناك فعلاً تربية وطنية، تحفّز المواطنة والانتماء إلى وطنٍ جامعٍ، وليس إلى مذهب أو دين أو منطقة أو عشيرة؟ وهل تجرأ المعلمون، طوال عقود، على الخوض في شؤون وشجون الفلسفة، إلا مواربة واستناداً إلى أقوال القادة الحكماء ـ العباقرة؟ وهل جرى الحديث عن تاريخ السوريين جميعاً دون تمييز واصطفاء وتهميش، أم أن التاريخ اختُزل في إنجازات القيادة وانتصاراتها؟ وهل تمت مقاربة الدين مصدراً أخلاقياً جامعاً، بعيداً عن التمييز والتحشيد؟
فمن المحتمل، والحال عليه، أن يكون ذو القرنين هذا أحد منتجات العمل التربوي السابق، بل ربما من قياداته. فمن كان مبرمجاً على ترديد شعارات شمولية وأبدية كل صباح، وعلى تلقين الدروس بصماً لتلاميذ، لا محاكاة فكرية لعقولهم، ولا تحفيز لمداركهم، بماذا يختلف عن صاحب القرون هذا؟