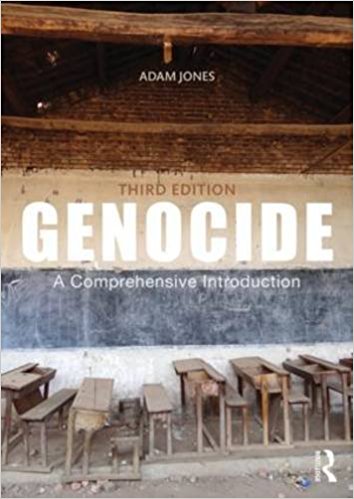نصر حامد أبو زيد: طبطب المرشد على كتفي وأعطاني بوصلة
١٦٠ سـاعة تسـجيل رواهـا جمـال عمـر فـي كتـاب
هذه مذكرات نصر أبوزيد
لم يكتبها بنفسه..
ولكنه ظل منصتا لأسئلة صديقه جمال عمر، الروائي المصري المقيم في أميركا لساعات طويلة، وفى جلسات متقطعة، يحكي عن طفولته، أحلامه، سنوات دراسته، لماذا اتجه إلى دراسة علوم القرآن، سنوات المنفى… حكى صاحب «التفكير في زمن التكفير» عن كل شيء تقريباً..، لم يكتف جمال عمر صاحب رواية «مهاجر غير شرعي» بما حكاه له أبوزيد، سواء في القاهرة أو نيويورك أو عبر الانترنت، ولكنه جمع كل ما قاله أبوزيد منذ بداياته الأكاديمية بل قبل ذلك ربما، منذ سن التاسعة عشرة وهو موظف في النجدة بالمحلة، حتى الرحيل إلا باستثناءات نادرة.. أكثر من 160 ساعة من التسجيلات جمعها أبو زيد نفسه، واحتفظ بها سواء أكانت تسجيلاً لحوارات صحافية وإذاعية وتلفزيونية، فضلاً عن محاضراته بالعربية والإنكليزية، وهو الأمر الذي يجعل من الكتاب تسجيلاً صادقاً لسيرة حياة، وسيرة أفكار تظل طويلا معنا، ونحتاج إلى تأملها ودراستها والبناء عليها لاستكمالها.
لقد هرب نصر أبوزيد من «مصائر» متعددة. كان يمكن ان يكون شيخاً ازهرياً، كما أراد والده المعجب بالمجدد الأكبر الشيخ محمد عبده، ولكن مرض الوالد وإدراكه أن ابنه البكر ينبغي أن يعيل الأسرة منعه من الالتحاق بالأزهر. كان يمكن أن يستمر نصر موظفاً صغيراً مهمته إصلاح «أجهزة اللاسلكي» في الشرطة المصرية بعد أن تخرج من «معهد فني لاسلكي»… ولكن طموحات الشاب كانت أكبر من أن يتم استيعابها، فقرر أن يعمل ليعيل اسرته، وأن يواصل دراسته الثانوية في المدارس الليلية وينتسب إلى الجامعة، تحديداً كلية الآداب. كان يمكن أن يكون ـ بعد تعينه في كلية الآداب ـ مثل آلاف الأساتذة في الجامعة، يملي على طلابه ما يقرأ في كتب الآخرين، ويطبع المذكّرات ويبيعها لهم. هكذا كان سيعيش حياةً مستقرةً، لكنّ نصر اختار أن يفكر خارج السرب، ويتجاوز خطوطاً حمراء، وضعها بعض المتزمّتين والظلاميّين الذين لا يسمحون لأحد بتهديد سلطتهم ومكتسباتهم.
ربما كانت أمنية نصر أن يكون شاعراً، تحديداً شاعر عامية، قد يحقق تميزاً في مجاله، وربما يغير مجرى الأغنية المصرية. كانت «شلة المحلة»، التي ضمت مجموعة الأصدقاء الذين ينتمون إلى تلك المدينة العمالية الشهيرة، وضمت جابر عصفور، الشاعر محمد صالح، جار النبي الحلو، سعيد الكفراوي، تطلق على نصر ابوزيد: «صلاح جاهين المحلة»، ليس فقط لتكوينه الجسدي الذي يشبه إلى حد كبير الشاعر الشهير، ولكن لمحاولاته الهامة في كتابة قصيدة عامية مختلفة عما كان يكتب وقتها، بل إنه نشر أول دراسة نقدية له حول: «أزمة الأغنية المصرية» عام 1964.
وربما كانت أمنيته الأخرى أن يصبح «ناقداً أدبيا» بعد أن أنتهى من دراسته الجامعية، وكان أول دفعته في كلية الآداب. ولكن أساتذته أخبروه أن قسم الدراسات الإسلامية لا يوجد به متخصصون، وأنهم في حاجة ليستكمل دراسته العليا بالقسم. فأخبرهم أنه يخشى أن يكون مصيره مثل من سبقوه: طه حسين، أمين الخولي، ومحمد أحمد خلف الله، ولكنهم أخبروه بأن هذا لم يكن سوى خلاف بين الأساتذة ولا علاقة له بالفكر. فعشق أبوزيد التحدي، وواصل دراسته ليحصل على الماجسيتر والدكتوراه في الدراسات الإسلامية. لم يستمر ابوزيد موظفاً، ولا شاعر عامية، ولا ناقداً أدبياً، ولكنه أصبح «باحثاً» كما كان يصر. باحث «مهتم بفهم الظاهرة الدينية في تاريخيّتها لا أكثر».. هكذا هو… لا يريد أن يكون ما يريده له الآخرون.
يوضح عمر أن ما جذبه إلى أفكار أبو زيد أنه «يقول ما يؤمن به ويؤمن بما يقول»، داخل بيته كان أو أمام جمهور. النقطة الثانية هو ربطه بين كل الحقول المعرفية من خلال تحليل الخطاب، وربطه بين الثقافة الرسمية المكتوبة والثقافة الشعبية الحية المعيشة. بين ثقافة النخبة وثقافة العامة. من دون تفضيل واحدة على الأخرى. النقطة الثالثة وهو يؤكد عليها دائماً، أنه باحث، يبدأ من السؤال الذي تفضي إجابته او إجاباته الى أسئلة أخرى. في حالة تفاعل وجدل منتج. بخلاف نمط المثقف صاحب المشروع الأشبه بقطار يجري على قضيبين من القاهرة الى الإسكندرية. ولا يعبأ لا ببشر، ولا بإشارات مرور، هو فقط يريد ان يصل الى الإسكندرية بأي ثمن وأي وسيلة. لكن عند نصر الفكر ليس محطة وصول، بل هو الطريق وكيفية المشي فيه، هي التي تميز مثقفاً ومفكراً عن مثقف ومفكر آخر…. نقرأ سيرة الباحث في الألغام… ربما نرى فيها ما يضيء الكثير من أسئلة الراهن المحتقن. والأهم أيضاً أن المذكرات التي ستصدر خلال ايام عن دار العين تأتي في إطار احتفال كبير بمناسبة الذكرى السبعين لميلاد نصر (10 يوليو 1943 ـ 5 يوليو 2010). وقد بدأت الاحتفالات الأسبوع الماضي في الجامعة الأميركية بعرض فيلم تسجيلي عن الراحل بعنوان «علامات نصر».. كما تصدر المذكرات، فضلا عن عدد كبير من الاحتفالات والندوات، في محافظات مصر المختلفة.., هذا انتصار كبير لأفكار صاحب «التفكير في زمن التكفير».
محمد شعير
جاءت رسائل الدعم من كل مكان في العالم العربي، واتصل بي معهد الدراسات المتقدمة ببرلين في المانيا، يُعلمني برغبته في تقديم موعد المنحة المقررة لي، في أكتوبر العام القادم، لتكون هذا العام. وجامعة بون، عبر رئيس قسم الإستشراق فيها، الذي قال: «يا نصر هات ابتهال وتعالى». بل إن الأستاذ «فريد ليمهاوس»، الذي كان مفترضاً أن نذهب الى حفل وداعه مغادراً مصر. اتصل بي وقال: انتظرني سآتي أنا الى بيتك في السادس من أكتوبر. وعرض علي أن أذهب الى جامعة «لايدن» بهولندا التي تمثل حلماً لكل دارس في الإسلاميات. وصديقي الشاعر زين العابدين فؤاد هو الآخر يسعى باتصالاته مع بعض طلابه ومعارفه في الخارجية الهولندية لنفس الهدف. ووسائل الإعلام، الغربية. تتناول ما حدث، وغاب الإعلام الحكومي المصري عن الساحة. طالبت وزير الإعلام، أن أشرح في التلفزيون أو الإذاعة وجهة نظري، فليس لي منبر مسجد، كما يفعل الآخرون، أخطب عليه، بل اقترحت أن تعقد ندوة، تلفزيونية تضم د. محمد عمارة، ود. سليم العوا من جهة، ود. محمود علي مكي ود. مصطفى الصاوي الجويني، من جهة أخرى، فليس من المعقول أن يظل الإعلام المصري هو الوحيد الأطرش في الزفة. التقارير الصحافية الغربية، تجاهلت دور المصريين، العاديين، والتضامن معنا من منظمات المجتمع المدني المدافعة عن الحريات، التي تقاوم الإسلاميين الذين يريدون أن يحكموا المجتمع، والقضاء.
آلمني أن أحد الأساتذة، في أول اجتماع لقسم اللغة العربية، الذي أنتمي اليه، بعد الحكم، قدم طلباً، بفصلي من القسم، ذلك من الضغوط التي تُمارس على الجامعة. وحتى طالب الدكتوراه السوري، الذي انتهى منها، تحت إشرافي. واعتذر عضو من لجنة مناقشة الرسالة، أستاذ في السبعين من عمره، من جامعة عين شمس عن المشاركة، وقال إنه خائف على حياته. فلم تناقش الرسالة.
بدأت عملية تصحيح أوراق الامتحانات في هذه الظروف الصعبة، وكانت رسائل الطلاب المتضمنة في ورقات الإجابة، ودعمهم، حتى الإسلاميين منهم، والعجيب أن الكثير منهم اتفق على الاستشهاد بأبيات من قصيدة للشاعر أمل دنقل، لم أدّرسها لهم، كلمات سبارتكوس الأخيرة، تقول:
المجد للشيطان.. معبود الرياح/من قال لا في وجه من قالوا نعم/من علّم الإنسان تمزيق العدم/ من قال لا فلم يمت/ وظل روحاً أبدية الألم/ معلق أنا على مشانق الصباح/ وجبهتي ـ بالموت ـ محنية/ لأنني لم أحنها حيّة
اتصل بي الكاتب والروائي السوري نبيل سليمان وقال: «يا نصر. تليفونك مشغول طول الوقت يا خيي، لكن بدي أقول، انك عملت الشويتيت دول، من شان تتخلص من ابتهال، وخططت حكاية القضية، لكن يا خوي هذي ابتهال قالت إنها متمسكة بك، خلاص. وكلنا بدنا نعمل مثلك، لكنك فشلت». ورسومات الكاريكاتير، في الصحف: واحد جالس ينظر الى زوجته ويقول لنفسه، «أنا عايز أعرف ابن ابوزيد ده عملها ازاي». وأتتني منى ذو الفقار، وزوجها علي الشلقاني، يطلبان توكيلاً قانونياً، بتكوين لجنة دفاع أمام محكمة النقض. دفاع عن المجتمع والسلام الاجتماعي وتهديد القيم المصرية. والغريب أن المحاكم المصرية، تمتلئ بقضايا الطلاق، التي تستمر سنوات، ولا يُفصل فيها، وأي إجحاف بحقوق السيدة المصرية خلالها، إلا أن ابتهال هي المرأة الوحيدة، التي لم تطلب الطلاق، وتُطلق رغماً عنها. فأرسلت كلمة، الى الندوة العربية التحضيرية للمؤتمر العالمي للأمم المتحدة، حول المرأة. التي عُقدت في تونس، في الخامس والعشرين من يونيه. تحدثَت فيها عن: هتك عرضها من قِبل من رفعوا القضية وقالت: «زاعمين أنهم قاموا بذلك من أجل مصحلتي ولحمايتي، هل نسوا أني كائن، عاقل، بالغ، كامل الأهلية، وصلت الى سن الرشد منذ زمن وأستاذة جامعية أساهم في بناء وتنشئة جيل المستقبل؟! أم أن المرأة ستظل في نظرهم مجرد حيوان من فصيلة الثدييات، مجرد من أي وعي أو عقل أو إدراك يقتصر دوره على إشباع الرغبات والإنجاب».
محبوس
دخل فرد الأمن الذي يلازمنا الى شقتنا المليئة بالضيوف، يخبرني أن أتوبيساً بالخارج. سألته «أتوبيس. أتوبيس ايه؟». قال والقلق على وجهه: «أتوبيس طلبه، بيقولوا إنهم من تلاميذك وعايزين، يسلموا عليك». قلت: «يسلموا علي، الشقة ليس بها ثقب، سأخرج لهم بالخارج». قال في حدة: «لكن يا دكتور ليكون حد فيهم مخبي حاجة يطعنك بها». قلت بحسم: «الطلبة؟ لا، هؤلاء ولادي». خرجت الى الشارع وكان أتوبيس رقيق الحال، جمعوا نفقاته بأنفسهم، ليعبروا عن مساندتهم، أخبرتهم أن شقتي صغيرة، وليس هناك مكان للترحيب بهم، وأنا شاكر وممتن لهم. تفهموا الوضع، ونزلوا من الأتوبيس، وسلمت عليهم، فرداً، فرداً. وكان ذلك يعطيني الأمل، في مواصلة الدفاع عن قيم الحق والعدل والحرية. جاءت الأخبار، يوم السابع والعشرين من يونيه، أسبوعان بعد الحكم، بمحاولة اغتيال رئيس الدولة ذاته، في زيارته لأديس أبابا بأثيوبيا. لتزيد من الاحتقان بالداخل وتكشف عن المدى الذي وصلت اليه الأمور بمصر، في المواجهة بين سلطة الدولة بأجهزتها القمعية وبين جماعات العنف الديني المسلحة.
أصبحت حياتي اليومية، «مسخرة»، «لست سوى سجين يقف على بابه جنود الشرطة، يسألون عن زواره، وأستأذنهم قبل أن أغادر بيتي، لا أستطيع الذهاب الى أحد، أو السهر عند صديق بدونهم. فالحكومة تحميني، وتفتح المساجد لمن يطالبون بدمي». فهل تنتهي القضية بالجنازة الشعبية وبيانات الشجب والإدانة وظهور صورتي في التلفزيون؟. حاول الأمن أن يثنيني عن مناقشة رسالة جامعية لأحد تلامذتي، كنت مشرفاً عليها بجامعة القاهرة، للدواعي الأمنية. لكني رفضت. ركبت سيارتي ومعي رجال الأمن، وسيارة أخرى تتبعنا. وصلت الجامعة، ففوجئت أن الحرس موجود في كل مكان، وعلمت أن الأمن قد أفرغ الجامعة منذ الثانية ظهراً، «لو أمي كانت عايشة كانت فرحت بما يحدث»، وجدت لواء شرطة وعمداء يحيونني أنا ابن الفقراء الذين يرهَبون الغفير، وقد وضعت الشرطة أجهزة أشعة كشف الأسلحة، ليمر عليها كل من سيحضر المناقشة، وطلبوا من الطالبة أسماء من سيحضر من أهلها، للتحري عنهم، وحدثت المناقشة في حجرة صغيرة، من أجل إحكام تأمينها.
من هذه التجربة أدركت الضغوط والعبء على الجامعة، وعلى طلبتي الذين سيكون الأمن حاجزاً بيني وبينهم. هذا ونحن في الإجازة الصيفية، فماذا سيكون الوضع عند عودة الدراسة؟ ولو اتخذت الجامعة قراراً بإبعادي عن التدريس على أساس عدم امكانيتي للتدريس وسط هذا الحصار، واذا صممت على التدريس فسيمثل هذا ضغطاً شديداً على الجامعة، التي تتعرض لضغوط شديدة من جانب المتطرفين لفصلي، بعد صدور الحكم. شعرت أن حلم الجامعة الذي عشت وكافحت من أجله يتسرب، وأن جزءاً كبيراً من فعاليتي ونشاطي، بالتدريس في الجامعة قد تم استئصاله. أنا محبوس، وعملياً مسجون. كيف يمكن لي أن أعيش؟ ليكن ما أشعر به مسألة عاطفية أو نوعاً من الرومانسية، لكني لا أستطيع أن أتحمل دخولي الجامعة على هذا النحو، وحصارها بهذه الطريقة، وإبعاد الطلبة عني.
طفولة
في طريق عودتنا من المناقشة، وبالسيارة، طلبت من ابتهال، أن نمشي من هذا الوضع. فلنأخذ إجازة، فنحن تقريباً لا ننام، وهي عندها منحة في اسبانيا شهري سبتمبر واكتوبر، فنقضي شهر أغسطس هناك. ونفكر في الخطوة التالية، طلبت إجازة من الجامعة، وأعلنا أننا ذاهبون الى الساحل الشمالي، ولم يعرف أحد بسفرنا غير والدتها وأخوها، والأمن. أخذنا الطائرة المتجهة الى مدريد، الحادية عشرة والنصف مساء الرابع والعشرين من يوليو. يعتصرني سؤال داخلي: لماذا حدث ذلك؟ كنت غاضباً جداً، ليس من شخص معين. بل زعلان من مصر، غاضب من الوطن، لقد عشت حلم الوطن وحلم الجامعة، فقد بلغت الثانية والخمسين، ولم أملك شيئاً. أتخيل أن دوري هو أن أعلم الطلبة كيف يفكرون، ولقد أخلصت في عملي، كفنيّ لاسلكي، أو كأستاذ في الجامعة، وسافرت الى كل مكان في العالم، كي أتعلم وأفيد وطني بهذا العلم. كرجل من غمار الموالي. شعرت بشعور النبي محمد، في الطائف، حين قال: «اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي, وقلة حيلتي, وهواني على الناس, أنت أرحم الراحمين, ورب المستضعفين, وأنت ربي, إلى من تكلني؟ إلى قريب يتجهمني, أو إلى عدو ملكته أمري, إن لم يكن بك عليّ غضب فلا أبالي, غير أن عافيتك هي أوسع لي, أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات, وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة, أن ينزل بي غضبك, أو يحل بي سخطك, لك العتبى حتى ترضى, ولا حول ولاقوة إلا بك». أيقظت ابتهال وقلت لها «لو حدث ومت في أي مكان في العالم ادفنيني حيث أموت. وكعادتها تحاول أن تخفف عني، فقالت: طيب خلاص». وعادت بي ذاكرتي، الى مشواري الطويل. منذ أن اشتد عزم الحرب العالمية الثانية، وأنا أخرج للوجود، في العاشر من شهر يوليو سنة ثلاثة وأربعين. بقرية قحافة.
تبعد عشر دقائق مشي عن مدينة طنطا، مركز الصوفي الكبير السيد أحمد البدوي، عاصمة مديرية الغربية، على ضفاف فرع النيل. لم تصل الكهرباء ولا الماء النقي الى قريتنا بعد، نسير في شوارعها مستخدمين مصابيح الجاز والكيروسين، شوارع لا تصل بك الى طريق مسدود، دائماً مفتوحة الاتجاهين. بيوت من الطوب اللبن إلا القليل كبيت العمدة. الملكيات الزراعية صغيرة لم تكن بها إقطاعيات كبيرة. بيتنا له بابان، تدخل من أحدهما فتمر على الغرفة البحرية، قاعة الفرن الشتوية، بمصطبتها، فوق الفرن مفروش حسير، ورزونة السقف، التي تُفتح وتغلق للتحكم في دفئها بالشتاء، حين ننام جميعا بها، ومبني في الحائط (كُتبية) ذات رفوف لحفظ الوثائق الهامة، وحفظ المصحف الشريف. أبي: حامد رزق أبوزيد، في التاسعة والعشرين من العمر، قصير القامة بدين الجسم، يعرف القراءة والكتابة، ُينادى عليه بالشيخ حامد، بدأ حياته مزارعاً، لكنه أيقن أن المساحة الصغيرة التي يزرعها لا تكفي لإعاشة أسرته، فباع القراريط الصغيرة وافتتح دكان البقالة الثانية بالقرية، عند ناصية، تقابل الشارعين الرئيسيين. حالته الصحية تعبانه. أمي نعيمة بنت الشيح محمد لبدة، مقرئ القرآن المشهور في قحافة وأجوارها، لأسرتها مكانة واحترام حاملي كتاب الله، في الحادية والعشرين من العمر، جميلة، تتميز بين أخواتها بنعومة بشرتها، كانت المفضلة عند أبيها، لا تبرح البيت، حتى أنها حينما انتقلت الى بيت زوجها كانت تحتاج مساعدة كي تعرف الطريق الى بيت أبيها في القرية، تعمل.
تأخرت أسرتي في تسجيل ميلادي، على ما أظن، مثل الكثيرين من مواليد ذاك الزمان، خوفاً من موت المولود. كان الجدل دائماً بين أصحاب أبي الذين يتجمعون حول الدكان، عن نتائج الحرب، ورغبة الكثيرين في انتصار جيوش المحور، بقيادة زعيم الألمان، الذي دخل في الإسلام (محمد هتلر)، للتخلص من احتلال الإنكليز. أنا الثالث بين الأبناء، بعد أخي الذي مات طفلا، وبعد أختي بدرية التي تكبرني بثلاث سنوات. مع انتهاء الحرب العالمية الثانية، ولد أخي محمد. حفظت بعض قصار السور، وتعلمت الصلاة في البيت، وأنا في الخامسة، أرسلني أبي الى كُتاب الشيخ المنيسي، في بيته، بجوار غرفتة، توجد غرفة العريف التي بدأت فيها تعلم القراءة والكتابة والحساب، نذهب الى الكُتاب من طلوع الشمس حتى المساء. أمسك بلوح الإردواز وأكتب عليه بالطباشير، لم أكن أشارك الأطفال في ألعابهم التي تتطلب الجري، لبدانة جسمي، فكنت أجتهد في التعلم الذي أظهرت كفاءة فيه على الأطفال. كنت أتألم كثيراً من دفع والدي لي لأن أتسلق مثل الأولاد أو أجري مثلهم.
أتشوق الى اليوم الذي أنتقل فيه من غرفة العريف الى غرفة الشيخ، للبدء في حفظ القرآن، وبسرعة انتقلت وحملت اللوح المعدني، وأمسكت بالفرشاة البوص، ودواة الحبر، بدأنا بتعلم جزء (عمَّ)، نتعلم كتابة الآيات على اللوح ويقرأها علينا الشيخ عدة مرات، ونذهب لحفظها، حتى يأتي وقت التسميع. ينظر الينا الشيخ المنيسي فلا يشاهدنا، ولكنه يرانا جيداً، وضعني أمام كرسيه بين رجليه المدكوكتين، وبيده عصاته التي قُدت من الجنة. فأنت تقرأ على الشيخ المنيسي، وحينما تخطئ تأتيك لسعة، كلسعة دبور من عصاته، خفيفة على رأسك. فعليك أن تعيد الآية، لو أخطأت تأتيك لسعة أخرى، فتعيد ثانية، فيصحح لك الخطأ. حينما أعود الى أمي أحياناً، أشكو، تقول لي «عصاة الفقي من الجنة».
كنت دائم التواجد في دكان أبي لأساعده، مع ازدياد المرض عليه، وكأنني انتقلت الى عالم الكبار، الذين يتجمعون حول أبي أمام الدكان، فيطلبون مني قراءة الجريدة. وأستمع الى قصصهم، وحكايات أبي، التي كان بارعاً في قصها علينا بالبيت، مع اشتداد المرض ووجوده لفترات طويلة في البيت. التي كانت دائما تسبب مشاكل مع أمي بسبب تواجد زبائنها بالبيت فقد بدأت تعمل خياطة. استطعت إتمام حفظ القرآن في الثامنة وأختي كريمة لم تكمل عامها الأول. فكان الاحتفال بمسجد القرية الكبير، ارتدى الشيخ المنيسي أجمل ثيابه، وبحضور الناس وأمام أبي بدأ يمتحنني، فيذكر الآية وأكمل بعده، كنت سعيداً سعادة غامرة، بالرغم من قلقي الا أنني اجتزت الامتحان، وقبلت يد شيخي. ولأن أبي لم يكن من مزارعي القرية كانت هديتة للشيخ المنيسي، جبة وقفطان وعمة، ومبلغاً من المال. وأنا احلم ان أصبح أمام الجميع الشيخ نصر. كانت أمي في غامر السعادة، وهي توزع الشربات على الجيران، تساعدها أختي بدرية، وأخي محمد يذهب في كل أرجاء البيت. فحلم أبي أن أذهب الى الأزهر، ودعوات أمي أن أكون مثل الشيخ محمد عبده، المفتي الشهير الذي درس في المعهد الأحمدي بطنطا. أصبحت أؤذن للصلاة بالمسجد، حتى أن بعض المصلين قدموني للإمامة.
الإخوان
كنت في أشبال الإخوان بشعبة قريتنا، الأخ ابراهيم رجب، ناظر مدرسة قحافة، هو مسؤول الشعبة، أخبرنا أن شعبتنا ستشارك في حفل استقبال المرشد العام للجماعة، بنادي مركز شباب طنطا وعلينا ان نستعد، وسوف يكون هناك طابوران من الأشبال وطابوران من شباب الجوالة. كنت سعيداً بهذه المشاركة. ويوم العرض اختاروني أن أكون في المقدمة لصوتي الجهوري، وبينما نحن نمر أمام الأستاذ المرشد، حملني أحدهم ووضعني أمام ترابيزة فضيلته، الذي طبطب على كتفي ودعا لي بالهداية، وأعطاني بوصلة تحدد اتجاه قبلة الصلاة. شعرت بفرحة كبيرة من تقدير المرشد. وافتخار ببوصلة فضيلتة. طلبت من الأخ ابراهيم رجب أن أُرقى من الأشبال الى الجوالة، فضحك وقال: «لكنك صغير». وتحت الحاحي فتح دفتر العضوية وقال: «أي الأسر تريد أن تنضم لها؟» فقلت «أسرة عمر بن الخطاب». وكان أبي يدفع اشتراكاً شهرياً بسيطاً لنشاط الشعبة بالرغم من ميوله الوفدية. انضم الى أسرتنا مولود جديد أسماه أبي أسامة.
أصبحت قريباً من الأستاذ عيسى مدرس اللغة العربية، الذي طلب منا في حصة التعبير أن نكتب رسالة نوجهها لملك الأردن حسين لحثه على الوحدة العربية. ووقفت أمام الفصل، بصوتي الجهوري أقرأها. وبعد انتهائي نظر لي الأستاذ عيسى وقال: «لم تخطئ في النحو ولا قواعد اللغة ورسالتك حماسية، لكن تعرف النمرة التي تستحقها رسالتك»، صمت قليلا وأنا أنظر اليه بلهفة وقال: «صفر، تعرف ليه؟ لا ترسل رسالة لواحد تشتمه فيها»، أدركت من كلام الأستاذ عيسى أنني كتبت ما هو شائع ويردده البعض ولم أكتب ما بداخلي، كنت مدفوعاً بما هو حولي من مواقف الملك حسين، وكان درساً هاماً لي بعد ذلك أن أستخدم اللغة ولا أجعلها تستخدمني. وخرجنا معاً الى مصلى مدرسة العبيدية لأداء صلاة الظهر.
قبض علي وعلى أبي، لأن أسماءنا كانت في كشوف جماعة الإخوان. ونظر الضابط الى أبي ولي وقال «من منكم العضو أنت ولا هو؟» قال أبي: «لا أنا ولا هو، الأطفال يذهبون الى الجماعة السنية هذا أفضل من وجودهم بالشارع وكنت أدفع اشتراكاً بسيطاً كل شهر لكي أساعدهم». فأفرجوا عني وعن أبي بعد ذلك. لكن ما حدث مع الأخ ابراهيم رجب مسؤول الشعبة كان كثيرا ولا أتخيل أبدا أن هذا الرجل كان متآمراً على حياة عبد الناصر، الذي ملأ العيون والقلوب بحيويته وزعامته. شعرت أن ما يحدث للأخ ابراهيم ظلم.
جمال عمر (القاهرة)