ولكنّها، في النهاية، هي دمشق/ عارف حمزة
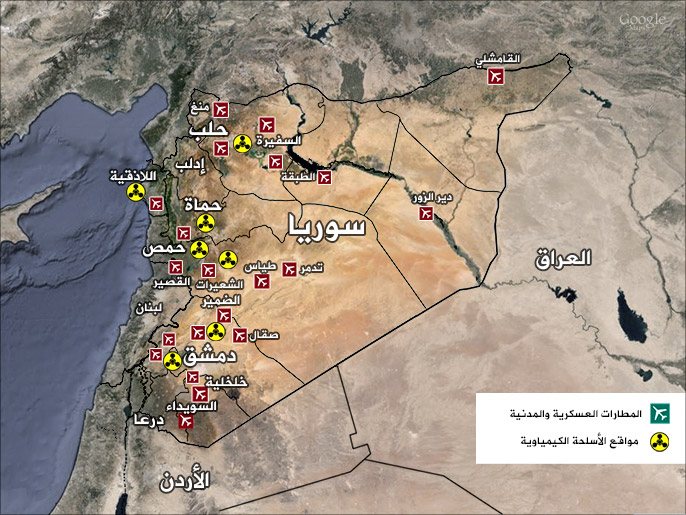
لم يتم بعد توجيه الضربة “العلاجيّة” أو “الرادعة” أو “العقابيّة” لدمشق، وأنا أكتب هذه الكلمات الآن. وربّما عند نشر هذه المقالة تكون دمشق، دمشق يا الله، قد تلقّت نصيبها الموجع المرسوم، في مقامات طيش التاريخ، لهذه المنطقة البائسة من العالم. دمشق الصغيرة التي صارت تعيش في مصحّ نفسيّ منذ أكثر من عامين، وهي تودّع أبناءها إلى ساحات المعارك التي اندلعت بين الأخوة، ثم توْدع أبناءها جوف الأرض.
التاريخ يُعيد نفسه. كم هذه الجملة كريهة على قلبي. ولكن التاريخ يُعيد نفسه بالفعل بعد عشرة أعوام بالتمام والكمال. ففي عام 2003 سهرنا ليالي طويلة أمام شاشات التلفزة ونحن ننتظر الأضواء الخضراء التي تصوّر الضربات الأميركيّة للعراق. وبات علينا أن نسهر كلّ يوم الآن كي نتلقى حصّتنا من الضربات الخضراء القويّة والسريعة لجسد مدينة الياسمين الذي هرم.
عقد كامل من الزمن لم يعلق من العراق في ذهن المحبّ سوى أرقام القتلى الذين داوموا على الموت منذ عام 2003 ولحدّ الآن. وبعدها صرنا نراقب السيارات التي لا تملّ من الانفجار، موقعة عشرات القتلى في كلّ يوم. وفي نهاية كلّ أسبوع كانت تتحالف العديد من السيارات في الذهاب لقتل العراقييّن في وقت واحد في الساحات والأسواق والجوامع والبيوت وأمام ثكنات التدريب على ضبط الأمن. ولم يعلق في ذهني ذاك الوقت سوى مزق اللحم على أقواس بغداد وحجارتها الترابيّة، بينما الشوارع والأرصفة كانت مردومة بالأحذية الخالية من الأقدام.
وبقدر ما كنتُ مطالباً بإعدام الديكتاتور صدام حسين، حتى قبل إعدامه بسنوات طويلة، بقدر ما تفاجأت بأولئك
الأصحاب الذين بكوا على مصير ذلك البطل القوميّ!. وكان بعض المثقفين يربطون زعلهم ذاك، وفصامهم الإنسانيّ ذاك، بموقفهم الصلب تجاه منع تطبيق عقوبة الإعدام. وعندما كنتُ أصرّح برأيي، أنا الذي أعمل في منظمات للدفاع عن حقوق الإنسان، بأنّني ضد عقوبة الإعدام صحيح، ولكن في حالات مثل حالات السفّاح صدام حسين فأنا مع تطبيقها بحقّه عشرات المرّات، كان أولئك المثقفون ينظرون إليّ بعين شاتمة، وكافرة برأيي الشنيع هذا؛ إذ يُعتبر صدام حسين بالنسبة للشعوب العربيّة المتخلّفة، شبيه ذلك الوحش المسجون في دواخلهم. ولكن ماذا كان يرمز للمثقفين؟. إذ كيف يمكن لمثقف ما أن يقف إلى جانب طاغية كصدام حسين؟ صدام الذي قتل ما يقارب خمسمائة ألف نسمة من الشعب العراقي. وقام ولده عدي لوحده باغتصاب مئات الفتيات العذراوات بعد خطفهنّ من أمام مدارسهن. عدي الذي أجبر الفتيات الآشوريّات على لبس الحجاب والنقاب كي يُخفين الدم الآشوري الجميل في وجوههنّ البريئة. كي لا يعثر على نقطة جمال واحدة تبرّر فضّ بكارتهنّ منه، قبل أن يرميهن للاغتصاب الجماعيّ من قبل مرافقيه، وقبل أن يتم رميهن مقتولات ومضرّجات بوحشيّة لا أعرف كيف استحملته واحدة عزلاء منهن على يد ذلك القطيع من الوحوش.
الشعب العراقيّ هو الذي تلقّى تلك الويلات، ولم نتلقّها نحن، في ذلك الوقت، على يد صدام حسين. وهو الذي كان يتمنى موته آلاف المرات، تقطيعاً وحرقاً وحتّى اغتصاباً، وليس إعداماً فحسب، وبالتالي ليس علينا نحن السورييّن أن نقف ضد عقوبة ذلك المجرم الذي استلم كرسيّ السلطة في العراق الحبيب. “لو كنت عراقياً لم تكن لتقف ضد عقوبة الإعدام بحقّ صدام حسين”. قلت ذلك لصديقي المثقف الذي وصل الحوار بيننا لسبيل مسدود، وهو مصرّ بغرابة على رأيه الغريب تجاه إعدام صدام حسين. وعندما بدأت المجازر الدمويّة في سوريّا، وعرف ذلك الصديق المثقف أساليب التعذيب الوحشيّ للمواطنين السورييّن الأبرياء، قال بأنّه مدين لي باعتذار كبير، وصرّح بأنّه مع إعدام هكذا طغاة آلاف المرّات. ليس هذا فحسب. بل أنّه أحبّ أن يتطوّع كي ينفّذ بنفسه تلك الإعدامات المتكرّرة بحقّ الرئيس!.
جاء اليوم الذي نشعر فيه بتلك الرغبة من الانتقام. اليوم الذي حوّلنا فيه الوحش القائد إلى وحوش لا يمنعها أيّ رادع من الانفلات. فمن كثرة ما دامت المجازر بحق السورييّن، وبطرق وأساليب أقل ما يُقال عنها بأنّها وحشيّة. ومن كثرة ما روّج النظام الدمويّ لحلول أسمعها للشعب علانيّة؛ كالاقتتال الطائفيّ، والاقتتال العرقيّ، والتقسيم، والإبادة، صار الآخر يُؤمن بهذه الحلول للتخلّص من النظام نفسه ومريديه. وصار التصريح من قبل طائفة بإبادة طائفة أخرى أمراً لا يمكن أن توبّخ صاحبه على مجرّد التفكير به، وليس التصريح به. وصار بإمكان سكّان مدينة ما بأن يعلنوا بأنّهم سيذبحون أبناء مدينة بكاملها طوال الطريق الواصل بين المدينتين! وصار بإمكان صديق، حاصل على ماجستير في الأدب العربيّ، أن يتحدّث بطلاقة عن أعماله في التقطيع والتعذيب والقتل إذا صار حاكماً عرفيّاً بعد نجاح الثورة!!. وهذه بعض النتائج التي عمل النظام على زرعها وسقايتها وحصدها في حياة السورييّن الأبرياء، وهو يماثل الكيماوي الذي تجرّأ على إطلاقه لقتل مئات السورييّن العزّل في غمضة عين. إذ لم يكن هناك من عمل لهذا النظام، طوال العقود التي حكمنا، وحاكمنا فيها بالحديد والدم سوى تربية الفساد وتشويه الجينات السوريّة وتحويل العلاقة بين السورييّن إلى صلة المطالبة بالدم، وهدر الدم، وليس صلة القرابة بالدم. لهذا السبب على الأقل صار بإمكان السورييّن المعارضين التصريح بأنّهم على استعداد للتحالف مع الشيطان من أجل التخلّص من هذا النظام الدمويّ، الذي داوم على دفن سوريّا وهي حيّة. بينما صارت مأخذاً عليهم من قبل مريدي النظام الذين لا يُريدون تذكّر بأنّ الذين يبرّئون النظام من دمهم كانوا سورييّن بريئين، حلموا بدفع بلدهم برفق وحب نحو دولة الحريّة والقانون والمواطنة.
ليس هذا الوقت وقت المقارنة بين فعل السلمييّن في المطالبة بالحريّة، وبين ردّ فعل النظام الذي استخدم كل أنواع البطش، من تهجير واعتقال وتغييّر ديموغرافي وقتل وذبح واغتصاب وتنكيل وضرب بالمدفعيّة والصواريخ والطائرات… ثمّ السلاح الكيميائيّ، لمنع نسائم الحريّة من تفتيت هذه العتمة من الديكتاتوريّة المستمرّة. وليس من المعقول نسيان مقتل مائتي ألف شخص، بالإضافة لاعتقال مئات الآلاف ونزوح ملايين الناس، ومن ثم الوقوف ضدّ التدخّل الأميركيّ لمنع هذه المجازر. ليبدو الأمر وكأنّه بدأ من لحظة التدخّل، وليس من تراكم الجثث طوال أكثر من عامين ونصف. لذلك ينجح أحدهم عندما يسأل الآخر: هل من المعقول أن تقف مع فكرة ضرب أميركا لسوريّا؟ فهم طوال الثورة نسوا سوريّا نهائيّاً وفكّروا ببشار الأسد. هم الذين كانوا يقولون “الأسد أو نحرق البلد”. هم الذين على استعداد لحرق كل سوريّا وكلّ السورييّن من أجل بشار الأسد… يتبجّحون الآن بذكر سوريّا، وكأنّهم هم مَن سيُقاتلون الأميركييّن من أجل بقاء سوريّا على قيد الجغرافيا والحياة، وهم الذين يعرفون بأنّ قائدهم المفدّى لم يترك شبراً واحداً من سوريّا لم يتعرّض للتعذيب والتنكيل والموت. ولا يُريدون أن يفهموا بأنّ الذي اعتدى على السورييّن هو رئيسهم الرقيق والطبيب والمواطن الذي تربّى على الأخلاق الغربيّة وحقوق الإنسان! لذلك يحلو للمؤيّدين أن يُخوّنوا الضحيّة لأنّها استجارت بأيّ أحد لرفع آلة القتل عن رقبتها، كما كان يحلو لهم تخوينهم عندما طالبوا بالحقّ في الحياة بكرامة. عندما طالبوا بالحريّة لكلّ السورييّن. عندما طالبوا بإعادة الاعتبار لسوريّا التي داس النظام على رقبتها طوال عشرات السنين، ولم يُفكّروا للحظة واحدة بالدفاع عن سوريّا تحت أقدام رأس النظام. إذ ماذا تعني سوريّا، لأولئك المؤيّدين، من دون شعبها وفقرائها ومخلصيها ومحبيها؟
أكتب الآن والضربة مقبلة لا محالة. وستكون دمشق مغمضة العينين، لكن نحو فتحهما على اتساعهما لرؤية الحياة لها ولأبنائها الأبرياء، وليس مغمضة العينين نحو الأبد كما يعمل على ذلك هذا النظام المستمرّ في البطش والديكتاتوريّة.
لكنّها دمشق التي ستتلقّى الضربة الأمريكيّة، يتبجّح مؤيّدو النظام. فيردّ عليهم الضحايا: ولكنّها دمشق التي تستحقّ الحياة.
المستقبل





