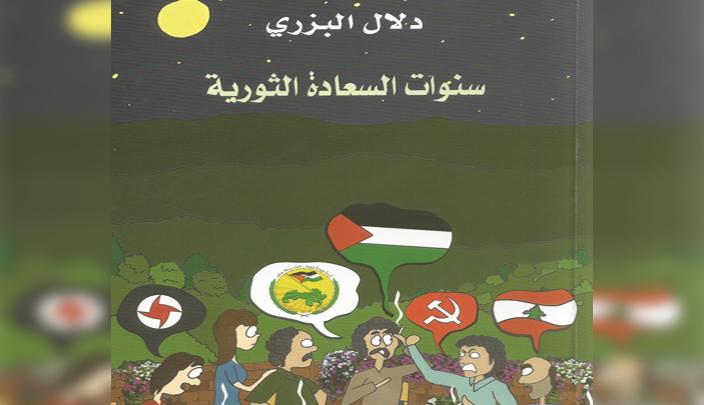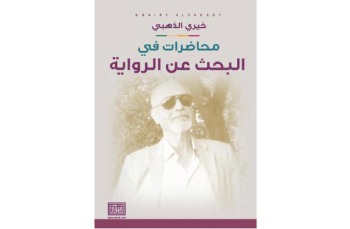عندما يوسّع فيليب مانسيل «شرقه» لرثاء حلب/ وسام سعادة

«حلب. صعود وتهاوي أكبر مدينة تجارية في سوريا» كتاب صدر نهاية الشهر الماضي، لفيليب مانسيل، المؤرخ البريطاني الموسوعي للبلاطات والمدن، الذي راكم أعمالاً لامعة عن فرنسا والشرق العثماني على حد سواء، وخصوصاً عن التشابك الحضاري بينهما، وتداعياته ومآلاته.
يأتي كتاب مانسيل عن حلب محكوماً بسرعة في الكتابة، بالتزامن من استثناء المدينة الدموي من الهدنة السوريّة الهشّة. يأتي للقفز بنا نحو الدلالة التاريخية والحضارية للحاصل، ولو في حدود ما تبقيه النمطية الاستشراقية النافرة أحياناً، وذات الطابع الرثائي. الإيقاع التصويري، «القفشاتي»، والملاحظات الصادرة عن خبرة واسعة النطاق بالتاريخ الطويل الأمد، تقلّل مع ذلك من فظاظة هذا التنميط، أو شاعريته الساذجة. يبقى أن حرفة مؤرخ البلاطات، تجعله ينشده أكثر بالطابع المهرجاني لأسواق المدينة وحفلات قصورها، مؤثراً ذلك على عناء السبر التاريخي – الإجتماعي للأنسجة والأحوال، على ما فعله ايرا لابيدوس على سبيل المثال، في كتابه المرجع «المدن الإسلامية في العصر الوسيط» الذي تناول فيه ثلاثية القاهرة ودمشق وحلب في المرحلة المملوكية.
وبخلاف اختيار لابيدوس الفترة المملوكية، يبدأ مانسيل روايته قصة المدينة بالفتح العثماني لها، ولبلادنا ككل، قبل خمسمئة عام من الآن بالتحديد. فالفتح العثماني بعد معركة مرج دابق، سيخرج حلب من من وضعية المدينة الحدودية (التي عادت اليها في أعقاب تفكك السلطنة)، وحلب ستظهر بدورها السمة المركبة والتعددية للدولة والعصر العثمانيين، كعصر شهد بخلاف الفترة المملوكية، تضاعفاً في النسبة العددية لمسيحيي بلاد الشام، ولدورهم، مثلما شهد صراعاً ارثوذكسياً – كاثوليكياً محموماً داخلهم.
لم يحصر القرار في المدينة بمركز واحد. كان هناك الوالي، وآغا الانكشارية، وكبار العلماء والأشراف، والشهبندر على رأس التجار. وكانت حلب المدينة العربية الوحيدة التي تكررت فيها زيارات السلطان، خصوصاً سليمان القانوني، ومحطة محورية لمرور القوات في فترات الحرب مع فارس الصفوية. كانت ولايتها الأكثر استقراراً بالنسبة للحكم العثماني، باستثناء التهديد الذي شكله مطلع القرن السابع عشر علي باشا جانبولاد اوغلو حين تولاها، وهو الزعيم الكردي المتعاون مع دوقية توسكانا وشاه عباس، وسلف آل جنبلاط في تاريخ جبل الدروز الغربي (جبل لبنان الجنوبي) لاحقاً.
ينبهنا مانسيل إلى أنه كتب لحلب طوال الفترة العثمانية وبعدها، الاستقرار عمراني، المزدهر تجارياً وثقافياً وفنياً في مراحل عديدة، أو المنكمش تدريجياً في القرن الأخير، وبشكل مرهق في سنوات حافظ الأسد، مع تفادي الدمار الكبير الذي أصاب مدناً أخرى، ومع الحفاظ على تعدديتها الدينية والاثنية، إلى أن تجرّعت الكأس بمرارة وطاقة عدمية هائلة في السنوات الأخيرة.
المدينة تعثمنت عمرانياً، بمساجدها وقيسارياتها وخاناتها وأسواقها، أكثر من أي مدينة عربية أخرى، لكن التجارة في الفترة العثمانية حوّلتها إلى مدينة عالمية، يذكرها شكسبير في «ماكبث» وأكثر من عمل. ومع القناصل، والمحاكم القنصلية، ونظام الفصول أو الامتيازات الحصانية (العهدنامة)، تحوّلت حلب العثمانية إلى مدينة «ليفانتينية» بامتياز. والليفانت في الأساس تسمية ايطالية لشرق المتوسط، اعتمدت لاحقاً، خصوصاً بالفرنسية، للاشارة إلى بلاد الشام، كما اعتمدت، بالفرنسية وغيرها، لاشارة أوسع، إلى عتبات الشرق العثماني المتوسطي، أي المدن الساحلية التي ازدهرت فيها جاليات أجنبية تتمتع بالحصانات القانونية، وخلطات بلدية أجنبية مرتبطة أساساً بالتجارة و»اللينغا فرانكا»، أي تلك اللغة التجارية العابرة للمتوسط، التي شكّلتها الايطالية المكسورة، ثم المطعمة بكلمات قشتالية، وفرنسية، وبروفنسالية، وعربية، وتركية.
سبق لمانسيل أن أفرد كتاباً مهماً لهذا الشرق العثماني المدائني الساحلي المختلط دينياً والمفتوح للأجانب، «الليفانت» (2010)، وقدّمه على أنه فضاء ولد من رحم التحالف المديد بين فرنسا والدولة العثمانية في القرن الخامس عشر، وأنه بالأحرى شبكة من المدن، أو من أحياء معينة في كل مدينة، مثل «دوالي بيرا» في محاذاة أسوار غلاطة، شمال الخليج الذهبي في القسطنطينية، النموذج الأول لليفانت، التي ستشكل «مركزاً ديبلوماسياً عالمياً» بامتياز، يتداخل مع حياة الأهالي بأقوامهم المتعددة، في وقت كان فيه السفراء بفارس والمغرب الأقصى يقيمون بعيداً عن العواصم.
في «عتبات الشرق» هذه، كان الأوروبيون أكثر حرية، ثقافياً وسياسياً وجسدياً مما كانوا عليه في بلادهم آنذاك، وما كانوا بمنأى في الوقت نفسه، عن «الشتيمة اليومية» للكافرين.
بيد أن مانسيل في كتابه «ليفانت» نادراً ما ذكر حلب. عنايته كانت ساحلية بامتياز: رباعية «بيرا» في القسطنطينية، وازمير، والاسكندرية، وبيروت. لم يذكر حلب تقريباً إلا في موضعين: مرة للتفريق بين عربية أسماء مدن شرق المتوسط الداخلية، وأجنبية أسماء مدنه الساحلية، ولتمييز حلب بأنها من دون هالة القداسة التي لدمشق أو بغداد أو القاهرة، ومرة للتمييز بين حلب التي يتوجب على التجار الأجانب فيها المبيت في خانات يقارنها بالنظام «الداخلي» لطلاب كليات اوكسفورد آنذاك، وبين ازمير حيث تملك التجار الأجانب منازلهم الخاصة، وكانوا بهذا المعنى أكثر حرية ومتعة.
دمار حلب الأخير هو اذاً المتغيّر الذي جعل مانسيل يتنبه إلى أن ما نخسره حالياً هو آخر مدينة حافظت على عثمانيتها الليفانتينية لمدة أطول من سواها، عمرانياً ومعاشياً. هي مدينة عاش فيها مطولاً المسلمون والمسيحيون واليهود، وكانت فترات التعايش بينهم أطول بكثير من لحظات التصادم، وان كان تعايشاً يجمله مانسيل بثنائية «الهامشية والبحبوحة». وكان يسمح في حلب لأهل الذمة بركوب الخيل، وهذا كان متعذراً في الأستانة. وكان يمكنهم تحجيم التمييز الذي يلزمهم بارتداء الألوان الغامقة، في مقابل دفع المال. واذا كان مانسيل اهتم في كتابه السابق باظهار كيف أن مسلمين كانوا يفضلون الاحتكام للمحاكم القنصلية في قضايا مالية وتجارية بدلاً من المحاكم العثمانية، فانه يكمل اللوحة الآن باظهار كيف أن مسيحيين بلديين كانوا يفضلون اللجوء إلى المحاكم السنية بدلاً من محاكم كنائسهم، لأنها أسرع وأوفر.
مع أنها كانت مهملة في كتابه عن «الليفانت»، فهي تعود اليوم مأسوفة على حضارتها، بعد أن حلّت بها الكارثة. يحوّل مانسيل كتابه، المقتطع أكثره لمجتزآت من نصوص المستشرقين والقناصل والرحالة، إلى مرثية ليفانتينية بامتياز، فحلب كانت المدينة الليفانتينية الوحيدة الباقية، بعد أن صارت تسالونيك يونانية صرف، واستنبول وازمير تركية صرف، والاسكندرية مصرية صرف، وبيروت وبغداد معازل سنية وشيعية.
في شعريتها، تحكي هذه المرثية عن انكماش عاشته حلب بشكل خانق بعد انقلاب حافظ الأسد، وشيء من الترميم مع بشار الأسد، ثم تدمير لا يفوت المؤرخ أن يحمّل مسؤولية معظمه لبشار الأسد ونظامه. الشعرية المأتمية تدفع مانسيل لتشبيه حلب حالياً إلى أطلال «المدن الميتة» الرومانية المحيطة بها.
أما الصيغة النثرية، «النظرية»، للمرثية، فتجدها في خاتمة «ليفانت» حين اعتبر مانسيل ان المدن الليفانتينية، مثل كل المدن، بحاجة إلى قوة عسكرية لحماية هشاشتها، وهذه استطاع العثمانيون والفرنسيون تأمينها، لكن ليس بمستطاع أهل المدينة نفسها ذلك، «فما من مدينة ليفانتينية خلقت شرطة فعالة لها أو حرساً وطنياً حامياً»، والصفات التي تصنع هذه المدن تهدَد أيضاً وجودها.
وفي كتابه السابق، استعاد مانسيل فكرة ديفيد بن غوريون الذي حذّر المجتمع الصهيوني من «روح الليفانت الهدامة للأفراد والمجتمعات» (وهو تحذير من الليفانتية نجده محورياً في نص النازي الفرد روزنبرغ أيضاً)، مع فارق أنه اقتفى أثر ليفانتينية جديدة محمية بالعسكر، في لندن ونيويورك ومومباي وسنغافورة، وموسومة هناك أيضاً بالمباينة الجلية بين أحوال هذه الحواضر المتعددة الأضواء والأصوات، وبين الأراضي الداخلية المحيطة بها.
أما كم أنّ «روح الليفانت» هذه كانت تاريخاً من «البلا روح»، وكم أنّها تشكّل «عقبة معرفية» أيضاً لكتابة تاريخ المدينة، تاريخ «غير المبهرج» في أكثر المدن بهرجة، فهذا منحى لا يمكن طلبه من زاوية نظر «متصوفة بالمدن»، كما لو كانت فناء لبلاط، وسوقاً لخان، كتلك التي يثبت عليها مانسيل في كل أعماله.
٭كاتب لبناني
القدس العربي