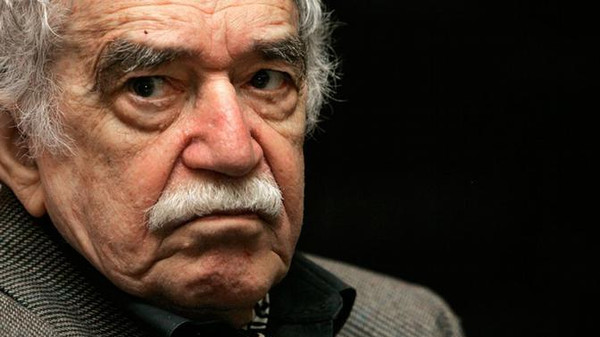أرض الاستبداد المحروقة بالكذب والخداع
دلال البزري
الأنظمة الساقطة، أو الآيلة الى السقوط، تترك خلفها أراضي محروقة، من بينها أرض الأخلاق؛ الاخلاق التي هي في درجة الصفر. على رأس قائمة هذا الحطام الأخلاقي، يقف الكذب، أبو الرذائل كلها… الكذب التأسيسي، الصميمي، الذي تحمل توقيعه كل منظومة الأخلاق السياسية السائدة عربياً. صحيح أن الكذب رذيلة مصاحبة للشرط الإنساني، وأن درجته تنخفض وترتفع تبعاً لأمور عديدة. وصحيح أيضاً أن لا وجود للكذب المطلق، ولا نظيره، الصدق المطلق. ولكننا هنا نتكلم عن درجة غير معتادة من الكذب… نتفوق بها على غيرنا من الأمم.
اللحظة التي يتأسّس فيها الكذب بصفته رذيلة محورية هي لحظة الاستيلاء على السلطة، التي لا تتم مرة إلا بالقوة، بقوة السلاح أو برفعه. السلطة الجديدة كانت دائماً “اغتصاباً”… معلناً، أو شبه معلن (كم من مرة تم “اغتصاب السلطة”…؟ العبارة الدارجة). وعلى خطى هذا الاغتصاب، يتشكّل المعنى المجمّل له، المعنى الذي يجعله مقبولاً من الناس: إنها الرواية الرسمية لنشأة هذه السلطة، حيث يتحول حدثها التأسيسي الى أنهار من البراءة والعطاء. إنها أيضاً “القضية” التي سوف تتكئ عليها صاحبة السلطة الصاعدة هذه، تختارها من بين قضايا أخرى تناسب ظرفها أو سياقها أو خياراتها الايديولوجية: الصهيونية، الامبريالية، الاستقرار، الاشتراكية، حكم الله، التنوير… إنها عبادة الحاكم، وتحميله هالة فوق إنسانية، قداسة لا يجوز معها الإشارة الى كينونته حاملة صفات الكمال والخلود.
وعندما ينتقل هذا الحكم الى مرحلة تثبيت هذه السلطة، تزداد الحاجة الى “القضية”، الى التقديس، الى السرديات الملفقّة… وإذ تتآكل الشرعية مع الزمن، تتحول الرواية نحو الملائكية الفائضة؛ وتتحول “القضية” الى صرح هائل ومعقّد من التناقض بين القول والفعل، ونسيج لا تنتهي خيوطه من الشعارات والأقوال والصفات، كلها مبنية على أسس صلبة من الخداع أو النفاق أو الرياء أو أي رذيلة أخرى مصاحبة للكذب. مثل ذلك كذبة أن أصحاب السلطة يخدمون الصالح العام، أو الأكاذيب الأقوى التي سمحت لقادة “الجمهوريات” أن يتحولوا الى قادة سلالات، هي الى المَلَكية أقرب.
ما الذي جعل كل هذا يدوم كل هذه العقود؟ من زاوية الأخلاق السياسية التي نحن بصددها هنا، فإن غياب منظومة أخلاقية مناهضة للدجل المنظم والرسمي داخل المجتمع نفسه هو واحد من الإجابات. لا الأحزاب المعارضة كانت أصدق من السلطة التي تناهضها، قولاً أو عملاً؛ ولا في الـ”مجتمعات المدنية”، التي لا نعرف لها أخلاقاً خاصة؛ ولا في الطوائف أو العائلات أو الجماعات الأخرى، الواقفة على جنبات النظام، أو المتواطئة معه. الحصانة الأخلاقية للمجتمع معدومة، ولم تستطع أن تشكل أخلاقياتها الخاصة. أما المورد الثقافي والروحي، فكان لترويجه بصيغته الطقوسية التي نعرفها أثر مناقض لما ينتظره الداعون اليه: فكلما زاد انتشار هذا الدين الطقوسي، انحطّت أخلاق الناس..
والخوف لا ننسى الخوف؛ الخوف الذي يرسي تعايشاً بين الواقع والرأي والمشاعر ونقيضهم كلهم، طلباً للسلامة.
بهذا السكوت الطويل عن الكذبة الرسمية، عن الأخلاق السياسية الحاكمة، ينتقل الكذب الى القعر الأدنى، فيبصح اجتماعياً، وبذلك، يكون لبراءة الصدق وصف مطابق لانتشار الكذب: الذكي هو الذي يعرف أن يكذب، والغبي هو الذي يفصح عما يعتقد أنه الحقيقة. ويكون للمرء وجهان: وجه لا يكشفه إلا أمام الموثوقين، إن وجدوا، ووجه أمام الجموع أو الناس أو رب العمل أو الشرطة أو الجيران. إذ يصبح الجميع رقيباً على الجميع من إمكانية أن يكون واحد من بينهم قد تجاسر وقال رأيه أو وصف ما يشاهده أو يحدسه أو يشعر به.
في ظل كل الديكتاتوريات العربية، للمرء وجهان: واحد صادق وسري، والآخر كاذب ومعلن، يتفاعل بواسطته المرء مع غيره حول الحياة وكسب العيش والاجتماعيات والغراميات… يتفاعل معهم حول هذه الأمور الخطيرة بوجهه الكاذب. والنتيجة هي الخراب الأخلاقي المعمّم: مواعظ أخلاقية-السياسية لا نهاية لها، روايات ملغومة وطقوس تصديق، وشيفرات تفكّ كودات الكذب، يتخصص بها فضوليون هامشيون…
ثم تأتي لحظة ثورة، التي هي في الأساس فعل أخلاقي، لحظة تجلّ عليا، ترفع من شأن الصدق وأيضاً من شأن ملكات أخرى نظيرة له، مثل النداوة والنزاهة والكرم والاستعداد للموت من أجل الحرية. والحرية في لحظة الثورة ليست سوى صرخة عالية ضد التواطؤ مع السلطة على أكاذيبها، ضد افتعال التصديق، والإعلان بصوت عالٍ بأن كل مظاهر الطاعة السابقة لم تكن سوى تقية… الثورة هي رفض للكذب واحتفال بالصدق الآتي من رياح الحرية العاصفة. الثورة هي لحظة نادرة من تاريخ البشر الذين يتعرّفون فيها الى الصدق السياسي. لحظة من دون جاذبية الأرض، يرتفع فيها المرء عن سطحها قليلاً؛ يكاد يطير من خفته، من سعادته الجديدة، من المستقبل الذي يفتتح فصوله الأولى هو، بنفسه… هو الذليل، الجبان، مبتلع الأفاعي كلها، ها هو يتسامى على شرطه البشري وترتفع أخلاقه بأجنحة صدق حلّت عليه بفعل ثورة… فهو يخوض معركة الكذب الاستبدادي بأسلحة الصدق والشفافية الديموقراطيين. فالثورة الديموقراطية هي ثورة ضد الكذب…
أثناء ذلك لا تتوقف الثورة عن رمي حمم الحقائق الجديدة التي تنكشف بفضل حدوثها؛ الديكتاتور، أسراره، أمواله، فساده، عائلته…. ثروات الفاسدين، القرارت بالقتل، الأسرار كلها تقذفها الثورة في وجه من يستطيع أن يتلقفها، فتُكتب سيرة أخرى، رواية مختلفة عن تلك التي استقرت سنوات، ويكون الحافز على الصدق طاقة داخلية فوّارة، تبحث عن سنواتها الضائعة، وما أُهدر من عمرها… الى أن يأتي زمن الثورة المضادة.
وأكثر الأدلة سطوعاً على هذا الدور الكاشف للثورة هو تلك المعركة الإعلامية التي يخوضها النظام السوري المتهاوي ضد الثورة المنفجرة بوجهه: فهو يفبْرك الوقائع والمواقف، يحرّف مضامينها، يخترع فزاعات الإرهاب (وهي بالمناسبة من “البضائع” التي كان “يبيعها” لمحيطه الاقليمي والدولي، أي الخارجي…)، بعدما عاند الحقائق دهراً من الزمن. يقوم بكل هذا بإصرار وحنكة؛ ولكنه لا يعطي أي برهان، بل يفعل العكس: يغلق البلاد على الصحافة العالمية، يعامل ناقلي الخبر من أبناء الثورة معاملة الخونة العملاء، يعتقلهم، يعذبهم، يمثل بجثثهم بعدما يقتلهم، شهداء نقل الحقيقة بالصورة والفيديو والنص: معركة الحقيقة حول ما يحصل، ضد الذين يقتلون الثورة بقتل وقائعها، بين أفعال الثوار وتصميمهم، وجرائم النظام المتفوقة على الخيال.
أما الثورة المضادة، فهي لا تقتصر على حركة عاصية على الثورة أو معادية لها، كالنظام الساقط أو القوى ذات المصلحة المغايرة لمصلحة الثورة. قد تأتي أحياناً من داخل الثورة نفسها: عندما يختل ميزانها الأخلاقي، فتبدأ دورة كذب جديدة، عندما تتحول الثورة الى نظام، يزيد أو تنخفض درجة كذبه، بمعدل انخفاض أو ارتفاع درجة الشفافية فيه، أي الديموقراطية.
هل يعني ذلك بأننا محكومون، بفعل التاريخ نفسه على تكبد انعدام أخلاقنا؟ ربما نكون، وربما لا. الأمر مرهون بيقظتنا. لكن الفرق، كل الفرق يكمن في درجة الشفافية أو الديموقراطية: قد تساعدنا على ابتداع أنظمة يتعادل في داخلها الخير مع الشر، المعدل الإنساني للكذب؛ حيث لا كذب مطلقاً ولا صدق مطلقاً. إذا بلغنا هذا المعدل، نكون بذلك في طريقنا الى نوع من السعادة السياسية، تعيش بأرواح خفيفة، بضمائر مرتاحة، بأجساد غير معذبة…. “يوتوبيا”؟ نعم، يوتوبيا تمدّ الأمل بالخيال.
المستقبل