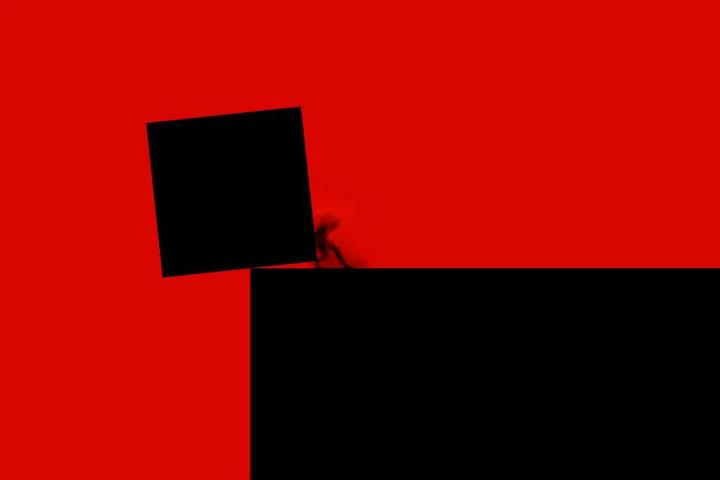أكثر من 60 مقالا تناولت الثورة في مصر

مصر: الإنذار الكبير
حازم صاغيّة
جاءت انتفاضة مصر الثانية تردّ على الذين قالوا إنّ ثورات «الربيع العربيّ» أتت بالإسلاميّين وثبّتتهم في مواقع السلطة، وكان الله يحبّ المحسنين. وبالطبع عجّت مثل هذه الأحكام بما لا يُحصى من أشكال الوعي التآمريّ، فضلاً عن المبالغات المحسوبة والمدروسة.
فما يحصل في مصر يدلّ، في المقابل، إلى أنّ تلك الثورات فتحت الباب مشرعاً للحرّيّة التي جاءت بالإسلاميّين ثمّ مهّدت، هي نفسها، للانقضاض عليهم.
هكذا، وبعد أطنان الكلام المكتوب عن «الإسلام والديموقراطيّة» ممّا لم يكن قابلاً للاختبار والقياس، يوفّر الظرف السياسيّ المحتدم تعريض هذه المعادلة، للمرّة الأولى، إلى اختبار فعليّ. والحال أنّ تجربة العام الذي قضاه محمّد مرسي في سدّة الرئاسة المصريّة جاء شهادة سلبيّة ومكثّفة في سلبيّتها على الفشل. فكيف وأنّ الإسلام السياسيّ الحاكم في تركيّا، وإن على سويّة أرقى كثيراً من السويّة المصريّة، يواجه أزمة كبرى في ممارسته السلطة، بينما الإسلام السياسيّ الحاكم في إيران، وعلى سويّة أشدّ انخفاضاً من السويّتين التركيّة والمصريّة، يستنجد بحسن روحاني الذي ربّما كان آخر أوراق التوت.
هذا بذاته، ومن حيث المبدأ، تحوّل كبير سنعاينه على مدى حقبة مقبلة يُرجّح أن تطول.
لكنْ بالعودة إلى مصر، تتقاطع المطالبة المبرّرة بتنحّي مرسي (أو تقصير ولايته) تمهيداً لانتخابات رئاسيّة جديدة مع معضلة كبرى تعاون على خلقها التاريخ السياسيّ والثقافيّ للبلد وحاكميّة الإخوان المسلمين بعد ثورة يناير.
والمعضلة هذه التي تكاد تقسم الشعب شعبين، قد تنتهي إلى مآزق لا تستطيع الثقافة السياسيّة بانقساماتها المعهودة ووسائط تحكيمها أن تتغلّب عليها لأنّها، ببساطة، تفيض عن الثقافة السياسيّة بانقساماتها المعهودة.
وضع كهذا يحمل على افتراض الاحتمالات الراديكاليّة والقصوى، من نوع نشوب حرب أهليّة لم يعد توقّع نشوبها هلوسة محلّلين ذوي خيال سخيّ، أو من نوع انقلاب عسكريّ يقطع الطريق على الاستقطابات الحادّة والمتعادلة، ويكون واسع التأييد بعد التعب والإنهاك الشعبيّين اللذين تسبّبت بهما المواجهات المتّصلة منذ يناير 2011 وما رافق ذلك من تردٍّ في الأمن والاقتصاد.
والحقّ أنّ احتمالات كهذه، في حال حصولها، ستكون إنذاراً، بل نذيراً، لا لمصر وحدها، بل لعموم المنطقة التي كثيراً ما تؤشّر مصر إلى وجهتها. ذاك أنّنا إذا عطفنا مثل هذه الاحتمالات على خليط الثورة والأزمة والحرب الأهليّة في سوريّة، وتخبّط الوضع الليبيّ، وتراكم أسباب الانفجار في تونس، أمكن الخروج بخلاصة بالغة التشاؤم والسوداويّة عن آفاق الديموقراطيّة في المنطقة العربيّة.
فإذا صحّ أنّ الحرّيّة تفتح الأبواب للتقدّم، بما فيه التقدّم نحو الديموقراطيّة، صحّ أيضاً أنّ الحرّيّة ليست سحراً يستطيع التغلّب على معضلات عصيّة ترعرعت في حضن تاريخ وثقافة بعينهما.
فهل تنجح مصر، بشبّانها وشابّاتها في ميدان التحرير وسائر الميادين، في إنقاذ الثورات وتسهيل العبور من الحرّيّة إلى الديموقراطيّة، أم أنّها ستفشل أمام هذا التحدّي فتترك الحرّيّة كي تتفسّخ إلى فوضى، أو كي تُخنق على يد انقلاب عسكريّ؟
وهذا ربّما كان سؤالاً يشبه المعضلة الكبرى لواقعنا، من حيث أنّه يتجاوز السياسيّ إلى الثقافيّ والمجتمعيّ؟
الحياة
مرسي وساعة السيسي
غسان شربل
ما اصعب الخريف حين يهب على الحاكم. ما أقساه حين يأتي عاصفاً ومبكراً. تتلاعب الريح بستائر القصر وعيون الحراس. تتكلخ أوراق الهيبة. يتساقط وزراء ومستشارون ومتحدثون. يقفزون من السفينة. يتناسون انحناءاتهم ومدائحهم ويبتعدون.
ما أصعب أن يتجمع أبناء الأحياء استجابة لنداء «تمرد». وأن تلقي كل هذه الانهار بنفسها في ميدان التحرير. وأن تهدر الأصوات متعالية «ارحل… ارحل». وأن تفوق مليونيات الغاضبين مليونيات الموالين. وأن تنذر السيول باقتراب الطوفان. وما أصعب أن يلوحوا بالعلم مع الهتاف. كأن الرئيس ضد العلم. كأن الاعلام تقترع ضد الرئيس.
لم يكن يتوقع أن تأتيه الطعنة من ذلك الميدان. من الميدان الذي أرغم حسني مبارك على الرحيل. الميدان الذي أصر على الذهاب إليه بعد فوزه في الانتخابات. كأنه كان يريد القول إنه يؤدي اليمين الدستورية أمام الثورة وفي ملعبها الأول. يتصاعد غضب الرئيس. لا يعقل أن يسجل التاريخ أن أول رئيس مدني منتخب لمصر ذهب بالأسلوب نفسه الذي ذهب به مبارك.
يغادر المستشارون ويبقى الرئيس وحيداً مع الرئيس. يعرف أنه ليس رئيساً معزولاً. وأن مصير الجماعة التي جاء منها غير منفصل عن مصيره. وأنها لا تملك ترف التضحية به. وأن هزيمته تعني هزيمتها. وخريفه يعني خريفها. وربما يعني ايضاً خريف كل الإسلاميين الذين أخرجهم «الربيع العربي» من السجون والملاحقات وفتح لهم صناديق الاقتراع ومعها أرائك الحكم.
يسمع الأصوات الوافدة من الميادين. «ارحل…ارحل». من أفسد علاقة الرئيس بكل هؤلاء الناس؟ هل صدقوا باسم يوسف وإبراهيم عيسى ووائل الابراشي ومحمود سعد ويسري فودة وعمرو أديب ولميس الحديدي وسائر جنرالات الشاشات؟ وهل يجوز ترك مصر في عهدة هؤلاء ومحاكماتهم اليومية التي لا تنتهي؟ وهل يجوز أن يتقرر مصير مصر العظيمة على يد «مراهقين» اتقنوا التجوال على صفحات «الفايسبوك» و «تويتر»؟ لا يمكن تركها في عهدة هؤلاء.
سخر الرئيس حين قرأ قبل شهور كلاماً لأحمد شفيق يجزم فيه «أن مرسي لن يكمل ولايته». سخر ايضاً حين قرأ ما قاله محمد البرادعي: «التقيت الرئيس وحاورته ويئست منه … والحل انتخابات رئاسية مبكرة». لم يصدق حمدين صباحي حين قال: «ان 30 حزيران (يونيو) هو موجة ثورية جديدة وأن مرسي تحول عائقاً أمام استكمال الثورة». لم يتوقف طويلاً عند قول عمرو موسى انه خائف على روح مصر وهويتها التي تصنع ثقلها واستقرارها ودورها. ابتهج حين قرأ كلام عصام العريان عن أن الرئيس لن يكمل ولايته فقط بل قد يترشح لولاية ثانية.
العريان ايضاً لم يتوقع ان تغرق ساحات مصر بالمحتجين. لم يقرأ مقدمات الخريف. يقول الرئيس في سره. ويتابع. وهي مقدمات كان يمكن التشاطر عليها لو لم يفعلها السيسي. فعلها السيسي. إنذار الجيش أعلن بوضوح أن الخريف هب فعلاً على عهد مرسي. ها هو الجيش يتحالف مع الميادين والملايين. كأنه يثأر من «يسقط يسقط حكم العسكر».
فعلها السيسي. وببراعة. دبج إنذاراً إنقاذياً. أبعد تدخله عن صيغة الانقلاب. لم يترك للرئيس والجماعة غير خيارات مؤلمة أو انتحارية. الاصطدام بالجيش. أو الاصطدام بالمتظاهرين. أو إغراق البلد في مقدمات حرب أهلية ستسهل للسيسي تنفيذ إنذاره بذريعة منع الانزلاق.
يتمشى مرسي في مكتبه. المهلة التي أعطاها السيسي تقترب من النفاد. الساعات تهرب وأوراق شجرة العهد تتساقط. الانحناء أمام الإنذار مرير. سيحتفل كثيرون بـ «خريف الإخوان». المجازفة بمواجهة في الشارع قرار انتحاري يفوق في خطورته قرار خوض الانتخابات ووضع قصر الرئاسة تحت عباءة «الإخوان». يشعر الرئيس بشيء من سوء الحظ. يقول في سره ليت الرئاسة كانت من نصيب خيرت الشاطر. يتعب الرئيس يذهب الى النوم بعد أن يلتفت مجدداً الى ساعته. في هذا الوقت كان رجل آخر يتفقد ساعته. اسم الرجل الفريق عبد الفتاح السيسي. في المبارزة مجازفة. والوقت يدهم. واللعبة بلا رحمة. اذا نجا الرئيس سيهجم الخريف على السيسي.
الحياة
فلننحن لمصر
عقل العويط
لسنا مع حكم العسكر بالطبع. ولن نكون. لكن ما جرى ولا يزال يجري حالياً على مستوى الشعب المصري، وخصوصاً لدى أجياله الشبابية، يرتقي بدون مواربة إلى رتبة اللحظات التاريخية، المحوِّلة في حياة الأمم والدول والشعوب. نقول ذلك، وقد بات عهد “الإخوان المسلمين” في مصر، في يد الأجل السياسي المحتوم، بعد أيام “النزول العظيم”، وما ترتّب عليها من وقائع تَحَضَّر لها الجيش المصري، في كواليس السياسة والأمن والمخابرات وتعقيدات اللعبة الدولية. هل نكون نورّط الأسطورة الأدبية فنقول إن الضغط الشعبي المصري، الديموقراطي، السلمي، المنظَّم، الرافض حكم “الإخوان”، وقد أفضى إلى رحيل الطاغية الإسلاموي، يرتقي إلى رتبة اللحظات الشعرية؟!
لن ننزلق إلى التحليل. لن نستسلم لـ”حكمة” الرأي والرأي المضادّ. لن نقع في متاهة المنطقَين اللذين يتحكّمان بالشارع المصري. فليفعل المحلّلون ما يحلو لهم أن يفعلوه. عندنا، أن ثمة حقيقة ساطعة، كبرى، هائلة، شبيهة بانفجار الضوء، هي حقيقة الرفض والتمرد والثورة المستعادة، الماثلة في معاندة الأمر الإسلاموي الواقع. ثمة ملايين من الشعب المصري بقيت تهدر علناً وجهاراً، في الوجدان الجمعي وفي الشارع، مطالِبةً باسترداد ثورتها المسروقة، قائلةً، بأرقى الوسائل الديموقراطية، إن حكم “الإخوان المسلمين”، ومَن معهم من الظلاميين والسلفيين، ليس هو الحلّ.
يا للعجب! بل يا لسذاجة الأوهام الإسلاموية في السلطة!سنة واحدة في الحكم كانت كافية تماماً لتعرية التجربة الإسلاموية في أعلى الهرم السياسي المصري، ولـ”إنجاز” هذا السقوط الحرّ، بعد خمسة وثمانين عاماً من التحضير “الإخواني” الدؤوب. فكيف ظلّ يتجاسر حاكمٌ مصري إسلاموي على الاستمرار في السلطة، وهو يتدحرج هذا التدحرج العلني، المريع، رافضاً الرضوخ لإرادة هذا البحر الهادر؟
رأينا قبل أيام، فتاتَين مصريتين ترتديان الشورت اللائق في ليل شارع الحمراء، في بيروت، في ترميز ساطع ضد تزمّت الثوب الإسلاموي، كلٌّ منهما تحمل لافتةً تختصر روح المشهد المصري: مرسي أصغر بكتير من مصر. مصر أكبر منّك يا مرسي!
هل من ضرورة إلى أكثر من هذا المَثَل الحقيقي، البسيط والمتواضع والشفّاف، لمعرفة أن مصر هي أكبر من الإسلامويين، ومن الحكّام الإسلامويين، مثلما كانت أكبر من الفراعنة القدامى والجدد، ومن مبارك وطغمته الديكتاتورية الفاسدة؟
يستطيع الحاكم المصري، بل كلّ حاكم، أن يتعامى. أن يتهرّب. أن يخادع. أن يهرب إلى الأمام. يستطيع أن يمالئ شرقاً وغرباً، كما يستطيع أيضاً أن يستنجد بالشبّيحة الإسلامويين، وبالزمر المسلّحة، مهدِّداً بالحرب الأهلية. يستطيع أن يستدرج السطوة العسكرية، مومئاً إلى أن ما جرى ويستمرّ جارياً، إنما يشكّل انقلاباً على الديموقراطية التي جاءت به. يستطيع أن يفعل هذا كلّه، وغيره، بالتأكيد، لكنه لن يستطيع أن يستمر في مصادرة السلطة والاستئثار بها، من طريق “الأخونة”.
نعرف أن ثمة في الدهاليز والكواليس والأقبية، ما قد يدعو إلى التوجّس مرةً أخرى. ثورة 25 يناير التي سُرِقتْ من أيدي الشعب المصري الحالم الحرّ، يجب ألاّ تُسرَق منه مرةً ثانية. نعرف تماماً أن الأمور أشدّ تعقيداً مما يتجلّى على السطح من مكوّنات اللحظة التاريخية الحاسمة. لكن الحقيقة الآن، هي هذه الحقيقة بالذات: “الإخوان المسلمون” ليسوا هم الحلّ في مصر. فكيف بالسلفيين والظلاميين؟!
إذا كان ثمة فعلٌ يليق بالشعب المصري، الآن، ففعلُهُ المجيد أن يسهر على انجاز الاستحقاقات الدستورية المترتّبة على عملية الضغط الديموقراطي المنظّم، بعد خلع الحاكم، كخطوةٍ لا بدّ منها، على طريق تحقيق أحلامه الجوهرية في الحرية والديموقراطية والكرامة، وفي لقمة العيش، على السواء.
وإذا كان ثمة شيءٌ يليق بنا، فأن نهتف مع الشعب المصري، مع “حركة تمرّد”، من خطبة مشهورة للزعيم مصطفى كامل، كلمات الشاعر محمد يونس القاضي، وتلحين سيد درويش: بلادي بلادي بلادي لك حبّي وفؤادي/ مصر يا أمّ البلاد أنتِ غايتي والمراد/ مصر أنت أغلى درّة فوق جبين الدهر غرّة/ يا بلادي عيشي حرّة واسلمي رغم الأعادي/ مصر أولادك كرام أوفياء يرعوا الزمام/ سوف نحظى بالمرام باتحادهم واتحادي.
فلننحنِ أمام هذه اللحظة الحاسمة! فلننحنِ لمصر المحروسة والمتمرّدة!
النهار
نهاية مرسي أم هزيمة «الإخوان»؟
محمد شومان *
التاريخ لا يكرر نفسه، لكن ما أشبه الانتفاضة الثورية في كانون الثاني (يناير) 2011، بما يجري في مصر الآن، وأوجه التشابه كثيرة، لعل أهمها حضور الملايين وغياب القيادة والتنظيم والبرنامج الثوري، وفي الانتفاضة الأم التفت الجموع حول مطلب رحيل مبارك وإسقاط نظامه، وفي 30 حزيران (يونيو) تكرر الإجماع العام حول رحيل مرسي وإسقاط نظامه الذي لم يكتمل بناؤه! وفي الحالين لا يوجد اتفاق أو تفاهم بين كل هذه الحشود المليونية حول خريطة المستقبل، وكيفية تحقيق أهداف الثورة خصوصاً العدالة الاجتماعية.
وهنا الخطر لأن الحشود المليونية في الثورة الأم وظفت لمصلحة «الإخوان»، باعتبارها القوى المنظمة، ويومها كانت محل تعاطف جماهيري واسع، حيث لم تكن الجماعة قد خاضت اختبار السلطة منذ تأسيسها عام 1928، أما اليوم فإن أخطاء حكم «الإخوان» أساءت إليهم عند معظم المصريين، وتحولت نغمة التنظيم الحديد القائم على السمع والطاعة إلى نقمة، توشك أن تفجر مواجهة دموية بين «الإخوان» وبين الشعب والجيش والدولة! باختصار، هناك تحولات هائلة في علاقة «الإخوان» بالشعب، وفي توازن القوى بين الرئيس وجماعته وحلفائه الإسلاميين، وبين باقي الشعب والقوى السياسية، علاوة على السلفيين.
احتمالات الصدام وخسارة «الإخوان» شبه محسومة، لكن يبقى السؤال عمن يحصل على نصيب الأسد في ترتيبات ما بعد رحيل مرسي؟ الإجابة صعبة ومعقدة، خصوصاً في ظل احتمال تفكك جبهة الإنقاذ، واستمرار أمراض النخبة السياسية العجوز وصراعاتها، وحرصها في الوقت ذاته على تهميش الشباب والمرأة والأقباط، وبالتالي قد تتراجع الحشود المليونية أو تختفي لبعض الوقت من المشهد، ولا يبقى إلا القوى المنظمة، والتي يمكن حصرها الآن في لاعبين اثنين فقط هما الجيش العائد بقوة وبحرص على عدم تكرار أخطاء 2011، والجماعات السلفية، والأخيرة تأمل بوراثة دور «الإخوان» في الحياة السياسية وفي العلاقات مع واشنطن، أما شباب الثورة فإن أخطار تهميشهم كبيرة، ومن المحتمل أن يكون مصير شباب «تمرد» مثل مصير شباب يناير الذين فجروا الثورة ولم يشاركوا في صناعة نظام ما بعد يناير.
مهما كانت أوجه الشبه والمخاوف فمن المؤكد أن المصريين تعلموا فضيلة الثورة وأخطارها، وقضوا تماماً على كل خوف من السلطة. في هذا السياق شكل 30 حزيران موجه ثورية هائلة فاقت توقعات حركة «تمرد» والمعارضة، و «الإخوان» والسلفيين، والجيش، وأربكت حسابات الجميع! فأعداد المشاركين تجاوزت انفجار يناير 2011 الثوري الذي أطاح مبارك وحاشيته، كما اتسع نطاق المشاركات الجماهيرية وشمل محافظات وقرى مصر، واجتاح مناطق في الريف والصعيد لم تساهم من قبل في موجات الثورة، وكانت معروفة بدعمها الدائم لـ «الإخوان» والسلفيين.
الخروج المليوني والذي لم تعرفه مصر في تاريخها له أسباب كثيرة، أقلها ضياع صدقية الرئيس وجماعته، ونزعتهما لـ «أخونة» الدولة والاستحواذ على السلطة، والفشل في إدارة الدولة، ما ضاعف من مشكلات الاقتصاد والبطالة ونقص الوقود والكهرباء. والغريب أن الرئيس وجماعته تعاملا مع كل هذه المشكلات بإنكار غريب للحقائق والتداعيات السياسية والاجتماعية، وبالتالي تصورا أن الوقفات الاحتجاجية والتي بلغ عددها 7709 والتظاهرات والمصادمات التي وصل عددها إلى 5821 خلال العام الأول من حكم «الإخوان» ليست سوى مؤامرات من فلول نظام مبارك وبعض عناصر المعارضة، ومن ثم لم يقدم الرئيس أية تنازلات أو مبادرات سياسية لاحتواء الغضب الشعبي المتنامي والذي استغلته حركة «تمرد» لمصلحتها في حشد وتعبئة تحالف عريض من شباب الثورة والأحزاب المدنية والغالبية الصامتة أو ما يعرف بحزب الكنبة، علاوة على أنصار النظام القديم (من المرجح انهيار هذا التحالف بمجرد رحيل مرسي)، لكن المفاجأة أن غالبية أجهزة ورجال الدولة منحوا تأييدهم لحركة «تمرد»، وبدا مرسي على رأس دولة لا ترغب في بقائه أو استمراره لأن انحيازه لـ «الإخوان» أدى إلى تقسيم المجتمع والدولة وتعميق الاستقطاب والصراع بين كل الأطراف.
مقاومة بيروقراطية الدولة لمرسي تجاوزت حدود التلكؤ أو التسويف في تنفيذ قرارات الرئاسة، وأسفرت عن وجهها بوضوح، فالقضاء والإعلام يقاومان «الأخونة»، والشرطة ترفض حماية مقار «الإخوان» أو قمع المتظاهرين، والجيش يؤكد وقوفه على الحياد. هكذا، بدت كل الأطراف تتعلم من دروس يناير 2011، عدا «الإخوان». نجحت جبهة الإنقاذ في توحيد صفوفها وتوارت في خلفية المشهد، لتفسح المجال لشباب حركة «تمرد» أو الجيل الثاني من شباب الثورة، والمفارقة أن فكرة «تمرد» أسفرت عن حراك سياسي وحيوية جماهيرية تتجاوز طاقة «تمرد» وكل أحزاب جبهة الإنقاذ، ما يعني أن الجماهير تتحرك من دون قيادة أو أطر تنظيمية ضابطة – تماماً كما جرى في ثورة يناير – وهي ظاهرة تفرضها معطيات موضوعية لكنها تنطوي على مقدار من الأخطار. أيضاً، الشرطة ومعظم أجهزة الدولة ورجالها ابتعدوا عن الرئيس ولم يتورطوا كما حصل في يناير 2011 في الصدام مع الشعب، لكن «الإخوان» وحدهم لم يتعلموا درس رحيل مبارك وكيف أدى تأخره في تقديم تنازلات أو مبادرات سياسية في احتواء غضب الشارع، وأعتقد هنا أن الرئيس وجماعته لم يتأخرا وإنما لم يقدما أصلاً أي تنازل، ولم يمتلكا استراتيجية محددة للتعامل مع حركة «تمرد»، واستخدما خمس أوراق ثبت فشلها: الأولى ورقة تكفير المعارضة، والثانية الشرعية، فالرئيس منتخب ولا يجوز شرعاً أو دستورياً إزاحته قبل أن يكمل ولايته الأولى، والورقة الثالثة هي تخويف وإرهاب المواطنين من أحداث عنف متوقعة واشتباكات دموية، والورقة الرابعة الرهان على الدعم الأميركي. وتبقى الورقة الخامسة وهي حشد أعضاء ومناصري الجماعة من القاهرة والأقاليم أمام مسجد رابعة العدوية في القاهرة.
أوراق الرئيس وجماعته جاءت محدودة التأثير، وكشفت غياب الخبرة والخيال والقدرة على التأثير في الشارع، حيث جاءت تحركاتهما محدودة وفي إطار رد الفعل لتحركات شباب «تجرد»، كما حصرا وجودهما في رابعة العدوية، واعتمدا على حشد وتحريك أعضاء الجماعة، ومن دون أنصار ومتعاطفين، لأن خطاب «الإخوان» وهم في السلطة فشل في حشد وتعبئة أنصار ومتعاطفين، بل إن كثيرين منهم انفضوا من حول الجماعة، لذلك بدت منبوذة مجتمعياً، وبعيدة من حاضن اجتماعي أو سياسي، ما أكد خطأ كثير من الأحكام السائدة والانطباعات عن كفاءة «الإخوان» وفاعليتهم السياسية وقدرتهم على الحشد. وأعتقد أن فشل الحكم «الإخواني» قد وضع الجماعة، وللمرة الأولى في تاريخها منذ قيامها، في صراع وصدام مع غالبية الشعب، وقد ظهر ذلك بجلاء في تظاهرات 30 يونيو، فالجماعة تحشد في رابعة العدوية، وبعض المدن، وهي حشود أشبه بالغيتو إذا ما قورنت بالملايين الرافضة للرئيس و «الأخونة» التي خرجت تجوب مدن مصر وقراها.
حيوية الشعب والالتفاف العام حول مطالب «تمرد»، دفعا الجيش إلى إعلان وقوفه إلى جانب المطالب الشعبية، لكن مع التشديد على أن الجيش لن يكون طرفاً في السياسة أو الحكم، وفي الوقت نفسه أمهل كل الأطراف 48 ساعة لتحقيق مطالب الشعب، وإلا فسيعلن خريطة مستقبل وإجراءات يشرف على تنفيذها وبمشاركة جميع الأطياف والاتجاهات الوطنية المخلصة، بمن فيها الشباب الذي كان ولا يزال مفجراً لثورته المجيدة، ومن دون إقصاء أو استبعاد أحد. والحقيقة أن بيان الجيش حرص على عدم تكرار أخطاء مرحلة ما بعد مبارك وتجربة حكم العسكر، وطمأنة مخاوف شباب الثورة من عودة الجيش إلى الحكم، لكنه أكد دوره كلاعب رئيس في العملية السياسية، كما استعاد الكثير من شعبيته، إذ رحب الشارع – المعارض في غالبيته لـ «الإخوان» – بتدخل الجيش، وتحول كثير من التظاهرات الغاضبة إلى مناسبة للاحتفال بتأييد الجيش للشعب. في المقابل اعتبر «الإخوان» وحلفاؤهم البيان بمثابة انقلاب عسكري ضد الشرعية وهو ما نفاه الجيش، ومع ذلك قرروا تنظيم تظاهرات في كثير من المدن، وهو أمر قد يفتح المجال لاشتباكات دموية تأخذ مصر إلى طريق الحرب الأهلية، حيث يصعب تفادي التحام التظاهرات في الميادين والشوارع في المدن الصغيرة في الدلتا والصعيد، وقد وقع بالفعل كثير من الاشتباكات، كما تورط بعض المتظاهرين ضد «الإخوان» في اقتحام كثير من مقار الجماعة وحزبها وإحراقه.
الأحداث متلاحقة والمشهد لم يستقر، وكل الاحتمالات مطروحة، لكن النتيجة محسومة لغير مصلحة «الإخوان» وجماعات الإسلام السياسي، فمعظم المصريين ضد استمرار حكم «الإخوان»، والجيش والشرطة يدعمان مطالب الشعب، وأعلن السلفيون تأييدهم لانتخابات مبكرة، ومع ذلك من الصعب أن تستسلم الجماعة بسهولة وتضحي بمرسي، وأرجّح أن أمامها خيارين، الأول: أن تتدخل في مواجهة محدودة مع الشعب والجيش والشرطة، وتتخذ إجراءات تصعيدية محسوبة من أجل أن تضمن لها مكاناً في النظام السياسي بعد رحيل مرسي، بمعنى تحسين شروط هزيمتها، بحيث تتكيف الجماعة وتوافق على رحيل مرسي، مقابل عدم ملاحقته وآخرين قضائياً، مع ضمان أن يكون له مكان ودور في عملية التفاوض على ملامح ما بعد مرسي.
الثاني: أن تخوض الجماعة غمار صراع مفتوح وتصعيد من دون ضابط يغيّر توازن القوى على الأرض، وهو ما يعني إما الفوز أو الخسارة، وأعتقد أن «الإخوان» لن يميلوا إلى هذا الخيار على رغم التلويح به، لأنهم يعرفون جيداً أن موازين القوى ليست في مصلحتهم داخلياً وإقليمياً ودولياً، كما أن قرارهم الآن، علاوة على فشلهم في حكم مصر لن يؤثر فقط في وضعيتهم في مصر وإنما في تحديد مصير «الإخوان» في العالم، وربما مصير جماعات الإسلام السياسي ومآلاتها في المنطقة العربية وفي دول الربيع العربي تحديداً. فالفكرة والجماعة والدعوة التي بدأت في مصر، هل تموت وتزول في المجتمع الذي أفرزها واحتضنها 85 عاماً؟!
* كاتب مصري
الحياة
إتجاه – مغزى الحدث المصري
ماجد كيالي
من المبكّر التكهّن بمآلات مايجري في مصر هذه الأيام، لكن ذلك لا يمنع من تقديم قراءة أولية في مغزى هذا الحدث الكبير، الذي يؤكّد بأن “الربيع العربي”، ليس مجرّد شتاء إسلامي، كما روّج البعض، وأن الشعوب لم تعد تطيق صبراً على حكمها بالطريقة الإقصائية السابقة، وأن الديموقراطية ليست محض عملية انتخابية فقط، ولا تحكّم أكثرية بأقلية.
فمنذ فوز الرئيس محمد مرسي في الانتخابات، قبل عام، ارتكب النظام الحاكم في مصر العديد من الأخطاء، من ضمنها محاولة أخونة الدولة، في حين أن هذه يفترض أن تكون مجالاً عاماً، في معزل عن هيمنة الحزب الحاكم، ما يصحّ على حزب الإخوان كما على غيره. وضمن هذه الأخطاء جاء “الإعلان الدستوري”، الذي حاول من خلاله الرئيس الاستحواذ على السلطتين القضائية والتشريعية، أيضاً، ما يتنافى مع مبدأ مؤسّس، وهو الفصل بين السلطات، في دولة المؤسسات والقانون. وبالتأكيد فإن التفرّد في تشكيل الجمعية التأسيسية، التي صاغت الدستور الذي أثارت بعض مواده المخاوف من محاولة الإخوان فرض تصوّراتهم على الدولة والمجتمع، كان له دور كبير، أيضاً، في فقدان الثقة بالنظام الحاكم.
الآن، يخشى أن يؤدي الشطط في اعتبار “الربيع العربي” “ربيعاً إسلامياً” إلى شطط مقابل قوامه استعداء تيار الإسلام السياسي، وبالتالي خلق واقع من استقطاب علماني/إسلامي، أو مدني/ ديني، يتأسّس على انتهاج سياسات التهميش والاقصاء والمحو، ما يتناقض مع الديموقراطية والمشاركة، ومع قيمتي الحرية والمساواة.
علماً أن إقصاء تيار ما اليوم، قد يشرعن لإقصاء تيار آخر غداً. ناهيك عن أن هذه السياسات، التي هي من نتاج النظم الاستبدادية، تساهم في تعزيز التشقَقات في المجتمع، وتدفع نحو التطرّف والكراهية، وربما العنف، وهو مطبّ ينبغي الحذر من الوقوع في إغرائه.
وعدا عن اعتبارات الديموقراطية، فثمة مصلحة للجميع، في تمكين حزب الإخوان المسلمين، وغيره من الأحزاب الإسلامية، المعتدلة، والتي لا تنتهج العنف، من تطبيع ذاتها في الحياة السياسية، وإدراك متطلبات إدارة الدولة والمجتمع، والتعامل بطريقة عصرية مع شؤون الاقتصاد والثقافة والتعليم والبلديات وحاجات المواطنين. لأن هذا مايحوله من حزب يرى في نفسه حزبا للسماء الى حزب يهتم بشؤون البشر. ومن حزب ديني الى حزب مدني، مايضعه في اطار الاختبار، وبالتالي في اطار المساءلة والمحاسبة، كحزب يديره بشر يمكن أن يخطئوا أو أن يصيبوا، شأنهم شأن غيرهم.
والقصد أن مايجري، رغم صخبه ومشكلاته، لا بد أن يساهم في إنضاج الجميع، إسلاميين وعلمانيين، لأننا تعودنا، مع الأسف، على دفع أثمان باهظة من أرواحنا ومواردنا وأعمارنا، كي نتعلم، وكي تنضج أفكارنا.
النهار
هل يُزهر الربيع العربي مجدّداً؟
موناليزا فريحة
في سنتين ونصف سنة، صنع المصريون تاريخ بلادهم مرتين ونصف مرة. في الاولى خلعوا رئيسا نصّب نفسه فرعونا على بلاد النيل، وفي الثانية نزعوا شرعية آخر حاول “التفرعن “باسم الدين. ويبقى التحدي الاكبر ألا تستكين هذه الدينامية وتهدأ، قبل أن يتوج شعب مصر التاريخ بقيادة تليق بـ”أم الدنيا” لا مكان فيها لمكر “الاخوان” ولا لحكم العسكر طبعا.
عندما هزّ شباب ميدان التحرير عرش مبارك في “ثورة 25 يناير”، تخلخلت عروش كثيرة وطارت رؤوس كبيرة في المنطقة. انتهى القذافي مختبئا كالجرذ، وأخرج علي عبد الله صالح لـ”العلاج”. وقبلهما، ركب زين العابدين بن علي الطائرة الاولى في مطار قرطاج الدولي، الى جدة.
ليس مبالغاً فيه القول أنه كما تميل مصر مال العرب. كانت ثورتها قوة الدفع الرئيسية للتغيرات التي اجتاحت المنطقة. ألهمت حماسة شبابها الشباب العربي، وصار لميدان تحريرها رديف في كل عاصمة عربية. أكسبت ثورتها الانتفاضات عن حق صفة “الربيع العربي”، لذا عندما تعثرت كثر سلاخو ذلك الربيع.
شكّل وصول “الاخوان” الى السلطة في مصر انحرافا في مسار الثورة وأثر على مسار الديناميات الديموقراطية الوليدة في المنطقة. استقوى الاسلاميون في العالم العربي بشقيقتهم الكبرى، واستوحوها. صمَّت النهضة في تونس آّذانها عن الآراء المخالفة لرأيها. وقبل أن يصلوا الى الحكم، لم يعد “اخوان” سوريا يرتضون بأقل من الغالبية في أي مجلس أو هيئة للمعارضة!
في أقل من سنة، غاب تعبير “الربيع العربي” عن المنابر. صارت مصر مصرين، وتحولت الانتفاضة الشعبية في سوريا حربا دموية، وغرقت ليبيا في أزمات تبعدها أكثر عن بناء الدولة، وتزايدت أسباب الانفجار في تونس. للبعض، صار “الربيع العربي”، “ربيعاً اسلاميا” ولآخرين “خريفا دمويا”.
أنعش “التمرد” المصري على حكم مرسي واستبداد “اخوانه” الآمال في تصحيح المسار واستعادة العرب ربيعهم. وليس مشهد الطوفان البشري التاريخي المتدفق في شوارع المدن المصرية للمطالبة بتنحي رئيس مدني منتخب اكتفى من الديموقراطية بصندوق الاقتراع، الا فرصة جديدة لاعادة الاعتبار الى شعارات الحرية والديموقراطية التي رفعتها الشعوب العربية.
وكما في 25 كانون الثاني 2011 و30 حزيران 2013، تتجه الانظار مجدداً الى شباب مصر وشيبها في ميدان التحرير وقرب قصر الاتحادية وغيرهما من الميادين والقصور. هناك سيتقرر لا مصير الثورة المصرية فحسب، وإنما مصير شعوب عربية عدة. فهل تنجح مصر مجددا في العبور الشائك الى الديموقراطيّة وتساهم في اعادة الروح الى “الربيع العربي”، أم تضطر الى الخيار الصعب بين حرب أهلية تمهد لها سياسة الانكار التي يمارسها “الاخوان”، وحكم العسكر؟
النهار
تصحيح مصري للربيع العربي؟
راجح الخوري
لن تذهب مصر الى التجربة الدموية التي تقلبت فيها الجزائر ردحاً طويلاً من الزمن، ولن يستطيع “الاخوان المسلمون” دفع المصريين الى الوقوع في التجربة اليمنية، التي وضعت الشعب ضد الشعب الى ان تنحى علي عبدالله صالح. فبعدما قال الجيش المصري في بيان حاسم “الامر لي” لن يكون في وسع “الاخوان” مواجهة الشعب والجيش معاً، بما يعني ان حكم محمد مرسي انتهى بعد عام من الاخطاء والاوهام، التي ارتكبت على قاعدة ان على المصريين ان يكونوا شعباً في السمع والطاعة لأمير المؤمنين الجديد الذي تصفق له المخابرات الاميركية!
البيان العسكري الذي أمهل مرسي 48 ساعة لإيجاد حل ينهي الازمة، ولوّح بوضع خريطة طريق لمستقبل البلاد، يمكن ان يختصر بكلمة واحدة وهي تلك التي يرفعها المصريون أي “ارحل”، لكن مرسي ومن ورائه “الاخوان” تجاهلوا ان نصف الشعب المصري على الأقل نزل الى الشارع مطالباً بانهاء هذه الحقبة المريرة التي أعقبت الثورة على حسني مبارك، وتمترسوا وراء القول ان مرسي انتخب ديموقراطياً، ولكأن الشعوب لا تستطيع ان تقول كلمتها إلا في صناديق الاقتراع، في حين تبدو مصر كلها بمثابة صندوق اقتراع يجمع على إنهاء المهزلة المستمرة منذ عام، حيث حاول الاخوان الامساك بخناق الدولة والمجتمع وابتسار السلطة كلها.
لم يكتف مرسي برفض المهلة التي حددها العسكريون، بل اتهم الجيش ضمناً “بتعميق الفرقة بين ابناء البلد الواحد وتهديد السلم الاهلي”، زاعماً انه سيمضي في خططه للمصالحة الوطنية، في حين وزّع “الاخوان” السيناريو الذي يقول ان الجيش ينفذ انقلاباً عسكرياً ضد السلطة المنتخبة شرعياً، وهذا ليس بصحيح كما تفهم واشنطن جيداً وان كانت تتحسر الآن من التفليسة المبكرة لمرسي و”الاخوان”، الذين بدا حتى الامس انها تدعمهم رغم رفض الشعب المصري القاطع لهم!
مرسي آخر من يحق له الحديث عن الدولة الديموقراطية المدنية الحديثة بعدما اثبت خلال عام الى اين يريد ان يذهب بمصر، ولا يمكن الحديث عن حفظ مكتسبات “ثورة 25 يناير” ما لم يتم ترحيله عن السلطة، ومن المؤكد انه لن يكون في وسع “الاخوان” الذين حصدوا الفشل باكراً بعد جهد بذلوه منذ 85 عاماً للوصول الى السلطة في اكبر بلد عربي، ان يواجهوا تحالف الجيش مع الشعب المصري، وخصوصاً ان هذا الجيش دولة داخل الدولة.
المصريون الذين اجتاحوا الميادين لإنقاذ الثورة من تحريف “الاخوان” لا يصححون مسارات محمد مرسي الخاطئة فحسب، بل يصححون اتجاهات ما سمي “الربيع العربي” الذي انقضّ عليه “الاخوان” الذين لا يلتفتون كثيراً الى القومية او الوطنية، في اكثر من بلد وسط مباركة اميركية مدفوعة بحماسة اسرائيلية… ورحيل مرسي يرسي الربيع على قواعد صحيحة!
النهار
عَسْكَرَة الحلّ أَم عودة العسكر؟
الياس الديري
لم يعد السؤال هل يبقى الرئيس محمد مرسي في قصر الاتحاديّة طويلاً، ومن حوله جموع منوّعة من “الأخوان” والأصوليين والتنظيمات المتطرّفة، بل أصبح هل يعود العسكر الى السرايات والقصور، ويعسكرون الحكم والسلطة والنظام مرة أخرى، جديدة، مختلفة، موقّتة، أخفّ وطأة؟
لا انقلاب عسكرياً خلف تحرّك قيادة الجيش، كما صدرت التأكيدات أو هي سٌرِّبت من “عواصم القرار”. ولا نيّة لاسترجاع مشاهد تعيد الى الأذهان انقلابات الماضي، ودباباتها، واستيلاء ضباطها على مقاليد الحكم، بعد الانتهاء من إذاعة مسلسل البيانات وفرض الأحكام والقرارات، وما الى ذلك…
لا، لن يكون شيء من هذا. و”البيان” التمهيدي الذي أهدته قيادة الجيش الى المصريّين يشير الى أسلوب مختلف في عملية التغيير والتصحيح، واشتراك ممثلين للمتمردين والثائرين في العملية… التي لا بد من إبراز دور الجيش فيها، وبكل قوته وآلياته وأركانه وضباطه.
هكذا يصبح الانقلاب أقرب الى “الكوكتيل”. أو الثورة المختلطة، والتي تبعد صيغة الانقلاب بكل حدتها ومعناها ومضمونها…
في كل حال، هذا الكلام، وهذا التصوّر، وهذا الاحتمال، لا يشبه اختراع البارود. فهو حديث كل الأوساط، وعَبْر كل وسائل الاعلام والاتصالات. وليس في مصر وحدها، أو في بعض العواصم العربية، إنما هو “المادة” الأساسيّة في الحوارات والنقاشات التي عبرت المنطقة والبحار السبعة.
ولتحتل الصدارة، والمانشيت الأولى، والخبر الأول في المقروء والمرئي والمسموع…
ثمة سياسيّون وصحافيون ومحلّلون لم يترددوا في القول، وحتى التأكيد، إن ساعة “التغيير الكبير” والشامل، وربما المفاجئ، آتية لا ريب فيها. وفي حال حصوله اليوم، أو خلال فترة وجيزة، فإنه لن يقتصر حتماً على الرئيس مرسي وحكومته وحاشيته، بل سيشمل كل ما “زرعه” وبَذَره ونَشَره حكم “الاخوان المسلمين” وحلفائهم في المؤسسات، كما في النصوص والنفوس والأجواء وبين الناس.
وتالياً، وفي السياق ذاته، لن تتوقّف “حركة التغيير” هذه، وبكل مفاعيلها ومفاهيمها، عند حدود مصر، إنما ستنتقل سريعاً وباندفاع قوي، وتنقل عدواها الى العالم العربي بأسره.
وخصوصاً حيث مرّ “الربيع العربي” في بداية انطلاقته من تونس الخضراء، مروراً بليبيا واليمن. ومن يدري، فقد تتوغّل العدوى الى أبعد وأعمق.
ولن يكون مفاجئاً أبداً إذا ما شوهدت طلائع علامات “الثورة المصرية” وهي تقتحم أسوار الحرب الأهلية الطاحنة في سوريا، لتفرض نفسها ومفاهيمها وتداعياتها على الوضع السوري بكل فظاعاته ومآسيه ودماره.
من البديهي جداً وصول طراطيش مختلفة الى الربوع اللبنانية. وقد تكون لمصلحته… بلا علامة تعجّب.
النهار
ما هكذا يتم إسقاط مرسي
الياس حرفوش
بقدر ما هي الصورة واضحة في مصر لجهة الشرخ الكبير القائم بين أنصار الرئيس محمد مرسي ومعارضيه، هناك غموض كبير يحيط بالمخارج الممكنة من هذه الأزمة، التي هي من دون شك أقسى ما تواجهه الثورة المصرية بعد سنتين ونصف على إطاحة حسني مبارك.
وسبب الغموض أنه ليس هناك مخرج واضح يسمح بإنهاء الأزمة على خير، وبتجنب الحرب الأهلية التي كان الجيش صريحاً (ومحقاً) في التحذير منها. لا مطلب المعارضة بتنحي الرئيس وبإجراء انتخابات رئاسية مبكرة سيلقى تجاوباً من مرسي وأنصاره، ولا دعوة مرسي إلى الحوار مع المعارضة واعترافه (الذي تأخر كثيراً) بالأخطاء التي ارتكبها، سترد عليها المعارضة باليد المفتوحة، بعد أن رفعت سقف مطالبها وأصبح التراجع عنها سيرتب كلفة سياسية كبيرة.
وإذا كان يسجل لقيادات المعارضة المصرية أنها تخوض، من خلال احتشاد ملايينها في شوارع القاهرة وسائر مدن مصر وأنحائها، حملة تصحيحية لسلوك «الإخوان المسلمين» واستخدامهم الدين في الدفاع عن ممارساتهم، الذي بلغ حد تكفير خصومهم، فان المعارضة يجب أن تنتبه إلى أن ما تفتقر إليه حملتها هذه بشكل خاص وأساسي، هو الشرعية الدستورية، التي لا تسند مطلب تنحي رئيس منتخب بعد العام الأول من ولايته. وإلا لكان سلوك طريق احتجاجات الشارع للمطالبة بإسقاط الرؤساء أمراً طبيعياً في كثير من الأنظمة الديموقراطية، حيث يخسر الحاكم كثيراً من شعبيته بعد شهور أو سنوات على انتخابه.
لقد كان التخوف في البداية من أن الإسلاميين سوف يقطعون الطريق على التداول الديموقراطي السلمي للسلطة، إذا وصلوا إلى الحكم وأمسكوا به. ولذلك فليس في مصلحة المعارضة المصرية اليوم، وهي التي تدعو إلى حكم القانون والالتزام بالنظام العام، أن تبدو وكأنها هي التي تتجاهل الأحكام والموجبات التي يفرضها احترام الشرعية الدستورية، وعلى رأسها احترام المواعيد الدستورية لتبديل ولايات الحكام، وبخاصة إذا كان وصول هؤلاء قد تم بطريقة قانونية لم يشكك كثيرون، بمن فيهم معظم وجوه المعارضة، بسلامتها ونزاهتها.
وهذه هي النقطة التي التقطها مرسي في حديثه بالأمس إلى صحيفة «الغارديان» البريطانية عندما قال: إذا قمنا بتغيير شخص بالقوة بعد أن تولى منصبه بنتيجة الانتخاب حسب الشرعية الدستورية، سيقوم أشخاص ضد الرئيس الجديد أيضاً وسيطالبون بتنحيه بعد أسبوع أو شهر على انتخابه.
لهذا السبب يجب أن تنتبه المعارضة في تحركها الذي تخوضه الآن، والذي أخذ يقترب من الطابع العنفي من خلال هجمات بعض أنصارها على مقرات «الإخوان المسلمين» وإحراقها. فإظهار «الإخوان» وكأنهم ضحية انقلاب على السلطة، كما وصفه عصام العريان، يقدم لهم خدمة كبيرة لم يكونوا يحلمون بها، ويفقد المعارضة الحصانة القانونية والدستورية التي كانت تتحصن بها في عملها السياسي، وخصوصاً خلال مواجهتها لنظام حسني مبارك.
كما أن صورة الضحية سوف تساعد «الإخوان» في أي مواجهة انتخابية مقبلة، سواء على الرئاسة أو في الانتخابات البرلمانية، وسوف تحشد حولهم الكثيرين من مؤيديهم وربما من المستقلين أيضاً، الذي سوف يرون أنه تم إسقاط أول رئيس مدني منتخب في مصر تحت ضغط الشارع، بعد أن عجز المعارضون عن إسقاطه في صندوق الانتخاب.
لا أحب أن يفهم من كل هذا أنه دفاع عن الرئيس المصري، وقد انتقدت هذه الزاوية الكثير من قراراته في مناسبات مختلفة. لكنه دفاع عن القيم التي أعادت الثورة المصرية الاعتبار إليها، وأهمها استبعاد لغة الاستئصال من الخطاب السياسي واحترام آليات العملية الدستورية. من دون ذلك تصبح البلطجة هي الممارسة المقبولة، سواء كانت بلطجة «الإخوان» أو بلطجة خصومهم.
لقد أعلن مرسي الاعتراف بالأخطاء التي ارتكبها، ووعد بإعادة النظر في نصوص الدستور التي تشكل موضع جدل، ودعا المعارضة إلى المشاركة في الانتخابات النيابية، التي ستقرر الحجم الحقيقي للكتل السياسية وحقها في المشاركة في الحكم. ولعل هذه تكون بداية معقولة لإعادة إنتاج الثورة المصرية على أسس صحيحة، قبل أن تسقط في المجهول.
الحياة
الاخوان رفضوا الخريطة والسيناريو الجزائري غير مستبعد
عبد الباري عطوان
المهلة الاخيرة التي اعطاها الجيش للسلطة والمعارضة في مصر لإيجاد حل توافقي لإنهاء ‘حرب الميادين’، والحيلولة دون حدوث صدامات بالتالي، تنتهي اليوم ولا يوجد اي مؤشر بأن ايا من الاطراف المتصارعة مستعد للتجاوب معها.
المعارضة ادعت انها ضد هذه المبادرة، والدولة العسكرية بالتالي، ولكنها في بواطنها تنفجر فرحا، لان ‘خريطة الطريق التي سيعلنها الجيش اليوم، مثلما جاء في خطاب الفريق اول عبد الفتاح السيسي قائد الجيش ووزير الدفاع، ستحقق لها ما عجزت عنه، اي رحيل الرئيس محمد مرسي من السلطة.
حركة الاخوان المسلمين في المقابل وصفت تدخل الجيش في السياسة، وتوجيهه انذارات ووضع خرائط طريق بمثابة الانقلاب على السلطة المدنية الشرعية، وقررت التصدي لمنع هذا الانقلاب.
الرئيس مرسي قال ان اي انقلاب عسكري لن يمر الا على جثته، بينما دعا محمد البلتاجي احد صقور حركة الاخوان انصاره الى القتال حتى الشهادة لمنع اي انقلاب على الرئيس مرسي.
انه السيناريو الجزائري بكل تفاصيله، الذي استمر عشر سنوات وادى الى مقتل حوالى 200 الف انسان، بسبب خروج المؤسسة العسكرية من ثكناتها، واجهاض نتائج عملية انتخابية نزيهة كانت تؤشر الى فوز جبهة الانقاذ الاسلامية.الطرفان الجيش والاسلاميون احتكما الى السلاح فجاءت النتائج كارثية.
المقارنة بين مصر والجزائر قد لا تكون في محلها، فلكل بلد خصوصيته، وكل شعب له جيناته المختلفة، وظروفه الخاصة، وطبيعته الجغرافية والديموغرافية التي تشكل هويته، وتحكم طريقة رد فعله، ولكن العامل المشترك هو الانقلاب على نتائج حكم صناديق الاقتراع.
‘ ‘ ‘
ليس في تاريخ الجيش المصري القيام بانقلابات دموية، واستخدام السلاح ضد الشعب او خصومه على وجه الخصوص، وليس في تاريخ حركة الاخوان اللجوء الى العنف باستثناء محاولة اغتيال الرئيس الراحل جمال عبد الناصر الفاشلة في الاسكندرية. هذا لا يعني وجود بعض حوادث العنف المحدودة.
الجناح السلفي الجهادي المصري اقدم على استخدام السلاح، واغتال الرئيس محمد انور السادات، وهاجم سياحا في الاقصر والقاهرة، ولكن هذا الجناح كان معاديا للاخوان المسلمين ايضا، وقيادتها المتهمة بالتخاذل والخنوع لحكم الرئيس السادات وتوقيعه اتفاقات سلام مهينة لمصر وشعبها مع الاسرائيليين.
الرفض المسبق للتنحي من قبل الرئيس مرسي وفقا لخريطة الطريق التي قد تعلن اليوم، واستبداله بمجلس رئاسي بقــيادة رئيــــس المحكمة الدستورية العليا، وحل مجلس الشورى وتعطيل الدستور، يعني نزول الاخوان الى الشوارع احتجاجا على سلب سلطة منهم وصلوا اليها عبر الانتخابات.
خريطة الطريق التي جاءت من اجل انهاء حالة الفوضى وعدم الاستقرار وتوفير فرصة للخروج من الأزمة، واعادة هيبة الدولة والحيلولة دون انهيار مؤسساتها، قد تؤدي الى المزيد من الفوضى وربما الصدامات الدموية اذا لم تلتزم بها جميع الاطراف، وتحكم العقل والمنطق، وتقبل بالحفاظ على الخيار الديمقراطي واحترام حكم صناديق الاقتراع.
للمرة الألف نقول ان الرئيس مرسي ارتكب اخطاء كبيرة، سواء في تعاطيه مع الملف المصري الداخلي، او الملفات العربية، وابرزها الملفان السوري والفلسطيني، فقد كان لزاما عليه ان يقطع العلاقات مع اسرائيل وسورية في الوقت نفسه، وان يجعل الغاء اتفاقات كامب ديفيد او تعديلها في اضعف الاحوال على قمة اولوياته، ويطرد السفيرة الامريكية التي لم تتوقف مطلقا عن التدخل في الشؤون الداخلية المصرية كأنها ‘حاكم سام’ لمصر.
‘ ‘ ‘
جون كيري وزير الخارجية الامريكي اصبح، وبفضل هذا النهج، يلقي محاضرات على الرئيس مرسي ويطالبه بالاستماع الى صوت شعبه، اي مغادرة السلطة. فالشرعية الوحيدة التي يريدها كيري ورئيسه في مصر هي التي توفر الحماية لاسرائيل وتلتزم باتفاقات كامب ديفيد كاملة، وتنزع انياب المقاومة ومخالبها في قطاع غزة.
نتمنى ان لا تلجأ حــركة الاخوان المسلمين الى السلاح، ومصر مليئة بكميات كبيرة منه جاءت من ليبــــيا بفضل تدخــــل حلف الناتو، وان تتعاطى بحكمة وتعقل مع تطــــورات الأزمة المرعبــة، مثلما نتمنى على قيادة الجيش المصري ان لا تكون منحازة لطــرف ضد آخر في هــذه الأزمــة، وان تتعهد، اذا ما قررت انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة، وقبلت جمــيع الاطـــراف المتصارعة بها، ان تكون حكما، وان تقدم الضمانات الكافية لاحترام نتائجها.
انصار النظام السابق الذين مارسوا التحريض واعمال البلطجة طوال العامين الماضيين، واوصلوا البلاد الى الهاوية المؤسفة التي نراها في ابشع صورها حاليا يجب ان لا يفركوا ايديهم فرحا، وهذه مسؤولية الجيش، مثلما هي مسؤولية المعارضة وشباب حركة تمرد.
نتضرع الى الله ان يحمي مصر ويحفــــظها من المخططات التي تحاك ضدها لتمزيقها واغراقها في حرب اهلية دموية، وانهاك جيشها، فبعد تمزيق العراق وحلّ جيشه العظيم، واغراق سورية في حمام دم، لم يبق لنا كعرب غير مصر وجيشها، ويبدو ان الغرف السوداء المغلقة تريد تكرار السيناريو الجزائري لإيصال مصر الى النتائج المذكورة نفسها، او ما هو اخطر منها.
القدس العربي
انتفاضة مصرية ضد سياسة لا أخلاقية
د. وحيد عبد المجيد
لم يكن ممكناً أن يخرج ملايين المصريين لسحب الثقة من رئيس بعد عام واحد على انتخابه إلا لثقتهم، وآخرين كثر يؤيدونهم، في أن سلطة هذا الرئيس وجماعة «الإخوان» تفتقد الحد الأدنى من المقومات الأخلاقية الذي يتعذر أي إصلاح في غيابه. وهذا هو جوهر الأزمة التي أنتجت انتفاضة شعبية هائلة تجاوزت تلك التي حدثت في مطلع عام 2011، فكان التحدي الأخلاقي هو الأهم بين تحديات كثيرة عجزت قوى الإسلام السياسي، التي صعدت في بلاد عربية شهدت تغييراً في العامين الأخيرين، عن الاستجابة لها. فلم تقدّم هذه القوى نموذجاً يضفي طابعاً أخلاقياً على السياسة حين وصلت إلى السلطة، وأخفقت في الوفاء بما وعدت به طويلا حين ادعت أن تديين السياسة يجعلها أكثر أخلاقية.
وها هي التجربة تثبت أن السياسة التي لا يمكن أن تكون نظيفة دائماً إلا في المدينة الفاضلة (اليوتوبيا) تسيء إلى الدين الذي ينبغي أن يسمو به الجميع فوق ألعاب هذه السياسة وألاعيبها. لكن التجربة نفسها تثبت ما هو أبعد من ذلك حين تفشل قوى الإسلام السياسي، وخاصة جماعة «الإخوان» في مصر، في الاستجابة إلى تحدي الأخلاق.
فقد ثبت أن هذه القوى تضع مصالحها الضيقة فوق قيم الإسلام وكل مبادئ الخير والفضيلة، وأنها في حاجة ماسة إلى إضفاء إصلاح أخلاقي باعتباره لا بديل عنه إذا أرادت استعادة شيء من الثقة فيها. فالسلطة -أية سلطة- التي لا تحترم التزاماتها ولا تفي بوعودها وتنفض تعهداتها، إنما تعاني معضلة أخلاقية. فما بالنا إذا كانت القوى التي تدير هذه السلطة بنت شرعيتها وحصدت الكثير من الأصوات من خلال خطاب يقيم توجهاتها السياسية على أساس ديني، وليس فقط أخلاقياً، وعبر ادعاء أنها حارسة للأخلاق والفضيلة.
ولا يعني ذلك تعذر إضفاء طابع أخلاقي بدرجة أو بأخرى على العمل السياسي، أو استحالة أن يساهم الإسلام في تهذيب هذا العمل بشكل أو بآخر. لكن هذا الطابع الأخلاقي يتطلب إيماناً حقيقياً بصحيح الإسلام وإزالة ما لحق به من تشويه لأسباب في مقدمتها طريقة تعامل كثير من هذه القوى معه وتحويله إلى وسيلة لتحقيق مكاسب سياسية.
وفي تاريخ مصر الحديث ما يدل على ذلك، حيث ساهم الإسلام في إضفاء شيء من الأخلاق والقيم النبيلة على العمل السياسي والاجتماعي في بداية تطوره في عشرينيات وثلاثينيات القرن الماضي التي تعد أكثر فترات هذا التاريخ ازدهاراً.
فكان المفهوم السائد للإسلام وسطياً معتدلاً يقوم على روح الدين الحنيف الأصيلة، والتي كانت جزءاً من روح مصر في تلك الفترة على النحو الذي عبّر عنه الكاتب الكبير الراحل توفيق الحكيم في روايته المشهورة «عودة الروح» التي أصدرها عام 1933. فكان معظم المسلمين بل أغلبيتهم الساحقة يفهمون دينهم الحنيف باعتباره أساس الرحمة والمحبة والتسامح وارتباط الأفئدة وفقاً لما أجراه الحكيم على لسان أحد ركاب القطار المتجه من القاهرة إلى دمنهور.
وبدا ذلك واضحاً في الحوار الذي تخيّله الحكيم في أحد دواوين هذا القطار بمناسبة إفساح الركاب مكاناً لرجل ضخم الجسم لم يجد له مقعداً، وقول أحدهم: «تفضل يا حضرة، كلنا مسلمون نسع بعضنا»، الأمر الذي دفع راكباً آخر للحديث عن مناقب الإسلام التي يفتقدها الغرب حيث لا يهتم أحد بغيره. فكان أن تدخل راكب ثالث شارحاً أنه ليس للإسلام والمسيحية في مصر صبغة طائفية، وأن تقاليد المصريين جميعهم واحدة، وأن الإسلام يغذيها من منابعه الصافية حيث الرحمة والتسامح.
غير أن هذا المفهوم الرائق للإسلام تعكر نتيجة محاولة حركات وجماعات بدأت في الظهور في تلك الفترة احتكاره والاتجار به، الأمر الذي ساهم في إفقاد مصر روحها وأدى إلى عجز قوى الإسلام السياسي فيها -وفي تونس أيضاً- عن الاستجابة لتحدي الأخلاق في ممارستها السلطة التي باتت بين يديها. فقد انكشفت هذه القوى، وتبين أنه ليس هناك ما يميزها في ممارسة السلطة عن أكثر الأحزاب والحركات إيماناً بمنطق أن الغاية تبرر الوسيلة، الأمر الذي يثير الجدل الآن حول حاجتها إلى أصلاح أخلاقي لتصحيح سياساتها ولكي تستقيم مواقفها ومن أجل تهذيب أداء بعض رجالها وأنصارها وأتباعها.
وترتبط أولوية هذا الإصلاح، الذي تحتاج تلك القوى إلى مثله في مجالات أخرى، بما سبق أن تعهدت به عندما التزمت بانتهاج سياسة أخلاقية ونظيفة. واقترن ذلك التعهد بادعاء جماعة «الإخوان»، وأحزاب أخرى تدور في فلكها، أنها تقوم على مرجعية إسلامية، فانتظر من توسموا فيها خيراً سياسات عادلة وممارسات نظيفة لأن الأديان بما تنطوي عليه من فضيلة وخير وتسامح ومحبة هي أحد أهم مكونات الأخلاق.
لكن ما يحدث الآن غير ذلك بل عكسه. فقد وجد من انتظروا سياسات أخلاقية نظيفة ممارسات تستبيح بعض الأخلاق الإسلامية والفضائل الدينية الأساسية من أجل الهيمنة على السلطة والتمكن منها.
ولذلك يبدو الإصلاح الأخلاقي ضرورياً لتصحيح ممارسات وسياسات جماعة «الإخوان» في مصر، فضلاً عن تهذيب خطاب بعض قادتها بعد أن صار مثيراً لاشمئزاز كثيرين، ومنهم آخرون في تيارات الإسلام السياسي. فالاشمئزاز هو التعبير الذي استخدمه القيادي في حزب «النور»، نادر بكار، في تعليقه على أسلوب أحد الوزراء والألفاظ التي يستخدمها والإيحاءات التي ينطوي عليها. فلم يستطع بكار إلا أن يصف طريقته المتكررة في الرد على أسئلة الصحفيات بأنها «سوء أدب مقترن بفشله». وليست هذه حالة فريدة، وإن بدت أكثر وضوحاً وسط فيض من الخطاب الذي يعبّر عن هذه الحالة بأشكال مختلفة، منها ما حكم القضاء بأنه سب وقذف علني.
وإذا كان الخطاب الذي ينطوي على تجاوز يتطلب إصلاحاً أخلاقياً، فإساءة استخدام السلطة تجعل هذا الإصلاح أكثر إلحاحاً، لأنها تتعارض مع أي أساس أخلاقي للسياسة وتنطلق من «ميكافيلية» مفرطة تبرر أي وسيلة مهما بلغ فسادها طالما أنها تحقق الغاية المطلوبة.
وهكذا أخفقت جماعة «الإخوان» في الاستجابة إلى تحدي الأخلاق، رغم أن قادتها وأعضاءها قدموا أنفسهم لفترة طويلة كما لو أنهم حماة الأخلاق والمدافعون عنها قبل أن يتبين لمن صدقوهم مدى فقرهم في هذا المجال. فقد ظلوا على مدى عقود يزعمون السعي إلى بناء الإنسان الصالح أخلاقياً وروحياً، قبل انكشافهم حين لم يتمكنوا من تجنب شر السلطة ونقمتها على من لا يمتلك المناعة الكافية. فالسلطة مُفسدة لمن لا يستطيع مقاومة إغراءاتها وفي غياب منظومة رادعة لإساءة استخدامها. وعندئذ يصبح الإصلاح الأخلاقي ضرورة عاجلة وملحة.
الاتحاد
دور الجيش في أزمة مصر
عبد الرحمن الراشد
أستبعد أن نرى في مصر ما نراه في باكستان، جنرالات يقفزون على الحكم في كل أزمة. لن يحكم مصر جنرال آخر، وحتى الرؤساء السابقون، عبد الناصر والسادات ومبارك، عندما خرجوا من الثكنة انخرطوا في الحكم المدني. أما التجربة الباكستانية فقد غلبت عليها المؤسسة العسكرية التي تستمر إلى اليوم تحكم من خلف الستارة وأمامها.
كان بإمكان المشير محمد حسين طنطاوي، رئيس الجيش ووزير الدفاع عندما قامت الثورة، أن يطيل في عمر حكم مبارك وحمايته لبضعة أسابيع أو أشهر، وربما إجهاض الثورة، لكنه هو الذي قرأ الشارع المصري وقرر الاستجابة بإسقاط الرئيس وشكل مجلسا عسكريا للحكم. وبعدها بدا واضحا أن العسكر غير مهيئين، لم يملكوا خطة لإدارة الدولة، ولا مشروعا سياسيا للحكم. وجدوا أنفسهم هدفا وسط التراشق بين القوى السياسية، فاختاروا الهروب إلى الانتخابات حتى قبل أن يكتب الدستور الجديد، وسلموا الحكم لمرسي الذي فاز على رفيقهم المتقاعد الفريق أحمد شفيق.
أما لماذا قرأ «الإخوان» قدرة الجيش بطريقة خاطئة؟ اعتقدوا أنهم حيدوه، عندما عزلوا أقوى شخصيتين: المشير طنطاوي والفريق سامي عنان، ولأنهم هادنوه عندما وافقوا على عدم التعرض لميزانية الجيش ومميزاته.
«الإخوان» بدلا من التعامل مع الرئاسة على أنها تجربة جديدة على المصريين، مارسوا ما فعلته الرئاسات المصرية السابقة بالاستيلاء على مفاصل الدولة في عمليات سميت «الأخونة»، مما أفزع الأحزاب السياسية، وأقلق العسكر أن الدم قد يصل إلى الشارع.
ما الذي سيفعله العسكر، الذين يظهر أنهم يعانون من حساسية مبررة، حيث يخشون أن يتهموا بأنهم ينفذون انقلابا عسكريا؟ وعدوا بخارطة طريق للخروج من الأزمة، وهذا يعني أن عليهم أن يحددوا موعدا لانتخابات رئاسية جديدة، فالانتخابات المبكرة هي المفتاح الوحيد في يد العسكر للخروج من عنق الزجاجة؛ لأن الخلافات ستكبر لاحقا.
وفي تصوري أن المهمة الأصعب، والضرورية، إقناع القوى الإسلامية بالمشاركة في العملية السياسية وطمأنتهم بأنهم جزء من الحاضر والمستقبل المصري؛ لأن «الإخوان» قد يفضلون الطعن في شرعية أي مشروع جديد برفضه، رفض التعديلات الدستورية، ورفض الانتخابات المبكرة، ورفض الحكومة التي تنجبها، وهذه بالتأكيد ستجعل الانتقال عملية عسيرة. ولا بد أن الجميع يريدون الإسلاميين، إخوانا وسلفا، لأنهم أثبتوا أنهم رقم سياسي صعب تجاهله.
“الشرق الأوسط”
سيسي مصر لا أتاتورك تركيا!
طارق الحميد
يسألني أحد الزملاء: هل يكون الفريق عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع المصري، كمال أتاتورك الجديد بعد بيان القوات المسلحة الأخير بمصر؟ الإجابة: لا. ففي حال التزمت المؤسسة العسكرية المصرية ببيانها فإن وزير الدفاع المصري سيكون سيسي مصر، لا أتاتورك تركيا، والفارق كبير.
الفريق السيسي تحرك لحماية «الدولة» لا إطارها الآيديولوجي، انطلاقا من دور المؤسسة العسكرية «المرسوم لها في الفكر الديمقراطي الأصيل النابع من إرادة الشعب»، بحسب بيان قيادة القوات المسلحة المصرية. وكما أسلفنا ففي حال التزمت القوات المسلحة المصرية ببيانها فعليا فحينها نكون أمام نسخة عسكرية مصرية متطورة بشكل مختلف تماما عن نموذج عسكر تركيا، وحتى باكستان، وهذا ما سيكون له أثر إيجابي كبير على الجمهوريات العربية، وتحديدا دول الربيع العربي، وربما سيكون له تأثير حتى على جيش الأسد، وإن كان جيشا طائفيا. وعندما نقول إن المؤسسة العسكرية المصرية، بقيادة السيسي، قد قدمت نموذجا متطورا، فالحقيقة الماثلة أمامنا تقول إن عسكر مصر استفادوا من تجاربهم، وطوروا رؤيتهم، وعمقوا عقلانيتهم أكثر من الأحزاب المدنية، والجماعات الإسلامية، خصوصا أن بيان القوات المسلحة المصرية يتحدث عن أن المؤسسة العسكرية تنوي بعد المهلة المطروحة تقديم «خارطة مستقبل وإجراءات تشرف على تنفيذها، وبمشاركة جميع الأطياف والاتجاهات الوطنية المخلصة، بما فيها الشباب الذي كان ولا يزال مفجرا لثورته المجيدة.. ودون إقصاء أو استبعاد لأحد». أي أن العسكر، ورغم كل ما فعله «الإخوان المسلمون»، فإنهم يقرون بأنه لا إقصاء، لأن الدول لا تبنى أصلا بالإقصاء والتغول، وهذا ما لم يعه «الإخوان» بمصر.
والحقيقة أن بيان الفريق السيسي يعد أول خطاب سياسي حقيقي منذ اندلاع موجة الربيع العربي في كل تلك الدول، سواء كان خطاب نظام أو معارضة، حيث انطوى البيان العسكري على رؤية واضحة، والتزام صريح، ورسم مفصل للمبررات والدوافع، وحتى الإطار الشرعي للتحرك، خصوصا عندما قال البيان: «لقد عانى هذا الشعب الكريم ولم يجد من يرفق به أو يحنو عليه، وهو ما يلقي بعبء أخلاقي ونفسي على القوات المسلحة التي تجد لزاما أن يتوقف الجميع عن أي شيء بخلاف احتضان هذا الشعب الأبي الذي برهن على استعداده لتحقيق المستحيل إذا شعر بالإخلاص والتفاني من أجله».
وعليه، وحتى كتابة هذا المقال، فالواضح أمامنا أن المؤسسة العسكرية المصرية قد فتحت آفاقا سياسية للخروج ليس بمصر وإنما بكل المنطقة من هذا النفق المظلم، حيث إنه ولأول مرة نستمع لخطاب سياسي عقلاني حقيقي يثبت أننا أمام حالة جديدة اسمها سيسي مصر لا أتاتورك تركيا، لكن قد تتطور الأوضاع للأسوأ خصوصا إذا ما لم يتعقل «الإخوان المسلمون»، ويدركوا أن اللعبة قد انتهت، وأنهم في حفرة عميقة وليس من الحكمة مواصلة الحفر، وإلا أصبحت ورطتهم أكبر، ليس في مصر وحدها بل وفي كل المنطقة العربية.
الشرق الاوسط
مصر أعادت إلى الانتفاضة العربية الإصرار على الإصلاح والحرية
راغدة درغام
تنشّق «الربيع العربي» نسمة أحيته هذا الأسبوع بعدما صادره الاستبداد واحتكار السلطة ونزعة الاستفراد بالقرار وبالهوية. شكراً يا مصر لأنكِ أعدتِ الى الانتفاضة العربية الإصرار على رؤية الإصلاح والحرية ورفض الإملاء والتسلّط، بكل تمرد وعنفوان ومثابرة. عاد الإصلاح الى الواجهة كمطلب جدي. وعادت قوى العصرنة والحداثة لتبلغ قوى الرجعية الدينية وإقصاء الغير ان هذه معركة مصيرية على الدستور والحريات. والرسالة واضحة أيضاً في عنوانها الآخر – الى أولئك الذين تسرعوا في احتضان صعود الإسلاميين الى السلطة وفي تهميش وتحجيم العلمانيين والحداثيين والمدنيين – وعلى رأسهم الأميركيون. إنما هذا ليس نصراً للروس الذين عارضوا الإسلام السياسي في السلطة، ولا هو تأشيرة خروج للنظام في دمشق من أزمته بإعفاء وإعادة تأهيل له بلا محاسبة. وزمن المحاسبة في المنطقة العربية ما زال في مستهله. التمرد الذي نجح في مصر ماضٍ الى تونس لاستعادة زمام التغيير نحو الحداثة وإبلاغ حزب النهضة أنه بات مرفوضاً كحاكم متسلط. فلقد بدأ «الربيع العربي» في تونس ومصر كحركة تمرد ضد استبداد الأوتوقراطية، وها هي الثورة الثانية في مصر تسجّل حركة التمرد ضد الثيوقراطية، أي الحكومة الدينية. المعركة الطائفية مستمرة في سورية وتهدد لبنان، وهي بالتأكيد معركة ضد الراديكالية واستفراد حزب وعائلة بحكم البلاد. المرحلة الانتقالية في المنطقة العربية ما زالت هشّة ومهمة في آن، وهي في حاجة الى قيام مختلف المعنيين مباشرة وغير مباشرة بمراجعة نوعية لمساهمتهم فيها. الولايات المتحدة في طليعة المطالبين بإصلاح بعض من تصورها ومساهمتها، لا سيما عبر مصالحة ضرورية مع قوى الاعتدال التي عانت من استخفاف الإدارة الأميركية ومختلف القطاعات الفكرية والإعلامية بها. الأهم أن تُصلِحْ الإدارة الأميركية والكونغرس الأميركي افتراضهما الخاطئ بأن تحويل مصر – الإخوان الى الاتكالية على الأموال الأميركية سيحمي اتفاقية «كامب ديفيد» وسيجعل من الإخوان المسلمين في السلطة شريكاً طائعاً ينفذ الإملاء. مصر الاستقرار ومصر الآمنة في حاجة الى ضخ الأموال في مؤسساتها بمؤسساتية بالأموال الأميركية والأموال الخليجية على السواء. المؤسسة العسكرية في مصر أعادت اختراع نفسها – والأرجح بمساعدة أميركية وإرشاد أميركي إنما منذ اندلاع ثورة 25 يناير، وأثبت الجيش المصري مرات عدة أنه جيش الشعب. هذه فرصة للجيش لصياغة هيبة شديدة تتماشى مع متطلبات المرحلة الانتقالية الراهنة والآتية. وهذه مناسبة جيدة للذين راهنوا على «النموذج التركي» لإعادة النظر في تطبيق ذلك النموذج من الحكم الديني على المنطقة العربية. سقط النموذج في مصر. بل انه بدأ السقوط في تركيا أيضاً في الأسابيع الماضية. أما التغيير في الحكم في قطر التي موّلت صعود الإخوان المسلمين، فإنه موقع تساؤل بين الذين يقرأونه بداية لانحسار التوجه القديم والذين يقولون إنه بداية جديدة أكثر التزاماً بصعود الإسلاميين الى السلطة. الباقي، حتى الآن، هو الحكم الثيوقراطي في الجمهورية الإسلامية الإيرانية. فهو الذي أتى على منطقة الشرق الأوسط بالحكم الديني وتسلّطه. لكن الغرب والشرق معاً في مصالحة وتهادنية مع حكم الملالي في تجاهل أميركي وأوروبي لكل تجاوزات طهران وفي تظاهر روسيا بأن صعود الإسلاميين الى السلطة أمر سنّي لا يخص حليفتها إيران.
كثيرة هي أخطاء الرئيس المصري محمد مرسي الذي عُزِل بقرار الشعب والجيش هذا الأسبوع، تحكّم بازدراء للشعب المصري واعتبار احتجاجه عابراً مستخدماً وجماعته في «الإخوان المسلمين» تعابير التحقير له مستهتراً بقدراته. صادر وجماعته ثورة 25 يناير في أعقاب انتخابات متسرعة وخاطئة أساساً لأنه كان يجب إجراء انتخابات برلمانية والاتفاق على الدستور قبل الانتخابات الرئاسية. لم يحدث ذلك نتيجة قرارات محلية وإقليمية ودولية. فافترض مرسي وجماعته أن هذه «فيزا» أميركية للتفرد والاستفراد، طالما عقد صفقة عدم المسّ باتفاقية الصلح مع إسرائيل، كامب ديفيد، التي تشكّل أولوية أميركية.
عكف الإخوان المسلمون على احتلال كل مفاصل الحكم، بجشع وغطرسة. واعتبروا الانتخابات آخر محطة للديموقراطية وليس أوّلها. عقدوا العزم على الاستيلاء على السلطة والتحكم بها بإقصاء كامل لغيرهم. حرّضوا وخوّفوا وهدّدوا واقتنعوا أنهم فوق المحاسبة. اعتقدوا أن أميركا باقية حليفاً دائماً لهم بسبب استخفافها وتحجيمها للعلمانيين والمعتدلين. زعموا أنهم انبثقوا من القاعدة الشعبية التي بنوا معها قنوات وشبكات عندما كانوا خارج السلطة لكنهم سرعان ما تصرفوا بتعال عن الشعب ومطالبه بعدما أخذوا السلطة.
وفشلوا. فشل الإخوان المسلمون ورئيسهم مرسي اقتصادياً كما سياسياً كما اجتماعياً. اغضبوا حتى الذين صوتوا معهم نكاية بالماضي وبالرئيس السابق حسني مبارك، ثم ثاروا عندما لمسوا أن ما أراده الإخوان المسلمون هو الحكم الدائم ذاته الذي ثاروا ضده بثورتهم ضد مبارك.
إقليمياً فشلوا مع دول الخليج كما داخل سورية. بدوا وكأنهم يدعمون التطرّف المسلّح داخل سورية لغايات «إخونجية» وليس دعماً للمعارضة السورية ضد النظام والاستبداد. المكابرة والمغالاة والغطرسة اختطفت نزعاتهم، ففقدوا حس الحكمة والحكم الحكيم. لم يملكوا رادار الشعب.
الفصل الثاني من انتفاضة مصر في 3 تموز (يوليو) 2013 سجّل للشعب المصري رفضه التهميش وقدرته على التنظيم وحشد الملايين وراء «ارحل». شاء الشعب للرئيس الذي خيّب أملهم وتوقعاتهم أن يرحل، فرفض وراهن على وهن الشعب والجيش معاً. قال الشعب للإخوان المسلمين إنه لا يريد حكماً دينياً ولا دستوراً دينياً ولا إملاء دينياً على نوعية الحياة المدنية. لم يقل الشعب إنه ليس متديناً أو إنه ضد الدين. قال إنه مصرّ على فصل الدين عن الدولة. انتصر الشعب وعزل الرئيس مرسي الذي عاند كما عاند الرئيس مبارك. فقال الشعب «ارحل». قال إنه يرفض كل من لديه العطش للاحتكار والاستفراد والتسلط في السلطة. قال «ارحل».
ما حدث في مصر سيحدث في تونس وفي ليبيا وفي سورية وفي العراق وفي لبنان وفي الدول الخليجية إذا ما استبدّ الحكام. رسالة مصر الرائدة للعرب هي أن الشعب لا يريد إقحام الدين على الدولة. إنها صرخة الحرية والحداثة التي ستدوي في كل المنطقة العربية لأن حنجرة مصر أطلقتها.
سيخشى البعض من انقسام داخل مصر قد يقود الى حرب أهلية، وهذه خشية ليست من دون مبرر. فالإخوان المسلمون غاضبون وعازمون على استرجاع السلطة، وقد يلجأون الى العنف وإلى زرع بذور الانتقام. إنما الأرجح ألاّ تسقط مصر في دوامة حرب أهلية. ميدان التحرير كان مليئاً بكل أنواع الناس من الصبايا المحجبات الى كبار السن وليس فقط الشباب. وهذه حصانة.
الجيش هو الحصانة الأهم إذا ثابر في «خريطة الطريق» التي أعلنها بعدما جمع الأزهر والكنيسة والفعاليات المدنية وحشدها وراء العملية الديموقراطية – دستوراً وانتخابات. الجيش تصرف بكل حزم وجدية ولم يتلكأ عندما تحداه مرسي الى المبارزة. الجيش رفع العلم المصري سلاحاً وشعاراً شأنه شأن المتظاهرين في ميدان التحرير ومختلف أنحاء مصر ليقول: أنا جيش الشعب ولست جيش الأنظمة.
لم يقل أحد من القيادات العسكرية والدينية والمدنية إنه يريد إقصاء الإخوان المسلمين عن العملية الديموقراطية وعن الحكم عبر الوسائل الديموقراطية وبضمانات ديموقراطية وللدستور الديموقراطي ولفصل الدين عن الدولة. تحدثوا بلغة المصالحة الوطنية والتسامح مع النفس والغير. شددوا على ضرورة أن تكون المرحلة الانتقالية برعاية الجيش سليمة وسريعة. أكدوا حكومة الكفاءات التي تجمع الأجيال وتضع مصر على طريق التعافي.
إذا تعافت مصر، تعافت المنطقة العربية. الشعب المصري أعاد بعض الاحترام للربيع العربي الذي تناثر على رياح اقتناصه على أيادي الإخوان المسلمين بدعم متعدد المصادر والجهات. الانتفاضة في تركيا أوقفت قطار رئيس الحكومة رجب طيب أردوغان الذي ظن أنه وضع سكّة انطلاقة حكم الإخوان المسلمين في كامل المنطقة العربية انطلاقاً من المحطة المصرية الفائقة الأهمية.
ما يجدر بإدارة أوباما أن تقوم به الآن هو إصلاح كامل العلاقة مع مصر، بالذات عبر ضخ الأموال الضرورية لإنقاذ الاقتصاد. ليس كافياً أن تكون واشنطن وافقت ضمناً أو دعمت فعلاً ما قام به الجيش في مصر – رغبة منها أو اضطراراً. مصر في حاجة الى عملية إنقاذ ضخمة لاقتصادها. واشنطن قادرة على التأثير في المؤسسات المالية الدولية وكذلك في الدول العربية القادرة على ضخ هذه الأموال. أي تلكؤ في هذا الأمر سيرتد على الجميع.
هذه لحظة احتفاء بشعب قيل إنه خضع لعملية تدجين قضمت ظهره أثناء حكم دام ثلاثين سنة. هذه دقيقة تأمّل في قدرات شعب خلع رئيسه مرتين في غضون سنة. هذه ساعة مفترق في المنطقة العربية لأن مصر تتأهب للقيادة مجدداً. فليفكر الذين يعتقدون أن الحدث المصري الذي سجّل انحسار الحكم الديني شهادة لهم باستمرار الحكم الاستبدادي. فلا الأوتوقراطية ولا الثيوقراطية ولا الراديكالية باقية. إنه زمن التمرد على الاستبداد واحتكار السلطة والاستفراد بالبلاد بإقصاء للآخرين. فلنفرح اليوم لأن المسيرة معقدة وصعبة وطويلة.
الحياة
مصر والفشل الثلاثي لـ”الإخوان المسلمين“
[إفتتاحية صحيفة “لوموند”
الفرنسية (30 حزيران 2013)
تعيش مصر، أكبر بلد عربي، ساعات صعبة وربما حاسمة لمستقبل الديموقراطية. في شوارع القاهرة الآن وفي المدن المصرية الأخرى يسود مناخ من المواجهة، مناخ حرب أهلية مقبلة. وخلاصة هذا الصراع ان مصر “العلمانية” التي دعت للتظاهر يوم الاحد 30 حزيران، تحتج على “مصر الاخوان المسلمين”. الى حدّ ان الجيش الذي نشر قواته حول المباني الحكومية يهدد بالتدخل “لوقف هذا التصاعد الذي يجرّ البلاد الى صراع لا يمكن السيطرة عليه”.
محمد مرسي، أول مدني في تاريخ مصر ينتخب رئيساً لها، آت من الاخوان المسلمين، يحتفل اليوم (30 حزيران) بميلاده الاول في موقع الرئاسة في جو قاتم مكفهر. فبعد عام تماماً من تنصيبه في موقعه، ها هو يقدم جردة حساب كارثية.
فشل سياسي أولاً. لقد كان محمد مرسي عاجزاً عن القيام بخطوة، أو أن يجد الكلمات، أو أن يبدي أي موهبة ضرورية تخوّله تجميع الناس حوله، غير ما عرف عن حشده لجماهير الاخوان المسلمين.
أنصار مرسي لا ينفكون يرددون بأن المعارضة العلمانية رفضت مقترحات الانفتاح التي تقدم بها الرئيس؛ ولكن الواقع هو ان الرئيس بدى دائماً متردداً، عاجزا عن الإمساك بأي منعطف، ناهيك عن المبادرة اليه. هو استاذ الهندسة أعطى الإنطباع بأنه لا يتمتع بالمؤهلات القيادية اللازمة التي تسمح له بقيادة البلاد.
فشل اقتصادي واجتماعي بعد ذلك: وهو فشل شعر به المصريون بقوة بقدر ما كانوا يتأملون بأن تغيير النظام سوف يحسّن أوضاعهم جذرياً. فبالنسبة للغالبية العظمى منهم، الهمّ المعيشي هو الأساس. الوضع الإقتصادي المنهك هو انعكاس لوضع سياسي تسوده الفوضى. والفشل المترتّب عليه هو دليل على غياب أية خطة إقتصادية لدى الاخوان وعلى عدم تمتعهم بمهارات إدارية وفنية. ولم يظهر انهم يملكون سرّ طريقتهم الاقتصادية التي تمزج بين المحافظة الدينية والحداثة الاقتصادية.
هكذا تشكل ائتلاف عريض مناهض للاخوان، يجمع أساساً المعسكر العلماني، زائد بعض الناقمين من أبناء نظام مبارك؛ وهو ائتلاف بوسعه ان يستثمر في اليأس الذي نال من قسم هام من المصريين. فنجحت حملة توقيعات ذيلها ملايين من المصريين، تطالب باستقالة محمد مرسي وباجراء انتخابات رئاسية مبكرة.
ان هذا الائتلاف المعارض الشديد التنوّع لا يبدو انه بدوره يملك برنامجا مشتركا يحاكي المستقبل، سواء من الناحية الاقتصادية أو السياسية. ما يجمع كل مكونات هذه المعارضة هو عداؤها لمحمد مرسي والخشية من أن يجرّ مصر نحو الأصولية الاسلامية. الرئيس مرسي بدوره رأى بأن شرعيته مهددة من الشارع؛ لذلك صار التشنج عنوان مواقفه كلها تجاه المعارضة العلمانية. فكانت له أسوأ ردود الأفعال، بأن قرر الإستناد الى أكثر الاجنحة تطرفاً في تياره الاسلامي الموالي له، بمعظمه.
هكذا تمكن مرسي من تأجيج مناخ المواجهة وجرّ الجيش الى التهديد بالتدخل. والجيش، وهو ثالث الأفرقاء في هذا الصراع، يتحمل بدوره قسطاً وافراً من المسؤولية. فهو الذي أخذ بزمام البلاد بعد سقوط مبارك لمدة الثمانية عشر شهرا التالية عليه، وكانت إدارته للبلاد خلالها كارثية.
مثالياً، الفريقان اللذان يربطهما العداء للنظام القديم يجب عليهما ان يتحاورا. وعليهما ان يستمدا من نهر النيل الحكمة المطلوبة لإدارة هذا البلد القديم.
المستقبل
مصر: بعد الاحتفال… الأسئلة
حسام عيتاني
يتحدى الحراك المصري أي نظر نمطي أحادي. لا يحيط به تعريف جاهز ولا ينصفه نعت سهل. ففيه تجتمع صفات الثورة الشعبية والانقلاب العسكري ويقابله انقسام عربي ودولي بين مؤيد وشاجب.
ارتكز اعتراض جماعة «الإخوان المسلمين» على الإطاحة بالرئيس محمد مرسي على مبدأ الشرعية. فالرجل جاء بعد انتخابات أيده فيها 51.5 في المئة من الناخبين، ولم يشكك في نتائجها احد. وهو المسؤول المنتخب الوحيد في مصر بعدما أسقط القضاء شرعية الهيئة التشريعية بمجلسيها (طعن القضاء في شرعية مجلس الشورى قبل أيام قليلة من تظاهرات 30 يونيو). عليه، لا مجال لنفي الشرعية عن حكم مرسي، وهذا لا غيره (على ما يتوهم أنصار نظرية المؤامرة)، مصدر تأييد الغرب له.
الشرعية التي حوّلها مرسي بتلعثمه وهزال منطقه إلى سخرية، حمّالة أوجه. فثمة فارق كبير بين شرعية المسؤول المنتخب وبين كفاءة الأداء في المنصب التي يستمر التفويض الانتخابي وفقاً لها. وليست نادرة الحالات التي أسقطت فيها انتفاضات شعبية رؤساء منتخبين وشرعيين، بسبب انعدام كفاءة يظهر عادة على شكل عجز عن معالجة الأزمات الاقتصادية والاجتماعية. وحركة «تمرد» انطلقت من هذه المنطقة الفاصلة بين الشرعية وديمومة التفويض، بتعميمها فكرة سحب ثقة الشارع من الرئيس.
الديموقراطية نقطة مهمة ثانية إلى جانب مرسي. فالرئيس، ومن ورائه «الإخوان المسلمون» وصلوا إلى الحكم في عملية ديموقراطية مفتوحة. بل إن «الإخوان» انتصروا في كل عملية اقتراع جرت في مصر منذ إطاحة نظام حسني مبارك. ففازوا في الاستفتاء على التعديلات الدستورية في آذار (مارس) 2011، وفي انتخابات مجلسي الشعب والشورى وفي الانتخابات الرئاسية. الحديث عن تزوير وضغوط واستخدام المغريات لتحقيق «الإخوان» انتصاراتهم لا قيمة له. كانت الساحة مفتوحة امام كل القوى وكان في وسع الجميع الاستفادة من كل الوسائل المتاحة، في ظل حال السيولة التي كانت تعيشها اجهزة الرقابة المصرية. وليس ذنب «الإخوان» وحزب الحرية والعدالة الذي أسسوه انهم نجحوا في مجالات الحشد والتنظيم والتعبئة فيما فشل الآخرون.
رغم ذلك، اساء مرسي تفسير مبدأي الشرعية والديموقراطية. لقد حالت رغبة الجماعة في السيطرة على مفاصل الدولة دون تشكل آليات توازن ديموقراطية وانطلاق عملية «التحقق والتوازن» بين السلطات. وجاءت محاولة الهيمنة على الدولة برمتها في الإعلان الدستوري الملحق في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، لتقول ان الديموقراطية في خطر شديد. ثم أقر الدستور في ما يشبه عملية التهريب رغم الاستفتاء الذي وافق فيه 63.8 في المئة من المشاركين، على اقراره في كانون الأول (ديسمبر) الماضي، حاملاً العديد من الثغرات خصوصاً في مجالات الحريات الفردية والمساواة بين المواطنين وحقوق الأقليات، اضافة الى تجاهل شبه تام لمسألة العدالة الاجتماعية.
الأهم أن رفض العمل بمبدأ توازن السلطات وانفصالها عن بعضها، واختفاء اي دور واقعي للمؤسسة التشريعية، ترك «السلطة الرابعة» في موقف شديد العداء لحكومة «الإخوان» بقيادة شخصية متخبطة وضعيفة هي هشام قنديل. ظهر الإعلام كعاصفة هوجاء اجتاحت مركب مرسي وقنديل، وتركته حطاماً لا نفع فيه. وما كان لظاهرة مقدم «البرنامج» باسم يوسف ان تنمو بهذا الشكل الهرقلي لو لم يوفر لها مرسي وقنديل ووسائل إعلام الحركات الإسلامية كل عوامل النجاح. من جهة ثانية، بدا ان الجيش لا حاضن سياسياً له في وقت يسيطر على ما يتراوح بين ثلاثين وأربعين في المئة من الاقتصاد المصري، وعلى موارد هائلة. ومفهوم أن يغري هذا الوضع المؤسسة العسكرية بالبحث عن حلفاء يضمنون مصالحها في ظل انعدام الود المتبادل بينها وبين «الإخوان».
اجتمعت هنا تناقضات شكلت الجبهة التي اطاحت حكم مرسي و «الإخوان»: من حزب النور والدعوة السلفية الى اليسار والليبراليين وجبهة الإنقاذ وبقايا الحزب الوطني المنحل. وجاءت ذكرى انتخاب مرسي لتصوغ فرصة تعبير هذه القوى عن رفضها لنهج «الإخوان» بجملته وبتفاصيله، من اخفاقاته الاقتصادية والاجــــتماعية الى غطـــرسة مرشده وبنهمه الاستـئثاري وبارتباك سياساته الخارجية.
يبدو هنا ما جرى في الثالث من تموز (يوليو) مزيجاً من انقلاب عسكري ومن ثورة شعبية. من علامات الانقلاب ان القوات المسلحة أرغمت رئيساً منتخباً على التنحي عن السلطة وباشرت حملة اعتقالات لمعارضي خطوتها، وإغلاق وسائلهم الإعلامية. لكنه انقلاب ناقص لأسباب منها أن الجيش امتنع عن الإمساك بالسلطة إمساكاً مباشراً، ولو على طريقة المجلس العسكري الذي جاء بعد خلع مبارك، ولوجود آلية رقابة مرتجلة (وقد تظهر الأيام انها غير مؤثرة) متمثلة بملايين المواطنين المصريين الذين اعلنوا – بتوقيعهم عرائض «تمرد» وبمشاركتهم في التظاهرات التي اكتسحت الساحات – رفضهم لإكمال مرسي مدته الرئاسية، اضافة الى حضور الهيئات السياسية التي وافقت على تحرك الجيش.
أما الثورة فحفلت بمظاهر الرفض والغضب حيال كل ما حمله حكم «الإخوان المسلمين» من رموز وخطاب. ولعل الولع الرومانسي بالثورات وحالات النشوة التي تتركها صور الحشود الهادرة تساعد على نسيان حقيقة بسيطة تقول ان تكرار الثورات يشير عملياً الى عمق الصدع المجتمعي. وليس عديم الدلالة ان يقف اليساريون الى جانب انصار مبارك للإطاحة بمرسي برعاية الجيش. فهذا يقول، على الأقل، ان المصالح التي حملت الجانبين على القبول بعودة الجيش الى اداء دور حاسم في انهاء حكم فاشل، عاجزة عن التحقق إذا تُركت تسير وحدها في طريق ديموقراطي ناجز، من دون الاتكاء على ذراع الجيش.
الحياة
فخّ الثورات ودرسها
سامر فرنجيّة
هناك قراءتان للحدث المصري الأخير، الأولى مرتبطة بسياق الثورات العربية وفكرها، والثانية بالوضع المصري وسياسته. فبغضّ النظر عن النتائج السياسية المباشرة التي أدّت إليها «مليونيات» مصر الأخيرة وطبيعة المسار السياسي – العسكري الذي سيليها، هناك نتيجة واحدة يبدو أن لا تراجع عنها، وهي أنّ استعادة الثورة المصرية ميادينها قضت على مقولة «حتمية» الإسلام السياسي في المنطقة. هذه المقولة التي تشارَك داعمو التيار الإسلامي ومعارضوه في إنشائها وتثبيتها، اعتبرت أن الإسلام السياسي «حقيقة» تلك المنطقة وتمثيلها السياسي الوحيد. غير أنّ «٣٠ يونيو» أسقط تلك المقولة، وحوّل محمد مرسي من كونه نتيجة حتمية لهذا الاحتكار إلى مجرّد «رئيس الـ52 في المئة»، وهذا في أفضل الأحوال.
جاء سقوط مرسي بفعل تظاهرات شعبية، التحق بها سريعاً الجيش المصري، وتمّ من خلال «تطبيعه»، أي سحب هواجس الخيار الإسلامي والهالة التي نُسِجت حوله. فقد شكّل صعود الإسلاميين بعد الثورات مادة دسمة لبناء مقولات حول العالم العربي، تحوّلت سريعاً إلى نوع من الهستيريا الجماعية تداخل فيه خوف العلمانيين مع رعب الأقليات وجنون الممانعين، لتصبح حقيقة المنطقة ملخّصة في الإسلام السياسي. وكان لهذه الرواية تاريخ طويل، يعود إلى ما قبل الثورات العربية، رأى في خيار الإسلام السياسي وعداً لم يطبق لحل مسألة الشرعية السياسية في المنطقة. أمّا من منظار ما بعد «٣٠ يونيو»، فيبدو أنّ هذا الخوف وأسطورته يشرفان على نهايتهما، مع صعود نقد عميق وشعبي وشرعي وغير مسبوق لحكم الإسلاميين.
لكن ما سقط أيضاً مع انتهاء صلاحية مقولة «الإسلام السياسي» هو كل المحاولات التي بُذِلت منذ انطلاق الثورات لتلخيصها في مقولة نمطية، «حتمية إسلامية» كانت أو «حتمية ليبرالية» كما أشار وسام سعادة في صحيفة «المستقبل» (٣ – ٧ – ٢٠١٣). فسقوط «الحتمية الإسلامية» جاء بعد سقوط المقولة الممانعة في أوائل الثورات، بخاصة بعد وصولها إلى سورية، و «المقولة الليبرالية» رافقت انطلاق الثورات لتسقط مع أول انتخابات ديموقراطية. ومن المتوقّع أن تسقط أية محاولة جديدة قد تُحاك اليوم حول الحراك المصري، من مقولة المواجهة بين العلمنة والإسلام إلى رواية الثورة والثورة المضادة.
نقول «قد» و «ربمّا» و «بصرف النظر عن»، لأنّ لسقوط مقولة حتمية الإسلام السياسي، وما حملته من هواجس وانتظارات، دلالة على استحالة تلخيص الحراك السياسي الذي بدأ قبل سنتين بتفسير جاهز. فالطابع الموقت للتقويمات يعود إلى ميزة أساسية للثورات العربية، حاول كثرٌ إغفالها إمّا من باب التمسّك بنظريات أو مقولات بائتة أو من باب الخوف والملل، وهي أنّها «حدث»، له تاريخ يحدّده ويحوط به، لكنّه مفتوح الأفق. فهي، بهذا المعنى، ليست مجرّد استكمال لسيرورات حاضرة، بل نهاية لمرحلة. وطابعها كنهاية جعلها محرقة للخطابات التي حاولت منذ انطلاقتها أنّ تلخّصها بنتيجة ما، أو تدخلها في اصطفاف قائم، أو تجعلها تأكيداً لروايات سياسية قائمة. هذا هو فخ الثورات، وقد سقطنا جميعاً فيه.
هذا على صعيد الثورات العربية، فالخط الذي يصل المليونيات الشعبية بتطبيع الإسلام السياسي وينتهي بالقضاء على الحتميات، إنجاز تاريخي قدّمه شباب مصر للعالم العربي بأكمله. ويُرجّح أن تكون لهذا الإنجاز ارتدادات عربية، خصوصاً مع تصاعد الانتقاد لحكم «النهضة» في تونس وبداية تبلور نقد داخل الثورة السورية لانتهاكات بعض الفصائل الإسلامية، ما قد يحررها من هاجس الإسلام السياسي. قد تكون الثورات العربية خرجت من الجوامع ولكن يبدو أنّها لن ترجع إليها حتماً.
لكن هناك قراءة ثانية يمكن استنتاجها من هذا الحدث. فإذا سقط الإسلام السياسي على يد الجماهير، سقطت جماعة «الإخوان المسلمين» على يد الجيش وانقلابه الذي من غير الواضح هل سيكون موقتاً. قد يكون إغلاق بعض وسائل الإعلام جزءاً من «ميثاق الشرف الإعلامي» الذي وعد به الفريق السيسي، واعتقال بعض قيادات «الإخوان» تمهيداً لإشراكهم في «اللجنة العليا للمصالحة الوطنية»، غير أنّ هناك ارتياباً بأنّ يكون ذلك مدخلاً لإعادة التجربة الجزائرية السوداء. فالجيش التحق بمطالب الشعب، وهناك حدود لقدرته على السيطرة السياسية، لكنّه ما زال خطراً أساسياً على السيرورة الديموقراطية في منطقة عانت منذ نصف قرن سيطرة الجيوش، لا سيطرة الإسلاميين.
كما أنّ سقوط حتمية الإسلام السياسي لا يعني خروج «الإخوان المسلمين» من السياسة في مصر. فهم ما زالوا يمثّلون شريحة واسعة من الشعب المصري، وربّما اللاعب الأساسي في أية انتخابات مقبلة. فكان مرسي «أول رئيس مدني ومنتخب» وكسب حزبه ثلاث انتخابات خلال أقلّ من سنتين. هذا لا يعني أن لا حق للشعب في إطاحته، لكن المقصود مجرّد تنبيه إلى أنّ مرسي ليس مبارك جديداً، وأن أُسس دعمه محصورة في جهاز دولة أو بعض مرتزقة وبلطجية. لقد فشل «الإخوان» وفقدوا هالتهم وانتهت حتميتهم، لكنهم ما زالوا قوى سياسية أساسية.
غير أنّ الخط الذي يصل العسكر بالانقلاب على «الإخوان» وينتهي بانقلاب ليس حتمياً. فإذا كان هناك درس من «٣٠ يونيو» فهو أنّ الثورات العربية لن تلخص بتفسير أو نظرية إلا عند انتهائها كحدث وإعادة انضوائها في التاريخ. سقوط الإسلام السياسي بات حتمياً، أما الانقلاب فما زال خطراً، وليس قدراً. وإحدى طرق مواجـهته في عدم أبلسة «الإخوان» وإعادتهم إلى مرتبة الهاجس بعد أنّ تمّ تطبيعهم.
قد لا تكون الثورات العربية استقرّت بعد على نظام سياسي يرضي من بدأ يعاني من ملل ثوري، أو أنتجت نظرية كاملة متكاملة تشفي غليل من يحاسبها بتجرّد وتسرّع. غير أنّها من خلال سلبيتها وإيقاعها المتقلّب باتت تفرض نمطاً للكتابة عنها، عليه قدر الإمكان احترام طبيعتها كحدث. وهذا الأسلوب هو نمط من الكتابة الهشة أو التجريبية التي تدرك أنّها مهما حاولت الإمساك بالواقع، ستبقى متأخرة عنه وجزئية وموقتة ومنحازة. هشاشة الكتابة، بهذا المعنى، احترام للواقع، وقد يكون درس الثورات العربية، وإنجاز «٣٠ يونيو»، ضخّا بعض التواضع في الكتابة، ريثما يعود التاريخ.
الحياة
الوضع المصري لا يُقرأ بـ”الحتمية الإسلامية” ولا بـ”الحتمية الليبرالية“
وسام سعادة
ستبقى خطوة قطع العلاقات الديبلوماسية مع النظام السوريّ نقطة تحتسب للرئيس محمد مرسي، بصرف النظر عن تأثيرها المتواضع، وكونها اتّخذت بالتحديد عشية اتّساع نطاق الانتفاضة الجماهيرية المصرية الهادفة إلى تنحية الرئيس الإخوانيّ بعد عام واحد على انتخابه، بما من شأنه زجّ هكذا خطوة في معمعان الانقسام الأهليّ المصريّ الحاد، وهو انقسام يستدعي من قوى الثورة السوريّة أن تُحاسب هي الأخرى فتبقى خارجه، ملتزمة الدعم العام لمسار ثورة الشعب المصريّ، ومتفادية الانزلاق إلى أي رهان خاطئ، متخذة العبرة من الرهان الخاطئ الذي وقع فيه الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات ومنظمة التحرير بدعمهما صدّام حسين بعد اجتياحه الكويت، وهو رهان أضرّ كثيراً بالقضية الفلسطينية بداية التسعينات، وأخلّ بموقع الفلسطينيين التفاوضي بشكل رهيب في بداية عملية السلام.
أمّا إذا كان لا بدّ من تسجيل “إنجازات” لمرسي، فهما “إنجازان” اثنان: إحالته المشير حسين طنطاوي والفريق سامي العنان إلى التقاعد بعدَ وقت قصير على انتخابه، وطريقة تعامله الموزونة مع الحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة. لكنّ المؤسف حقاً أنّ حُكْم الإخوان سارعَ إلى صرف هذين الرصيدين في الداخل، بسرعة مذهلة، وبسذاجة رعناء، وبروحية استئثارية استنزفت نفسها بنفسها في المواجهة المفتوحة مع “المتن المدنيّ” للثورة المصريّة، ومع الصحافة والتلفزيون، ومع “الدولة العميقة”، بدءاً من القضاء المصري، ومع المؤسسة الأزهريّة، ومع الكنيسة القبطية، وكلّ ذلك من دون أن تؤمّن الجماعة الإخوانية نفسها على رأس جهاز دولة ليس منها وليست منه، بما جعلها عاجزة تماماً عن قمع الحركة الشعبية المضادة كونها لا تستطيع أن تواجه هذه الحركة بجهاز الشرطة وبفتيان الجماعة في وقت واحد.
وما لا شكّ فيه أنّ ضعف المقاربة النظرية لطبيعة جهاز الدولة ومؤسساتها لم يكن يؤهّل الإخوان لسياسة داخليّة أكثر رزانة وإحاطة، فهذه المقاربة تستدعي إعمال مرجعيات فكرية من خارج خطاب الحركات الإسلاميّة. إلا أنّ المشكلة أكبر كون الإخوان ارتكبوا أيضاً الخطأ الذي نهض فكر الحركة الإسلاميّة المعاصرة على قاعدة التنبيه عليه والتحذير منه، وهو خطأ جعل “الانتخاب” لحظة تأسيسية مطلقة، فاعتبروا أنّ واقعة انتخاب مرسي وكونه أوّل رئيس منتخب لمصر من طريق الاقتراع العام تجعله حرّاً في سلق الدستور وفرضه بشكل همايونيّ، إلى أن وصلنا إلى ما وصلنا إليه من حالة انفجار جماهيري بركاني تطالب بتنحية الرئيس.
وهذا الجموح السياسي الإخوانيّ الفاقد لشروطه كان يسبح في مشكلة ثقافية أكبر، ذلك أنّ من أهم أسباب عثرة الإخوان السياسية في تجربة حكمهم المهدّدة بالسقوط المدويّ الآن، أنّ المجتمع المصري سادت فيه بالفعل أنماط من التديّن التزمّتي الاستهلاكيّ في العقود الأخيرة، بحيث إنّ هذا المجتمع أنجز أكثر ما كان يطلبه “الإخوان المسلمون” منه، معهم أو مع غيرهم، وقبل سقوط نظام حسني مبارك. وهكذا، فإن الملايين التي خرجت ضدّ مرسي هي في معظمها تتبع أنماطاً من التديّن التزمّتي الاستهلاكيّ المتشرّب للنظرة الإخوانية إلى الدين والحياة، وفي هذا فارق أساسيّ بين “مدنيي مصر” وبين علمانيي تركيا الأتاتوركيين، وعلمانيي تونس البورقيبيين.
لقد أوصل “حكم الإخوان” الجماعة إلى طريق مسدود في أقلّ من عام، إلا أنّ ذلك شيء والتوهّم بأنّ “الإخوان المسلمين” قد خرجوا من التاريخ شيء آخر تماماً، فالانقسام الأهليّ الحاد بين الإسلاميين وأخصامهم ما زال محدّداً أساسيّاً للمسار المصريّ العام، كما وأنّ بعض هذا الانقسام يتخذ منحى جغرافياً إلى حدّ ما، بين “مصر سفلى” مناوئة لهم، و”مصر عليا” ما زالت إلى حد كبير موالية لهم.
وإذا كانت “الحتمية الإسلاميّة” بأنّ الإخوان جاءوا ليحكموا مصر إلى فترة طويلة لم يكن لها أساساً ما يسندها على أرض الواقع، فإنّ “الحتمية الليبرالية” التي تذهب إلى أنّ الحركة الإسلامية صارت وراءنا، ومطامع العسكر وراءنا، وليس لنا بعد ذلك إلا بناء الديموقراطية “طوبة طوبة” كما يقال باللهجة المصرية هي أيضاً نظرة تسطيحية، كلّ ما يهمّها هو أن تلتقط من الواقع مشاهدات تدلّ على سلامتها النظريّة، أي تماماً على طريقة ما كانت تفعله “الماركسية الدوغمائية” قبل ذلك، عندما يتحقّق كهنتها من أنّ الواقع أثبت صحّة نظريّتهم وتوقّعاتها السديدة.
في مقابل هذه الحتميات، يدعونا الواقع الحيويّ المصريّ للتفكير. مساحة التفكير هذه يدعونا إليها الرئيس الأميركيّ باراك أوباما بشيء من الحكمة، وهو يعلّق على التظاهرات المصرية الأخيرة من تنزانيا: “الديموقراطيات لا تعمل عندما يقول الجميع إن الخطأ هو خطأ الطرف الآخر ويصرّ كل طرف على الحصول على 100 في المئة مما يريد”.
المستقبل
عن “الإخوان المسلمين” و”الإخوان العلمانيين” في مصر وغيرها
ماجد كيالي
لا فصل بين الديموقراطية والليبرالية
بعيداً عن المعنى المباشر للصراع الجاري على السلطة في مصر، والذي يتضمّن نزع الشرعية عن حكم حركة الإخوان المسلمين، فإن هذا الصراع يرتبط، بأبعاده العميقة والبعيدة، بالصراع على معنى الدولة والديموقراطية والمواطنة، المتأسّسة على الحرية والمساواة والكرامة، من دون أي تمييز بين المواطنين، وهذا الكلام ينطبق على التيارات الدينية كما على التيارات المدنية.
القصد أن ما يجري في مصر ينضوي في إطار تعزيز، أو إنضاج، فكرة الديموقراطية بحمولاتها الليبرالية، المتعلقة بتكريس مفهوم المواطن، الفرد/المستقل، والحريات الشخصية والعامة، والمساواة بين المواطنين، واعتبار الدولة مجالاً عاماً، وليس مجالاً حزبياً، يحتكره الحزب الحاكم، أو حزب الأكثرية، أياً كانت خلفيته، علماً أن هذا الأمر لا يتعلق فقط بالإخوان المسلمين، وإنما يشمل مجمل التيارات السياسية الليبرالية واليسارية والقومية والعلمانية، في مصر وفي العالم العربي.
وهذا الفهم لدولة المؤسسات والقانون والديموقراطية، القائمة على الفصل بين السلطات، وتداول السلطة، هو لصالح الجميع، الأكثرية والأقلية، لأن الأكثريات والأقليات السياسية تخضع للتغيرات، فالحزب الذي يحقق أكثرية ما في انتخابات معينة، قد يتحول إلى أقلية في انتخابات أخرى. عدا عن ذلك، فإذا كان من حق حزب ما أن يحتكر السلطة، وأن يتحكم بالتوجهات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في مرحلة معينة، فهذا لا يمنحه الحق بالتحكم بجهاز الدولة، أو بصوغه حسب مزاجه السياسي. هذا هو معنى أن الديموقراطية لا تقتصر على مجرد عمليات انتخابية، وأن تحقيق أكثرية في انتخابات ما لا يعني التحكم بالدولة والمجتمع، وصوغهما على مقاس الحزب الحاكم. وهذا هو معنى الكلام عن الدستور، واعتبار الحرية والمساواة والكرامة والعدالة وتكافؤ الفرص بين المواطنين قيماً فوق دستورية.
هذه المشكلة تبدو مستفحلة عندنا بسبب عدم هضم الديموقراطية لمسألة الحرية الفردية، أو بسبب الفصل بين الديموقراطية والليبرالية، في حين انها تبدو أقل حدّية في الدول الديموقراطية في الغرب، بسبب أن ديموقراطيتها مطعّمة بقيم الليبرالية، المتعلقة بضمان الحريات الفردية والعامة، وحياد الدولة إزاء الأكثريات والأقليات السياسية، ولكونها أنجزت تحولاتها نحو الليبرالية قبل التحولات الديموقراطية، علماً انه لا يوجد نظام سياسي كامل أو نزيه، لكن هذا هو النظام الأمثل الذي دلّت عليه خبرة البشرية، في مجال النظم السياسية، حتى الآن.
راهناً، وبخصوص ما يجري في مصر، فلا شكّ فيه أن ثمة مشكلة في فهم الإخوان المسلمين للديموقراطية، ولمعنى الدستور، والمواطنة، والحريات. لكن التجربة لم تثبت أن التيارات القومية واليسارية والعلمانية، كانت أفضل حالاً في تمثلها لمقاصد الديموقراطية والدستور والحريات في الأنظمة التي تسيّدت فيها، في العالم العربي أو في البلدان الأخرى. ولا شكّ أن “الإخوان المسلمين”، في مصر وغيرها، أخطأوا في مجالات عديدة، لكننا في غضون ذلك ينبغي أن نكون واضحين، ومنصفين، إذ لا ينبغي أن ننسى أن النظم “القومية” و”اليسارية” هي، أيضاً، أسهمت في تكريس الاستبداد والتسلط، وتهميش الدولة والمجتمع، وتقييد الحريات، وتأخّير قيام دولة المؤسسات والقانون والمواطنة في عديد من بلدان العالم العربي؛ وهذه هي الملاحظة الأولى.
الملاحظة الثانية، وعلى ضوء ما يجري في مصر، والاستقطاب الحاد، بين مؤيد لحكم الإخوان والمعارض له، ثمة مخاطر من تفشّي نوع من الخطابات التي تتأسس على التشكيك والتهميش والإقصاء وكراهية الآخر والإلغاء. فهذه اللغة العدائية والعدمية، مضرّة، وغير مفيدة، في الصراعات السياسية، وهذا ينطبق على التيارات الدينية والمدنية. ومعلوم أن هذه اللغة أصلاً هي من نتاج العقليات والنظم الاستبدادية، وهي لغة من المفترض نبذها والثورة عليها، لأنها تتنافى مع الحرية والمساواة والديموقراطية، ولأنها تؤدّي إلى ترسيخ الانقسامات المجتمعية، كما تؤدي الى قيام علاقات عدائية تغذي التطرف والعنف.
الملاحظة الثالثة، وهي أن تيارات الإسلام السياسي تتحمّل مسؤولية عما جرى، كونها تبوأت السلطة، عبر الانتخابات، في مصر (كما تونس)، ولكنها تصرفت وكأن المجتمع ملك يديها لمجرد رفعها راية الإسلام، الأمر الذي أغراها بعدم الالتفات للقوى الأخرى، والتسرّع في محاولاتها بسط هيمنتها على الدولة والمجتمع، ما أوقعها في مشكلات عديدة، وأسهم في عزلها، وتراجع شعبيتها. وعدا عن تسرّعها، وعدم استفادتها من التجارب الماضية، وظنّها أن الطابع الديني يحميها من النقد، والمساءلة، فإن خطأ التيارات الاسلامية، كغيرها من التيارات الحاكمة التي سبقتها، والتي برّرت نفسها بأيديولوجيات مطلقة، يكمن في محاولتها الهيمنة على الدولة وتحويلها من مجال عام إلى مجال حزبي، وفرض وجهات نظرها على المجتمع بوسائل قسرية وزجرية، واعتبار ذاتها تحتكر الحقيقة، ووضع المنتسبين إليها فوق المجتمع.
الملاحظة الرابعة، وبغضّ النظر عن كيفية سير الأمور، فإن الشعب المصري بات اليوم يعيش حالاً من الانقسام، بين مؤيد لحكم الإخوان ومعارض لهذا الحكم، وهذا يعني أن ثمة ازمة سياسية بلغت مرحلة الاستعصاء. لكن ينبغي الانتباه، على الرغم من كل ذلك، أنه لا حل لهذا الاستعصاء البتّة بالطرق غير السياسية، لأن طريق العنف يعزّز الانقسام السياسي، ويودي بالدولة، ويفضي الى تشقّق المجتمع، وأيضا لا حلّ ناجز بالعودة الى حكم العسكر، لأن ذلك يعيد انتاج التجارب المريرة، وربما إنتاج دورة جديدة للاستبداد. والمقصد أنه لامناص من البحث عن حلول سياسية للأزمة في مصر، وهذا لايضير الإخوان المسلمين، إن أرادوا الاستفادة من هذه التجربة، وإن أدركوا أهمية تجاوز المخاطر التي يمكن أن تنجم عن العناد بالاستمرار بالتشبث بالسلطة بعد كل ماجرى، حتى لو كانوا يمتلكون أكثرية ما، بغض النظر عن صحة ذلك أو عدمه.
والواقع فإن الدول والمجتمعات التي تتمتّع بحيوية سياسية لا يضيرها التوجّه نحو استفتاء الشعب، ولا حتى التوجّه نحو انتخابات مبكّرة، لحسم خلافاتها وانقساماتها في لحظات الاستعصاء، فحتى في اسرائيل حدث ذلك مراراً. لكن حتى لو تم التوجه نحو هذا الخيار أو ذاك، فإن الجميع معني بالاستفادة من هذا الدرس، باعتبار أن مصر لجميع المصريين، وأن شعب مصر لم يعد يحكم بالطريقة السابقة، وأن الحرية والمساواة والكرامة قيم عليا لا ينبغي المسّ بها، ولا التمييز بشأنها بين المواطنين، ولا لأي سبب، هذا ينطبق على مصر وعلى غيرها، وعلى الاخوان المسلمين والإخوان العلمانيين.
المستقبل
مصر: الانقلاب واحتمالات ما بعده!
حازم صاغيّة
ليس الاستسهال والتبسيط العلاج المحمود للأزمة المصريّة البالغة التعقيد. فهناك انفجرت المشكلة السياسيّة في ظلّ تصدّع وطنيّ فاقمته الأنظمة العسكريّة المتتالية، قبل أن يضيف الإخوان المسلمون إسهامهم الكبير إليه. هكذا التحمت المشكلة المذكورة بذاك التصدّع حتّى صار واحدهما الوجه الآخر للثاني.
وربّما كان التجلّي الأبرز لما نصفه انعدام الوسائط والجسور بين مجتمع الإخوان ومجتمع (مجتمعات؟) باقي المصريّين. وفي نظرة عريضة للتاريخ المصريّ الحديث، كان يمكن التعويل على حزب كحزب الوفد كي يضطلع بالدور هذا. إلاّ أنّ الحكم العسكريّ في طوره الناصريّ التأسيسيّ قضى على احتمال كهذا فوُئد «الوفد» مع وأد الحياة السياسيّة برمّتها.
رأب هذا الصدع لا يتمّ بغير الصبر الديموقراطيّ، أو التحمّل الديموقراطيّ على مدى طويل، ومحاولة الانصياع تالياً لإجماعات تتأسّس في موازاة صناعة المناخ السياسيّ الجديد.
هنا فوّت الإخوان ورئيسهم المنتخب محمّد مرسي فرصة ثمينة حين أبدوا قدراً هزيلاً جدّاً من التحمّل الديموقراطيّ لشركاء مفترضين في الوطن. لكنّ خصومهم على الضفّة الأخرى أبدوا قدراً أكثر هزالاً حين قادهم نفاد الصبر إلى تفضيل الحلّ العسكريّ والانقلابيّ، خصوصاً أنّ الحكم الإخوانيّ كان يتصدّع بوتيرة يوميّة، وكانت إجراءاته القمعيّة تأتي مرفقة بهزالها وتهافتها وبقدرة مدهشة على السخرية منها (دع جانباً المبالغات عن «توتاليتاريّة» مرسي «الحديديّة»).
يترتّب على ما سبق أنّ احتمال السقوط السياسيّ للإخوان كان يلوح وشيكاً، وكان يقترب معه احتمال دخول الإسلام السياسيّ في أفول مديد تتردّد أصداؤه في غير بلد إسلاميّ.
هنا جاء الحلّ العسكريّ لينذر بأمور محدّدة بالغة الخطورة:
فأوّلاً، تبدّى أنّ الكتلة العريضة المناوئة للإخوان، وعلى رغم الحضور الجماهيريّ المدهش في الميدان، لا تملك، حين يجدّ الجدّ، إلاّ الاستنجاد بالعسكر وتدخّله. لقد جاء ما حدث مصداقاً لقول القائلين إنّ مجتمعاتنا لا تنتج إلاّ الجيش والإسلام السياسيّ، أمّا حاملو الديموقراطيّة فلا يُحسب لهم حساب في اللحظات الحاسمة.
وثانياً، تبدّى أنّ الثقافة الديموقراطيّة لا تزال هشّة جدّاً. تكشف عن ذلك الفترة القصيرة (والسحريّة) للانتقال من «يسقط يسقط حكم العسكر» إلى اعتبار ذاك العسكر نفسه المخلّص المرجوّ.
وثالثاً، تمّ إنقاذ الإسلام السياسيّ من ورطته عبر إعادة تسليحه بسلاح المظلوميّة. فكيف إذا ذكّرنا بتجربة الجزائر في 1989 وتجربة غزّة في 2006. لقد صار الإخوان أصحاب الشرعيّة الدستوريّة، شئنا أم أبينا.
ورابعاً، قد يجوز القول إنّ الانقلاب الأخير أنقذ مصر من مواجهة بين مجتمعيها، لكنْ قد يجوز القول بثقة أكبر أنّه أدخل مصر في مواجهة قد تكون أشدّ حدّة ومرارة يشي بها كلّ ما يصدر عن الإخوان المسلمين والناطقين بلسانهم.
وخامساً، وفي معزل عن النيّات الحسنة لدى بعض المهلّلين للانقلاب، ليس هناك وراءنا ما يطمئن إلى أنّ الجيوش تسلّم السلطة هكذا، خصوصاً أنّ الحركة الشعبيّة الباهرة التي رأيناها قبل الانقلاب سوف تخضع للتسريح عاجلاً أو آجلاً.
أمّا أن يكون هذا التأويل مخطئاً، فهو ما لا يرجو كاتبه سواه!
النهار
رأي في عجز «الإخوان»… وفي عجزنا عن مشابهتهم
حازم الأمين
ثمة مستوى لإخفاق الإخوان المسلمين لم يبلغه النقاش بعد. انه فشلهم في ان يكونوا جزءاً من الزمن. من تقدمه وارتكاساته ومن سرعته. وهو فشل عام لا يُستثنى منه فرع لهم، كما يشمل معظم جماعات الإسلام السياسي في المنطقة. ومن المرجح ان يكون لهذا الفشل دور في سرعة استهلاكهم حقبتهم، سواء المصرية، ومن المرجح التونسية، ولاحقاً حقبات افتراضية كان من المتوقع ان يبلغوها في بلدان كالأردن والجزائر.
العلاقة مع الزمن. والزمن هنا أذواق وإعلام وأصوات أفراد ونساء، وهو أيضاً اقتصاد مختلف، ومساحات من العبث بهذا الاقتصاد، وهويات أقل رسوخاً. والإخوان المسلمون بصفتهم جماعة إحيائية، ارتدوا إلى شخصية أولى لا تقيم وزناً لكل هذه العناصر إلا بصفتها وسيلة لتثبيت «الشخصية الأولى» ولبعثها، وفي وجوهنا.
الرئيس المصري المخلوع محمد مرسي لا يعرف مثلاً ان رئيساً للجمهورية لا يمكن له ان يرفع الأذان. مؤذن المسجد هو من يفعل ذلك، وهو رئيس للجمهورية وليس مؤذناً. كما لا يعرف ان رئيس جمهورية مصر، المسلم حكماً، لا يمكن ان يبدأ خطاباً بربع ساعة من البسملة والحمدلة. هذا شأن الوعاظ وليس الرؤساء. حركة حماس بدورها لا تدرك ان حملة لتأديب شباب غزة اسمها «ارفع سروالك» ستثير في وجهها ليس سخطاً فحسب، وإنما كذلك حملات من السخرية تقوّض نفوذها. فللسخرية في مواجهات كهذه قدرات تقويضية، اختبرها الرئيس المصري عبر ظاهرة باسم يوسف التي كان لها دور كبير كما يبدو في الثورة المصرية الثانية.
الإخوان المسلمون ايديولوجيون، والأيديولوجيون عموماً أناس غير ظرفاء ومقيدون، فما بالك اذا كانت ايديولوجيتهم إحيائية، قليلة الحركة ويقتصر طموحها على بعث قيم يصعب بعثها. هذا الأمر كان في صلب الحدث المصري الأخير. كنا في القاهرة أمام مشهدين، الخفة المطلقة في مقابل الأيديولوجيا المطلقة، باسم يوسف في مقابل محمد مرسي.
والحال ان خلل علاقة «الإخوان» بالزمن، بزمنهم هم كممارسين جدد للسلطة، تم اختباره على نحو مأسوي في السنوات الأخيرة. فحماس لم يعد باستطاعتها الاختباء في قطاع غزة. وضبط المجتمع الغزاوي بحدود القطاع وبحدود الحصار ما عاد ممكناً. فقد تسلل محمد عساف في غفلة منها والتحق بـ»آراب أيدول» وفاز، وما كان لاستنكار حماس سوى ارتدادات سلبية على صورة سلطتها.
المشكلة التي يواجهها «الإخوان» تتمثل في انهم ما أن يبلغوا السلطة حتى تتكشف ضائقتهم هذه. قبل ذلك، تمارس المجتمعات التي يقيمون فيها خبثاً، فتقبلهم كما هم، وتُشعرهم بأن ما هم فيه ليس أمراً جوهرياً، ولكن ما ان يبلغوا السلطة حتى يقع الاحتكاك. فها هم في المجلس الوطني السوري جزء غير نافر من مكوناته الغريبة. فيجلس مراقبهم محمد رياض الشقفة، كشيخ صوفي حموي، الى جانب استاذ الجامعة الباريسي برهان غليون من دون ان يكشف الاختلاف عن نفور كبير. فالشيخ قانع بحاله، وغليون سيغادر الاجتماع متوجهاً الى باريس، والناس منتظرة حتى تحل السلطة ويحل النفور.
ليس «الإخوان المسلمون» جماعة رجعية على رغم احيائيتهم. فهم لم يتركوا شأناً من شؤون الدنيا إلا وخاضوا فيه. يتاجرون كثيراً ويتعلمون كثيراً ويسافرون كثيراً ويتزوجون وأحياناً لا يتزوجون. لكنهم في أفعالهم هذه يقيمون فقط في مجتمعاتهم. فحين يُسافر الإخواني السوري الى لندن يكون بهدف زيارة اخواني هناك. وحين يُتاجر في عمان، يفعل ذلك في دائرة الاقتصاد الإخواني السوري فيها، وحين يتزوج الشاب انما يتزوج بطلب من والده الذي يكون قد اختار له ابنة أخيه في الجماعة.
يُنتج هذا الضيق ضيقاً موازياً، فالاقتراب من مجتمع «الجماعة» يصبح مستحيلاً لغير أبناء الدعوة. الاقتراب منهم ممكن، لكنه زيارة موقتة يتبادل فيها من يفعل ذلك أحاديث مع رجال لطفاء لكنهم أغيار.
ليس هذا حال السلفيين مثلاً، فهؤلاء يمكنهم ان يقتلوك، لكنهم لا يتجنبون الاقتراب منك أو مشابهتك. وأحياناً يخافون منك لشدة مشابهتك لهم، فيهربون من وجهك. هم ليسوا جماعة. انهم الإسلاميون الأفراد، وأصحاب أمزجة خاصة لم يَصُغْها المرشد، لطالما تزوجوا من سافرات وتولوا تنقيبهن، وبعضهم لم يقو على زوجته فتركها وشأنها وراح يتألم.
في مصر قررت الجماعة ان تحكم. هي لا تعرف ان تفعل ذلك إلا وحدها. هذا الضيق وصل الى السلطة محملاً بهواجسه من الآخرين، وناقلاً مجتمعه إلى القصر. محمد مرسي لم يُخاطب في المصري إلا الإخواني الذي في داخله، أو انه لم يُخاطب إلا الإخواني المصري. رئيس مصر ترك المصريين وتوجه الى جماعته فقط. إنهم الرئاسة والحكومة والقضاة، وكانوا باشروا الانتقال إلى الجيش والشرطة. لا تعرف الجماعة طريقاً آخر الى الحكم. المصريون الآخرون بدوا ضيوفاً، والتجار الآخرون غير شركاء، وليس مهماً ان يمتنع ممثلو الأقباط، كل الأقباط، عن التـــصويت عــــلى الدستور. هذا الفعل، أي قلة الاكتراث لغياب الأقباط، ليس سياسياً. انه جـــزء من بديهيات الجماعة، تماماً كما هو ليس سياسياً ان يتولى الرئيس مهمة المؤذن، وأن يجلس في حضرة شيوخ يُكفّرون الشيعة. وهذا جزء من السعة الإخوانية، وليس من الضيق، فهذا الأخير يتجسد في شعائر أخرى: في حقيقة ان مرسي لا يعرف ان يحكم من دون الجماعة، ولا يجيد غير لغتها. وبما انه ليس الرجل الأول فيها، فلن يكون الرجل الأول في مصر، ذاك ان مُرشده سيحاصره بأكثر من خيرت الشاطر ليتولى نقل التعليمات.
وإذا كان مجتمع «الجماعة» قيّد الرئيس بقيمه وأخلاقه، مضافاً إليها الضيم الذي لحق بالإخوان جراء سقوطهم المبكر في فخ السلطة، فإن الخروج على «الجماعة»، وهو شرط لا تستقيم سلطة من دونه في مصر، إلا إذا كانت سلطة بعث أو ولي فقيه، هو تماماً ما عجز عنه محمد مرسي طوال سنة من حكمه… ذلك أن جماعته أرادته مؤذن المسجد، فيما الإمام الحقيقي يقيم خارج القصر.
الحياة
بين شرعيتين وشبح نزاع أهلي
حسن شامي
خلال أيام معدودة انعطفت مصر انعطافة كبرى قد يتطلب حصولها سنوات طويلة في سياقات أخرى. وها نحن نلهث، والعالم أيضاً، على إيقاع تاريخها المتسارع. ولا نعلم بعد إذا كان تسارع الإيقاع تعبيراً عن استعجال الخلاص أو بداية الرقص على حافة الهاوية. هل نحن حيال ثورة في الثورة؟ هل هي ثورة مضادة؟ هل ما حصل انقلاب عسكري من طراز خاص، ما دام تدخل الجيش لم يأتِ خلسة من الغرف السوداء بل سبقه توجيه إنذار أمهل الرئيس مرسي يومين لاستجابة مطالب الشعب المحتشد بالملايين في ميدان التحرير وغيره؟ ولكن كيف نَصِف الإطاحة برئيس منتخب بعد سنة واحدة على ولايته؟ هل ما جرى تصحيح لمسار مفترض للثورة التي أسقطت مبارك، أم أننا أمام نزاع حول مفهومين للشرعية، أحدهما يحمله في الشارع وبنبرة شعبية هادرة ائتلاف قوى موقت، يحمل في تشكله الظرفي عناصر مواجهات تنذر بتحويل حاضر المصريين إلى متاهة؟ أما الثاني فيلخص الشرعية ويختزلها بقانونية الانتخابات وما أسفرت عنه صناديق الاقتراع، كما يستفاد من خطاب مرسي الأخير، وترديده عشرات المرات تمثيله للشرعية الدستورية. هل تكون هبة النيل في هذه الحالة قيد الدخول في حال من الثورة الدائمة؟
هذا غيض من فيض أسئلة مقلقة أطلقتها وقائع الحدث المصري المتسارع في الأيام الأخيرة، والمرشح لديمومة قد لا تخلو من مفاجآت. سيسيل حبر كثير وستلهج الألسنة بشتى الاحتمالات والعواطف والأهواء. سنخوض في ذلك وسط قلق وخوف كبيرين وحبس للأنفاس.
ليس عزل الرئيس المصري على يد القوات المسلحة هو ما يحبس أنفاس كثيرين، ويعيد خلط الأوراق ورسم خريطة اصطفافات، ليس على المستوى الوطني وحده، بل كذلك على المستويين الإقليمي والدولي. فهذا العزل ومعه تعطيل الدستور موقتاً وتكليف رئيس المحكمة الدستورية العليا عدلي منصور قيادة البلاد في المرحلة الانتقالية والتحضير لانتخابات رئاسية وتشريعية مبكرة، كل هذا يحتمل أن يكون عملاً إجرائياً، ما دام ملايين المحتشدين رحبوا وابتهجوا به. ما يحبس الأنفاس أن شبح مواجهة قاسية بدأ يحوم وبسرعة قياسية حول المشهد المصري، وقد تتخذ هذه المواجهة، في حدها الأدنى، شكل نزاع حاد وعنيف، وشكل حرب أهلية في حدها الأقصى.
ليس أمراً بسيطاً أن يحوم شبح حرب أهلية في بلد مثل مصر، تبدو فيه الهوية الوطنية راسخة وتقاليد الدولة المركزية عريقة ونمط الاجتماع يعرف درجة عالية من التجانس مقارنة بالانقسامات العمودية وغلبة منطق العصبيات الضيقة الطائفية والمذهبية في معظم بلدان المشرق. مثل هذا الاحتمال المشؤوم سيعني الكثير بما في ذلك معنى الحرب الأهلية ومفهومها. وكانت الحرب الأهلية اللبنانية رسّخت في الأذهان القريبة والبعيدة صورة واحدة عنها، هي صورة تطاحن عصبيات طائفية تزج بأهلها، أحبوا ذلك أم كرهوه، في حرب الكل الأهلي ضد الكل الآخر لتحقيق غلبة عارية، أي بلا صفة سياسية بالمعنى النبيل للكلمة. وقد يكون هذا التوصيف للحرب الأهلية اللبنانية إنجازها الوحيد. وهذا مثلاً ما يحمل طرفي النزاع في سورية على رفض هذه التسمية لنزع شبهة الطائفية أو ما يعادلها عن هوية الصراع ورهاناته.
حفل المشهد المصري الهادر، منذ تظاهرة 30 يونيو (حزيران) على الأقل، وقبل تنحية مرسي ووضعه في الإقامة الجبرية في وزارة الدفاع واعتقال عدد من قادة «الإخوان»، بمؤشرات إلى إمكانية أن يتطور الانقسام إلى نزاع أهلي مفتوح. فخلال أيام قليلة سقط حوالى خمسين قتيلاً ومئات الجرحى في صدامات بين معارضي مرسي ومؤيديه. ترافق ذلك ليس فحسب مع تصريحات وأشكال تعبئة تحض على المواجهة، بل كذلك مع حرب أرقام ينشد فيها طرفا المواجهة حيازة الأكثرية الشعبية وشرعية تمثيلها.
لكن المؤشر الأكبر هو انتظام التظاهرة الشعبية الضخمة المعارضة لمرسي في ميدان التحرير، تحت راية مرفوعة تعلن القطيعة مع نمط وأسلوب في الحكم يجسده مرسي وتنظيم «الإخوان». واستندت هذه الدعوة إلى تنحية مرسي على تشخيص غير خاطئ لأداء الرئيس المنتخب وأخطائه الفادحة. فقد ظهر خلال سنة ان مشروع مرسي وحزبه ليس إدارة بلد متنوع ومتعدد بمقتضى تفويض عقدي ترجمته صناديق الاقتراع، بل السيطرة على مفاصل الدولة ووضع اليد عليها. ولم يكن صعباً اعتبار ذلك احتيالاً على الإرادة الشعبية وعلى كتلة واسعة من الناخبين، فضلت مرسي لأنه أقل خطراً وسوءاً من مرشح النظام السابق أحمد شفيق. الشرعية القانونية المتأتية من الانتخابات ليست الصيغة النهائية لمفهوم الشرعية ولا غايته، خصوصاً في لحظة انتقال صعبة ومعقّدة تتصارع فيها مفاهيم مختلفة عن الشرعية وركائزها. فلنترك للحقوقيين وأهل الاختصاص أن يتفحصوا أي شرعية من الشرعيتين المتنازعتين تتطابق معيارياً مع المنظومة الحقوقية المثالية. ما يعنينا هو حقل الصراع ذاته، وما تعنيه فكرة الحق والشرعية لدى فئات اجتماعية متباينة وكيف تتمثلهما وما هي الرهانات المعقودة عليها.
الدولة ليست غنيمة، خصوصاً حين يكون الوصول إلى إدارتها عبر انتخابات وليس بالحرب. هذا هو جوهر الاعتراض الواسع والشرعي على حكم مرسي و «الإخوان» من خلفه، بالأحرى من أمامه ما دام كثيرون يرون أن مكتب الإرشاد هو الذي يدير فعلياً البلد والدولة، ويتحكم بالتعيينات وتوزيع الحصص والمسؤوليات. وهذا بالضبط ما يمكن أن يدفع «الإخوان» إلى اعتبار شرعيتهم مطلقة واعتبار كفّ يدهم انقلاباً واغتصاباً لسلطة حصلوا عليها بعد انتظار مديد.
لا نعلم ما ستؤول إليه التظاهرة التي دعا إليها «الإخوان» للدفاع سلمياً عن شرعية مرسي، ولكن يمكننا أن نتوقع انزلاق فريق منهم نحو جذرية عنيفة. ثمة في المقابل ما يشي بإمكانية استيعاب الصدمة ومناخات الصدام. فخط الانقسام لا يفصل بين إسلاميين وعلمانيين، بل يقتصر على عزل «الإخوان»، وجيد أن ترفض جبهة الإنقاذ والقوى الأخرى استبعاد الإسلاميين من الحياة السياسية. لا حاجة للمقارنة بنماذج جاهزة مثل الجزائر وتركيا، فمصر لا تشبه إلا نفسها.
الحياة
اليتامى المكللون بالغار
هاني درويش
هل كان من الممكن افتراض مآل آخر لحسم الأمر؟ بمعنى بقاء ملايين المصريين في الشوارع لأسابيع مثلاً، في ظل تجبّر وكِبر محمد مرسي، وجماعته الصماء البكماء؟ ما الذي كان سيحدث لو نفد صبر أهل النقاء الثوري من سلمية لم تحرك ذرة في الجلد السميك للرئيس السابق؟ نفكر في هذا الاحتمال لمواجهة المأزق الأخلاقي الذي حشر فيه البعض، توصيفاً متأرجحاً للجاري، بين الانقلاب والثورة.
ولنكمل ملحمة الخيال تلك. ملايين تتجاوز، في اليوم الرابع أو الخامس، الحسّ الكرنفالي المميز. تعتلي بالمئات أسوار قصر الاتحادية، وتعلن من أروقتها إسقاط محمد مرسي، فتتحرك جحافل مؤيدي الرئيس من ميدان رابعة العدوية، ويلتقي البحران في مذبحة مدوية. هل كان أهل النقاء الثوري على استعداد، بالسلاح والعتاد والكوادر البشرية، لمواجهة الفاشية، في معركة شريفة في الشوارع؟ وأقصد بالمعركة الشريفة هنا تقلص عدد القادرين على إدامة عنف متوازن مع الإخوان إلى حدود الجماعات الأناركية الصغيرة مثلاً، وشرفاء الوطن من عصابات بلطجة الشوارع وتجار المخدرات… أي الشرائح القادرة، من دون أي اعتماد على أجهزة دولة قمعية، على مقاومة الميليشيا الإسلامية لمدة ساعتين على الأكثر. وبافتراض تشكل هذا الحليف (الثوري العصبوي) هل كانت دوامة العنف لتحسم شيئاً؟
المؤكد أن قوة أي حراك في مصر، منذ الثورة الأولى، اعتمد بشكل أساسي على الحشد، القنبلة الديموغرافية التي سخر منها حسني مبارك. الحشود السلمية الكرنفالية بالملايين كانت وراء إسقاط مبارك في الأصل وفي الصورة. قوتها المعنوية والأخلاقية هي ما أجبر الجيش، مفزوعاً أو محتسباً مصالحه، على هجر مبارك، ثم هجر مرسي، لما تحتويه هذه الجمهرة تحديداً من احتمالات عنف، رغم قلّتها. لكن مجرد تخيل هذه الحشود منفلتة سيؤدي إلى كارثة. الملايين التي قد يشكل وجودها منفردة، إرادة لا تحمد عقباها. قد تدير نفسها ذاتياً، أو تتبنى مطالب تتجاوز إسقاط النظام، مع احتمال أن يعلو سقف مطلبها إلى التفاصيل الطبقية أو الاجتماعية. ولأنها تحديداً لا تملك رافعة سياسية موازية لها في القوة والاتجاه، كان تفكير الجيش غالباً هو الدخول عليها بمنطق الاحتضان، قبل أن تتخثر المطالب وتتشعب، أو يتلقف تيار ما هذه الأشواق ويحولها إلى برنامج عمل جذري.
لذا، كان تصوير الجيش لفيديوهات الاحتشاد، صك براءة تحركه اللاحق، أوراق اعتماد لإزالة ما يراه احتقاناً يمكن علاجه بتغيير مركب السلطة. كان يوثق للعالم بأنه يتحرك باسم هذه الحشود تحديداً. ورغم ذلك لم يسلم من الضغط بعدم اعتراف العالم بمشروعية تحركه. فالعالم، كما مرسي، أصابه صمم أمام المطالب الموضوعية للمعارضة، منذ شهور. العالم اختزل مصر، منذ الانتخابات الرئاسية، في فقرة “القرد أبو صديري” الذي يجلب ضحك جون ستيوارت. العالم كان سعيداً بانحطاط الثورة المصرية وخلو ميادينها من صور البهرجة الكرنفالية غير محمودة العواقب.
شرفاء النقاء الثوري هم يتامى اللحظة، المكللون بالغار. يتحدث قديسهم الطبقي تامر وجيه عن غياب المطالب الاجتماعية عن تظاهرات إسقاط مرسي. لا يأسف الرجل على فشل جماعته اليسارية حتى في توسيع المنضدة التي يسهرون عليها. فالجماهير في الشارع للأسف تبدو “نخبوية” “مثقفة” وهي تطالب بالحرية غير الطبقية، وهي تقاوم كآبة الاستبداد بروح الفكاهة واللامسؤولية الاجتماعية. وجماعته التي لم تفلح في اختراق حزب صغير، في ظرف بهذا الزخم الثوري، خرجت للتباكي على العنف ضد الإسلاميين.
عنف ضد الإسلاميين؟ الحقيقة إن أي مراجعة عقلانية للصور والفيديوهات قبل أسبوع، حتى الدعائية منها، والتي تصرخ بالمذابح المتوهمة ضد الإسلاميين، تكشف ببساطة مَن الذي يحمل السلاح. ففي الثورة الأولى، كان المواطنون الشرفاء في حماية الأمن، الأعداء الحقيقيين للثورة. بينما لا تخفي الفيديوهات هذه المرة جبروت الإسلاميين حاملي الأسلحة المتوسطة والآلية في قلب شوارع الجيزة، في أسيوط والمنيا والسويس، مستخدمين البيوت والمساجد والجامعات كمناطق تمركز لقتل الثوار العزّل. ولا تخرج بكائية هؤلاء على الدم المسكوب والمتخيل، من حدود لعب دور تحويل القاتل إلى ضحية كالعادة، فمظلومية بعض قوى اليسار المصري هي التوأم الملتصق لمظلومية حلفائهم الإسلاميين.
تعوض جماعات “الصعبان عليّ” فشلها المزمن في تنقية الثورة من شوائبها (الفلول، السياسيين التقليديين، جمهور الكنبة)، بالبحث عن ثقوب في ثورة ٣٠ يونيو. بذلت جهوداً مضنية في ضرب الإجماع قبل النزول إلى الشارع. “تفليل” الشارع هوايتها. ولم تستغل أربعة أيام من الاحتشاد الأكبر في تاريخ العالم، في مراجعة منطقها. ولأن عصابها الأساسي هو التعالي على وعي الجمهور- وهنا تشبه الإسلاميين- بل واحتقاره طالما لم يفهم مهمتها السامية، كان طبيعياً أن تلتحم فوراً بالإسلاميين، حتى قبل أن يكشف الجيش خطته للمستقبل، وذلك بمنطق رفض الانقلاب. فيما لم تقدم سيناريو واحداً مقبولاً للخروج من الأزمة. اكتفت بدور “الندابة” المستأجرة في مشهد لا يثبت عزلتها فحسب، بل إدمانها التاريخي على التذيّل للإسلاميين، نصراً وهزيمة.
نستطيع جميعاً أن نعود إلى المقاهي، متمنين في الثورة المقبلة أن يتوافر الظرف الذي يسمح لنا بقيادة الملايين. نستطيع أن نكتب ألف كلمة من الآن عن مقاومتنا للعسكرة. نستطيع أن ندفن رؤوسنا في ألف “لو” نقدية. لكن التاريخ لا تصنعه” اللولَوَة”. ما يحدث يحدث، لأن ما كان يفترض أن يحدث، طالما أنه لم يحدث، فهو لا يستحق الندم.
المدن
مَن يقوى على الحلم؟
نهلة الشهال
النقاش حول ما إذا كان عزل الرئيس محمد مرسي حصيلة انقلاب عسكري أم ثورة شعبية، وهل هو جائز شرعاً، ليس سوى جزء يسير من الموضوع. فإن اختُزل الموقف به شابه الجدل حول جنس الملائكة. وليس هذا استصغاراً لشأن الموضوع ولا لضرورته، ولا استخفافاً بأهمية تحديد ضوابط وأصول للحكم وللممارسة السياسية، بل تعيين للعصب الذي يمسك بالحدث.
فالظاهرة الأولى المدهشة في ما يجري مصرياً هي محرّكات الناس، تلك الملايين الكثيرة التي نزلت إلى الشارع لتقول ما لا تريد، إن لم يكن ما تريد. ولا يوجد جهاز استخبارات في العالم يمكنه أن يحرك مثل تلك الكتلة الهائلة. قد يلاقيها، قد يحاول استغلال حركتها والسعي إلى توظيفها في وجهة ما، قطف ثمارها على مستوى «السياسة» بما هي محصلة فوقية، لكنه لا يصنعها، بمعنى الخلق.
ومن يفكرْ على هذه الصورة يكنْ قابعاً في خريطة الماضي، مع أن طبيعة الحدث تنتمي إلى المستقبل. وهذه ليست ثنائية شكلية. في انزياح النقاش إلى تلك النقاط حصراً أو بالدرجة الأولى، تفويت ما هو أساسي وجديد: انطلقت الدعوة إلى تظاهرات «30 يونيو» من «تمرد»، وهي شبكة شبابية غير مهيكلة، لعلها ورثت شبكات سبقتها كـ «6 أبريل» وسواها، ولعل دعوتها إلى توقيع تلك العرائض أفلتت من أيديها (ولكن، هل لها أيدٍ؟ هذه فرضية ومنهج في التفكير ينتميان إلى ما اعتدنا عليه، إلى «الماضي»).
مَنْ خطر في باله مع انطلاق حملة «تمرد» أنها ستجمع تواقيع كل تلك الملايين؟ ومن خطر في باله- وهذا الأهم- أن ملايين الناس سينزلون إلى الشارع في ذلك اليوم المحدد، فيشكلون «أكبر تظاهرة في تاريخ البشرية» (هل هذا تفصيل؟). لم يخطر ذلك في بال «الإخوان» قطعاً، ولا في بال المعارضة المنظمة المنضوية في جبهة الإنقاذ، ولا في بال الجيش. الأخير تدخل لضبط هذه الحركة ومنعها من الإفلات في اتجاهات غير محسوبة بالمعنى السياسي، وكذلك لمنع صدام دموي بينها وبين «الإخوان المسلمين» يمكن نعته اختصاراً بالحرب الأهلية، وإن كان التوصيف ليس دقيقاً تماماً. والجيش هنا تصرف كمؤسسة وطنية، أي كجهاز لعله الوحيد الذي بإمكانه (يمتلك السلطة والقوة اللازمتين) الحفاظ على «الدولة»، وحمايتها. وهذا يتجاوز من بعيد حيّز الانقلاب.
الشرعية ليست فقط موقفاً أخلاقياً، ولا حتى سياسياً، بمعنى اختصارها بمحصلة صناديق الاقتراع مثلاً (على ما ذكّر أوباما مرسي في المكالمة الهاتفية بينهما قبيل عزل الأخير، والتي صارت شهيرة إذ حاول «الإخوان» إعادة «منتجتها» لتلائمهم!). تتجسد فكرة الشرعية في آليات متوافق عليها، أو معلنة، ينبغي بالطبع تعيينها وممارستها واحترامها. والرئيس مرسي فاز في الانتخابات، ولا شك، الاستفتاء على الدستور الذي طرحه نال غالبية مريحة، ولا شك. ولكن التعرف إلى اللحظات التاريخية يرتبط تحديداً بالحالات التي يفرض فيها واقع الأحداث تجاوز ذلك.
وبالمناسبة، واستطراداً، من اللافت أن الالتزام الحرفي بتعريفات الشرعية تلك، وبهاجس احترامها فوق أي اعتبار يطغى على رد الفعل البريطاني مثلاً، ليس الرسمي فحسب، بل أيضاً ذلك الذي عبرت عنه أصوات تحليلية وحتى الإعلام عموماً، ما يكشف عن قوة التقاليد السياسية ورسوخها في هذا البلد، ويعبر أيضاً عن مزاجه العام والعميق، والذي حال دون أن يكون بلد ثورات، بعكس فرنسا مثلاً، ووفر انتقالاته التاريخية الكبرى بطرق هادئة وبناء على توافقات.
وما بدا بليداً ومفوتاً في رد فعل «الإخوان» على ما يجري لهم ومعهم، هو التمسك فقط بـ «لكننا فزنا، نحن الشرعية». وهم هنا أظهروا عجزاً عن التقاط الدينامية الجارية والمتجاوزة هذا المعطى، على رغم أهميته. وهذا يشبه الغضب من فيضان نهر عظيم، ومحاولة الاعتراض عليه بالقول إن «العقد» معه هو أن يجري في مهده المحفور في الأرض عبر آلاف السنين، وأن يروي الزرع والناس، ويصب في مكان معلوم. لكنه فاض! انتهك مجراه وفاض. ليس بأدب، وليس في توقيت معلوم ومناسب كما يفعل النيل منذ فجر التاريخ، فكانت «مصر هبته» كما قيل، بل بعنف كاسح وفي شكل غير متوقع، فما العمل؟ هنا، بدا «الإخوان» مفتقدين تماماً الخيال السياسي، علاوة على ثقل دمهم. ولعل هذا الجانب هو أصلاً ما أفشلهم وكشف مقدار ماضويتهم في آن. فقد ظنوا أن الفوز في الانتخابات والاستفتاءات يمنحهم الحق في التصرف بالبلاد. وصموا آذانهم عما يتعدى فوزهم، ففوّتوا فرصة اقتراح توافق وطني يمكنه الإحاطة بالمرحلة الانتقالية لما بعد مبارك، بمعطياتها الكثيرة والمتناقضة، وتحدياتها الهائلة. اعتبروا أن الأمر هو ممارسة السلطة طالما هم أمسكوا بها، بينما التحدي كان في مكان آخر.
هناك قطيعة وقعت، ولم يدركوها. والأرجح أن الأطر التقليدية والمعتادة للمعارضة لم تدركها كذلك، لذا فهي تجادل «الإخوان» وتماحكهم على الهوية الفكرية، الأيديولوجيا وعلى الحق في الإمساك بالسلطة، ومقداره وكيفيته، وتفرك يديها فرحة بـ «غلبناهم»… وهي في هذا تسلك وفق ميراث الماضي وصراعاته، وكاستمرار له، وإن تغيّرت الوجوه. وهذه هي الثورة المضادة بالمعنى العميق للكلمة! بينما هناك أفق انفتح فجأة أمام الجميع، طارحاً تحديات هائلة، ومفترضاً امتلاك النضج اللازم لحملها وإيجاد حلول لها. وهو معنى أننا هنا أمام «لحظة» بالمعنى التاريخي، تَغيُّر في إيقاع الزمن يَخرج عن الانسياب المعتاد للأحداث السياسية، وإن الكبرى، بقوانينه المألوفة. فمن يقوى؟
وأخيراً، يقع كل اعتراض على قمع «الإخوان» أو التنكيل بهم، في هذا الباب تحديداً وليس فقط في مجال حقوق الإنسان، مما هو معتبر كذلك. لا شك في أنه ينبغي تعطيل قدرة «الإخوان»، أو ربما جنوحهم إلى العنف بسبب الشعور بالخسارة، وبسبب خوفهم من عودة الاضطهاد لهم أو الظلم، وهو خوف عميق لديهم، أصيل ومتلازم مع الجنوح إلى العنف. لكن نقاش كيفية التعطيل ضروري تماماً، وليس بدهياً أن تقتصر أدواته على الملاحقة والحبس.
فالتحدي الذي ينتصب أمام الجميع، حركات إسلامية وليبرالية ويسارية، يتعلق بالنجاح في صوغ معادلة للتوافق الوطني، نقيض الصراع على السلطة، لإنتاج خريطة طريق (حقيقية، وليس فقط كمخرج من مأزق آني وأزمته) نحو مستقبل مصر. فمَنْ يقوى؟
الحياة
حقائق وعِبَـر من الانتفاضة
خالد غزال
من المبكر رصد الاتجاهات المقبلة للتطورات المصرية بعد إسقاط حكم جماعة «الإخوان المسلمين»، وكيف سترد القوى والتيارات المنضوية تحت عباءتها، والصعوبات التي قد تنتصب في وجه الحكم الجديد. لكن الانتفاضة المصرية الثانية أظهرت حقائق تتصل بمصر ومجمل العالم العربي.
الحقيقة الأولى تشير إلى أن التظاهرات المليونية التي عادت تملأ ميادين القاهرة وشوارعها، تؤكد استحالة إعادة الشعب إلى «السجن» الذي سبق ووضعته الأنظمة العربية داخله. فما عاد بالإمكان الحجر على الجماهير ومنعها من التعبير عن موقفها في الشارع بعدما كسرت جدار الخوف وتحدت الأجهزة الأمنية وقمعها منذ عامين ونصف العام.
الحقيقة الثانية أرادت فيها الجماهير المصرية أن تعبر عن موقف ديموقراطي رفيع يتصل بحقها في المشاركة السياسية وصناعة القرار، وهو أحد المكاسب المهمة للانتفاضات العربية التي أعادت السياسة إلى الشعب بعدما صادرتها أنظمة الاستبداد. اتخذت الجماهير قراراً بإنهاء حكم «الإخوان»، وأمكنها تحقيقه كما جرى قبل عامين ونصف العام عندما أنهت حكم حسني مبارك. كان الشعار واحداً في الحالين: ارحل، الشعب يريد تغيير النظام.
الحقيقة الثالثة أثبتت قدرة الجماهير المصرية على إنهاء حكم «الإخوان» خلال فترة قصيرة مدتها سنة، وهو أمر فاجأ كل القوى السياسية في مصر والعالم، وبالتأكيد فاجأ «الإخوان المسلمين» الذين توقعوا لعهدهم الديمومة إلى أمد غير معروف. كان سقوطهم سقوطاً لمشروعهم السياسي القائم على شعار «الإسلام هو الحل»، والذي تكسّر أمام تحديات فرضتها وقائع التدهور المريع في الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تخبط بها حكم «الإخوان»، وبدا فيها أن من المستحيل إلهاء الشعب المصري بشعارات ديماغوجية، تعويضاً له عن حاجته إلى الخبز والحرية.
الحقيقة الرابعة تتصل بممارسة «الإخوان» السلطة. فلم يكونوا مبادرين الى إعلان الانتفاضة الأولى ضد مبارك، لكنهم ركبوا الموجة وانخرطوا فيها، وتبنوا شعارات ديموقراطية بدت في أعين كثيرين مفاجئة، لجهة أن تغيرات جذرية أصابت «الإخوان» في عقيدتهم وممارستهم، جعلتهم أقرب إلى الأحزاب الليبرالية. ولم يتوانوا عن التزام شعار الدولة المدنية والمساواة بين المصريين على كل المستويات. وما إن تمكنوا من الحكم عبر عملية ديموقراطية، حتى انكشف زيف الشعارات التي رفعوها خلال الانتفاضة، ولم تكن سوى أكاذيب لخداع الجماهير ونيل تأييدهم.
عاد «الإخوان» إلى نـــزع القــــناع عن فكرهم الأصلي الذي يقوم على الإقـــــصاء والاستئصال لسائر القوى غير المنضوية تحت عباءتهم. توهّموا أن تحقيق هدفهم الذي يسعـــون إليه منذ تأسيس الحركة في عشرينات القرن الماضي في الوصول إلى السلطة، سيمكنهم من السيطرة على المجتمع المصري والحياة السياسية فيه. ولأنـهم أصحاب نظرية شمولية ترفض الآخر، اعتبر «الإخوان» أن النموذج الإيراني أو الشيوعي سيسود في مصر، وسيجعل الشعب يخضع لسلطتهم بالقوة كما حصل في هذين النموذجين.
هكذا، بدأ «الإخوان» ممارسة سياسة الهيمنة على مؤسسات الدولة، من المؤسسة العسكرية إلى المؤسسات الإدارية، إلى وسائل الإعلام، إلى إعلانات دستورية تعيد إلى مصر أسوأ أنواع الديكتاتورية، أين منها ديكتاتورية زمن مبارك. وفي سياق سلطتهم أقصوا القوى السياسية الأخرى، بما فيها قوى إسلامية سبق وتحالفت معهم. لم تنجم ممارسات «الإخوان» هذه عن أخطاء قد يقع فيها كل طرف يصل إلى الحكم، لكن هذه الممارسات هي تتويج لمنظومة أيديولوجية متماسكة لديهم تنبع من نظرتهم إلى أنفسهم على أنهم بشر فوق البشر، «يحق» لهم أن يحكموا مصر وسائر العالم الإسلامي. فوظفوا الدين في خدمة مشروعهم السياسي، وأثاروا الكراهية بين مكونات المجتمع المصري، كما أثاروا الغرائز الطائفية، وهي أمور لم تنبع من خطأ في الممارسة، بل تقع في صلب تكوينهم الأيديولوجي والسياسي.
سيعود التاريخ ليثبت أن التحولات السياسية في مصر تشكل مفتاحاً لتحولات في سائر أقطار العالم العربي. وما أصاب حكم «الإخوان» في مصر سيشكل درساً للتيارات الإسلامية الساعية إلى السيطرة على مقدرات المجتمعات العربية، بأن برنامجها السياسي وعقليتها في الحكم سيكون مآلهما الفشل بعد أن انهار المشروع السياسي لأب هذه التيارات وأمها، أي «الإخوان» المسلمين.
يستحق «الإخوان» المصير الذي آلت إليه أحوالهم بعد سقوط حكمهم، وتستحق الجماهير المصرية كل التحية لكونها عادت لتعطي الأمل للجماهير العربية بأن خيارها الديموقراطي ليس مقفلاً، وأن النضال في سبيله يستحق التضحيات.
الحياة
خطيئة “الإخوان” وخطر العسكر
يوسف بزي
إذا كان الرئيس جمال عبد الناصر هو أول مصري يحكم مصر منذ عصر كليوباترا، فإن الرئيس محمد مرسي هو أول حاكم مصري على الاطلاق يتم اختياره من قبل الشعب. هو أول رئيس “منتخب” بكل نزاهة وديموقراطية. بل هو أول رئيس مدني منذ العام 1952.
مع ذلك، وبعد عام واحد بالتمام تم “عزل” محمد مرسي، أي بعد عامين فقط من”خلع” الرئيس السابق حسني مبارك، القابع في السجن. لا يمكن فهم هذا المسلسل الدراماتيكي بأنه مجرد “انقلاب” قام به الجيش ليطيح بالتجربة الديموقراطية، ولا بأنه “مؤامرة” خارجية، وفق سيناريو إيران 1953 للإطاحة بمحمد مصدق, ولا بأنه “ثورة ثانية” مضادة قام بها “الفلول” و”الدولة العميقة”. فعلى الأرجح، ما حدث بين 30 حزيران و3 تموز، هو استمرار لثورة 25 كانون الثاني 2011. طور جديد يؤكد على عمق الثورة المصرية وقوتها الجارفة والجذرية، أو بالأحرى هي تأكيد على شمولية “الربيع العربي” واستمراريته، لا في مصر وحدها بل في كل الدول التي شهدت ثورات، كما في الدول التي تتوجس اندلاعها اليوم أو غداً.
إن أعظم إنجاز تاريخي تحقق عام 2011 في العالم العربي، هو ان المواطنين أمسكوا بحريتهم ولن يفلتوها ثانية. وهم مصممون على التعبير والمشاركة في السياسة، وعلى المراقبة والمحاسبة، وعلى عدم الخضوع لـ”القدر” ولا الانقياد لأي سلطة تناقض طموحهم في الحرية والكرامة والعدالة.
على هذا الإنجاز، وبسببه، اندفع المصريون إلى الاستفتاءات وإلى الانتخابات النيابية والرئاسية، ومنعوا مرشح “الفلول” أحمد شفيق من الوصول إلى الرئاسة، كما أجبروا في المرحلة الانتقالية الأولى المجلس العسكري على تنفيذ برنامج تسليم السلطة في مدة وجيزة تحت شعار “يسقط حكم العسكر”. كانت الثورة تواجه رموز النظام أولاً، ثم مجمل منظومته ومؤسساته “العميقة” والمتجذرة في بنية الدولة و”ثقافتها”، وهي تشكل كتلة إجتماعية ـ طبقية متمكنة ووطيدة، في الجيش والشرطة والإدارة والقضاء والإعلام ومصادر الثروة الوطنية والمرافق الحيوية..
التصدي لكل هذا، معطوفاً على السعي إلى التحول الديموقراطي في الدستور وفي الممارسة السياسية وفي ثقافة الحكم، كان مهمة ثورة تتصف بأنها مكوّنة من جناحين، يتم تسميتهما اصطلاحاً “التيار المدني” و”التيار الإسلامي”.
وإذا كان التيار المدني في مصر عبارة عن ائتلاف فضفاض ومتنوع، فإن التيار الإسلامي أكثر تماسكاً وتنظيماً، وتقوده جماعة “الإخوان المسلمين”، التي تأسست عام 1928، وهي صاحبة تاريخ مديد من العمل السري النشط، وعانت الاضطهاد والملاحقة طوال عقود، لكنها منذ منتصف السبعينات استطاعت إبرام عقد غير مكتوب مع السلطة: عدم تهديد النظام مقابل إطلاق يدها في “العمل الاجتماعي” (العمل الخيري والدعوى معاً). وبين القمع وغض النظر عنهم، استطاع “الإخوان المسلمون”، بالتزامن مع صعود الإسلام السياسي في أرجاء العالمَين الإسلامي والعربي، تكوين قاعدة اجتماعية عريضة مؤيدة لهم، عدا عن تراكم خبرتهم وصقل حنكتهم في العمل السياسي “الباطني” والكتوم (إن صح التعبير).
صحيح أن “الإخوان المسلمين” تأخروا أياماً قليلة عن ميدان التحرير عام 2011، لكن انضمامهم إليها كان أصيلاً وليس انتهازياً، وهم منحوا الثورة زخماً أتاح امتدادها إلى أنحاء مصر وبخاصة في الأرياف والضواحي ومدن الصعيد والدلتا والإسكندرية ومدن السويس، عدا القاهرة نفسها.
بهذا المعنى، كان “الإخوان المسلمون” أكثر استعداداً وجهوزية لخوض تحديات ما بعد سقوط النظام، ومهيئين للاستحقاقات الكبرى: الاستفتاءات، الانتخابات، كتابة الدستور.. وفي أثنائها جميعها، ممارسة كل أنواع المناورات والتكتيكات السياسية الممكنة للوصول إلى السلطة بوسائل شرعية (وديموقراطية). كانوا جاهزين لقطف ثمار الثورة.
غفل “الإخوان المسلمون”، بعد استلامهم للحكم أن التفويض الانتخابي الذي منحته الثورة لهم، إنما هو من أجل تحقيق أهداف الثورة المصرية لا برنامج حزبهم (حزب “العدالة والحرية)”: “التمكين” في أجهزة الدولة و”أخونة” المجتمع. وغفلوا أيضاً أن الديموقراطية ليست فقط أن “تصل” إلى السلطة بالانتخابات، لكن أيضاً أن “تحكم” بالديموقراطية. لقد نسوا منطلقات الثورة واستخفوا بالمعارضة. ويمكن تعيين الخطأ الاستراتيجي للإخوان في يوم 22 تشرين الثاني 2012 عندما أصدر الرئيس محمد مرسي إعلاناً دستورياً يفوّض نفسه بموجبه صلاحيات شبه مطلقة، ثم جاءت الخطيئة المميتة عندما أعلنت الجمعية التأسيسية في الشهر ذاته إقرارها للدستور الجديد، رغم مقاطعة القوى المدنية والكنيسة، واعتراض النخب والجسم القضائي.
بدا واضحاً للجميع أن “الإخوان المسلمين” يسعون نحو حكم الحزب الواحد. وفوق كل هذا رأى المصريون، وهم المتدينون والمحافظون تقليدياً، أن “الإخوان” ينظرون إليهم بوصفهم ليسوا مسلمين كفاية، لذا بات محمد مرسي ليس رئيساً لجميع المصريين.
بسبب تلك السياسة الاستئثارية، مضافاً إليها الفشل الاقتصادي والإداري والأمني والتخبّط السياسي، تجدّدت الثورة ودخلت في طورها الثاني مع انطلاق حركة “تمرد” (26 نيسان 2013)، التي ستؤسس لائتلاف ما لا يأتلف: حزب الكنبة، الفلول، الشرطة، الجيش، الجسم القضائي، الأزهر، الكنيسة، الإعلام، البيروقراطيون والمجتمع المدني والقوى الثورية الشبابية والمعارضة التقليدية. ويمكن القول أن “الإخوان” حشدوا، بسبب عنجهيتهم، كل مصر عدا المحازبين لحزب “العدالة والحرية”. ولم يجدوا معهم في ميدان رابعة العدوية سوى الملاك جبريل، حسب قولهم!؟
خرج “الإخوان المسلمون” من الحكم ومن الثورة أيضاً، لكن من الخطأ إخراجهم من الحياة السياسية أو إجبارهم على المنفى أو إقصائهم من الحياة العامة، فكما أن الفلول ارتضوا طيّ زمن النظام السابق فإن للإخوان المسلمين الحق بـ”المراجعة” وباستئناف الحضور.
ومن الخطأ أيضاً أن تسمح المعارضة، التي استقوت بالجيش للإطاحة بمحمد مرسي، بعودة العسكر إلى السياسة، أو بإقرار سلطة الجيش على القرار السياسي، وإلا فسيكون يوم 3 تموز 2013 ليس استرداداً للثورة والديموقراطية بل هو “انقلاب” عسكري “كامل الأوصاف”.
العالم العربي كله ينتظر.
المستقبل
إعادة اعتبار للشعب والثورة
سليمان تقي الدين
خلال سنتين ونيّف من عملية ثورية متواصلة متعددة الأشكال، سلمية وديموقراطية، حقق الشعب المصري تغييراً سياسياً مهماً كان الأبرز فيه حفاظه على وحدته وتمسكه بتراثه المدني والحيوية الاستثنائية لأوسع فئاته. لم تكن ثورة مصر أبداً «ثورة ملونة» أو عملية سياسية مدبّرة من خارج أو حركة جماعة أو حزب أو تيار، بل كانت أصيلة عميقة الجذور وشاملة فاستحقت أن تكون نموذجاً رائعاً للثورة ولتصحيح مسار الثورة بوعي شعبي ومثابرة وتصميم قل نظيره أمام محاولات الاحتواء والسرقة والمصادرة والتحوير.
اختبر الشعب المصري سريعاً التجربة «الإخوانية»، بل تجربة الحزب المنظم الذي أراد ان يختصر لنفسه وبنفسه الثورة والدولة والمجتمع. أخذت هذه التجربة مداها فإذا هي تكرار فاشل وممسوخ لحكم الحزب العقائدي الواحد وللنزوع الشمولي الفاشي لإعادة تشكيل المجتمع على نموذج نقيض لحريته ونمط عيشه وكرامته. وبمقدار ما كانت انطلاقة الثورة مفاجئة بزخمها كان الاستمرار في المحاسبة والمساءلة مفاجئاً ومدهشاً من حركات شبابية أثبتت انها تعرف تماماً ما تريد، وكيف تُسقط الهالة والمهابة المزيّفة لجماعات تأخذ رصيدها من التلاعب الانتهازي بالشعارات وبالدين وهي مكشوفة الارتباطات ومغرقة في التبعية واستدرار الدعم الخارجي لتثبيت سلطتها.
ما أُنجز هو الثورة وما بقي لا يزال هو مهمة بناء الدولة المدنية أولاً لكل مواطنيها وحقوقهم، والعادلة ثانياً بتكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية التي تصحّح منظومة طويلة من المظالم والامتيازات والحرمانات والتلاعب بالموارد القومية، وضرورة تحقيق السيادة الفعلية بوجهيها السياسي والاقتصادي. ولعل معركة الدستور هي الأولوية التي ستعيد تأكيد انبثاق السلطة من الشعب وكيف سيمارسها عبر المؤسسات الديموقراطية ومن خلال دولة القانون.
إلا ان الحدث المصري له دلالات أخطر من ذلك. فهو يرد الاعتبار بقوة للثورات وللربيع العربي الذي تضافرت على تشويهه تيارات الإسلام السياسي ومداخلات النظام التقليدي العربي ومحاولات الاحتضان المشبوه و«الحب القاتل» الغربي وغير الغربي. فلم تكن الثورة المصرية إيذاناً بانبلاج عصر الإسلام السياسي الثوروي الذي ينتهي إلى خيار بين أمرين: أحدهما نظام شمولي مغلق، وآخر ليبرالي تابع للنظام الدولي واحدى أدواته. لا تسعف ثورة مصر المبشّرين بالدولة القوية والحديثة والعادلة من خلال حكم وسلطة جماعة دينية أو حزب يحاول ان ينقض التطور الحضاري المدني لشعب باسم ثقافة بدائية أو سلفية أو أصولية تأتي من خارج سياق الطبيعة المتراكمة والمكتسبة وإبداعاتها. فلم يسقط الإسلام السياسي الإخواني وحده في ثورة مصر وهو إسلام طوائفي منتج في بيئة وأجهزة ومصالح وعبر أشخاص يطبعونه بطابعهم ونوازعهم.
لقد سقط مشروع الاعتداء الشامل على حرية المجتمع بفرض عقيدة أو فرض نظام أو خيارات من خارج وعيه وإرادته وحريته. سقط حكم الجماعة والحزب والقائد والديكتاتور والطغمة بمختلف أشكاله وتجلياته. ومن مصر نستمد الروح ليس فقط لتصحيح التوازن الإقليمي المختل بصورة كاسحة في الاتجاه السلبي ضد حقوق الشعوب العربية، بل كذلك لمواجهة كل الهراء والمراوغة والادعاءات التي جرّبت ان تحول ثورات الشعوب العربية إلى مشاريع مؤامرات أو حركات فوضى وعنف وإرهاب، وفي أحسن الأحوال إلى تخريب أنظمة التسلّط التي أنتجت الثورات وأنتجت كذلك تشوهاتها حيثما وقعت هذه التشوهات أو انكسرت إرادة الشعوب أمام التعاون والتقاطع المعروفين في المصالح الإقليمية والدولية.
وتبقى تجربة مصر مثالاً لإجماع «الشعب» لا القبائل والطوائف وشيوخها وزعمائها ومرشديها وقديسيها. ففي الميدان الذي صنع التغيير صورة كل الأطياف والفئات والبيئات والمهن والكادحين بسواعدهم وعقولهم والمثقفين بقطاعاتهم والفنانين بفرحهم والإعلاميين والتواصليين بشاشاتهم وسخريتهم وغضبهم وبهجتهم، الذين صنعوا ويصنعون الحياة وثقافة الحياة الحرة الكريمة ضد جلاوزة السياسة وشعوذة وتهريج الفكر والعقم الفكري والسياسي.
السفير
الدرس المصري
سناء الجاك
مرةً جديدة يأتي المشهد من مصر ليمنحنا الأمل بأن التغيير ممكن من دون سفك دماء، وبأن المخاض مهما جاء صعباً ومعقداً ثمة ربيع سيولد مكتملاً، ولو بعد حين. اليوم وأكثر من أي وقت مضى، للدرس المصري أهميته. فهو لا يُقرأ فقط في أرض الكنانة بل يتجاوزها الى حيث تجب القراءة. الأهمّ أن من أسقط نظام مبارك قادر على إسقاط نظام “الإخوان”. محاولات استخدام أسلوب النظام السوري الدموي لإفشال حركة 30 يوليو لم تنفع. الجيد ان هذه الحركة ترافقت مع جهود الأمن المصري لحماية الاستقرار والسماح للشعب بالتعبير عن رفضه ممارسات الرئيس المصري محمد مرسي ومن يقف خلفه ويلقّنه كيفية التسلل الى الدولة ومؤسساتها للاستيلاء عليها. ولأن الإحباط ليس قدراً، لم يكتف الشعب المصري بالبكاء على أطلال ثورته في مواجهة سرّاق هذه الثورة. أيضاً لم تفلح محاولات جرّه الى الفتنة لتنحرف قضيته عن مسارها وتغرق مصر في حرب أهلية تساوي الضحية بالقاتل، حيث يبدأ الحديث الدولي والاقليمي عن طرفَي نزاع يجب أن يجلسا الى طاولة حوار لإمرار تسويات الكبار ومطامعهم على حساب الصغار، تماماً كما يحدث في نعيم النظام الأسدي، وكما تعبث الأيدي ليلتحق لبنان بالمسار والمصير في سوريا.
الدرس المصري يصفع كل من يريد ان يصوّر الثورات حركات اسلامية سلفية، ويصوّر أكثرية الشعوب الساعية الى التغيير “تكفيرية”، ولا يريد أن يرى أن فورة الإسلاميين والسلفيين والمتطرفين بعد الثورات تعود إلى جهوزيتهم أكثر من الشباب المندفع غير المسيّس، وإلى جهوزية من يدعمهم ويمدّهم بالمال والخبراء ويفتح لهم وسائل إعلام على قياسهم.
في تونس مثلاً، وبعد الثورة، قالت لي محامية ناشطة إن في الشارع حيث تسكن يتم استئجار شقق لجمعيات إسلامية لم يسمع بها أحد من قبل، ويتم دعمها بالمال لتجذب المنتسبين إليها، في حين يناضل العلمانيون وناشطو الحراك المدني لغرس اسس شفافة للديموقراطية لا يجدون من يمد إليهم يد العون. كما في تونس، شهدت ليبيا محاولات تسلل إلى ثورتها حتى وصل الأمر إلى رفض كل الأجانب مع التشديد على رفض فئة بعينها تمتد أصابعها من محور الممانعة إلى المرحلة السياسية لما بعد القذافي. في اليمن حدِّث ولا حرج. فالعابثون أكثر جرأة وشمولية، دعم لـ”القاعدة” وللحوثيين. المهم ان تفشل الثورة وتدبّ الفوضى ويتمّ إرساء مَواطن قدم للنفوذ الإيراني. في لبنان، جهابذة الممانعة عندنا يخوضون حربهم الضروس ضد الشعب السوري لحماية نظام يتيح لهم إبقاء طريق الحرير سالكة وآمنة. يفجرون ظاهرة في صيدا وأخرى في طرابلس، ويلاحقون داتا الاتصلات بأسرع من البرق، ولا يتوقفون عند تفاصيل صغيرة كقتل هاشم سلمان أمام السفارة الايرانية كأن الامر لم يحصل في الأساس.
الدرس المصري فضح الجميع، في مقدمهم هؤلاء الذين حسبوا أن المرحلة مرحلتهم ليبقوا الى الأبد. لم يتعلموا انه لو دامت لغيرهم لما وصلت اليهم. استعجل “الإخوان” فانكشف أمرهم وتبيّن أنهم حاضرون لمدّ اليد إلى أيّ شيطان يموّلهم ويدعمهم ويدرّب عناصر منهم على الخطف والقتل للقضاء على معارضيهم، واتهامهم بالزندقة والفحشاء، تماماً كما يتهم ديكتاتوريون آخرون من يعارضونهم بأنهم “تكفيريون” ويستحضرون متطرفين يدعمونهم سراً ويتخذون منهم سببا لإبادة الشعب علناً.
الدرس المصري يفضح كل من لا يقبل إلاّ من كان على مثاله. محور الممانعة يريد لجميع اللبنانيين والسوريين ان يكونوا على مثاله. جنرال الرابية يؤكد ان أصهرته على مثاله، لذا يجب ان يحتلوا كل منصب يليق بهم في دولتنا العلية. “الإخوان” يفخخون الجيش المصري ليصبح على مثالهم، ولا يتعاونون سرّاً إلاّ مع من كان على مثالهم. كل من يفضحه هذا الدرس يلجأ الى الباطنية والتقية وما الى ذلك من طرق تكفل له الاستمرار والسيطرة لنصرة الاسلام، أو “حماية” الأقليات الخائفة من الاسلاميين.
النهار
إتجاه – “الاخوان” والديموقراطية
محمد ابرهيم
آخر من يحق له الحديث عن الشرعية والديموقراطية والانتخابات والصناديق هم “الاخوان المسلمون” في مصر.
كان واضحا منذ بداية الثورة على مبارك ان هناك قوى ثلاثا نجح تناغمها في انهاء عصره: الشباب و”الاخوان” والجيش. لكن الادوار، لم تكن متساوية. فالمبادرة، وتحمل الاكلاف الاصعب، والتصميم، كانت كلها من حصة “الشباب”، فيما كان الدور الاسلامي هو الدعم، لكن المتردد في احيان كثيرة، والانتهازيي في بعض الاحيان. اما الجيش فمساهمته كانت ايجابية في سلبيته تجاه دعوات مبارك الى التدخل ضد الشعب.
من هنا كانت الشرعية الثورية في معظمها من نصيب “الشباب”. لكن المشكلة كانت عدم التناسب بين قوة الشباب الثورية وقوتهم الانتخابية، خصوصا مع التفتت والهزال التنظيميين للمعارضة العلمانية.
لقد استعمل “الاخوان” مزيجا من الانتهازية في التعامل مع الجيش، ومن الاستثمار الاقصى لقواعدهم الانتخابية القديمة، لتحقيق هدف الانفراد بالحكم بصفته الفرصة التاريخية التي لن تتكرر: فالجيش عاجز عن وراثة مبارك والمعارضة العلمانية عاجزة عن توظيف شرعية الشباب الثورية.
لكن حتى بمقاييس موازين القوى بين مكونات الثورة فإن الانتخابات الرئاسية التي شكلت اساس الشرعية “الاخوانية”، لاحقا، لم يفز فيها مرسي في وجه شفيق،إلا بعد انحياز المكون الشبابي- العلماني اليه. من هنا فإن الحديث عن الشرعية الانتخابية لمرسي في وجه “الشباب” يفقد الكثير من شرعيته.
لقد كان واضحا في ذهن “الاخوان” انهم يقتنصون لحظة تاريخية لن تتكرر، ليس لإرساء نظام ديموقراطي، وانما لبناء نظام اسلامي يصعب لاحقا اطاحته بعد ان يكون قد ارسى آليات اعادة انتاجه بتوجيه ضربات للقضاء والاعلام يعود بعدها الى تصفية الحساب مع الجيش.
لو كان “الاخوان” يرغبون فعلا بنظام ديموقراطي ينقلهم من مرحلة حزب نزلاء السجون الى الحزب الشريك في السلطة او في المعارضة، كان عليهم ان يتبنوا برنامج الحد الادنى للقاء القوى الثورية، ولا يشمل ذلك اطلاقا ان يتصدر الثورة رئيس اخواني او ان تكون الجمعية التأسيسة اسلامية.
واليوم، وبعد كل ما حدث، فإنه لا يزال في مستطاع اخوان مصر تحديد ما اذا كانت مصر تتجه نحو بناء نظام ديموقراطي ام نحو اعادة بناء نظام عسكري. فلا شيء يخدم ترسيخ نفوذ الجيش ومصادرته الثورتين الاولى والثانية اكثر من المعارضة الاسلامية التي تجنح نحو العنف. ولا شيء يسمح باعادة الجيش الى ثكناته اكثر من ادراك الاسلاميين، انهم جزء، لا اكثر، من مصر الجديدة التي لا تستطيع ان تبقى تعوّض بثوراتها عن ضعف مؤسساتها.
النهار
ظل المرشد وظل الجنرال
غسان شربل
ذهب الدكتور محمد البرادعي إلى قصر الاتحادية للقاء رئيس مصر محمد مرسي بناء على اقتراح الأخير. كان الاجتماع ثنائياً لكن الزائر استشعر وجود آخرين. رأى وراء الرئيس ظل المرشد محمد بديع وظل نائبه خيرت الشاطر. وهذا النوع من الظلال مثير للشكوك. خاف الزائر أن يكون المرجع الفعلي للرئيس مرشد الجماعة لا الدستور. ولهذا قال البرادعي لصحيفتنا «التقيت الرئيس وحاورته ويئست منه».
ذهب حمدين صباحي إلى قصر الاتحادية. إصرار الظلال على حضور الاجتماع ذكره بما دار بينه وبين مرسي المرشح قبل الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية. كان حمدين نال ما يقرب من خمسة ملايين صوت في الدورة الأولى لكنه خرج من السباق. وكان مرسي يأمل في اجتذاب هذه الكتلة لضمان فوزه في مواجهة الفريق أحمد شفيق. طرح حمدين على مرسي سؤالاً صعباً: «هل ستكون في حال فوزك رئيساً مستقلاً عن إرادة جماعة الإخوان؟». لم يستطع مرسي الإجابة ورد مقترحاً على حمدين منصب نائب الرئيس لكن الأخير اعتذر.
ذهب عمرو موسى إلى قصر الاتحادية والتقى الرئيس والظلين. لم يخف بعد اللقاء ومتابعته أداء الرئيس خوفه على مصر التي انجبت طه حسين ونجيب محفوظ ولعبت دوراً تنويرياً في حياة أمتها. خاف على روح مصر.
كان ذلك قبل أيام من 30 يونيو (حزيران) الذي اتفق الثلاثة في اعتباره يوماً مفصلياً. اعتبروا أن لا بد من انتخابات رئاسية مبكرة لإنقاذ البلاد من عهد مرسي وبدا واضحاً أنهم يستهدفون إنقاذها من الظل الكبير المخيم على العهد ظل المرشد.
تقضي المهنة أن لا يقع الصحافي تحت جاذبية المعارضين. لذلك كان لا بد من الذهاب إلى مقر «حزب الحرية والعدالة» الذراع السياسية لـ «الإخوان». سألت نائب رئيس الحزب الدكتور عصام العريان إن كان توقع سقوط الرئيس حسني مبارك وأن تنتقل مصر إلى العيش في ظل رئيس من «الإخوان». أعجبني جوابه: «أجزم بأن هذا الحلم لم يخطر على بال أي مصري. يكذب عليك أي مصري يقول لك إنه كان يتوقع نجاح الثورة أو سقوط حسني مبارك أو أن يصبح محمد مرسي رئيساً. لولا أن عصر المعجزات انتهى لقلت لك إننا نعيش هذا العصر».
لم يكن العريان قلقاً من «30 يونيو». طمأنينته دفعته إلى القول إن مرسي لن يكمل ولايته فقط بل قد يفوز بولاية ثانية. كان واثقاً ومطمئناً ودعانا بعد انتهاء الحديث، زميلي محمد صلاح وأنا، إلى مكتب رئيس الحزب سعد الكتاتني حيث لم نشم أيضاً رائحة قلق.
فاجأت «ثورة يناير 2011» مرشد الجماعة كما فاجأت كبير الجنرالات يومها المشير حسين طنطاوي. تصرف الرجلان تحت وقع المفاجأة. حرص الناخبين على إبعاد ظل الجنرال مبارك وجنرالاته أوقعهم في عهد مرسي وظل المرشد. لم يستطع مرسي تبديد الانطباع «أن مكتب الإرشاد هو رئيس الرئيس». تراكمت أخطاؤه ولم يرحمه الإعلام.
خوف ملايين المصريين من «الأخونة» حول «30 يونيو» إلى انتفاضة واسعة ضد الرئيس والظل المرابط في القصر. في يناير 2011 شعر طنطاوي أن على الجيش الالتحاق بالميادين. في يونيو 2013 شعر الفريق أول عبد الفتاح السيسي أن على الجيش أن يتصالح معها ويرعاها. انتفاضة واسعة كاملة وشبه انقلاب. رفض «الإخوان» الاعتراف بكامل المشهد. رفضوا التوقف عند الأسباب التي دفعت الملايين إلى الميادين للهتاف ضدهم. ورفضوا التوقف عند الملايين التي وقعت على عريضة «تمرد». فضلوا التوقف عند ظل الجنرال السيسي لتقديم الجماعة في صورة الضحية وصورة المظلوم. وحين أدى رئيس المحكمة الدستورية العليا المستشار عدلي منصور اليمين القانونية رئيساً للبلاد فضلوا الاكتفاء برؤية ظل الجنرال السيسي وراءه.
ما شهدته مصر أمس مقلق فعلاً. دفع البلاد إلى نفق الاقتتال بين ظل المرشد وظل الجنرال وخيم العواقب. جازف «الإخوان» بإدخال ظل المرشد إلى قصر الرئاسة. إزاحة رئيس منتخب في شبه ثورة وشبه انقلاب تتضمن أيضاً مجازفة. لا حل غير الإسراع في الخروج من هذا النفق. الخروج إلى مصر تعيش في ظل دستور منسجم مع روحها وفي ظل رئيس منتخب لا يكبله في القصر ظل المرشد أو ظل الجنرال.
الحياة
مصر بين صحوتين
مصطفى زين
ما يطلق عليه الصحوة الإسلامية، قابلته صحوة اجتماعية. اعتمدت الصحوة الإسلامية تأويل النص الديني ليتواءم مع تطلعاتها السياسية. ارتضت بالانتخابات وبالسلطات المتعارف عليها، سلطة تنفيذية وسلطة تشريعية وأخرى قضائية، مع تفريغها من مضمونها المعاصر، وشل عملها وتسخيرها لمصلحة الحزب الواحد (الإخوان)، في انتظار اللحظة المناسبة لإعلان الخلافة.
لربما كانت التجربتان المصرية والتونسية أفضل ما يمثل هذا التوجه. في تونس حاولت حركة «النهضة» مكرهةً التعايش مع المؤسسات الحديثة، فاصطدمت بالأحزاب الأخرى التي شاركتها الثورة على ديكتاتورية بن علي، وها هي تتنازل مرة وتتمسك بأيديولوجيتها مرة أخرى، موازنة بين تأويلها السياسي للدين واتجاهات الشارع. وبين التوجه الدولي، خصوصاً الأميركي، والبقاء في السلطة (كانت تونس من الصقور في مواجهة النظام السوري وقد خبت حماستها إلى حدود التلاشي في الأشهر القليلة الماضية).
أما في مصر، فاعتبر «الإخوان» فوزهم في الانتخابات تفويضاً شاملاً لتغيير كل المؤسسات، فراحوا يخضعونها لسلطة المرشد الذي كان يرسم السياسات، الداخلية والخارجية، ويكلف الرئيس محمد مرسي تنفيذها.
بمعنى آخر، شكل المرشد ومجلس الشورى و «دار الخلافة» السلطة الفعلية، وتحول الرئيس إلى والٍ يحكم باسمه، يساعده في ذلك مجلس الوزراء والقضاء والبرلمان. وتعينه هذه المؤسسات مجتمعة في تطبيق نظرية «التمكين»، أي السيطرة على كل مفاصل الدولة والأحزاب والهيئات المدنية والإعلام والقوات المسلحة والمؤسسة الأمنية (بدأ عدد من قادة الشرطة وعناصرها يطالبون بالسماح لهم بإطالة لحاهم شرعاً).
لتطبيق هذه النظرية، اعتمد «الإخوان» سياسة خارجية مهادِنة إلى حدود الرضوخ للشروط الدولية (اقرأ الأميركية)، فحافظوا على اتفاقات كامب ديفيد مع إسرائيل، وهدموا الأنفاق الواصلة إلى قطاع غزة، وأقنعوا حركة «حماس» بوقف المقاومة، وكفلوا تحولها إلى حركة سياسية «مسالمة». ووقفوا بحماسة شديدة ضد النظام السوري، وتراجعوا عن التفاهم مع إيران، معتبرين ذلك انتساباً إلى التوجه الدولي في الشرق الأوسط، علهم «يتمكنون» ويستفردون بالحكم في مصر. أي أنهم اتبعوا سياسة النظام السابق للتغطية على ممارساتهم الداخلية. لكن مثلما لم تحم هذه السياسة الخارجية حكم مبارك في مواجهة الجماهير (للمرة الأولى يعرف العالم ما تعنيه هذه الكلمة) كذلك لم تستطع هذه «الفهلوة» حماية «الإخوان».
سياسة «التمكين» جعلت حكم «الإخوان» يستعجل السيطرة على كل المؤسسات، فاستعْدَوْا عليهم الأحزاب والمؤسستين الأكثر عراقة ورسوخاً في مصر، الجيش والأزهر.
للمقارنة فقط، استغرق الأمر رجب طيب أردوغان عشر سنوات كي يتمكن من القضاء والمؤسسة العسكرية التركية، بينما بدأ مرسي من الأسبوع الأول عملية التطهير في القضاء ووزارة الداخلية وتغيير القوانين. وحاول وضع يده على الأزهر.
في المقابل كانت صحوة الجماهير بالمرصاد لـ «فقه الحيلة» الذي اعتمده الإخوان. تحركت الأحزاب اليسارية والقومية والليبرالية وهيئات المجتمع المدني والإعلام، وكلها شارك في الثورة على الديكتاتورية والحكم الأوليغاريشي، وطالب بالحرية والكرامة، وبعودة مصر إلى دورها العربي، بعد عقود من الوقوع في الكوما وإدارة الظهر لكل ما يحدث في بلاد الشام وفي أفريقيا، وهما المَدَيان الإستراتيجيان الحيويان لمصر.
انتفض الناس واستعانوا بالمؤسستين العسكرية والدينية، وكان لهم ما أرادوا. وقف قائد الجيش، وإلى جانبه شيخ الأزهر وبابا الأقباط، مدفوعاً بالخوف من فتاوى مرسي ودعوته إلى الجهاد، وارتداد ذلك إلى الداخل وتوريط القاهرة في الحرب على سورية، فأقاله.
ضرب الجيش ضربة استباقية قبل أن يتمكن «الإخوان» منه، استعاد السيطرة على الأوضاع بغطاء «شرعي» من الجماهير ومن المؤسسة الدينية.
الجميع عينه على مصر، وهي الآن بين صحوة الماضي الآفل بسرعة وصحوة الحاضر التي لم تخط في طريقها بعدُ، ومضطرة إلى الاستعانة بالعسكر، وهذا مكمن الخطر الذي لا بد منه.
الحياة
بعد نكسة 30 يونيو.. ماذا يَنتظر قيادة «الإخوان» بمصر.. إقالة أم استقالة؟
جمال خاشقجي *
يفترض أن حملة الاعتقالات التي يشنها «النظام الجديد» بمصر على «الإخوان المسلمين» ما هي إلا موقتة فرضتها ظروف الانقلاب والخشية من أن ينظم «الإخوان» أو أنصارهم مقاومة له تفتح باباً لفتنة لا يريدها أحد، ذلك أن مثل هذه العلاقات تتنافى مع روح الثورة الأولى (25 يناير) التي قيل إن الثورة الثانية (30 يونيو) جاءت لتصحيح مسارها.
ويفترض أيضاً أن تتعافى القوى المدنية من نشوة الانتقام وتعود إلى مبادئها فترفض اعتقال خصومها من «الإخوان»، وقمع الحريات الإعلامية ونزعة الإقصاء المتنامية في الإعلام المصري، فتدعم المصالحة الوطنية ومشاركة الجميع في بناء مصر جديدة بعد السقوط السريع للجمهورية الثانية.
ويفترض أيضاً أن يتوقف «الإخوان» عن تسيير التظاهرات تحت راية «إعادة الشرعية»، والاكتفاء بالرسالة التي بعثوا بها، وهي أنهم ضحوا وماتوا من أجل مبادئ الديموقراطية وسيادة الشعب، فهم يعلمون (أو يفترض ذلك) أنهم سيعجزون عن إسقاط النظام الجديد الهجين والمختلط بين عسكر ومدنيين ويتمتع بمباركة الدولة العميقة (نظام مبارك) وقوى إقليمية، فالتظاهرات الحاشدة التي أسقطتهم سمح لها وشجعت وموّلت من دولة عميقة وقوى خارجية وإعلام متواطئ ضدهم، أما تظاهراتهم فهي تفتقد كل ذلك، وسيتم التعامل معها بقسوة لأنها «تهدد الوحدة الوطنية». نعم إنه تمييز في المعاملة، ولذلك جعل الله سنة التدافع والابتلاء، والحصيف من أدرك ذلك.
بعد حصول كل الافتراضات السابقة سيكون من الجيد أن يقبل «الإخوان» ولو على مضض بالأمر الواقع على طريقة الاعتراف «دي فاكتو» ليس بالنظام القائم وإنما بالواقع، ويعودوا إلى الساحة التي يجيدون التدافع فيها، أي العمل السياسي، يجب ألا يغرقوا في قصة المؤامرة، فهي موجودة، وثمة من أراد سقوطهم وعمل على ذلك، ولكنهم سقطوا بما كسبت يداهم، هل هناك خطأ أكبر من اختيار أضعف القيادات لتقود أخطر مرحلة؟ يجب أن يقتنعوا بأن الملايين التي خرجت في 30 يونيو أرقام حقيقية وجزء كبير منها صادق.
أمام «الإخوان» مهمات عدة، ولعل من أهمها دراسة حالة الكراهية والرفض لهم من قبل قطاع كبير من المصريين. إنها خسارة أكبر من خسارة الحكم، ما يستدعي الإجابة عن السؤال «لِمَ يحمل لنا البعض هذه القدر من الكراهية؟»، الإجابات الأسهل مثل أن هؤلاء من «الفلول»، أو لأنهم غير متدينين، مريحة ولكنها ليست صحيحة. الخطوة الأولى هي الاعتراف بأن «الإخوان» خسروا الكثير في قلب وعقل المواطن المصري.
يجب ألا يراهنوا على رفض المجتمع الدولي للانقلاب. إنه مجرد احتجاج روتيني من قوى غربية. ليكن الضغط الآن على السلطة الجديدة للتعجيل بخريطة الطريق وإجراء الانتخابات ومنع الإقصاء وعودة السلطة للشعب، ففي ذلك مساحة ستعيدهم إلى أجواء التعاون مع القوى الوطنية الأخرى، وإن كنت أتوقع أن ثمة قوى ستسعى إلى إقصاء «الإخوان» وإذلالهم، وستحاول دفع الآخرين لرفض التعاون معهم، حركات صبيانية ولكن السياسة المصرية للأسف طافحة بها.
ولكن قبيل ذلك أو معه، لا بد لـ «الإخوان» من إعادة ترتيب بيتهم من الداخل، ومن ثم ساحة الإسلام السياسي الذي خسر الكثير في نكسة 30 يونيو.
في أدبيات «الإخوان المسلمين» حديث متكرر عن تحويل «المحن إلى منح»، فلتكن هذه إحداها. لعل حكيماً بينهم يقول لهم «لا تحسبوه شراً لكم، بل هو خير لكم» فالانقلاب جاء في الوقت المناسب لتطهيرهم من جملة من الأخطاء تدافعوا إليها منذ أن قرروا دخول الانتخابات الرئاسية. أخطاء كفيلة بأن تفكك الجماعة من الداخل، فما تسرّب من خلافات بين قطبيها نائب المرشد خيرت الشاطر والقيادي المعتدل حسن مالك أثار قلق قواعد الجماعة، وخوفها على تماسك الجماعة. ليس سراً أن «إخواناً» حقيقيين (الكاتب الشهير صاحب سر المؤلفات العديدة ضد «الإخوان» ثروت الخرباوي ليس منهم) انصرفوا بعيداً وبهدوء وآثروا الصمت تقديراً للمرحلة التي تتطلب وحدة الصف.
حان الوقت لجلسة محاسبة وجرد للمكاسب والخسائر، وعملية إعادة هيكلة للجماعة تحميها من عملية التآكل التي أصابتها منذ عقدين، التي خسرت فيها خيرة قياداتها، والتي كانت السبب الرئيس لنكسة 30 يونيو.
إن محور الصراع داخل الجماعة هو بين تيارين، عنيد يرى الجماعة قلعة متماسكة تقود المجتمع، وتيار يرى الجماعة قوة وطنية بين آخرين، مستعدة للتعاون والتنازل وقبول أنصاف الحلول. المجموعة الأولى يمثلها خيرت الشاطر، أما المجموعة الثانية فهم أمثال أبوالعلا ماضي، وعصام سلطان، والدكتور محمد محسوب، وآخرهم عبدالمنعم أبوالفتوح. إن أياً من الأسماء السابقة كان قادراً أن يقدم وجهاً مقبولاً للإسلام السياسي لو حلّ مكان الرئيس «المقال» محمد مرسي الذي كان مجرد «إخواني» تقليدي دفعته الظروف إلى سدة القيادة.
منذ أعوام وثمة حديث عن إصلاحات أردوغانية تحتاجها الجماعة، في إشارة إلى ما فعله رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، ولكن كانت دوماً تنتهي بخروج أو إخراج دعاتها من الجماعة. بعد ثورة 25 يناير 2011 جرت تلك الإصلاحات ولكن بشكل ظاهري فقط، عندما شكّل «الإخوان» حزباً سياسياً مستقلاً يمثلهم هو «الحرية والعدالة»، ولكنه كان مجرد واجهة، فأسوأ قرار اتخذه الرئيس المقال (التعديلات الدستورية في تشرين الثاني /نوفمبر الماضي الذي كان بداية النهاية)، لم يتخذه بناءً على معلوماته كرئيس له مخابرات وأمن، بل بناء على معلومات وتوصيات مكتب الإرشاد.
خلال الأزمات التي صنعها الرئيس مرسي أو صنعت له، برزت كفاءات إسلامية خارج حزب «الإخوان» (الحرية والعدالة)، كانت أقدر على التواصل مع القوى الوطنية الأخرى، وأكثر إقناعاً، مع التزام كامل بالمشروع الإسلامي الوطني، خصوصاً في حزب الوسط، وحزب النور السلفي. إنه من العبث أن تبقى هذه التيارات العدة متفرقة. المشروع الأردوغاني يقول بذلك، ولا يمكن لهذه التيارات أن تندمج في تكتل واحد طالما أنه يتلقى أوامره من «الإخوان»، ولكن يمكن في لحظة التأمل هذه، بعيداً عن الحكم، واستعداداً للجولة الثانية في بناء الدولة المصرية الجديدة، أن تتدارس القوى الإسلامية الشابة كيف تستطيع أن تخرج بمشروع توحيدي كهذا، ولكن يحتاج ذلك إلى قرار من «الإخوان» ومرشدهم بالابتعاد عن مجريات الأمور والبقاء في مجال الدعوة للفكرة الإسلامية وليس لتفاصيلها.
هل يستطيع «الإخوان» ذلك؟ بالطبع، إذا ما تحملت القيادة التي خسرت معركة 30 يونيو مسؤولياتها، فتستقيل طواعية وتفتح الباب أمام جيل جديد يفهم التحولات من حوله ويتفاعل معها بشكل أفضل.
* كاتب وإعلامي سعودي
الحياة
في أسباب السقوط السريع
سميح صعب
كثيرة هي الأسباب التي أودت بحكم “الأخوان المسلمين” في مصر. لكن أهمها ان الاداء السياسي للجماعة لم يكن مقنعا بالنسبة الى المصريين من غير المنتمين اليها. من الانفراد بالحكم وتجاهل المعارضة الى سلوك الرئيس السابق محمد مرسي الذي كان أشبه بزعيم حزبي أكثر منه رئيساً لكل المصريين كما كان يفترض فيه ان يكون. وكانت خطبه الثلاثة الاخيرة أسطع دليل على ضيق صدره بالصوت الآخر وبالمعترضين على حكمه.
وعليه فإن أكثر ما عجل في اسقاط حكم “الاخوان” كان “الاخوان” أنفسهم الذين رفضوا ان يخرجوا من الخطاب الحزبي الضيق الى الخطاب الوطني الذي كان يمكن ان يشكل رافعة تمكنهم من الاستمرار في الحكم مدة أطول. وكان هذا الخطأ الاكبر الذي اقترفه مرسي ومن ورائه “الاخوان المسلمون” الذين لم يستهدوا بتجربة اخوانهم في حزب العدالة والتنمية في تركيا الذين بداوا حكمهم عام 2002 باعلان الولاء للجمهورية وبالابتعاد عن كل ما من شأنه ان يثير نقمة المؤسسة العسكرية. ولم يتجرأ اسلاميو تركيا على لجم دور المؤسسة العسكرية والتصرف بحزبية ضيقة الا بعد عشرة اعوام من تسلمهم الحكم. اما “الاخوان” في مصر، فقد بدأوا حكمهم من حيث انتهى اليه “اخوان” تركيا الآن.
والخطأ الرئيسي الآخر الذي وقع فيه “الاخوان” في مصر، كان العمل بنظرية الرئيس المصري السابق حسني مبارك القائمة على ان ارضاء اميركا يمكن ان يشكل السند الاساسي الذي يمنع قيام اي تحرك يهدد حكم الجماعة. وفي هذا الاطار كان حرص مرسي على التهدئة في غزة ومنع “حماس” من خرق وقف النار مع اسرائيل ومن ثم إغراق الانفاق بين مصر والقطاع، علما ان اسرائيل لم تنفذ التزاماتها بموجب الاتفاق ولاسيما منها فك الحصار الاقتصادي عن غزة.
وكلما كان يشتد الضغط على مرسي داخليا، كان يقدم المزيد من الخدمات للولايات المتحدة. وآخر هذه الخدمات اقفاله السفارة السورية في القاهرة وقطعه العلاقات تماما مع دمشق واعلانه الجهاد على النظام في سوريا. كما ان مرسي تبنى خطابا طائفيا واضحا في الاسابيع الاخيرة لحكمه مهدت لهجوم على الشيعة في مصر، ولهجة عدائية حيال ايران و”حزب الله” اللبناني، على رغم ان طهران سعت حثيثا خلال فترة حكم مرسي الى علاقات طبيعية مع القاهرة. لكن “الاخوان” قابلوا ذلك بالحرص على عدم اغضاب واشنطن.
واذا ما اضيفت الاخفاقات السياسية الى الاخفاقات الاقتصادية، لم يبق أمام المصريين سوى التمرد، لأن الديموقراطية ليست فقط صناديق اقتراع. وبعد تجربة “اخوان” مصر، ثمة كثيرون يتحسسون رؤوسهم في المنطقة الآن.
النهار
معضلتنا المصرية: لا طائل من الإنكار
جهاد الزين
حَكَمَ “الإخوان المسلمون” العام الفائت مصر بحسٍّ فئويٍّ أكيد، ناهيك عن القصور المدهش والفاضح والمثير للشفقة الذي ظهرت لا كفاءتُهم عليه. لكن علينا الاعتراف أنهم أُخْرِجوا من السلطة وتركوا لنا معها معضلة كبيرة جدا تتعلّق بالشرعية الديموقراطية.
مع أن كاتب هذه السطور مثل أعداد غفيرة في العالم العربي تجزم بعدم قدرة الحزب الديني على إدارة شؤون دولة كمصر، إلا أن إصرار “الإخوان” على عدم إيجاد مخرج شرعي لمطلب ملايين المعارضين تنحّي الرئيس محمد مرسي – وهو مخرجُ مبادرةِ مرسي إلى الدعوة لانتخابات مبكرة تُغْني عن إبعاده القسري- أرغَم المعارضةَ والجيشَ والنخبة الليبراليةَ والعلمانيةَ بكاملها على اللجوء إلى دور للجيش في التغيير.
نجح “الإخوانُ” بحسّهم الفئوي في خلق أزمة شرعية ديموقراطية لا مجال لإنكارها. تدخّلُ الجيش فيه قدرٌ فعليٌّ من الانقلابية سيلطّخ نقاء مسار الثورة الثانية الحقيقية ضد “الإسلام السياسي” وعجزه الصارخ، لاسيما مع الإيغال في جلافة الاعتقالات السياسية.
لقد أربك “الإخوانُ” العالمَ الديموقراطيَّ كلّه.
صحيح أن تدخل الجيش هو بصيغته الشعبية يحمل شرعية مقابلة لكن علينا – وراء النخبة المصرية – أن ندخل في صلب النقاش وأسئلته الصعبة بدل الهروب أو الإنكار: هل كان يجب أن تلجأ الحركة الشعبية إلى تدخّل الجيش؟ عندما سقط الرئيس حسني مبارك كان حياد الجيش هو الفعّال منحنيا أمام الإرادة الشعبية. الآن لم تكن حيادية الجيش المنحازة هي الحاسمة بل انحيازه غير الحيادي.
تتجمّع في ثنائية الحركة الشعبية-الانقلاب العسكري عناصرُ معقّدةٌ وشرعيّاتٌ متعددة، مما يذكّر بالتسمية التي أطلقها الصحافي التركي جنكيز تشاندار على الانقلاب العسكري عام 1997 ضد أول رئيس وزراء إسلامي في تركيا: .Post Modern Coup d’Etat الانقلاب التركي يومها لم يكن شعبياً وكان الجيش قويّا ومُهابا إلى درجة أنه اكتفى بإرسال رسالة إلكترونية على موقعه تطلب استقالة حكومة نجم الدين أربكان لكي تحصل الاستقالة وينجح الانقلاب دون تحريك أي دبابة (ولهذا السبب الإلكتروني سُمّي “بوست مودرن”).
ربما اليوم يستحق “الانقلاب” المصري أكثر من التركي تسمية مبدعة من نوع جديد، لأنه قبل أي شيء لم يكن انقلابا لمصادرة الحياة السياسية بل تلبية عسكرية مباشرةٌ ومراقَبَةٌ لموجة شعبية واسعة وعميقة وأكيدة. كان العالمان الواقعي والافتراضي في ذروة زخمهما في الثورة الثانية أيضا وأكثر من الأولى.
على الرغم، إذن، من التلويث الذي أصاب به الإعلانُ العسكري نقاءَ الثورة الشعبية الهائلة التي جمعت عدديا ربما أكثر من تظاهرات “ميدان التحرير” في كانون الثاني 2011، فالأكيد أن الجيش لم يعد قادرا على لعب دوره اللاديموقراطي بالمعنى الذي عرفناه في عهود عبد الناصر والسادات ومبارك. تظاهرة واحدة ضد الجيش كفيلة في المستقبل – إذا لم تذهب فئوية “الإخوان” إلى حدود توتير النظام الأمني العام – بإفهام الجيش أن الحكم أصبح جوهريا للمدنيين في مصر.
لقد ارتدَتْ مصرُ ثوبا مدنيا نخبويا وشعبيا رائعا في الأيام الأخيرة ولكنها وضعت مؤقتا على رأسها قبعة عسكرية. أبدلت الثوبَ المدنيَّ الناصعَ الذي ارتدته عام 2011 والذي تعرّض للشرشحة في ظل “المدنية الإخوانية” وعمامتِهم الفئوية بثوب مدني حقيقي جديد أُرغِمت على تتويجه ب”البيريه”.
أحد أهم التعليقات على إسقاط الرئيس محمد مرسي جاءت من “المرشد” الآخر الكبير للحكم في تونس الشيخ راشد الغنوشي. لقد اعترف الغنوشي بفئوية الحكم “الإخواني” عندما قال أن ما حدث في مصر لن يحدث في تونس لأن الحكم في تونس إئتلافيٌّ بين ثلاثة أحزاب (دينية وليبرالية وعلمانية) تشارك في السلطة مشاركة حقيقية.
هذه أكبر “إدانة” لـ”الإخوان” بعد إسقاط مرسي حتى لو أن الرئيس التونسي المنصف المرزوقي انتقد التدخل العسكري.
ماذا عن المستقبل؟ هنا بعض الأسئلة:
– هل ستحتفظ النخبة الليبرالية العلمانية بل التحالف الذي وقف ضد “الإخوان المسلمين” بوحدته التي تميّز بها في السنتين ونصف السنة التي انقضت على عمر الثورة الأولى؟ وهي وحدة لعبت دورا مهما جدا في عدم تمكين “الإخوان” من السيطرة على الدولة والحياة العامة؟
– أي تأثير في الكواليس للتأييد السعودي للثورة الثانية على السياسة الإقليمية للوضع المصري الجديد؟ مع العلم أن القوى التي قادت الاعتراض الذي أسقط “الإخوان” ليست كلها مجمعةً على سياسة خارجية واحدة ويمكن للمراقب أن يتوقع انقسامات كبيرة على هذا الصعيد. صحيح أن الحساسية السلبية السعودية – والإماراتية – من “الإخوان” كانت معروفة سابقا ولكن التغيير المصري الأخير كشف مدى ما آل إليه عمقُها العدائي.
السؤالان الأول والثاني لا بد أن الإجابة عليهما تتوقف على الاستراتيجية التي سينتهجها “الإخوان” في الوضع الجديد؟
لا شك أن التحوّل المصري لا سيما بزخمه الشعبي يشكّل نوعا من التوجيه المختلف لمسار “الربيع العربي” بل حتى “تصحيحه” رغم الغمامة “الانقلابية” التي أربكت فضاءَه، وهو سيعيد طرح لا أهمية “النموذج المصري” بالنسبة للولايات المتحدة الأميركية والعواصم الغربية، فحسب، بل أيضا عدم ثبات هذا الوضع وانفتاحه على احتمالات غير محسوبة. جوهر وجهة النظر هذه أن التحالف العلماني القومي الليبرالي البيروقراطي الذي أسقط الرئيس مرسي هو تحالفٌ متنوّعٌ جدا والعناصر الاستقلالية فيه قوية وحاضرة مثلما هي العناصر “المحسوبة” أو القابلة لتَوقُّع أفعالها أو ردود أفعالها؟ فهل تستطيع النخبة الجديدة الالتزام بسياسة مختلفة مستقلة عن التبعية الخارجية السابقة التي كان يمارسها عهد مبارك والتي لم يخرج عنها “الإخوان” قطعا؟ هناك أسئلة كثيرة بين النخبة الحاملة لمعايير الثقافة الوطنية المصرية على هذا الصعيد.
– يبقى أن مراقبة التأثير المصري غير المنظور – وغير المباشر – على الوضع التركي ضرورية جدا لاسيما من ناحية الصيغة الجديدة التي يمكن أن تكون مغريةً لدور الجيش المستند على دينامية شعبية؟
لا شك أن للأحداث المصرية كواليسَها الخارجية وستتضح هذه الكواليس لاحقا من المواقف التي ستتخذها “الكتلة” الحاكمة الجديدة. لكن الأساس هو أن المخاض متواصلٌ والنخبة غير “الإخوانية” هي من الآن فصاعدا تحت الامتحان الداخلي والخارجي.
النهار
الكابوس الجزائري في مصر
عبد الرحمن الراشد
العنف كان رسالة قادة «الإخوان» في مصر، بعد إقصاء محمد مرسي من الرئاسة، في أعقاب المظاهرات الاحتجاجية الضخمة ضده. مشاهد القتلى ورائحة الحرائق والفوضى في أنحاء مصر، الجمعة الماضي، تذكّرنا بما حدث في الجزائر بعد وقف الانتخابات 1992، وقد يكون الإسقاط صحيحا، لكن لا بد من إيراد الرواية بعناصرها. فقد سبق تعطيل الانتخابات في الجزائر الفوضى، والتهديد برفض النظام، وفي أعقاب التعطيل صار العنف، وبعده خسر المتطرفون الرأي العام الجزائري، وفشل العنف في تحقيق أهدافه.
قبل ذلك، وحتى أواخر عام 1988، كانت الجزائر بلدا مغلقا في بداية مشروع انفتاح اقتصادي، وعندما حاول الرئيس الراحل الشاذلي بن جديد التراجع، وأعلن عن التقشف الاقتصادي بسبب انخفاض أسعار النفط، اندلعت المظاهرات ضده. قدّم بن جديد مشروعا إصلاحيا اعتمد دستورا جديدا أنهى سيطرة الحزب الواحد، وسمح بالانتخابات، والحريات الإعلامية. وبسبب التنافس دخلت البلاد في فوضى، ومظاهرات لم تنقطع لأكثر من عام. وولدت عشرات الأحزاب، بينها الجبهة الإسلامية للإنقاذ (فيس)، الذي كان نجما. ولم يكن سهلا التعرف على الحزب الجديد، إلا من خلال ما يصرح به قادته، ومعظمهم كانوا معتدلي الخطاب، مثل الشيخ عباسي مدني، وفي الوقت نفسه، تزعم بعضهم مظاهرات متطرفة في ميادين العاصمة، تتحدث بلغة مختلفة، وتتوعد بإلغاء الدستور بعد الفوز، ومن أبرزهم كان علي بلحاج نائب رئيس الحزب. وازدادت حالات العنف المرتبطة بالحزب، لكن لم يصدق أحد أبدا أنهم وراءها، اتُّهم الجيش بافتعالها، وليس مستغربا حينها أن الجيش ربما كان يريد مبررات لوقف الانتخابات والإمساك بالحكم، لكن بعد سنوات اتضحت براءتهم، لأنها نفسها العمليات التي ترتكبها الجماعات التكفيرية المسلحة على مدى 20 سنة لاحقة. وقد أعطى المتطرفون كمّا كبيرا من الأعذار، إضافة إلى العنف، مثل التهديدات بإلغاء الدستور بعد الفوز، وأن الديمقراطية حرام، وإحراق محلات عامة بحجج دينية. واستمر كثيرون لا يصدقون أنها من فعل أتباع «فيس» المتطرفين، فضلا عن أن الجزائر في الثمانينات لم تكن مستعدة للتغيير، فكرا ومؤسسات، أيضا كان دخول المتطرفين أول شاهد ملموس على استحالة ترويضهم، وإدخالهم بيت الديمقراطية.
لا يمكن فهم مصر دون قراءة تجربتي الجزائر وتركيا. ففي تركيا حزب إسلامي حاكم يقدم نموذجا إسلاميا حديثا قادرا على المواءمة والحكم. أما إخوان مصر، فهم أقرب إلى تجربة جبهة الإنقاذ في الجزائر، التي تريد الفوز بالانتخابات لكنها لا تريد الالتزام بشروطها في الحكم. «الإخوان» في مصر حركة سياسية تحاول استيعاب كل ما يمكن أن يحقق لها الفوز والحكم. وهذا من الناحية النظرية عمل سياسي سليم، لولا أنه جعل الحركة مستعدة لتغليب أصوات المتطرفين داخلها، وارتكاب مخالفات دستورية للهيمنة على الحكم، بدل اعتماد المشاركة فيه، أي باحترام فصل السلطات حيث لا يجوز للرئاسة أو السلطة التنفيذية التغول على السلطة القضائية، الذي كان هدفا صريحا للجماعة. هل تدخل مصر النفق الجزائري؟ لا أدري، لكن لكل مجتمع خصائصه، والأغلب أن المصريين، الذين هم في مخاض عسير اليوم، قادرون على صياغة تجربتهم، وإنتاج مشروعهم الذي يخرجهم من الظلام إلى النور.
الشرق الأوسط
مصر لم تخرج من عباءة العسكر بعد!
خالد الدخيل *
يوم الأربعاء الماضي عزلت القوات المسلحة المصرية محمد مرسي، أول رئيس منتخب في تاريخ مصر. لم تكتف بذلك، وضعته رهن الإقامة الجبرية في مكان ما من وزارة الدفاع. حدث هذا في ظل حال ثورية لم تخرج منها مصر منذ أكثر من ثلاثة أعوام، ولا يبدو أنها ستخرج منها قريباً. هي حال ظلت تنتقل من لحظة انسداد إلى أخرى. وآخر هذه اللحظات كانت تلك التي انتهت بعزل الرئيس. يقال إن حال الانسداد السياسي وما كانت تحبل به من مخاطر، هي التي فرضت تدخل الجيش لعزل الرئيس. ربما هذا صحيح، لكن الطريقة التي عزل بها الرئيس تتناقض تماماً مع طبيعة الثورة وأهدافها، إذ عطّل الدستور تمهيداً للعزل كعملية استثنائية وليست قانونية فرضتها حال الانسداد السياسي. ودلالة ذلك واضحة، وهي أن العملية السياسية التي انطلقت بعد سقوط الرئيس حسني مبارك، وما انطوت عليه من صراعات، ومناورات ومنازعات وانتخابات، وما صاحبها من إعلانات دستورية، وكتابة دستور ثم التصويت عليه، وما صرف عليها من أموال، كل ذلك ذهب أدراج الرياح وكأنه لم يكن. 60 عاماً بعد ثورة 23 يوليو، ومصر لا تزال في حاجة للجيش لعزل الرئيس كإجراء استثنائي. الدلالة المحزنة هنا أن عجلة التراكم السياسي والدستوري لم تتحرك بعد، أو أن حركتها بطيئة جداً. انتهت العملية السياسية الأولى بانتخاب مرسي، لتنطلق إثر ذلك عملية سياسية أخرى، وهذه هي التي انتهت بعزله. ربما كان يستحق العزل، لعجزه عن تقديم مخرج من حال الانسداد أمام تصاعد الحال الثورية، لكن الإشكالية الكبيرة في هذا أنه تم من دون إطار دستوري، ومن دون أي إجراءات قانونية، ما يعني أن منصب الرئيس لا يزال غير محصن، لأنه يفتقد سياج الاستبداد، وأن أصوات الناخبين التي أتت بالرئيس ليست لها قيمة أو حرمة قانونية، وأنه يمكن انتهاك وتجاوز كل ذلك إذا ما فرضت اللحظة الحرجة نفسها على الجميع.
وأكثر ما يلفت النظر هنا أن القوات المسلحة، لا القضاء ولا الدستور ولا البرلمان ولا حتى الصوت الشعبي، كانت ولا تزال هي اللاعب المركزي في كل المشهد، واللاعب الذي يلجأ إليه الجميع في كل مرة تصل العملية السياسية أو اللحظة الثورية إلى حال انسداد. القوات المسلحة هي التي فرضت التنحي على ابنها حسني مبارك، وهي التي تولت المرحلة الانتقالية بعد ذلك، وهي التي كانت تراقب عمل الرئيس المنتخب، وأخيراً هي التي أزاحت الرئيس المنتخب. ليس غريباً والحال كذلك أن هذه القوات هي الطرف السياسي الوحيد الذي يراكم مكاسبه السياسية. جميع الأطراف كسبت شيئاً وخسرت ربما أشياء، وأكبر الخاسرين هم جماعة «الإخوان»، لكن القوات المسلحة لم تخسر شيئاً حتى الآن.
في ضوء ذلك، كيف يمكن وصف ما حدث يوم الأربعاء الماضي؟ هل كان انقلاباً عسكرياً على الشرعية، كما يقول «الإخوان»؟ أم تصحيحاً لمسار الثورة، كما يقول خصوم «الإخوان»؟ وضع الإشكالية حصرياً بين هذين الخيارين المتناقضين ينطلق من الصفة التي ارتبطت بالانقلاب العسكري، وهي أنه عمل سياسي مشين، لأنه تعدٍّ على إرادة الشعب، وانتهاك للشرعية، واغتصاب للسلطة بالقوة، ومقدمة لفرض حكم العسكر. وهذا شيء عرفه الكثير من الدول العربية في خمسينات القرن الماضي وستيناته، ولذا انحصر الجدل بين رأي «الإخوان» ومن ينتصر لهم بأن الذي حدث أعاد مصر إلى عصر الانقلابات، وبين خصوم «الإخوان» الذين يعتبرون أن ما حدث كان تصحيحاً للثورة، بل ثورة أخرى أعطيت اسم 30 يونيو. هذا الانقسام الحاد في الرأي طبيعي أمام حجم ما حدث وخطورته، وهو أيضاً متوقَّع، نظراً للتاريخ الطويل من العداوة بين «الإخوان» وخصومهم في مصر، وهي عداوة أعادتها إلى الواجهة حادثة عزل الجيش للرئيس مرسي في إطار حال ثورية ما إن تهدأ حتى تتصاعد مرة أخرى.
لكن لماذا حصْرُ توصيف ما حدث في خيارين اثنين، وانغلاق السجال والصدام عليهما؟ الأرجح أن هذا حصل انطلاقاً من أن سوءة عزل الرئيس مرسي منحصرة في أنه كان انقلاباً بالنسبة لفريق، وأن حسنته أو إيجابيته منحصرة في أنه لم يكن كذلك بالنسبة للفريق الآخر. لم يؤخذ في الاعتبار أن هناك خياراً ثالثاً لوصف ما حصل وما ترتب -أو قد يترتب- عليه، وأن هذا الخيار قد يكون أكثر، أو لا يقل سوءة عن الانقلاب. ما يفرض الخيار الثالث هو أن عملية عزل مرسي تمت في سياق ثورة شعبية لم تجد سبيلاً بعد للوصول إلى مبتغاها، ثم دخلت حال انسداد بدت خطورتها للجميع. هذه الثورة امتداد للربيع العربي، أو الثورة الشعبية على الإرث السياسي الذي خلفته مرحلة الانقلابات في خمس جمهوريات عربية حتى الآن، من بينها مصر. من هذه الزاوية، يبدو أن حصر الإشكالية بين خيارين ينفي أحدهما الآخر ينتمي إلى الثقافة السياسية لمرحلة الانقلابات تلك، وبالتالي يتجاهل التغير الكبير الذي أتى به عامل الثورة الشعبية، وهو عامل مستجد لم تعرفه مصر في تاريخها من قبل. فرض هذا التغير إطاراً سياسياً، يختلف كثيراً عن ذلك الذي كان سائداً في زمن الانقلابات. وبالتالي يقتضي الأمر وضع ما حدث الأربعاء الماضي في هذا السياق، والتعامل معه على هذا الأساس. يمكن تعريف الانقلاب العسكري بأنه عمل تآمري سري، ينفرد الجيش فيه بقرار الإطاحة بالسلطة السياسية، وينفرد أيضاً بالاستيلاء على هذه السلطة. وهذا لا ينطبق على ما حصل الأربعاء الماضي.
هل ينفي هذا إذاً صفة الانقلاب على ما حصل؟ وقفت أمام السؤال لأنني لم أهتد إلى مصطلح يختصر ويعبر عما حصل. فمن ناحية، لا يمكن تجاهل شبهة أو رائحة انقلاب، لأن الجيش هو الذي عزل الرئيس بالقوة ووضعه تحت الإقامة الجبرية، ثم بدأت بعد ذلك ملاحقة قيادات «الإخوان» واعتقالهم، والتلويح بتقديمهم للمحاكمة، بما في ذلك الرئيس نفسه، وتعطيل بث القنوات التابعة لـ «الإخوان» أو التي تمثل موقفهم. ومن ناحية ثانية، فإن ما قام به الجيش لم يكن عملاً سرياً، ولم ينفرد فيه بالقرار، ولم يستول مباشرة على السلطة. كان الجيش يعمل ضمن سياق تفاوضي مع كل الأطراف، واتخذ قرار عزل الرئيس بالتوافق مع الأزهر والكنيسة القبطية وحزب «النور» السلفي، وممثلين لـ «جبهة الإنقاذ»، وحركة «تمرد». وقبل ذلك وبعده الجماهير في مختلف المدن المصرية التي تطالب بتنحي الرئيس. ماذا يعني ذلك؟ يعني أن حال الانسداد تعبر عن فشل الرئيس، ومعه جماعة «الإخوان»، كما تعبر عن فشل المعارضة أيضاً. بعبارة أخرى، نحن أمام فشل الطبقة السياسية في قيادة الحال الثورية إلى بر الأمان. هل كان عزل الرئيس هو البديل لذلك؟ المستشار المصري طارق البشري المعروف بخبرته القانونية ورؤيته السياسية المتوازنة، يرى أن عزل مرسي هو «انقلاب عسكري صريح على دستور ديموقراطي أفرزته إرادة شعبية حقيقية». ويضيف أن المَخرج من حال الانسداد كان متوفراً، وهو إجراء انتخابات برلمانية تفرز حكومة وطنية. لكن القوات المسلحة انتكست، كما يقول، على الثورة، وأنها «تقيم نظاماً استبدادياً من جديد».
من الواضح أن معارضي «الإخوان» لم يتقبلوا فوزهم في الانتخابات البرلمانية والرئاسية، ولذلك لم يكونوا على استعداد للتعاون معهم. من ناحيتهم، لم يتصرف «الإخوان» بعد فوزهم الكبير بحنكة ومهارة لاحتواء معارضيهم. على العكس، تصرفوا بطريقة من يريد الاستفراد بكل شيء، ما استفز الجميع. وقد زادت العداوات والشكوك القديمة بين الطرفين الأمر سوءاً. بات هدف المعارضة إفشال حكم «الإخوان»، وهدف «الإخوان» التمسك بالحكم. لكنّ هذه هي طبيعة العملية السياسية، وبالتالي كان من الممكن التوصل إلى حلول، وهو ما لم يحصل. وعلى رغم أنهم يتمتعون بقاعدة شعبية أكبر بكثير مما يتمتع به خصومهم، إلا أن «الإخوان» فشلوا في كسب الشارع من غير أتباعهم إلى جانبهم. هنا تعقدت حال الانسداد السياسي، وتحولت في 30 يونيو إلى صدام عنيف بين الشرعية الدستورية للرئيس والشرعية الثورية التي تمثلها جماهير الشارع. من هذه الزاوية يمكن القول إن عزل مرسي كان انقلاباً عسكرياً، لكنه يختلف عن الانقلابات التقليدية، لأنه استخدم الحال الثورية السائدة كغطاء للانقلاب على الشرعية الدستورية، ولم يعط فرصة لمخارج سياسية أخرى مثل الانتخابات البرلمانية، أو الاستفتاء على انتخابات رئاسية مبكرة.
من الواضح الآن أن القيادات السياسية لم تكن قادرة على حل. هل لهذا علاقة بأن هذه القيادات، وأولها «الإخوان»، ليست هي من فجر الثورة، وإنما التحقت بها؟ أم أن الثورة كشفت أن مصر بعد ستين عاماً من الاستبداد تم تجريفها سياسياً، وأضحت من دون طبقة سياسية تملك مهارة وخيالاً يسمحان لها باجتراح الحلول في مثل هذه اللحظات التاريخية الحرجة؟ كان لا بد من اللجوء إلى القوات المسلحة. كأن ثورة 25 يناير ليست للتأسيس لجمهورية ثانية، وأنها لا تزال أسيرة لميراث الجمهورية الأولى التي بدأت مع انقلاب 23 يوليو. بعد أكثر من ستين عاماً على ذلك الحدث المفصلي لا تزال مصر غير قادرة على حل أزماتها السياسية وعلى العبور إلى الضفة الأخرى إلا بواسطة القوات المسلحة. وقد عبّر محمد البرادعي عن ذلك بقوله: «إن الجيش تصرف بالنيابة عن الشعب». لكن القيادات السياسية هي التي تمثل الشعب، لأنها هي التي تنتخب وليس الجيش. هذا الفشل السياسي في ظل ثورة شعبية، معطوف على الدور المركزي للجيش، والصراع بين «الإخوان» ومؤسسة القضاء، يشير إلى أن مصر لم تخرج من عباءة العسكر بعد. وأمام هذه الحقيقة، ما الفرق بين أن تصف عزل الرئيس مرسي بأنه كان انقلاباً عسكرياً أو تصحيحاً للثورة؟
* كاتب وأكاديمي سعودي
الحياة
«الإخوان»: نحن أو الحرب الأهلية
عبدالله إسكندر
جماعة «الإخوان المسلمين» في مصر، هل تدفع في اتجاه مواجهة شاملة في سبيل تحقيق شعار مرشدها العام محمد بديع بأن الدماء ستبذل من أجل عودتها إلى السلطة؟ المؤشرات السياسية والميدانية تؤكد الشكوك بأن الجماعة لن تترد في خيار «عليَّ وعلى أعدائي»، بعدما انتزعت منها السلطة عنوة. وهي التي تعمل منذ تشكيلها قبل زهاء نحو قرن، من أجل هذا الهدف، واستخدمت كل الأساليب الممكنة من أجل ذلك، مع ما انبثق عنها من تنظيمات وجماعات العنف الإسلامي التي تحالفت مع «الإخوان» فور توافر الظروف، خصوصاً بعد وصول «إخواني» إلى الرئاسة.
لقد أطلقت الدعاية «الإخوانية»، مع حلفائها الذين تخلوا علناً عن فرض توجههم السياسي بقوة السلاح قبل فترة قصيرة فحسب، وبعدما قتلوا ونهبوا لسنوات طويلة في مصر وخارجها، أكبر عملية نفاق سياسي، عبر الادعاء بالدفاع عن الديموقراطية والتعددية. أين كان كل هذا الكلام عندما كان مرسي في قصر الاتحادية رافضاً، مع مكتب الإرشاد والمرشد لجماعته، سماع أي صوت مصري يطالب بإعادة صوغ المرحلة الانتقالية على نحو يشترك فيه الجميع؟ أين كان صوت العقل عندما أقدم «الإخوان» على كل ما هو غير عقلاني من أجل توطيد حكمهم، ومنع احتمالات تداول السلطة.
تأمل الجماعة أن ينطلي هذا النفاق على الغرب الذي يعتبر، لأسباب ثقافية، أن صناديق الاقتراع هي التي تحدد من يحكم. لذلك تلعب الجماعة على هذه المسألة من أجل استدرار الرفض الغربي للمرحلة الانتقالية الحالية كونها وليد «انقلاب عسكري». وكما التبست الأمور يوماً في الجزائر، عندما اعتبرت جبهة الإنقاذ الإسلامية أن التنديد الغربي بإلغاء نتائج الانتخابات النيابية التي فازت فيها بالغالبية جواز مرور لمواجهة النظام بالسلاح، تلتبس الأمور مجدداً في مصر على نحو قد يشجع الجماعة على خوض غمار مغامرة مماثلة، وإن تكن أقل دموية حتى الآن من نظيرتها الجزائرية.
ويدرك «الإخوان»، بفعل التجربة، أن كثيراً من المعارك السياسية تكسب عبر الهيئات والمنظمات الحقوقية في العالم التي ترصد انتهاكات حقوق الإنسان. وأفضل وسيلة لتحويل «الإخوان» إلى ضحية تتعاطف معها هذه الجمعيات، هي الدفع من أجل إظهار سلطة المرحلة الانتقالية، ومعها المؤسسة العسكرية، كمن يرتكب إساءات إلى هذه الحقوق، من حملات اعتقال تعسفي أو جماعي أو إطلاق نار على متظاهرين. وهذا ما تشهده مصر حالياً بفعل التحريض من قادة الجماعة، كما حصل بعد خطاب بديع أمام متظاهري رابعة العدوية.
وإذا كان هناك من خدمة يؤديها الغرب، خصوصاً الولايات المتحدة، لمصر وشعبها ومستقبلها وللاستقرار فيها، فهي الامتناع عن ملاقاة الدعاية «الإخوانية» في منتصف الطريق، إذ إن الديموقراطية في وجهها «الإخواني» حالياً باتت الاستحواذ مجدداً على السلطة أو بدء العصيان المسلح، كما نرى إرهاصاته في شوارع المدن المصرية أو في العمليات الإرهابية العلنية ضد رموز الدولة المصرية في سيناء، والتي ينفذها مؤيدو «الإخوان» وحلفاؤهم وربما أعضاء في الجماعة.
وفي هذا التصعيد أيضاً تهديد للداخل في مصر التي ينحو شعبها تاريخياً نحو السلم والاستقرار والكاره لسفك الدماء، ولم يعرف العنف والإرهاب على نطاق واسع إلا على أيدي الإسلاميين. ويتضمن توسيع دائرة التهديد استهداف أعز ما لدى المصريين، أي السلم الأهلي، مع ما ينطوي عليه ذلك من تهديد لإمكان استعادة الدورة الاقتصادية الطبيعية وتحسين ظروف العيش.
هكذا تندرج أعمال العنف التي يرتكبها «الإخوان» وحلفاؤهم ضمن استراتيجية جديدة تهدف إلى وضع البلاد أمام خياري: نحن أو الحرب الأهلية.
الحياة
مصر تحتاج الى مانديلا والاخوان يعيدون حساباتهم
عبد الباري عطوان
ما زالت مصر تعيش حالة انقسام في اليوم الثاني من الانقلاب العسكري الذي اطاح بالرئيس الاخواني محمد مرسي، واتى بالمستشار عدلي منصور رئيسا انتقاليا مؤقتا، يتولى مهام الاشراف على انتخابات رئاسية وبرلمانية في موعد لم يحدد بعد.
الانقسام الآن ينعكس على شكل ملايين تحتفل بانتصارها بإطاحة نظام تقول انه لم يصدق بتعهداته للشعب المصري ولم يحقق اي انجاز، وملايين صامتة وما زالت تعيش حالة الصدمة، والمقصود بهؤلاء انصار الرئيس المعزول والتيار الاسلامي عموما.
غبار كثير يحجب الرؤية السياسية الثاقبة ينتشر في سماء مصر هذه الايام، ولذلك من الحكمة الانتظار حتى يهدأ وينقشع لنحاول رصد التطورات بطريقة علمية صحيحة، ولكن ما يمكن قوله في عجالة ان التهديد الاسلامي الذي يمثله الرئيس مرسي وحركة الاخوان في نظر الليبراليين والمؤسسة العسكرية قد يكون انحسر مؤقتا، بفعل التدخل العسكري وخريطة الطريق التي طرحها، ولكن مصر تظل مفتوحة على تهديدات اخرى، ربما لا تقل خطورة، وهي حالة الفوضى.
السلطات العسكرية اعتقلت الرئيس مرسي والمرشد العام محمد بديع ونائبه امس، وقيادات اخوانية اخرى، وبدأت في توجيه التهم اليهم تمهيدا لمحاكمتهم، ولكن هذه الاعتقالات لا يمكن ان تظل دون ردود فعل غاضبة، فهي ليست مثل اعتقالات رموز النظام السابق الذي توحدت الغالبية الساحقة من الشعب ضده وسعت لإطاحته، فالاخوان لهم انصار وقاعدة شعبية لا يمكن التقليل من حجمها، خاصة في الارياف العمق الحقيقي لمصر.
بمعنى آخر ‘ثوار الميادين’ في ميدان التحرير وقصر الاتحادية في القاهرة وسيدي جابر في الاسكندرية هم من الطبقة الوسطى في غالبيتهم، بينما الاربعون مليون مصري الذين يعيشون تحت خط الفقر هم في الارياف ولا يعرفون شيئا اسمه ‘الفيس بوك’ و’التويتر’ و’الانترنت’، هذا لا يعني عدم وجود طبقة وسطى في الارياف، ولكنها محدودة النسبة.
‘ ‘ ‘
هناك توصيفان لحال الثورة المصرية في ظل التدخل العسكري، الاول يقول انها تجددت واخذت زخما جديدا بفضل ‘حركة تمرد’ وخريطة طريق العسكر، ومعظم انصار هذا الطرح من الليبراليين وانصار جبهة الانقاذ، والثاني يرى ان الثورة المصرية اجهضت لانها بدأت من اجل الديمقراطية واحترام صناديق الاقتراع، وانتهت بانقلاب عسكري قذف بصناديق الاقتراع من النافذة، واصحاب هذا التوصيف هم من انصار الاخوان وتيارهم الاسلامي.
من المفارقة ان الليبراليين المصريين، او معظمهم، الذين هتفوا دائما بسقوط حكم العسكر ايّدوا هذا الانقلاب، وباتوا يدافعون عنه ويقدمون له المبررات، بينما سيقاتل الاخوان المسلمون سياسيا وربما عسكريا في المستقبل كضحايا للعسكر، ومن اجل الديمقراطية والعدالة والحريات.
ولا نستغرب ان يتفاخر انصار الرئيس مرسي غدا بان عهدهم لم يشهد اغلاق محطة تلفزيونية واحدة من تلك التي كانت تشتمهم ليل نهار، ونحن نتحدث هنا عن الفضائيات والقنوات الكبرى، بينما كانت اول خطوة اتخذها قادة الجيش اغلاق ست قنوات تلفزيونية دفعة واحدة محسوبة على الاخوان والتيار الاسلامي.
اذا كان خصوم الاخوان لم يسمحوا للرئيس مرسي ان يلتقط انفاسه باعتصاماتهم ومظاهراتهم والحملات الاعلامية المتواصلة، فإن انصارهم قد يفعلون الشيء نفسه، وربما ما هو اكثر بعد ان خسروا الحكم ولم يعد لديهم ما يخسرونه هذا اذا لم يلجأ المتطرفون منهم الى وسائل عنفية.
المشروع الاخواني في مصر انهزم، وسبب هذه الهزيمة ذاتي ولعوامل واخطاء داخلية تتعلق بالأداء، وخارجي يتعلق بالتدخل العسكري ومظاهرات المعارضة.
حركة الاخوان ارتكبت اخطاء قاتلة، ابرزها طرح مبادرات في اللحظات الاخيرة وبعد فوات الأوان، فالثقة الزائدة عن الحد جعلتها تحاول التفرد بالسلطة وعدم التعايش منذ البداية مع الآخرين، والتجاوب مع مطالبهم، والصدام مع مؤسسات الدولة مثل القضاء، وعدم توسيع دائرة المشاركة في دائرة اتخاذ القرار.
نضرب مثلا على ذلك وهو تقدم الرئيس مرسي بمبادرة الدعوة لحكومة وحدة وطنية من المستقلين قبل انتهاء مهلة الجيش له بدقائق معدودة، وكذلك عرضه بتشكيل لجنة خبراء لتعديل الدستور، فلماذا لم يتقدم بهذه المبادرة قبل ستة اشهر مثلا، ولماذا يصدر اعلانا دستوريا ثم يندم عليه؟
‘ ‘ ‘
الاهم من ذلك، الدكتور مرسي تقدم بمبادرة رباعية لحل الأزمة سياسيا في سورية وهو في ذروة قوته، ثم قرر ان يجعلها ثمانية (من ثمانية اعضاء) اي اضافة موفد من النظام السوري وآخر من المعارضة وممثل عن الجامعة وآخر عن منظمة المؤتمر الاسلامي، الى جانب السعودية وايران ومصر وتركيا، ثم يفاجئ الجميع، وفي ذروة المظاهرات المضادة له، بإعلان فتح ابواب الجهاد في سورية؟
مصر بحاجة الى نيلسون مانديلا لتحقــيق المصالحة الوطنية، ويحشد المصريين خلف مشروع وطني، بعد ان فشلت حركة الاخوان او المعارضة الليبرالية في ذلك، ولا نعتقد ان الجيش الذي انحاز الى طرف في الصراع يمكن ان يوفر البديل.
نخشى على مصر من ان السكون الذي يسودها حاليا وبعد انتصار ‘حركة تمرد’ والمعارضة في اطاحة الرئيس مرسي وحكم المرشد، على حد وصفهم، هو السكون الذي يسبق العاصفة.
ربما نكون متشائمين اكثر من اللازم في زمن الاحتفالات واطلاق الالعاب النارية، ولكن التحذير وقول الحقيقة او جزء منها واجب حتى لو لم يتفق معنا البعض.
القدس العربي
مصر وإقليمها “الإخواني“
حـازم الأميـن
تبدو خريطة المواقف الإقليمية من التغيير في مصر فائقة الدلالة في تأشيرها لوجهة الحدث، المتمثل بالدرجة الأولى بإقصاء “الإخوان المسلمين” عن السلطة في مصر. دول الخليج رحبت مجتمعة بالحدث، وكذلك فعل الأردن، وغرّد الرئيس السوري بشار الأسد قائلاً: “إنها نهاية الإسلام السياسي”. إيران صمتت، وقطر صُدمت، والعراق ولبنان اعتبرا ان صمتهما في ظل الصمت الإيراني.
رصد هذه الخريطة لا يُلغي رغبة المرء بالترحيب الحذر بالحدث المصري، ذاك ان عشرات الملايين من المصريين قرروا تغيير رئيسهم المنتخب، وجرى ذلك بالحد الأدنى من التجاوز على الدستور، وبتنصيب رئيس موقت غير عسكري.
لقد رحّب النظام العربي القديم بالتغيير في مصر. هذا الأمر لا يمكن ان تخطئه عين، حتى لو كانت هذه الأخيرة منحازة الى الثورة الثانية التي أنجزها شباب مصر. وإذا كانت الدوافع الى المسارعة بالترحيب متفاوتة، ومرتبطة بمعطيات داخلية في كل بلد على حدة، فإن الإنجاز المصري يبدو أكثر تخففاً من هذه الأسباب، فلن يضير الثورة المصرية الثانية ترحيباً من أنظمة مشابهة لتلك التي أطاحتها مصر في ثورتها الأولى، إلا ان ذلك يؤشر الى أن مصر نجحت في جعل الحدث مصرياً، وأقل إقلاقاً لأنظمة مجاورة، وإنْ كانت جائرة. وإعادة الاعتبار الى مصرية الحدث المصري تبدو حاجة ملحّة بعد أن شرعت “إخوانية” هذا الحدث بفتح حدوده على أزمات المنطقة بأسرها. فربط التغيير في مصر بتغيير في المنطقة بأسرها يُعقّد الشرط المصري للثورة. فها هي الثورة المصرية الأولى عالقة بين المأزق “الحمساوي” في غزة وخلية “الإخوان المسلمين” في الإمارات والثورة في سورية. ولا شك في أن ذلك ارتدّ على التغيير الأول وصعّب على المصريين المرحلة الإنتقالية، وأثقل الدولة بملفات أضيفت الى ملفاتها الداخلية. ومهمة أقلمة الثورة واستعجال مدّ نفوذها، كان “الإخوان المسلمون” المصريون هم من تولاها ومن دفع باتجاهها.
الشرط الإقليمي يبدو اليوم أقل وطأة على القاهرة، على رغم فولكلورية الترحيب الإقليمي بالثورة الثانية، وعلى الأوهام التي تقف وراء هذا التغيير. فتغريدة الأسد لجهة اعتقاده ان ما جرى في مصر مثّل نهاية للإسلام السياسي، تبدو ممجوجة إذا ما استرجع المرء حقيقة أنَّ من يحمي نظام الأسد هو إسلام سياسي بنكهة شيعية.
النظام العربي القديم شعر من دون شك بأن الثورة الثانية في مصر هي خطوة الى الوراء. وهذا الأمر يبدو صحيحاً إذا ما قيس بضعف الوازع المصري لدى “الإخوان المسلمين” المصريين، ذاك أنّ “إخوانيتهم” سبقت مصريتهم خلال أدائهم في السلطة. غزة صارت أقرب الى القاهرة من رام الله، وعمر البشير وجد فيهم ملجأ في ظل عزلته في الخرطوم، وإديس أبابا انقضّت على النيل في غفلة منهم، مستعينة بضعف وجدانهم غير الديني.
خطوة الى الوراء… لا بأس، إذا كانت الثورة الأولى خطوتين الى الأمام.
موقع لنان ناو
التغيير في مصر… سورياً
وليد شقير
في انتظار أن يأخذ التغيير الذي تشهده مصر مداه، وأن يرسو على معادلة في الأشهر المقبلة، فإن مراقبة الدينامية النموذجية لحراك المجتمع المصري تشي بأنه لا بد من أن تفضي الى خلط أوراق على الصعيد الإقليمي، يغيّر في الخريطة السياسية لدول الربيع العربي.
لم يكن منتظراً أن تستقر الثورات العربية منذ اندلاعها نهاية 2010، على معادلة واضحة فور التغيير في السلطة. فالانتقال من الأنظمة الاستبدادية كان محفوفاً بالصعوبات والثغرات، بعد عقود من مصادرة الإرادة الشعبية ومن تدجين الحياة السياسية في كل من الدول المعنية بالانتفاض على التخلف والتهميش والقمع والإذلال ونهب الثروات وترويض المؤسسات، إذ لم يترك المستبدون شيئاً من هذه المؤسسات. وكان لا بد لأطياف المجتمعات التي شكلت وقوداً لهذه الثورات من أن تمر بمخاض عسير، قد يمتد حقبة أخرى، وفق دروس التاريخ، فالثورات لا تنجح في تحقيق أهدافها وفرز البدائل في لمحة بصر، لا سيما في دول ترك المستبدون فيها بنى سياسية متخلفة خاضعة لإرادة فرد، أو قلة تعتمد الأساليب المافيوية. وكان لا بد لهذا التخلف من أن يمتد الى البنى السياسية المعترضة والثائرة أيضاً، والتي كانت قاصرة هي الأخرى عن إدارة عملية التصحيح والتغيير، والانتقال الى الحداثة في توزيع الثروة وتحقيق المشاركة ثم التنمية.
لم يكن الإخوان المسلمون في مصر وحدهم الذين أثبتوا فشلهم في الانتقال الى نظام جديد، بل إن أقرانهم في تونس والمغرب، وأشباههم في ليبيا لم يكونوا أحسن حالاً، مع أن لكل من هذه الدول ديناميتها الداخلية. حتى أن «الإخوان» السوريين، وهم ما زالوا في موقع المعارضة والصراع مع النظام، وقعوا مع غيرهم في لعبة الاستئثار والتناحر التي كانت من الأسباب الكثيرة التي أخرت التغيير في بلاد الشام. أما في اليمن فإن للعبة قواعد أخرى.
لمصر آليات مختلفة لأنها تكاد تكون الوحيدة التي فيها دولة ومؤسسات، تنتظم فيها القوى الاجتماعية المختلفة، وتسمح عراقتها، بصرف النظر عن سرعة استجابتها للحراك الشعبي، بأن تستوعب ما يستجد في المزاج الشعبي.
وإلا ما معنى حصول التغيير الذي نشهده اليوم بفعل تحالف وتعاون المؤسسة العسكرية مع مؤسسة القضاء والمؤسسة الدينية والمؤسسة الثقافية والمؤسسات الحزبية في التجاوب مع الاعتراض الشعبي المليوني على فشل حكم «الإخوان» في الإجابة عن أي من مشاكل مصر السياسية والاقتصادية والاجتماعية، بعد الفرصة التي أعطيت لهم للمحاولة، من دون جدوى؟
ومع تدافع الأسئلة عن قادم الأيام في مصر، حول مدى مناعة الحراك القائم إزاء احتمالات اندلاع العنف، وحول مدى قدرة القوى السياسية والشبابية التي أثبتت قدرتها على اجتذاب الملايين الى الميادين، في إيصال صوتها الى الريف حيث لـ «الإخوان» نفوذ، فإن المرحلة الجديدة من التغيير في أرض الكنانة، لا بد من أن تخلط الأوراق على الصعيد الإقليمي لسبب بسيط، فاستقرار المعادلة فيها لا بد من أن يعيد الى القاهرة ثقلها في رسم سياسات العالم العربي. ومتى بقيت مصر ضعيفة في الداخل غارقة في مشاكلها بقي دورها الخارجي ضامراً ومتراجعاً، قياساً الى أدوار القوى الإقليمية الأخرى وتحديداً تركيا وإيران وإسرائيل. وقد تستغرق استعادتها لهذا الدور بعض الوقت لاستمرار انشغالها بترتيب أوضاعها الداخلية لجهة ضمان مشاركة «الإخوان» في العملية السياسية الجديدة، ولجهة إثبات حراك الميادين المبهر قدرته على فرز قيادة واضحة تتجاوز الشرذمة التي تسببت بفشله في الانتخابات العامة والرئاسية قبل أكثر من سنة. إلا أن تأثير التغيير الحاصل لا بد من أن ينعكس على سائر دول الربيع العربي لأنه أمثولة بأن صعود الإسلاميين في هذه الدول ليس قدرها المحتوم، كما حاولت دول في الغرب والشرق أن تقنع نفسها، وبعض الأقليات الخائفة، والشعوب العربية، بأنه كذلك.
وعلى الأرجح، لن يغتبط الرئيس السوري بشار الأسد ويفرح طويلاً لـ «هزيمة الإسلام السياسي» كما جاء في تعليقه أمس على الحدث المصري. فهل يعقل أن يتصرف الرئيس السوري كشريك سياسي للذين أسقطوا هذا النهج في مصر، هو الذي اختصر المؤسسة العسكرية والأمنية السورية بشخصه وبعائلته، والذي أخضع المؤسسة الدينية والأقليات بالتخويف وألّب أهل المدن على الريف وأباح كل أشكال الدعم الخارجي لنظامه في حرب الإبادة التي يشنها على شعبه ودمّر البنى التحتية السورية للاحتفاظ بالسلطة ففاق عدد القتلى السوريين المئة ألف، فيما لم يقفز عدد قتلى المواجهات في مصر خلال الأيام الخمسة الماضية من المواجهات عن عدد أصابع اليدين، ولم يتجاوزوا بضع مئات في ثورة 25 يناير قبل سنتين ونصف السنة؟
في مصر سمح الناس للإسلام السياسي بأن يخوض التجربة ثم حاسبته الميادين على فشله. في سورية قُصفت الميادين وارتكبت المجازر في من يرتادونها باسم الوقوف ضد الإسلام السياسي.
الحياة
ما هذه الأميركا؟!
راجح الخوري
كان من المثير تماماً ان تستقبل واشنطن عملية سقوط محمد مرسي وحكم “الاخوان المسلمين” بما يشبه مناحة صامتة، ما يؤكد بوضوح فجيعتها وهي ترى ان تحالفها الجهنمي مع الاخوان قد انهار في اكبر بلد عربي، بما يؤسس لإنهيار رهانات مماثلة تقيمها في تونس وليبيا وسوريا وغيرها. وليس خافياً ان كل تلك الرهانات تأتي في اطار الحرص على إعاقة تطور الدول العربية، تارة من خلال دعم انظمة الديكتاتوريات العسكرية الآخذة في الانهيار وطورا عبر اطباق “المرشديات الاخوانية” على السلطة.
واشنطن كانت على دراية كاملة بأدق التفاصيل، وعرفت ان ما حصل هو انقلاب شعبي على حكم مرسي والاخوان الذين اختطفوا الثورة، وفي حسابهم ادخال مصر عصر “الفرعونية الاسلامية”، وليس انقلاباً عسكرياً كما قال مرسي وكما حاول باراك اوباما ويا للسخرية، ان يوحي عندما اصدر توجيهات الى الاجهزة الاميركية لمراجعة” ابعاد تدخل الجيش المصري” بحيث يقرر ما اذا كان ذلك سيؤثر على المساعدة الاميركية لمصر”. كانت الشوارع تغص بأكثر من ثلاثين مليوناً من المصريين الصارخين “ارحل ارحل”، وكانت واشنطن تراقب المشهد جيداً ولكن اوباما لم يتردد في الحديث عن انقلاب عسكري… غريب!
تلويح واشنطن بوقف المساعدات غباء كبير لأنه يبدو مهيناً لصورة اميركا اكثر من إهانته لمصر، فليس من المقبول ان تتعامى واشنطن عن ملايين المواطنين يطالبون باستعادة ثورتهم المخطوفة وبإنهاء سريع لحكم أفلس باكراً لأنه قام على التسلط وامتهان الدستور وإذلال القضاء والتمييز بين أطياف المجتمع، ولا من المقبول ان تكون مصر في حجم حفنة من الدولارات في حساب اميركا، لكنه الغباء المطلق الذي سينتهي سريعاً عندما تهش السفيرة الاميركية آن باترسون وتذهب لتقديم التهنئة والتأييد للقادة المصريين الجدد.
لم يكن انقلاباً بل كان تصحيحاً بارعاً لمسار احمق وقد اختير بعناية لانهاء مرحلة قاتمة، كانت تهدد مستقبل مصر بل مستقبل ما سمي “الربيع العربي” الذي سارع الاخوان الى سرقته وتزويره. ولم يكتف عبد الفتاح السيسسي بالـتأكيد ان القوات المسلحة ستظل بعيدة عن العمل السياسي وان ما فعلته هو تلبية نداء الشعب وانها ستعمل على ارساء التوافق بين القوى السياسية والاطراف كافة في مصر، وذلك من خلال سهرها على صون العملية الديموقراطية واعادة التوازن الى البلاد، فقد توالت على المنصة من بعده اصوات تمثل المرجعيات الدينية والسياسية والشبابية ولم يغب صوت المرأة، بما يؤكد ان ما جرى كان عملية سحب للشرعية الشعبية من مرسي والإخوان، ورغم ان البيت الابيض كان يراقب المشهد احس بالاختناق لكنه سرعان ما سيبتلع تهديداته السخيفة ويذهب لتقديم التهنئة!
النهار
أحداث 30 يونيو تعيد مصر إلى المربع الأول
بشير عبد الفتاح
ما لم ينزع فتيلها وتطفأ نيرانها، لن تتورع أحداث 30 يونيو 2013 عن الإجهاز على المكتسبات الغضة لثورة 25 يناير 2011 والعودة بأرض الكنانة إلى المربع الأول؛ عبر ظهور ثلاثة أخطار أساسية طالما قوضت جهود العبور بالبلاد صوب الديمقراطية والتنمية الشاملة والمستدامة طوال عقود خلت.
ويأتي النظام السابق الفاسد والمهترئ – الذي من أجل إطاحته قامت الثورة – في مقدمة هذه الأخطار؛ إذ لن يفضي التحالف القائم حاليًا بين المعارضة “الثورية” وفلول ذلك النظام إلّا إلى انقضاض هؤلاء الأُخر على الثورة والهيمنة عليها أملًا في إعادة إنتاج نظامهم البائد. وثانيها، دفع تيار الإسلام السياسي، بشتى أطيافه، صوب التخلي عن نهج الانخراط في العمل السياسي المدني والقبول باللعبة الديمقراطية والالتزام بقواعدها، والعودة إلى العمل من خارج الأطر المؤسسية والدستورية وبغير الآليات السياسية الديمقراطية. أما ثالثها، فيتجلى فى عسكرة السياسة وتعزيز دور الجيش فى الحياة المدنية، وتحديدًا في العملية السياسية.
ويبدو أنّ بلوغ حالة المكايدة السياسية – التي تخيّم على المنافسة السياسية بين قطبي الثورة من قوى الإسلام السياسى والتيار العلماني بمختلف مشاربه – مبلغًا يتجاوز القدرة على التوافق والرغبة في التعايش والتشارك فى العمل من أجل استكمال الثورة وتحقيق أهدافها، قد زين للمعارضة العلمانية “الثورية” التي تطالب بتنحي الرئيس محمد مرسي كتوطئة لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، أن تتحالف تحالفًا مشبوهًا مع فلول النظام السابق بغية الاستفادة من آلته الانتخابية الجبارة، وقدراته المالية والتنظيمية والدعائية الهائلة، علاوة على خبراته وكوادره السياسية وأجهزته الأمنية.
فبالتوازي مع أحكام “البراءات” المتتالية لرموز النظام السابق وعمليات التلميع ورد الاعتبار التي تجري لحسني مبارك شخصيًا خلال الأيام التى تسبق يوم 30 يونيو، لم ترعو قيادات جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة عن توفير غطاء سياسي ومبررات أخلاقية لهذا التحالف. ففي مقابلة له مع جريدة الحياة اللندنية، قال رئيس حزب الدستور المعارض الدكتور محمد البرادعي “إنّ كلمة فلول صارت من الماضي، ولا بد من احتضان من لم يرتكبوا جرائم من المحسوبين على النظام السابق”. وقد أكد على الأمر نفسه حمدين صباحي المرشح السابق لانتخابات الرئاسة في مقابلة مع قناة فضائية مصرية خاصة، واصفًا الذين يعارضون التحالف مع فلول النظام السابق بأنّهم “مراهقون سياسيون وأصحاب عقول ضيقة”.
ولا تكمن خطورة هذا التحالف بين المعارضة الثورية ورموز النظام السابق في مواجهة رئيس منتخب في كونه جرس إنذار بتعاظم فرص نجاح الثورة المضادة فحسب، وإنما أيضًا في أنّه يثير شكوكًا عميقة بشأن مدى التزام تلك المعارضة بقواعد اللعبة الديمقراطية.
وفى مسعى للبحث عن طوق نجاة، وردًا على موقف المعارضة، لم يتردد الرئيس مرسي وجماعة الإخوان المسلمين في الاستقواء بباقي ألوان طيف الإسلام السياسي، بما فيها تلك التي تتبنى خطابًا راديكاليًا ونهجًا تكفيريًا جهاديًا. ووصل الأمر إلى غض الطرف عن إقدام بعض رموز التيار الجهادي المؤيدين للرئيس على توصيل رسائل تخويف وترهيب للقوى السياسية المعارضة التي تخطط لتظاهرات 30 يونيو؛ الأمر الذي من شأنه أن يطرح تساؤلات مثيرة بشأن جدية التيارات الإسلامية في نبذ العنف ومواصلة نهج الانخراط فى العملية السياسية والقبول بقواعد الممارسة الديمقراطية وآلياتها.
ومع تفاقم أجواء التوتر والاضطرابات، بدأت أنظار قطاع واسع من المصريين تتجه نحو الجيش مطالبة إياه بالنزول وإدارة البلاد؛ إما بسبب إخفاق الرئيس ذي الخلفية الإسلامية أو عجز المعارضة العلمانية عن توفير بديل أفضل. وامتد الأمر إلى نخب مهنية يفترض فيها الحياد كالقضاة؛ إذ أصدر نادي القضاة برئاسة المستشار أحمد الزند قبل أيام بيان تأييد للفريق أول عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع وللقوات المسلحة. ويخطأ من يظن أنّ الجيش قد ابتعد بالفعل عن التفاعلات السياسية فى مصر عقب إطاحة المشير القائد العام للقوات المسلحة محمد حسين طنطاوي ورئيس الأركان سامي عنان؛ فلم تبرح القوى المدنية المعارضة تناشد الجيش التدخل لتعضيد موقفها التنافسي في مواجهة تيار الإسلام السياسي.
ومن جهتها طفقت مصادر عسكرية تؤكد قبيل أحداث 30 يونيو أنّ الجيش غير راغب في تولي السلطة، وفى السياق ذاته، يستبعد محللون غربيون سعي الجيش للإمساك بزمام السلطة من جديد، سواء بسبب الحالة الحرجة التى تجتاح البلاد، أو الانتقادات التى وُجهت للمجلس العسكرى إبان إدارته للبلاد خلال المرحلة الانتقالية، أو لأنّه لا يريد أن يظهر دوليًا كمنفّذٍ لانقلابٍ عسكري، أو لأنّ إطاحة رئيس إسلامي منتخب قد يستنفر أطياف تيار الإسلام السياسي ويدفعها للعودة إلى العنف في مواجهة الدولة على غرار ما جرى فى الحالة الجزائرية مطلع تسعينيات القرن الماضي؛ وهي الحقبة السوداء التى امتدت لعقد كامل.
غير أنّ خصوصية الظرف الراهن الذي تمر به مصر حاليًا قد تخلق واقعًا مغايرًا يقود بدوره إلى نتائج أو مخرجات جد مختلفة أو غير متوقعة فيما يتعلق بدور الجيش فى الأزمة. ففي مناسبات عديدة، أكد الفريق أول السيسي أنّ الجيش لن يسمح باندلاع حرب أهلية بين أبناء الشعب المصري، وسيتدخل لحقن دماء الشعب أو إن حاولت السلطة السياسية قمع رغبات الشعب، وأنّه لن يسمح بترويع الشعب المصرى ولا بسقوط الدولة ولا بإهانة الجيش، ودعا أهل الحكم والمعارضة إلى ضرورة التوافق السياسي.
من جانبه، ربما كان الرئيس مرسي يتطلع إلى أن يقوم الجيش بدور حماية الشرعية من خلال الذود عن الرئيس المنتخب على غرار ما فعل كل من رئيس الأركان الفريق محمد أحمد صادق وقائد الحرس الجمهورى اللواء الليثي ناصف فى أزمة أيار/ مايو 1971 بين الرئيس الأسبق محمد أنور السادات ومراكز القوى؛ فبعد أن تكشفت للسادات مؤامرة مراكز القوى بقيادة سامي شرف سكرتير رئيس الجمهورية ووزير شؤون الرئاسة والفريق محمد فوزي وزير الحربية للقيام بانقلاب على نظام الحكم من خلال محاصرة الرئيس وإلقاء القبض عليه أثناء إلقائه خطابه داخل مبنى الإذاعة والتلفزيون، كاد السادات أن يسقط لولا مساندة الجيش له ممثلًا في الفريق صادق واللواء الليثى اللذين رفضا الانقلاب. وقام ناصف باعتقال جميع أفراد المؤامرة جميعًا لتقديمهم للمحاكمة فيما عرف حينئذ بثورة التصحيح.
ولعل الرئيس مرسي قد ارتكز فى رهانه هذا على تشابه الظروف بين تلك الأزمة وأزمة 30 يونيو 2013، فقد تمثّل السند الدستوري والأخلاقي الذي ارتكن إليه الفريق صادق فى موقفه وقتذاك أنّ ظروف البلاد بعد نكسة عام 1967 لا تجعل الشعب يتحمّل صراعًا على السلطة قد يتطور إلى حرب أهلية وفتنة سياسية حادة وانقسامات خطيرة، ولا سيما أنّ مصر لن تحتمل انقلابًا فى ظل وجود عسكري أجنبي وقواعد سوفيتية فيها، وبخاصة أنّ نفوذ من عرفوا بمراكز القوى كان يمتد إلى الجيش والشرطة والإعلام والمخابرات العامة ومؤسسة الرئاسة نفسها.
وسواء صدق حدس الرئيس مرسي أم لا، ومهما كانت صيغة أو شكل التدخل المرتقب من قبل الجيش في أزمة 30 يونيو، يجوز القول إنّ هذه الأزمة – التي أظهرت مدى هشاشة وضعف القوى المدنية وعجزها عن التوافق – قد فتحت الباب على مصراعيه أمام تجذير دور الجيش المصري في الحياة السياسية حتى بعد ثورة 25 يناير وانتخاب رئيس مدني للمرة الأولى وفك الارتباط المزمن بين رئاسة الدولة وقيادة الجيش. ويضيف هذا أعباءً وتحديات جسام أمام عملية التحول الديمقراطي ومدنية السياسة فى مصر لآماد زمنية تالية.
وفي حال تحقُّق تلك الأخطار الثلاثة، فإنّ ثورة 25 يناير سوف تتقهقر خطوات إلى الوراء؛ وقد تعود الأمور إلى المربع الأول بما يعوق اكتمال هذه الثورة التي قامت بأهم عملية تحرير سياسي ووجداني وفكري للمصريين فى تاريخهم الحديث.
رئيس تحرير مجلة الديمقراطية، وباحث في مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية بالأهرام.
معضلة الانقسام: خيارات مصر بعد 30 يونيو
مركز الجزيرة للدراسات
خرج المصريون، كما كان متوقعاً، يوم 30 يونيو/ حزيران 2013 إلى ميادين وشوارعِ مدنهم، لاسيما العاصمة القاهرة، فكانوا بالملايين، مؤيدين كانوا لرئيس الجمهورية المنتخب، د. محمد مرسي، ومعارضين له، في أجواء انقسام لم تشهدها البلاد، المنقسمة على نفسها أصلاً، منذ إطاحة نظام الرئيس مبارك في 11 فبراير/ شباط 2011. وقد طرح كل من الطرفين، وفي الشارع، أقصى مطالبه. بذلك، وبغض النظر عن حجم واستمرارية الحشود في المعسكرين، دخلت مصر أزمة سياسية مستحكمة.
هذه قراءة مبكرة لأسباب وتداعيات الأزمة، وللخيارات المطروحة أمام مصر وقواها المختلفة للخروج منها، وما إن كانت هناك فرصة تبقت لحماية النظام الديمقراطي الوليد.
أزمة قديمة متجددة
مصر، كما معظم الدول العربية، هي بلد منقسم على ذاته، وقد أصبح هذا الانقسام واضحاً منذ اللحظات الأولى لانهيار النظام السابق. تجلى هذا الانقسام تقريباً في كل محطات الفترة الانتقالية، وصولاً إلى الانتخابات الرئاسية. في أساس هذا الانقسام، كان الخوف المتبادل بين معسكر القوى الإسلامية السياسية ومعسكر يضم قوى مختلفة من الأحزاب والجماعات ذات التوجهات الليبرالية واليسارية. في الشهور الأولى من المرحلة الانتقالية، كانت الأغلبية الشعبية تميل لصالح المعسكر الإسلامي؛ وهذا ما انعكس في التصويت على التعديلات الدستورية في مارس/ آذار 2011، وخارطة الطريق التي حملتها تلك التعديلات، وفي الانتخابات البرلمانية الأولى. ولكن الدعم الشعبي لمعسكر الإسلاميين بدأ في التآكل، نظراً للتخوف من بعض الجماعات السلفية وبعض الأصوات الإسلامية الراديكالية، وبفعل هجمة إعلامية منظمة وواسعة النطاق ضد الإسلاميين؛ ونظراً لاستعادة شبكات النظام القديم لأنفاسها، والدعم الذي تلقته من دول عربية.
ولعل الفارق الضيق بين الأصوات التي حصل عليها مرسي عن الأصوات التي ذهبت لمنافسه، أحمد شفيق، رجل النظام السابق، في الانتخابات الرئاسية، كان انعكاساً لهذا التراجع. خلال العام الأول من رئاسة مرسي، تفاقم الانقسام وازداد تراجع الدعم الشعبي للمعسكر الإسلامي، لعدة عوامل: الأخطاء التي ارتكبها الإخوان المسلمون في الحكم، وتعنت قوى المعارضة والرافضة لمجرد وجودهم في الحكم، والصعوبات الاقتصادية الهائلة التي تواجهها البلاد، وتدخلات عربية في الشأن السياسي المصري. ولَّد هذا التفاقم تخندقاً استقطابياً في المناخ السياسي، حيث راحت القوى والجماعات المعارضة تطالب بتخلي الرئيس عن منصبه، رافضة أية دعوة للمشاركة في الحكم، بينما أصر المعسكر الإسلامي على شرعية الرئيس وبقائه حتى الانتخابات الرئاسية المقبلة. وهذا ما أصبح عنوان الانقسام والتدافع في مظاهرات 30 يونيو/ حزيران 2013.
خارطة الاحتجاج والتأييد
ضمت حشود المحتجين على رئاسة مرسي قطاعات واسعة من المصريين العاديين، غير المنضوين في أحزاب سياسية، بل ومن فقدوا ثقتهم في الأحزاب والشخصيات السياسية. وقد خرج هؤلاء مدفوعين بتدهور الأوضاع الاقتصادية، وبفعل ضخ إعلامي أحادي كثيف. كما ضمت الحشود أعداداً من النشطين السياسيين، سواء الأعضاء في الأحزاب والجماعات السياسية المناهضة لحكم مرسي باعتباره رئيساً إسلامياً، أو أولئك الذين يعتقدون بأن مرسي لم يستطع، ولا يبدو أنه يعمل من أجل، تحقيق أهداف الثورة المصرية، بما في ذلك أحزاب مثل مصر القوية، الذي يقوده الإخواني السابق عبد المنعم أبو الفتوح.
ولوحظ أن أعداداً كبيرة من المسيحيين المصريين، قُدِّرت بمئات الآلاف، شاركت في حركة الاحتجاج، سيما في ميدان التحرير، وأمام قصر الاتحادية، أو في مدينة الإسكندرية. وليس ثمة شك، أن شبكة واسعة من قيادات وكوادر ومؤيدي النظام السابق، بما في ذلك وزراء داخلية وضباط أمن سابقون، ساهمت في الحشد وتواجدت بقوة وصورة ملموسة وصريحة في مواقع التظاهر؛ كما ضخ رجال أعمال كبار أموالا هائلة، استخدمت لتنظيم عمليات الحشد في بعض المواقع، ومن الراجح أن بعض قوى النظام السابق تجد من مصلحتها إثارة الفوضى ولو بعمليات اغتيال لأعضاء من جماعة الإخوان حتى تعطي انطباعا بأن البلد سينهار، فتأخذ القوات المسلحة السلطة . وإن صدق حديث الفريق أحمد شفيق التليفوني من الإمارات، مساء يوم 30 يونيو/ حزيران، مع قناة دريم المعارضة، يبدو أنه لعب دوراً رئيساً، بالتوافق ومشاركة محمد البرادعي، في التخطيط لحركة الاحتجاج ولما يمكن أن ينجم عنها من إطاحة الرئيس مرسي.
من جهة أخرى، اصطف في الحشد المؤيد للرئيس أبناء جماعة الإخوان المسلمين وحزبها، حزب الحرية والعدالة، والجماعة الإسلامية وحزبها، حزب البناء والتنمية، وكافة القوى السلفية، بما في ذلك الجبهة السلفية، وحزب الوطن، المنشق عن النور (الذي اختار موقفاً حيادياً)، والقوى الإسلامية الوسطية، مثل حزب الوسط، وقطاع شعبي واسع، من المتعاطفين مع الرئيس عموماً، أو الحريصين على حماية الشرعية الدستورية ومكتسبات النظام الديمقراطي الوليد.
دلالات تدخل قيادة الجيش
كان المشهد عشية 30 يونيو/ حزيران مثيراً للقلق. خلال النهار ومعظم المساء، أظهر الطرفان قدرة فائقة على الحشد، بغض النظر عن مدى توافق أهداف ودوافع المحتشدين في كل معسكر. ولكن أياً من الطرفين لم يبدو قادراً على الحسم. في المؤتمرين الصحفيين الذين عقدهما ناطقان باسم الرئيس، لم تقدم الرئاسة تنازلاً جوهرياً لمطالب القوى السياسية التي تقف خلف حركة الاحتجاج، سيما ما يتعلق بتنحي الرئيس أو انتخابات رئاسية مبكرة؛ كما لم يبدو أن الرئيس قادر على احتواء حركة الاحتجاج، التي هدد منظموها بالتصعيد في الأيام القليلة المقبلة. من جهة أخرى، لم تستطع المعارضة وحركة الاحتجاج إخافة الرئيس، ولا بدا أنها قادرة على إطاحته. كلا الطرفين، بكلمة أخرى، لم يكن يستطيع حسم المواجهة، سيما أن خلف كل منهما حشد جماهيري كبير.
إضافة إلى ذلك، قدمت التقارير من أنحاء البلاد صورة للعنف والاشتباكات بين الطرفين أكبر بكثير من تلك التي حملتها وسائل الإعلام، سواء من حيث عدد حوادث الصدام، والصدامات المسلحة، على وجه الخصوص، أو الخسائر في الأرواح التي بلغت 28 قتيلاً ومئات الجرحى، والدمار الذي نزل خاصة بمقار الإخوان وحزب الحرية والعدالة، وبصورة أقل حزب الوسط. ونظراً لنفوذ ضباط الشرطة والأمن ووزراء الداخلية السابقين، المؤيدين لحركة الاحتجاج، بدا أن وزير الداخلية فقد السيطرة على قطاعات وعناصر من قوات الشرطة في كافة أنحاء البلاد؛ بل إن بعض عناصر الشرطة انضم بالفعل لحركة الاحتجاج، وقام بدور في العنف الموجه ضد الإخوان ومقارهم ولو بالامتناع عن حماية مقرات الإخوان من هجمات البلطجية كما حدث في مقر الإخوان بالمقطم.
كان القائد العام للقوات المسلحة، الفريق عبد الفتاح السيسي، في 23 يونيو/ حزيران 2013، قد وجَّه نداء للقوى السياسية يدعوها للحوار والتوافق وتجنب مخاطر 30 يونيو/ حزيران. وفي ضوء الصورة التي أسفر عنها اليوم ذاته، وجدت قيادة القوات المسلحة أن عجز الطرفين عن حسم الموقف وتصاعد العنف، يتطلب تدخلاً سريعاً، وإلا فإن البلاد مقبلة على صدام واسع النطاق وباهظ التكاليف، قد لا يستطيع الجيش احتواؤه إن اندلع. وهذا، ربما ما دفع قيادة القوات المسلحة، التي يرأسها الفريق السيسي (وليس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، كما أشيع)، إلى إصدار بيان 1 يوليو/ تموز، الذي أكد على أن ليس لدى الجيش رغبة في الدخول طرفاً في الحياة السياسية، والتزامه بأسس الحكم الديمقراطي، ولكنه أنذر القوى السياسية المعنية جميعها بإيجاد حل للخروج من الأزمة خلال 48 ساعة، وإلا فإن الجيش سيضطر إلى طرح خارطة طريق.
فما الذي يعنيه بيان القوات المسلحة؟
بعد شهور من حرصها على إظهار الولاء للرئيس مرسي وإدارته، اتخذت قيادة الجيش موقف الحياد من الانقسام المتفاقم في البلاد وحالة الصراع المحتدمة. وبالرغم من أن بيان القوات المسلحة لم يتضمن إشارة إلى الشرعية والدستور، فإن الأرجح أن الجيش لا يريد القيام بانقلاب عسكري، بالمعنى التقليدي، وأنه حريص على الابتعاد عن تحمل الأعباء السياسية لإدارة البلاد. ولكن عجز الطبقة السياسية المصرية عن مواجهة الالتزامات التي يفرضها النظام الديمقراطي، سيما في مرحلة تحول وانتقال، وحالة الانقسام البالغة التي تشل التجربة الديمقراطية الوليدة، جعلت الجيش حكماً بين القوى، وليس حاكماً. هذه العودة، ستبطئ عملية التحول الديمقراطي في البلاد، وستجعل الجيش، لعدة سنوات قادمة، الحكم والحارس والرقيب المشارك، بدلاً من أن يكون هذا الدور مقصوراً على صناديق الاقتراع والإرادة الشعبية الحرة.
خيارات غير حاسمة
دخول الجيش إلى ساحة التدافع بالصورة التي دخل بها لا يعني أن خيارات مصر باتت محسومة. هذا تدخل مركب، وليس انقلاباً صريحاً، وقد لا تسير الأمور في الأيام أو الأسابيع القليلة القادمة كما يريدها أي من الأطراق، بما في ذلك قيادة القوات المسلحة. لقاء الفريق السيسي، بعد صدور بيان قيادة القوات المسلحة، بالرئيس مرسي ورئيس الحكومة في جلسة ثلاثية، امتدت لساعات، كان توكيداً على أن الجيش لا يريد الانقلاب على الرئيس والدستور. وهذا ما أكده الناطق باسم القوات المسلحة في بيان ثان في مساء اليوم نفسه. ولذا، فإن المتوقع أن تشمل خارطة الطريق التي سيقترحها الجيش تحقيقاً لبعض مطالب كلا الطرفين، وليس كلها، وتستبطن تنازلات من كلا الطرفين، على حد سواء، وأن تظل خارطة الطريق هذه ضمن الإطار الدستوري.
يمكن، مثلاً، أن تطرح خارطة الطريق تصوراً لتشكيل حكومة كفاءات، شبه ائتلافية جديدة، وتغيير النائب العام، وهي مطالب للمعارضة، وتحديد موعد لانتخابات برلمانية، وفق القانون الذي انتهى منه مجلس الشورى ولم يزل محل بحث المحكمة الدستورية، وهو ما يريده الرئيس. ويمكن أن تطرح الخارطة تصوراً محدداً لتشكيل لجنة وطنية من كافة الأطراف، تبحث تعديل الدستور؛ وهو أمر لا يعارضه الرئيس. ولكن، وبالرغم من أن الجيش لا يريد، ومن المستبعد أن يلجأ، إلى خطوة مثل إقالة الرئيس، فليس من الواضح إن كان سيدعو لإجراء استفتاء شعبي حول إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، أو إن كان سيقنع الرئيس بالدعوة إلى مثل هذه الانتخابات، قبل الانتخابات البرلمانية أو بعدها. ما هو مؤكد، أن الجيش، مهما كان موقفه من موقع رئاسة الجمهورية وتصوره لمستقبل الرئيس الحالي، لا يؤيد عودة النظام السابق، أو أحد رموزه، مثل أحمد شفيق، ولن يقبل بشخصية مثل محمد البرادعي، ولا بأي شخصية أخرى، يؤدي وجودها على رأس الدولة إلى استقطابات حادة وسط المصريين.
رغم أن حالة الانقسام والصراع تفسح المجال لعودة الجيش حكماً، فليس من الضرورة أن تصدر خارطة الطريق الموعودة فعلاً، أو تجد الخارطة، إن صدرت، قبولاً من كلا الطرفين معاً. بعد ساعات قليلة على صدور بيان الجيش، شرع المعسكران في تعزيز وجودهما الجماهيري في الشارع، في القاهرة وخارجها، وفي توكيد تصوره للأمور، في رسائل ضمنية للجيش بأن انحيازه للطرف الآخر سيترتب عليه عواقب وخيمة. كما أكد الإسلاميون بصورة لا تدع مجالاً للشك رفضهم لأي انقلاب على الشرعية. ولأن الإسلاميين يرون أنهم يدافعون عن وجودهم ذاته ضد مخاطر عودة عقارب الساعة إلى الوراء، وليس فقط عن الشرعية والدستور، فقد خرجوا، في استعراض بالغ للقوة، في 12 محافظة مصرية بمئات الآلاف مساء 1 يوليو/ تموز، إضافة لوجودهم المليوني في مدينة نصر بالقاهرة، للإعلان عن دعمهم للشرعية.
في النهاية، لا يبدو أن أياً من الطرفين سيستسلم لخارطة طريق يطرحها الجيش، إن صبت لصالح الطرف الآخر؛ كما إن قبول الطرفين بخارطة الطريق لا يعني بالضرورة أن الأمور ستسير قدماً وبسلاسة، ولو نسبية، على أساس من هذه الخارطة.
إن توافقت القوى السياسية على خارطة الطريق المقترحة من قيادة القوات المسلحة، فسيكون هذا تنفيسا للأزمة، ولو إلى حين. إن لم تتوافق، فسيصبح على الجيش كشف أوراقه كاملة والقيام بانقلاب سافر، ومن ثم تحمل أعباء مثل هذا الانقلاب؛ أو أن يترك الشارع، بحشوده وقواه السياسية، لتدافعها الحالي إلى أن ينهزم أحد الطرفين، أو يجدا معاً طريقاً للتوافق السياسي.
عُجالة مصرية
زيـاد مـاجد
يمكن تسجيل الكثير من الملاحظات على الأوضاع المصرية، خاصة بعد المظاهرات الضخمة التي شهدتها القاهرة والاسكندرية وأكثر المدن والمحافظات ضد الرئيس محمد مرسي وجماعة الأخوان المسلمين. النصّ التالي إشارة الى ثلاث منها.
الملاحظة الأولى، أننا أمام تأكيد جديد لعمق التحوّل الذي أحدثته ثورة 25 يناير (كانون الثاني) 2011. فالنشاطية السياسية والتعبئة الشعبية ومدى الحرّيات السياسية والإعلامية والفنّية غير المسبوق منذ العام 1952 لم تكن لتتحقّق لولا جذرية الثورة التي أطاحت بحسني مبارك وحكمه، والتي حالت عام 2012 دون عودة فلول النظام البائد الى موقع الرئاسة.
الملاحظة الثانية، أننا نشهد منذ الانتخابات الرئاسية العام الماضي حالة صراعية لا تشكّل بالضرورة استمراراً للثورة، ولا هي بثورة ثانية. فالثورة حصلت وشارك فيها الأخوان المسلمون (ولو غير مبادرين) وأسقطت النظام القديم، وأتاحت الانتخابات الأولى التي تلتها وصول مرشّح “الأخوان” الى الرئاسة. ولسنا أمام ثورة ثانية إذ أن معظم معارضي مرسي و”الأخوان” لا يطالبون بإسقاط “النظام الجديد” الذي وُلد بعد الثورة والذي لم تتبلور كامل معالمه بعد، بل يريدون إسقاط ثقافة الحكم وممارساتها التي اعتمدها الرئيس المُنتخب وحزبه والتي تُناقض ما شاؤوا تأسيسه من نموذج ديمقراطي مدني. وهم لا يواجهون مؤسسات الدولة “الجديدة” جميعها، لا سيّما الأمنية والعسكرية، كما كانت الحال في الثورة وكما هي الحال عادةً في الثورات. بل يصحّ القول إن بعض الفاعلين في هذه المؤسسات لا يقلّون عنهم عداءً لمرسي ولتياره السياسي، ولو لأسباب مختلفة (وغير ديمقراطية في أغلب الأحوال).
والملاحظة الثالثة أننا أمام مفارقة كبرى في الحياة السياسية المصرية (والعربية). فمحمد مرسي هو أول رئيس مُنتخب ديمقراطياً في تاريخ مصر (ومن القلّة في التاريخ العربي). كما أنه أول رئيس غير عسكري. لكن الرجل وقادة تيّاره الأخوانيّ لم يكترثوا لمعنى ذلك ولثورية دلالاته. فاعتبروا أن التفويض الانتخابي يعني السلطة المطلقة لهم، وحاولوا الاستئثار بمؤسّسات الدولة السياسية والإدارية و”أخوَنَتها”. وفاقم من الأمر أن غرورهم وقلّة حنكة الرئيس وفقر مخيلّته وتمنّعهم على مدى أشهر عن الانفتاح على القوى التي حملت الثورة أو شاركت فيها، أدّت الى تراجع شعبيّتهم خارج حلقة أعضاء التنظيم الأخواني والمستفيدين منه، والى تخوّف كثر ممّن صوّتوا لمرسي (قطعاً للطريق أمام مرشّح بقايا النظام “القديم”) من الأضرار التي قد تتسبّب بها سياساته وثقافة تيّاره على مستقبل حياة سياسية ما زالت قيد التأسيس…
في المقابل، ليس جميع معارضي “الأخوان” ديمقراطيين. فبعضهم ينتمي بالفعل الى “الفلول” (وثمة “فلول” التحقوا بالأخوان والسلفيّين أيضاً)، وبعضهم من الشعبويّين الذين يتناسلون من تيّارات قد لا تكون أقل تعطّشاً للسلطة ولاحتكارها من “الأخوان” ذاتهم.
المهمّ أننا أمام لحظة تظهر، بمعزل عن القيادات السياسية، رفضاً شعبياً مصرياً عارماً للممارسات التسلّطية المستظلّة بالدين. والمهمّ كذلك ألّا يؤدّي هذا الرفض الضروري الى صدامات أهلية تبرّر أي انقلاب يعيد الجيش مرة جديدة، ولو تحايلاً، الى السلطة. فإن كانت المواجهات الدائرة بين “الأخوان” ومعارضيهم تحرّر السياسة من محاولات “تديينها” وتنهي غرور جماعات الإسلام السياسي مبيّنة التنوّع في المجتمع المصري وفشل الحكم الفئوي، فإنّ عودة العسكر تُعد نكوصاً للسياسة وللتنوّع وللحرّيات التي انتزعها المصريّون في ثورتهم قبل عامين ونيّف. والتصدّي لاحتمالات عودةٍ كهذه لا يقلّ أهمّية عن التصدّي لما تبقّى من سعيٍ استئثاري أخواني، ولو أن الكفاح على جبهتين سيكون مرحلياً مهمّة صعبة…
موقع لبنان ناو
سيناريوهات ما بعد 30 يونيو
عمرو الشوبكي
بدأت المعارضة المصرية في حشد أنصارها استعدادًا لموقعة يوم 30 يونيو، ودعت بعض قواها الراديكالية والشبابية إلى إسقاط أول رئيس مدني منتخب في تاريخ مصر عبر ثورة ثانية تطيحه وتفرض مجلسًا رئاسيًا انتقاليًا أو رئيسًا مؤقتًا هو رئيس المحكمة الدستورية العليا، في حين طالب قطاع واسع من المعارضة بضرورة التمسك بآلية ديمقراطية في مواجهة الرئيس، وطالبوا بضرورة الضغط السلمي لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، أو بتغيير الحكومة وتعيين حكومة تكنوقراط من الخبراء والمستقلين إلى حين إجراء انتخابات نيابية جديدة.
ومع ذلك ظلت دعاوى إسقاط النظام والرئيس محمد مرسي سائدة في خطاب قطاع من التيارات “الثورية”، واعتبر تكتل القوى الثورية أنّ “فجر الثورة سيشرق من جديد وسندخل القصر لنعلن انتصار ثورتنا”، ورُفع غير ذلك من الشعارات التي دعت بشكل واضح إلى إسقاط الرئيس، بل وتوعدت بممارسة العنف ردًا على تهديدات الإخوان المسلمين بممارسة العنف أو التصدي للمتظاهرين.
وإذا كانت إبداعات المعارضة الشبابية المصرية منذ ثورة 25 يناير مؤكّدة، وبخاصة مع ظهور حركة “تمرد” (وهي حملة توقيعات سلمية طالبت بسحب الثقة من الرئيس وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة)، فإنّ أحد معضلات المعارضة في مصر تكمن في أنّها ما زالت أسيرة الصوت الاحتجاجي غير القادر على بناء مؤسسة حزبية أو بديل سياسي لحكم الإخوان، على الرغم من اتساع رقعة الرفض الشعبي لهذا الحكم؛ الأمر الذي يشير بوضوح إلى أنّ رفض قطاع واسع من المصريين لحكم لإخوان لم يترجم إلى تكوين إطار سياسي متماسك للمعارضة.
وقد تباينت التقديرات بخصوص تداعيات 30 يونيو بين من يتوقع أن تدخل البلاد في فوضى عارمة، وتنهار العملية السياسية ويسقط حكم الإخوان، وبين من يحلم بالمخلّص الذي لن يأتي؛ فيبحث عن “عبد الناصر جديد” و”يوليو أخرى”، وربما وجد هؤلاء جزءاً من ضالتهم في البيان الأخير لوزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسي (الذي أعلن فيه أنّه لن يسمح بترويع الشعب المصري ولا بسقوط الدولة ولا بإهانة الجيش، ودعا أهل الحكم والمعارضة إلى ضرورة التوافق السياسي)، ولا يعرف أولئك أيضًا أنّ شروط المرحلة التاريخية التي جاءت بثورة يوليو وعبد الناصر مختلفة عن المرحلة الحالية، وأنّ مصير مصر اليوم متوقف على قدرة أبنائها على العمل والتوافق.
المؤكد أنّ أزمة مصر الكبيرة لا تكمن في الاستقطاب السياسي، وإن كان هذا أحد مظاهرها الأساسية، لكنّها تكمن في الأساس الدستوري والقانوني المشوّه الذي ساعد على تحويل التنافس السياسي إلى صراع دموي أصبح معه هذا الاستقطاب أحد أعراض المرض وليس سببه الأصيل.
الطريق إلى 30 يونيو
مرّ الطريق إلى 30 يونيو عبر سلسلة من الأخطاء الفادحة التي جعلت المواجهة بين تيار واسع من الشعب المصري بما فيها المعارضة الشبابية والحزبية من جهة، وبين جماعة الإخوان المسلمين من جهة أخرى شبه حتمي.
ولعل الشرط الأول لنجاح عملية التحول الديمقراطي هو في طريقة التعامل مع مكونات النظام القديم، والتي اختار كثير من المصريين أن يهتف ضدها، في حين أنّه سار عمليًا على نهجها؛ فجنوب أفريقيا التي ناضلت ضد حكم عنصري وناصرها الكثير من بلدان أوروبا الشرقية وأميركا الجنوبية، تبنت مفهوم العدالة الانتقالية الذي يقوم على تخصيص دوائر قضائية وقانونية مستقلة للتحقيق في الجرائم التي جرت في العهد السابق وإغلاق هذا الملف نهائيًا بعد محاكمة كل من ارتكب جريمة. كما أنّ قلة من التجارب هي التي عُزل فيها عدد قليل من رموز النظام القديم ولفترة من الزمن كما حدث في تشيكوسلوفاكيا مثلًا التي عزلت رجال السياسة المتعاونين مع الأمن وقُدِّروا بالعشرات وليس كل أعضاء الحزب الشيوعي الذين بلغوا مئات الآلاف.
إن ّالمزايدة بموضوع الفلول على مئات الآلاف من المصريين ممن دخلوا الحزب الوطني الديمقراطي لسبب أو آخر والعمل بكل قوة على إقصائهم بحسب الطلب والحسابات المختلفة، أصبح يمثل كارثة حقيقية لأنّ هؤلاء لم يعاقبوا على جرائم محددة، ولم يتورط كثير منهم في أي قضايا فساد، وبعضهم دخل الحزب بصورة انتهازية بحثًا عن منصب أو موقع عن طريق تملّق الحزب الحاكم، وهي كلها ظواهر- في ما عدا الجرائم – تحارب بالسياسة وببناء منظومة سياسية لا تسمح طبيعتها الجديدة والديمقراطية لصعود هؤلاء.
إنّ استخدام النظام الحالي – سواء الرئيس محمد مرسي أو جماعة الإخوان المسلمين أو غيرهما من قوى سياسية – لقضية النظام القديم والحزب الوطني حوّلت الخلاف السياسي بين التيارات السياسية والحزبية إلى صراع بين الثورة والثورة المضادة، وهو مما لا يساعد على بناء نظام ديمقراطي يتساوى فيه الكل سواء من هم في الحكم أو في المعارضة، ومن عملوا مع النظام القديم أو الجديد طالما لم يرتكبوا جرائم. ومن شأن ذلك أيضًا إعادة إنتاج مفردات نظام مبارك مثل “الجماعة المحظورة” و”القلة المندسة” بخطاب “الثورة المضادة” و”الفلول”، الأمر الذي أتاح لقيادات القوى المعادية للثورة أن يكون لها امتداد جماهيري، كما أتاح لها إمكانية الحركة والمناورة الواسعة. إنّ عدم تنظيف جرح النظام القديم، وعدم الاتفاق على آلية ومعيار صارمين يتوافق عليهما أغلب التيارات السياسية في التعامل مع مكونات النظام القديم، أدخل هذا الموضوع عمليًا في دائرة المزايدة السياسية والسجال الحزبي؛ فإذا كان بعض رموز النظام القديم متعاونين مع النظام الحالي فإنهم يوصفون برجال أعمال شرفاء وتكنوقراط محترمين، أما إذا عارضوه فيصبحون فلولًا وفاسدين. إنّ هذا الأسلوب لا يحقق بناء نظام ديمقراطي ودولة قانون بأي صورة من الصور؛ فالقضية ليست في قبول التحالف مع رجال النظام السابق أو رفضه، بل في ازدواجية المعايير وتغيّرها حسب المصلحة، فطالما لا يوجد أي نص دستوري أو قانوني يحول دون هذا التحالف، فإنّ الأمر يصبح خاضعًا للحسابات السياسية لكل تيار سياسي، ويترك الأمر لعموم المصريين أن يحكموا على صحته من عدمه.
أما الشرط الثاني لنجاح التحوّل الديمقراطي فهو وضع الأسس والقواعد القانونية والدستورية للنظام السياسي الجديد قبل تسليم السلطة لأي فصيل سياسي، وهذا ما فعل عكسه المجلس العسكري خلال إدارة المرحلة الانتقالية.
فعلى الرغم من تسليم المجلس العسكري السلطة لرئيس مدني منتخب، فقد تخلى عن واجبه في المرحلة الانتقالية في وضع الأطر القانونية والدستورية لهذه السلطة؛ فهو إذ لم يحرص على الاحتفاظ بالسلطة ولم يتآمر من أجل ذلك كما توهم البعض، فإنّه أيضًا لم يحرص على أن يضع أي قاعدة قانونية ودستورية تحكم العملية السياسية – مثلما تقول تجارب النجاح – قبل أن يسلم السلطة للإخوان أو غيرهم. فتعديل دستور عام 1971 والاستمرار به لحين إجراء الانتخابات كان خيارًا منطقيًا ومنجزًا، كما أنّ التوافق على دستور جديد قبل بدء الانتخابات كان حلمًا أيضًا ولكنه صعب المنال، وكلاهما كانا جزءًا من خيارات النجاح؛ أي التوافق على القواعد الدستورية والقانونية قبل انطلاق العملية السياسية.
وقد عمّق من هذه المشكلات إدارة الإخوان المسلمين للمرحلة الانتقالية ونهمها للسلطة؛ مما جعل حزب النور، الحليف السابق للإخوان، يعلن رفضه ما سمّاه بأخونة الدولة، ويقدِّم للرئيس 12 ألف اسم زرعهم الإخوان في مفاصل الدولة المختلفة. كما تمسَّك رئيس الجمهورية برئيس وزراء اعتبرته المعارضة وقطاع واسع من الشعب المصري هو الأفشل في تاريخ البلاد، والمدهش أنّ الرئيس تمسَّك بحكومة أغلبها من أعضاء جماعة الإخوان ومناصريها متجاهلًا الدستور الذي ينص على ضرورة أن تنال الحكومة ثقة البرلمان، وأن تكون معبرة عن أغلبية حزبية داخله، وهو ما لم يحدث نظرًا لحل مجلس الشعب.
ليس بالصندوق وحده تحيا الأمم
من المؤكد أنّ الرئيس محمد مرسي هو أول رئيس منتخب بشكل ديمقراطي منذ 60 عامًا، وأنّه جاء من خلال “صندوق الاقتراع”؛ ولذا فإنّ تغييره كما يرى كثيرون يجب أن يكون من خلال الصندوق أيضًا. وإذا كانت الانتخابات التمثيلية وشفافية الصندوق هما أساس شرعية أي نظام سياسي، فإنّهما بالتأكيد ليسا الأساس الوحيد، فالنظم الحية هي التي تنجح في دمج القوى السياسية الجديدة والشبابية داخل العملية السياسية والانتخابية ولا تستخدم الأخيرة كوسيلة لإقصائها.
وعلى الرغم من أنّ ثمة تجربتين من تجارب النجاح (البرازيل وتركيا) التي حقق نظامهما الحاكم إنجازات اقتصادية وإصلاحات سياسية وديمقراطية هائلة، فإنّ الأمر لم يخلُ من وجود احتجاجات واسعة نظرًا لوجود أجيال وتيارات جديدة لديها طموحات تتجاوز النخبة الحاكمة ولا تستطيع العملية الانتخابية دمجها في العملية السياسية وتمثيلها بشكل جيد في المجالس المنتخبة.
إنّ العملية السياسية الناجحة هي نتاج لنظام سياسي ناجح – وليست أساسًا لانتخابات ناجحة – قادر على الانفتاح على الجديد الذي يتشكل داخل المجتمع، وعلى دمجه داخل العملية السياسية والديمقراطية، وعلى دفعه إلى الاقتناع بجدوى المشاركة في العملية السياسية والانتخابات، وعلى مساعدة القوى الجديدة والثورية على تغيير جانب من خطابها لتعترف بشرعية الصندوق والمسار السياسي والشرعي. وثمة أمثلة على تجارب النجاح هذه كالتيارات الثورية اليسارية في أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية، ومنها ما حدث في فرنسا مع ثورة الطلاب في عام 1968 التي تحول معظم شبابها الثوري والشيوعي والتروتسكي إلى قيادات في أحزاب إصلاحية اشتراكية.
والحقيقة أنّ دور النظام السياسي هو خلق عملية سياسية فعّالة وقادرة على دمج معظم القوى السياسية فيه، وهذا ما حدث عكسه تمامًا في عهد نظام حسني مبارك، ولذلك كان سقوطه مدويًا، بعد أن مارس عملية إقصاء كاملة لكل التيارات السياسية الفاعلة وعلى رأسها التيار الإسلامي. ولو أنّه قام بدمج، ولو جزئي، لهذا التيار وأتاح له فرصة التفاعل مع نظام سياسي ودولة ودستور وقوانين موجودة وشبه راسخة لتطور هذا التيار – أو على الأقل جانب كبير منه – بشكل تدريجي، ولوجدنا تيارًا إسلاميًا ديمقراطيًا ليس هدفه الوحيد الاستحواذ على السلطة وإقصاء الجميع.
وبما أنّ هذا لم يحدث في عهد مبارك، وبما أنّه أيضًا لم يحدث في المرحلة الانتقالية التي يديرها الإخوان الذين أصروا على عدم الالتفات إلى كل من يطالبهم بمراجعة الأساس الذي بنيت عليه العملية السياسية، وبما أنّ البلاد تتفاقم أزمتها الاقتصادية والسياسية كل يوم، فهم يرون أنّه لا توجد مشكلة، وأنّ الأمر لا يتجاوز أعراض الزكام الذي سنتعافى منه حتمًا على الرغم من مبالغات المعارضة.
سيناريوهات ما بعد 30 يونيو
هذا هو الطريق الذي أوصلنا إلى 30 يونيو: سلسلة من الأخطاء الجسيمة ارتكبها من أداروا المرحلة الانتقالية، وجعلنا أمام ثلاثة سيناريوهات:
السيناريو الأول: أن يشارك ملايين المصريين في احتجاجات 30 يونيو، وينهار نظام مرسي، ويجبر على إجراء انتخابات رئاسية مبكرة. ويستلهم هذا السيناريو ما جرى مع مبارك في مظاهرات الـ 18 يومًا التي أدت إلى تنحيته عن السلطة، لكن يتناسى من يعتقدون بهذا السيناريو أنّ نظام مرسي يعتمد على جماعة عقائدية (أو شبه عقائدية) ما زال قطاع واسع منها يعتبر أنّها تدافع عن الحق في مواجهه الباطل، وهناك جزء فاعل من الشعب المصري ما زال يؤيد مرسي وجماعته وهو أمر يختلف عن مظاهرات “الهواة” التي أيدت مبارك أثناء ثورة 25 يناير. لذا، هناك تشكك في أن يكون سيناريو الانتخابات الرئاسية المبكرة من السيناريوهات السلسة والسلمية خاصة في ضوء خطاب مرسي في 26 حزيران/ يونيو 2013.
السيناريو الثاني: أن تستمر التظاهرات الكبيرة لبعض الوقت، ثم يأتي شهر رمضان والأجواء الحارة ويبدأ الناس في العودة إلى بيوتهم بعد أن فشلوا في إسقاط الرئيس، ويستعدون لجولات أخرى ستحسم بالنقاط وليس بالضربة القاضية.
السيناريو الثالث: هو تكرار لسيناريو مبارك ولكن بصورة أعنف؛ أي أن تستمر المظاهرات ويتخللها عنف، ليحسم مسارها الجيش (الذي أثبت أنّه جيش الدولة وليس النظام)، والذي لن يتدخل بـ”يوليو جديدة” بل للسيطرة على العنف، ثم الضغط على السلطة السياسية إما من أجل اختيار حكومة جديدة تضم فقط المستقلين والتكنوقراط، أو إطلاق عملية سياسية جديدة تجرى فيها انتخابات رئاسية مبكرة. ولكن الجيش لن يكون في كل الأحوال طامحًا، وربما غير قادر (لاعتبارات داخلية ودولية) على تولي السلطة بطريقة انقلابية.
ستشهد مصر – على الأرجح – صدامات عنيفة وواسعة عقب 30 يونيو، ومن المؤكد أنّ القوى السياسية لن تستطيع بمفردها حسم معركة السلطة في مصر، وأنّ دور الجيش سيكون حاسمًا كما جرى مع مبارك حين تخلى عنه؛ فحسم المعركة في 18 يومًا. ويبقى أنّ طبيعة هذا الدور ستتراوح من الوسيط بين الأطراف السياسية إلى الضامن لعملية سياسية نزيهة وجديدة.
وسواء بقي مرسي في الحكم أو قبل بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة؛ فإنّ مصر معرّضة لخطر السقوط في براثن الدولة الفاشلة من فوضى وحرب شوارع وغياب للأمن، وتلك تحديات يجب مواجهتها قبل فوات الأوان.
باحث مصري وبرلماني سابق ورئيس منتدى البدائل العربي للدراسات.
عندما يتفوق مرسي على مبارك
عبدالله إسكندر
نجح الرئيس محمد مرسي، وحزبه جماعة «الإخوان المسلمين» ومن معها، في سنة واحدة ما اقتضى أكثر من ثلاثة عقود للرئيس السابق حسني مبارك وحزبه وأزلامه، لتحقيقه. لا بل تفوق مرسي على مبارك، لكونه تمكن من أن يجمع بعد سنة واحدة من الحكم، من المعترضين في الشوارع والميادين اكثر بكثير مما جمع مبارك ضده، بعد طول حكم واستبداد وفساد. لكن ما يُحسب لمبارك أنه أدرك استحالة الاستمرار في المأزق الذي أوصل حكمه البلاد إليه، فتنحى لتبدأ مرحلة أخرى انتقالية.
وإذا لم يستوعب مرسي، وقبله مكتب الإرشاد للجماعة، هذه المفارقة، فان كل حديث عن حوار ومصالحة ليس سوى ذر للرماد في العيون.
لقد تحرك المصريون على نحو يكاد يكون عفوياً ضد حكم مبارك، بعد الانتخابات التشريعية الأخيرة في عهده، نظراً إلى أن الكيل طفح بفعل كميات التزوير في هذه الانتخابات لمصلحة الحزب الوطني الحكم آنذاك، وزمر السلطة. وفي الوقت الذي كان فيه «الإخوان» لا يزالون يراهنون على تعايش مع حكم الحزب الوطني ورفع سيف الاعتقال عن رقابهم، كانت الشوارع والميادين في مصر بدأت تهدر بشعار «ارحل» الذي لم تعتمده الجماعة إلا بعدما اتضح أن مبارك راحل بالفعل.
وفي مطلع المرحلة الانتقالية، انضم المصريون إلى خيار «الدولة المدنية» في مواجهة الحكم العسكري، الذي اعتبر، عن خطأ أو صواب، أن احمد شفيق هو مرشحه. فنال مرسي، كمرشح مدني، غالبية فوضته تولي رئاسة المرحلة الانتقالية. هذه المرحلة التي أراد المصريون أن تكون مرحلة إرساء لدستور مدني فعلاً يرسي التعددية والديموقراطية وحياد الدولة إزاء الأحزاب السياسية.
ويمكن القول، من دون مبالغة، إن أول رئيس مدني منتخب لمصر، تصرف، هو وجماعته، على أساس ملكيتهما لمصر مع شعبها. إذ لم يصدر أي قرار من الرئيس على أي مستوى كان، داخلي أو خارجي، يعكس حداً من الاهتمام بالآخرين وتطلعاتهم. والأخطر من كل هذا الفوات في القرار هو التبرير «المؤامراتي» لحجم المعارضة التي راحت تتسع منذ الإعلان الدستوري الأول الذي شكل صدوره العنوان الفعلي والعميق للديكتاتورية الزاحفة على مصر. وهو ما تأكد مع القرارات اللاحقة، إضافة إلى الخيارات السياسية الخاطئة والانتهازية على المستوى الخارجي.
إن تهديداً بهذا الحجم لتطلعات الشعب المصري هو الذي جعل مرسي ينجح في حشد هذه الملايين ضد حكمه في الشوارع والميادين. وهذا ما لم تدركه بعد، أو لا تريد إدراكه، جماعة «الإخوان المسلمين»: لقد ثار المصريون في ثورة يناير ضد الطغيان المتوحش، في ظل حكم مبارك، واقترعوا ضد خطر عودته مع أحمد شفيق، وهم الآن في الشوارع لمنع تجذره مع حكم مرسي و «الإخوان».
صناديق الاقتراع تكون هي الحكم في ظل استقرار وتساو في الفرص أمام الجميع، ويتولى السلطة من تعطيه الصناديق الغالبية شرط عدم اللجوء إلى قرارات انقلابية تضرب أسس الاستقرار والعدل. لكن المرحلة الانتقالية تفرض حكماً توافقياً وسلطة تعكس الثقل الانتخابي لكل الأطراف. وهذا ما لم يعترف به «الإخوان»، فقلبوا قواعد اللعبة في المرحلة الانتقالية، فاستأثروا بمفاصل القرار وافتوا بتخوين المعارضة. فأخلوا بشرط حكم صناديق الاقتراع الذي يدافعون عنه فقط لمجرد التمسك بالحكم وليس من أجل الخروج من المأزق. ويعكس رد الرئاسة على بيان الجيش إنكاراً لهذه المسألة الغاية في الأهمية، ومدى التدهور الحاصل بين «شرعية الصناديق» التي يستغلها «الإخوان» وتطلعات المرحلة الانتقالية إلى إرساء الديموقراطية.
الحياة
«الإخوان» والساعة والبركان
غسان شربل
من حق الرئيس محمد مرسي أن يقول إنه أول رئيس مدني منتخب في مصر، وإنه دخل القصر بتفويض من الناخبين لا على ظهر دبابة، وإن زعماء المعارضة باستثناء منافسه احمد شفيق، اعترفوا بشرعيته ونزاهة الانتخابات، وإن محمد البرادعي وعمرو موسى وحمدين صباحي زاروه في قصر الاتحادية، وإن العالم اعترف بشرعيته واستقبله رئيساً، ومن حقه أن يقول إن المصريين فوَّضوه لولاية كاملة لا يصح اختصارها تحت ضغط الشارع… من حقه أن يقول كل ذلك لكن من واجبه الالتفات إلى ساعته.
يستطيع محمد مرسي أن يقول إنه ليس رئيساً معزولاً، وإن الجماعة التي وَفَدَ منها عميقة الجذور في المجتمع المصري، وإن الإسلاميين لن يقبلوا بخلع أول رئيس إسلامي في مصر، وإنه قادر على تنظيم مليونيات موالية في مواجهة المليونيات المعارضة، وإنه قادر على تكليف شباب «الإخوان» حماية القصر إذا تردد الجيش في حمايته… وعلى رغم ذلك، من واجب الرئيس الالتفات إلى ساعته.
في المقابل، لا يستطيع الرئيس اتهام من احتشدوا امس في ميدان التحرير وأمام قصره بأنهم مجرد فلول وبلطجية يحنّون إلى العهد البائد. استُهلكت هذه اللعبة من فرط ما استخدمت. ولا يستطيع القول إن ملايين الموقِّعين على عريضة «تمرد» هم من الليبراليين الضالعين في مؤامرة صهيو – أميركية لإحباط مشروع النهضة الذي حمله معه إلى القصر. لا يستطيع الرئيس إنكار أن السنة الأولى من عهده تميزت باضطراب مريع وعمقت الانقسام في الشارع وخيبت من اقترعوا له من خارج تياره خوفاً من أن يؤدي فوز شفيق إلى ترميم النظام البائد. لا يستطيع الرئيس أيضاً إنكار ما تقوله الأرقام عن تدهور الاقتصاد وتزايد البطالة والفقر وتدهور الخدمات والأمن. لا يستطيع أيضاً إنكار تزايد الاعتقاد أن السنة الأولى من عهد الجماعة في الحكم كشفت الافتقار إلى الخبرة والكادرات المؤهلة والقدرة على إدارة الدولة بمنطق الدولة.
قبل أسبوعين دفعتني الحشرية الصحافية إلى زيارة مصر، خفت أن أكتب عن المعركة الكبرى الدائرة فيها من بعيد، وهي معركة تعني «الإخوان» في مصر وفي كل مكان، وتعني الإسلام السياسي ونتائج «الربيع العربي». التقيت قادة من المعارضة و «الإخوان»، والتقيت إعلاميين ومواطنين عاديين توهموا أن الثورة ستفتح أبواب الأمل، وستجعل الخبز أقل صعوبة، وستعيد إلى مصر رسوخها في هويتها وروحها ودورها.
عشية مغادرتي القاهرة انتابني خوف شديد من الأيام الآتية، شعرت أن ملايين المصريين يعيشون خوفاً عميقاً وقلقاً غير مسبوق وغضباً يتحفز للتعبير عن نفسه، هذا خائف من إفلاس مصر، وهذا خائف من التلاعب بروح مصر، وثالث يقول إن نظام «الإخوان» هو نفسه «نظام مبارك لكن بسحنة إسلامية»، ورابع يقول إن الدولة تتآكل، وإن عمليات «الأخونة» ستقود إلى صدام في الشارع «لاسترجاع الثورة من الذين سرقوها»، وخامس يقول إن على الجيش أن يتحرك قبل انفجار البركان.
شعرت أيضاً أن حسني مبارك فاجأ المصريين بسقوطه السريع، وأن القوى السياسية لم تتوقع ذلك ولم تستعد، وأن المجلس العسكري تصرف كمن يقلب الجمر بين يديه ويرغب في التخلص منه، لهذا تسرع وأخطأ، وأن «الإخوان» ارتكبوا بخوضهم انتخابات الرئاسة مجازفة كبرى لا «تضحية كبرى». وعلمت أن غلبة الراغبين في الانقضاض على الوليمة تمت بحفنة أصوات يتبين اليوم أنها أدت إلى مجازفة «الإخوان» برصيدهم وبمصر أيضاً.
أخطأ مرسي في قراءة رسائل الثورة، وفي حدود التفويض. تراكمت الأخطاء بفعل أسلوب التعامل مع الدستور والقضاء وإدارة الدولة والتعامل مع روح مصر ومكونات هويتها. تراكم الأخطاء أيقظ جمر الثورة، وأنهار الجمر تنذر بتحرك البركان. بكَّرَ «الإخوان» في دخول القصر، وساهم تسرُّعهم في استدعاء البركان. يصعب توقع انحناء «الإخوان» أمام احتجاجات «تمرد»، لكن الأكيد أن إقامة مرسي في القصر ستكون مضنية للجماعة والبلاد، فلا شيء أسوأ من الإقامة على أطراف البركان.
الحياة
أطول 48 ساعة في التاريخ!
أمجد ناصر
‘الأسلحة آلات للقتل وليست أدوات العاقل
فهو لا يستعملها إلا إذا لم يبق لديه خيار
السلم والسكينة عزيزان على قلبه
ليس النصر سبباً للفرح
إن من يفرح بالنصر يفرح بالقتل
عندما يقتل عدد كبير من الناس
ينبغي النواح عليهم بمرارة
ما الفرق إذن بين النصر والجنازة؟’
من ‘كتاب التاو’ الصيني
ترجمة: هادي العلوي
ينعقد لسان المرء وهو يرى المشاهد الملحمية في ميادين مصر وشوارعها. المشاهد نفسها، بصرف النظر عن قضيتها ودعواها، غامرة، مذهلة، باعثة على القشعريرة، ولقد ظننا أننا لن نراها، مرة أخرى، بعدما استجمع المصريون كل تواريخ القهر والاستغلال والإذلال ونفثوها من صدروهم دفعة واحدة فانفجر بركان الغضب في ثورة 25 يناير عام 2011.
لم يخطر في بال من كُتِبَ له أن يشهد ذلك الحدث المزلزل أنه قابل للاعادة والتكرار. ظننا (بل ظن العالم كله) أن تلك هي ‘بيضة الديك’. شيء يحدث مرة واحدة فقط وغير قابل للتكرار. ولكن ها هم المصريون يعيدون الكرَّة. ها هم يحطمون رقما قياسيا عالميا في التظاهرات السياسية سبق لهم أن سجلوه هم ذاتهم قبل نحو عامين ونصف. فما شهدته ميادين المدن المصرية وشوارعها يوم الثلاثين من حزيران ‘يونيو’ الماضي كان حسب عنوان عريض للبي بي سي بالانكليزية: أكبر تظاهرات في تاريخ البشرية. لم يشهد العالم شيئا كهذا من قبل الا في مصر. ولا يمكن لهذه الحشود، التي تتلاطم كأمواج يوم الحشر، أن تجتمع، أيضاً، على باطل. لا يمكن جمع كل هؤلاء الناس، من مختلف الأعمار، الطبقات، الميول السياسية، الجغرافيا المصرية الشاسعة، بقرار سياسي. لا تقدر قوة معارضة، مهما كانت شعبية ومعبرة عن مزاج اجتماعي عريض، على حشد كل هؤلاء البشر. يحدث أن تتقاطع مواقف قوى سياسية معينة مع مزاج شعبي ما فتسهم في ارتفاع منسوب الحشد والتعبئة.. ولكن ليس كما أرتنا مصر في الثلاثين من حزيران وما تلاه من أيام مشهودة. ذلك هو الشعب المصري نفسه وليست قواه السياسية. وبدقة أكبر ذلك معظم الشعب المصري لأن للطرف الآخر من معادلة الصراع السياسي في مصر الآن قاعدته وجمهوره.
ما حصل (ويحصل) في مصر الآن لا يحسب على قوة سياسية. ليس فعل معارضة محسوبا. ليست سياسة تكتيكية. ذلك هو الشطر الأعظم من الشعب المصري وقد خرج يعبر عن خيبته في الرئيس الذي أدلى قسم كبير منهم بصوته له وأولوه ثقتهم فلم يكن أهلا لتلك الثقة.
‘ ‘ ‘
أكتبُ هذه الكلمات وأنا أتابع تتالي المَشَاهِد التي تحبس الأنفاس على التلفزيون وانتظر، مثل ملايين غيري، ما سيسفر عنه انتهاء مهلة الجيش للقوى السياسية لايجاد حل. هذه الساعات الثمان والاربعون هي، جرياً على الأرقام المصرية القياسية، أطول ثمان وأربعين ساعة في التاريخ.
أكتب باضطراب، بتقطّع في النفس والأفكار والجمل كما تلاحظون.
‘ ‘ ‘
الشعب المصري المتحضِّر في الجوهر وليس في البرقع والشكل صبر على حكامه الجدد. والصبر شيمة حضارية بامتياز. أعطى فرصة. التمس عذرا. لكن الحكام الجدد السادرين في ‘التمكين’، المنقلبين على وعودهم ومواثيقهم لشركائهم في الثورة والوصول الى كرسي الحكم من دون أن يرفَّ لهم جفن، فسروا الصبر رضى، قبولا غير مشروط، أو ربما لا مبالاة ونفاد طاقة بسبب طول المرحلة الانتقالية وتكسُّر النصال على النصال.
لم يكن الأمر كذلك.
هذا ما أثبتته الأيام.
لقد استعدى الحكام الجدد، ما ظهر منهم وما بطن، طيفا واسعا من المصريين وبسرعة قياسية: القوى السياسية المدنية، المرأة، شباب الثورة، الاعلام، القضاء، الفنانين، المثقفين، أجزاء من الحركة السلفية، كما أنهم أحرقوا جسورهم مع القوى الوطنية المصرية ذات المرجعيات المدنية التي كان يمكن أن يبنوا معها تحالفا واسعا (على الشاكلة التونسية رغم عثراته) لعبور المرحلة الانتقالية الصعبة، بل المأساوية على الصعيد الاقتصادي، لكنهم فضلوا، للأسف، التحالف مع فصائل اسلاموية لها تاريخ راسخ في العنف ومنعدمة الجذور شعبياً.
في المحصلة لقد أخطأ ‘الاخوان المسلمون’ في التقدير. بل يمكن القول إنهم تكشفوا عن سذاجة سياسية منقطعة النظير. فجروا أنفسهم، ومصر معهم، الى شفير الاقتتال الأهلي إن لم يقص جناح الصقور في ‘جماعتهم’ عن المشهد و’يفرملوا’ في قضية ‘الشهادة’ على مذبح ‘الشرعية’، فلا تستحق ‘الشرعية’ (= الكرسي) اراقة الدم وتمزق المجتمع وتنابذه.
‘ ‘ ‘
ما يحدث في مصر ثورة شعبية وليس انقلابا.
إنها ليست مؤامرة. على ‘الاخوان’ أن يعوا ذلك. أن يخرجوا من قوقع النكران الذي حبسوا أنفسهم فيه فلم يعودوا يرون الا ما يحدث داخل القوقعة. هذه ثورة ثانية، او استمرار للثورة الاولى التي لم تؤت أكلها كما كان متوقعا.
فإذا كانت تونس أطلقت شرارة التغيير في العالم العربي عبر جسد محترق فإن مصر هي التي أرست وجهة الموجة وحددت معالمها سواء من حيث الشكل (الحشود، احتلال الفضاء العام) أو من حيث الجوهر: المجيء بالاسلاميين، أكثر القوى السياسية العربية تنظيما. فبعد الموجة الثورية المصرية راحت نظم عربية تنهار أو تتضعضع مؤذنة بوصول قوى الاسلام السياسي (في صيغتهم الاخوانية) الى السلطة في مصر، تونس، ليبيا، المغرب، فضلا عن وجودهم المؤثر في الثورة السورية، الحراك الاردني، العراقي، اليمني، اللبناني، الفلسطيني إلخ.
وها هي مصر (أو للدقة، معظمها) التي أولت الاسلاميين ثقتها عبر صناديق الاقتراع تعيد النظر، في الشارع، بذلك التفويض المشروط ضمنا بعد عام من الفشل في ادارة جهاز الدولة، والأهم بعد شهوة مضطرمة للإستئثار بالسلطة في مرحلة انتقالية من طبيعتها أن تكون ائتلافية.
‘ ‘ ‘
ولكن.. بعد كل ما سبق علي أن أتوقف عند نقطة مهمة. لقد اندفع الكتاب والمثقفون العرب في تقريظ ‘الربيع العربي’ في وهلته الاولى، وعندما جاء بالاسلاميين راحوا يشتمونه ويصفونه بالخريف، وها هم اليوم يسدرون، كعادتهم، في نشوة ‘الانتصار’. سمعت، وقرأت، في الايام الماضية الكثير من التنظيرات عن ‘كنس′ الموجة الاخوانية، الاسلاموية عموما. عن اختفائها الوشيك من المشهد العربي. مهلا أيها الاخوة. ما يحدث في مصر الآن (وهو قابل للتكرار في غير بلد عربي) ليس لحذف الاسلاميين من المشهد السياسي بل لتصحيح المسار وتعديل للكفَّة. المشهد المصري الراهن يرينا، في أحد وجوهه، أن لا طرف قادر على ‘شطب’ طرف آخر، تماما، من الحياة السياسية، وأن ‘الشرعية’ ليست ورقة في صندوق ثم كفى الله المؤمنين شرَّ القتال، بل هي رضى، قبول، والأهم: إنها منجز.
الناس تريد عنبا.
وليس مقاتلة النواطير.
الناس تريد حياة كريمة
وليس احتلال الميادين والشوارع لسبب او من دون سبب.
هذا درس تلقنه الجماهير المصرية لنخبتها سواء كانت دينية أو مدنية.
على الجميع أن يتعظ.
القدس العربي
مرسي ضيع اللحظة التاريخية
عبد الرحمن الراشد
في خيمة «الإخوان» معسكران؛ صقور وحمائم، لكن تاريخيا الكلمة العليا للصقور الاستعلائيين: لا تتنازل، لأن التنازل سيهدد التنظيم بالانهيار، وسيحتاج «الإخوان» إلى 50 عاما للعودة مرة أخرى. كانت هذه رسالة صقر «الإخوان» خيرت الشاطر إلى الرئيس الإخواني محمد مرسي. نهاه عن القبول بدعوة الجيش المصري قبل عشرة أيام، وحذر العسكر بأنهم لن يسمحوا بالتأزم أن يهدد أمن البلاد، وتمنوا عليه أن يتوصل إلى حل سياسي مع القوى السياسية الأخرى.
الرأي الثاني براغماتي تصالحي، طالبوه بأن يكون من الحكمة بالقبول بمطالب المعارضة. قيادات إسلامية خارجية دعت لمثل هذا التعاون، وينسب للشيخ راشد الغنوشي، رئيس حركة النهضة التونسية، أنه حث على التصالح، حتى لا تضيع الفرصة «هرمنا في انتظار هذه اللحظة التاريخية».
خسر «الإخوان» اللحظة والتاريخ، وأضاعوا حكم أكبر دولة عربية، والذي جاءهم سهلا على طبق من ذهب. وكان الثمن المطلوب منهم للبقاء التعايش والمشاركة والقبول بنظام ديمقراطي متكامل. مرسي والشاطر والمرشد عجزوا عن السير في هذا الطريق، بعد أن فازوا في الانتخابات وصار من حق «الإخوان» الرئاسة، كحزب مصري لا يمكن إنكار وجوده، وشعبيته، ومعاناته بسبب إقصائه. مشكلة «الإخوان» يمكن اختصارها في كلمة واحدة: الفاشية. وبقدر ما أن هذه الكلمة موجعة ومؤذية فإنها بكل أسف تصف بشكل صحيح الفكر الذي يقود التنظيم الإخواني. فالنازية كانت حركة وطنية في ألمانيا، والموسولينية كذلك في إيطاليا، وفازت في انتخابات ديمقراطية لولا أن هتلر وحزبه في ألمانيا ألغى المؤسسات وقرر تصفية منافسيه زاعما أن المشروع الوطني يبرر له إلغاء منافسيه.
«الإخوان» ظلوا يتحدثون أنهم يؤمنون بالتعايش مع أصحاب الأفكار الأخرى، وهم مستعدون للقبول بنظام تداول السلطة سلميا، والأهم العمل ضمن المؤسسات. إنما فور بلوغهم السلطة تعجلوا بالصدام مع القوى السياسية التي قامت بالثورة. أقصوا القوى التي صوتت لهم، من شباب وناصريين وغيرهم، والذين تحالفوا مع «الإخوان» جميعا ضد المرشح المنافس لهم الفريق أحمد شفيق. ثم دخل «الإخوان» بعد وصولهم للرئاسة في عراك مع مؤسسات الدولة: أرادوا إبعاد مفتي الجمهورية، وطرد شيخ الأزهر، وعزل النائب العام، وتغيير كل قيادات القضاء، وعزلوا حتى المشير محمد حسين طنطاوي وزير الدفاع، الذي وقف مع الثورة ومكّن «الإخوان» من الرئاسة. كل هذه القوى المجروحة شكلت جبهة ضد «الإخوان»، بالتحالف مع المبعدين أصلا، مثل الأقباط، ومن يسمون بالفلول، وهم يقدرون بعشرات الآلاف من أعضاء الحزب الوطني، والأقاليم، والمؤسسات الحكومية. ثم عادى «الإخوان» وسائل الإعلام، برفع دعاوى ضدها بالاعتقال والغرامات، وقبل أسبوعين أصدروا قرارات بإيقاف أكبر خمس محطات تلفزيونية خاصة معارضة، بذريعة حجج استثمارية واهية. بإغضاب الجيش، وتهديد القضاء، وإبعاد الحلفاء من شباب ويسار، ومعاداة القطاع الأكبر من الإعلام، كان حتميا أن يسقط مرسي برغبة أو رضا من معظم الشعب، الذي عاش وضعا اقتصاديا وأمنيا أسوأ مما كان في عهد حسني مبارك، بخلاف وعود لهم بأنها ثورة خبز وحرية. مشكلة «الإخوان» فكر وسلوك. هم ليسوا مستعدين بعد للتحول إلى تنظيم مدني ديمقراطي، لا يزالون بنفس الفكر الفاشي، حيث يؤمنون بصوابية موقفهم، مدعين أنهم وحدهم يمثلون الإسلام، ويرفضون التعايش سياسيا مع الآخرين!.. سلوكهم منذ أول يوم عبر عن جهل بأولى مهارات الحكم: البراغماتية.
خسروا أعظم فرصة لهم لحكم مصر، الدولة الأهم والأكبر في العالم العربي، بسبب استعلائهم. كما أفقدوا الشعب المصري أعظم فرصة في انتقال تاريخي نحو نظام ديمقراطي مدني سلمي يغير البلاد. وهم ليسوا وحدهم، بل تجارب جماعات الإسلام السياسي متماثلة، تعتقد أن الديمقراطية وسيلة للاستيلاء على الحكم، وهذا الذي دفن حلم حركة «فيس» الجزائرية، وهو الذي مكن الديكتاتورية من حكم السودان بسبب جبهة الترابي هناك، ونظام الحكم الفاشي في إيران أعطى أسوأ صورة عن الإسلام السياسي، والآن «الإخوان» المهزومون المطرودون في مصر.
الشرق الأوسط
انقلاب عسكري بوجه مدني وغطاء ديني
عبد الباري عطوان
اثبت الفريق اول عبد الفتاح السيسي انه الرئيس الفعلي للبلاد، مثلما اكد ان المؤسسة العسكرية هي الوحيدة المتماسكة والقادرة على قلب نتائج صناديق الاقتراع في اي وقت، تحت عنوان ‘تلبية طموح جموع الشعب والحفاظ على مصالحه الوطنية’.
انه انقلاب عسكري بوجه مدني، وبغطاء ديني ووعد ديمقراطي، وهذا ما يفسر اشراك شيخ الازهر وبابا الاقباط في عملية اتخاذ قرار عزل الرئيس مرسي وحركة الاخوان المسلمين، والقذف بهم الى المجهول، وربما الى غياب السجون في زنزانة مجاورة لزنازين الرئيس مبارك ورهطه.
وعندما نقول انه انقلاب بوجه مدني، فإننا نقصد بذلك ان المؤسسة العسكرية اختارت رئيسا مدنيا مؤقتا وهو رئيس المحكمة الدستورية العليا، ودعت لانتخابات رئاسية وبرلمانية بعد ستة اشهر، وتشكيل لجنة من الخبراء لوضع دستور جديد.
الفريق اول السيسي لم يسر على نهج استاذه المشير حسين طنطاوي ويتزعم مجلسا عسكريا، وفضل ان يظل صانع ملوك، يجلس في مقعد القيادة دون ان يكون قائدا، تماما مثل المرشد العام للاخوان المسلمين، او المرشد الاعلى للثورة الايرانية.
‘ ‘ ‘
من المؤكد ان المؤسسة العسكرية انحازت للطرف الاقدر على جمع الملايين في ميادين مصر وشوارعها، حسب ما جاء في البيان الذي اذاعته مساء امس، ولكن من المؤكد ان حركة الاخوان المسلمين التي انتظرت تسعين عاما للوصول الى السلطة ستشعر انها الضحية، وان الرئاسة سُرقت منها، مهما اختلفنا مع هذا الطرح او اتفقنا.
انصار حركة تمرد الذين نزلوا بالملايين الى ميدان التحرير وقصر الاتحادية احتفلوا بطريقة اكبر من احتفالهم باطاحة الرئيس السابق حسني مبارك، وهذا من حقهم، فقد تحققت طموحاتهم، وجرى تلبية مطالبهم في اطاحة ‘حكم المرشد’، مثلما كانوا يهتفون طوال الايام والاسابيع الماضية.
الجيش المصري خطط لهذا اليوم جيدا، ولعله استفاد من تجربة نظيره التركي في لعب دور الحامي للدولة المدنية، ومنع المتشددين الاسلاميين من الوصول الى الحكم ولو من خلال صناديق الاقتراع، مثلما حصل لحزب الرفاه والسعادة بزعامة نجم الدين اربكان.
وعندما نقول خطط لذلك جيدا، فاننا نقصد انه ضمن ولاء ودعم مؤسسة الازهر والكنيسة القبطية، وجبهة الانقاذ المعارضة، وحركة تمرد التي تضم جيل الشباب، ووظف كل هؤلاء وانصارهم لدعم تدخله الحاسم.
السؤال الآن هو حول كيفية تسويق الفريق اول السيسي لخريطة الطريق التي طرحها على الجانب الآخر المتضرر، اي حركة الاخوان المسلمين، ثم كيف سيكون رد فعلها؟
من المؤكد ان الحركة التي تملك شعبية كبيرة لا يمكن التقليل من شأنها، خاصة في الريف المصري، وقالت مسبقا على لسان الرئيس مرسي والدكتورين محمد البلتاجي وعصام العريان، انها لن تسكت وستقاتل من اجل الدفاع عن الشرعية حتى آخر نقطة دم.
هناك جناحان في الحركة، الاول جناح الصقور الذي يمثله مرسي ومحمد البلتاجي، وجناح الحمائم الذي يضم شخصيات مثل خيرت الشاطر، وسعد الكتاتني زعيم حزب الحرية والعدالة، وان كان البعض يقول انه لا فرق بين الجناحين والمسألة مسألة تبادل ادوار فقط، وما زال من المبكر القول بان ايا من الجناحين سيغلب الآخر، لكن عندما يقول الرئيس مرسي انه سيموت واقفا حاملا كفنه على كتفه، وعندما يؤكد الدكتور البلتاجي انه سيقاتل دفاعا عن الشرعية حتى آخر نقطة دم، ويدعو انصاره الى الشهادة فإن علينا ان نتوقع الاسوأ.
‘ ‘ ‘
مصر كانت منقسمة قبل صدور بيان المؤسسة العسكرية، والآن اصبحت اكثر انقساما، ولا نستغرب او نستبعد تبادل الادوار، اي ان ينسحب المعارضون من الميادين ليحتلها المتضررون وربما بأعداد اكبر.
سابقة الجزائر تتكرر حرفيا في مصر، مع فوارق طفيفة، وهي ان المؤسسة العسكرية الجزائرية اجهضت عملية انتخابية فاز فيها اسلاميون قبل ان تعلن نتائجها، بينما اقدمت المؤسسة العسكرية المصرية على اجهاض عملية انتخابية بعد ظهور نتائجها.
شيخ الازهر قال امس ‘مصر الآن امام امرين، واشد الامرين سوءا هو سيلان دم الشعب على التراب لذلك وعملا بقانون الشرع الاسلامي القائل بان ارتكاب اخف الضررين واجب شرعي’.
نتفق مع شيخ الازهر احمد الطيب في توصيفه هذا، ولكننا لا نعتقد ان تفاؤله في محله، فأخف الضررين ربما يصبح اخطرهما او سببا في اشعال فتيل حرب اهلية.
نحن ضد سفك الدماء، وضد الاحتكام الى السلاح مهما كانت مبرراته، ولذلك نتمنى ان ترجح كفة العقل، وان يتقبل الاخوان المسلمون الامر، وان يتجرعوا كأس السم، ويستعدوا للانتخابات الرئاسية والبرلمانية القادمة، ويؤكدوا بذلك على سلميتهم، وحرصهم على مصر، وحقن دماء ابنائها، وان يفعلوا ما لم يفعله خصومهم، اي الاحتكام الى صناديق الاقتراع.
نبالغ في تفاؤلنا.. نعم.. نطرح طرحا ساذجا في نظر البعض.. ايضا نعم، ولكننا ننطلق من كل هذا من حبنا لمصر، وحرصنا على حقن دماء شعبها، ونحن نرى ما حدث في دول الجوار، سورية والعراق وليبيا على وجه الخصوص.
القدس العربي
ثورة أم انقلاب؟
شادي لويس
بمجرد إلقاء الفريق عبدالفتاح السيسي بيان القوات المسلحة الذي، ونزولاً عند رغبة الجماهير التي احتلت الميادين في طول البلاد وعرضها، أعلن سقوط نظام الحكم الإخواني ومشروع الإسلام السياسي في بلده الراعي والمؤسس بعد عام واحد من ولاية الرئيس محمد مرسي، انتاب قطاع عريض من النشطاء والحقوقيين ارتياحاً حذراً، غالَبه شعور عميق بالمرارة والجزع. فصور الجثث التي جرجرها جنود القوات النظامية على أرصفة وسط القاهرة ليلقوها إلى جانب أكوام القمامة، والمدرعات التي دهست بجنون مسعور جثث الأقباط في “ماسبيرو”، والمحاكمات العسكرية التعسفية لألوف المصريين، ومئات الشهادات عن التعذيب وكشوف العذرية، وغيرها من جرائم القوات المسلحة الموثقة في حق المصريين إبان الفترة الإنتقالية تحت حكم المجلس العسكري… كلها مَشاهد تجعل من غير المستساغ قبول فترة إنتقالية ثانية يؤدي فيها العسكر الدور الرئيسي، ولو من وراء الستار، ولا يستساغ الانخراط في مصالحة وطنية يرعاها قتلة مينا دانيال ومن عرّوا “ست البنات” وداسوها بأحذيتهم العسكرية.
حملة إغلاق القنوات التلفزيونية الداعمة لتيار الإسلام السياسي، والقبض على العاملين فيها بشكل غير قانوني، إضافة إلى اعتقال العشرات من قيادات الإخوان المسلمين بعد إذاعة البيان مباشرة، عزّزت هواجس هذا القطاع من النشطاء والحقوقيين، في شأن النوايا الحقيقية للقوات المسلحة، ومنهجها الذي ربما يعمّم تلك الاجراءات الإستثنائية ويستخدمها في التنكيل بالجميع مستقبلاً. ينظر هذا القطاع أيضاً، بكثير من القلق، إلى خطاب شعبي وإعلامي مقبول على نطاق واسع بخصوص الإسلاميين، يتمحور حول شيطنتهم، وتُرجم اعتداءات يومية ضد ملتحين ومنقبات في أماكن عامة خلال الشهور القليلة الماضية. الأمر الذي ربما سيقود إلى عزل اجتماعي وسياسي لفئة سكانية عريضة تقدر بالملايين من مؤيدي الإسلام السياسي، ويتعارض مبدئياً مع أي محاولة للمصالحة الوطنية المزعومة.
وفوق كل شيء، يرى هذا الفريق أن دعماً شعبياً عارماً لخطوات الجيش، لا يزعزع حقيقة واحدة لا تقبل النقاش، مفادها إن ما حدث هو إنقلاب عسكري محض، لا تكمن خطورته فقط في استبدادية أي حكم عسكري بالتعريف، بل أيضاً في الدعم الشعبي والنخبوي غير المشروط لخطواته الإستثنائية.
على الجانب الآخر، ثمة قطاع عريض من النشطاء والمثقفين العلمانيين، رغم انزعاجه المبطن من مشاهد الاحتفالات الجماهيرية بسقوط النظام الإخواني ومن مشهد رجال الشرطة محمولين على أكتاف المتظاهرين في ميدان التحرير فيما الهتافات تعاند الذاكرة القريبة: “الشعب و الشرطة و الجيش ايد واحدة”… فإن هذا القطاع يرى أن ما حققه المصريون في هذا اليوم هو تحول تاريخي استثنائي يستوجب الإحتفال. فكوابيس السلطوية الإسلامية وأحلام جماعة حسن البنا، التي، على مدى الأعوام الثمانين الماضية، كانت سبباً مباشراً أو غير مباشر في تقويض أي تجربة ديموقراطية والترويج للطائفية والرجعية والتسلط، في مصر والعالم العربي والإسلامي، هذه الكوابيس انسحقت أمام التجربة وإرادة الجماهير التي انتفضت ضدها، مستلهمة مشروعاً تنويرياً أكثر إنسانية وتعددية لوطن يتسع لكل أبنائه بلا تمييز.
ومع وعي هذا المعسكر بتحديات المستقبل القريب، وريبته الغريزية في العسكر، إلا أنه يرى أن القلق المبالغ فيه ليس سوى تعالٍ نخبوي على الجماهير المحتفلة، ويشابه فرض وصاية على فرحتها وإبخاساً لقدرتها على التمييز بين الصواب والخطأ، بل ويشكك في استبسالها دفاعاً عن حقوقها وحرياتها الأساسية وفي استفادتها من أخطائها في الماضي. يرى في القلق هذا احتقاراً مبطناً لحشود خاضت نضالاً مستمراً طوال عامين ونصف العام في وجه ديكتاتورية حسني مبارك، ثم المجلس العسكري، والإخوان المسلمين. نضال ضد “دولة يوليو” وغريمها التاريخي في الوقت نفسه. نضال ضد سلطوية رجال الدين، وضد استئثار العسكر، توّج في كل مرة بانتصار الإرادة الشعبية لقيم الحرية والعدالة والحق، ولو بعد حين. في النهاية، يرى هذا الفريق أن نقاشاً حول ماهية ما حدث، بوصفه انقلاباً أم ثورة، لا يعدو كونه رطانة تقنية لكهنوت نخبوي يعتبر نفسه قادراً على ضبط المصطلحات منفرداً، ومنح ختم الثورة أو نزعه عن الجماهير، حينما يحلو له. كهنوت لا يقل، في احتقاره لجماهير الشعب، عن أي سلطوية أخرى يدّعي معارضتها.
خلف الإنقسام المبدئي الجلي، داخل المعسكر العلماني، اتجاه الأحداث الجارية، تتجلى مخاوف مشروعة ومعها قلق منطقي إزاء المستقبل، تدعمه الذاكرة القريبة ويؤججه تأنيب على وعود لم تتحقق باسترجاع حقوق الشهداء، إضافة إلى أمل مستحَق في غد أفضل يحدوه إيمان عميق في المستقبل وفي قدرة الشعوب على الانتصار لحرياتها وإرادتها. هكذا، يحتدم جدل يبدو ضرورياً وحتمياً ومطلوباً، كأداة للنقد الذاتي والمراجعة، في طريق طويل من النضال أمام الجميع، لن يخلو من عثرات وكبوات ومحن آتية لا محالة.
المدن
اخوان مصر: أردوغانية أم “قطبية”؟
سعد محيو
يخطئ من يعتقد أو يراهن، على أن إطاحة الرئيس محمد مرسي، ستعني بداية النهاية لجماعة الإخوان المسلمين المصرية.
صحيح أن خسائر الجماعة كانت فادحة على كل الأصعدة حتى قبل “الانقلاب الشعبي- العسكري” عليها، حيث عجزت عن إثبات أنها قادرة وهي في الحكم على بلورة إجماع وطني جديد حول دولة وطنية جديدة؛ وصحيح أن أحداث الأيام الأربعة أثبتت تراجعاً كبيراً في قدرتها على التعبئة والقبول الشعبيين، إلا أن الصحيح أيضاً أن هذه الجماعة لم تمت طيلة 80 سنة من القمع والعمل السري، ولن تموت الآن على رغم محنتها الكبرى الراهنة.
لكن السؤال الكبير الآن هو: كيف ستتفاعل الجماعة من داخلها مع هذه المفاجأة السريعة الكبرى التي نقلتها من جنة الحكم والسلطة، إلى جهنم السجون والاعتقالات والملاحقات (مجدداً)؟
ثمة سيناريوهان هنا:
الأول، أن تؤدي ردود الفعل الغاضبة والانفعالية على الانقلاب الشعبي- العسكري إلى تضخيم مشاعر الاضطهاد والظلم لدى قادة الجماعة وقواعدها، الأمر الذي قد يسهِّل إعادة إنتاج الظاهرة القطبية (نسبة إلى سيد قطب) فيها والداعية إلى تكفير الدولة والمجتمع والعودة إلى العمل السري والعنف.
والثاني، حدوث تفاعلات وتمخضات تنظيمية حادة داخل الجماعة، ربما تشمل انشقاقات وتصدعات، ما يساهم في انتقال أجنحة فيها من الحالة الإسلامية الأربكانية التركية التي أرساها الزعيم الإسلامي التركي نجم الدين أربكان وسقطت على يد الجيش أيضاً العام 1997، إلى الحالة الأردوغانية الليبرالية التي تصالح في إطارها الإسلاميون الجدد الأتراك مع كل من الحداثة الفكرية والمادية ومع مفهوم الدولة الوطنية.
وربما يبرز أيضاً سيناريو ثالث قد يكون أسوأ من الأول، تعجز فيه الجماعة عن فهم الدرس الأساسي لفشل تجربتها في السلطة وهو أنها بقيت تنظيماً مغلقاً على نفسها حتى بعد أن باتت مسؤولة عن 85 مليون مصري وليس فقط مليوناً من الأعضاء الملتزمين. وحينها ستتمسك الحركة بتركيبتها السرية، مع العمل لاحقاً على المشاركة المحدودة في العمل السياسي تحت شعار “المشاركة لا المغالبة” الشهير الذي طبّقته طيلة العقود الثلاث من الحكم السلطوي للرئيس حسني مبارك.
أي السيناريوهات الثلاثة سيكون الأقرب إلى التحقق؟
الأمر هنا لن يعتمد فقط على التمخضات الداخلية داخل الجماعة (على رغم أنه يتوقع أن تكون بالفعل زلزالية)، بل وبالدرجة نفسها على التحالف العسكري- اليساري الليبرالي الحاكم الجديد، الذي سيتعيّن عليه أن يساهم في النقاشات الداخلية الأخوانية، من خلال فتح كل الأبواب والنوافذ أمام فرصة انضمام الجماعة إلى المرحلة الانتقالية الجديدة.
“خريطة المستقبل” التي طرحتها القوات المسلحة، وعزز مضامينها محمد البرادعي وشيخ الأزهر وبابا الأقباط، كانت حريصة على الدعوة الملحة إلى المصالحة الوطنية. وفي حال شق هذا التوجه طريقه إلى التنفيذ، سيكون في وسع الأردوغانيين المحتملين في الحركة أن يقوموا هم أيضاً بـ “ثورة ثانية” تحاكي ثورة 30 حزيران/يونيو الشعبية الثانية.
لكن، إذا ما كان لا بد من المغامرة في ممارسة لعبة التكهنات والتوقعات حيال السيناريوهات الثلاثة، سنقول أن سهم التاريخ سيصب في صالح السيناريو الأردوغاني الثاني.
لماذا؟
لأن تجارب الأحزاب الديمقراطية المسيحية في أوروبا في القرن التاسع عشر وتجربة الحركة الإسلامية في تركيا وأندونيسيا في القرنين العشرين والحادي والعشرين، تشي بأن الأحزاب الدينية التي دخلت عرين السياسة، تميل إلى طرح الإيديولوجيا جانباً والإعلاء من شأن البراغماتية الواقعية حين تتعرَّض إلى نكسات أو ردود فعل قوية من الدولة أو المجتمع.
والأرجح أن إخوان مصر سيسيرون هم أيضاً على هذا الطريق، ولو بعد حين، أي بعد أن يفيقوا من هول الضربة التي نزلت على رؤوسهم وأفقدتهم التوازن وحس الاتجاهات.
المدن
مصر تنهي فزّاعة الحكم الإسلامي !
روزانا بومنصف
من المفارقات اللافتة ان الدول الغربية في تبريرها لمسار الثورات العربية لدى انطلاقها توقعت ان تعبر هذه الثورات مخاضا طويلا وسنوات طويلة قبل ان تستقر على نتائج نهائية تلبي طموحات الشعوب تماما. اذ ان التجربة والتاريخ يثبتان ان الثورة لا تحصل وتفرز نتائج وتهدأ الامور وتنتهي بانتخابات نيابية او رئاسية خصوصا في حال لم تلبِّ هذه الانتخابات تطلعات الشعوب.
لكن ديبلوماسيين كثرا يقرون بأن ما حصل في مصر كان مفاجئا جدا بالنسبة اليهم لجهة نزول ملايين المصريين الى الشارع مطالبين برحيل الرئيس محمد مرسي اعتراضا على حكم الاخوان، تماما كما فاجأتهم مصر في ثورتها الاولى ضد الرئيس حسني مبارك على رغم المواكبة الدولية للمشكلات المصرية الاقتصادية والمالية المتعاظمة وتصاعد الاعتراضات ضد الرئيس المصري وقراراته. بذلك تفرض الثورة المصرية الثانية على الدول الغربية وكل الباحثين اعادة نظر جذرية في نظرياتهم حول اتجاه المنطقة الى الاسلام السياسي المتشدد على وقع حكم الاخوان في مصر وسريان عدواه في اتجاه تونس وسوريا وكل الدول المرشحة على خارطة الربيع العربي. فالليبراليون لا يزالون اقوى في مصر المتديّنة والمسلمة، علما ان مشكلة مصر متعددة الوجوه ومن بينها اساسا وجوهريا مشكلة اقتصادية وادارية لم يعرف حكم الاخوان التعاطي معها وتلهى بانتصارات وهمية في وضع يده على مفاصل الحكم. سيصعب على الدول الغربية واكثر على روسيا التذرع بعد الآن بالمخاوف من حكم اسلامي متشدد او اصولي من اتباع تنظيم القاعدة وانصاره يمكن ان يحل مكان النظام السوري حين يتفق على رحيله خصوصا ان سوريا متعددة الطوائف والاثنيات اكثر مما هي الحال في
مصر.
ويقول هؤلاء ان الثورة المصرية الثانية لم تكن في وجه الاخوان وحدهم مقدار ما كانت ايضا في وجه الولايات المتحدة التي دعمت وصولهم وساهمت في تغطيته حرصا على مصالحها في المنطقة الى جانب مصلحة اسرائيل وموقع مصر في المعادلة المتصلة بالموضوع الفلسطيني. وتاليا سيكون من الصعب على الولايات المتحدة ان تنأى بنفسها كما تفعل في الموضوع السوري، علما ان الوضع مختلف بين مصر وسوريا او ان تتدخل ايضا من اجل الا تكرر خطأ دفع الاخوان وتغطية دعم وصولهم الى الحكم في الوقت الذي لا يمكن ان تسمح للامور بأن تتدهور امنيا في شكل خاص وسياسيا
ايضا.
النهار
عن المآزق وخرائط الطرق
هشام ملحم
الانذار الذي وجهه وزير الدفاع المصري الفريق أول عبد الفتاح السيسي الى الرئيس محمد مرسي لتلبية مطالب الشعب والا فإنه سيتدخل لفرض خريطة طريق المستقبل، ورفض مرسي الانذار باسم الشرعية الانتخابية، أدخلا مصر في مأزق غير معهود وعمق الاستقطاب السياسي والايديولوجي على نحو يهدد السلم الاهلي. مصر الآن في حال تيه سياسي يأتي على خلفية ازمة اقتصادية خانقة وضعت البلاد على حافة الافلاس، وادت الى تفكك مؤسسات الدولة.
في الأيام الاخيرة تحدث كل طرف مصري عن خريطة طريق. والحقيقة المؤلمة أن لا طرف يملك وحده خريطة طريق لانقاذ البلاد. لا الجيش يملك مثل هذه الخريطة وهو لا يستطيع تحمل حكم البلاد مباشرة، والامر ذاته يسري على المعارضة بكل اطيافها، وقطعا لا مرسي ولا “الاخوان المسلمين” الذين اوصلوا البلاد الى الطريق المسدود.
التغييرات التي شهدتها مصر بين حزيران 2012 وحزيران 2013 مذهلة فعلا. قبل سنة ادى “تحالف” القوى الليبرالية – العلمانية الى اعادة العسكر الى ثكنهم وانتخاب محمد مرسي رئيسا. وخلال سنة فرض الاسلاميون دستورهم، وخاضوا حربا ضد القضاء، ووضع مرسي نفسه فوق القانون، وحاول الهيمنة على مؤسسات الدولة و”أخونتها”. هذه الممارسات اغضبت المعارضة، واتاحت المجال للعسكر كي يستعيدوا سمعتهم (المبالغ فيها) كمؤسسة وطنية فوق الشبهات.
أكثر المؤسسات المصرية اليوم معلقة، او مفككة او في حال انهيار تدريجي. من البرلمان، الى القضاء، الى الشرطة (التي أعلنت عمليا العصيان على مرسي) وغيرها. الاحصاءات تبين وجود فلتان أمني خطير: معدلات الجريمة ازدادت بنسبة 300 في المئة وتضاعف عدد السرقات المسلحة 12 مرة منذ 2011. المصريون يتسلحون بشكل غير مسبوق. في سيناء تطبق الشريعة الاسلامية على ايدي لجان محلية. السلطات المحلية في بعض المدن تنيط بالبلطجية او “باللجان الشعبية” مهمات حفظ الأمن في بعض الاحياء لأنها لا تثق بالشرطة.
خيارات الفريق اول السيسي محدودة. الانقلاب العسكري سيرتد عليه، لأنه سيدفع الاسلاميين المتشددين الى الكفاح السري العنيف، كما انه سيجازف بخسارة الدعم الاميركي العسكري، نتيجة المعارضة القوية في الكونغرس والاعلام. وواشنطن التي طورت علاقات عمل جيدة مع مرسي تحض الجيش المصري للضغط عليه توصلا الى تسوية (وشركة) مع المعارضة. إدارة اوباما رفضت انتقاد انتهاكات مرسي علنا، وهي تعامله الآن كما كانت تعامل مبارك، ورفضت جهود الكونغرس لتعليق المساعدات. وسفيرة واشنطن في القاهرة آن باترسون انتقدت لجوء المعارضة الى الشارع. فرد مرسي الجميل بتضييق الحصار على غزة واغراق انفاقها، واتخذ موقفا متشددا من ايران والنظام السوري. لكن أوباما لا يستطيع انقاذ مرسي.
النهار
السقوط المدوّي لحكم “الإخوان“!
راجح الخوري
عندما يقول خيرت الشاطر نائب رئيس المرشد “اذا سقط محمد مرسي لن يصل الاخوان المسلمون الى السلطة في مصر ولو بعد خمسين سنة” فذلك يعني ان الجماعة قررت ان تغامر بكل ما تملك من الاوراق وان تقف لا في وجه الشعب المصري فحسب، وقد افترش الميادين والساحات مردداً الصراخ “ارحل”، بل في وجه الجيش المصري الذي حمى الثورة في الماضي، وتبنى في بيانه الصريح اول من امس مطالب الشعب داعياً الى تفاهم خلال 48 ساعة ينهي الازمة، وملوحاً بخريطة طريق لاخراج مصر من الازمة الخانقة التي سببتها سياسة “الأخونة” الحمقاء.
وهكذا عندما اختار محمد مرسي ان يقف في منتصف الليل، ليلقي على اسماع اكثر من 30 مليون مصري يحتشدون في الساحات، خطاباً ممجوجاً في تكرار شعاراته الواهمة والخادعة اعتبرت المعارضة انه ساذج، فذلك يعني ان “الاخوان” اختاروا المواجهة مع الشعب والجيش، الامر الذي يذكّر بالسيناريو الذي اشار اليه الشاطر، والذي حدث عام 1954 عندما انقلب جمال عبد الناصر على محمد نجيب، وقام بالتنكيل بـ”الاخوان”، الذين ظلوا في التهميش الى ان انقضّوا اخيراً على “ثورة 25 يناير” التي يبدو انهم خسروها ويخسرون انفسهم معها، لسبب بسيط هو انهم لم يفهموا ان مصر دولة لا يمكنها، شعباً وجيشاً، ان تذعن للمرشد وان تنام في حريم السلطان!
كان مضحكاً بالفعل ان يقف رجل متحدياً 30 مليوناً من مواطنيه، فقد كرر مرسي حديثه عن شرعيته 37 مرة، معلناً رفضه اي اجراءات تهدد هذه الشرعية، ومهدداً بأنه سيحفظها بدمه، في اشارة الى رفضه بيان الجيش، بينما كانت الجحافل الشعبية التي تولد منها كل الشرعيات تستشيط غضباً وتكرر دعوته الى الرحيل.
وفي حين ارتفعت اصوات مؤيديه من “الاخوان” تدعو الى الاستشهاد دفاعاً عن شرعيته تعمّقت المخاوف من جنوح مصر الى التجربة الجزائرية الدامية، لكن مصر ليست الجزائر، واذا كان مرسي قد استطاع ان يدس روح “الأخونة” في الدستور وفي السلطتين السياسية والقضائية، فانه لا يستطيع وضع الجيش في جيبه بمجرد “تزحيط” محمد طنطاوي واستمالة سامي عنان مستشاراً شخصياً له، والذي سرعان ما استقال داعياً الى تلبية مطالب الشعب.
وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي هو ابن مؤسسة عسكرية لها حجم دولة داخل الدولة ومصلحتها الحيوية تنبع من ثبات الدولة، لهذا حرصت دائماً على الانحياز الى الشعب والابتعاد عن مغريات حكم العسكر، وعندما تتحدث عن خريطة طريق لتحقيق مطالب الشعب فعلى مرسي و”الاخوان” الاختيار بين امرين: اما اعادة مقاليد الثورة التي خطفوها الى الشعب، واما العودة الى مربع التهميش خمسين سنة اخرى كما يقول الشاطر!
النهار
الثورة تسترجع مِصرها والربيع
الياس الديري
قُضي الأمر، وتم ما جاء في كتاب الثورة التاريخيّة الأولى، وسقط محمد مرسي الذي لقبوه أخيراً فرعون “العشيرة الاخوانية”، وعادت الفرحة والبسمة لتغرّد في ميادين مصر وعلى وجوه المصريين الذين غادروا القمقم منذ الثورة التاريخية الأولى، وقرروا ألا يرجعوا اليه.
فجأة، وفي ساعة تخلّ، استطاع “الاخوان” والتنظيمات المشتاقة الى السلطة والحكم والهيمنة وضع أيديهم ومناصريهم واتباعهم في كل مفاصل الدولة والمؤسسات… حتى أعادوا الى أجهزة القمع والتسلّط “أمجادها” السابقة.
لكن الذين قرروا التمسّك بالحرية والديموقراطية دون تردّد، عادوا الى الميادين. وبعناد وتصميم قالوا فلتكن ثورة ثانية. ولتكن مليونيّات. ولتكن مواجهة مع سارقي الثورة التي جعلوها “ملكهم”، والربيع الذي ذبل سريعاً وصار خريفاً دائم العبوس والتجهّم.
باعتزاز كبير وثقة تامّة، يستطيع الشعب المصري العنيد حقاً أن يقدّم نفسه للعالم بأسره كنموذج عصري لثائر لا يتهاون مع حاكم، أو سلطة، أو جماعة، اذا ما حاولت الاعتداء على حرية انتزعها بصبر وإصرار، وعلى ديموقراطية أراد لها أن تكون مثالاً يُحتذى، وعلى مصر أم الدنيا، مصر الجديدة، مصر النموذج الحديث في العالم العربي المغلوب على أمره، هو وشعوبه التي فشلت حتى في إدارة انتصاراتها الرائعة على حكّام الاستبداد والتسلّط والإرهاب.
ماذا الآن، أي مصر سنرى غداً، أي حكم، أي حكّام، أيّ نظام، أي دستور، أية حريّات، هذا كله سيبقى مرسوماً في الأذهان والعقول والقلوب، الى أن يظهر الخيط الأبيض من الخيط الأسود في “الثوب” الجديد الذي تفضّله قيادة الجيش للمرحلة الانتقالية، ولمصر الثورة الثانية ونظامها ومؤسساتها…
كان لزاماً على القوات المسلحة أن تأخذ المبادرة، فتقدم على خطوة جريئة لا بد منها، كفيلة بإنقاذ مصر من أيدي “العشيرة الاخوانية”، وتنتشلها من الهاوية التي دفعها اليها حكم رجل كاد يتصوّر نفسه مشروع مبارك أو قذافي “إخواني”، أو نسخة “منقحة” عن كبار في التاريخ، كالرئيس جمال عبد الناصر مثلاً.
أجل، الى هذا الحد، والى هذه الدرجة…
كان لا بد من هذه الثورة، التاريخية بدورها. وهذا الانقلاب الشعبي العسكري السياسي الوطني، الذي أعاد الى الثوار، الأساسيّين الحقيقيين، ثورتهم. مثلما أعاد ثقتهم بأنفسهم وبهذا الشعب الذي انتصر على الخوف، وحتى على البلطجيّة وحُماتهم.
الآن، نقطة في نهاية “حكم العشيرة”، والى ورشة بناء مصر جديدة يستحقها شعب عظيم.
النهار
سلفيو مصر يفاجئونها و«يمزّقون» الأيديولوجيا
سمير العركي *
تمكنت الحالة السلفية من حفر مكان بارز لها في عمق الحالة الإسلامية منذ سبعينات القرن المنصرم، إلا أنها تميزت بحال من الركود والكمون النسبيين طوال ثلاثة عقود تقريباً ولم تبرز كحالة مؤثرة في الساحة المصرية إلا بعد نجاح ثورة يناير 2011 حين فوجئ المجتمع المصري بحشود هائلة من الشباب ذوي المظهر الموحد تملأ الميادين والطرق، بخاصة مع أول استحقاق ديموقراطي تشهده مصر بعد الثورة خلال الاستفتاء على تعديل بعض مواد الدستور في 19 آذار (مارس) 2011. وظهر جلياً حينها مدى قوة التيار السلفي الذي لعب دوراً مؤثراً في توجيه الرأي العام المصري للتصويت ب «نعم» بنسبة تجاوزت 77 في المئة، متعللاً حينها بأن «نعم» ستضمن عدم المساس بهوية مصر الإسلامية وعدم الاقتراب من المادة الثانية للدستور الخاصة بكون مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع.
بروز التيار السلفي بتلك الصورة سبب دهشة كبيرة في الشارع المصري، لأنه ظل منزوياً مبتعداً من الأضواء عقوداً بفعل القبضة الأمنية القوية التي وضعت له حدوداً عليه ألا يتخطاها، إضافة إلى الجدب الفكري الذي طبع حالة التيار والتي أثرت عليه في التفاعل مع قضايا العصر نتيجة إيمانه بتفاهة الالتفات إلى هذه المستجدات الفكرية على حساب كتب السلف التي آمن التيار بأنها تحوي كل الحلول لمشكل عصرنا ومجتمعاتنا، ملغياً الأبعاد الزمانية والمكانية لتراث أمتنا الكبير.
وكان دخول التيار السلفي حيز الأضواء إيذاناً ببدء حالات نقاشية عن ماهية أفكاره ومدى استعداده للجمع والتوفيق بين الأصالة التي يجنح إليها باستلهام خطى السلف وبين المعاصرة بقيمها وآلياتها. كما تمددت النقاشات واتسعت حول مدى قبول السلفيين للديموقراطية وتداول السلطة، بخاصة بعد تأسيس حزب «النور» الذي تمكن من الفوز بنحو 25 في المئة من مقاعد مجلس الشعب (البرلمان) في مفاجأة أذهلت الجميع نظراً إلى حداثة تكوينه واشتغاله بالسياسة.
إلا أن البحث الجاد في الحالة السلفية ما زالت تكتنفه صعاب جمة ويتجشم الخائض فيه مرارات وعذابات نتيجة لأمرين: الأول عدم انتظام التيار السلفي العام في سلك فكري واحد أو انضوائه تحت غطاء أيديولوجي جامع، ولكننا هنا أمام فسيفساء فكرية تتشظى تبعاً لانتشار «المشايخ» ووجودهم، ما يوقعنا في إشكالية التعميم الخاطئ، فما يلتزم به «شيخ» ما أو مجموعة ما قد لا تلزم غيرهم.
الثاني: قلة الأدبيات التي تعالج المسائل الفكرية المتجددة في الحياة المعاصرة نتيجة ابتعاد التيار السلفي عن الشأن العام لسنوات طويلة وعدم إيمانه بجدوى مثل هذه الاشتباكات.
الأيديولوجي الممزق والبديل الغائب
تمثل ثنائية المطلق والنسبي إحدى أهم المشكلات داخل الخطاب السلفي خصوصاً والحركة الإسلامية عموماً، فطوال العقود الماضية كان الخطاب متمترساً خلف مقولات لم يتم اختبارها أو التأكد من صحتها ونفعها.
ففي حيز الأيديولوجيا كنا أمام خطاب زاعق يتميز بميله إلى التحريم والرفض المطلق لمعظم قيم العصر الحديث ومفاهيمه من دون بذل الجهد في محاولة التقريب أو بناء نموذج مقارب مرتكزاً على الثوابت العقدية والقيمية الإسلامية. فعلى سبيل المثال كان الخطاب السلفي مصراً على «تكفير» الديموقراطية كمفهوم وممارسة باعتبارها افتئاتاً على حق الله تعالى وإهداراً لمفهوم «الحاكمية»، وشن رموز السلفيين غارات متتالية عليها وكان لزاماً أن يأخذوا في طريقهم جماعة «الإخوان المسلمين» التي كانت الوحيدة تقريباً بين فصائل الحركة الإسلامية قبل الثورة المهتمة بالعمل السياسي. فالقطب السلفي عبد المنعم الشحات (الناطق باسم الدعوة السلفية في الإسكندرية) لم يتورع عن اتهام «الإخوان» قبل الثورة بمخالفة قواطع الشريعة، إذ رأى أنهم يدفعون ثمناً باهظا لدخول لعبة «الديموقراطية»، وهي غير إسلامية في الأصل، ما اضطرهم لتقديم تنازلات. وظهرت بوادر خلاف حاد حول انضمام عصام العريان إلى مكتب الإرشاد، لميله إلى تقديم مزيد من التنازلات في سبيل الاندماج في اللعبة الديموقراطية، بما في ذلك الاعتراف الضمني بـ «الوصاية الأميركية» على التجربة الديموقراطية في مصر.
ويضيف الشحات: «وبينما يفضل الإخوان الخوض مع كل هذه الأخطار من الهيمنة الأميركية إلى التحالف مع الأحزاب العلمانية، ترى الدعوة السلفية أن الفاتورة التي يُطالب الإسلاميون بدفعها تمثل خصماً من أحكام شرعية قطعية لا يمكن بحال قبولها، ومن ثم أعرضنا عن الحياة السياسية بمفهومها المعاصر، وانصرفنا إلى الدعوة إلى إصلاح المجتمع: حكاما ومحكومين، وإلى التزام الجميع بشرع الله، ومن الطبيعي لدعوة اختارت أن تنأى بنفسها عن المشاركة في النظام الديموقراطي لأسباب شرعية أن تنأى بنفسها عن مناقشة تفاصيله، وأن تستوي عندها فيه خياراته».
ودأبت الدعوة السلفية على مهاجمة الديموقراطية عبر العديد من الأدبيات واللقاءات المسجلة، كسلسلة «السيادة للقرآن لا للبرلمان» لمحمد إسماعيل المقدم، وكتاب «الديموقراطية في الميزان» لسعيد عبد العظيم.
انتقال مفاجئ
ولكن فور أن وضعت الثورة أوزارها فوجئ الجميع بانتقال الدعوة السلفية «السلمي» من ضفة «التحريم» إلى ضفة «المشاركة والمغالبة» من دون سابق تمهيد أو معاناة بحث وتدقيق، بل سارعت إلى تمزيق أيديولوجيتها السابقة على رؤوس الأشهاد، وذلك بصدور القرار السلفي بإنشاء حزب «النور» لخوض غمار التجربة الديموقراطية وما استتبعه من تقديم التنازلات ذاتها التي أنكرها الشحات قبل ذلك على جماعة «الإخوان»، كالاعتراف بحق المرأة في الترشح للمجالس البرلمانية والاعتراف بالأحزاب المؤسسة بعيداً من المرجعية الإسلامية، والاعتراف بحق الأقباط في الترشح للمناصب العامة عدا رئاسة الجمهورية بطبيعة الحال، وهي اجتهادات حركية استجابت للتغيرات الحادة التي أصابت البيئة المصرية.
تفسير هذه التحولات السلفية الحادة بعد الثورة لا يخرج عن أمرين، الأول أنها جاءت نتيجة اقتناعات فكرية حقيقية مؤسسة على اجتهادات فقهية جديدة تؤسس لنظرة سلفية جديدة إلى الواقع السياسي وكيفية التعامل مع مفرداته وآلياته. والثاني، أن هذه التحولات إنما جاءت من باب «البراغماتية» التي لا تعبر عن تغير فكري حقيقي، بخاصة أن فتاوى الكثير من «مشايخ» السلفية كانت جازمة في تحريم الديموقراطية حتى وإن مورست ممارسة سليمة صحية وسمحت بدمج الإسلاميين فيها. ففي فتوى سابقة للقيادي في الدعوة السلفية الشيخ سعيد عبد العظيم سئل فيها عن حكم دخول مجلس الشعب البرلمان قال: «الديموقراطية وثن يُعبد من دون الله، وهي دين عند أهلها، كما أن الإسلام دين عند أهله. وقد تأتي صناديق الاقتراع بملاحدة أو زنادقة (ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا) ومن الوهم أن نعتبرها مثل الشورى الإسلامية، ففي النظام الديموقراطي تجري الشورى في الأمور التي وردت فيها النصوص الشرعية، ويُستشار في ذلك من لا دين عنده على عكس ما يحدث في الشورى عند المسلمين فلا يجوز أن نتشاور مثلاً في منع الخمر أو إباحتها. لقد انتهج بعض الدعاة خطاباً سياسياً ديموقراطياً وخطاباً شعبياً دينياً وهذا من التناقض المريب، والوصول إلى الحكم لا يبرره، إذ هدفنا هو مرضاة ربنا، والغاية لا تبرر الوسيلة، كما نرفض مناداة البعض بالإصلاح الديموقراطي وإقامة حياة ديموقراطية سليمة كما يقولون، إلى غير ذلك من التعبيرات الممجوجة والفاسدة».
والبراهين التي أقامها عبد العظيم كدليل على صحة فتواه لم يتغير منها شيء حتى نقول إن تغير الواقع أدى به إلى تغير فتواه، فصناديق الانتخابات من الممكن أن تأتي بملاحدة وزنادقة على حد تعبيره ووصفه. كما أن واقع المشاركة الديموقراطية يفرض على السلفيين القبول بما أنكروه على غيرهم، وبخاصة جماعة «الإخوان المسلمين» من جواز ولاية غير المسلم وولاية المرأة، إذا كانا اختيار الجماهير وإفراز الصناديق.
ويبقى التفسير الثاني هو الأقرب إلى القبول بخاصة فى ظل ندرة الكتابات الفكرية والفقهية المعمقة التي تعالج مثل هذه الإشكاليات المشار إليها والتي تؤسس لرؤية سلفية جديدة تجاه الديموقراطية وقيمها وآلياتها، خصوصاً بعد تمزيق الأيديولوجيا السابقة والذي لم يواكبه جهد مكافئ يوضح النظرة السلفية العامة ليس في قضية الديموقراطية وحدها بل في كل القضايا ذات الصلة.
• كاتب مصري
الحياة
اخطاء «الاخوان» تقود إلى الثورة المصرية الثانية
شفيق ناظم الغبرا *
لم ينجح النظام المصري بقيادة الرئيس محمد مرسي في تقديم استجابة مناسبة لظروف مصر الجديدة والملتهبة. فقد ظل النظام الجديد، الذي ورث نظام حسني مبارك بعد ثورة ٢٥ يناير، محل شك وتحت الاختبار من جانب الشعب المصري. وقد استمرت الاتهامات الموجهة إلى النظام الجديد من المعارضة منذ انتخاب الرئيس في حزيران (يونيو) ٢٠١٢ مؤكدة وجود حالة استبعاد، فرض للدستور، أخونة، ارتجال، سوء إدارة، تلاعب في مناطق صناديق الاقتراع، مما شكك في قدرة النظام الجديد على إدارة وضع بلد بحجم مصر. وفي البداية لم تكن غالبية المصريين لتستمع الى اتهامات المعارضة بحق الرئيس انطلاقاً من أنها اتهامات منحازة وأنه يجب تجربة الرئيس. لكن فوز مرسي بنسبة ٥١ في المئة من مجموع الأصوات عنى موضوعياً ان الـ ٤٨ في المئة الآخرين ممن صوتوا للفريق احمد شفيق خوفاً من «الإخوان» وعلى حرياتهم الشخصية (قطاع كبير ممن صوتوا للفريق شفيق كانوا مناصرين ومشاركين في ثورة ٢٥يناير) هم في حالة تشكك دائم، وأن حصول تفكك في الجبهة التي ساهمت أساساً بفوز الرئيس مرسي و «الإخوان» سينعكس على مجمل التحالفات، لهذا فالاستقالات والخلافات حول الدستور وكتابته وبروز جبهة الإنقاذ (وهذه فئات انتخبت الرئيس) كانت بداية النهاية لأنها عنت تراجعاً كبيراً في وضع رئيس انتُخب بفارق بسيط بعد ثورة لا يزال الكثير من ممثليها في الشارع وخارج السلطة.
الرئيس مرسي لم يأخذ في الاعتبار ان السياسة الناجحة بعد فوز ضعيف يجب ان تكون قادرة على تحقيق إنجازات واضحة لإقناع الذين انتخبوه بصحة خيارهم ولإقناع من عارضوه من الـ ٤٨ في المئة المتشككين بضرورة الالتفاف حول سياساته. لكن عدم نجاح مرسي مع الذين صوتوا له في البداية ثم مع الذين لم يصوتوا له هو الذي دفع بالوضع في مصر إلى هذه الثورة. فمع الوقت وعلى مدى عام قامت تحالفات جديدة وتم تحفيز فئات المجتمع من الغالبية الصامتة بسبب سوء إدارة النظام الجديد وضعف قدرته على احتواء الناقدين وبسبب تخبطه.
الحالة المصرية نموذج بامتياز لما قد يقع بعد ثورة كبيرة وشاملة من نمط ٢٥ يناير ٢٠١١، فمن يتصدر المشهد في البداية ويستعجل حصد نتائج الثورة يدفع ثمن هذا التصدر ولن يكون موجوداً في الواجهة في مراحل لاحقة ان لم يحسن الادارة والاحتواء والتحالف والتنازل والمساومة. فالثورة المصرية كانت في البداية ثورة مشتركة بين فئات عدة، وهي في هذا مختلفة عن الثورتين الروسية والإيرانية، والثورة المصرية حتى اللحظة ثورة مشتركة بين فئات عدة، لهذا فمن يسعى للاستحواذ أكان الجيش ام «الاخوان» او غيرهما سيدفع ثمناً كبيراً من رصيده ومكانته ومستقبله.
لقد أخطأت الجماعة (تيار «الإخوان المسلمين») إستراتيجياً عندما تراجعت عن موقفها الأول بعد ثورة ٢٥ يناير والقاضي بعدم الاستفراد وبعدم ترشيح رئيس للجمهورية منها، وأكدت الجماعة بعد الثورة انها لن تسعى الى أكثر من ثلث مجلس الشعب حتى لو استطاعت الحصول على أكثر. كنت أعتقد حينها أنها فعلت كل هذا لأنها تعلم أن الثورة التي وقعت في مصر كانت مدنية ولم تكن إسلامية وكانت مشتركة ولم تكن لفصيل محدد. هذا التواضع في البداية شجع الكثيرين على الثقة بحكمة «الإخوان» وإمكانية ان يكونوا جسراً ايجابياً في المرحلة الانتقالية. لكن موقف «الإخوان» تغير مع الوقت لمصلحة ترشيح رئيس للجمهورية والسعي لأخذ أكبر عدد ممكن من المقاعد في مجلس الشعب والشورى في ظل انتخابات شابها الكثير من التساؤلات. وقد سعت الجماعة لفتح عشرات المقرات في مصر بما في ذلك المقر الذي تم فتحه في المقطم والذي يطل على القاهرة. وعندما زرت المقر بعد افتتاحه لإجراء حوار مع احد قادة التيار كنت أشعر أن هذا من حق التيار، لكنني كنت أتساءل إن كان «الاخوان» سيعيدون، من دون قصد، استنساخ صيغة شبيهة بالحزب الوطني ومقراته وطريقته.
بعد عام من حكم الرئيس مرسي انتقلت المبادرة الى الشارع بعد أن تبين أن الرئيس لا يعرف ماذا يريد وكيف يحققه وربما لا يحكم بصورة مباشرة. لقد أدت حالة التآكل في الدولة المصرية وأزمة كتابة دستور بصورة شبه منفردة وتهميش للفئات المجتمعية الأخرى بما فيها الثورية التي صنعت الثورة في ظل تراجع الخدمات والبنزين والكهرباء والعمل والاستثمار الى زيادة منسوب الغضب الشعبي. بل أدى خطاب الرئيس منذ أسبوع الى أكبر خيبة امل، فقد وضح من خلال الخطاب ان الرئيس كان معزولاً عن مجرى الأوضاع في الشارع، مما ساهم في انضمام فئات جديدة الى حركة «تمرد» التي جمعت ملايين التوقيعات مطالبة باستقالة الرئيس وبانتحابات مبكرة.
وبينما لا يستطيع الجيش في مصر إلا الانحياز الى الشعب بملايينه وذلك لتفادي انهيار الدولة وتفككها، إلا أن الرئيس مرسي تجاهل في خطابه ليل اول أمس حجم الحدث المصري الشعبي ومغزاه من منطلق التمسك بالشرعية. كان الافضل للرئيس القبول بانتحابات مبكرة، لأن البقاء من الآن فصاعداً سيجعل خسائر الرئيس وحزب «العدالة والتنمية» و «الإخوان المسلمين» أعلى. على الأغلب كان الخطاب الاخير لمرسي مناسباً لو قيل قبل أسبوع، لكنه جاء متأخراً عن حركة الشارع وسيساهم في حشد مزيد من الناس ضد الرئاسة.
إن خطأ الرئيس مرسي هو الانطلاق من أن صراع الشرعية في مصر مرتبط فقط بصندوق الاقتراع. لكن الأمر أعقد من هذا، بل يرتبط بمدى قبول الناس بالرئيس بعد ارتكابه أخطاء رئيسة جعلت شرعيته تسقط في أعين المجتمع، والمشهد مرتبط باستمرار وجود شرعية ثورية نتاج مراحل الثورة المصرية وتحولاتها. لهذا عندما ينزل ملايين من الناس إلى الشارع من الصعب أن تصمد شرعية مهما كانت راسخة. إن الشارع لا يلتئم كل يوم بمشهد مثل الذي نراه في مصر. إن تجاهل نزول ملايين المصريين الى الشارع انتحار سياسي للفصيل الذي يجرؤ على هذا التجاهل.
ان الحديث عن دور خارجي في تفسير المشهد المصري فيه الكثير من الاستخفاف بالشعب المصري وبالأعداد الهائلة التي اندفعت مطالبة بالتغيير، فالظاهرة في مصر داخلية ومحلية بكل الأبعاد، لكن هذا لا يعني ان أطرافاً عربية ودولية لم تتداخل، لكن الأهم أن قيمة مواقف او تداخل هذه الاطراف، أكانت اميركية ام عربية هي ثانوية نسبة الى الوضع الداخلي الرئيسي الذي يحرك المشهد: فشل تجربة مرحلة الانتقال وبروز أجواء ثائرة على الوضع في الوسط المصري الشعبي. في امكان الأطراف الخارجية التأثير في فئة وجماعة بهذا الاتجاه وبذاك، لكنها لا تحرك ملايين الجماهير الواسعة المكونة من ريف ومدينة وفقراء وأغنياء، وطبقة وسطى من نساء ورجال وشباب وحركات ثورية ملتزمة بمبادئها.
ان ما يقع في مصر يؤكد أن الثورة المصرية متجددة كما أنها تمر بمراحل ودورات. كما يؤكد ما يقع في مصر أن «الربيع العربي» ليس إسلامياً كما يعمم ناقدو الربيع، بل الربيع في جوهره إنساني ديموقراطي مدني ومشترك يطالب للشباب العربي وللشعوب بحقوق وتقرير مصير وتداول سلمي على السلطة. التيار الإسلامي مرحلة من مراحل الربيع العربي، والتيارات المعارضة الرسمية التقليدية هي الأخرى تيارات آنية وستمثل مرحلة من مراحل الربيع، بل ان الطبقة السياسية العربية المعارضة الراهنة تمثل مرحلة، بينما جوهر الثورات العربية شبابي، ويمثل جيلاً جديداً ويحمل روحاً نقدية لمفهوم الدولة والسلطة كما تنشقتها الأجيال العربية الرسمية. إن فكرة مدنية الدولة وحياديتها تجاه المجتمع في ظل رفض واضح للاستبداد السياسي والاستبداد الديني والطائفي تمثل احد اهم روافد الثورات العربية بقيادة التجربة المصرية.
هناك تغير كبير في مصر تجاه الاسلام السياسي (على رغم تنوع مواقفه) وتجاه مظاهر التدين المبالغ بها، وسيزداد هذا الامر حدة إن وقعت مواجهات وخسائر، لكن تيار «الاخوان» سيبقى تياراً فاعلاً في الحياة السياسية المصرية، وسيكون لزاماً عليه القيام بمراجعات شاملة للوضع السياسي والفكري الذي جعله يفقد نسبة كبيرة من الحضن الشعبي الذي قدم له الحماية والدعم والقوة على مدى سنوات وعقود. فالتجربة خير معلم للشعوب وللتيارات وللقوى السياسية كما وللأنظمة والسلطات الحاكمة.
إن تحقيق أماني المصريين سيتطلب العودة ثانية الى ألف باء المرحلة الانتقالية التي تتضمن انتخابات رئاسية وبرلمانية جديدة وتآلفاً وطنياً ودستوراً ينسج بإجماع القوى السياسية وتساهم في كتابته كل الاطراف الرئيسة. ثورة مصر كانت ولا تزال ثورة شباب، لهذا يجب ان تترجم هذه الثورة عند مأسستها أماني الشباب ويجب أن تسمو الى الروح التي أنتجت شجاعتهم وحركت تضحياتهم.
* استاذ العلوم السياسية في جامعة الكويت
الحياة