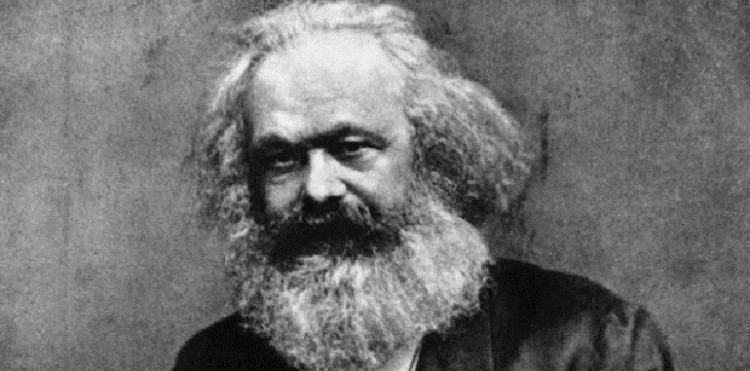أيديولوجيات فجّة حول الثورات العربية
شاكر الأنباري
جماهير متنوعة شاركت في الثورات العربية وبأكثر من بلد، معظمها لا تقاتل ضمن أيديولوجيا بعينها. هذا التنوع في المشاركة هو الذي يضعها، ربما، في خانة الثورات الشعبية. ثورات شعبية يحاول البعض الاستفادة منها وتجييرها، سواء كانوا من الاسلاميين أو من اليسار والقوميين، ويمكن قراءتها كثورات، غير مسبوقة النمط، أكثر من قراءة، وكل ذلك يعكس غناها وخصبها. ومن هنا تأتي أهميتها الراهنة، وقدرتها على نقل الوعي العربي، تاريخيا، الى مرحلة جديدة، تقترب، بالمحصلة، من نبض الفضاء العالمي.
الصورة التي نراها، تتعايش فيها اتجاهات مختلفة: سلفية، اخوان مسلمون، قوميون، شيوعيون، ليبراليون وسلفية جهادية. والأمر ليس بمستغرب ما دامت تعكس مجتمعا في سيرورة غليان، وتحول. ثمة مشتركات واضحة بين تلك الثورات، وفي الوقت ذاته ثمة خصوصيات لا يمكن تجاوزها. في المغرب، على سبيل المثال، خرجت تظاهرة قبل فترة شارك فيها نحو خمسة عشر ألف متظاهر تناوئ الاسلاميين الذين فازوا في الانتخابات الأخيرة، بينما اسفرت انتخابات الجزائر عن حصول الاسلاميين على نسبة منخفضة من الأصوات. ربما تقرأ الحالة الجزائرية من زاوية تختلف عن مثيلاتها العربية، فالجزائر ورغم تأثير وجود جبهة التحرير التي فازت في الانتخابات، وكونها تمسك بالسلطة، الا ان الجزائر تعرضت طوال عقدين تقريباً لتجربة مع السلفية الجهادية، التي كادت ان تحول الجزائر كلها الى ساحة حرب. دفع ثمن ذلك آلاف المدنيين، اضافة الى كونها، اي السلفية الجهادية، حركة ارتدادية عن الحياة المدنية، ما جعل الجزائريين ينكصون عن تأييد التيار الإسلامي سواء كان متشدداً او معتدلاً. الشعب الجزائري جرب الاسلاميين، في مدياتهم القصوى، اي تغيير الواقع بالعنف وقوة السلاح. الإسلام السياسي الجزائري في ذروة وجوده على الساحة تبنى العنف لتغيير الواقع، عبر مجموعات مقاتلة كانت تواجه السلطة، لتنتهي في أخريات ايامها لمواجهة الجميع.
في العراق أيضاً تبنت السلفية الجهادية، بما في ذلك القاعدة، الأسلوب ذاته. ابتدأت نشاطها تحت شعار محاربة الاحتلال الاميركي ثم انتهت بمحاربة الطوائف الأخرى والأديان المختلفة في محاولة لفرض واقع مذهبي سلفي، عنفي، فكان أن فشلت تماماُ في التجربة، ما انتج تيارات شعبية لا تؤمن بالعنف في تغيير الواقع والتجأت الى الأسلوب السلمي، اي التظاهرات الجماهيرية، والنشاطات المدنية والوسطية في تغيير الواقع، وعلى رأس ذلك الانتخابات. الثورات التي نجحت في اسقاط الحكم كتونس ومصر، شاركت فيها مختلف التيارات والآيديولوجيات، لكنها تتعرض الى ضغطين يريدان ارجاع الساعة الى الوراء. الأول هم الاسلاميون بمختلف أطيافهم، والثاني هي التيارات القومية واليسارية. لعل أهم تيارين قوميين وصلا الى الذروة هما تجربتا حزب البعث في العراق وفي سورية، والنهاية التي وصل اليها بعث العراق معروفة، اما بعث سورية فهو في الطريق الى بلوغ مصير مشابه، سواء كنظام حكم أو كآيديولوجيا. من هذه الخارطة المتداخلة أميز ما يمكن ملاحظته ان هناك خطين بارزين ظهرا منذ بداية الألفية، خط متشدد في العداء للغرب، وأميركا، يتاجر باسم فلسطين والمقاومة، ويقمع أي معارضة داخلية وتعددية وحرية إعلامية، ويستخدم خطاباً ديماغوجياً لسحب الجماهير حوله، تغطية على القمع المتطرف نحو اي صوت معارض، وتجسد ذلك في نظام معمر القذافي، وصدام حسين، وبشار الأسد، وعلي عبدالله صالح، ويصب في محيطه معظم الأحزاب اليسارية والاخوانية والسلفية. وهو يسعى جاهداً الى التمسك بالسلطة، والإحتفاظ بها بأي ثمن، وكان بشكل ما عنواناً للنظام العربي الرسمي طيلة عقود. ورأينا انحياز معظم الأحزاب الشيوعية الرسمية الى هذه الأنظمة، أو على الأقل تلاقت مع رؤيتها للعالم العربي، مهما طرحت من ذرائع. وتجلت هذه الحقيقة بابتذال واضح في موقف أحزاب الجبهة الوطنية في سورية، وبعض الأحزاب الشيوعية الرسمية الأخرى، تحت الشعارات ذاتها، العداء للامبريالية، والتدخل الخارجي، والقضية الفلسطينية.
في الجانب الآخر كان هناك تيار واسع ينبع من حاجات الشعوب اليومية، في مطالبتها بالحرية، والتعددية، والانتخابات، والانفتاح على شعوب العالم، ورفض تغوّل الأجهزة الأمنية، التي تاجرت طويلا بالقضايا القومية، وأمجاد العرب، والحضارة الزاهرة التي بنيت ذات يوم. لعقود طويلة قامت الأنظمة وأجهزتها القمعية والاعلامية بتضليل تاريخي لتلك الشرائح، سرعان ما انكشف في اللحظة التي اصطدمت فيها تلك الجماهير مباشرة بالسلطة. حينئذ تبدى لها الوجه البشع، والحقيقي للسلطة. كنا شهود زور على بشاعة ما مارسته كتائب القذافي ضد شعبها والمدن الثائرة، فكانت المدن تقصف بالدبابات والصواريخ وكأنها مدن لا تنتمي الى الوطن. اما المجازر فارتكبت بضمير ميت، وعلنيا، وبتبجح فج من قبل وحوش تربت عقودا على تلك الأكاذيب التي نمتها، وصنعتها تلك الأنظمة كبضاعة جاهزة. هذا ايضا ما نشاهده في الثورة السورية، اذ ان العدو أصبح كما يقول بشار الأسد داخليا، اي الشعب السوري، وليس اسرائيل المحتلة للجولان والتي تغتصب الأرض والحقوق.
التيار الشعبي الذي بدأ الثورة، وقادها، ولم يقطف ثمارها حتى اليوم، لم يعد يؤمن بمقولات حكامه الفارغة حول المقاومة، والامبريالية، والمؤامرة الخارجية، والخصوصية الوطنية، وغير ذلك من مفاهيم كانت غطاء للقتل والنهب والتسلط طوال خمسين سنة. يريد تيار الثورة ان يدلي برأيه من دون أن يعتقل أو يقتل من دون أن يتهم بالخيانة من قبل حراس الآيديولوجيا. ويريد ان يسافر، ويتعلم، ويقيم في البلد الذي يشاءه، ويتخابر بأحدث الأجهزة مع مواطني العالم، ويرى إعلاماً يلائم فكره وذوقه، ويتعلم في الحواضر المتقدمة. يريد عملاً وشوارع نظيفة ومستشفيات متطورة وقضاء نزيهاً غير مرتهن لسلطة الحاكم، وأجهزة شرطة تحترم مواطنيها وتكون حقاً في خدمتهم وليس العكس. الحرية فوق كل شيء، هذا ما ارادت تلك الثورات ايصاله الى العالم. هذه الجموع التي دفعت دماءها ثمنا لتغيير مثل هذا لا يمكن لها أن ترضى بسلطة مشابهة للتي ثارت عليها حتى وان جاءت برداء اسلامي.
ومن يلاحظ الانتخابات الرئاسية المصرية يمكنه الوصول الى هذه الحقيقة. نسبة المشاركين في التصويت بلغت حوالي واحد وخمسين بالمئة، واستطاع الليبراليون، بمجموع مرشحيهم، من نيل ما يقارب الاثني عشر مليون صوت، بينما حصد الاسلاميون ما يقارب التسعة ملايين، واذا اعتبرنا ان من لم يشارك في التصويت بعيد عن تأييد الاسلاميين فالنتيجة من دون شك ان الكتلة الأكبر من المجتمع المصري تريد مجتمعا حضارياً، ليبرالياً، متعدد الأحزاب، حر الصحافة، منفتحا على العالم، يحلم بحياة افضل ولا يرغب في الارتداد الى القرون الوسطى. هذه الكتلة لا تميل مستقبلا الى تقبل آيديولوجيا واحدة تتحكم بها، خاصة الاسلامية واليسارية والقومية بنماذجها المجربة. وهي تؤمن بالخيارات المتعددة، وتنزل الى الشارع اذا ما أحست ان السلطة التي تحكمها لا تلبي طموحات حياة حرة وكريمة، اجتماعياً واقتصاديا.ً
في التجربة العراقية، على سبيل المثال، كانت هيمنة التوجه الاسلامي على المجتمع جاءت بالقمع، والفرض، والقتل أحياناً، وهي حال مرفوضة شعبيا. لكن هذا الرفض، وبسبب انشقاقات طائفية وقومية وحزبية، لم يتبلور في الشارع على شكل حركة احتجاجية واسعة. أُجهضت الحركة الاحتجاجية في «ساحة التحرير« قبل سنة بقمع وحشي وتضافرت الأحزاب الاسلامية على تشويهها وتطويقها ثم انهائها. لكن القناعة العامة ان الحكم الاسلامي مفروض فرضا بوسائل عديدة، اقلها ذكاء هو العنف. في مجتمعات اخرى، بمواصفات أقل تشتتا، مثل المجتمع التونسي، لن تتكرر التجربة الديكتاتورية حتى بوجود قوة اسلامية على رأس السلطة. وصول الحركة الاسلامية الى السلطة انتصار موقت، وهو استدراج مستقبلي لثورة ليبرالية أخرى. البيئة الثائرة لن تعيد انتاج الخنوع ذاته مرة ثانية.
هذه الحقائق، وغيرها، لا يريد مناوئو الربيع العربي رؤيتها، ولا يريدون رؤية التغيرات النوعية في العقل العربي. التغيرات التي هزت بديهيات كانت سائدة طوال عقود في علم الاجتماع السياسي، خصوصاً اليساري منه والاسلاموي. لخص ذلك سلامة كيلة، المفكر الفلسطيني السوري في تحليل ناتج عن تجربته الشخصية في السجن الأسدي، وعلى قناة المشرق المعارضة، انه رأى شبانا مسلمين في السجن، وخارجه. لكنهم ينظرون الى الثورة بمنظار حضاري جداً. هم بعيدون عن الاسلام المذهبي، ولا يفكرون بمقولة تطبيق الشريعة، ومصادرة حقوق الآخر المختلف دينياً ومذهبياً. انهم ثوار، أبناء هذا الواقع. خروجهم من الجوامع في التظاهرات ليس بسبب النزوع الديني، بل لأن الجامع كان المكان الوحيد الذي تسمح به السلطة للتجمع، لذلك كانت هناك اعداد كبيرة من الشباب تأتي الى الجامع لهذا الغرض، وليس بحس ديني كما يعتقد الاسلاميون أصحاب الأدلجة.
المستقبل