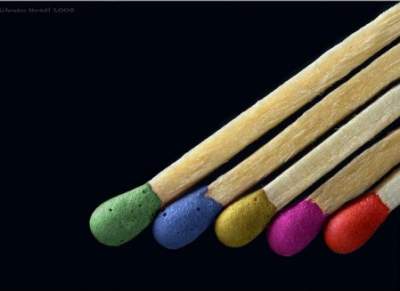إيديولوجيّات تَقتل باسم الله!/ صلاح أبو جوده

قد يتحوّل الماضي الى ملجأ وهمي لرفض مواجهة تحديات الحاضر وجِدّته بعقلانية. فالعالم يتغير باستمرار وهذه حركة لا رجعة فيها.
أشار الأستاذ جهاد الزين في مقالته بعنوان “أفكار البابا الجديد المعادية لسلطة المال…” (“قضايا النهار”، 2014/1/4)، إلى أنّنا نعيش “في زمن تسييس بل أدلجة غير مسبوقة للدين الإسلاميّ”، وإلى أنّ المدّ السياسيّ الإيديولوجيّ هذا “يعني بالضرورة تراجع القيمة الأخلاقيّة لصالح القيمة السياسيّة”.
في الواقع، فإنّ تحوّل الدين، أيًّا كان، إلى إيديولوجيا يبدأ بتفضيل المضمون العقائديّ الذي هو تفسير النصّ الدينيّ والأحداث التاريخيّة المؤسِّسة للدين تفسيرًا بشريًّا محكومًا حتمًا بعوامل المكان والزمان الثقافيّة والاجتماعيّة والسياسيّة وغيرها، على القيم الأخلاقيّة السامية التي مصدرها الخالق نفسه، وفي طليعتها الحفاظ على النفس البشريّة، أي عدم القتل، واستخدام العقل بمنطق وخدمة الخير.
بل يؤول هذا التفضيل إلى إلغاء كلّ سموّ أخلاقيّ، إذ يصبح الجهاد من أجل إحقاق “الحقّ الإلهيّ” أو الدفاع عن “العزّة الإلهيّة” أو تحقيق “القصد الإلهيّ” الذي يكتسب بُعدًا أُحاديًّا وشموليًّا مقدَّسًا، مبرِّرًا للقضاء على كلّ مَن هو وما هو مختلف. وممّا لا شكّ فيه أنّ تحوّل التفسير البشريّ للنصّ الدينيّ إلى تعليم شموليّ ثابت لا يمكن المسّ به، بحيث يعوّق عمل العقلانيّة (بالمعنى الإبيستيمولوجيّ) ويتجاوز ضوابط القيم الأخلاقيّة السامية، قد أنتج طوال التاريخ ولا يزال ينتج إلى اليوم مآسي مروّعة. أليس باسم الحفاظ على صحّة العقيدة قامت محاكم التفتيش في القرون الوسطى؟ وباسم “أرض الميعاد” هُجِّر شعب وارتُكبت مجازر؟ وباسم الله تُرتكب أقبح الجرائم في شرقنا إلى اليوم؟
عندما تُهمَّش القيم الأخلاقيّة وتُلغى العقلانيّة من الحقل العقائديّ الدينيّ، لا يعود من السهل تحاشي هيمنة العصبيّة الناتجة من قالب العقيدة الجامد على الفرد والجماعة؛ عصبيّة تختلط في تكوينها العوامل العاطفيّة والباطنيّة والثقافيّة وأحيانًا العرقيّة، وتفسح في المجال لاستغلال الفرد والجماعة سياسيًّا. فالفرد يذوب في الجماعة التي لا تشجّعه على التفكير الشخصيّ النقديّ. وفي حال تجرّأ عليه، يجد نفسه في موضع اتّهام بالخيانة؛ فالتماثل يفرض نفسه.
أمّا الجماعة المتماسكة بفضل عصبيّتها فتشهد منافسة ممثّليها الأقوى بغية مصادرة قرارها داخليًّا، وتجد نفسها تلقائيًّا في مواجهة الجماعات الأخرى الخارجيّة. وتدخل قوّة التقليد التي تترسّخ وتزداد مع تعاقب الأجيال في ظلّ غياب النقد الموضوعيّ، لتحصّن عصبيّة الجماعة بعادات وأخلاقيّات ومسالك وأشكال ثقافيّة خاصّة، بل يصبح التقليد هذا المرجع الذي يُضفي شرعيّة على البُنى الاجتماعيّة والتربويّة والسياسيّة التابعة للجماعة. وهكذا، تتوافر كلّ العناصر التي تجيز لقادة الجماعة تأنينَ العقيدة وأحداث الدين المؤسِّسة سياسيًّا، أي إسقاط المعنى العقائديّ والدينيّ لأحداث جرت في الماضي السحيق على أوضاع اليوم السياسيّة، فيسخّرون لمصالحهم أو مشاريعهم الجماعةَ التي باتت أسيرتهم، وباتوا هم ضمانة هويّتها واستمرارها. فلا عجب أن يصبح هؤلاء القادة “رموز” جماعتهم ومحطّ – ما يُسمّى في علم الاجتماع – “عبادة القائد أو الزعيم”.
يكمن بُعد الدين الإيديولوجيّ هذا في صميم الإشكاليّات التي يعيشها الشرق الأوسط والتي يختصرها إلى حدّ بعيد الواقع اللبنانيّ الطائفيّ والمذهبيّ. ولا شكّ في أنّ الخروج من هذه الحلقة المفرغة المأسويّة يقتضي قبل كلّ شيء إعادة المنزلة المفترضة للقيم الأخلاقيّة المتسامية في صلتها بالعقيدة، بحيث لا تُفهم عقيدة ولا تُأوّن بمعزل عن تلك القيم. وليس من شأن هذه العمليّة أن تخفّف من الاحتقان الطائفيّ والمذهبيّ السائد فحسب، بل تؤدّي إلى تحرير الدين من الإيديولوجيا أيضًا، إذ تفسح في المجال لبروز التعدديّة الصحيحة التي باتت أمرًا واقعًا مع حدث العولمة، ومقاومتها لن تأتي إلاّ بمآسٍ إضافيّة وتزيد من الهوّة الفاصلة بين الشرق والغرب.
وفي الواقع، إذا كانت الإيديولوجيا الدينيّة الحديثة والمعاصرة قد نشأت في الشرق الأوسط بسبب تراكم الصدمات النفسيّة المتأتّية من سياسات الدول الكبرى، وتأسيس دولة إسرائيل، وظلم الأنظمة التوتاليتاريّة، والضيق الاقتصاديّ، فإنّها أتت أيضًا ردّ فعلٍ على الحداثة -لا سيّما مع إخفاقات الإمبراطوريّة العثمانيّة في مواكبة تطوّرات الغرب- ومن ثمّ حدث العولمة. ومن الجليّ أنّ الحدث هذا، عندما نعتبره بمعزل عن سياسات الدول الكبرى الخارجيّة الماكيافيليّة، يضع الإيديولوجيا الدينيّة إزاء خيار عسير: إمّا التصلّب في التمسّك بشموليّة العقيدة وأُحاديّتها والانغلاق على الذات ورفض التعدديّة، وإمّا حلَّ نفسها. ذلك أنّ العولمة تجعل من كلّ عقيدة حقيقة نسبيّة. فالحقيقة التي طالما ادّعت الإيديولوجيا شموليّتها وحصريّتها، تظهر أُفقًا بعيدًا يشمل غيرها من عقائد. ولا سيّما أنّ للقيمة الأخلاقيّة السامية دورًا أساسيًّا في العبور إلى التعدديّة المرجوّة.
إذا كانت الأمانة لجوهر الدين نفسه تفترض التسليم بأنّه ما من تفسير مقبول للنصّ المقدَّس يمكن أن يكون متعارضًا مع أخلاقيّة سامية مصدرها الله نفسه ومستقلاًّ عنها، فإنّ هذه الأخلاقيّة نفسها تمثّل فرصة للدين ليتحرّر من سجن الماضي ومن البحث عن استعادة أمجاد الماضي بدل تجديدها. أو، بالأصحّ، ليصوّب علاقته بالماضي. صحيح أنّ حاضر الدين يفترض ذاكرة الماضي بصفتها مخزون خبرات ومصدر إلهام يسمح بخلق تماسكٍ بين الأحداث طوال التاريخ ويُضفى عليها معنى. ولكن أليست الأخلاق السامية في نهاية الأمر مصدراً أساسياً لهذا التماسك، وحافزاً يفتحه على التطوّر، إذ تشمل مبادئ العمل العقلانيّ واحترام الآخر والسعي من أجل خير الجميع؟
فخارجًا عن دور الأخلاق هذا، قد يتحوّل الماضي إلى ملجأ وهميّ لرفض مواجهة تحدّيات الحاضر وجدّته بعقلانيّة. فالعالم يتغيّر باستمرار، وهذه حركة لا رجعة فيها. لذا، لا بدّ من قيام فكرٍ نقديّ يضع موضع تساؤل خبرات الماضي وأنماطه ونتائجه، مستنيرًا بالأخلاق السامية. إنّ الإيديولوجيا تسعى لتلوي التاريخ ليتلائم وعقيدتها الشموليّة الجامدة، وهي بذلك لا تخالف مسار الحياة الطبيعيّ فحسب، بل تولّد معاناة إضافيّة للبشريّة كلّها أيضًا، وتخون جوهر رسالة دينها الذي تدّعي حرصها عليه. فتلك الرسالة التي لا تستغنى عن غنى الذاكرة المتراكمة، تحتاج، كيما تكون حيَّة، إلى تجاوز “التقليد” والعبور إلى “الابتكار”. ثمّة عنوان رسم منقوش للفنّان الإسبانيّ فرانشيسكو غويا (1746-1828) يُلخِّص مأساة الإيديولوجيا: “سُبات العقل يُنتج الوحوش”.
أستاذ في جامعة القدّيس يوسف
النهار