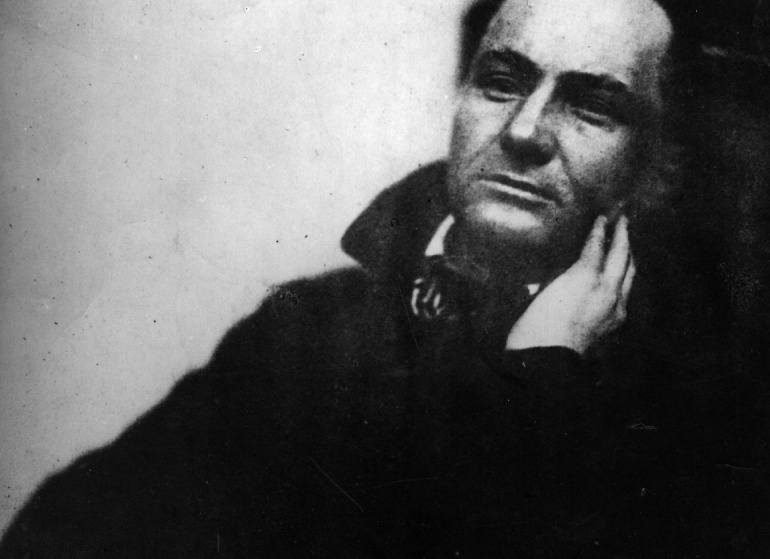احجزوا لي قنّاً، قد أفكّر بالصياح../ ديمة ونوس

منتصف أوتستراد المزة. خريف العام 2010. مقهى من تلك المقاهي التي يمتلكها أشخاص لا نعرفهم. نسمع بهم وبثرواتهم وعلاقاتهم، لكننا لا نراهم. حتى ولا نلمحهم. ليسوا جزءاً من الأمكنة التي يمتلكونها. ثمة من يدير لهم أعمالهم في تلك المقاهي ويحصي لهم الأرباح ويتجنّب الخسارات بأي ثمن. يدفع رشاوى للسماح بالتدخين داخل المقهى وإن لزم الأمر، يسمح أيضاً بتقديم الأراغيل، مع أن إسم المقهى إيطالي وهو جزء من سلسلة مقاهي معروفة في معظم العواصم الأوروبية. ثم ينصب شاشات عرض ضخمة تبث طوال اليوم فيديوكليبات لأغان عربية حديثة. ولا يكاد يمر شهران على افتتاح المقهى، حتى تبوخ ألوان الجلد الذي يغلف الكراسي والكنبات. وتتسلّل الرطوبة إلى الجدران ويتحوّل الطلاء إلى قشور تتدلّى بكآبة. منافض السجائر، أطرافها متآكلة أو مكسورة. والطاولات تغطّيها طبقة دبقة من أوساخ متراكمة وبقايا طعام. زجاج الواجهة العريضة المفضية إلى الأوتستراد والضجيج، مغبرّة. وإن كنت شخصاً صباحياً يصل إلى المقهى في الثامنة والنصف مثلاً أو التاسعة، ستشهد كل أعمال التنظيف التي يمكن تصوّرها. أعمال التنظيف لا تبدأ باكراً، ومدير المقهى لا يشعر بالحرج من تزامن وجودك هناك كل صباح مع أعمال الشطف والمسح والتنشيف. وقد يطلب منك عامل التنظيفات أن ترفع قدميك قليلاً لينشف الماء تحت طاولتك، كما تطلب منك أمك ذلك في البيت.
هناك في ذلك المقهى، التقيت بشاب يدعى “ن”. طالب جامعي من حمص، يعمل نادلاً ليؤمن تكاليف دراسته في العاصمة دمشق. جملة تقليدية قد نعثر عليها في أي رواية أو فيلم أو مسلسل تلفزيوني. إلا أن حكاية “ن” لا تكمن في كونه نادلاً ولا في كونه يدرس ويعمل في الوقت ذاته. بل تكمن في خياله المتّقد والمرهف. يتحدث “نون” وكأنه خارج للتو من رواية تجري أحداثها في بقعة جغرافية بعيدة. أسلوبه في “التلصّص” لا يشبه أسلوب الآخرين. خفت في البداية. وذلك الخوف هو أحد أمراض النشوء في بلد كسورية يحكمه الشكّ بالآخر والتعميم المطلق. إذ يقال إن كل عاملي النظافة، ينتمون إلى المخابرات. وكل عاملي المطاعم والمقاهي، يكتبون التقارير الأمنية عن زبائنهم. وكل سائقي سيارات الأجرة أو السرفيس أو باصات النقل العام، يحقّقون مع الركاب ليستكملوا تقاريرهم الأمنية. “نون” وبالرغم من ملامحه الطفولية وعينيه المتّقدتين بحلم بعيد وطموح أوسع من جدران المقهى، أثار خوفي في البداية. ورحت (مثل معظم السوريين)، أتذاكى عليه وأجيب على أسئلته بطريقة فضفاضة ومن دون الدخول إلى التفاصيل. في حين كان يدهشني بأسئلة عميقة تثير التأمل. يسألني مثلاً عماذا أكتب اليوم. أخبره بأنني أرغب بالكتابة عن الجدران. فيتعجّب ويسأل من جديد: “هل الكتابة فعل إرادي إذاً؟ ثم يضيف: ماذا عن جدران الوجوه؟” ويستغرق في تلك الأفكار والأسئلة إلى درجة تنسيني خوفي منه وشكّي الدائم بأنه موجود هنا ليراقب الناس ويستجوبهم. وأفكر الآن بعد مرور ثلاث سنوات على عمر الثورة، كم أن الفكرة تلك قاسية وموجعة. كيف كان باستطاعتنا أن نلغي وجود آخرين، وأن نلغي إنسانيتهم، استجابة لشكوكنا الدائمة بأن كل مواطن سوري هو مشروع تقرير أمني، أو ملاحقة.
لا أذكر بعدها ماذا حدث. ربما عاد “نون” إلى ضيعته. وربما انقطعت أنا عن الذهاب إلى ذلك المقهى. لم ألتقِ “نون” منذ ذلك الحين. لكنه بات صديقاً “افتراضياً” على صفحة “فيس بوك”. وبدأت سلسلة من الرسائل المتقطعة يسألني فيها “نون” عن أحوالي وعن الكتابة والحياة والجدران. وفي كل مرة، أطلب منه أن يبدأ في كتابة رواية ما أو قصة لما يمتلكه من خيال يتعدّى هندسة المعلوماتية التي انتهى من دراستها قبل عام.
يقول “نون” إنه لن يكتب وإن القارئ مسكين إذ يعتقد أن الكاتب يفصّل الحروف له ويشتري الأزرار الملوّنة، لأن الكاتب في الحقيقة ليس سوى كائن أناني يكتب لنفسه وعن نفسه فقط. هذا ما يقوله “نون” الذي عاد إلى ضيعته بعد بداية الثورة. وكتب لي من هناك: “وصلت إلى حمص في تمام التاسعة. الزحام هو الزحام، كالعادة. الناس المستعجلة أبداً. باصات النقل الداخلي التي تأكل الركاب وترحل بهم عند المشفى الوطني. تأمّلت مكان القذيفة (ذلك الحين، كانت القذيفة الأولى التي ضربت حمص)، بعض باعة العربات مبعثرين في الجهة الأخرى. المحلات لا تفتح في مثل هذا الوقت إلا بعض الصيدليات ومحلات الرياضة، كي يحافظ الناس على صحتهم، (يكتبها “نون” بسخرية). في الباص المتّجه نحو السكن الجامعي كان الطلاب يتدافعون ليمتلئ المكان على آخره وقوفاً وجلوساً. لم أعثر على ابتسامة ألفتها موجودة على الوجوه. اتجهنا نحو بابا عمرو. بعض طلقات الرصاص قاطعت أغنية فيروز. شوارعها بدت خالية. أفراد عند الحاجز هناك يتفيّأون بظلال شجرة ويشربون المتة كطقس صباحي معتاد. وصلنا إلى السكن الجامعي وبدأت معاناة الروتين وطوابير الطلاب ونزق الموظفين. نسيت للحظات أنني في حمص وصرت أبحث لنفسي عن مكان بين الزحام. بعد انتظار أربع ساعات، حصلت على الغرفة العظيمة. وبعد جولة التنظيف المعتادة جلست لأرتاح. حادثت صديقي فأخبرني بأن حمص خربانة. استغربت الأمر فهي هادئة كما تبدو. ربع ساعة مرّت وبدأت تعلو أصوات الرصاص من كل صوب وانهالت مطراً على السكن الجامعي. نصف ساعة ولا صوت يعلو فوق صوت الرصاص. إنها حمص. لا عجب”.
وبعد أيام، سألني “نون” إن كنت أذكر الشاب الآخر في المقهى. الشاب الأسمر الذي كان يعدّ القهوة. نعم، تذكرته. لقد قتل على إحد الحواجز. وبعد أسابيع كتب لي “نون” عن كيفية استقباله لجثمان أخيه. وبعد أشهر اكتفى بجملة واحدة: “احجزوا لي قنّاً، قد أفكّر بالصياح.. هل تغيّرت سماكة الجدار فصار الحلم أبعد؟ هل النافذة مجرّد خدعة بصرية؟”.
ثم: “في القرية الباردة، كلهم بخير يمارسون الحياة كما يجب. بعضهم ينسى الأيام. جدتي تكبر. الحياة تمضي أليس كذلك؟ أبحث عن عمل. أمضي جلّ وقتي في التسكّع خلف الفراغ”.
“نون” شاب من حمص. شاب سوري يعيش أيامه هناك، حيث هاجر الكثيرون وتركوا البلد لمن اختار البقاء قسراً أو طوعاً.
“أنا بخير. هل أحمُد الآلهة على ذلك؟ الشام كما هي. كما غبت عنها منذ عامين. الوجوه القاسية هي ذاتها. رائحة عفن في كل مكان. ما زال سائقو السيارات يصافحون شرطة المرور. الطلاب يتّجهون إلى مدارسهم وجامعاتهم في ما أظنها محاولة للتهذيب “التربوي”. الأراكيل المضاءة بالفحم تشي بلوثة في العقول. الأسواق الفوضوية ما زالت تنفث الضجيج مع زفير غبار. دمشق ليست جميلة ولا تشبه صبايا حارتنا وأعجب من نفسي كيف تسحرني؟”.
المدن