استدراج لوقيانوس السميساطي إلى مسرح حلب/ عزيز تبسي
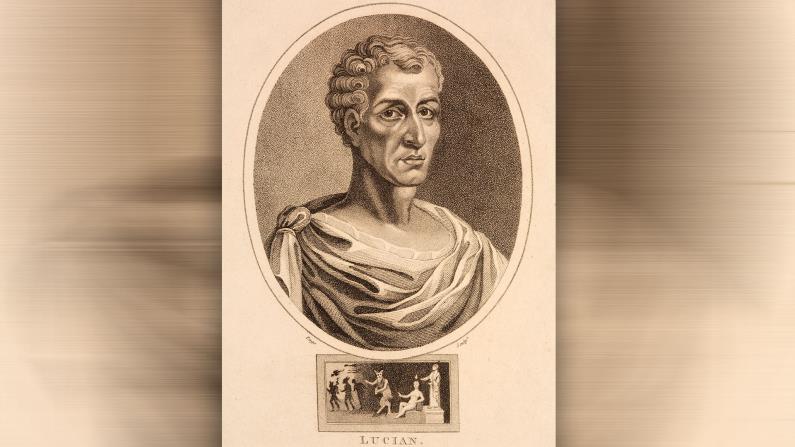
-1-
ولد، في بلدة سميساط، أو شميشط، وفق لغة أهلها السريانية، ليست بعيدة عن حلب، تقع على الضفة الشمالية لنهر الفرات، في الأناضول العائد للجمهورية التركية. تلاشت منذ ما يقارب ربع قرن من فوق الأرض، بعدما غمرتها مياه البحيرة العملاقة لسد أتاتورك.
يدفع مصيره ومدينته وأهلها، إلى الإيمان بالحراسة، حراسة اللغة والثقافة، التاريخ والأرض. تُفقد في الطريق إليه أشياء كثيرة، اللغة السريانية لغة شعب هذه الأرض، وقد وزعها الزمن بين الطقوسية الدينية والمتحفية، الأرض السورية التي تقطعت وتوزعت، مدينته ذاتها وقد أمست تحت مياه البحيرة. تقطع شوارعها الأسماك، وتذيب حجارتها موجات المياه، وتطمرها الرمال كل عام، التي تجرفها السيول مع ذوبان الثلوج.
لم تتمكن الشعوب المضطهدة، من الوصول إلى مناهج، تقيها اجتياح أرضها، وإقصاء لغتها وثقافتها، وإهانة أهلها. لتبقى أسيرة أقدار تاريخية لا فكاك من مصائرها.
أن تولد وتعيش في مدينة على ضفة الفرات العظيم، يعني أنك محكوم بقدريْن مائيين اثنين: التجدد الدائم والترحل، وخطر الموت المؤكد، يأتيه فيضان يغرق المدينة وأهلها.
عمل في طفولته معاوناً لقريبه النحّات، وحين ضربه لكسره لوحاً رخامياً، عاد إلى البيت، وفكر بطريق آخر يفصح من خلاله عن ذاته وابداعاته. غادر إلى أثينا، حيث تعلم اللغة الإغريقية وأتقن الكتابة والخطابة بها، وترحل في أراضي وبلدان الإمبراطورية الرومانية “أيونيا وإنطاكية وأثينا وروما والإسكندرية”، يعلّم ويتعلّم، يراقب ويكتب، يحاور ويسخر، حتى يوم وافته المنية في بلاد النيل. عاش في القرن الثاني الميلادي، ولد عام 125 ميلادية، في العصر الذي أعقب محاورات أفلاطون وتراجيديات سوفوكليس وإسخيلوس ويوريبيدس، التي شكلت مع غيرها، من الإنجازات الفكرية الجليلة، ذخيرة ثقافية، لأي مبدع جديد.
يحيل لوقيانوس السميساطي، إلى الهوية المركبة لسورية وبلاد الشام، الهوية التي تشكّلت على مهل، عبر زمن طويل، بتعاقب أنظمة الحكم، أي”السلالات العسكرية” المتمايزة بهوياتها العرقية واللغوية، تفاعلت بنار الزمن داخل أنابيق مختبرات الكيمياء بين حشد من الثقافات العالمة (الثقافات المحلية والثقافات الوافدة من روما وأثينا وفارس وبابل ووادي النيل، وحشد آخر رديف من الثقافات العامية، المنتجة في أرباض التجمعات البشرية الموزعة حول الواحات والسهول المخصوصبة بمياه الأنهار).
واطئة حيطان هذا الشعب، لم يبق غازٍ طموح إلا واجتازها، راصداً بحذاقة عجز شعبها، عن
إنتاج دولة مركزية قوية، وانهماكه بصناعة المحاريث والزوارق وغرافات المياه، وعصر الزيتون والعنب، وكتابة الشعر وتقليد تغريد الطيور، وعدم اكتراثه بصناعة الأسلحة وتنظيم الجيوش وتأهيل المحاربين.
حاور الآلهة، في زمن لم تكن قد ارتفعت بعد، الأسوار بينهم وبين البشر، مضوا إليهم مع الفجر ليحاوروهم وينتقدوهم، كاشفين الازدواجية بين أقوالهم وسلوكهم. ارتفعت الأسوار في ما بعد، وتحولت إلى مشكلات مستعصية، مع الكهنة وأنصاف الآلهة وأرباعهم وأخماسهم.
لم يعد يستدل على ذاك النبع الرقراق الذي زودهم بالطعم البكر للغة والموسيقى، الحكمة المثقلة بالتجربة، والتأمل الحي بالوقائع. خسروا ماضي البراءة في مهد يهدد ولا ينهد فوق رؤوسهم.
قد يصلون إلى الأم الأولى من رائحة حليبها، لكن هناك استحالة الوصول إلى الآباء العجولين (الفرس والرومان والإغريق والعرب المسالمين والعرب المسلحين والبويهيين والسلاجقة والأكراد والمماليك الشركس والسلاجقة والعثمانيين) من الذين حملوا خصائص الماء، لا لون ولا طعم ولا رائحة.
-2-
مضى الناس إلى العرض المسرحي، بعدما قرأوا في إعلاناته “سهرة كوميدية”، وقد فقدوا القدرة على الضحك منذ زمان، وبات من الاستحالة ضبطهم متلبسين به. أرادوا أن تصعد بهم مناطيد قهقهاتهم إلى السماء، علها تشفيهم بمصول الضحك من تسمم الواقع.
اكتشفوا أنهم أوقعوا في خديعة ترويجية، فالعرض المسرحي لا علاقة له بالكوميديا، التي يبحثون عنها. ثمان لوحات مسرحية مقتطفة من نصوص مشحونة بقوة البلاغة والسخرية السوداء من الواقع. تدعوا بوضوح يلامس أحياناً حدود التقريرية، لمحاسبة اللصوص والمتجبرين ومدّعي الإيمان، وتفصح عن رغبة عالية النبرة لتحقيق العدالة وتثبيت أركانها، ومواجهة النقائض ببعضها الحرب – السلام، الخير- الشر، التعالي – التواضع.
يبقى للمسرح دور المتمم المعرفي أو التجهيلي، قد يساعد في استجلاء الحقيقة أو زيادة حجبها.
لكن لم يعد أحد يطالب المسرح بوصفه فسحة ثقافية – حوارية – جمالية – ترفيهية، القيام بأدوار ثورية ليست له، في وقت تتراجع الأحزاب المدرجة تحت باب الثورية عن مهامها.
يختم العرض بطلب “مينيبوس” أسير الجحيم، رؤية جسد هيلين، التي عُزي لجمالها وحده، سبب الحرب الدامية التي امتدت لعشر سنوات بين اليونانيين، يأتيه حارس الجحيم بجمجمة متآكلة، ويقدمها له، فيبدي عجبه، أهذا ما آل إليه وجه هيلين الجميل؟ مستغرباً مآلات الجمال بعد الموت. إن كان هذا مصير هيلين، ترى كيف سيكون مصير أثينا والمدن العامرة الأخرى؟ لماذا لم يتنبه الإغريق، في حربهم المديدة، لكل هذه الكوارث؟
وبرغبة للتماثل بين الجمالين، تتعاقب على الخلفية لوحات عدة، تعرض صور دمار أحياء ومساجد وخانات وأسواق مدينة حلب.
-3-
لم يبارح إيليا قجميني، مخرج العرض المسرحي مدينة حلب، طيلة الزمن العاصف وأقداره، وهو خريج الأكاديمية الإيطالية للمسرح، في سبعينيات القرن الماضي، وله دور بارز في الحركة المسرحية في المدينة، ومساهمات متعددة في أفلام سينمائية، وحقل الترجمات لنصوص سينمائية ومسرحية عن اللغة الإيطالية. عمل في “سهرة كوميدية مع لوقيانوس” مع مجموعة من الشبّان الهواة، أغلبهم يصعد لأول مرة إلى خشبة المسرح، مما ضاعف شغله على إعداد الممثلين، وتدريبهم المتأني على فن الإلقاء والحركة، في مدينة تعيش منذ أشهر بلا كهرباء.
اختار استحضار لوقيانوس السميساطي، الذي نهل منه الأدب الأوروبي (شكسبير، فولتير، رابليه، سيرانو دي بيرجيراك، جوناثان سويفت. كما يشار إلى نهل صاحب رسالة الغفران وأصحاب ألف ليلة وليلة) الكثير من الأفكار والأساليب التعبيرية، ليعرف أهله الذين لا يعرفونه، ويجهلون قيمة ومكانة إبداعه.
لم يعد مهماً اليوم إن خاطبناه لوقيانوس أو لوسيان أو لوقا، لأنه في زمنه “يأمر الملوك بإعدام كل قنديل، لا يستجيب ملبياً نداء اسمه، وإعدامه لا يعني سوى إطفائه”. كما لم يعد مهماً مديح المسرح والمسرحية أو الكشف عن هناتها وعثراتها، المهم عودة الحياة أو بعضها إلى المسرح.
ضفة ثالثة


