استنساخ/ عباس بيضون
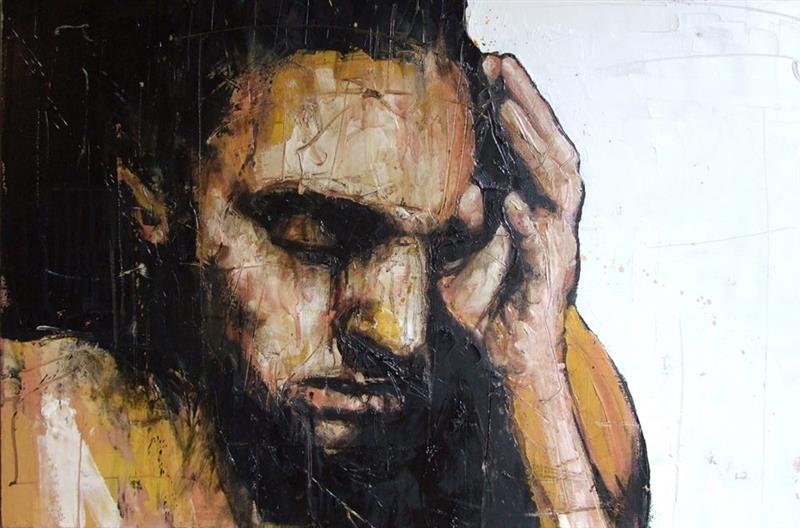
لم يطل الوقت حتى كان بن علي ومبارك والقذافي أزيحوا عن سلطاتهم، بدا هذا كأن النظام العسكري العربي موشك على الأفول. أفسح التفتت الاجتماعي بل التذرر الاجتماعي لنشوء فاشيات قومية مثلتها الطغم العسكرية التي توجت بهالات القادة الذين صاروا بغير جدارة سوى نرجسيتهم، معلمي الشعوب.
لن يطول الأمر حتى تظهر الصفحة المقابلة. يصمد بشار الأسد بعد أن يتقلقل في موضعه، لكن الاختبار الأفدح يحدث في مصر، بعد أن تراءى أن الذي سقط هو النظام الذي بدأ مع انقلاب 1952 واستمر أكثر من نصف قرن وتوالى عليه ثلاثة رؤساء. كان هذا النظام هو تقريباً النموذج والمثال لما صار بعد ذلك نسبياً النظام العربي، بدا هذا النظام في مصر من القوه والثبات بحيث أشعر تزعزعه المفاجئ وانحداره وسقوطه بعد ذلك بأنه اقتلع من جذوره وأن هذا سيكون بداية انزياحه في كل مكان. كانت الدلائل على ذلك كثيرة ووافية، لقد انتهى «البيات» الشعبي وتحررت كتل كبيرة من الخوف وهبت على أول نداء ورابطت في الشارع وتسيست بسرعة قياسية، ووسعها أن تفهم على نحو سياسي تفاصيل إدارية وحكومية، وبدا انها قادرة على إبطال خدع السلطة وأحابيلها، لقد ارتفع الوعي الشعبي إلى مصاف يعز نظيره. بحيث أمكن اكتشاف تواطؤ العسكر أولاً. كما أمكن في مرحلة ثانية تفكيك السلطة الأخوانية، كانت الرقابة الجماهيرية صاحية ودينامية بحيث أمكن أن تنتقل بطواعية من ضفة إلى ضفة وبحيث لم تنخدع بشعارات الدولة الإسلامية بل استطاعت بسرعة كبيرة أن تكتشف عدم ملاءمة شعارات كهذه في مجتمع متعدد وفي عصر راهن. لقد كانت هنا المعجزة، جمهور يميز ويغير انحيازاته ويراقب بعين لا تنام، لدينا شواهد كثيرة على ذلك بحيث بات في وسعنا أن ندعي أن النظام القديم تآكل من الداخل، وانه افتضح نهائياً، وان أساليبه، وعوده، إغراءاته وانذارته، جميعها لم تعد ذات بال. كان في إمكاننا لذلك أن نجزم بأن عصراً قديماً انتهى، وأن عصراً جديداً على وشك البزوغ، وأن الساعة هي لوعي آخر.
خرج الثلاثون مليوناً، إذا كان هذا الرقم للتهويل فهو لا يخلو من حقيقة، الملايين التي تحدثت عنها الأغاني والأزجال والمواويل والأشعار خرجت بقضها وقضيضها، كان يمكن التأريخ للثورة انطلاقاً من هذا اليوم، ستخرج هذه الجماهير مرة ثانية لتفوّض الجيش، لقد وصل المد إلى أعلاه وبدأ الجزر والانحسار. صار الشارع هذه المرة ملعباً للمتمردين، للإخوان المطرودين وانقلب الصراع في برهة قصيرة من مجابهة بين السلطة والشعب، إلى مجابهة بين الأقلية الرافضة لطردها والشعب الممثل هذه المرة في سلطته، لقد عاد فجأة إلى الحياة الفولكلور السياسي القديم، عاد الشعب هو الشعب الذي في الأغاني وفي الاحتفالات الرسمية، الشعب هو الآن وراء جيشه ووراء قائده، ومن في الشارع هم العصاة والمرتدون والمطرودون، الصراع هكذا بسيط إلى حد الابتذال، من جهة هناك الجيش والشعب والحكم ومن جهة أخرى هناك الخارجون، أنفار منقلبون على الشعب والسلطة والجيش.
كانت هذه نتيجة سنين انقضت في غليان، في حراك استنفذ بالتأكيد زخمه، في ثوران سرعان ما بدا انه يتغذى من نفسه ولا ينتقل إلى مكان. وحين وصل إلى أوجه في حملة العشرين مليوناً، بدا كأنه صار عبئاً ووجب أن نضع في هذه اللحظة ختاماً له. لقد استدرج «تمرد» ومن ورائه الجيش الشعب إلى خروج بالملايين لكنها كانت مناسبة لتقرير أن الشارع فعل ما عليه. وآن الأوان لكي «يفوض» سلطة أو قائداً أو الاثنين معاً، صارت المعركة الآن مع الإخوان الخارجين وأي معركة سواها، أي مسار آخر، أي غرض ثان، ستكون تشويشاً وانحرافاً بالصراع عن ساحته الأولى والأساس، زج في السجن على هذا الطريق متظاهرون ضد قانون التظاهر، ولم يشعر كثيرون بذلك. استفرد تنظيم من المشاركين في الثورة، ولم يشعر كثيرون بذلك. لم يشعر كثيرون بأن السلطة العائدة تكرر وبنسب أكبر بكثير خطوات النظام المتعافي: العنف بمعدلات أكبر، مئات وربما آلاف القتلى، ضرب اليمين واليسار (إن جازت التسمية)، الأمر الذي يبقى الحق دائماً في جانب السلطة أو يبقيها ميزان الحق، استعيدت أيضاً، ولو بطريقة همايونية، إيديولوجية المؤامرة الخارجية وتوجه الاتهام إلى الولايات المتحدة، وعلى طريق عبد الناصر قام السيسي بزيارة مشهودة إلى روسيا. لم ينتبه كثيرون إلى ان السلطة الجديدة تستعير أواليات مختبرة وتستعير في ذات الوقت إيديولوجيا من بدايات النظام ومرة ثانية تشكل الدعاوة الوطنية الممزوجة بالبارانويا ممراً تدريجياً لفاشية وطنية عمادها الرئيس القائد والجيش والتهديد الأجنبي.
لا نبرئ الإخوان، لو استمروا لكانوا نشأوا نظاماً قائماً على العنف الأوتوقراطي. ناهيك عن تخلفه وشعائريته، لكن خروج الملايين إلى الشارع تنديداً بهم ووقوف الجيش والمؤسسات في وجههم، ما كان ليتيح لهم أن يؤسسوا لخلافة ورائية أو ان يحتفظوا بالسلطة. هل كان ممكناً إزاحة الإخوان بطريقة أخرى. أي طريقة تعيدهم إلى الحياة السياسية بدون ان يتحولوا إلى الإرهاب. هذا سؤال لسنا لنجيب عليه. تعوزنا في الأرجح دلائل ومعلومات كافية، كان الإخوان قد انخرطوا في اللعبة السياسية عهد السادات ومبارك، لكن هذا ليس ضمانة، إذ لا يستبعد ان ينزعوا إلى الاستيلاء والعنف ما ان تحين الفرصة. هذا سؤال لسنا لنجيب عليه، لكن على هذه الإجابة، إذا توفرت، يتوقف بالتأكيد جزء هام من التحليل.
نزلت الملايين إلى الشارع، ونزلت مرة أخرى لتفوّض السيسي، وعلى الأرجح ستنتخبه رئيساً بأكثرية ساحقة، انها ذات الجماهير التي نزلت ضد تحصين مرسي لنفسه وللإخوان في الاعلان الرئاسي، الجماهير التي نزلت تدافع عن استقلال القضاء، الجماهير التي صرخت في وجه طنطاوي «فليسقط حكم العسكر». الآن تسكت على أحكام إعدام بالمئات، والآن تعيد مشيراً إلى الرئاسة، والآن تساند السلطة في بطشها بالإخوان وتأديبها لليسار والليبراليين. ليس في هذا ذرة من الرقابة الجماهيرية. انه تسليم كلي.
قد يكون متسرعاً وغير مفيد أن نبدأ الكلام عن الغوغاء. فهذه «الغوغاء» أمكن لها ان تؤسس في الشارع نوعاً من سلطة مضادة، سيكون أفضل أن نفكر بطريقة أخرى. يتاجر العسكر بالاستقرار والسلم الاجتماعي. هذا بالتأكيد مؤشر لكنه ليس كافياً. كانت الرقابة الشعبية بالتأكيد رقابة نخب انجرت الجماهير وراءها. بعض هذه النخب تواطأ مع الجيش، أعاد هذا إدخال الجيش في الحياة العامة ولم يكن له منافس تقريباً.
إذا كانت الثورة تفكيكا للمؤسسات والكتل فإنها تفعل هذا أيضاً على مستوى القاعدة. الغليان الجماهيري لا ينفي عملية التفكيك هذه والحاجة مجدداً إلى جهة استقطاب وإلى وهم اجماع ومعركة جامعة، إلى قائد بالدرجة الأولى، لقد ظهر السيسي في اللحظة المناسبة. سلمته النخب، في حفل عزل مرسي وعرض خارطة الطريق، الزمام. لقد ارتضت بما قرره ومنذ هذه اللحظة صار الحكم باسمه وما جرى بعد ذلك هو الاحتفال القديم الاعلامي الغنائي بالقائد. لكن ما يبدو إلى الآن ان ليس من خيال جديد، ان استنساخ التجربة الناصرية يستمر بدون تعديل يذكر بل وبإفراط ومبالغة. إذا كان الشارع سلم فلا يزال يقظا. لن تنطفئ الجذوة السياسية بهذه السرعة. لن يستطيع تقمص التجربة الناصرية ان يكفي إلا لأمد الاحتفال. بعد ذلك ستكون هناك أمور أخرى وأسئلة جديدة. ولن يكفي الردع، ولا أحكام الإعدام، جواباً.
السفير

