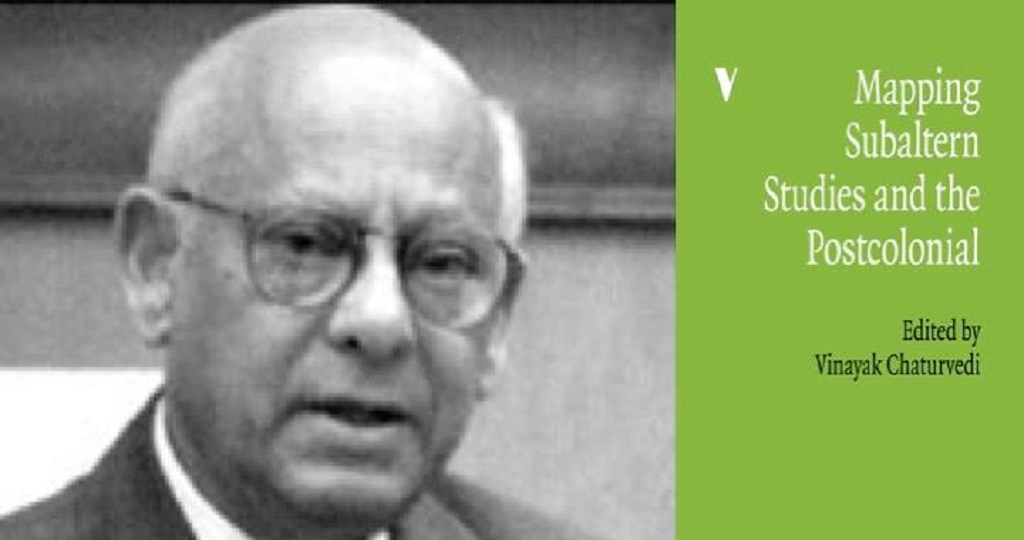الأحزاب الإسلامية أمام الشعار المستحيل
علي حرب
من فوز «حزب النهضة» الاسلامي في تونس بانتخابات المجلس التأسيسي، الى تصريح الدكتور مصطفى عبد الجليل رئيس المجلس الوطني في ليبيا بأن الشريعة الاسلامية هي «المصدر الرئيسي للتشريع»، وصولاً الى الأقوال الملتبسة والمتعارضة التي تصدر عن «الإخوان المسلمين» في مصر. نحن إزاء مواقف وأحداث تثير المخاوف والاسئلة والسجالات، سواء داخل العالم العربي بين الاحزاب والكتل المتصارعة على السلطة، أو في الدول الغربية التي تدعم الثورات العربية. هنا مقاربة في المسألة.
التواضع والاعتراف
هل ينجح الاسلاميون الذين يصلون الى الحكم في تطبيق شعارهم ومبدأ عملهم الاسلام هو الحل؟ أنا لا أعتقد أن الحلّ هو بالاسلام. فمن الصعب، وربما من المستحيل، إدارة بلد وتنمية مجتمع في هذا العصر بعدة العقيدة الدينية والشريعة الاسلامية. لكل زمن أفكاره ومعارفه وقوانينه، كما له مصادره ومؤسساته ووسائله. ولذا فمن ينجح، اليوم، هو الذي يندرج في سياقه العالمي، ويفيد من المنجزات التي حققتها المجتمعات الغربية الحديثة، والتي شكلت موجة حضارية جديدة.
فليتواضع الاسلاميون لكي يعترفوا بالحقائق: نحن نقيم على مأدبة الغرب، معرفةً وتقنية وحضارة، منذ عصر محمد علي باشا، بل منذ دخول المطبعة الى جبل لبنان. فالغرب هو أستاذنا ومرشدنا ونموذجنا في غير حقل ومجال. ولا يليق بنا إنكار ذلك، اذا لم نشأ ممارسة الزيف الوجودي.
هل الغرب مارس الغزو والعنصرية والهيمنة والتوحش في سعيه للسيطرة على بلداننا أو في تعامله معنا؟ هذه حقبة استعمارية آفلة كان لها سلبياتها وإيجابياتها. ثم ان ما نمارسه نحن، ضد بعضنا البعض، لا يقل عنصرية ووحشية. وها هي الشعوب العربية تجد نفسها، بعد عقود من تحرّرها من نير الاستعمار، تستنجد بالدول الغربية لكي تساعدها على التحرّر من طُغاتها الذين هم من أبناء جلدتها، أشقاء في الوطن أو الدين.
واذا كان الغرب يتراجع الآن، فيما تصعد على المسرح العالمي، قوى اخرى ناشئة تمارس حيويتها الخلاقة بالمشاركة في صناعة الحضارة الراهنة (اليابان، الصين، البرازيل، الهند، تركيا)، فلا سبيل للعودة الى الوراء. والدرس المستخلص هو أن يمارس كل مجتمع خصوصيته الثقافية والقومية، على سبيل الاستحقاق والفاعلية والازدهار، عبر الاختراع والابداع في هذا المجال أو ذاك.
نظام للوصل والفصل
والتجربة التركية شاهد. فحزب «العدالة والتنمية» الآتي من خلفية إسلامية، قد نجح في امتحان التنمية والديموقراطية والتحديث، لأن قادته لم يفكروا بعقلية المنظّر العقائدي أو بموجب النظام الفقهي، أي لم يعملوا بشعار الإسلام هو البديل والحل، بل فكروا بعقل حديث، واستخدموا الأحدث من الوسائل، وتصرفوا كساسة همهم الأول اجتراح الامكانات لحل المشكلات وتحسين شروط العيش، في بلدهم، وذلك بالعمل على تفعيل الاقتصاد وتنمية الثروات، مستفيدين مما حققه الآخرون في هذا المجال من غير عقد أو حساسيات.
هذا فضلاً عن حفاظهم على مكاسب الدولة العلمانية بنظامها الجمهوري وحكمها الديموقراطي. ولا تعني العلمانية هنا نقيض الدين ووجهه الآخر الذي يتواطأ معه، وكما مارسها العلمانيون العرب بعقلهم الأصولي وفكرهم الاحادي، مما حوّلها الى لاهوت مضاد. ما تعنيه هو شكل من الحكم يقوم على تعدّد الانماط والنماذج والمذاهب، بقدر ما هي صيغة مرنة، مركبة، تستوعب الاختلافات وتدير التعارضات، على نحو يضع حداً للحروب بين الجماعات والطوائف الدينية، عبر التمرس بالعمل الديموقراطي والتدرب على الإدارة التداولية، والانخراط في بناء مجتمع مدني.
نحن إزاء نظام من الوصل والفصل بين الخصوصي والعمومي، أو بين الأهلي والرسمي، أو بين المدني والحكومي، يقتنع معه الواحد بأنه لا سبيل لتأمين مصلحته وتنميتها، إلا بالحرص على المصلحة العامة وتوسيع مساحاتها ودوائرها. ومن يفكر على هذا النحو يتعامل مع سواه بوصفه شطره الآخر الذي لا ينفك عنه، كشريك في الوطن، أو كفاعل في المجتمع، أو كناشط في الحياة العامة، بل كنظير في الانسانية…
على هذا النحو تمارس الدولة المدنية العلمانية دورها البناء والفعال، أي بوصفها تشكل وسيطاً بين الواحد والآخر، بقدر ما تشكل الأمر الجامع والنصاب الشرعي والحارس للمصلحة العمومية أو الراعي للفضاء العمومي.
وإذا كان المسلم العقائدي يرفض العلمانية، كما أن العلماني المغلق لا يحسن استثمار الحقل الديني، «فإن المسلم التقي»، والعاقل ايضاً، وكما قال رجب طيب أردوغان، رئيس وزراء تركيا، إنما يقبل العلمانيّة، كصيغة للحكم ملائمة وفعالة، هي ثمرة العقل والتجربة، كما شهدت النماذج الناجحة في المجتمعات الغربية الحديثة التي عانت من فظائع وكوارث الحروب الدينية.
بهذا المعنى الواسع والمركب والوسطي، لا تعادي الدولة العلمانية الدين. بالعكس هي تصون حقوق الطوائف بقدر ما تتجاوزها بمؤسساتها وقوانينها، وتردعها بعضها عن بعض بقدر ما تحررها من المخاوف التي تجعلها فريسة نزاعاتها وعلاقة القوة بينها، وتتيح لها ممارسة حرياتها، بقدر ما تتيح للمتدين أن يكسر قوقعته الطائفية، لكي يمارس هوية خارقة عابرة، متعددة الوجوه والصور والأبعاد، بحيث تتقدم عنده، على هواجس الهوية الصافية والأصول الثابتة واليقينيات المغلقة، مبادئ المواطنة وقواعد الشراكة وروابط المهنة والزمالة أو النقابة والندوة أو الحي والجيرة… أي كل ما يصنع الوجود اليومي المعيش بشبكة علاقاته المتبادلة والمتحولة.
السلطة ضد القِيَم
لا يعني ذلك نهاية الدين، بل يعني أنّ ما يبقى من الانتماء الديني في التجربة الحديثة الناجحة، هو النسق الثقافي من الاسماء والرموز والتقاليد والطقوس والفرائض، كالصلاة والحج والأعياد والفولار الجميل والشهر الفضيل بأجوائه البديعة وموائده العامرة. ولا أنسى بالطبع منظومة القيم الاسلامية التي تتجسد في التواضع والتقى والتعارف والتواصل والتآزر، من حيث إدارة شؤون الحقيقة والسلطة والثروة، وهي قيم لا يحسن سوى نسيانها أو انتهاكها الاسلاميون الساعون الى الحكم أو الذين وصلوا الى جنّته لتحويل الحياة إلى جحيم.
وهكذا تبقى الاديان فاعلة كرأسمال رمزي أو رصيد خلقي، أي بوصفها مرجعية للمعنى، بين مرجعيات عديدة، تخضع للمناقشة والنقد بالحُجّة، بعيداً عن لغة التقديس والتجديف. أما أن يعامل الدين كسلطة مطلقة أو كحقيقة نهائية، فمآل ذلك الانتهاك؛ أما إن عومل كهوية وطنية أو خطة سياسية أو برنامج للحكم أو نموذج للتنمية، فذلك مآله الإخفاق. هذا ما حصل حيث حكم الاسلاميون أو سيطروا. ان التحدي على هذا الصعيد هو أن يلتزموا بعض الالتزام، بالقيم الدينية التي تحض على إقامة العدل واحترام الحقوق والحرص على الأموال العامة، ومحاربة آفات الفقر المدقع أو الثراء الفاحش. وهذا الجانب لا يستأثر باهتمامهم، لأن الهم الأكبر هو الوصول الى السلطة والحفاظ عليها بأي ثمن كان. وهكذا نحن نستنكر ما يمس الأمور المتعلقة بالحجاب والزواج أو ببناء المآذن والرسوم الكاريكاتورية في أوروبا، ولكننا نسكت على النهب والاستبداد، ولا نستنكر ما هو أفظع: الجوع الكافر.
والشاهد الفاضح هو الصومال، هذا البلد المسلم الذي تُرك فريسة لمنظمة تكفيرية سمّت نفسها «المحاكم الاسلامية» لتطبيق الحاكمية الالهية بصورة بربرية؛ كما ترك فريسة للفقر والجوع، مع انه كان بإمكان الاثرياء من الاسلاميين توظيف أموالهم فيه لإنقاذه، أو على الأقل للحدّ من أزماته. وما لم يفعلوه يقوم به الآن بيل غيتس، عبر مؤسسته الخيرية الإنمائية: التوظيف والاستثمار في مجال الزراعة في غير بلد افريقي.
المشكلة والتحدي
المغزى من الشواهد والتجارب أن كل مجتمع يخترع معادلته ويصنع نموذجه في مشاريع النهوض والاصلاح والتحديث، باستلهام مختلف التجارب والنماذج والتراثات الحية، للافادة منها والبناء بها، بما في ذلك بالطبع، التراث الاسلامي. فلا مهرب من تغيير العقليات والتشريعات، بالتوازي مع تحديث الأدوات والمؤسسات، إذ لا يستقيم حكم اليوم بأفكار الماضين وأحكامهم ووسائلهم.
وهذا هو التحدي أمام «حزب النهضة» التونسي الذي فاز بأكثرية المقاعد في المجلس التأسيسي، باقتراع ديموقراطي شهد له من في الداخل والخارج، الأمر الذي أهّله لتشكيل الحكومة التي ستهتم بإرساء أسس الاصلاح والبناء من جديد.
ولكن إعادة البناء تحتاج الى فكر مفتوح يتحرر أصحابه من عقدتهم الاسلامية التي تحملهم على التشبّث بشعار: الاسلام هو الحل، أو على تكرار مواقف الشيخ محمد عبده برد ثمرات النجاح والتفوق في الغرب الى الاسلام نفسه، لكي يقعوا في فخ النرجسية الدينية. بذلك يخدعون أنفسهم وجمهورهم ومجتمعهم، ويتمسكون بشعار لم يعد صالحاً كإطار للنظر، أو كنموذج للعمل، كما هو شأن كل المشاريع الدينية السياسية التي باتت عملة فائتة، غير قادرة على تقديم أجوبة أو حلول في ما يخص المشكلات والازمات المعاصرة والراهنة. إذ لكل زمن مشكلاته وأزماته التي تحتاج الى ابتكار المقاربات والمعالجات، لتجديد المفاهيم والصيغ والقواعد والأساليب.. من غير ذلك نحسب المشكلة حلاً. وبالعكس، بل نحول علاقتنا بالدين إلى مشكلة لأهله وللناس جميعاً، تعصباً وتطرفاً وإرهاباً.
الإسلام وإمكاناته
إن الاسلاميين العرب، من أصحاب البرامج السياسية، في مصر أو تونس أو ليبيا، هم الآن على المحك: ان يخلقوا نماذج معاصرة تشكل إضافة قيمة على رصيد الحضارة. فالديموقراطية التي نتبنّاها اليوم هي حقاً، وكما جاء في «وثيقة الازهر» بمثابة «بديل معاصر» لمؤسسة الشورى الاسلامية. مما يعني أن الشورى ليست هي البديل الإسلامي الحديث للديموقراطية، كما يخال البعض. وهذا الاعتراف من جانب الوثيقة يدلّ على تحرّر أصحابها من العقلية التي تسوقهم الى السطو على منجزات الغرب لنسبتها الى الاسلام، كما يفعل دعاة ومفسرون يسرقون بلا خجل النظريات العلمية لنسبتها الى القرآن.
لنعترف بما أنجزه الغير، كي نحسن استثماره. فالديموقراطية هي اختراع يوناني طوره الغرب الحديث. ونحن ننقله عنه. ولا أعتقد ان مجتمعاتنا تنجح في امتحان التحول الديموقراطي، اذا لم تتوصل الى إغناء مفهوم الديموقراطية وتطوير آليات ممارستها، بحيث نخترع صيغتنا في هذا الخصوص.
والنماذج الناجحة تُنسَب، اليوم، الى البلدان أو الى الاتحادات، كا يقال النموذج التركي أو الياباني أو الأوروبي. وفي حال نجاحنا قد ينسب النموذج الى تونس أو مصر، أو الى المجموعة العربية. وها هي الثورات العربية باتت عابرة، اذ هي تستلهم في غير بلد، بما في ذلك الولايات المتحدة الأميركية.
لذا، لا يجدي نفعاً أن ننسب نتائج أو ثمرات أعمالنا الى الاسلام، لأننا بذلك نحمّله ما لا طاقة له به. فإن أخفقنا نسيء اليه وننتهك قيمه، كما تشهد تجارب الاحزاب والمنظمات والحكومات الاسلامية في غير بلد عربي، وإن نجحنا نمارس الالتفاف والمداورة والخداع، اذ نسمي الشيء بغير اسمه ونعزو الانجاز الى غير مصدره.
لنستخدم الدين بما يتيحه ويقدر عليه بوصفه مصدراً من المصادر المشروعية الرمزية، وذلك بالتشديد على القيم الخلقية الجامعة، ليس فقط بين المسلمين، بل بين البشر أجمعين.
في ضوء هذا الفهم للمشكلة، ليست المسألة الآن هي التوفيق بين الاسلام والحداثة أو الديموقراطية. هذا نوع من التلفيق غير المجدي. إنه تمويه للمشكلة، لأننا نقيم منذ زمن في العالم الحديث. وما بوسعنا فعله، وما ينتظر منا هو ممارسة حداثتنا بصورة عالمية، منتجة وبناءة، بتكييف الدين والتعامل معه كعنصر بين عناصر عديدة، أو كحقل بين حقول مختلفة، تتفاعل ضمن وحدة تدار بمفردات الاعتراف المتبادل والفكر المركب والعقل التداولي ومنطق التحويل الخلاق، سواء على مستوى دولة أو مجموعة دول، أو على المستوى العالمي.
السفير