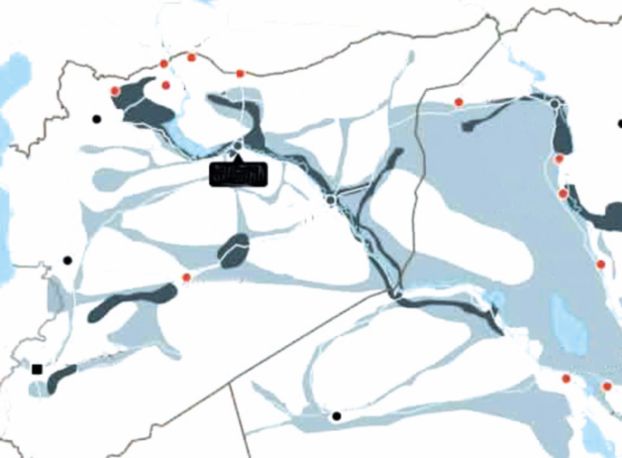الأفكار السياسية في امتحان الثورة السورية

ماجد كيالي
منذ أن باتت الأفكار السياسية الكبرى بمثابة أيديولوجيات مغلقة، وبالأحرى بمثابة “أديان” أخرى، فقدت عقلانيتها وقيمتها، وبالتالي فقدت حيويتها وفاعليتها، وباتت أفكاراً ساذجة، لا قضية لها، ولا روح فيها.
هكذا تمخّضت فكرة اليسار عند بعض “اليساريين”، عن تبرير التسلّط، وتدجّين الناس، وسلبهم حريتهم، باعتبارهم مجرّد مكوّنات طبقية صمّاء، لا ذوات لها، بادّعاء أولوية النضال من أجل “العدالة الاجتماعية” ومقاومة الرأسمالية العالمية والإمبريالية.
هذا ينطبق، أيضاً، على بعض العلمانيين، من الذين جرّدوا فكرة العلمانية من جوهرها المتعلّق بحرية العقل والرأي والتعبير، وضمن ذلك ضمان حرية التديّن، والتمييز بين الديني والدنيوي، وبين الدين كمجال خاص والدولة كمجال عام. كما ينطبق ذلك على القومجيين الذين ابتذلوا الفكرة القومية وباتت تعني مجرّد التعصّب، ونبذ الآخر، والاستعلاء القومي، والعنصرية، بما في ذلك تنميط للناس، من دون احتساب لخصائصهم وفرادتهم. أما المقاومة، التي فكّت الارتباط بين معنى التحرير ومعنى الحرية، فقد تحوّلت إلى مجرّد مجالاً للتورية، والتلاعب، والاستهلاك، كما تمثّل ذلك في ما يسمى معسكر “الممانعة والمقاومة”. وبالطبع فإن هذا يشمل بعض التيارات الإسلامية، التي باتت، بدورها تدّعي احتكار الحقيقة، وحقّ تفسير الإسلام على هواها، مع محاولاتها فرض ذلك بوسائل العنف على المجتمع، مشهرة تهمة الجاهلية، وسيف التكفير في وجه من يقف في مواجهتها، حتى لو كان ينتمي إلى تيارات إسلامية أخرى.
وبالإجمال، فقد آلت هذه الأفكار إلى تخليق جماعات من متعصّبين، يجمّلون ويبرّرون الاستبداد والفساد ونهب البلاد، والحطّ من قيمة الشعب، علما انها كلها تدّعي الكلام باسم الشعب، وتعتبر نفسها وصية عليه.
نجم عن هذا الوضع نشوء ظاهرة أخرى تتمثّل بالنزوع إلى تنميط أو تصنيف الناس، على أساس أيديولوجي، بحيث بتنا وكأننا أمام حالة طائفية، و”هوياتية”، من نوع آخر، كأن العلمانيين، أو الإسلاميين، أو القوميين، أو اليساريين، أو الليبراليين، من نسيج واحد، وهو أمر غير معقول، وغير عملي.
والأنكى أن هكذا تصنيفات “هوياتية”، تحيل تلك الجماعات إلى “طوائف” مغلقة ومتعصّبة، مثلها مثل الطوائف الدينية التي هيمنت عليها فكرة الطائفية، بحيث يغدو الإسلامي في مواجهة العلماني واليساري والقومي، واليساري ضد الليبرالي والإسلامي والقومي، والقومي ضد الاسلامي واليساري والليبرالي، وهكذا. علماً أن الواقع يشتغل على نحو آخر، فثمة إسلاميين ويساريين وعلمانيين وقوميين وليبراليين في خندق أنظمة الطغيان، مثلاً، كما في الحالة السورية، كما ثمة مثل هؤلاء ضمن ثورة السوريين. أيضاً، لا يوجد تيارات خالصة، ومطلقة، لفكرة بعينها، إلا إذا كانت هذه التيارات في حالة موات، فالتيارات الحية تتعايش فيها جملة من الأفكار فثمة في التيار اليساري ليبراليون، وقوميون، أيضاً. وثمة في التيار الإسلامي ليبراليون وقوميون، كما ثمة في التيار الليبرالي يساريون وإسلاميون، لأن الإنسان أصلاً شخص متعدّد ومركّب وغني بتنويعاته.
على ذلك ليس من المجدي نقد شخص ما، أو محاباته، بدلالة التيار الذي ينزع إليه، فقط، سواء كان يسارياً أو اسلامياً أو قومياً أو علمانياً أو ليبرالياً، بمعنى أن هذا أو ذاك، ينبغي أن يتأسّس على الموقف من قضايا الحرية والمساواة والكرامة والعدالة والمواطنة، فهذه القيم الجمعية هي التي تحدّد، لا الأيديولوجيات أو التنميطات الهوياتية المغلقة.
هكذا، فإن مآلات حزب الله، مثلاً، تفيد أن الأحزاب القائمة على أيديولوجيات شمولية، دينية كانت أو علمانية (يسارية أو قومية)، إنما تحوّل منتسبيها وجمهورها إلى أدوات صماء، غير عاقلة، بحيث يمكن توجيهها في هذا الاتجاه أو بعكسه. وهذا ما حصل، أيضاً، مع الجيش “العقائدي” الذي تحوّل، بفضل النظام “القومي” المقاوم والممانع، من جيش الشعب إلى الجيش الذي يقتل الشعب دفاعاً عن نظام “الأسد إلى الأبد”.
ولعل هذا الاختلال في تعاطي تيارات “اليسار” أو العلمانية أو الإسلامية أو القومية، مثلاً، مع القيم المتعلقة بحرية الانسان وكرامته، والتي تعلو على قيمة الأيديولوجيات، هو الذي أدى إلى عزلة بعض هذه التيارات في المجتمعات العربية، وتخبّط بعضها الآخر، أي أن الأمر لا يعود لأسباب لها علاقة بتخلّف الوعي السياسي لهذه المجتمعات فقط.
الآن، إذا عدنا إلى الموقف من ثورة السوريين، التي تعتبر الأكثر شرعية بين كل الثورات، بالنظر إلى تجبّر نظام الأسد، وامتهانه كرامات الناس، وتحويله البلد الى ملكية خاصة، يتم توارثها من الآباء الى الأبناء، وبالنظر إلى الكيفية التي تعامل فيها هذا النظام مع شعبه، لكسر ثورته، يمكننا ان نفهم كم ان هذه الثورة كانت ضرورية، وكم هي شرعية، رغم كل مشكلاتها.
الآن، وإزاء كل النواقص، والثغرات، التي تعتور ثورة السوريين، ربما يمكن تفهّم آراء بعض اليساريين والقوميين والعلمانيين والليبراليين، من توانسة ومغاربة ومصريين وعراقيين وأردنيين وفلسطينيين ولبنانيين، بشأن عدم مساندتهم للثورة السورية، وتخوفهم منها، وهذا حق لهم، لكن لا يمكن البتّة تفهّم، ولا تقبّل، موقفهم المحابي لنظام استبدادي يقتل شعبه، في حين انه لم يقاتل اسرائيل منذ اربعين عاما، بقدر ما قاتل اللبنانيين والفلسطينيين والسوريين. وقد يمكن تفهّم رفض البعض لأداء الثورة السورية، أو قياداتها، لكن لا يمكن البتّة تفهم موقفهم المتنكّر للضحايا الأبرياء من الشعب السوري، الذين يقتلهم النظام بالطائرات والدبابات والمدفعية، المفترض انها مكرسة لتحرير الجولان، وصدّ اعتداءات اسرائيل.
القصد، أنه في هكذا أوضاع، ينبغي التمييز بين مشروعية الثورة من أجل الحرية والكرامة والعدالة، وبين الموقف من وسائل عملها وخطاباتها السياسية، تماماً مثلما ينبغي التمييز بين رفض الثورة من الأساس وبين التعاطف مع الضحايا الأبرياء الذين يستهدفهم النظام بالقتل الجماعي.
قصارى القول، الأمر هنا لا يستدعي ادّعاء تمثّل أي من الأفكار الكبرى، ولا يحتاج أصلاً إلى التفكير، بقدر ما يحتاج إلى بصيرة، وإلى بعض من حساسية أخلاقية. ويبدو أن الثورة السورية، المستحيلة، واليتيمة، والأكثر شرعية بين الثورات، هي ثورة كاشفة، أيضاً، فهي كشفت، وامتحنت، كثير من الأفكار والتيارات، التي لطالما تحكمت بنا وحكمتنا باسم القضايا والأفكار الكبرى.
المستقبل