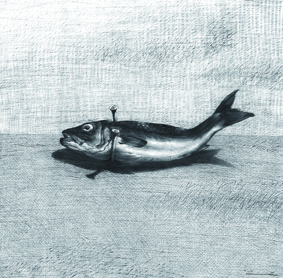الإعداد للسفرة الأخيرة/ عزيز تبسي

-1-
من غير المجدي التورّط بما يسمى “علم الأنساب”، حيث يغيب العلم ويتغيّب النسب، ويعمل على تنسيب رجالات السلطة أو أرباب المال الجدد، إلى قبائل عربية، حملتها أنظمة الحكم المتعاقبة سمات امتيازية، بتجاهل للتطورات والتحولات التي عصفت بالمجتمعات والمدن العربية، من اجتياحات عسكرية كبرى، إلى فناء العديد من المدن وإعادة قيامها، إلى التزاوج والتصالب بين عشرات الأعراق، والتي التقى أبناؤها فوق هذه الأرض، فضلاً عن التدخل المتعمد، بأنساق الأنساب لغاية تحصيل الامتياز من أغصان أشجار، جفّفها الزمن واحتطبها، والعمل على تنسيب رجال من فارس وآسية الوسطى والأناضول والقفقاس إلى أرومة قبائل عربية، أو بيوت منها، البيت الهاشمي على وجه التحديد، لما يحققه من مكارم دينية، وفوائد حياتية، وصلت مع طبقة الأشراف إلى عتبة الامتياز، بعدما شاركوا الحكم جنباً إلى جنب مع الولاة العثمانيين، وقبضوا على حصتهم الوافرة من امتيازاته، بإدارة الأوقاف وما يستتبعها من أملاك زراعية وتجارية واحتكار العديد من الفعاليات الاقتصادية.
التفاف عن الانتساب لطريقة صوفية، الطريقة الرفاعية، انتشرت في البقاع والمدن الإسلامية، بادعاء الانتساب، وهو ما يصعب التحقق منه، إلى سبط مؤسسها، أحمد بن علي أبو العباس المتوفي في 23 سبتمبر/ أيلول 1183 في بلدة أم عبيدة، التابعة لمقاطعة واسط في العراق، الذي سمي بالرفاعي نسبة لأجداده المنحدرين من قبيلة رفاعة.
أول من عرف من الرفاعيين الحلبيين، رجل يدعى “شاهين”، كان جندياً ومات سنة 1695، ولد له ابن بعد موته بخمسة أشهر دعي “عمر”، تربّى في كنف عمه “عبد القادر”. تعلّم القرآن الكريم، وأصول التجويد في المدرسة الحلوية. كذلك أخذ مبادئ الألحان، والكيفيات التي ينتقل بها، من مقام غنائي إلى آخر، مع طول النفس بالإنشاد، فبرع في هذا الفن. قرأ “الأجرومية”، وهي كتاب في النحو ألفه أبو عبد الله محمد بن محمد بن داود الصنهاجي، الشهير بابن أجروم. وتضلّع في المعارف الدينية ونسخ الكتب، عهدت إليه في سنة 1735 إمامة جامع الرضائية والمدرسة العثمانية التابعة له. سكن خلالها في دار واسعة قريبة من مكان عمله، عرفت بدار “الجربوعي”، وهناك رزق ولداً سمّاه محمد.
تزوج “محمد عمر شاهين الرفاعي”، من ثلاث نساء وكانت إحدى زوجاته، السيدة آسية بنت السيد محمد الزنابيلي والدة محمد أبي الوفاء.
-2-
دخلت سنة 1846، فحدث في حلب وباء عظيم، كثرت الوفيات حتى ضاق النهار على الجنائزية، وصاروا يشتغلون في الليل، والتزم الناس بيوتهم، خوفاً من أن يدرك أحدهم الأجل وهو خارجه.
وأحس الشيخ “أبو الوفا” بـ “الحمى الباردة” وهي الاسم المتداول للفالج. اعتكف على أثرها، وشرع بتأليف منظومته عن أولياء حلب، كأنما رغب في الالتجاء إليهم، وطلب شفاعتهم لينال الشفاء. بقي على خلوته سنة كاملة، ملازماً الصلاة والقراءة والعبادة، متبتلاً بالحديث الشريف “أكثروا من ذكر هادم اللذات”، مردداً بلا انقطاع ذكر الموت.
عبرت في هذه الخلوة الاضطرارية، سنوات عمره… يوم احتفال أهله بختم أجزاء من القرآن الكريم. حينما سار الموكب يتقدمه المطربون وضاربو المزاهر والطبول، والنافخون في النايات، ووراءهم زمرة دراويش المولوية. تلويح الأولاد بأعلام صغيرة، وخفق الكبار برايات كبيرة، فوق رؤوس العابرين، في الأزقة المزدحمة. انسحاب السابلة إلى يمين الزقاق ويساره، ليوسعوا الطريق للموكب المبهر.
امتطى الفتى حماره الأبيض، خلفه شيخه راكباً برذونه، تشدّ كفه اليمنى عصا التأديب الطويلة. رجل يحمل مسنداً خشبياً وضع عليه المصحف الشريف، يعقبه رجل يرنح مبخرة، لردع اقتحام الجن، إنجاز الفتى الناجح، بلعنة الحسد. رجال ينثرون على الناس شعيراً، اتقاءً من إصابة العين. نساء يتعقبن الموكب من خلف المشربيات. استقبال الأب وخدمه الموكب أمام بوابة البيت، بأطباق نحاس ممتلئة بالزبيب، والقضامة السكرية والفستق الحلبي.
انتقاله بعدها إلى رحاب المدرسة العثمانية، التابعة لجامع الرضائية في حي الفرافرة، حيث سكن أعيان المدينة المسلمون. تعلم في صفوفها اللغة التركية على معلمها الشيخ حسن المدرس، والذي أتى من بلدة كِلس إلى حلب واستقر فيها، واللغة والأدب على الشيخ مصطفى الكوراني، الأديب الصوفي، وركن الطريقة الشاذلية. استكملها بحضور دروس الشيخ إسماعيل المواهبي في الجامع الكبير، كما مثابرته على زاوية الشيخ إسماعيل الكيالي، تحصيل دؤوب مكنّه من اللغة العربية ونحوها وصرفها، وقواعد الفقه والتفسير.
الصراع الدموي بين جند الإنكشارية والأشراف في عام 1797، وكان خلالها في بيته، حين داهمته جماعة منهم، وذبحوا ابنه أمامه، غير ملتفتين لرجائه وتوسلاته. استكمل هذا الصراع بمذبحة جامع الأطروش، والذي احتمى به الأشراف، ولم يتمكن الإنكشاريون من دخوله، فحاصروهم وقطعوا عنهم الماء والطعام، ثم طلبوا منهم التسليم وأمنوهم على أنفسهم، لكن نقض الإنكشارية الاتفاق، بعد استسلام الأشراف، وقاموا بذبحهم.
استنفاره عام 1800 لتعبئة العامة للتجند في الكتائب العسكرية الماضية لمصر للدفاع عنها بعد احتلالها من جيش نابليون بونابرت، والتي قد تكون إحدى نتائجها قتل الجنرال كليبر، من قبل أحد أبناء المدينة: سليمان الحلبي.
اضطره ذلك للسفر إلى إسطنبول وتقربه من السلطان، بعد وفاة والده سنة 1804، وتفاقم الخلاف على زعامة الطريقة الرفاعية. حيث تمكن من نيل اهتمام رجالات السلطة، وعاد إلى حلب مؤيداً بالإنعامات الشاهانية، وتثبيت زعامة الطريقة.
رحيله إلى العراق سنة 1837 أثناء حملة إبراهيم باشا، ليتجنب أي ضغوط، أو إحراجات تدفعه لتأييد الحملة وإجراءاتها، وهو عثماني القناعة والهوى، وولاؤه للباب العالي والسلطان. عاد بعدها مزداناً بمآثر الصالحين المتبركين من زيارة قبر عبد القادر الكيلاني، ورأى ابنه بهاء الدين مفتياً على ولاية حلب.
تتألف “منظومة الشيخ وفاء” من سبعمائة وستة وخمسين بيتاً شعرياً. رحلة في زمن القرنين الثامن عشر والتاسع عشر، تتنقل من مقام إلى مقام، ومن زاوية إلى زاوية ومن قبر إلى قبر، تسير في طرقات المدينة وأزقتها، بين القلعة وحي الجلوم وباب النيرب، وفي أطرافها في حي الصالحين، والشيخ فارس، والشيخ أبي بكر، والمشارقة.
تعود بعض المقامات إلى زمن إبراهيم الخليل، الأب الروحي للديانات التوحيدية، والذي عاش لألفي سنة قبل الميلاد، قد يكون مرّ بحلب في طريقه من مدينة أور إلى فلسطين، وقد لا يكون مر بها، رغم ذلك لإبراهيم الخليل مقامان في حلب، أحدهما في القلعة والثاني في صدر مقبرة الصالحين.
وزكريا صاحب مقام الجامع الكبير، وهو والد يوحنا المعمدان المعروف بـ “يحيى”، وقبر أبلوقيا الذي حيّر تنسيبه المؤرخين المسيحيين بين إحالته إلى إفلوجيوس الرهاوي، أو إفلوجيوس الراهب السوري، إلى قبور شمعون ونعمان وبنقوس.
تشكل هذه المنظومة الشعرية مرجعاً متمماً لتاريخ المدينة وعائلاتها الإسلامية، من خلال قبور ومزارات وزوايا يعود أصحابها بأصولهم إلى عائلات تركية وكردية وهندية وشركسية وأذربيجانية وفارسية.
فككت مزارات أولياء الله الصالحين، منظومة التعالي الديني وأرستقراطية حامليه الاجتماعيين، بتحريره من احتباس التجريد، ونقله إلى صيغ عيانية ملموسة. ومحاولة لإعادة اعتبار دورية، للأتقياء المنحدرين من صفوف العامة، الذين أحبوهم في حياتهم، واحترموا سلوكهم وتقشفهم وبعضاً من غرابة سلوكهم، واستمروا باحترام قبورهم، التي تحولت مع الزمن إلى مقامات، وجبت زيارتها وأخذ البركة والشفاعة منها.
احتمى بها الفقير والغريب والمسافر والمنبوذ والمريض والمجذوب، ضمتهم بأعطافها، عناق المنبوذ المهمش للمنبوذ المهمش. مشفوعة بأسمال أقمشة ومناديل، معقودة على قضبان خشب أو حديد، تسور قبورها، وحولها بقايا أواني الخزف، لمّا تزل في قعرها آثار الزيت، الذي اشتعلت ذبالة قنديله عند أقدام المقام.
مقامات رسّخها الزمن والأتباع في الأرض، توزعت في أنحاء هذه المدينة، كما توزعت في المدن الإسلامية، من سمرقند بمقام الشيخ عبدالله، وبخارى حيث يرقد مولانا الشاعر الجامي، وتركستان، الخوجه أحمد النسغي، وقونية، مولانا جلال الدين الرومي، ومصر، الشيخ البدوي، ودمشق، محيي الدين ابن عربي، وحلب، السهروردي والنسيمي. ومقامات أخرى لحشد من مشايخ الطرق الصوفية الرفاعية والشاذلية والقادرية والنقشبندية والمولوية والبدوية.
كل دخول يفصح عن خواتمه، سوى دخولين، دخول السجن ودخول القبر. وكأنهما إيذان بسفرة لا عودة بعدها.
لم يجرِ التيقّن من حالة المنبعث من قبره بعد. ما تيقن منه حال الخارجين من السجن.
رقد الشيخ محمد أبو الوفاء الرفاعي في مقبرة الصالحين، على غير مبعدة من مقام إبراهيم الخليل، يتمهل الزائر، يعاين المقام ويقرأ ما توج به القبر:
“إذا ما تولّى الله نفس وليه / تهون عليه سكرة الموت بالحق
وما هي إلا دعوة وإجابة / ويخلص من رق الكثافة بالعتق”
*اعتمد المقال على المبحث التحقيقي، والذي أجراه الأب فردينان توتل اليسوعي، عن أولياء حلب في منظومة الشيخ وفاء. المطبعة الكاثوليكية بيروت 1941.
ضفةثالثة