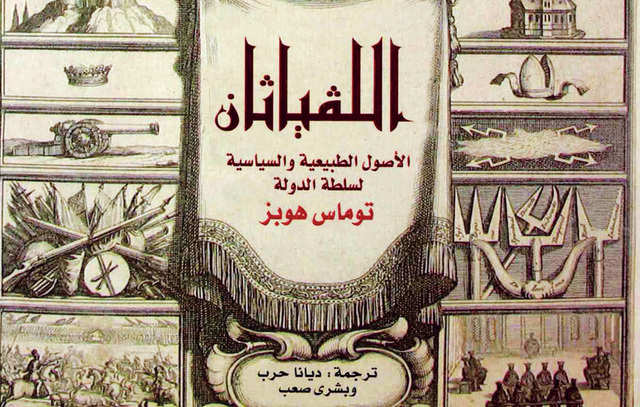الاستقرار طريقاً إلى الفوضى/ بدر الإبراهيم

صحيح أن الثورة المضادة التي تسعى إلى ترميم النظام الرسمي العربي، وإعادة تثبيته بصيغة قريبة من صيغته القديمة، تستخدم أساليب عنيفة لتحقيق هذا الهدف، منها الانقلابات التي تُمارس القمع بشراسة، لكن ذلك لا يعني تغييب الأساليب الناعمة التي تخطب ودّ الجماهير، وتشرعن ذلك القمع، فتصنع بالفعل “ثورةً مضادة”، بما تعنيه من انحياز قطاعات جماهيرية لعملية الترميم هذه، وانقلابها على الثورات الأصلية ومبادئها، والتبرؤ منها.
الاستقرار هو العنوان الأبرز لدعاية الثورة المضادة، وهو المفتاح لاكتساب خطاب الثورة المضادة الشرعية الجماهيرية، فدموع التماسيح التي تُذرَف على الدماء المُسَالة، والشكوى من الفوضى والاضطراب، وغياب الأمن والأمان في دول الثورات، يصبّ كله في صالح المقارنة، بين ما أتت به “فوضى الحرية” وما يمكن أن تقدمه عودة الاستبداد من أمن واستقرار. هكذا، يصبح الاستقرار مطلباً شعبياً، عند قطاعات من الأغلبية الصامتة، ومجموعاتٍ أيدت الثورات وتابت، فتركب الأنظمة الاستبدادية الأمواج الشعبية المتطلعة للأمن والاستقرار، في طريقها إلى تثبيت استقرارها مجدداً.
يشير التدقيق في رواية الثورة المضادة للفوضى والاستقرار، في زمن الثورات العربية، إلى حجم التلاعب الذي يمارسه خطاب الثورة المضادة؛ فهو يغفل حصول الثورات، نتيجةَ فشل الأنظمة في تحقيق التغيير المنشود، وعدم سماعها مطالب كثيرين بالتغيير، إذ إن الثورات لم تحصل، إلا لأنها باتت الخيار الوحيد الممكن، للخروج من حالة انسداد الأفق التي صنعتها الأنظمة.
” يشير التدقيق في رواية الثورة المضادة للفوضى والاستقرار، في زمن الثورات العربية، إلى حجم التلاعب الذي يمارسه خطاب الثورة المضادة، فهو يغفل حصول الثورات، نتيجةَ فشل الأنظمة في تحقيق التغيير المنشود، وعدم سماعها مطالب كثيرين بالتغيير، إذ إن الثورات لم تحصل، إلا لأنها باتت الخيار الوحيد الممكن، للخروج من حالة انسداد الأفق التي صنعتها الأنظمة.”
يبدأ التلاعب من إغفال عمل الأنظمة الاستبدادية على رفع كلفة التغيير، باستخدام العنف ضد المحتجين، وقتلهم في الشوارع، وتحميل الثورات مسؤولية ارتفاع ثمن التغيير. عند دعاة الاستقرار الجدد، تتحمل الثورات مسؤولية القتل والدماء، لا الأنظمة التي استبدَّت، وقمعت قبل الثورات، وقتلت واعتقلت في أثنائها، وقادت إلى مزيد من الاضطراب، أو إلى الاحتراب الأهلي. لا يتساوى القاتل والمقتول هنا، بل يتحمل المقتول، وحده، مسؤولية قتله، وما أحدثه قتله من فوضى واضطراب. يشبه هذا هوس كتاب عرب بتحميل المقاومة وصواريخها مسؤولية أعمال القتل الإسرائيلية، حيث يدور الحديث كله حول استبعاد الجلَّاد من النقاش، والتركيز على فعل الضحية، واعتباره صانعَ المشكلة.
يكثر الحديث في خطاب الاستقرار عن نتائج المطالبة بالتغيير، فيتم استعراض الاحتراب الأهلي، وظهور العصبيات الطائفية والقبلية، ويقال إن الثورات هي ما أوصلت إلى هذه النتائج، فيما لا يقال شيء عن دور الأنظمة في الوصول إلى حالة الاحتراب الأهلي، عبر مقاومة التغيير ورفض الإصلاح، وتفضيل بقاء النظام، ولو أدى إلى الفوضى، والحرب الأهلية، وغياب الاستقرار.
كذلك لا ينتبه (أو لا يريد أن ينتبه) أحد من دعاة الاستقرار إلى أن هشاشة الاستقرار السابقة على الثورات أدَّت إلى الفوضى والحرب الأهلية نتيجة طبيعية، إذ إن الأنظمة الاستبدادية اختزلت الدولة بها، ولم تبنِ مؤسسات راسخة، يمكنها أن تصمد في حالة الاضطراب، وهكذا، تكون الفوضى نتيجةً هشاشة الدولة، والاحتراب الأهلي نتيجةً لغياب المشترك الوطني الذي يجمع المواطنين، فهم يعودون إلى طوائفهم وقبائلهم، مع تيقّنهم بعدم وجود مظلة أكبر يستظلون بها، ومؤسسات حقيقية، يعتبرونها مؤسساتهم، ويدافعون عنها. الدولة المهلهلة والمريضة قبل الثورات، كانت تنتظر انطلاق شرارة الثورة، لتعلن عجزها عن تأمين الحد الأدنى من الاستقرار، القائم على وجود وحدةٍ وطنية، لا تشبه اجتماع الناس، مرغمين على التسبيح بحمد القائد الذي يتمثل به الوطن، في الإعلام الرسمي.
يعود خطاب الإرهاب ليُطرح عربياً، ويدعم الحاجة إلى الاستقرار، فالخطر اليوم على المجتمعات العربية، كما يخبرنا هذا الخطاب، هو من انبعاث الجماعات الجهادية وتمددها، وهنا، تُخَيَّر المجتمعات العربية بين الفوضى الناتجة عن المطالبة بالتغيير، والتي تسمح بنمو الجماعات الجهادية، والأمن الناتج عن تمكين الأنظمة الاستبدادية، ومنحها الشرعية لتحارب “الإرهاب”، مع تأجيل المطالب بالتغيير، وغضّ الطرف عن الانتهاكات لحرية الناس تحت عنوان محاربة الإرهاب، فالأمن والأمان أولاً وقبل كل شيء، وفي سبيله يهون كل شيء.
غير أن الواقع يشير إلى أن الأنظمة هي التي توفر بيئة خصبة، لنمو الجماعات الجهادية، فإغلاق المجال السياسي بالكامل، وتقليص حرية التعبير، وملاحقة الناس بناءً على مواقفهم وآرائهم، تغذي اتخاذ العنف وسيلةً للتغيير، وتقنع كثيرين بالالتحاق بالجماعات الجهادية، للتنفيس عن غضبهم، ومقاومة قمع الأنظمة وبطشها (مع الأخذ بالاعتبار عدم الوقوع في فخ اعتبار الديمقراطية والمشاركة السياسية حلاً نهائياً لمشكلة العنف، لكن إغلاق المجال السياسي عامل مهم في تغذية العنف).
ليست القضية هنا في طرح التغيير الديمقراطي حلاً خلاصياً، يُؤَمِّن الاستقرار سريعاً، ويحقق التنمية، ويحل القضايا القومية الكبرى، ولا في استسهال تحميل الاستبداد وحده مسؤولية كل ما يحدث من إشكالات على الساحة العربية. بل القضية في القول إن الاستقرار الذي يستعيد الاستبداد والفساد هو وصفة للمزيد من الفوضى، وهو مشكلة وليس حلاً، وأن التغيير الديمقراطي يفيد أكثر في إيجاد استقرار يقوم على أسس متينة.
يقول دعاة الاستقرار إنه طريقُ التنمية والتطوير، وحين نفحص حال بعض الأنظمة، نجد الاستقرار الأمني مترافقاً مع الفساد والفشل التنموي. ليس أيُّ استقرارٍ هو المطلوب، إنما الاستقرار الذي لا يرتبط بالعوامل التي أدَّت، وتُؤدي، إلى الفوضى والاضطرابات.
العربي الجديد