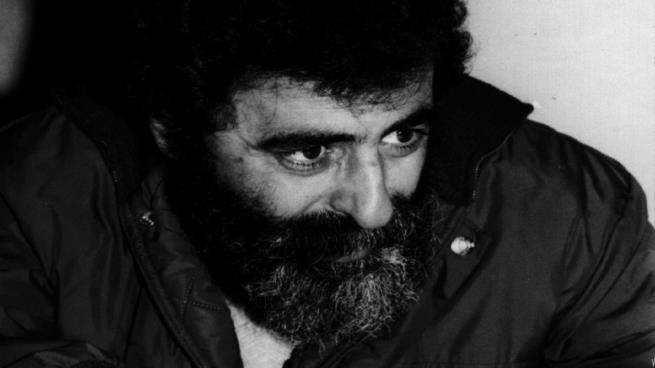البشر والجرذان: صراع المركز والهامش/ حاتم الصكر

في صراع الشارع العربي والسلطة المهيمنة والمتشبثة بكراسيها في هبّات التغيير الربيعية، وبعد تمدد الغضب الشعبي، ندّت عن الطغاة المحاصَرين أوصاف تحقيرية لشعوبهم وللشباب من الثوار خاصة، فنعتوهم بالجرذان والجراثيم وقطّاع الطرق والغوغاء والفوضويين. وهي نعوت تعكس مركزية الحاكم- ومن يحيط به كجزء من منظومته- واستخفافه بما ينشأ على هامشه أو بعيدا عن مركزه، كطاعة أولي الأمر التي ينظّر لها فقهاء السلطات، ويبررون بها صد الوعي الهامشي والمقصى والمكتوم، ويجسدونها بنعوت الجرذان والغوغاء والجراثيم؛ لأن السادة يقابلون العبيد في ثنائية قديمة لا تزال تعمل في لاوعي أو وعي مستخدمي الخطاب وصانعيه، وفي الخطاب ذاته، ولكن بتنويعات مرادفة تتخفى وراء اللغة. فالغوغاء مثلًا يجسد دونية النظر للطبقات الثائرة عفويًا. ويستغل المهيمنون وصانعو الخطاب الرسمي تلك العفوية لوصف الثوار بالغوغاء بمقابل النخبة، أو الهمج والسوقة بمقابل السادة، الذين هم الجسد – المتن وسواهم خارج الوصف الإنساني. وذلك سيبرر سحقهم بطرق شتى ليس العنف إلا أبرزها وأشدها. وذلك يليق بمن وصف بجرثوم- هامش دخيل على الجسد لا بد من مكافحته، فالسادة الحكام هم البشر، وسواهم طارئ كجرذ السفينة أو السدّ لا بد من طرده.
إن من بين ما تسببت في تغييبه النظريات الشمولية والوصفات الكاملة لحياة الإنسان ومجتمعه واقتصاده، أنها أغفلت العوامل الفاعلة في التغيرات على مستوى البنى الثقافية، والوعي بوجه خاص.
لقد اقترحت تلك النظريات ثنائيات تريح معتنقيها، وتفهرس أنصارها وأعداءها، وتشكل الصورة النمطية للأشياء، ليسهل رفضها أو قبولها: مؤمنون وكفرة، طبقات مسحوقة وأخرى ساحقة، عالم أول وعالم ثالث. وهكذا صارت الانشقاقات تتم على أساس فرز الفكر وتنميطه. بذا دارت حروب الصلبان والفتوحات، وحروب الطبقات، والتحضر والتخلف، والفقر والغنى. لكن انشقاقات كبرى ظلت تزيل عن الأرض قشرتها لتجلو صراعات ثانوية، أخذت تفعل فعلها في المصائر، لعل من أبرزها معارك المراكز والأطراف الاجتماعية والدينية، تلك المتجسدة في أسطورة شعب مختار له حق سلب بلد ومحو شعبه كما تجلى في هيمنة الصهيونية كفكر استعلائي محفوف بالأساطير والخرافات، والتي قابلتها نزعة مضادة بدأت فعليا بالثورة على اللوغوس، والهيمنة المطلقة للمركزالموحى إليه أو المفوّض غيبيًا، وإزاحة الذات لصالحه وهيمنته في صنع الخطاب. ومن بين ما انتعش عمليا ما يحدث من هبّات شعبية تلغي سلطة الحاكم وتهز عرشه، بصعودها بديلا لهيمنته كمركز لا يكف عن السيطرة بقوة السلطة وخطابها القريب من النص المحكَم غير القابل للمناقشة والمراجعة؛ لأنه يتقنع بالوطن كله، ويختزله فيه، ويحتج بالوطنية وينزعها عن سواه، فصار الحاكم مثلا يعني الوطن، والتطاول على ظلمه ورفضه سيكون خيانة وطنية بالضرورة. هكذا ستأخذنا تنازعات المركز والأطراف، وتجاذبات المتن والهامش، إلى تأمل تنوعاتها الثقافية في مجالات شتى، كنبذ نظرية اللغات القوية والضعيفة بتوصلات اللسانيات الحديثة التي لا تجد في ذلك التفضيل اللغوي إلا عنصرية وعرقية بغيضة، لأن اللغة اكتفاء بالتداول والتوصيل، وذلك يكفي لجعلها حيوية في إطارها التداولي. فليس من لغة أفضل أو أقوى وأحسن إلى آخر تلك التوصيفات المتقنعة لسانيا عن الشوفينية ونصرة العرق وإعلائه. وحدث مثل هذا في الكتابة أيضًا، إذ أصبحت السيرة الذاتية فنًا متاحًا حتى للصغار، وليس للمشاهير والأعلام فحسب، كما أن عناصر الجمال في النظريات العلمية ستتغير لتنبذ النمطيات الشائعة عن الجميل، ولا يعود هو المفيد فحسب، بل المتمثل لعناصر المتعة أيضا، وعندها لا تتوقف القيم الجمالية عند ما استقر في الذاكرة الجمعية عن لون مميز أو شكل مفضل. وتم بسبب تغير تلك المعايير الجمالية تحريك مفهوم الجميل ليس بدخول عارضات أزياء سود البشرة أو من منحدر آسيوي، ولا بفوز ملكات جمال سمر وصفر، ولا بصعود نجمات السينما الملونات، بل بالاعتقاد بنسبية الجميل أي بظرفيته والثقافة التي تحف بمستهلكيه. تبع ذلك تبدل الأزياء وتخففها من التقاليد الرسمية، وظهور العدسات الملونة وسائر عمليات التجميل مثلا لهدم مقولة الجمال المطلق أو الثابت في صورة نمطية. وينسحب هذا إلى حقلي الفنون والآداب، فليس الجميل هو الموقَّع إيقاعًا خارجيًا في الشعر بل المستمد جماليته من إيقاعات خفية يشارك المتلقي في استكمالها وجلائها. وليست الموسيقى الجميلة هي الزاعقة أو الشعبوية ولا المكرَّسة في أطر إيقاعية ونغمية محددة، كما أن جمال اللوحة والصورة لم يعد يتحدد في واقعيتها الفوتوغرافية أو تلوينها، ولكن بعناصر بنائية تجريدية غالبًا، تدع للخيال استكمال فراغاتها ومدلولاتها. ونبذ الرسامون التقاليد المدرسية في الرسم وفتحت الأبواب للفن الشعبي والتلقائي…
واجتماعيًا توقفت هيمنة المدينة على الريف الذي صار عصب التحولات الاقتصادية، واقترب ديموغرافيًا من المدينة، فدخلته أغلب أدوات التحضر المديني ومظاهره، كالتعليم والصحة والمكننة والترفيه والكماليات، وتهدمت الحواضر الثقافية، وزال اقتصارها على المدن الكبرى والعواصم الشهيرة، كما كان يقال عن ثلاثي القاهرة وبيروت وبغداد، من أن الأولى تكتب والثانية تنشر والثالثة تقرأ، فشهدنا تبادلا واضحا للأدوار ذاتها، فبيروت وبغداد تكتبان والقاهرة تنشر كذلك، كما أنهما تنشران والجميع يقرأ!، فضلا عن تمدد المهمات لعواصم قصيّة في المغرب العربي مثلا والجزيرة والخليج، فتنشط الرواية في مدن مقصاة عربيا، ويظهر نتاج في الفن من كل جزء ربما ناله التهميش.
وعالميا ستنتشر الأعمال السردية الأفريقية واللاتينية لهدم مركزية البشر المتفوقين في الغرب. وعلى مستوى الأنواع الادبية ستتحرك الرواية لتتقدم المشهد بعد إقصاء مركزية الشعر عربيا وعالميا، ليس بموته بل بمجاورة أنواع أخرى له كي لا يظل في المركز متسيدًا، وهو تفسير يربط صعودها بالنزعة التحررية تلك، لا بصراع الأنواع لذاتها، بدليل تغير صورة (البطل) فيها، وصعود الهامشيين والمنبوذين كشخصيات رئيسة فيها، وهو تحول داخلي يصوّت لصعود المقصى إلى المتن.
تلك التجاذبات ستجد لها تنويعات أخرى منها؛ تهديم مركز الذات وهامشية الآخر، وصعود الجدل والحوار حول ثقافة الآخر وضرورتها كانحسار للشخصية المهيمنة وتسفيه الآخر، ومنها إزاحة مركزية الرجل في العائلة والمجتمع، لتكون المرأة حاضرة في بؤرة العلاقة بالسياسة والتربية والعمل والإبداع. ولئن شاب تلك الإزاحات تطرف، كالقول بعصر الرواية مطلقا أو محاولة إحلال المرأة مركزا وحيدًا بديلا، أو إفناء الخصوصيات الثقافية بسوء تفسير العولمة، فإن المعادلة لا تعود مرة أخرى إلى طرفيها التقليديين: البشر والجرذان، والأصحاء والجراثيم، حكام أولياء ورعية تابعين، ومنتجين ومستهلكين، مؤمنين ومارقين، رجولة وأنوثة.. كما أن التفسير المغلوط للنظريات المعرفية قد أسهم في تعميق الخلط بين المركز والسلطة، كتفسير نظرية أفلاطون في نفي الشعراء خارج جمهوريته بدعوى إحلال المركز- المثال المتحقق، وإبعاد صورته ونسخته أو ما يحاكيه شعريا، لانتفاء الحاجة له مع حضور المثال نفسه وتحققه عمليا. فالخلاف لم يكن لتحقير الشعر، بل لذلك الذي يجهد في اقتفاء المثل وتجسيدها، كما حصل من بعد في انتفاء الحاجة للرسم التشخيصي حين ظهرت آلة التصوير، وأغنت عن محاكاة الشيء كما هو في الخارج، واستبدال ذلك بما تضفي عليه الأنا من إسقاطات شعورية ونفسية.
وكذلك جرى تسويق قراءة الفكر الخلدوني لصالح سلطة المراكز الكبرى، وتفسير اجتهاداته حول المدن والمدر، وما هو حضري وبدوي، وأعرابي ومدني، ونفي القدرة على التقدم والتحضر عن المدر والبداوة، فهو يصف طبائع غير المدنيين التي تحول دون ذلك، ولا يراها لازمة لهم تقتضي فرض الهيمنة عليهم، بل يضرب الأمثال لبيان فداحة الخسارة بالهيمنة حتى يسمي أمما كانت كبيرة العدد، فأفنتها الفتوح واحتلال بلدانها، ما تسبب حتى في نقصان أعداد سكانها وزوال كياناتها، وتشبثها بذواتها جعلها تحسب التشبه بالمحتلين الغالبين سبيلا للنهوض، وتتخذ الإيمان بقوتهم وتفوقهم مبررا للخسارة، و ترى في تقليدهم ابتغاء القوة والانتصار.
لقد اتسعت مساحة التجاذبات، وحق لها أن تأخذ من فكرنا العربي المعاصر ما لها من أهمية، لا يراها غالبا الخطاب المركزي، لانشغاله بما هو آني ونمطي، وبتكريس هيمنته وتسلطه ومركزيته. وتمادي الخيال السلطوي في حلم مجنون بإمكان عودةِ ثنائيةِ العبد والسيد، وإذلال الآخر غير المطيع بتصنيفه مخلوقًا يتوجب المكافحة والإفناء، بوصفه جرذًا وجرثومة ونكرة من قطيع الرعاع والغوغاء!
ضفة ثالثة