الترجمة: رحلة المصاعب من لغة إلى أخرى/ فريد الزاهي
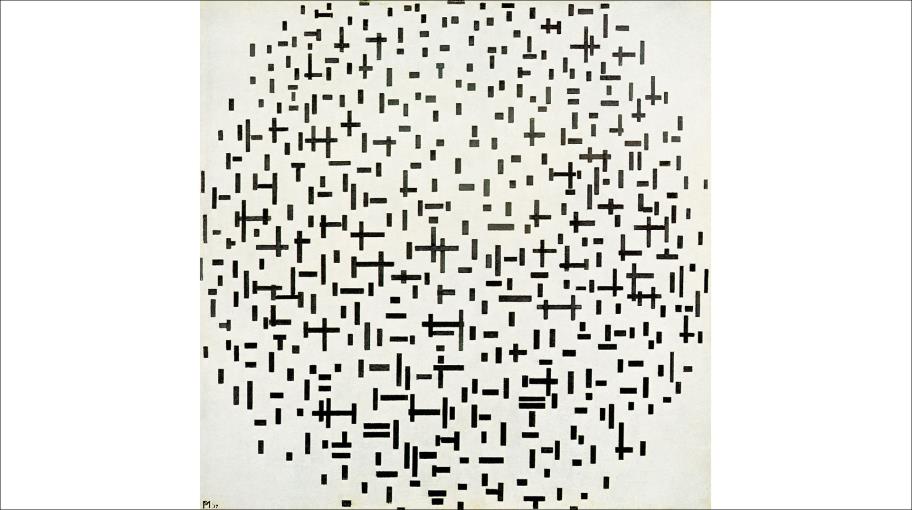
ليس كل من يمتلك لسانين قادراً على الترجمة. فثمة من مزْدوجي اللسان، ومثلَّثيه ومربَّعيه، من لم يترجم أبدًا نصًا واحدًا، ولو أن الترجمة، في تعريفها الفلسفي، ليست فقط الانتقال من لغة إلى لغة كتابة أو شفهيا. الترجمة أيضا عملية سابقة على التلفظ والكتابة، يعيشها مزدوجي اللسان، وهي تتم في حياتهم وتفكيرهم بشكل غير واع أحيانا.
ثمة أيضا من يكون قادرا على أن يجد لك المقابل اللغوي لأي كلمة تتلفظ بها من غير أن يقدر على صياغة ترجمة نصية صحيحة لجملة أو فقرة. بل إن أغلب منظري الترجمة في العالم ليسوا بالضرورة مترجمين ولا ممارسين لها. من ثم يمكننا القول بأن الترجمة النصية، أو ما يعرف بالترجمة الأدبية، موهبة وممارسة وحنكة ودربة وتميز. فالترجمة لا تمنح نفسها إلا لمن يمكنه غوايتها وتملكها واعتبارها حتى في أبسط حالاتها الممكنة.
الترجمة الممكنة والترجمة
المتمنّعة والترجمة الممْتنِعة
إذا كان من الأسهل الترجمة في العائلة اللغوية نفسها (من لغة لاتينية إلى أخرى مثلا) فإننا ما إن نواجه بين لغتين من عائلتين لسانيتين مختلفتين حتى يخرج بركان اللغة حممه لكي يحرقنا بالصعوبات والمعضلات. والحقيقة أن هذا الانتماء يكون أيضا بشكل أو بآخر انتماء إلى ثقافة عامة وذهنية متشابهة، بالرغم من الخصوصيات التي يمكن أن تكون في هذه اللغة أو تلك. لذا كانت الترجمة وستظل معرفة باللغة وبالثقافة، وحساسية لغوية وثقافية خصوصية، وذكاء تأويليا، وكتابة.
تكون الترجمة ممكنة حين يفصح النص عن أسرار لعبته وثقافته. لذلك كانت ترجمة النصوص التربوية أكثرها بساطة، بالنظر إلى الجهد التوضيحي والتفسيري الذي يمارسه الكاتب تجاه قارئه. كما تكون أقرب إلى الإمكان حين تتعلق أحيانا بثقافة مشتركة أو بتخصص مشترك. فالمتخصص في فكر مؤلف ما يكون أنجح في الترجمة من متطفل عليه. وهكذا يمكن لترجمة ممكنة أن تتحول إلى عذاب أليم على ذلك المتطفل الذي يعيش جحيمها بجهله للمؤلف ولتضاعيف فكره.
تتمنَّع الترجمة أو تكون ممتنعة حين تكون متعلقة مثلا بفكر فيلسوف يفكك الفكر ويدخله في متاهات للتأمل تستعصي أحيانا على الإدراك فكم بالأحرى على الترجمة، حتى لا نتحدث عن الشعر، الذي نعتبر أن ترجمته أعوص من صعود جبل، بالنظر إلى الاشتغال الدقيق على اللغة وعلى الصور وتفكيك مفهومنا لهما باستمرار. تلكم مثلا هي كتابات هوسرل أو جاك دريدا أو شعر مالارمي. أما الترجمة المستحيلة فهي تلك التي يكون موضوعها الفكري أو التخييلي هو اللغة أي الأداة التواصلية التي بها يكتب المؤلف وذلكم هو حال بعض كتابات الفيلسوف الفرنسي جاك دريدا أو كتاب “عشق اللسانين” لعبد الكبير الخطيبي مثلا.
بيد أن الكثير من الكتابات المتمنعة التي تعبر التاريخ من غير ترجمة، مع أنها تكون مرجعية ويتم الاعتماد عليها كثيرا، قد تغدو في لحظة معينة قابلة للترجمة حين يتنطع لها مترجم مغامر فيجرها لحلبة الإمكان. وذلكم مثلا هو حال “أزهار الشر” لبودلير أو كتاب “الخيال الخلاق” للفيلسوف الفرنسي هنري كوربان.
لكن الترجمة ليست دوما مضمونة الوجود. فالحاجة الاستعجالية للترجمة كثيرا ما تجعل العديد من المترجمين يلجأون إلى ترجمة كتب مرجعية لفرويد أو ماركس أو دريدا عن الفرنسية أو عن الإنكليزية، أي عن لغة وسيط لا عن اللغة الأصل. وبالرغم مما لهذه الترجمات من دور في مراحل معينة فإنها تستنفد مهمتها ما إن تتم ترجمة أدق من اللغة الأصل. فأنا لا أتخيل ترجمة لفرويد أو لاكان مثلا من لغة وسيط لأن اشتغال الأول على معاني التأويل النفساني واشتغال الثاني على البنية اللغوية التي تقود إلى الأعماق النفسانية يجعلان كل ترجمة من لغة ثانية ترجمة تحمل معوقات نجاحها في ذاتها. الترجمة من لغة وسيطة تعيش تحت خطر الموت المحقق، وذلك بولادة ترجمة مباشرة تلغيها وترديها قتيلة.
تكمن أكبر صعوبة في الترجمة في تحدي النص للمترجم، أي في استعلانه لذاته باعتباره وحداني الوجود والتداول. يسعى المترجم إلى ترويض النص كفرس جموح منطلق، ويحاول أن يمسك بهلاميته أو شبحيته الممكنة. بيد أن المترجم الكفؤ لا يمكن إلا أن يكون عنيدا. وعناده ذاك ليس على سبيل النزوة أو الإحساس بالخذلان، وإنما لمعرفته بقوة النص وسلطته. وهكذا يقرأ النص ويعيد قراءته ويترجم المقطع ويعيد صياغته حتى تستوي الترجمة لديه في ما يشبه المناظرة. وهو يستعين على حاله بالتعمق في استيضاح ما غمض من النص، لاجئا تارة إلى كتب أخرى ومحاولا استفهام علاقة النص بالنصوص التي يخفيها أو يحجبها أو يتمثلها أو يدمجها في عملية تناص معلنة أو مضمرة.
والحقيقة أن النص الأكثر استعصاء هو ذلك الذي يشبه دائرة المعارف، بما يقزّم أكثر المترجمين ثقافة ودراية بالموضوع. هذا ما أسميه الطابع القنفوذي للنص. وهذا الطابع إن كان من الممكن أحيانا تملكه، فإنه في مناح أخرى يصبح أشبه بالاستكشاف الجديد للمترجم، توسع من أفق ثقافته وإدراكه وتشحذ ذكاءه التأويلي والترجمي. بيد أن هذه الطبيعة التناصية القنفوذية شائكة بما يكفي، وهي تدمي لغة الناقد وذاته وأسلوبه بحيث يخرج من المعركة مثخنا بالجراح، أشبه بالأبطال الأسطوريين اليونانيين الذين لا يحققون النصر إلا بما يعادل جراحهم ووهن جسدهم وعدم قدرتهم على التلذذ بالنصر.
بين النص المستعصي والمترجم ثمة علاقة مركبة، بالغة التشابك. فثمة عشق أولي للنص يجعل الترجمة عملية رغبة ترجمية لا فقط مسألة طلبية أو تعاقد. وثمة ألم ومعاناة يومية في الخوض في متاهاته. وثمة الحيرة والشك في النفس وحالات اليأس والخيبة. وثمة الصعوبات المتعلقة باللغة والثقافة وبنياتها الأنثربولوجية والأسطورية والدينية. لكن المترجم الكفؤ يعيش الترجمة باعتبارها تجربة عشق ووصال ذات طابع جسدي واقعي مع جسد اللغة والنص، وباعتبارها تجربة صوفية يتخطى فيها مقامات الوجد حتى يتوحد بالنص الأصل وينفصل عنه في الآن نفسه. المترجم بهذا المعنى مجنون الآخر كما كان قيس مجنون ليلى. لا يهدأ له بال ولا تقر له عين حتى يعيش الوصال مع الآخر، فيلد الآخر فيه ويكوّنه من صلب لغته وترائبها. لذلك أقول دوما إن الترجمة حب وضيافة، لأن المترجم يستضيف الآخر بحب ويمنحه جسد لغته ولسانه وشفتيه… وليس ثمة كرم أكبر من هذا ولا عشق أعمق منه…
أما واسطة عقد الصعوبات والتحديات فهي هذا العشق الدفين الذي يعيشه المترجم ويكنه لمجموعة من النصوص من غير أن يستطيع في حياته القصيرة واهتماماته المتعددة أن ينذر حياته لها. لذا فهو كما الكاتب يعتبر أن أجمل النصوص التي يتوق إليها هي تلك التي لم يترجمها بعد.
كيْد الترجمة
الترجمة امرأة لعوب. إنها تمارس مع المترجم لعبة خليقة بما نجده في ألف ليلة وليلة. من ثم فكل نص هو أشبه بالمرأة التي تشترط على طالب يدها أن يفك ألغازا معينة على سبيل الاختبار. ولذلك فكل ترجمة محنة وامتحان. إنها أيضا أشبه بالمعبد الإغريقي الذي يطلب من الداخلين أن يفكوا ألغاز الأوراكل…
الترجمة يمكن أن تكون أيضا قاتلة كما يمكن أن تكون مخلِّصة. والمفارقة هنا أن الخطأ في الترجمة قد يكون مخلِّصا؛ إذ يُحكى أن الألمان في خضم الحرب العالمية كانوا يتقفَّوْن خطى الحلفاء. وكان أن اجتمع أيزنهاور وتشرشل وشارل ديغول ومحمد الخامس بالدار البيضاء سنة 1944. وبما أن المخْبر الألماني كان قد كتب باللغة الألمانية برقية تقول بأن اجتماع الحلفاء كان بمدينة كازابلانكا Casablanca، فإن المترجم لم يخَل أبدا أن الرئيس الأميركي سوف يتواضع ليقيم اجتماعا في مكان غير البيت الأبيض Casa Blanca. ولأن ترجمة كازا بلانكا هي البيت الأبيض، فقد خال المترجم أن الأمر يتعلق بالبيت الأبيض مقر الرئيس الأميركي، غير منتبه للفراغ الذي يجعل من المدينة كلمة واحدة ومن البيت الأبيض كلمتين عبارة عن اسم ونعت. وهكذا مر الاجتماع من غير أي مناورة حربية أو هجوم يستهدف هذا الاجتماع التاريخي الذي كان له دور حاسم في نهاية الحرب العالمية الثانية.
كما يمكن للترجمة أن تكون ماكرة لأنها تمارس ترجمتها الخاصة. فقد ترجم أحدهم فصلا من رواية “مراكش المدينة” للروائي الفرنسي وأحد رواد الرواية الجديدة، كلود أوليي claude Ollier، وحين وصل إلى عبارة “Livre de lecture” ترجمها بكتاب القراءة. والحال أن كلود أوليي الذي عاش بمراكش لمدة معينة في الخمسينيات لأن زوجته كانت مدرسة في عهد الحماية الفرنسية، يعرف اللغة العربية. ولذلك فقد قام بترجمة كلمة قرآن إلى “Livre de lecture” أي الكتاب الذي يقرأ ويُتلى. وبما أن المترجم لم ينتبه إلى سياق العبارة التي أتت في الحكي عن صبيان يتلون القرآن الكريم في الكُتّاب، ولم ينتبه أيضا إلى أن الكاتب مارس الترجمة الحرفية إلى لغته الأم كي يتملك الصورة، فإنه ترجم حرفيا عبارة مترجمة بدورها. والخطير في الأمر هنا أن كلمة القرآن كلمة اصطلاحية مرجعية، لا يجوز للمترجم أن يحرفها، وإن كان من حق المؤلف أن يتناولها بالطريقة التي يرغب فيها. من هنا تكون الترجمة المضاعفة لعبة ماكرة يمارسها المؤلف ويختبر بها حس المترجم وقدرته على الإمساك بلعبة الكتابة.
لست ممن يتصيدون أخطاء المترجمين، ولست أدري لم لا أسجلها عند مصادفتها، هل رأفة بمهنة المترجم الصعبة والمتعبة أم تجاوزا، خاصة أنني أعرف أن المترجم لا يقرأ عادة الترجمات بل يفضل قراءة النصوص الأصلية؟ ثم إن أخطاء المترجمين فيها المأساوي الذي يدعو إلى البكاء كإخطاء المعنى وتحريفه، وفيها المأساوي الذي يغدو طريفا يدعو إلى الضحك.
ومن ذلك أنني منذ زمن قرأت لمترجم نبيه وعارف ترجمة لميشيل فوكو. وفي سياق الحديث يتحدث ميشيل فوكو عن “هـ. أرندت”، ويسترسل في بسط تصورها للسلطة. وبما أن المؤلف لم يثبت الاسم الكامل للفيلسوفة الألمانية، فإن المترجم اعتبرها ذكرا وذكّرها في ترجمته للفقرة المتعلقة بها. وكانت كتابات هنا أرندت حينها غير معروفة وغير متداولة في الساحة الفكرية العربية. ولو كان المترجم يتمتع ببعض الفضول لبحث في الأمر ولاكتشف أن الأمر يتعلق بإحدى المفكرات الأكثر تأثيرا في الفكر المعاصر وأنها في بعض المناحي أكثر مرجعية من ميشيل فوكو نفسه.
ومن ذلك أيضا ترجمة تثير فيّ الضحك على الدوام كلما صادفتها هنا وهناك، وهي ترجمة عبارة “les arts plastiques” بالفنون البلاستيكية، وكأن الأمر يتعلق بفنون تستخدم مادة البلاستيك المصنعة من البترول. والحال أن المعروف منذ زمن هو ترجمتها بعبارة الفنون التشكيلية…
ضفة ثالثة



